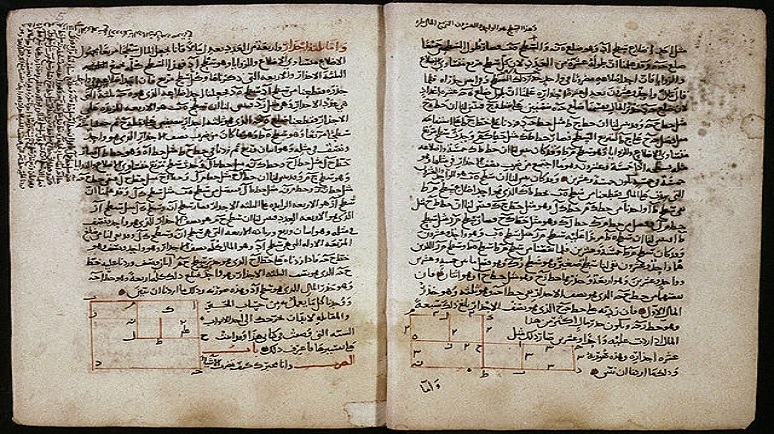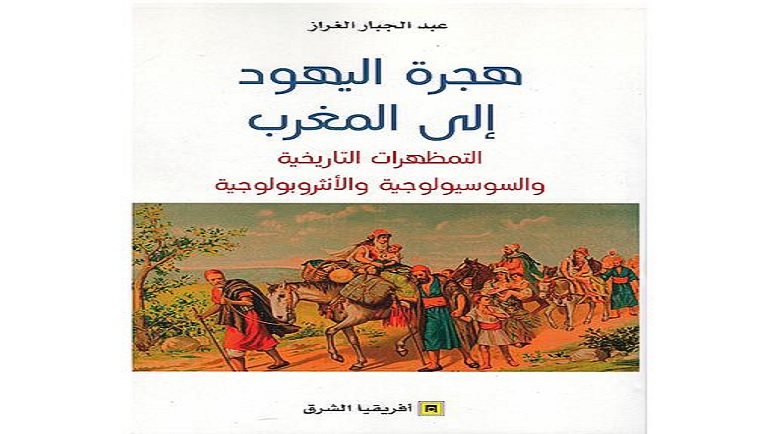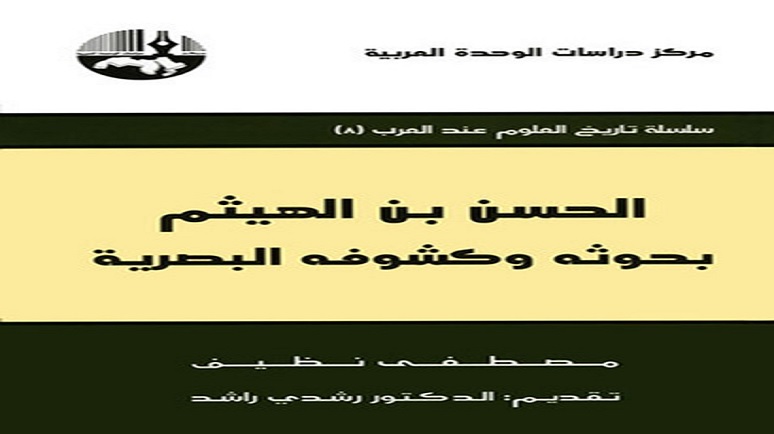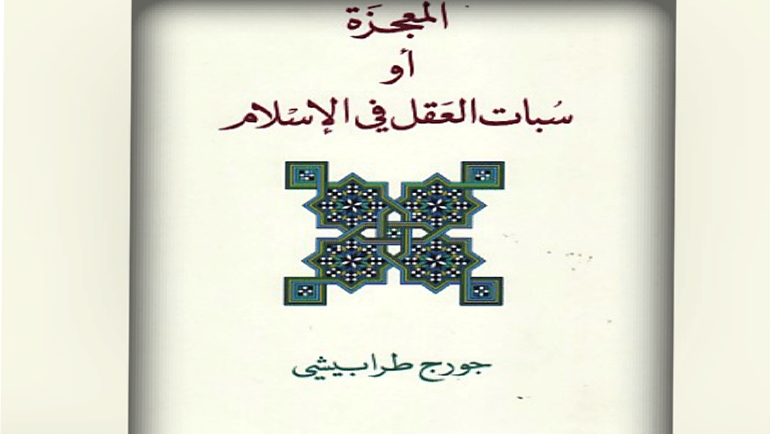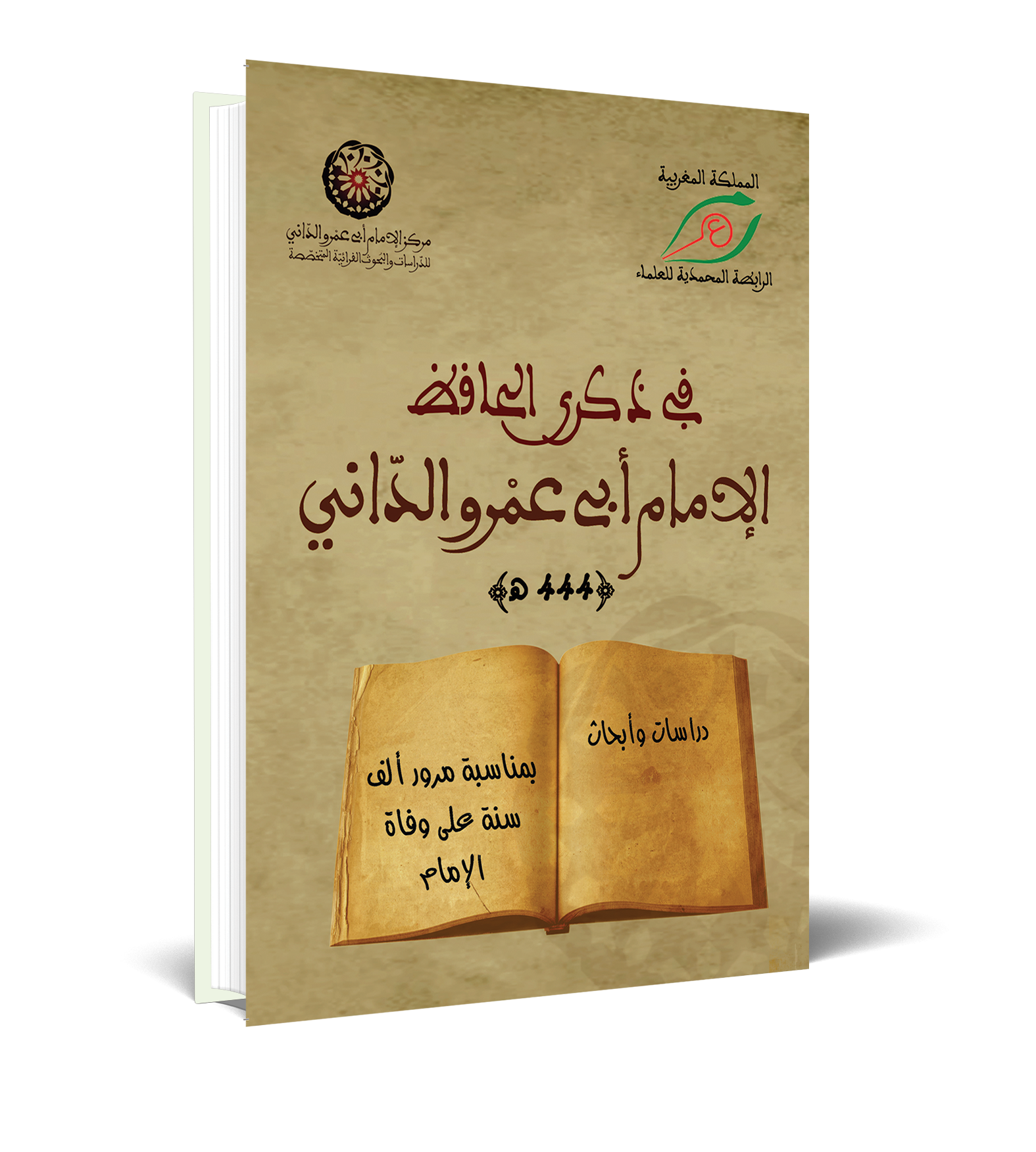الحلقة السابعة – بلاغة الالتفات من خلال فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للإمام العلامة شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبيّ (ت:743هـ)

إن القرآن الكريم هو قانون الأصول الدينية، ودستور الأحكام الشرعية، وهو المثل الأعلى في البلاغة بنظمه الغريب ورصفه العجيب، وسبكه الرائق وحبكه الفائق، ومبناه الرقيق ومعناه الدقيق، واحتوي بين دفتيه على نكت بلاغية تعنّ لها وجوهُ البلغاء، ويخرون لروعتها ساجدين.
ومن نكتها البديعة وأساليبها الرفيعة أسلوب الالتفات فهو لطيف المسلك، بديع المنزع، سهل المأخذ، ويعدّ «من أجل علوم البلاغة، وهو أمير جنودها، والواسطة فى قلائدها وعقودها»(1)، وقد اطلع جار الله الزمخشري على أغواره، وعني بكشف أسراره، إلى الإمام الطيبي الذي حرص على تفصيل مجمله وتبيين مشكله.
تعريف الالتفات:
الالتفات مصدر التفت يلتفت التفاتا، قال ابن الأثير –رحمه الله -: «وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل فيه عن صيغة إلى صيغة، كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر..» (2).
وأما في اصطلاح البلاغيين فهو –كما قال الطيبي رحمه الله –: «الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث إلى الأخرى لمفهوم واحد. وذلك الانتقال من دأبهم وافتنانهم في الكلام»(3)، وقال في «التبيان»: «الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث – أعني الحكاية والخطاب والغيبة – إلى الأخرى لمفهوم واحد رعايةً لنكتة»(4).
وهذا التعريف هو المشهور، لكنْ للسكاكي (ت:626هـ) رأي آخر، قال في «المفتاح»: «واعلم أن هذا النوع: أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختص المسند إليه ولا هذا القدر بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر ويسمى هذا النقل التفاتا عند علماء علم المعاني»(5). ومعنى كلامه أن الالتفات «إتيان الكلام على أسلوب مخالف لأسلوب سابق مطابقا أو لم يسبقه غيره والمعنى يقتضى خلافه»(6)، وإلى هذا التعريف مال يحيى بن حمزة العلوي في طرازه، وانتصر له، ونص كلامه: «هو العدول من أسلوب فى الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول، وهذا أحسن من قولنا: هو العدول من غيبة إلى خطاب، ومن خطاب إلى غيبة؛ لأن الأول يعم سائر الالتفاتات كلها، والحد الثانى إنما هو مقصور، على الغيبة والخطاب لا غير، ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضى إلى المضارع، وقد يكون على عكس ذلك، فلهذا كان الحد الأول هو أقوى دون غيره»(7).
والفرق بين التعريفين أن الأول أخص من قول السكاكيّ؛ فقوله تعالى: (عبس وتولى) [عبس:1] التفات على رأيه لأنه منقول عن (عبستَ وتوليتَ)، وليس التفاتا على التعريف الأول لعدم تقدّم خلافه(8). قال ابن معصوم: «فكل التفات عند الجمهور التفات عنده من غير عكس»(9).
والالتفات فن خطير الشأن، وتتجاذبه علوم البلاغة الثلاثة وإن كانَ بمباحث علم المعاني ألصق، وبمعاقده أعلق، ولذلك نجده ضمن أبواب علم المعاني في «مفتاح العلوم»، و«الطراز»، وضمن أبواب علم البديع في كتاب «التبيان» لصاحبنا الإمام الطيبي (ت:743هـ)، ويبين ذلك في «فتوح الغيب» بقوله: «ويمكن أن يقال: إن الالتفات من حيث إنه يفيد التطرية وحسنها من البديع، ومن حيث إفادته التفنن والإخراج لا على مقتضى الظاهر من المعاني، ومن حيث كونه مستلزماً لإفادة دقيقة مطلوبة من الكناية التي هي نوع من أنواع البيان»(10).
والالتفات أسلوب لطيف من أساليب البلاغة، وفن بديع من فنون اليراعة، فهو باب من أبواب الخروج عن مقتضى الظاهر، وإجراءٌ للكلام على طرق مختلفة لنكت لطيفة وفوائد منيفة، حتى سُمي بشجاعة العربية، «لأن الشجاعة هي الإقدام، وذاك أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره، ويتورّد ما لا يتورّده سواه، وكذلك هذا الالتفات في الكلام؛ فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات»(11).
يقول الزمخشري: «وهو [أي الالتفات فنّ من الكلام جزل، فيه هزّ وتحريك من السامع، كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكيا عن ثالث لكما: إنّ فلانا من قصته كيت وكيت، فقصصت عليه ما فرط منه، ثم عدلت بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة الحميدة في مجارى أمورك، وتستوي على جادّة السداد في مصادرك ومواردك، نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبيه، واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء، وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من طبعه ما لا يجده إذا استمررت على لفظ الغيبة، وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنف، يستفتح الآذان للاستماع ويستهش الأنفس للقبول»(12).
ويقول السكاكي منوّها بحسن موقعه: «والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب على أسلوب أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملأ باستدرار إصغائه وهم أحرياء بذلك، أليس قرى الأضياف سجيتهم ونحر العشار للضيف دأبهم وهجيراهم، لا مزقت أيدي الأدوار لهم أديما، ولا أباحت لهم حريما، أفتراهم يحسنون قرى الأشباح، فيخالفون فيه بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون قرى الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب ، وإيراد وإيراد، فإن الكلام المفيد عند الإنسان لكن بالمعنى لا بالصورة أشهى غذاء لروحه وأطيب قرى لها»(13).
وليس هذه التطرية التي تحصل بالانتقال من أسلوب لآخر «لمجرد كونه انتقالاً، بل لاستتباعه لطيفة؛ إذ اللفظ متبوع المعنى، فالتطرية إنما تحصل من انتقال المعنى من قبل انتقال اللفظ؛ لأن الأرواح إنما تستلذ بالمعنى»(14).
صور الالتفات:
يأتي الالتفات على ست صور، وهي(15):
1- الالتفات من التكلم إلى الخطاب.
2 – الالتفات من التكلم إلى الغيبة.
3- الالتفات من الخطاب إلى التكلم.
4- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة.
5- الالتفات من الغيبة إلى التكلم.
6- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.
أمثلة:
ذكر الإمام الطيبي – رحمه الله – في فتوحه بعضا من هذه الصور الست، ومنها:
1- الالتفات من الغَيْبة إلى الخطاب:
ومن أمثلته قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ … إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)، قال الزمخشري: «فإن قلت: لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان، قد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) [يونس: 22]، وقوله تعالى: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ) [فاطر: 9]»(16). قال الطيبي في تحرير كلامه: «قلت: الجواب من وجهين:
– أحدهما: أن قوله “لم عدل؟ ” كان استفهاماً فيه نوع إنكار، أي: ماذا حمله على ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر، وكان الأصل أن يجري الكلام على الغيبة. أجاب: أن هذا ليس بنكير في علم البيان، بل هو مشهور ومسمى بالالتفات الذي هو الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث إلى الأخرى لمفهوم واحد. وذلك الانتقال من دأبهم وافتنانهم في الكلام. ثم أتى بجواب آخر أعم منه فقال: “ولأن الكلام” أي: مطلق الكلام سواء صدر منهم أو من غيرهم “إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامع”، وهذه الطريقة وهي أن يتضمن الجواب الزيادة على المطلوب من الأسلوب الحكيم؛ ولهذا أتى بالمستشهدات المتنوعة الجامعة لأكثر أنواع الالتفات، لتكون كالتعريف له. وفيما شرحنا كلامه لطيفة وإرشاد إلى أن الأمثلة كالتعريف حيث وضعنا الحد موضعها، وفيما سلك إيجاز من وجه، لأنه علم منه حده وأقسامه.
– وثانيهما: أن في الكلام إطناباً، وأنه جواب واحد. وحقيقة الجواب قوله: “ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية” وقوله: “وذلك على عادة افتنانهم” توطئة للجواب، وقوله: “هذا يسمى الالتفات” توطئة للتوطئة. ونحوه سؤاله في أول “طه”: فإن قلت: ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب؟ قلت: غير واحدة، منها: عادة الافتنان في الكلام وما يعطيه من الحسن والروعة، ومنها كذا وكذا. و”الواو” في “وما يعطيه” كالواو في “ولأن الكلام” من عطف البيان على طريقة: أعجبني زيد وكرم »
* ومن أمثلته قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[البقرة: 21]، قال الزمخشري –رحمه الله-: «لما عدّد اللَّه تعالى فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين، وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف أمورهم، وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها، ويحظيها عند اللَّه ويرديها، أقبل عليهم بالخطاب»، قال الطيبي: «واللطيفة التي يتضمنها هذا المقام هي أنه تعالى لما عدد الفرق الثلاث بمسمعٍ منهم، مخاطبًا غيرهم، ووصف كل فرقةٍ بما اختصت به مما يسعدها ويشقيها، ويحظيها ويرديها؛ أقبل عليهم بقوله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) يعني: أيها المؤمنون كما شرفتكم ورفعت منزلتكم ومنحكتم الكتاب الكامل، ففزتم بالهدى عاجلاً، وبالفلاح آجلاً، دوموا على ما أنتم فيه، ولا تتوانوا، وزيدوا في الشكر والتقوى، لأزيدنكم في النعمة والإفضال، ويا أيها الكافرون أقلعوا عما أنتم فيه، وارجعوا عن عبادة غير الله الذي لا نفع فيه، ولا ضر، وتوجهوا إلى عبادة من خلقكم وآباءكم، وجعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناءً، ورزقكم وكيت وكيت، ويا أيها المنافقون، اعلموا أني عالم بما في ضمائركم وأسراركم، وأعلم ما تأتون وما تذرون، فأخلصوا العبادة لخالقكم الذي أنعم عليكم وعلى أسلافكم لعلكم تتقون، فتحذرون عن النفاق» (2/285)
*وقوله: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) [البقرة: 83]، «قوله: (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ) على طريقة الالتفات)، وهو من الغيبة في قوله: (أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) إلى الخطاب، والفائدة التأنيب والتوبيخ، استحضرهم فوبخهم»(2/557).
* وقوله: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ). فقوله (أَمْ حَسِبْتُمْ) التفات خفيّ نبه إليه الزمخشري تنبيها خاطفا بقوله: (قال لهم على طريقة الالتفات التي هي أبلغ: (أم حسبتم) ..)، ثم زاده الطيبي كشفا وإيضاحا، وقال: «فإن قلت: أين الالتفات ها هنا، فإن الالتفات هو: الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث إلى الأخرى لمفهوم واحد، وهذا المعنى ها هنا مفقود؟ قلت: قوله: “ولما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف”، معناه: أن قوله: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ) الآية، كان كلاماً مشتملاً بظاهره على ذكر اختلاف الأمم السالفة والقرون الخالية، وعلى ذكر من بعث إليهم من الأنبياء، وما لقوا منهم من الشدائد بعد إظهار المعجزات، ومدمجاً لتشجيع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الثبات والصبر مع المشركين، قال الله تعالى: (وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ) [هود: 120]، فمن هذا الوجه كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرادين في هذا الكلام غائبين، يؤيده قوله: (فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا)، فإذا قيل لهم بعد ذلك: (أَمْ حَسِبْتُمْ) كان نقلاً من الغيبة إلى الخطاب، والكلام الأول تعريض للمؤمنين بعدم التثبت والتصبر لأذى المشركين، فكأنه وضع ذلك موضع: كان من حق المؤمنين التشجع والتصبر على مكابدة المشاق من المخالفين وأعداء الدين تأسياً بمن قبلهم لجامع الإيمان، كما صرح به الحديث النبوي، وهو المضرب عنه “ببل” التي تضمنها (أَمْ)، أي: دع ذلك، أحسبوا أن يدخلوا الجنة ولما يأتهم مثل الذين خلوا من قبلهم، كقوله تعالى: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [العنكبوت: 2]، فترك ذلك إلى الخطاب مريداً للإنكار والاستبعاد» (3/340)
* وقوله: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (*) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) [النساء: 78- 79] قوله: «ثم وبخهم وعنفهم حيث رتب عليه بالفاء قوله: (فَمَالِ هَؤُلاءِ القَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا)، وجاء باسم الإشارة تحقيراً، وخص الفقه بالذكر تسجيلاً عليهم بعدم الفطنة، أي: فما لهؤلاء الجهلة لا يفطنون ما يتفوهون من لزوم تعدد الخالق المستلزم للشرك المؤدي إلى فساد العالم، ثم استؤنف بما هو حقيقة الجواب قائلاً: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ) على الخطاب العام، ليدخلوا فيه دخولاً أوليًّا مشتملاً على نوعٍ من الالتفات، أخبر عنهم أولاً على سبيل الغيبة في قوله: (وإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا)، ثم جعلهم كالحاضرين المشاهدين في قوله تعالى: (فَمَالِ هَؤُلاءِ) نعياً عليهم سوء مقالتهم إلى غيرهم، ثم صيرهم كالمخاطبين في قوله: (مَا أَصَابَكَ) مزيداً للتوبيخ على ما نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إضافة الشؤم إليه، »(5/ 77)
* وقوله: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (*) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا) [النساء: 145 – 147]، ففي قوله: (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ) التفات من الغيبة (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ…) إلى الخطاب، قال الطيبي –رحمه الله-: «التفت تقريعاً لهم أن ذلك العذاب كان منهم وبسبب تقاعدهم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة، وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية، وإلا فإن الله غني عن عذابهم فضلاً عن أن يوقعهم في تلك الورطات، فقوله: (إِنْ شَكَرْتُمْ) فذلكة لمعنى الرجوع من الإفساد في الأرض إلى الإصلاح فيها، ومن اللجأ إلى الخلق إلى الاعتصام بالله، ومن الرياء في الدين إلى الإخلاص فيه، فقوله تعالى: (وَآمَنْتُمْ) تفسير له وتقرير لمعناه، أي: وآمنتم الإيمان الذي هو حائزٌ لتلك الخلال الفواضل، جامع لتلك الخصال الكوامل، فتقديم الشكر على الإيمان، وحقه التأخير في الأصل، إعلام بأن الكلام فيه، وأن الآية السابقة مسوقة لبيان كفران نعمة الله العظمى والكفر تابع له، فإذا أخر الشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف» (5/208).
* وقوله: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (*) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (*) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ)[النحل:6]، قال الطيبي: «وأما تخصيص ذكر جنس الإنسان فلإفادة الالتفات، وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب».(9/ 79)
* وقوله: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (*) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ) [الأنفال: 13، 14]، قال الزمخشري: (وفي (ذلِكُمْ) للكفرة، على طريقة الالتفات)، قال الطيبي: «قوله: (على طريقة الالتفات): التفت من (شَاقُّوا اللَّهَ) وهو غيبة، إلى (ذَلِكُمْ) وهو خطاب»(7/48)
* وقوله: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (*) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا)[مريم:88-89]، قال الزمخشري: «وفي قوله (لَقَدْ جِئْتُمْ) وما فيه من المخاطبة بعد الغيبة- وهو الذي يسمى الالتفات في علم البلاغة- زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله، والتعرّض لسخطه، وتنبيه على عظم ما قالوا»(10/111)
* وقوله: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (*) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا) [مريم: 71 – 72]. قال الزمخشري: «وَإِنْ مِنْكُمْ) التفاتٌ إلى الإنسان، يعضده قراءة ابن عباس وعكرمة رضى الله عنهما: (وإن منهم). أو خطاب للناس من غير التفات إلى المذكور، فإن أريد الجنس كله فمعنى الورود دخولهم فيها)، ثم قال الطيبي: «المرادُ بالإنسان هو: الذي ذُكر عنه قوله: (وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً)، وهو – على ما فسر- يجوز أن يُراد به الجنسُ، وأن يُراد به بعض الجنس وهم الكفرة، والالتفات لازمٌ لما ذكر بُعيدَ هذا من قوله: “وإن أريد الكفارُ خاصةً”، وإما أن يُراد به ابتداء كلام ولا التفات فيه، ولا يلتفت إلى الإنسان المذكور من قبلُ، فالمخاطبون: كل من يصلح أن يخاطب لعظَم الخطب، ولذلك عدل من الإنسان إلى الناس»(10/75).
* وقوله: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا)[الفرقان:32] فقوله: (كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ) ففيه التفات، ولمَّح إلى ذلك الطيبي عند ذكره لحكمة تنزيل القرآن مفرقا، بقوله: «والحكمة فيه أن يقوي بتفريقه فؤاد الرسول – صلى الله عليه وسلم -، حتى يعيه ويحفظه ويبين لأمته ما يسنح له من الحوادث المتجددة، ويجيب أسئلة السائلين، ويظهر ما يقتضيه الوقت من الأحكام، وينسخه بحسب المصالح، وفي الكلام التفاتٌ، والله تعالى أعلم»(11/227).
*وقوله: (ومَا يَسْتَوِي الأَعْمَى والبَصِيرُ والَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ولا المُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ)[غافر:58]، قال الزمخشري: «وقرئ: (تَتَذَكَّرُونَ) بالياء والتاء، والتاء أعمّ».
قال الطيبي: «قال القاضي [أي البيضاوي]: لدلالة التاء على تغليب المخاطب أو الالتفات أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة» ثم قال الطيبي: «قلت: التغليب وإن كان أعم؛ لأنه أشمل في التناول، ولكن غير مناسب للمقام، وأما الالتفات فإنه أتم فائدة وهو أنسب للمقام. وهذه الآية متصلة بقوله: (لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) وهو كلام مع المجادلين، كما قال: فحجوا بخلق السماوات والأرض. والعدول من الغيبة إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على اللعن الشديد والإنكار البليغ» (13/532)
* وقوله: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (*) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)[التحريم:3-4]، قال الزمخشري: «(إن تَتُوبَا) خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات، ليكون أبلغ في معاتبتهما»، قال الطيبي: «قوله: (على طريقة الالتفات)، التفت من قوله: (وإذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ) إلى الخطاب» (15/500).
* وقوله: (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (*) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (*) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)[محمد:20-22]، ففي قوله: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) التفات، قال الزمخشري: «وقد نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات؛ ليكون أبلغ في التوبيخ»(14/350)
* قوله: (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (*) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (*) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (*) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (*) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (*) جَزَاءً وِفَاقًا (*) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (*) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (*) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (*) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا)[النبأ:21-30]، ففي قوله: (فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا) التفات وشاهد على أن الغضب، قال الطيبي: «قوله: (وبمجيئها على طريقة الالتفات شاهداً على أن الغضب قد تبالغ)، وذلك أنه تعالى لما حكى مآب الطاغين واستمرار لبثهم في جهنم، وأن لا ذوق لهم فيها سوى الحميم والغساق، وعلل ذلك على سبيل الشِّكاية إلى الغير بقوله: (إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا) أي: لا يخافون أن يُحاسبوا، كناية عن أنهم كانوا ينكرون البعث إنكاراً بليغاً، ثم عظم شأن تكذيبهم رسل الله ووحيه بصيغة التعظيم وأكده بقوله: كذاباً، التفت إليهم قائلاً: فذوقوا أيها الجاحدون المكذبون ذلكم الغساق والحميم، وليس لكم عندي سوى المزيد من أنواع العذاب، هذا كما تشكو إلى الناس جانباً، ثم تقبل عليهم إذا حميت في الشكاية مواجهاً بالتوبيخ والذم وإلزام الحُجة»(16/255)
* وقوله: (عَبَسَ وَتَوَلَّى (*) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (*) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (*) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى) [عبس: 1 – 4]، قال الطيبي: «إن في إسناد عبس وتولى إلى ضمير الرسول? في حال الغيبة، إشعاراً بأن ذلك مما لا يليق بمنزلة من في صدد الرسالة، لا سيما أنه ما أُرسل إلا رحمة للعالمين، وأنه لعلى خلق عظيم؛ فكأن العابس والمتولي غيره، ثم التفت يخاطبه قائلاً: وما يُدريك؟ تأنيباً، أي: مثلك بتلك المنزلة لا ينبغي أن يتصدى لغني ويتلهى عن فقير» (16/291).
* وقوله: (فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ)[التين:7]قال الزمخشري: «فإن قلت: (فَما يُكَذِّبُكَ) من المخاطب به؟ قلت: هو خطاب للإنسان على طريقة الالتفات، أي: فما يجعلك كاذبًا بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل، يعنى أنك تكذب إذا كذبت بالجزاء، لأنّ كل مكذب بالحق فهو كاذب، فأي شيٍء يضطرك إلى أن تكون كاذبًا بسبب تكذيب الجزاء». قال الطيبي: «قوله: (وقيل: الخطاب لرسول الله? )، عطف على قوله: “هو خطاب للإنسان”، وعلى هذا لا يكون في الكلام التفات، وتكون “ما” بمعنى “من”، أي: فمن يكذبك أيها الرسول الصادق المصدق، بما جئت به من الدين الحق، أو بسبب الدين بعد ظهور هذه الدلائل الدالة على نبوتك؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يحكم بينك وبين أهل التكذيب. وإذا قيل: إن الخطاب للإنسان، ينبغي أن يذهب إلى الالتفات، لما سبق من قوله: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)، ويجعل الباء للتسبيب، لأن الإنسان هو المكذب، والمعنى: أيها الإنسان، ما الذي يلجئك إلى أن تكون كاذباً بسبب تكذيب الجزاء. وفي الكلام تعجب وتعجيب؛ وذلك أنه تعالى لما قرر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رده إلى أرذل العُمر، دل على كمال قدرته على الإنشاء والإعادة، فسأل بعد ذلك عن سبب تكذيب الإنسان بالجزاء، لأن ما يتعجب منه يُخفي سببه، وهذا كما ترى ظاهر جلي، وإليه الإشارة بقوله: “فما سبب تكذيبك أيها الإنسان بالجزاء، بعد هذا الدليل القاطع؟ “، وعلى هذا قوله: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)، وعيد للكفار، وأنه يحكم عليهم بما هو أهله» (16/508)
2- الالتفات من الخطاب إلى الغَيْبة:
ومن أمثلته قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا)[النساء:47]، قوله: ((أَوْ نَلْعَنَهُمْ) يحتمل أن يكون التفاتا كما ذكر الزمخشري، قال الطيبي: «أراد الالتفات من الخطاب المستفاد من البدء في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ) إلى الغيبة في قوله: (أَوْ نَلْعَنَهُمْ)». (5/ 23)
* وقوله: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) [النساء: 64] ففي قوله: (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) التفات من الخطاب (جَاءُوكَ) إلى الغيبة، قال الزمخشري: «لم يقل: واستغفرت لهم، وعدل عنه إلى طريقة الالتفات، تفخيماً لشأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وتعظيماً لاستغفاره، وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه الرسول من اللَّه بمكان» (5/48)
* وقوله: (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [النحل:1]، ففي قوله: (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) التفات من الخطاب (فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ) إلى الغيبىة، قال الطيبي: «التفت من الخطاب إلى الغيبة في قوله: (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) نعياً على المشركين خاصة إلى غيرهم واستبعاداً لسوء صنيعهم، يعني: ماذا يستعجل منه أولئك البُعداء مع هذه العظيمة التي ارتكبوها، كقوله تعالى: (مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) [يونس: 50]، فما أبعدهم من قوم، وما أجهلهم من جيل في إشراكهم بالله تعالى مع تعاضد الأدلة السمعية والعقلية في قلعه واستعجالهم فيما يُرديهم!»(9/73).
* وقوله: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (*) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ)[الأنبياء:92-93]، قال الزمخشري: «الأصل: وتقطعتم، إلا أن الكلام حرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات، كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم، ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله. والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا، كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونه، فيطير لهذا نصيب ولذاك نصيب، تمثيلا لاختلافهم فيه، وصيرورتهم فرقا وأحزابا شتى. ثم توعدهم بأنّ هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون، فهو محاسبهم ومجازيهم»(10/401).
* وقوله: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ) [النور:12]، قال الزمخشريّ: «قلت: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم؟ ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر؟ قلت: ليبلغ في التوبيخ بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان، دلالةً على أن الاشتراك فيه مقتضٍ أن لا يصدق مؤمنٌ على أخيه ولا مؤمنةٌ على أختها قول غائبٍ ولا طاعن. وفيه تنبيهٌ على أن حق المؤمن إذا سمع قالةً في أخيه، أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك، وأن يقول بملء فيه بناءً على ظنه بالمؤمن الخير: (هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ)، هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته، كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه بأخوات!» (11/35)
* وقوله: (أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النور:64]، قال الزمخشري: «والخطاب والغيبة في قوله: (قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ) يجوز أن يكونا جميعاً للمنافقين على طريق الالتفات. ويجوز أن يكون (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) عاماً، (يُرْجَعُونَ) للمنافقين. والله أعلم»،: «قوله: (ويجوز أن يكون (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) عاماً)، أي: في المنافقين والمؤمنين، أما في المؤمنين وأحوالهم فمن قوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) الآية، وأما في المنافقين وخبثهم فمن قوله: (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)، فيكون تسليةً ووعداً بالنسبة إلى المؤمنين، وتهديداً بالنسبة إلى المنافقين، وتخويفاً في الدنيا، ووعيداً في العقبى خاصاً في حق المنافقين، لأن قوله: (فَيُنَبِّئُهُمْ) يأبى أن ينزل على المؤمنين، ولذلك غير التغليب في الخطاب بأنتم إلى الغيبة في (فَيُنَبِّئُهُمْ).»(11/ 165).
*قوله: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)[الروم:39] قال الزمخشري: «وقوله تعالى: (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) التفات حسن، كأنه قال لملائكته وخواص خلقه: فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم: هم المضعفون. فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم المضعفون. والمعنى: المضعفون به؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى ما، ووجه آخر: وهو أن يكون تقديره: فمؤتوه أولئك هم المضعفون. والحذف لما في الكلام من الدليل عليه، وهذا أسهل مأخذًا، والأوّل أملأ بالفائدة»، وقال الطيبي: «قوله: (فهو أمدحُ لهم من أن يقول: فأنتُم المُضْعِفُون)؛ لأنَّه إذا التفت إلى الغير شاكرًا لصنيعهم واستحمادًا منه لهم وترغيبًا له فيما نالوا به هذه المنزلة، كان أبلغَ وأبلَ ممّا لو قال لهم: فأنتم المُضعِفُون. وإليه الإشارةُ بقوله: ((كأنّه قال لملائكتِه وخواصِّ خَلْقِه: فأولئك [الذين] يُريدون وَجْهَ الله)) مباهاةً بهم. وأيضًا فيه إشعارٌ بأنَّ أولئك محقُّون بأنْ يكونوا مُضعِفين لاكتسابهم تلك الفضيلةَ، وليس في ((فأنتم المُضْعِفُون)) من ذلك شيءٌ. .. قوله: (وهذا أسهلُ مأخذًا والأوّل أملأُ بالفائدة)، قال صاحب ((التقريب)): والأوَّلُ أملأُ بالفائدة لدقيقةِ الالتفاتِ، والثاني أسهلُ مأخذًا؛ لأنَّ حَذْفَ المبتدأ أكثرُ في الكلام»(12/252)
* وقوله: (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ……..فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)[فصلت:9-14]، قال الطيبي: «(فَإِنْ أَعْرَضُوا) أي: فإن أعرضتم بعدما تتلى عليكم هذه الحجج على الوحدانية والقدرة التامة فكنتم محجوبين، فيترتب العذاب عليكم كما فعل بأشياعكم من قبل، وفيه التفات. وهذا التأويل موافق لما نقل الواحدي عن مقاتل، ولما قال القاضي، أو الترتيب في المرتبة أو الإخبار، والله أعلم»(13/579).
* وقوله: (حم (*) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (*) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (*) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (*) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (*) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (*) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (*) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (*) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ)[الدخان:1-9]، قال الطيبي: «ثم لفرط عنادهم وعدم إيقانهم التفت من الخطاب في قوله (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُون)، فبعدهم وطردهم؛ إيذانًا بأنهم مع إيقانهم ذلك منزلون منزلة الشاكين، حيث لم يعملوا بموجبه، وخلطوا مع اليقين الهزء واللعب، كما قال: قول مخلوط بهزء ولعب» (14/200).
* وقوله: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (*) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (*) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (*) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (*) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) [النجم: 19 – 23]، قال الطيبي: «أخذ يبين ضلالتهم بقوله: (أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ والْعُزَّى) إلى آخر الآيات، ووبخهم على غوايتهم، حيث جعلوا لله شركاء إناثًا، وسموها بأسامي لا حقيقة لها، أي: هذه الضلالة والغواية التي بلغت غايتها، ولذلك التفت من المخاطبة ناعيًا عليهم إلى الغيبة على الضلالة بعد مجيء الآيات البينات بقوله: (إن يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ ومَا تَهْوَى الأَنفُسُ ولَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الهُدَى)»(15/92).
3- الالتفات من الغيبة إلى التكلم:
ومن أمثلته قوله تعالى: (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)[النحل: 51]، قال الزمخشري: «نقل للكلام عن الغيبة إلى التكلم، وجاز لأنّ الغالب هو المتكلم، وهو من طريقة الالتفات، وهو أبلغ في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوه، ومن أن يجيء ما قبله على لفظ المتكلم». قال الطيبي: «قوله: (وجاز لأن الغائب)، أي: وجاز النقل؛ لأن الغائب في قوله: (إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ) هو بعينه المتكلم في قوله: (فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)؛ لأن شريطة الالتفات هو الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث إلى الأخرى، لمفهوم واحد.
قوله: (وهو أبلغ في الترهيب من قوله: فإياه فارهبون)، لما أنك تجدُ في الانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من نفس المخاطب ما لا تجدُ إذا استمررت على لفظ الغيبة.
وقوله: (ومن أن يجيء ما قبله على لفظ المتكلم)، أي: هذا الانتقال والاختلاف أبلغ من أن يُجاء به على سنن واحد، وهو أن يجيء على لفظ الغيبة ما يقال: إنما هو إلهٌ واحدٌ فإياه فارهبون، وأن يجيء ما قبله على لفظ التكلم، كما يقال: إنما أنا إلهٌ واحدٌ فإياي فارهبون. قال صاحب «الفرائد»: فائدة الالتفات أن يُعلم أن ذلك الواحد هو المتكلم، لا غيره؛ لأنه لما أفاد قوله: (لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ)، وأفاد قوله: (إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ) الأمر باتخاذ الواحد، وجب أن يبين أن ذلك الواحد هو المتكلم، فعبر عن ذلك بقوله: (فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)». (9/135)
* وقوله: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)[الإسراء:1]، قال الزمخشري: «ثم (إنه هو)، وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة»، قال الطيبي مفصلا لكلامه: «قوله: (هي من طُرق البلاغة)، وذلك أن قوله: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً) يدل على مسيره من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، فهو بالغيبة أنسبُ، وقوله: (الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) دل على إنزال البركات، وتعظيم شأن المُنزل، فهو بالحكاية على التفخيم أحرى، قوله: (لِيُرِيَهُ) بالياء: إعادةٌ إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم، فالغيبة بها أليق، وقوله: (مِنْ آيَاتِنَا): عودٌ إلى التعظيم على ما سبق، وقوله: (إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، أشار به إلى مقام اختصاصه بالمنح والزلفى وغيبة شُهوده فيعين “بي يسمع وبي يُبصر”، فالعود إلى الغيبة أولى»(9/242).
* وقوله: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ)[فاطر:9]، ففي قوله: (فسقناه) التفات من الغيبة إلى التكلم، إذ لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت، وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها، من الدلائل على القدرة الباهرة، قيل: فسقنا، وأحيينا؛ معدولًا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدلّ عليه» قاله الزمخشري (12/612).
4- الالتفات من التكلم إلى الغيبة:
ومن أمثلته قوله تعالى: (إنَّا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (*) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)[الكوثر:1-2]، فأصله: فصل لنا وانحر، فعدل من التكلم إلى الغيبة (الرب)، ولله در الفخر الرازي حين قال: «كان الأليق في الظاهر أن يقول: إن أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر لكنه ترك ذلك إلى قوله: فصل لربك لفوائد إحداها: أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة وثانيها: أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة، ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين، وينهاك أمير المؤمنين وثالثها: أن قوله: إنا أعطيناك ليس في صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره، وأيضا كلمة إنا تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه، فلو قال: صل لنا، لنفي ذلك الاحتمال وهو أنه ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك، فلهذا ترك اللفظ، وقال: فصل لربك ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال وتصريحا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى.»(32/319).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
(1) الطراز (2/71)
(2) المثل السائر (2/3)
(3) فتوح الغيب (1/745)
(4) التبيان (ص:158)
(5) مفتاح العلوم (ص:296)
(6) عروس الأفراح (1/273)
(7) الطراز (2/71)
(8) انظر: عروس الأفراح (1/273)، وشرح عقود الجمان (ص:93)
(9) أنوار الربيع (1/362)
(10) فتوح الغيب (1/746)
(11) المثل السائر (2/135)
(12) الكشاف بفتوح الغيب (2/286)
(13) مفتاح العلوم (ص:296)
(14) فتوح الغيب (1/747)
(15) الإيضاح في علوم البلاغة (2/ 87)
(16) الكشاف بفتوح الغيب (1/744)