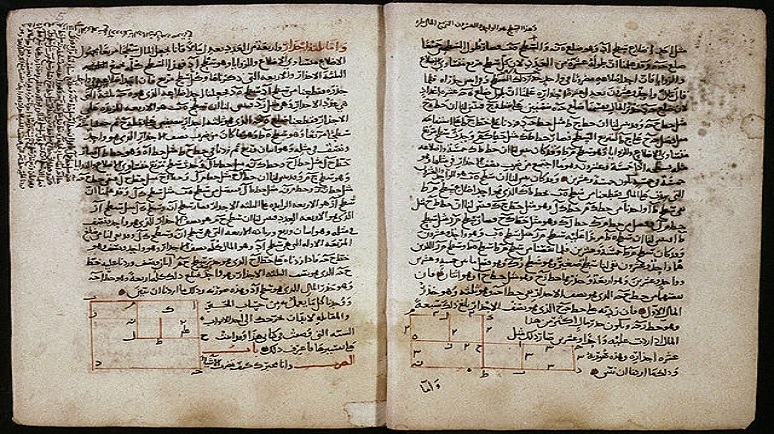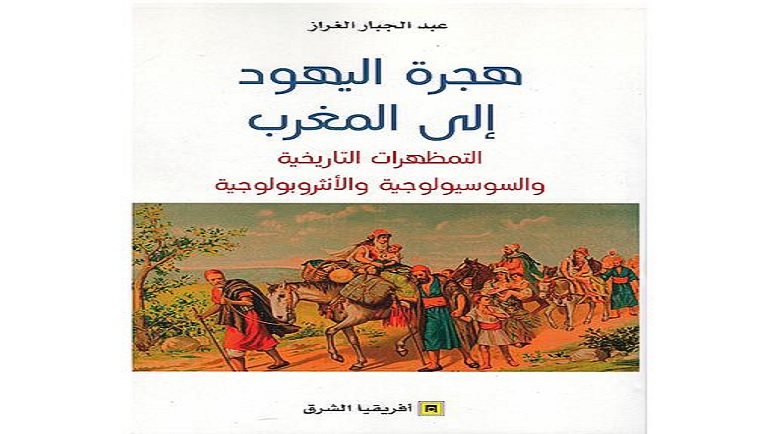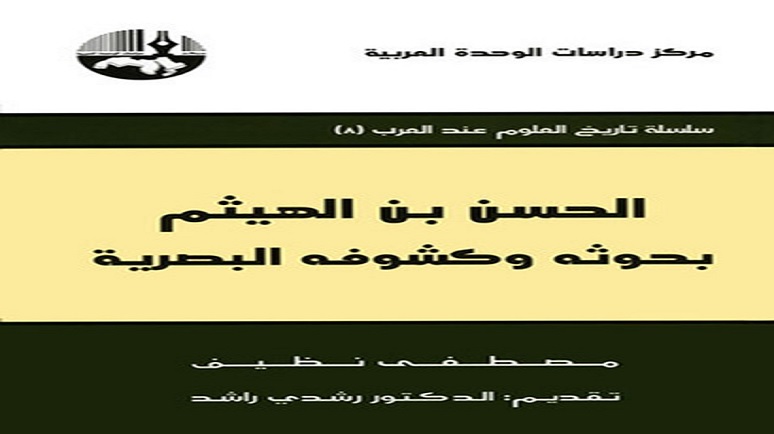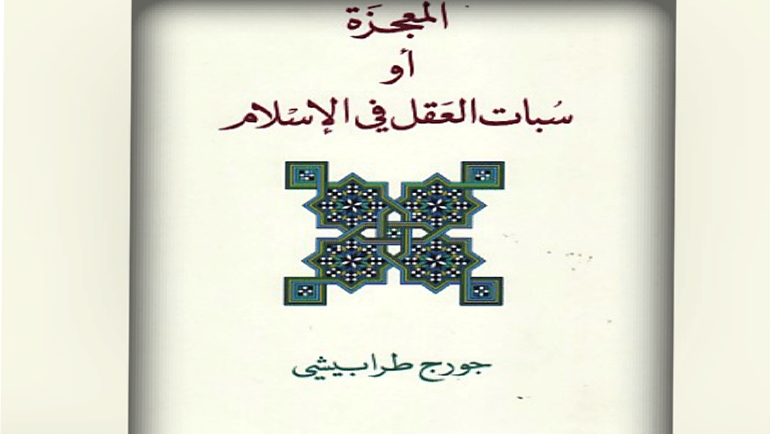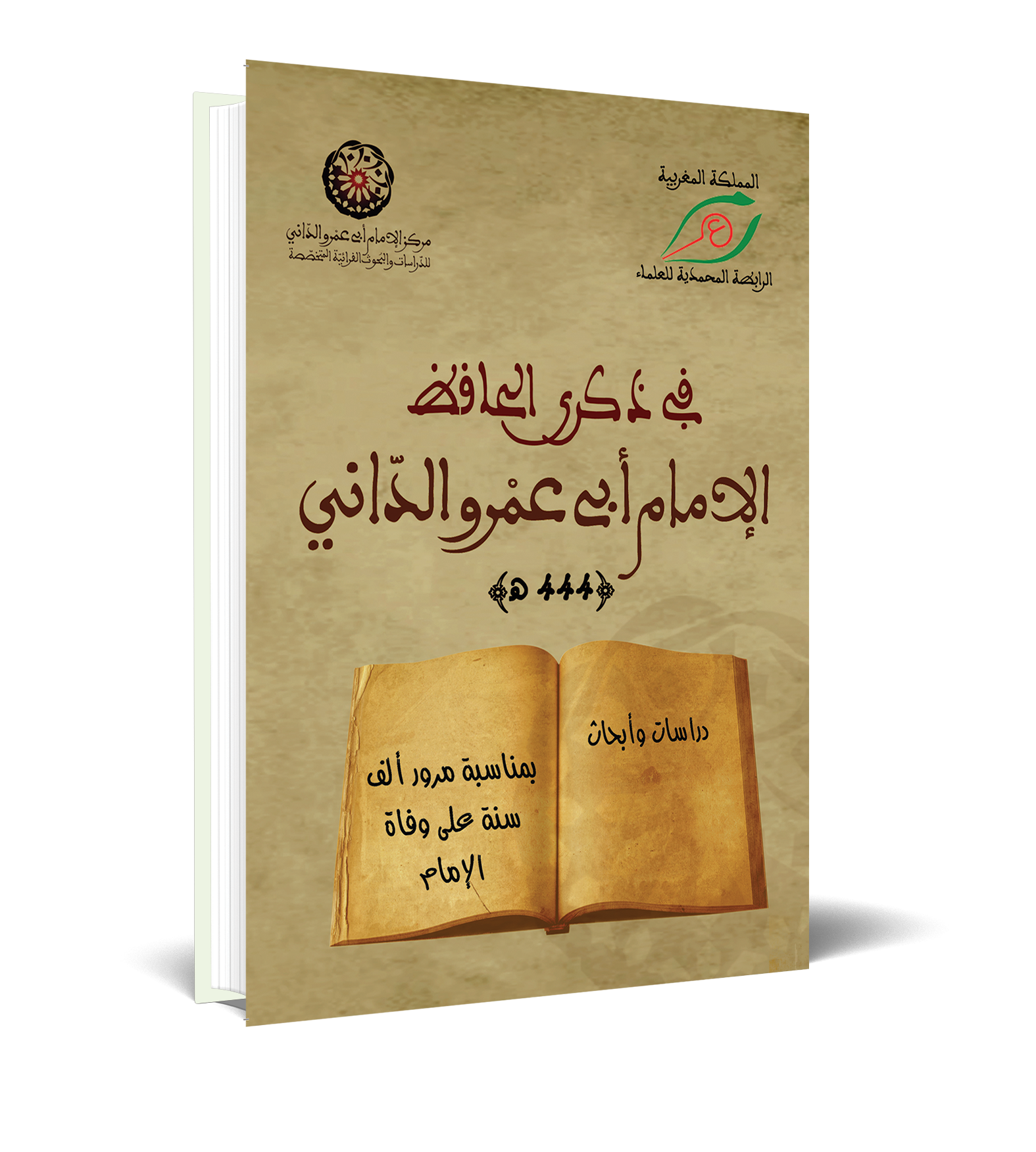المفسر الحديث والوحي.. قراءة في المقدمات التفسيرية لقطب وابن عاشور وحاج حمد

تمهيد
1. كيف كانت علاقة المفسّرين المعاصرين بالقرآن الكريم وإلى أيّ حدّ تنوّعت تساؤلاتهم الفكريّة وهم يعالجون النص المؤسس للحضارة الإسلامية؟
للإجابة عن هذا السؤال تواجهنا أكثر من مقاربة:
ـ لا يتردّد باحث أزهريّ معاصر، هو الشيخ محمد حسين الذهبي (توفي 1398ﻫ/1977م) المختصّ في علوم القرآن، من التصريح في سياق معالجته للتفاسير الحديثة؛ إذ يقول: “لم يترك الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب الله والكشف عن معانيه ومراميه… إذ أنّهم نظروا إلى القرآن باعتباره دستورهم الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة… والذي يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانها لا يدخله شك في أنّ ما يتعلّق بالتفسير من الدراسات المختلفة، قد وفّاه هؤلاء المفسّرون الأقدمون حقّه من البحث والتحقيق، فالناحية اللغويّة والناحية البلاغيّة والناحية الأدبيّة والناحية النحويّة والناحية الفقهيّة والناحية المذهبيّة والناحية الكونيّة الفلسفيّة، كلّ هذه النواحي وغيرها تناولها المفسّرون الأوَلُ بتوسّع ظاهر ملموس لم يترك لمن جاء بعدهم -إلى ما قبل عصرنا بقليل- من عمل جديد أو أثر مبتكر يقومون به في تفاسيرهم التي ألّفوها، اللّهم إلاّ عملا ضئيلا لا يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين أو شرحا لغامضها أو نقدًا وتفنيدا لما يعتَوِرُه الضعف منها أو ترجيحا لرأي على رأي، مما جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئة بالركود خالية من التجديد والابتكار[1].”
ـ مقابل هذا نقرأ في مقدمة تفسير الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (توفي 1393ﻫ/1973م) رؤية مغايرة إذ يقول: “والتفاسير كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل[2].” لذلك فهو بعد أن يذكر أشهر التفاسير من مثل تفسير الطبري والكشاف ومفاتيح الغيب للرازي وتفسير البيضاوي وتفسير الشهاب الألوسي وتفسير القرطبي والموجود من تفسير ابن عرفة التونسي يخلص إلى أنه سيُعرض في تفسيره عن العزو إلى تلك المدونة التفسيرية معتمدا على ما يفتح الله به من الفهم في معاني كتابه وما يجلبه من المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون، حسبه في ذلك عدم عثوره عليه فيما بين يدي الباحثين من التفاسير[3].
هذا مؤشر واضح على أن علم التفسير الذي كان يقال عنه في القرون الثلاثة الهجرية الأولى: إنّه علم من العلوم التي “لا نضجت ولا احترقت” تعبيرا عن قلّة وضوح الغاية من التأليف فيه وعن شدة ارتباطه بعلوم أخرى، يظل بعد مرور القرون وتوالي جهود العلماء في التقعيد له والتصنيف فيه بحاجة إلى مزيد المراجعة والتسديد.
ـ نجد تأكيدا لهذا المعنى عند الكاتب السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد (توفي 1425ﻫ/2004م) مؤلف “العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة[4]” الذي عمد إلى تجنب طريقة التفسير في مؤلفه ليعوضه بالتحليل القائم على إطار الوحدة القرآنية التي تتناول الجزء في إطار الكل عوضا عن الفهم المتداول المجزئ لآيات الكتاب وسوره. من هذا التمشي التحليلي الذي عبّر عنه الحاج حمد في مقدمته بأنه “أسلوب جديد” في تحليل القرآن، ندرك أن مقولة الشيخ الذهبي السالفة الذكر لا تلقى عند الحاج حمد وكذلك عند الشيخ ابن عاشور أي صدى باعتبار أن الرجلين عملا كلٌّ من منظوره الخاص، من أجل إنشاء علاقة جديدة بالمعنى القرآني لكونهما لا يقرّان بأن ما تركه الأوائل للأواخر في مجال تفسير كتاب الله كاف للكشف عن معانيه ومراميه.
ـ إذا كان ابن عاشور لا ينهج في تفسيره وخاصة في مقدماته ذات المنهج الذي سيعتمده صاحب “العالمية الإسلامية الثانية”، فإن الأول يلتقي مع الثاني في الإقرار بوجود أزمة يعاني منها هذا العلم الجليل. هو إقرار بأن الفهم الأمثل للنص المؤسس لحضارة المسلمين لا يمكن السعي إليه باعتماد المقايسة على أفهام القدامى من السلف.
هو إقرار نقدي للتراث التفسيري المدوّن يجمل الاعتراف بالأزمة التي يعرفها علم التفسير والتي تنطلق من ضرورة مراجعة النظر في طبيعة القرآن الكريم من جهة وضرورة الإجابة عن جملة تساؤلات المتداخلة، بعضها معرفي وبعضها منهجي وبعضها موصول بمسألة الإيمان.
2. كيف صاغ المفسر الحديث هذا الاعتراف بوجود أزمة في المنظومة التفسيرية؟
لعل من أفضل من حرر أحد أوجه الأزمة هو السيد قطب (توفي 1386ﻫ/1966م) حين كتب في مقدمة تفسيره، “في ظلال القرآن”، بأسلوبه الأدبي الرائق يدين مقولة المفسرين التقليدية التي قصرت التفسير على مجال الفهم وبيان المراد باعتماد جملة من المعارف من أبرزها علوم اللغة[5]. حين نعود إلى “الظلال” نتبيّن أن من أول ما يرمي إليه قطب هو تجاوز مقولة الزركشيّ (توفي 791ﻫ/1391م) الذي عرّف علم التفسير بأنه “علم يُفهم به كتاب الله المنـزل على محمّد -صلى الله عليه وسلم- وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحِكَمِه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ومعرفة أسباب النـزول والناسخ والمنسوخ[6].”
بالنسبة إلى صاحب الظلال فإن الغاية من أي عمل تفسيري هي تمَكّن من رؤية للعالم والوجود. هي رؤية كونية “تبين غاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني” وهو التوصل إلى حياة “ترفع العمر وتباركه وتزكيه…” إنّه الإحساس بالتناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله وحركة الكون الذي أبدعه الله[7].
نحن من هنا نقف على مفهوم جديد لعلم التفسير، وثيق الصلة بالمفهوم الفلسفي المعروف برؤية العالم Weltanschauung، وهو الذي يتيح لكل فرد تفسيرا للكون والعالم المحيط قصد تحقيق تفاعل أشمل معه ومع مكوناته.
ـ هذا ما يتيح تحديدَ أولَّ أوجه الأزمة في المنظومة التفسيرية. إنه الوجه المتعلق بطبيعة القرآن الكريم ذاته.
يقول ابن عاشور في مقدمة تفسيره: “فجعلت حقّا عليّ أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها، فإن الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد[8].”
بالعودة إلى الحاج حمد فإننا نقف على ذات المنطلق في تشخيص أزمة علم التفسير التي آلت حسب ابن عاشور إلى “تعطيل فيض القرآن”.
يقول حاج حمد محددا الطبيعة التي يراها للقرآن بـ”أنه مصدر الحكمة الشاملة وأن له قدرات في عطاءات عصورية مستقبلية[9].”
من هنا يبرز الفرق الجوهري بين من يرى أنّ القرآن كتاب حاوٍ لسور مفصّلة تتضمن عبادات ومعاملات، وبين من يرى فيه بالأخص سجلاّ إلهيا مفتوحا على التجربة الوجودية الكونية.
تمتاز الرؤية الأولى بطابعها الثبوتي الذي لا يولي كبير عناية لما يعنيه القرآن من فيض ما له من نفاد، وأنه مصدر الحكمة الشاملة والعطاءات الموصولة وأنه دفق الحياة الذي يرفع العمر ويباركه ويضيئه. إنها رؤية لطبيعة القرآن تجعل المؤمن القارئ لا يمكن أن يكون إلا تجديديا؛ أي معبرا عن حاجيات الأمة وتساؤلاتها المتجددة مستنيرا بفهم القرآن في كليته ونظريته المجسدة لحقيقة الرسالة المحمدية في لحظة تاريخية محددة.
بالعودة قليلا إلى مطالع العصر الحديث، نجد أن المنطلق التنظيري كان مع مقولة الإمام محمد عبده بأن القرآن “كتاب هداية” وهي مقولة فتحت طريقا جديدة للعلاقة بالنصّ القرآني، ومنها بدأت تتحدد للتفسير غاية مختلفة عما أرساه المفسرون التقليديون.
بعد محمد عبده كتب محمد إقبال كتابه عن التجديد مبينا أن السؤال الذي صاغه الإصلاحيون: “لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدّم غيرهم؟” سؤالا إشكاليا للتمشي الإصلاحي المطروح، أصبح متجاوَزا لكونه سؤالا غير بنائي؛ أي غير قادر على ربط الوعي الديني بالوعي التاريخي.
من هذين المنطلقين اتجهت علاقة المفسر الحديث بالوحي إلى فهم آخر لطبيعة القرآن، تحول دون الحجر على دلالات النص بالفهم الواحد. هي طبيعة تنبعث عبر التزكية الإلهية للإنسان؛ أي أنها تصل قدسية النصّ القرآني -في جانب منها- بالإنسان وأفقه وثقافته؛ إذ يتعيّن المعنى بما يتحقق من الجدل مع طاقات الإنسان ومع فاعليّة واقعه الفكري والاجتماعي.
3. هذا ما يحيلنا على الجانب الثاني من الأزمة، وهو وجهها المنهجي. هو وجه يمكن أن يصاغ في سؤال: هل غاية مفسّر القرآن الكريم اليوم هي الحفاظ على التراث التفسيري الضامن لـ”وحدة الأمة” المتحققة من خلال قدسية مرجعيتها؟ أم أنّ المقصود هو فهم النص المقدّس فهما حيّا يستوعب التراث التفسيري ويتجاوزه مستفيدا من مجالات المعرفة الإنسانية المختلفة، على معنى أن تلك القدسية تستلزم الإقرار بتعذّر التوصّل إلى فهم نهائي لنص الوحي؟
من خلال هذا السؤال ندرك البعد المنهجي في أزمة علم التفسير الحديثة.
ذلك أن ما انتهت إليه المدونة التفسيرية من سعي إلى إبانة كلام الله والكشف عن مراميه كانت قائمة على نظام فكريّ ونسق ثقافي يمثلان قاعدة التوازن الداخليّ لتلك المدونة، بعبارة أخرى، فإن كل التفاسير القديمة، سواء تعلّق الأمر بالتفاسير القائمة على الأثر أو الرأي أو ما سُمّي بالتفاسير الفقهية أو الاعتزاليّة أو الإشاريّة فإنّها -لاعتنائها بفهم النص وإفهامه- لا يمكنها التوصّل إلى مدلولات القرآن إلاّ بعُدّة معرفيّة صِيغت في بناء فكري كلاميّ وظيفته إقناعيّة وخصوصيّته دفاعيّة، وبناء على رؤية مثاليّة تتصوّر الحقيقة خارج التاريخ والعالَم.
ـ جِماع هذا يجسد الأزمة التي عالجها المفسرون المحدثون في بعدها المنهحي. هي معالجة تتمثل في سؤال عن طبيعة القرآن وعن غاية المفسر له: هل حقيقة التفسير تنفي كل صلة بين المعنى المراد ووعي الإنسان وثقافته أم أنها تفترض مواكبة تطوّر الإنسان ونموّ فكره وفاعلية واقعه الاجتماعي والثقافي؟
في كلمة: ماذا نعني بقولنا إن القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ أنقصد بذلك جاهزية الفهم الذي دوّنه السلف والذي يتيح مواجهة ما يستجدّ من أحوال ومشاغل في كل آن ومكان، أم أن تلك الصلاحية تعني أن لغة النص المقدّس لا تتوقف عن توليد المعنى عبر السيرورة التاريخية للإنسان ووعيه وتقدّم مجتمعه؟[10].
من هنا خطّ المسار الحديث لعلم التفسير طريقه الذي استفاده من مقولة محمد عبده الإصلاحية ومن قراءة إقبال التجديدية ليضبط من خلالهما إشكالية المفسر المعاصر. هو في ذات الوقت تأكيد على أن أزمة علم التفسير أزمة منهج، وأن تجاوزها يبدأ من اعتبار أنه لا تناقضَ بين القول بأن دلالات النص القرآني لا تنحصر في زمان أو مكان وبين اعتبار أن النص وثيق الارتباط بالقرن السابع في الجزيرة العربية.
ـ أهم ما في هذا التشخيص المنهجي للأزمة هو دلالتها الثقافية. ما تعنيه هذه المساعي الحديثة والمعاصرة هو أن الثقافة الإسلامية اليوم تحمل في داخلها صراعا لا يجوز التغاضي عنه، فهي ليست كُـلاّ أصمّ وروحا واحدة منغلقة. إنكار هذه الحقيقة ليس إلا مسايرة لمقولة ” أرواح الشعوب” المتداولة في الفكر الأوروبي التي انبثقت عنها نظرية “صراع الحضارات” المعتمدة على أن هناك حضارات متطورة ترتقي باستمرار وأخرى ذات خصوصيات ثابتة ونهائية وأن الأولى تمثل الخير المحض وأخرى الشر الخالص.
ما يثبته الصراع الفعليّ قديما وحديثا هو صراع بين القيم والمناهج داخل كل ثقافة وضمن كل فكر، مما أتاح مثاقفة متواصلة بين الشعوب والمجتمعات ظلت تميّز تاريخ الأفكار في العالم منذ قرون.
أولا: الإنسان في الخطاب القرآني
بعد أن بحثت في دراستي حول: “الإنسان والقرآن وجها لوجه”؛ فسوف ينصب حديثي هاهنا على علاقة المفسرين المعاصرين بالنص القرآني ومدى تنوّع تساؤلاتهم الفكرية؛ سعيا لتعميق الأفكار التي وقع طرحها في ذلك الكتاب من جهة الدلالة التي يعتمدها ذلك الخطاب للإنسان. هذا التساؤل قمت بتطوير جانب منه في دراسات حديثة بعضها منشور وبعضها ما يزال قيد الدرس. المنشور موجود في كتاب صدر حديثا عن دار الهادي في بيروت بعنوان: “النص الديني والتراث الإسلامي” قراءة نقدية. أما الجانب الآخر فهو جوهر العمل الذي أرجو أن أتمكّن من إنهائه عن موضوع علم الكلام الجديد أو البحث عن العصر الذهبي، والذي أحاول فيه أن أبيّن مدى الحاجة إلى تطوير علم للكلام يفسر ظاهرة الوحي مستعملا آليات جديدة للتفكير.
ـ الإشكالية التي اهتم بها اليوم تعتني بعلاقة الوحي بالتاريخ أو إذا اخترنا تعبيرا من الداخل قلنا: كيف ينبغي أن نصوغ الإيمان اليوم؟
العبارتان في تقديري ينتهيان إلى شيء واحد مصاغ بطريقتين مختلفتين ومتكاملتين. ذلك أن الإيمان هبة أو حقيقة يتلقاها الإنسان ويصوغها سلوكا وفكرا، وقديما قرن المتكلمون بين الإيمان والعمل؛ لأن الذي يؤمن لا يمكنه إلا أن يتمثل التحولات الكبرى التي تعتمل في النسيج الثقافي الخاص والبناء الفكري العام ويحوّلها إلى وعي بالذات.
عبارة: “صياغة الإيمان اليوم؟” لا تعني أننا فقط إزاء مسألة ذاتية خاصة متعلقة بالسلوك الفردي التعبدي، بل هي أيضا حركة وعي تقوم على معرفة العصر وتحديد متطلباته بشكل يجعل المؤمن في شروط تتيح تفعيل قدراته الخاصة، مما يفضي إلى حلول ومواقف جديدة أكثر فاعلية و تميّزا.
حين نعبر عن هذه الإشكالية بالعلاقة بين الوحي والتاريخ، فإننا لا نريد معالجة قضية كلامية مجردة لا صلة لها بالواقع وتساؤلاته الحضارية والفكرية خاصة التي يطرحها الواقع المعاصر. إنه البحث في شروط الوعي الذهني وكيف يمكن لمجتمعات المسلمين أن تعيش على شروط الوعي الحضاري العالمي الجديد. ما نعنيه بالوحي هي وظيفته وهي تحقيق الاتصال بين المطلق والنسبي، بين الكل والجزء للوعي بالكل. هدف الوحي إن فُهِم على هذا المعنى هو وضع الإنسان في سياق تاريخي ووجودي أشمل، وإعادة العلاقة بين الإنسان ومحيطه الكوني.
لعل هذا ما عناه فهمي جدعان حين قال عن الوحي بأنه خطا خطوة حداثية كبرى؛ إذ تدخّل في التاريخ ليحرّر العقلية العربية والفعل العربي من الميثولوجيا القديمة ومن سلطة الخرافة والتقليد وأساطير الأولين، وليسلّمها لسلطان السمع والبصر والفؤاد؛ أي إلى سلطات الإدراك الإنسانية الطبيعية لتكتمل بحكمتها وبالكتاب للإنسان أسباب العلم والفعل السديد.
ـ الملاحظة الثالثة التي تتصل بالملاحظتين السابقتين تتمثل في سؤال: هل الفكر الديني عندنا له “من التصورات والصياغات النظرية” التي يمكن أن نصفها بالمعاصرة؛ أي التي تكون مقبولة لدى أجيال من المسلمين وغير المسلمين الذين تمثّلوا بدرجة من الدرجات التطورات الفكرية والحضارية الحديثة؟ ما نريد أن نعمل ضمنه؛ هو الانخراط في هذا الطريق الجديد الذي شرع فيه بصفة واضحة محمد إقبال في النصف الأول من القرن الماضي، خاصة في كتابه تجديد الفكر الديني والذي واصله بعده عدد قليل من المسلمين وعدد أقل من المسلمين في البلاد العربية.
منذ كتب إقبال كتابه عن التجديد تبيّن، كما سلفت الإشارة، أن السؤال الذي صاغه الإصلاحيون “لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدّم غيرهم؟” ليكون السؤال الإشكالي للتمشي الإصلاحي المطروح أصبح متجاوزا لكونه سؤالا غير بنائي؛ أي غير قادر على ربط الوعي الديني بالوعي التاريخي.
عوضا عنه صاغ الفكر التجديدي وعيا ينطلق من أن العالم كله يعيش حضارة واحدة وإن تعددت واختلفت المداخل والخصوصيات الثقافية. هذا الوعي تبنّى تعريفا للدين على أنه؛ إيمان بمصير الإنسان مما يجعل حقيقة الحياة الدينية هي اكتشاف المؤمن رتبته في سلّم الموجودات. يحدّد إقبال ضمن هذا التمشي سؤال التجديد المختلف عن سؤال الإصلاح، فيقول: “هل الدّين أمر ممكن؟”؛ أي كيف يتأتّى تعقّل الدين الإسلامي اليوم بوسائل الحضارة المتاحة وبمعارفها المتجددة. بعبارة الحاج حمد: كيف يتم الالتحام بشروط الوعي المعاصر وليس وفق شروط الوعي التاريخي السابق؟
حين عالج المسلمون مسألة الوحي قديما عالجوها سواء أكانوا معتزلة أم أشاعرة أم فلاسفة من خلال الأطر المتداولة لديهم: ابن سينا، مثلا، في القرن الرابع الهجري 318-429 العاشر الميلادي 930-1037 قال عن الوحي إنه اتصال النبي بالعقل الفعال، العقل العاشر معبرا بذلك عن تصوّر داخل المنظومة المفاهيمية التي كانت سائدة. كيف يمكن اليوم أن نقبل مقولة العقول العشرة؟ هل نعوّضها بمقولة المعتزلة بأن الوحي أصوات وحروف منظومة ومخلوقة ابتدائيا من الله في الهواء على مسامع النبيّ –صلى الله عليه وسلم-؟ أم ننظر في ما عبّر عنه باحث معاصر على أنه ارتباط communication؟
ثم إن المسألة لا تتوقف عند هذا الجانب فقط، لذلك سألنا هل الفكر الديني عندنا له من “الصياغات النظرية“ التي تقتضيها الأطر المعرفية المعاصرة؛ أي التي تكون من جهة مقبولة من أجيال من المسلمين وغير المسلمين الذين تمثلوا بدرجة من الدرجات التطورات الفكرية والحضارية الحديثة. ومن جهة أخرى تتيح إعادة اكتشاف معاني القرآن وفق شروط الوعي المعاصر؟
السؤال يتعلق بكيفية تمثلنا الفكري والمنهجي لإيمان هو بحاجة دائمة للتحيين والراهنية.
بهذا السؤال يمكن تجاوز فكرة الصّدام شرق/غرب أو إسلام/مادّية، ويتحدّد التجديد بضرورة إعادة النظر في جملة من المفاهيم التأسيسية يكون على رأسها مفاهيم الدّين والوحي والمعرفة والنبوّة.
كيف نعمّق مسألة العلاقة بين الوحي والتاريخ وكيف نحقق راهنية الإيمان؟
أحاول أن أقدم فيما يلي وبنوع من التدرّج ثلاثة مستويات من النظر تتضافر للإجابة عن هذا السؤال المثنى: (التجديد والأنساق الثقافية -النص والخطاب – تنجيم المعنى).
1. التجديد: راهنية الإيمان
يمكننا أن نسأل في مستوى أول عمّ تميّز به هذا الكم من الإنتاج الذي يعالج نص الوحي مقارنة بما سبق أن نُشر من تفاسير أو دراسات قرآنية في قرون ماضية؟
إن أهم ما ظهر في القرن الماضي ضمن هذه الوفرة اللافتة من الإنتاج، هو ظهور إدراك موضوعي للفجوة الكبرى بين ما تمّ إنجازه من مدوّنة تفسيرية وبين القيم والمفاهيم والروابط التي أصبحت تصوغ الواقع وتحكم العالم من حوله. لقد اعتنى عدد من الباحثين في الدراسات القرآنية بالنسق الفكري الذي يحتكم إليه كل من يتعاطى مهمّة فهم الوحي. ذلك أن المتكلمين والمفسرين والدارسين يرتكزون على نظام فكري ومنظومة ثقافية حين يباشرون فهم النص مما يجعل إنتاجهم العلمي غير منفصل عن التاريخ الفكري والثقافي؛ أي أنه محتاج إليه قدر من النسبية يجعله أبعد ما يكون عن الخطاب الإيديولوجي الوثوقي.
معنى التجديد الذي تبلور في القرن المنصرم ضمن الأدبيات القرآنية العديدة ينطلق من تبـيان طبيعة الاختلاف بين المدونة التفسيرية الموروثة والحاجيات التي يطرحها الفكر والواقع المعاصرين. لذلك أمكن القول بأنه لا يُعَدّ مجددا من شخّص إشكالية المفسر الرئيسية خارج الموروث التفسيري وخارج البناء الفكري الذي قام عليه ذلك الموروث. هذا ما يسمح لنا أن نعتبر أي ضرب من الدراسات القرآنية التي تصدر اليوم تقليديا إن هو لم يزد في اهتمامه عن إعادة صياغة المعاني القديمة بلغة مستساغة، أو عن الاعتناء بترجيح بعض أقوال المفسرين القدامى في مسائل لغوية وعقدية وتشريعية، حتى وإن كان في ذلك مستفيدا من بعض الكشوفات العلمية أو التاريخية الجديدة.
في هذه الحالات يظل المسعى العلمي مستندا جوهريا على الجانب الموروث، فهو لن يزيد في ما ينتجه من أفكار وما يعتمده من نسق عن كونه يتيح لتلك المباني الفكرية والثقافية من إعادة إنتاج نفسها مع بعض التعديلات الشكلية الطفيفة. من ثَم فإن هذه الاستعارات لا تشفع للباحث الذي يظن أنه بصدد عمل تجديدي، في حين إنه يبقى عملا تراثيا؛ لأنه أوّلا: لم يطرح إنتاجه على محك النقد وإعادة القراءة، بناء على أن تشخيصه لطبيعة عمله العلمي يظل منصبّا على عناصر “خارجية” بالأساس.
ثانيا: يبقى هذا المفسر أو المتكلم تراثيا؛ لأنه لم يفكر هو من خلال تراثه بل يكون قد مكّن ذلك التراث من أن يتواصل عبر عملية استنساخ ثقافي تؤكد عدم الحاجة إلى إعادة بناء الفكر وتحيينه؛ بتعبير آخر يمكن القول: إن المجدد في المجال الذي يعنينا هو الذي يقطع إيجابيا مع التراث التفسيري القديم عندما يباشر فهمَ الوحي الإلهي، وبناءَ فهمه ذاك على وعي تاريخي يتجاوز آلية التراكم الكمي. ما يضبط لنا معنى القطع الإيجابي أو التجديدي هو أن يصير المفسر إلى ضرب من التفكير ليس بالتراث ومن خلاله فقط، لكنه تفكير يستوعب التراث التفسيري فيفهمه ليتجاوزه، مستفيدا في ذلك من مجالات المعرفة الإنسانية المختلفة.
تجديد المفسر، إذن، لا يسمح له أن يضحى مجرد أداة “يفكر” التراثُ عبرها، بل أن يقطع مع هذا المنهج ليفكر هو في التراث ومسوغات إنتاجه التاريخية والثقافية.
في كلمة، يُدرَك تجديد المفسر بقدر تحرّره من المدونة التفسيرية الموروثة، وذلك عبر استيعابها ونقدها ناسجا بذلك قراءة متميزة للنص تستمد تميزها من معرفة أدق بتاريخ نظام الفكر الإسلامي وخاصة في مجال تخصصه، ومن استحضارها لقضايا العصر الفكرية والاجتماعية والأخلاقية.
هذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن ظاهرة الوفرة في إنتاج أعمال كثيرة لفهم النص القرآني في العقود الأخيرة، يرجع في جانب رئيسي منه إلى جهود الحداثة العربية وما تبنته من مواقف نقدية كان لها الأثر الواضح على الدراسات القرآنية. لقد أدخلت في الاعتبار الفكر النقدي وجانب من المعارف الحديثة ضمن مجال كان يُحتكَم فيه إلى الأنساق التراثية ومبانيها العقلية المحدودة.
لذلك، فإنه يمكننا في هذا المستوى الأول أن نثبت أن رفض هذا التمشي الحديث وما يؤدي إليه من تجديد ليس في النهاية إلا تهديدا للبناء الديني نفسه، الذي يُظَن أن حمايته لا تكون إلا بعزله عن مسيرة الحضارة والتاريخ. هو تهديد صريح للرسالة الدينية؛ لأنه إهمال لمبدأ خلافة الإنسان التي لا تستطيع أن تتحقق خارج الشروط التاريخية والاجتماعية والفكرية المعاصرة.
2. من نص التوحيد إلى وحدة النص
إذا أردنا أن نحدّد موقع الإنسان في الخطاب القرآني فلابد أن ندرك أن الوحي لم يتجاهل الشروط الموضوعية للسياق التاريخي التي واكبته، مما جعل النص متعلقا في جانب منه بالأداء الحضاري للإنسان في القرن السابع ضمن البيئة العربية الشمالية. هذا الإقرار جزء ممّا يسميه المفكر الإيراني المعاصر مجتهد شبستري “علم النص” وهو علم يربط بين المتن وبين الواقعيات المحايثة له.
كيف يتبدّى لنا الإنسان في النص أولا وفي الخطاب القرآني ثانيا؟
ذُكر لفظ الإنسان في النص القرآني مرات قليلة لا تتجاوز 65 مرة؛ فهو من هذه الناحية لا يعتبر من أهم الألفاظ القرآنية مقارنة بلفظة الله التي تعدّ أشد الألفاظ تواترا حيث تبلغ نسبة اطرادها 2697 + 147 لكلمة إله= 2844 [قال 1721/ كان 1433/ ربّ 930/ أمن 924/ علم 855/ قام 560 أتى 548/ شاء 519/ يوم 474]. من جهة ثانية، فإن السياق الدلالي الذي ترد فيه كلمة الإنسان يتوزعه محوران: محور الإدانة الواضحة فهو ضعيف – يئوس – خصيم مبين – عجول – كفور- في خسر – أكثر شيء جدلا. هذا شأنه في أكثر من نصف الآيات التي تذكر الإنسان. إضافة إلى هذا نجد محورا يتحدث عن خلقه وما أودعه الله فيه من استعدادات متباينة: فهو من حمإ مسنون، من علق، من صلصال، هذا إلى جانب أنّ الله علمه البيان، وعلمه ما لم يعلم، وأن الشيطان له عدوّ.
كيف يمكن أن نعالج هذا الجانب من النص، والحال أن عموم الخطاب القرآني يتجه في خصوص الإنسان وجهة أخرى؛ إذ يجعله يحظى بمكانة متميزة فهو خليفة الله وهو مخاطَب بالوحي؟
هنا لابد من العود إلى ما أشرنا إليه من “علم النص” الذي ينطلق من الوعي بخصوصية الوحي وطبيعة الخطاب الإلهي للناس. يتأسس هذا العلم من مبدأ أن الله الذي تجلّى للعالم قد تجلّى للإنسان؛ فخاطبه بالرسالة وجعل نصها الديني غير منفصل عن تاريخه في الوقت الذي تكون وظيفة الوحي تعاليا وتحررا من ذلك التاريخ، بعبارة أخرى علم النص يعتبر أن الوحي الإلهي حين يتجسد نصا لا يستقل تماما عن التجربة الإنسانية وإن كانت غايته مجاوزتَها.
حين ينصّ القرآن، مثلا، على أن الإنسان “لا يسأم من دعاء الخير” وأنه إذا أنعم الله عليه “أعرض ونأى بجانبه”، حين يقع هذا، فلابد أن نتذكر:
أولا: أن لفظة الإنسان في اللغة القرآنية قريبة العهد بالاستعمال اللغوي العربي القديم الذي يتداول هذا اللفظ في سياق استهجاني؛ لأن الإنسان قرين الضآلة والانقطاع والخروج عن الجماعة. يساعدنا على التحقق من هذا لسان العرب ومعجم التاج الذي نجد فيه في فصل الهمزة باب السين: “الإنسان معروف والجمع الناس مذكر… والإنسان له خمسة معان أحدها الأُنُملة قاله أبو الهيثم… أشارت لإنسان بإنسان كفها… وثانيها: ظل الإنسان، وثالثها: رأس الجبل، ورابعها: الأرض التي لم تزرع، وخامسها: المثال الذي يرى في سواد العين ويقال له إنسان العين…”. ما ورد من الآيات عن الإنسان “الكنود” أو الذي “يفجُرُ أمامه” وثيق الصلة بالنسق المعتمد في الثقافة العربية السائدة وهو نسق يعتبر التفرد مهلكة وخسرانا بينما يعلي من شأن الانضواء في العشيرة والسعي المتواصل لجمع شتاتها. هذا الترسّب التاريخي المستهجِن لنـزعة التفرد قائم في النص القرآني رغم أن خطاب الوحي يريد باستعماله إياه أن يزحزحه و يدفع به خارج هذا الحقل، فيذكر أن الإنسان هو أيضا مصغٍ إلى النصح وقابل للتوجيه “وصينا الاِنسان بوالديه” أو “أنه على نفسه بصيرة” أو “أنه خلق في أحسن تقويم”.
هذه المواكبة التي يكشفها لنا بحث الإنسان في النص والخطاب تجعلنا ندرك أن النص يتفاعل مع الشروط الموضوعية التاريخية ولكنه لا يقف عندها. ومن ثم كان لابدّ من التمييز بين نص القرآن كمتن وخطاب القرآن الذي هو أوسع مجالا؛ لأنه مرتبط بعالم ذلك المتن وعالم النبي الذي استوعب الوحي.
صورة الإنسان في المتن، إذن، مختلفة عنها في الخطاب القرآني وهذا يتأكد خاصة عندما نتذكر ثانيا أن النص القرآني يعتمد لتحقيق هذه الزحزحة الدلالية على ألفاظ أخرى يركّز بها هذا المعنى الذي يدفع إليه الوحي دفعا من خلال قوالب فكرية وتعبيرية لها ملابساتها الخاصة. من ذلك ما نجده في لفظة “نفس” ذات الاطراد الأكبر وذات التوجه المعبر عن الاستعدادات الكبرى التي يتمتع بها الإنسان لتحمّل المسؤولية في رسالة التوحيد والاستخلاف. هي النفس الواحدة الجامعة “هو الذي أنشأكم من نفس واحدة”، وهي النفس المكلَّفة “ولا تكلف نفس إلا وسعها” وهي المسؤولة “يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها”. مع عبارة النفس التي سيستفيد منها الفلاسفة بعد ذلك، في مسار آخر نجد النص قد وفّر للخطاب دائرة دلالية أرحب مما أوضحته جزئيا عبارة الإنسان.
من ناحية ثالثة، أبان هذا التعدد التزامني Synchronique في الألفاظ المعتمدة المرتبطة بالإنسان ما يوجد من فروق هامة يريد الخطاب الديني أن يكشف عنها، فروق بين دائرة النفس ودائرة الإنسان باعتبار أن الأولى تمثّل مجالا أعمق من مجال نفسّية الفرد العادّية. هذا التمايز يوحي بإمكانية اتصال الذّات الإنسانية بذات الحق العليا بما يكشف عن تفرّدها وقدرتها.
هذا التعدد في مستويات الفهم مهمّ؛ لأنه كفيل بما يمكن أن نسميه “وحدة الخطاب وتعدد مستويات النص” وهو ما اعتنى به الحاج حمد صاحب الإسلامية العالمية الثانية حين ربط بين فهم القرآن في كليته و فهم طبيعة القرآن نفسه.
“وحدة الخطاب وتعدد مستويات النص” تبرز الفرق الجوهري بين من يرى أنّ القرآن كتاب حاوٍ لسور مفصّلة تتضمن عبادات ومعاملات وبين من يرى فيه بالأخص سجلاّ إلهيا مفتوحا على التجربة الوجودية الكونية. ظاهريا ليس هناك تناقض بين الرؤيتين، إلاّ أنّ الأولى مطبوعة بطابع ثبوتي لا يولي كبير عناية لما يمكن أن يعنيه أن القرآن مصدر الحكمة الشاملة أو ما يسميها الحاج حمد: “قدرات القرآن في عطاءات عصورية مستقبلية”. مثل هذه الرؤية لطبيعة القرآن تجعل المؤمن القارئ لا يمكن أن يكون إلا تجديديا؛ أي معبرا عن حاجيات الأمة المتجددة مستنيرا بفهم القرآن في كليته ونظريته المجسدة لحقيقة الرسالة المحمدية في لحظة تاريخية محددة.
“وحدة الخطاب وتعدد مستويات النص” جزء أساس من علم النص الذي لا يرى في النص سديما متراميا، فلا يقتصر على القول بأن القرآن هو نص داع لعقيدة التوحيد ولمستلزماتها السلوكية، بل يرى فيه أيضا النص الذي يمكّن المؤمن في كل فترة من خلال قراءة توحيدية للنص أن يتدخّل في التاريخ ليساهم في اكتمال حكمة الإنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فعله.
هذا التمشي التجديدي أو الحداثي حسب عبارة جدعان يمكّن من الانتقال من مستوى القول بأن القرآن هو نص مركِّز للتوحيد إلى مستوى يعتمد فيه على توحيد النص. هو مستوى من التوحيد يمكن أن يتحقق في كل عصر ومصر إذا انفتح المؤمنون على كامل القرآن؛ أي على عالمه وخطابه بكل استعداداتهم وبحسب ما تستلزمه طبيعة عصرهم من وعي جديد.
3. في تنجيم المعنى
عندما أكّد فضل الرحمان (1919- 1988) في مطلع كتابه “الإسلام وضرورة التحديث” أنه لا سبيل لتغيير اجتماعي في البلاد الإسلامية دون إرساء نـزعة عقليّة إسلامية، وأن هذه الأخيرة موصولة بأسلوب تفسير القرآن فتعثّرات الحاضر وعدم نجاعة الأدوات الفكريّة المعتَمدة، إنّما يرجع إلى “الافتقار إلى المنهج الصالح لفهم القرآن نفسه عندما أكد ذلك[11]“، فإنه كان يريد أن يثبت أمرين:
1. أن الوحي والخطاب القرآني قد تحوّلا كلاهما عند المسلمين اليوم إلى نص؛ أي إلى مرجعية توحيدية، لذلك فإن الذي يسعى إلى تغيير تلك المجتمعات والنهوض بها دون الاعتماد على القرآن كمرجع وذاكرة وهوية جماعية، سيُسقط إمكانية أساسية في عملية النهوض.
2. إن تعثر الجهود العديدة في التعامل مع النص القرآني منذ عقود راجع إلى أننا نقرأ النص على أنه متعال لا ينحصر في زمان أو مكان أو أننا نقرأه في اتجاه مناقض؛ أي على أنه لا ينفك مرتبطا بالقرن السابع في الجزيرة العربية.
ما عمل على إرسائه فضل الرحمان خاصة، هو القول بأن الرأيين في طبيعة القرآن ليسا بالضرورة متعارضين. بل إذا قلنا إن القرآن يظل دوما صالحا للتطبيق، فعلينا أن ننظر كيف تمّ اعتماد خطابه وتفسير تعاليمه لتناسب الظروف المتغيرة في العصور الأولى للإسلام. إنه استيعاب للدلالة العامة للنص وإدراك لتطبيقاتها المختلفة ووعي بالظروف التاريخية لتي صاحبتها ثم هو فوق كل ذلك ومن ثم تحقيب للوعي وقدرة على المساهمة في مشاغل المجتمع وتفاعلاته.
ثانيا: الرؤية القرآنية للإنسان
يمكن من خلال التطبيق السابق أن نقف على جانب أساسي من وظيفة الوحي في الخطاب القرآني. إنها وظيفة وجودية تحقق الاتصال بين المطلق والنسبي، بين الكل والجزء قصد الوعي بالكل وعيا متدرجا. أحد أهداف الوحي إن فُهِم على هذا المعنى هو وضع الإنسان في سياق تاريخي ووجودي أشمل، وإعادة العلاقة بين الإنسان ومحيطه الكوني؛ على هذا الأساس يضحي الإنسان كائنا تاريخيا وكونيا؛ أي أن إنسانيته في سيرورة وأنها تتحقق باستمرار. بذلك نتجاوز الفهم التراثي للإنسان وهو الذي يلح على جانب أصوله التي تكون أبعد مما يحيط به إدراكه الحسي، فهو يُخلَق إنسانا بفعل مباشر من الله ويتكوّن من مزيج عنصرين واحد إلهي والآخر غير إلهي.
كيف نحا الخطاب القرآني بالإنسان هذا المنحى الجديد؟
أقر الخطاب القرآني أولا الاختلاف واعتبره حالة طبيعية منذ خلق الله الخلق: ﴿ومن ـاياته خلق السموات والاَرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾ (الروم: 21).
تبعا لهذا يتخذ مصطلح الأمة بعدا مستقبليا وقيميا فتصبح الأمة الواحدة هي البشرية قاطبة: ﴿وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا﴾، (يونس: 19) بما يكسب الوحدة الإنسانية معنى التساوي في الخَلق والقيمة رغم التنوّع في المظهر والمخبر.
ضمن هذا الأفق يمكن أن ندرك المنحى الجديد، المنحى الاستخلافي: ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربُّك، ولذلك خلقهم﴾ (هود: 118).
في مستوى ثان تأتي إجرائية تنظيم هذا الاختلاف. هذه الإجرائية تنطلق من مجال القسط لتصل إلى قاعدة التعارف والتثاقف أو من قوله: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تَبرّوهم وتُقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين﴾ (الممتحنة: 8) إلى قوله: ﴿يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (الحجرات: 13).
ذكر بعد ذلك أنه بين الحد الأدنى والمقصد الأسنى أوضاع متنوعة منها التضامن: ﴿قل يأهل الكتاب تعالوا اِلى كلمة سواء بيننا وبينكم..﴾ (ال عمران: 63).
ثم حدد في المستوى الثالث قاعدة قارة لهذه السيرورة هي حرية المعتقد: ﴿لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيّ﴾ (البقرة: 255). تلك الحرية التي تسمح بالتثاقف والتعارف لكن دون التطلّع لإلغاء الاختلاف أو الذهاب به إلى حد التشرذم والتفرّد.
بهذه القراءة يكون الوحي في الخطاب القرآني قد تدخّل في التاريخ ليحرّر العقلية العربية والفعل العربي من الميثولوجيا القديمة ومن سلطة الخرافة والتقليد محققا بذلك ارتباط الوعي الديني بالوعي التاريخي.
هو تمهيد للإقرار بأن العالم كله يمكن أن يعيش حضارة واحدة وإن تعددت واختلفت المداخل والخصوصيات الثقافية.
تمثّل الخطاب القرآني على هذا النحو يحقق ثلاث نتائج كبرى هي:
الأولى: اعتبار النص القرآني ليس مجرد نص تاريخي، هو نص تجسدت فيه آيات المتعالي على التاريخ كما يعتقد المسيحي بإمكان وجود آيات المتعالي في الإنسان لكن هذا لا يعني أن النص القرآني لا يحمل جوانب تاريخية محايثة للواقع البشري، كما أنه لا يمكن أن يفهم على أنه نمط علاقة سؤال – جواب.
الثانية: أنّ الوحي بما هو علاقة بين الله والإنسان مما يجعل الخطاب القرآني هو الفهم للنص المقدّس فهما حيّا؛ أي أنه بالضرورة مختلف عمّا تحقّق في الماضي ولكنّه أكثر تحديدا إنْ هو تحقّق عبر تجربة معرفيّة وحياتيّة جديدة. إنه خطاب يستوعب النص وعالَمه وكذلك آلية الوحي ومقصده ليكون من قبيل الاستقبال والاحتضان للقدرة اللاّنهائيّة على الدلالة ومعنى الأشياء.
الثالثة: التاريخ والهوية معطيان متغيّران؛ أي أننا في كل عصر نعيد فهم الماضي فهما جديدا مما يجعل قراءة النص المقدّس – القديم وجود مستمر في حاضر يزداد وعيه بالماضي من خلال تجربته الحديثة. مقتضى هذا المبدأ يؤدي إلى أن الإقرار بانقطاع الوحي واكتمال تنجيم القرآن نصا لا يمنع من ارتقاء فهم النص الديني باعتماد المعرفة بمجالاتها الجديدة وما يطرحه الواقع من معضلات.
هذه المبادئ الثلاثة التي تختزل الجهد التجديدي الباحث في علاقة الوحي بالتاريخ تفضي إلى فهم جديد للإنسان. الإنسان في ظل المبادئ السالفة يكتسي معنى جديدا يقترب من المفهوم الحديث للإنسان تلك الذات المدركة لنفسها تمام الإدراك. إنه يضحي كائنا تاريخيا؛ أي تجاوزا دائما لما عليه فعليا فكأنه مدعوّ إلى أن يلد كيانه الخاص. تاريخية الإنسان في ضوء القراءة التأويلية تعني أنه يفهم نفسه ليس من خلال التأمّل العقليّ، بل من خلال التجارب المتجدّدة و الموضوعيّة للحياة. تبعا لذلك فإنه في فهمه المتجدد للنص المقدّس مقبل ضرورة على تعديل فهمه لنفسه فيكون في حالة اكتشاف مستمرّ لهويّته التي تكون في حالة تخلّق.
ما تؤدي إليه المبادئ الثلاثة والفهم التاريخي للإنسان توحي به الآية القرآنية التي تقول عن الوحي: ﴿قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا﴾.
إذا كان الوحي متجسدا في فهم حيّ لا يتوقف للخطاب القرآني فإن النص القرآني لا يمكن أن يكون مجرد وثيقة توجيهية نظرية عامة. إنه وحي إلهي امتزجت توجيهاته بتاريخ محدد وتلبست مقاصده في واقع مما اقتضى حلولا وإجابات مناسبة. نفس هذا الجدل يحتاجه كل قارئ للقرآن إن هو أراد أن يكون مجددا ليحدد به عنصر الفاعلية في النص وفي المدونة التفسيرية وليستبين ما هو مستتر من الإرادة الإلهية وهي تفعل في التاريخ وتزيد من كشف الفاعلية الإنسانية.
لابد، إذن، عند القيام بقراءة تجديدية تواجه النص القرآني، من التمييز بين ما هو ظرفي تاريخي وما هو قيم وتوجهات محركة للإنسان وطاقاته المبدعة، وأن يدرك كيف تمّ التزاوج بينهما في صياغات حققت تغييرات كبرى كان من أهمها مزيد لاكتشاف الإنسان لذاته ومكانته ووجهته.
الهوامش
1. محمد حسين الذهبي، “التفسير والمفسرون”، ج2، ص495. والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه في علوم القرآن نوقشت بكلية الشريعة، جامعة الأزهر سنة 1946.
2. محمد الطاهر ابن عاشور، “التحرير والتنوير”، ص7 من التمهيد.
3. المصدر نفسه.
4. محمد أبو القاسم حاج حمد، “العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة”، بيروت: دار ابن حزم، 1996.
5. سيد قطب، “في ظلال القرآن”، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر ط 7، 1391-1971.
6. محمد الزركشي، “البرهان في علوم القرآن”، بيروت: دار المعرفة، 1972، ج1 ص15 وما يليها.
7. سيد قطب م، س. ص3.
8. ابن عاشور، “التحرير والتنوير”، م، س.
9. حاج حمد، م، س.
10. انظر عملنا: “الإنسان والقرآن وجها لوجه، قراءة في مناهج المفسرين المعاصرين”، دمشق: دار الفكر، 2000.
[11]. هو الباحث الباكستاني والمدير السابق لمركز الدراسات الإسلامية بإسلام أباد ومدرّس الفكر الإسلامي في قسم لغات الشرق الأدنى بجامعة شيكاغو بالولايات المتّحدة الأمريكية.