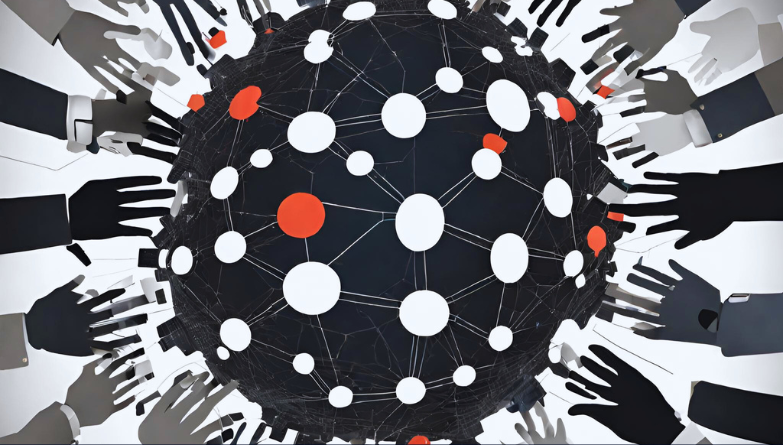لماذا يتحدد وجود الدين بين المحدثين وفي الأزمنة الحديثة كإشكال؟ لماذا تتحدد علاقتنا به كشنآن وخصومة؟ فكأيّ ما كانت الحالة التي ننزعج بها: سواء كان الدين، حضور الدين، هو سبب إزعاجنا أو كان، على العكس، انزعاجنا وقلقنا عليه، وافتقاد له، فكأيٍّ ما كان وجه الانزعاج، يتجلى الدين أساسا بين المحدثين كخلاف: فيه وحوله وبسببه. سؤالي: ما وجه/وجوه إزعاجه؟
عائقان اثنان يلزم تفاديهما كمقدمات للإجابة عن السؤال، لمقاربة الدين وتمكينه من السماح ببسط حقيقته:
- المقاربة السلفية للدين: تضل هذه المقاربة طريقها منذ البداية بافتراضها، اعتمادها، قيامها على تصور للزمن كانحطاط؛ الزمن بالنسبة لها زمان السقوط والضياع. بالنسبة لهذه المقاربة، بقدر ما نبتعد عن الزمن الأول، عن الإسلام الأول، عن الزمن الذهبي، بقدر ما نتيه، نضل ونشقى.
- المقاربة المحدثة للدين: لا تسلم هذه المقاربة من العيب الذي ارتبط أصلا بالمقاربة السلفية. وبالتالي فهي الأخرى تصطدم بمحدودية المبدإ المؤسس لها فتضيع موضوعها ضرورة؛ لأنها قامت رأسا على أساس: نحن الأنوار وما عدانا ظلام في ظلام. تدعي هذه المقاربة أن ما نحن عليه كمحدثين هو الحق، الصلاح والفلاح. ولا يوجد خارج طريقنا، خارج حاضرنا في الأزمنة الحديثة، إلا الضياع، الحجر والاسترقاق.
هذه الدعوى، حتى إذا غضضنا الطرف عن علاقتها بالماضي الذي ولى على الشاكلة التي ارتضاها لنفسه، غير آبه بحكمنا عليه، فإنها تُجرم في حق الأجيال القادمة بمصادرة حقها في التفكير بحرية ودون وصاية، حتى نحيل على كانط، مفكر الأنوار الأول. وهي بذلك تنتهك المبدأ الذي قامت عليه وقاومت من أجله. وبهذا الجرم، تسقط المقاربة المحدثة للدين بوقوعها في المحظور الذي عابته على غريمها التقليدي.
الحديث عن الدين، عن الإسلام خاصة، هو حديث عن حاضر، حاضر سمكه يربو على 14 قرنا. وهو ما لا ييسر مهمة المقاربة. نحن أمام معطى، طبقاته التاريخية المشكِّلة له، تجعل منه معطى غير شفاف، معطى تصعب قراءته وفك شفراته من أول وهلة. الإسلام كحاضر محمّل بتاريخ، تشكلت طبقات أحداثه وتراكَم ما حمله في ثنايا كل المراحل التي قطعها وعبرها، فشكلت روافدا له وجزءاً لا يتجزأ منه؛ سواء بتبنيها أو بالتمايز عنها.
هذا التهيُّب في مقاربة الدين يعني، فيما يعنيه، أن كل حديث عن الدين، الإسلام في موضوعنا، يستوجب الوعي بالزمن الفاصل بيننا وبين ظهوره؛ يعني أن الحاضر المتحدث عنه، ذي الملامح المتحدث عنها، يتم الحديث عنه الآن، في حاضرنا نحن، في حاضر غير حاضره، في حاضر مقاوم لحاضره. ومن ثمة فما نحاول القيام به هو استحضار، لا أقل ولا أكثر.
هذا الاستحضار ينطلق من أن حقيقة الإسلام الأول، حاضر الإسلام الأول، لا يمكننا أن نقف على كنهه، نتحقق منه اليوم إلا وقد اغتنى بما حمله من الأزمنة التي عبرها والتي صارت، بمعنى ما، جزءا منه. لا يمكننا أن نقارب هذا الإسلام، كمعطى تاريخي، كمعطى مؤسس للتاريخ، إلا عبر مساءلة مجموع التمثلات، التأويلات والترجمات التي اعترضت هذا الإسلام وتناولته، والتي تدين بوجودها له. يقول ابن عربي: “ليس ثم إلا اعتقادات”. وهذا ما نسميه بالمقارنة التاريخية للحدث الديني.
إلا أن هذا المعطى يعني، بالنسبة لبعض محدثينا اليوم، نفي المشروعية والحكم على ادعاء الدين، الإسلام، باستحالة أن يجد اليوم مكاناً بيننا. وهو ما يُشرع إعلان الحرب عليه في محاولته التضييق والتشويش على حاضر غير حاضره. من هنا يتخذ شكلُ العلاقة بالدين شكلَ حرب على الدين، شكل مقاومة للدين، مقاومة لهيمنة حاضر مُصر على الاستمرار رغم نفاذ شروط حضوره.
وهكذا تتحدد الحرب، وتتحدد مشروعية مناكفة دعوى الشرعية التي يرفعها الحاضر القائم في وجه حاضر آفل، وضرورة فسح المجال لمشروعية غير المشروعية الدينية التي استنفذت مشروعية القيام على حاضر غير حاضرها. اللهم إذا أقصرناها على الحياة الخاصة للناس. عندئذ وعندئذ فقط، ليعتقد كلٌّ ما شاء وليفعل ما يشاء.
بالنسبة لآخرين، اعتبر نفسي من بينهم، يتخلل هذا الخلاف حول قراءة الحاضر، مقاومة الهيمنة والتأصيل لسلوك في العيش مغايرة، يتخلله سوء فهم تُشكل مناسبة مقاربته فرصة لنا في الأزمنة الحديثة لتوسيع قاعدة مشروعنا الاجتماعي حاضرا. وهو ما لا يمكن أن يتسنى لنا إلا:
أولا؛ بالقيام بمساءلة مغايرة للتاريخ، للماضي، للدين. لأننا نعتبر أن التجديد في التاريخ، تجديدَ النظر في التاريخ، تجديدٌ في تاريخ الدين، في تاريخ العلاقة بالدين، تجديدٌ في تاريخ الدين كعلاقة، كرابط، كمجموع روابط.
وثانيا؛ لا يتسنى لنا تجاوز سوء الفهم ذاك إلا بالتخلص من شرنقة الفهم الضيق/المبتسر للحاضر، هذا الاعتداد الذي سبق لنيتشه أن ندد به، الذي ألزمنا به أنفسنا، لظروف تاريخية نجملها بالقول أنها من وقع/صدمة الجديد في مقابل هول الارتباط بالقديم واستبداده.
الوقوف على سوء الفهم، الذي يتخلل علاقتنا بالدين، هو إذا فرصة تُهتبل لربئ صدع الحاضر، الحاضر الحداثي، وتَراوحه بين انفتاحية الحداثة اللامشروطة من جهة، وتعلُّق هذه الحداثة بظرفية كابحة لروح التحليق التي أتت بها. وهو ما يحول بيننا في الأزمنة الحديثة وبين الانخراط الجدي في الالتزام بمستجوبات المقاربة التاريخية في جذريتها المفتوحة على المستقبل. فالحداثة حاضرٌ دوما آتٍ، حاضرٌ دوما مُقبل. يذكرنا بولتمان، وهو مع “كارل بارث”، من أكبر المجددين في مقاربة التصور المسيحي-اليهودي للدين، يذكرنا بحقيقة تاريخية حاسمة. يقول: “عندما نُذكر بحدث تم في الماضي، فإننا لا نُذكر به كحدث ولّى، بل نُذكر به كحدث لم يزل حاضرا في القول الذي تمت مخاطبتنا به”[1]. وهو ما سبق أن أشار اليه ابن عربي منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادي عندما قال: “كما أنك في التجديد عين ما أنت في الزمن الماضي”، “هو هو”؛ هو “ما ذكرناه من تجديد الخلق بالأمثال”[2]، “بل هم في لبس من خلق جديد”، “فلا يعرفون تجديد الأمر مع الأنفاس”[3].
فالدين في تجليه في زمن معين وفي ارتباطه وانخراطه، ضرورة، بحكم سلطان الوقت، بحكم ضرورة قوانين؛ الحياة، الطبيعة، التاريخ، وبحكم مستوجبات ظرفيته: ضرورة أن يتكلم لغة زمانه وأن يحاور منطق المعنيين الأُول بخطابه/رسالته، التي ينازعها الهيمنة/السيادة، تماماً كما تتنازع سيادته/سلطته اليوم، ينازعها الحق في التجديد وضخ حياة في الحياة، بعث الحياة في الحياة، في ما بقي من حياة ولّت، في ما بقي شاهدا/حاضرا من حياة مضت.
اختصارا ينازعها حق التأسيس لأزمنة جديدة)، أن الدين وهو يتجلى حسب سنن ظواهر الكون لا يتهافت في مبدئه، ولا يُعترض على رسالته ولا على مهمته بأنها مستنفَذة في زمن إنشائها/خطابها، “وإنما ورد الخطاب الإلهي بحسب ما تواطأ عليه المخاطبون وما أعطاه النظر العقلي”، كما قال ابن عربي[4]؛ وهو نفس ما يقوله معتبراً: “أن الخطاب يكون من البليغ على حسب ما تووطئ عليه في العالم حتى يفهم السامع منه لغتَه”[5].
أكثر من ذلك؛ إن الدين، وكغيره من الظواهر، يستوجب فسحة الزمان وانبساطه ليتحقق، باعتباره هو ما يمده بإيقاعه. وللتذكير، فـالدين المؤسِّس هو الدين الذي زامن وجوده مرحلة بيننا وبينها 14 قرنا ونيف، عندما هيمن الإسلام على زمانه، فصار كونيا. فمنذ ظهوره، وبظهوره تأسس شكل جديد لوجود الزمان، لعد الزمان والحديث عنه. وكما أن ظهوره تم في الزمن، وحسب مقتضيات الوقت فكذلك حقيقة الدين لا تميز مخاطبيها المباشرين (شهود ظهورها) عن باقي البشر بإقامة زمن ذهبي يجعل من باقي الناس مجرد لاحقين.
إلا أن هذه الحقيقة، شرط تجلي الأشياء في ما هي عليه، حقيقة الدين من بين ظواهر أخرى، هو ما اعترض عليه المحدثون في المبدإ المؤسس لمجتمعاتهم، في شكل تواجدهم الجماعي، فيما يدينون له في جمعهم. لا نستطيع في الأزمنة الحديثة أن نتصور الدين، على غرار ما نتصور به الظواهر الكونية الأخرى (الحقيقة، الفكر…)، إلا في ارتباطها وعدم استقلاليتها عن شروط ظهورها. وهو ما نسميها في أدبيات تفكيرنا النزعة التاريخانية. ومن ثمة فلا مجال لفهم الدين اليوم، وأن نقيم له مكاناً بيننا، إلا بإدراكنا لمحدودية منظورنا، وبالتالي إدراكنا لمصدر الشرور التي تلحق وجودنا وتنعكس على مجتمعاتنا.
يبدو أن لا إمكان في تجاوز سوء الفهم هذا والتأسيس لحاضر جماعي/إنساني أرحب وأوعى بالإنسان، إلا بنقد وتمحيص ما قام عليه هذا الحاضر في أفق إعادة تملُّك الأساس الذي تقوم عليه مجتمعاتنا، إعادة تملُّك ما يُميز وجودَنا الجماعي ويَطبع زمنيتَه. لا يمكننا أن نسلُب التقابلَ الديني، الاعتراضَ على الدين، إلا بتفكيرنا، تملُّكنا لـ”سرّ” الدين، “لسرّ القيام في زمانين”، كما يقول ابن عربي.
لا يمكننا أن نتمعن في روح الدين إلا بالتفكير:
- في ماذا تكمُن قدرة حاضر معين على الاستمرار، قدرتُه في أن يشمل ويمتد لأزمنة حاضرة غير التي شهدت بزوغَه، قدرتُه، 14 قرنا على ظهوره، في أن ينازع حاضرَنا دعوى/مطمحَ استقلاليته؛
- لا يمكننا الوقوف على روح الدين، روح الاستمرارية في الزمن، إلا إذا أسسنا لحاضر يُعلي من قيمة الحياة، من إنسانية الإنسان. وهو ما يعني أن نأخذ من الدين الشاهد، هذا “الاستعداد المسؤول”، نص بولتمان (cette disponibilité responsable)، الذي كان يحمله في زمن تجليه، في مهمته الأساسية؛ إذكاء الحياة فينا..
- لا يمكننا القيام بهذه المهمة في فهم الدين (الذي ندين به للحياة) إلا إذا حررنا الحياة فينا، حررناها من شرنقة تصورنا النزَّاع إلى اختزال الزمن في الزمن الحاضر، والحاضر في الراهن والملحوظ، تحرير علاقتنا بالزمن من هيمنة التصور التقليدي المهيمن. (ربط المصلحة رأسا بالمردودية، والمردودية بما ينعكس آنيا على الأنا الفردي، الأنا المجتزأ من التاريخ، السابق واللاحق عليه: أهمية سؤال الاستخلاف في التصور الديني).
نختم هذا العرض بإعطاء نماذج لعلاقة التحرر والتحرير هذه:
ثبت فيما روي عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أحد كبار الصحابة وواحد من الذين أسسوا ليس فقط حقيقة الإسلام، وإنما أيضاً من الذين أقاموا له ميثولوجيا، ميثولوجيا الإسلام. لم يستسغ هذا الصحابي، ولم يقو عقله الكبير الرجحان، لم يقبل نبأ موت النبي. وكان يلزم لإقناعه تذكيره بآية قرآنية من الأكيد ليس فقط أنه قرأها وأقرأها للكثير من رجالات الإسلام الأُول، ومع ذلك يعترف بفوات معناها البسيط والظاهر عليه. يقول، فيما روي عنه، بعد أن تُليت عليه، وكأنني أسمعها لأول مرة، وكأنني لم أسمعها من قبل!
هكذا يتضح أن ما يميز حاضر القول (الكلام/الخطاب) المؤسس، اللغة/المؤسسة، أنها/أنه دوما آت. إن القول الأول لا يفتأ يَؤول ويُتأول. إن حقيقته دوما متوارية، تنتظر ما يفسح لها الطريق ويوجب ظهورها، ظهور الحياة واستمرارية الحياة. يتحدث ابن عربي عن “الباعث على السؤال”، ويتحدث عن “ما يقتضيه حال دون حال وزمان دون زمان”، و”ما يعطيه الاستعداد”، وأن الاستعداد ليس للمرء/”للفرد فيه يد”، وأنه “من موجبات الوقت”، وأن “هذا السؤال من أغمض الأسئلة”، وأنه “سر القدر”، وأنه “غاية ما يدركه العقل”[6].
تحمُّل مسؤولية الحاضر، إنعامُ التفكير فيه، وتدبُّر مقتضيات ما يوجبه، سلبا وإيجابا، يَفسحُ المجالَ للحياة فينا ومن خلالنا، كحياة دينية، كمِنَّة وعرفان بالوجود (وهو من معاني الحاضر/العطاء، الهدية في اللغة الفرنسية). يميز ابن عربي بين صنفين من المتسائلين؛ “صنف بعثه على السؤال الاستعجال الطبيعي… والصنف الآخر بعثه على السؤال… احتياط لما هو الأمر عليه من الإمكان، وهو لا يعلم ما في علم الله، ولا ما يعطيه استعداده في القبول؛ لأنه من أغمض المعلومات الوقوف في كل زمان فرد على استعداد الشخص في ذلك الزمان. ولولا ما أعطاه الاستعدادُ السؤالَ ما سأل (…) ثم اقتضى لهم الحال في زمان آخر أن يسألوا؛ فإذا وافق السؤال الوقت (…) والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه ويشعر بالحال لأنه يعلم الباعث وهو الحال (…) فالاستعداد أخفى سؤال (…) وما ثم صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف؛ فهم الواقفون على سر القدر (…) وهو أعلى وجه يكون للمتكلم بعقله في هذه المسألة[7].
تماماً، وعلى غرار هذا التجاوز، فالعوائق التي تُفرزها القراءات المبتسرة للقول الديني: المساواة بين الرجل والمرأة، تصبح متجاوزة وغير ذات معنى بمقتضى ما يوجبه حاضرنا اليوم، تماماً كما انحلت عوائق الاسترقاق وتعدد النساء بالنسبة لمجتمعات نهاية القرن 19، زمن المصلح محمد عبده. لم يمح مسلمو القرن 19 آيات وأحكام الموالي والإيماء، بل تم نسخها/تجاوزها والإبقاء عليها رسما، على غرار منسوخ القرآن، شاهدا على سعة القول المؤسس ورحابة صدره في أفق تحقيق الإنسان لإنسانيته. نفس الشكل تم مع التعدد والمساواة.
(…) فما كان حراماً في شرع يكون حلالا في شرع آخر؛ أعني قولي يكون حلالا، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى؛ لأن الأمر خلق جديد ولا تكرار؛ فلهذا نبهناك[8].
سند آخر أجده لهذا الفهم/الاجتهاد فيما قاله أحد مصلحي النصف الأول من القرن العشرين؛ محمد إقبال. يقول: “لا يمكن أن يتم فهم القرآن قبل أن يتم فعلا تلقي كل مؤمن مؤمن له كوحي، تماماً كما تم تلقيه من طرف الرسول”. أن تتلقى الدين، أن تنزله، كفرد أو عصر لا يهم، وكأنك المخاطب والمعني الأول به. هنا سيتحدد التقليد، السير على سنن من قبلنا، كخلق للتقليد، بعث وتجديد لهذا الذي ولى. فولى كما تعلمون من الكلمات الأضداد، تعني الذي مضى وانقضى، ولكنها تعني أيضاً الذي عاد.
سند أخير لهذا الاجتهاد، ربما هو أصل قولة صاحب “إعادة بناء العقل الإسلامي”، محمد إقبال، أجده في ما قاله ابن عربي: “لا يعرف ما قلناه إلا من كان قرآنا في نفسه[9]“.
الهوامش
[1] . رودولف بولتمان، الإيمان والفهم، الترجمة الفرنسية، منشورات السوي، 1969، ج2، ص246.
[2] . محي الدين بن عربي، فصوص الحِكم، تعليق: أبو العلا عفيفي، بيروت: دار الكتاب العربي/لبنان، ص157.
[3] . المصدر نفسه، ص125.
[4] . المصدر نفسه، ص83.
[5] . ابن عربي، كتاب الأزل، رسائل ابن عربي، ص8.
[6] . فصوص الحكم، م، س.
[7] . فصوص الحكم، م، س، ص59-60.
[8] . المرجع نفسه، ص201-202.
[9]. المرجع نفسه، ص89.