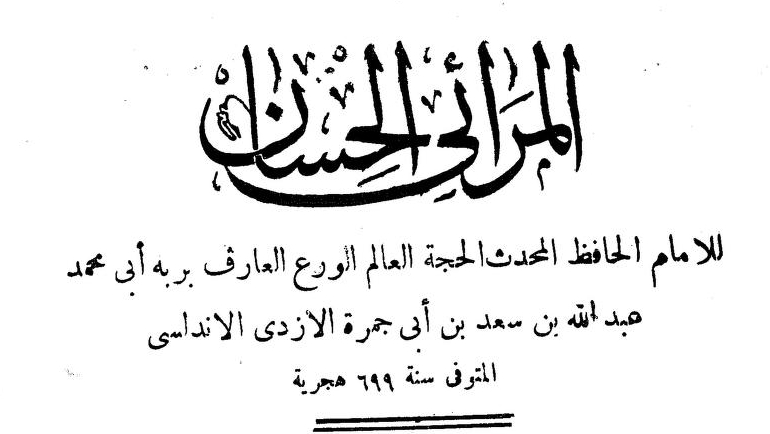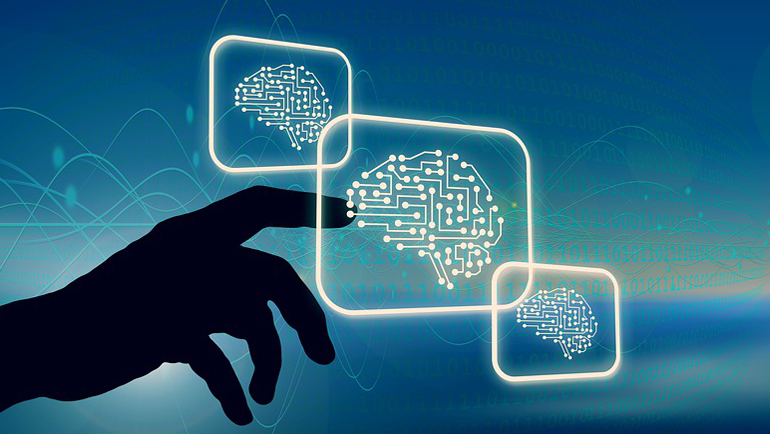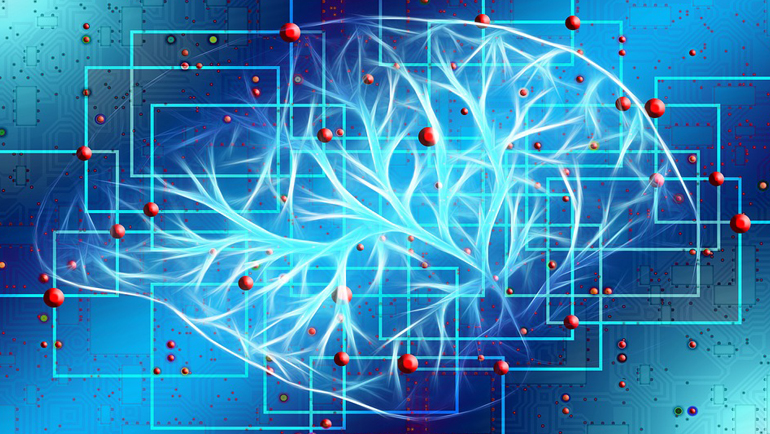لقد كانت مسألة التعدد والاختلاف في فهم النص من كبرى القضايا التي شغلت بال علماء التفسير والفقه قديماً وحديثاً، وهي لا تزال تمثل ركيزة اهتمام بالغ في الأوساط العلمية المعنية بدراسة الأديان عموماً والنص الديني خصوصاً. وبنظرة عجلى في المآثر التفسيرية والفقهية الإسلامية يمكننا تلمس الأثر الذي تركه اختلاف الفهم في اختلاف التفسير، وتعدد طرق الفقه في تلك النصوص التي احتملت الاجتهاد، وداخلتها أسباب الاحتمال اللغوي والشرعي التي سمحت بتعدد النظر والفهم حولها.
وبما أن النص التشريعي الإسلامي ثابت بالوحي الإلهي المباشر أو بتقريره وإقراره تبارك وتعالى نبيَّه محمداً عليه الصلاة والسلام؛ فإنَّ وطأة القضية تزداد ثقلاً، ذلك أن هذا التشريع من خصائصه الثابتة كونه عاماً وشاملاً لكل زمان ومكان وظرف ومكلف. ونصوصٌ بهذه الطبيعة لا مناص أن يكون فهمها وتفسيرها وتأويلها على قدر كبير من الخطورة والأهمية، لما تتمتع به من صفة الدوام والصلاحية، وما تتسم به من صفاء النبع وصدق الرسالة التي جعلتها هدى محضاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من أجل ذلك لا بدّ من دراسة واعية للمرتكزات الدلالية التي يتم بمقتضاها تحديد الإطار البياني للخطاب القرآني تحديداً وافياً بمهمة التشريع المتواصل ومسايراً للوحدة الاجتماعية ووحدة التكليف اللتين تحظى الأمة الإسلامية بركوب سنامهما واعتلاء صهوتهما.
في هذه الورقة سيتم شد النظر إلى أهم المرتكزات الدلالية التي تحتفظ للخطاب القرآني بصفة القيومية والهيمنة التشريعية موازية لخصيصة الثبات والاستقرار، لنضع بذلك حاجزاً منيعاً أمام الرؤى والنظريات الحديثة التي يراد لها أن تتسلل إلى عمق المنهجية الإسلامية في التعاطي مع دلالات النصوص الشرعية، لاسيما نظرية الهرمنطيقا الفلسفية الحديثة، ونظرية لعبة اللغات اللتين تَؤولان بالخطاب حتماً إلى أداة طيعة منقادة لما في نفوس المتلقين من أفهام مسبقة، وما في أذهانهم من تصورات سابقة وما في قلوبهم من أوهام لاحقة، متخذتين من فلسفة “لعبة اللغات” أساساً لتطويع النصوص وتسخيرها لمعان لا حصر لها ولا تتقيد بدلالة مركزية ثابتة، ليصبح فهم النص فوضى بلا قرار وكلأًً مباحاً بلا حِذار.
ومن أهم هذه المرتكزات:
أولاً: توزيع معنى النص إلى أقل المعنى وأكثره
أو ما يسمى حديثاً بالتوزيع الدلالي، وذلك من خلال وضع حدود تقريبية لمعنى النص يكون الجامع بينها كون المعنى الأقل سارياً في الأكثر غير مهمل ولا معطَّل، وأن ينتمي إليه المعنى الأكثر ويحتفظ بانتسابه إليه ولا يصل في البعد منه حد الإلغاء أو الإبطال أو الغرابة. ويستند هذا التصور إلى مجموعة من الدعائم العلمية، منها: أن كون الخطاب عاماً وشاملاً ومتعلقاً بجميع المكلفين يقتضي أن لا يقتصر به على فهم معين ضيق لا يتسع لمصاديق عدة، كما أن وحدة الأمة والتكليف تقتضي أن لا يختلف الفهم اختلافاً يرفع الثقة من فهم النص التشريعي ولا يمثل وحدة الخطاب والتكليف والأمة، فتوجيه الخطاب إلى الأفهام المختلفة يقتضي اتساع المعنى ومجيء البيان من وجوه عدة لا من وجه واحد، لكن شريطة أن يكون بين تلك الوجوه جامع يأخذ بناصيتها ويعصم أمرها.
يقول الإمام الشافعي (ت 204ﻫ): “البيان يكون من وجوه، لا من وجه واحد، يجمعها أنها عند أهل العلم مُبيْنة ومشتبهة البيان، وعند من يقصّر علمه مختلفة البيان”[1]، وذلك بعد أن بيَّن أن “البيان اسم جامع لمعانيَ مجتمعةِ الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربةُ الاستواء عنده، وإن كان بعضُها أشدَّ تأكيدَ بيانٍ من بعض. ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب”[2]. فالبيان عنده لا ينحصر في معنى، بل هو اسم جامع لكل المعاني المجتمعة المتشعبة، ويتوزع إلى البيان الأقل والبيان الأكثر، وأقل البيان هو: الفهم الذي فهمه المخاطبون بتلك النصوص ممن نزل القرآن بلسانهم، وهو متقارب الاستواء عند من خوطبوا به، فلا تختلف مستويات فهمهم له اختلافاً بعيداً، وإن كان في النصوص ما هو أكثر وضوحاً من بعضها، أو كانوا متفاوتين في قوة إدراكهم وفهمهم. ثم إن كل المعاني المجتمعة الأصول والمتشعبة الفروع ينبغي أن تترتب على مراعاة فهم المخاطبين بالقرآن والسنة، لأن ذلك الفهم هو الحد الأدنى الجامع بينها. ويبرهن الإمام صحة الاعتماد على توزيع النص إلى أقل المعنى وأكثره بقوله معقباً على نصوص قرآنية متفاوتة في درجات الوضوح: “… وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معاً، لأن أقل البيان عندها كافٍ من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهمه به كاف عنده”[3]. وللجاحظ (ت 255ﻫ) عبارة قريبة من عبارته يؤكد فيها تلك الحقيقة، إذ يقول: “البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير… كائناً ما كان ذلك البيان… لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلَّغتَ الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع”[4].
وتقسيم البيان إلى الأقل والأكثر يرادفه في الدراسات الدلالية الحديثة تقسيم الدلالات إلى دلالة مركزية ودلالة هامشية، فقد قالوا: إن الدلالة المركزية قدر مشترك من الدلالة يصل بالناس إلى نوع من الفهم التقريبي الواضح في أفهامهم بحيث إن الاختلاف بينهم لا يعوق التفاهم والتبادل بين وجهات النظر؛ لأنه اختلاف في نسبة الوضوح لتلك الدلالة لا يرفع الثقة من فهم النص. أما الدلالة الهامشية فهي تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاربهم وسجاياهم وقدراتهم وموروثاتهم عن الآباء والأجداد. فالدلالات الهامشية تختلف باختلاف أصحابها ومتغيرة، والدلالة المركزية دلالة ثابتة[5].
ثانياً: تعيين الحالة المقامية التي توجِّه دلالة النص إليها
وذلك باعتبار أن هذه الحالة المقامية عنصر مساعد على تحديد الدلالة المركزية في النص، ذلك أن الألفاظ تتعرض للتغيرات الدلالية بالتقييد والتخصيص والتعميم والاشتراك وغيرها، بتغير ظروف تداولها واستعمالها، فلفظة (سيارة) في سورة يوسف أريد بها قافلة مارة، وفي زماننا هذا تطلق على الآلة المعروفة في وسائل النقل الحديثة. فلو فتح النص أمام التداولات المختلفة لضاق بالمعنى المراد وتعطل عن الفائدة المرتجاة في كثير من الأحيان. والحالة المقامية شاملة للأساليب اللغوية والعادات اللسانية الجارية في وقت التنزيل وللعادات الفعلية والعرفية السائدة وقتئذٍ، يضاف إليها ما يروى في خصوص نزول أو ورود بعض النصوص التشريعية من أسباب قولية خاصة أو أسباب فعلية وحوادث وظروف خاصة كانت قرينة بالخطاب الشرعي وهي تبين مساقه وتستجلي مقصد الشارع منه. يقول الإمام الشافعي مبيناً لسان العرب الذي خوطب المكلفون بمقتضاه: “إنَّما خاطب اللهُ بكتابه العربَ بلسانها، على ما تعرف من معانيها”[6]. ويقول ابن تيمية (ت 729ﻫ): “الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول، صلى الله عليه وسلم، عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك… ولا يجوز أن يُحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه”[7]. وينتهج الإمام الشاطبي (ت 790ﻫ) منهجاً خاصاً في تسمية الحالة المقامية فيدرجها جميعاً تحت مقتضى الحال ثم يجعل السبب دليلاً عليه، والسبب عنده شامل للأسباب القولية والفعلية الخاصة والعامة بما فيها العادات الجارية؛ يقول: “معنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال… ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التـنزيل، وإن لم يكن ثمة سبب خاص”[8]. ثم يبين أثر المعرفة بالسبب في فهم النص قائلاً: “إن الغفلة عن أسباب التـنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات… هذا شأن أسباب النـزول في التعريف بمعاني المنـزل، بحيث لو فُقد ذكر السبب لم يُعرف من المنزَّل معناه على الخصوص، دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات”[9].
ثالثاً: تحديد إلى من توجه الخطاب الشرعي التوجه الأول المباشر
المرتكز الثالث يتمثل في تحديد إلى من توجّه الخطاب الشرعي التوجه الأول المباشر وجعل مستواه في الفهم والإدراك مستقرَّ المعنى المركزي للنص ومستودعه، ومرجعاً لجميع الأفهام والتفسيرات التي يمكن أن تستجدّ باستجداد أدوات الفهم والتفسير أو الاستكشافات التي تتعلق بالمضامين الكونية والحقائق العلمية التي تعرضت لها النصوص وأدلت فيها بدلوها. وهذا يعني أن لا نحصر النص في وجه واحد وأن لا نفتحه على كل المعاني، بل نراعي في الفهم مستوى المخاطبين به لنؤسس في ضوئه حدود النص وطاقاته الدلالية ومركز المعنى فيه، ثم نفتح النص على كل فهم وتفسير جديد يراعي ذلك الأساس من المعنى فلا يسقطه ولا يقصر عنه ولا يتجاوزه. ولقد أدرك العلماء الأوائل أهمية هذا الركن في تحديد دلالة النص وبيان أفقه الدلالي وطاقته البيانية الواسعة.
وكان الإمام الشافعي المدون الأول لعلم الأصول قد استهل رسالته ببيان هذا، حيث قال: “البيان اسم جامع لمعانيَ مجتمعةِ الأصول متشعبة الفروع. فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربةُ الاستواء عنده، وإن كان بعضُها أشدَّ تأكيدَ بيانٍ من بعض، ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب”[10].
فيقرر في هذه العبارة أن الفهم الذي لا يمكن تجاوزه والتقصير عنه هو: الفهم الذي فهمه المخاطبون بتلك النصوص ممن نزل القرآن بلسانهم، وأنه متقارب الاستواء عند من خوطبوا به، فلا تختلف مستويات فهمهم له اختلافاً بعيداً، وإن كان في النصوص ما هو أكثر وضوحاً من بعضها، أو كانوا متفاوتين في قوة إدراكهم وفهمهم. وبذلك فقد أثبت قاعدة أصولية في البيان مفادها أن كل المعاني والدلالات المجتمعة الأصول والمتشعبة الفروع ينبغي أن تترتب على مراعاة فهم المخاطبين بالقرآن والسنة؛ لأن ذلك الفهم هو الحد الأدنى الجامع بينها. وبهذا تكفَّل لنا الشافعي بالمحافظة على معنى الخطاب مهما اختلفت الثقافات والأنظار وتطورت وسائل الفهم والإدراك، فكل فهم تجاوز أقلَّ فهمِ من خوطبوا بخطاب الشارع وقت نزوله أو قصَّر عنه فهو فهم ساقط لا يدرج في المعاني التي تجتمع أصولها وتتشعب فروعها؛ لأن ذلك الفهم الخارج عن ذلك النمط يخرج الخطاب من أن يكون خطاباً، ويجعل النص معدوم المعنى أو داخلاً في إطار ما يسمى بلعبة اللغات.
رابعاً: مراعاة مقاصد صاحب الخطاب وعاداته
فبفقه مقاصد البيان يتحقق للمستنبط من النص اقتدار على ضبط حركة المعنى في النص، فضلاً عن أنه يحقق سبل القناعة الفكرية والوجدانية بما انتهى إليه الاستنباط من النص[11]. وهذا يعني أن نفسر النص ونشحن دلالاته بما عُهد لصاحب الشريعة من مقاصد في التشريع وعادات في البيان وأن ننزل عند العلل والمصالح التي أراد الشارع ترتيبها على الأحكام، وذلك عبر توجيه النظر إلى صفات الشارع وحدود ما أنزل الله به من التشريعات وبناء العلاقات البيانية التكاملية بين النصوص على أساس أنها وحدة بيانية واحدة تجمعها إرادة الشارع الواحد التي تأبى التناقض والتعارض والاختلاف[12].
يقول ابن حزم (ت 456ﻫ): “الآيات والأحاديث المبينة لها؛ مضموم كل ذلك بعضه إلى بعض، غير مفصول منه شيء عن آخر، بل هو كله كآية واحدة أو كلمة واحدة ولا يجوز لأحد أن يأخذ ببعض النص الوارد دون بعض، وهذه النصوص وإن فرقت في التلاوة فالتلاوة غير الحكم ولم تفرق في الحكم قط… والحديث والقرآن كله كاللفظة الواحدة، فلا يحكم بآية دون أخرى، ولا بحديث دون آخر، بل بضم كل ذلك بعضه إلى بعض، إذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض، ومن فعل غير هذا فقد تحكم بلا دليل”[13].
ومن هنا وجدت في الأصول مباحث تعنى بكيفية بناء العلاقات البيانية بين النصوص ووجدت مباحث التخصيص والتقييد والنسخ وبيان الإجمال ورفع التعارض بين النصوص والأحكام، كل ذلك ليجعلوا الدليل الشرعي هو مجموع البيان والمبين وليبينوا أن الحكم الشرعي محصَّل علاقات تكاملية بين نصوص الشارع التي تجمعها مقاصد متشابهة، ولذلك قال الشاطبي: “ومدار الغلط… إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها… فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً… وشأن متبعي الشهوات أخذ دليل ما أي دليل كان عفواً وأخذاً أولياً وإن كان ثَمَّ ما يعارضه من كلي أو جزئي”[14]. ولهذا “لا يقتصر ذو الاجتهاد على التمسك بالعام مثلاً حتى يبحث عن مخصصه، وعلى المطلق حتى ينظر: هل له مقيد أم لا؟ إذ كان حقيقة البيان مع الجمع بينهما، فالعام مع خاصه هو الدليل، فإن فقد الخاص صار العام مع إرادة الخصوص فيه من قبل المتشابه، وصار ارتفاعه زيغاً وانحرافاً عن الصواب”[15]. ثم إن مقاصد النصوص متكاملة، وبما أن المقاصد الضرورية والحاجية والتكميلية بعضها مقيد ببعض فكذلك نصوص الشارع التي هو دليل الكشف عنها، فحصل من ذلك أن خطاب الشارع يتوقف بعضه على بعض في الفهم[16].
فالأخذ بمقاصد الشارع ركن من أركان الفهم في النص، ووسيلة من وسائل تعيين المعنى ومنعه من تطرّق ألوان التأويل الفاسد إليه؛ لأن فهم الشريعة ليس منوطاً بالجانب اللغوي فحسب، بل الأمر كما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت 471ﻫ): “لابدَّ لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة… وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ومعانٍ شريفة ورأيت له أثراً في الدين عظيماً، وفائدةً جسيمة، ووجدته سبباً إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنـزيل، وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلَّق بالتأويل”[17]. فلابدَّ لمتفهم الخطاب أن يفرق بين سياق النص اللغوي العادي وسياق النص الشرعي، وأن يوجه فهمه للنص التشريعي توجيهاً خاصاً مراعياً كلَّ المراعاة مقام التشريع وما يفرضه ويستلزمه من مقاصد، فحينئذٍ تظهر له في سياق الخطاب الشرعي وجوه الاستدلال الصحيح وطرق الاستنباط السليم. وقد نبَّه الشيخ ابن عاشور إلى هذا فقال: يقصِّر بعض العلماء ويتوحَّل في خضخاضٍ من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ، ويوجِّه رأيه إلى اللفظ مقتنعاً به، فلا يزال يقلِّبه ويُحلله ويأمل أن يستخرج لبَّه، ويُهمل الاستعانة بما يحفّ بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق، فلا يتضح له ما يستنبط من العلل والحِكم والمقاصد، وإن أدق مقام في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليه مقام التشريع[18]. والأصوليون عندما طوَّروا الحديث في مقاصد الشارع فإنما أرادوا من ذلك تحديد وجهة النصوص، كي لا يُنحرَفَ بها عن مسارها التشريعي القويم المستقيم، فمقاصد الشارع عاصمة للتفسير ومحددة للمعنى المركزي في النص، والأصوليون عندما تحدثوا فيها أرادوا توظيفها في هذا الغرض، ولذلك لا صلة بين حديثهم وبين أفكار المحدثين من تيار اليسار الإسلامي ممن أرادوا من مقاصد الشارع والحديث فيها إلغاء دلالات النصوص وتحريف وجهتها وتطوير الدين وإلباسه لبوساً جديداً يجعله وهماً لا قرار له. وقد بيَّن الإمام ابن عاشور هذا الغرض من دراسة المقاصد وقال: “أدلة الشريعة اللفظيةُ لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية”[19] بدليل “أن الكلام لم يكن في لغة من لغات البشر، ولا كان نوع من أنواعه وأساليبه في اللغة الواحدة، بالذي يكفي في الدلالة على مراد اللافظ دلالة لا تحتمل شكاً في مقصده من لفظه”، وبما أن المقاصد تستخرج من “سياق الكلام ومقام الخطاب ومبينات من البساط” فإنها “تتضافر على إزالة احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه”[20]. لذا فإن من العبث النداءَ إلى الاستقلال بمبحث مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقه، لأنها مرتبطة به هذا الارتباط العضوي الذي يتلخص بأن مقاصد الشارع وسيلة من وسائل تحديد المعنى المركزي في النص ولا يمكن بحال من الأحوال أن تستقل عن النصوص التشريعية وعن الأحكام الفقهية المستقاة منها ولا أن يوجد ما يسمى مقاصد الشارع خارج دائرة النصوص بما فيها من القيم والعقائد والأحكام، إذ “لا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر”[21]، فعزلهما عن بعضهما يعني أن تكون دلالة نظم كلام الشارع في واد ودلالة مقاصده في واد، وهذا يعني في النهاية خلق نزعتين متناقضتين أو متقابلتين إحداهما حرفية تتمسك بالقوالب والألفاظ، والأخرى تحلق في غلواء المعاني، وقد تنتهي إلى نزعة باطنية جاحدة[22]. وإذا كانت المقاصد ركيزة الدلالة في نظم الكلام مع الاعتبار اللساني السليم له فإن الحاصل هو الفقه المسدَّد الذي يقربنا من مراد الشارع ويجعلنا على وسطية في الفهم هي خصيصة هذه الأمة وخاصتها. ولذلك ركز ابن القيم (ت 751ﻫ) على ضرورة الإلمام بالمقاصد التشريعية الجامعة وأسماها “حدود ما أنزل الله” في تفسير النص، وأشاد بالفهم الذي ينبسط عليها مذكِّراً بأن كلاً من أرباب الألفاظ وأرباب العلل والمعاني قد تجاوزوا الطريقة المثلى في فهم النص ولم يخرجوا عن دائرتي التجاوز والتقصير بالألفاظ عن مقاصدها ومراد الشارع منها، فتراه يقول: “يعرُض لأرباب الألفاظ التقصيرُ بها عن عمومها وهضمُها تارة وتحميلها فوق ما أريد بها تارةً، ويعرُض لأرباب المعاني فيها نظيرُ ما يعرض لأرباب الألفاظ… ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدتَه وآخيتَه التي يُرجع إليها، فلا يُخرج شيئاً من معاني ألفاظه عنها، ولا يُدخل فيها ما ليس منها، بل يُعطيها حقَّها ويفهم المراد منها”[23]. فعادات الشارع ومقاصده التشريعية تُعرِّفنا بحدود ما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ففي قوله تعالى: (فلا تَقُل لهما أفِّ) (الإسراء: 23)، لا يمكن أن يفهم جواز الشتم والسبّ، لأن الشارع إذا حرَّم قليل الأذى حرَّم ما فوقه، وإذا منع أدون الأمرين منع أعلاهما[24].
والنظر إلى مقاصد الشارع يجب أن يكون قيداً حاضراً في النزول على معهود المخاطبين بالشريعة كالذي أسلفنا بيانه في الفقرة السابقة، ولذلك أدرج الحنفية حال المخاطبين تحت حال المتكلم منبهين بذلك على أن حال المخاطب لها من الاعتبار ما جعلها حالاً للمتكلم نفسه، وذلك من حيث إن المتكلم لا يُخرج كلامه إلاَّ على موافقة حال المخاطب، فكانت حاله مقصودة في إرادة المتكلم، ومنبهين به أيضاً على أنه لا يجوز إدخال حال المخاطب في مقصود المتكلم إلاَّ إذا قصدها المتكلم، فما لم تصبح حال المخاطب مقصودةً للمتكلم فلا اعتبار لحاله في تفسير كلام المتكلم. وهم بذلك يخرجون من إشكال عظيم، هو أن تُجرَّ جميع أحوال المخاطبين إلى تفسير خطاب الشارع إلى درجة قصره عليها وإن لم يقصدها الشارع، وعليه فلا عبأ بأحوال المخاطبين في تفسير خطاب الشارع إلاَّ ما يُعلم أن الشارع قاصد إليها[25]. وهذا يعني أنه بمراعاة مقاصد الشارع يمكن تفادي الغلوّ الذي يقع بعض الباحثين في شراكه إذ لا يكادون يحملون النص إلاَّ على المعنى الذي يناسب طائفة واحدةً ولا يمكن عمومه للأزمان والبقاع والمكلفين. ومن هذا القبيل ما وقع فيه إمام المقاصد أبو إسحاق الشاطبي حين حصر العلوم التي يستعان بها في تفسير القرآن فيما كان للعرب عهد به من علوم ومعارف، حتى ادعى أميَّة الشريعة على الإطلاق، ورتب على ذلك أن الفهم الأمي هو المقصود للشارع[26]. فعلى الرغم مما تتمتع به فكرة الشاطبي من إيجابيات وفوائد علمية بيانية تعود على حرمة النص بالمغزى وتحافظ على وشيجة القربى بين التفاسير والأفهام حتى ينزل كل مجتهد في فهم النص منزلة واحدة دون شطط وانحراف ودون تغليب النزعات الشخصية والمذهبية على مفهوم النص، حفاظاً على وحدة التفاهم الديني للأمة المسلمة[27]؛ إلاَّ أن جمهرة من العلماء والمفسرين انتقدوه وطعنوا في صحة هذا الادعاء[28]. وممن ردَّ عليه الإمام ابن عاشور الذي يرى أنه في إطار مراعاة المستوى المركزي من الفهم وبعد التوصل إلى مكنون المعنى فإن جميع المعاني المتعلقة بالحقائق الكونية والسنن الإلهية في الأمم والأفراد والجماعات وبحقائق الأمور مما يجوز أن يتطور الفهم لها وتفسيرها تبعاً لتطور العلوم والمعارف، شريطة أن لا يجر الخطاب إليها جراً وأن تتناسق دلالات النص مع ضوابط الفهم الأول وتلتزم به؛ يقول: “لا شك أن الكلام الصادر من علام الغيوب تعالى وتقدَّس لا تُبنى معانيه على فهم طائفة واحدة، ولكن معانيه تطابق الحقائق، وكل ما كان من الحقيقة في علم من العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه، وذلك يختلف باختلاف المقامات، ويبنى على توفر الفهم. وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربيةً، ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل، ولا يكون تكلفاً بيناً ولا خروجاً عن المعنى الأصلي، حتى لا يكون في ذلك كتفاسير الباطنية”[29]. ولذلك أنكر حصرَ العلوم التي يستعان بها لفهم الخطاب القرآني فيما كان للعرب عهد به من علوم ومعارف في زمن التـنزيل، واستنكر حكمَ الشاطبي بالضلال على من طلب فهمه بغير ذلك[30] قائلاً: “إن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداءً لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوماً لديهم، فأما ما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وتحجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه”[31]. ويرى الشيخ ابن عاشور أن القرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج السامعون إلى علمه، وكل ما له حظ في البلاغة، سواءً كانت متساويةً أم متفاوتة في البلاغة إذا كان المعنى الأعلى مقصوداً، وكان ما هو أدنى منه مراداً معه، لا مراداً دونه، سواءً كانت دلالة التركيب عليها متساويةً في الاحتمال والظهور أم كانت متفاوتةً بعضها أظهر من بعض، ولو أن تبلغ حد التأويل[32]. واستطرد قائلاً: “ولما كان القرآن نازلاً من المحيط علمه بكل شيء، كان ما تسمح تراكيبه الجارية على فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب في أمثال تلك التراكيب مظنوناً بأنه مراد لمنزله، ما لم يمنع من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو توقيفية”[33]. وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون، أو ترجيح بعضها على بعض. “وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل، فلذلك كان الذي يرجح معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن يجعل غير ذلك المعنى ملغىً. ونحن لا نتابعهم في ذلك، بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيَع الكلام العربي البليغ، معاني في تفسير الآية”[34].
وقد كان الشيخ سعيد النورسي (ت 1379ﻫ) ينتهج منهجاً قريباً من منهج ابن عاشور في تفسير القرآن، وكان يرى أن معاني القرآن عامة وكلية ولا تنحصر ككلام البشر في زمن محدود وطائفة معينة ومعنى جزئي. فهو خطاب إلى جميع البشرية في كل الأعصار، لذا كانت معانيه جامعة لكل شيء وواسعة سعة خارقة. فلا ريب إذاً أن كلمات القرآن ليست محمولة على معان جزئية ومقاصد مخصوصة فقط. “بل نقول: إن جميع ما ذكره كافة علماء التفسير وما استنبطوه من المعاني اللاتي اشتمل عليها الكتاب صراحةً أو إشارةً أو رمزاً أو إيماءً أو تلويحاً أو تلميحاً لمراد ومقصود بالذات من الكتاب الكريم. ولكن شريطة أن لا يمنع عن تلكم المعاني القواعد العربية وأصول علمي النحو والصرف وقوانين الكلام والعقل السليم والمنطق الصحيح”[35].
هذا ولو أن الإمام الشاطبي جعل ذلك الفهم الذي يبنى على معهود المخاطبين وعلومهم ومعارفهم أساس الفهم، لا كلَّ الفهم، وجعل البيان من وجوه يجمعها جامع، لا من وجه واحد، كما فعل الإمام الشافعي، لتخلص من هذا الإشكال، ولسار بذلك على المهيع الملتزم الوسط، وسلك الطريق العدل الذي لا ميل فيه.
خامساً: مراعاة السياق والأغراض السياقية
والمراد بالسياق “كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى”[36]، كما نقل عن الرازي (ت 606ﻫ). فهو القرينة الكبرى التي تجتمع عندها مجموعة القرائن المقالية والمقامية ذات العلاقة بمعنى النص وغرض إفادته[37].
وقد اتفق علماء الأصول والدراية على أن “السياق طريق إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، وتنزيل الكلام على المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه”[38]، كما قال الإمام ابن دقيق العيد (ت 702ﻫ). ويقول الإمام ابن القيم: “السياق يُرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالَّة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: “ذُقْ إنَّك أنت العزيزُ الكريمُ” (الدخان: 49)؛ كيف تجد سياقه يدلّ على أنه الذليل الحقير؟!”[39]. فسياق الكلام “حارس من الفهم المخطئ”[40]، كما عبر ابن عاشور.
وقد اختلف العلماء في أنه إذا عيَّن السياق معنى من المعاني المحتملة أو رجح وجهاً من التفسير على وجوه أخرى محتملة في النص؛ هل يتعيَّن الأخذ به واطراح غيره أو يجوز اعتبار ما لم يرجحه السياق في أصل المعنى بجانب الدلالة المترجحة بالسياق؟
لقد وقف العلماء من هذا الإشكال موقفين، فهناك اتجاه يرى الترجيح حتماً مقضياً وسبيلاً لتفسير النص لا فكاك عنها، واتجاه آخر يرى الجمع بين الاحتمالات أمكنَ في التفسير، وأكثرَ إحاطةً بالنص ومراميه، وأكثر إعمالاً لطاقاته الدلالية. فبناءً على الاتجاه الأول لا بدَّ للمفسر أن يصل إلى فهم واحد هو أرجح من غيره، وذلك حفاظاً على المعنى المحدد للنص، وهو اتجاه عامة المفسرين والأصوليين والبلاغيين. وبناءً على الاتجاه الثاني يستشرف المفسر كل الاحتمالات الدلالية ويحاول أن يجمع بينها وسعه، فإن استطاع الجمع فهو أولى، وإن لم يستطع ذلك فلا أقلَّ من أن ذلك يمهد له السبيل لمطالعة قراءات جديدة في النص أو الاطلاع على آفاق النص الدلالية وسرِّه البياني. ويميل الإمام الزركشي (ت 794ﻫ) إلى الاتجاه الأول عازياً إياه إلى صنيع الزمخشري (ت 538ﻫ) في الكشاف، فيقول: “ليكُن محطّ نظر المفسّر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي، لثبوت التجوز. ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق له الكلام معتَمَداً حتى كأنَّ غيرَه مطروح”[41].
وقد تزعَّم الاتجاه الثاني الإمام الشافعي قديماً، وتبعه في ذلك جماعة من العلماء الأصوليين والبلاغيين، ودعا إليه ابن عاشور حديثاً، ولعلَّ مسألة “الجمع بين الحقيقة والمجاز” و”عموم اللفظ المشترك” من أهم المسائل التي عبرت عن هاتين الوجهتين في الدراسات الأصولية، فالإمام الشافعي -كما اشتهر عنه- يرى جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق واحد، وخالفه الجمهور. فحمل الشافعي الملامسة في آية التيمم على حقيقتها ومجازها، وقال بنقض الوضوء من اللمس باليد كالجماع[42]. كما يرى هو وجماعة من الأصوليين جواز تعميم اللفظ المشترك في سياق واحد، ونسب الشوكاني (ت 1250ﻫ) هذا الرأي إلى الجمهور. ومثاله حمل الشافعي لفظة (إلى) في الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين في آية الوضوء على الاشتراك بين إدخال الغاية في المأمور به وعدم الإدخال[43]. ولا ريب أن رأي الشافعي هذا يتماشى مع ما ذكره في البيان من أنه يجيء من وجوه لا من وجه واحد شريطة أن يجمع بين هذه الوجوه جامع ولا يخرج عن معهود المخاطبين بالنص، ولا شك أنه يجوز أن يكون بين الحقيقة والمجاز وبين معاني المشترك بغير التضاد وجه جامع ويكون ذلك الجامع مستساغاً لو عُرض على معهود العرب المخاطبين بالنص.
ويقول الشيخ ابن عاشور: القرآن لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان جديراً بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ، في أقل ما يمكن من المقدار، بحسب ما تسمح به اللغة. “فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالته من اشتراك وحقيقة ومجاز وصريح وكناية وبديع ووصل ووقف إذا لم تُفضِ إلى خلاف المقصود من السياق، يجب حمل الكلام على جميعها”[44]. ويخلص إلى أن الذي يجب اعتماده هو حمل المشترك على ما يحتمله من المعاني، سواءٌ في ذلك اللفظ المفرد، والتركيب المشترك بين مختلف الاستعمالات، سواءً كانت المعاني حقيقية أو مجازية، محضةً أو مختلفةً، “وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون، أو ترجيح بعضها على بعض… بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيَع الكلام العربي البليغ، معاني في تفسير الآية”[45]. ولكنه ذكر أخيراً أن ذلك “من أساليب القرآن المنفرد بها لتكثر معاني الكلام مع الإيجاز”[46]؛ أي إنه خاصة القرآن وحده وليس ذلك لكلام العرب على وجه العموم.
ويظهر أن كلا الاتجاهين يتفقان على أن النص لا يمكن تفسيره بما يأباه السياق، ولا يُحمل على معنىً ولا تستخرج منه دلالة على حكم إذا كان السياق مستعصياً عليه، أما إذا كان المعنى مما يحتمله السياق أو يشير إليه فإنه يجوز المصير إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه، سواء ورد ذلك المعارض في سياقه أو في دليل آخر، وإنما الخلاف في الجمع بين الاحتمالات الممكنة في النص في سياق واحد من غير ترجيح لمعنى من المعاني، فأجازه بعضهم، وأنكره الآخرون. ويميل بعض الدارسين المعاصرين إلى الترجيح، لأن السياق هو الفاصل بين المعاني، فإذا رجح معنىً من المعاني لزم الأخذ به وطرح غيره وإن كان محتملاً، وهذا يعني أنه يلزم الأخذ بالمعنى الأوفق بالسياق واطراح ما دونه. وممن تبنى هذا الرأي الشيخ يوسف القرضاوي[47] وتمام حسان[48] ومحمد عروي[49].
ويؤيد الشاطبي هذا المنحى ويرى أن أي تفسير بني على توسيع المعاني دون ترجيح معنى من المعاني فهو لا يعتبر به في خلاف الرأي ولا يخرم صحة الإجماع، فيقول: “من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان: أحدهما؛ ما كان من الأقوال خطأً مخالفاً لمقطوع به في الشريعة…والثاني؛ ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك”، وذكر من أمثلة ذلك: “أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات، ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافاً في الترجيح، بل على توسيع المعاني خاصة. فهذا ليس بمستقر خلافاً، إذ الخلاف مبني على التزام كل قائل احتمالاً يعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحتمالات حتى يبني عليه”[50]. ومعلوم أن عدم الاعتبار بالرأي في الخلاف يستلزم، من حيث المنطق، التزام المعنى الأوفق بالسياق والراجح بالدليل وعدم بناء المعنى على طريقة التوسيع في التفسير.
هذه كانت أهم المرتكزات الدلالية التي نوهنا بها في هذه الورقة، وهي في نظرنا المتواضع تعيد كثرة المعاني إلى وحدة بيانية جامعة لا تقضي على التعدد المحمود ولا تسمح بالتعدد المتضاد المتناقض الذي مآله رفع الثقة من فهم النصوص وبيانها ودلالاتها. علنا بذلك قد أعدنا إلى الذاكرة صورة عن المنهجية الشاملة لما ينبغي أن يسير عليه متفهم النص القرآني في فهمه وتفسيره واستنباطه، دون أن يتجمد عند ظاهر النص، ولا أن يجحد دلالات النصوص، ليكون باحثاً عن مراد الشارع بروية واتزان، ودراية وإتقان، دون تكلف في تأويلها، أو تعسف في تقصيدها.
الهوامش
1.الشافعي، محمد بن إدريس، الرِّسالة، شرح وتعليق عبد الفتاح ظافر كبارة (بيروت: دار النفائس، ط: 1، 1419ﻫ/1999م)، ص102.
2.المصدر السابق، ص35-37.
3.نفسه، ص63.
4.الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي، ط: 3، 1388ﻫ/1968م)، ج: 1، ص76.
5.انظر عبد الغفار، السيد أحمد، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة (الأسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د. ط، 1980م)، ص164-165.
6.الشافعي، الرسالة، ص55-57.
7.ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، الإيمان، تصحيح وتعليق محمد خليل هراس (د. م: د. ط، د. ت)، ص91، ص100.
8.الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق إبراهيم رمضان (بيروت: دار المعرفة، ط: 3، 1417ﻫ/1997م)، مج: 2، ج: 3، ص311-314.
9.المصدر السابق، مج: 2، ج: 3، ص313.
10. الشافعي، الرسالة، ص35-37.
11. انظر سعد، محمد توفيق، سبل الاستنباط من الكتاب والسنة – دراسة بيانية ناقدة (د.م: مطبعة الأمانة، د.ط، 1413ﻫ/1992م)، ص25؛ حبلص، محمد يوسف، البحث الدلالي عند الأصولييِّن (بيروت: عالم الكتب، ط: 1، 1411ﻫ/1991م)، ص13-17، نقل بتصرف.
12. انظر العلواني، رقية طه جابر، أثر العرف في فهم النصوص – قضايا المرأة نموذجاً (بيروت: دار الفكر، ط: 1، 1424ﻫ/2003م)، ص270-282.
13. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)، مج: 2، ج: 3، ص372، ومج: 2، ج: 3، ص380.
14. الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الاعتصام، اعتنى بها مكتب تحقيق التراث وأعدَّ فهارسها رياض عبد الله عبد الهادي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: 1، 1417ﻫ/1997م)، ج: 1، ص164-165.
15. الشاطبي، الموافقات، مج: 2، ج: 3، ص83.
16. المصدر السابق، مج: 2، ج: 3، ص381.
17. الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز (القاهرة: دار المنار، ط: 5، 1372ﻫ)، ص43.
18. انظر ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي (د.م: البصائر، ط: 1، 1418ﻫ/1998م)، ص135-136.
19. المصدر السابق، ص135.
20. نفسه.
21. هذا النص من كلام الزركشي. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تعليق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 1422ﻫ/2001 م)، ج: 2، ص167.
22. يقول السيد أحمد عبد الغفار: “تتميز اللغة العربية بأساليبها المتنوعة، ومن هذه الأساليب ما هو واضح المعنى سهل المنال تتساوى فيه الأفهام. ومنها ما يراد به غير ظاهره ويحتاج إلى نظرة وروية، فمع الحاجة تقع الفكرة. وعلى تلك الأساليب يجري النص الديني، فهو يحاكي اللسان العربي بكل ما فيه من فنون القول. وأما موقف المغرضين والمحرفين للنصوص الدينية فيختلف، إذ تصبح كل الأساليب أمامهم في حاجة إلى فهم عميق، ونظر صادق! وهو موقف يختص بهم ولا يختص بأساليب اللغة”. عبد الغفار، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، ص110.
23. ابن القيم، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق عبد الرحمن الوكيل (القاهرة: دار الكتب الحديثة، د.ط: 1418ﻫ/1997 م)، ج: 1، ص242-243.
24. انظر الشافعي، الرسالة، ص260.
25. انظر السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني (حيدرآباد الدكن: إحياء المعارف النعمانية، د.ط، د.ت)، ج: 1، ص193.
26. انظر الشاطبي، الموافقات، مج: 1، ج: 2، ص381-391.
27. للمزيد راجع الزنكي، نجم الدين قادر كريم، نظرية السياق – دراسة أصولية، ص388-390.
28. انظر الشاطبي، الموافقات، مج: 1، ج: 2، ص390-391، تعليقات دراز؛ سعيد، عبد الستار فتح الله، المنهاج القرآني في التشريع (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط: 1، 1395ﻫ/1975 م)، ص720-727؛ سعد، سبل الاستنباط من الكتاب والسنة، ص421 وما بعدها.
29. ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص41-42.
30. انظر الشاطبي، الموافقات، مج: 1، ج: 2، ص381-391.
31. ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص42.
32. المصدر السابق، ج: 1، ص91-92.
33. المصدر السابق، ج: 1، ص92.
34. المصدر السابق، ج: 1، ص97-98.
35. النورسي، بديع الزمان سعيد، إشارات الإعجاز في مظانِّ الإيجاز (د.م: دار المحراب، الطبعة الألمانية، د.ت)، ص259-261، نقل بتصرف من الملاحق.
36. المودن، عبد الله، “السياق: نظرية أصولية فقهية” في (مجلة التجديد، العدد السادس، أغسطس 1999م/ربيع الثاني 1420ﻫ)، ص167، نقلاً عن فخر الدين الرازي، المعالم في أصول الفقه، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض (القاهرة: دار عالم المعرفة، 1414ﻫ/1994م)، ص150.
37. الزنكي، نجم الدين، نظرية السياق، ص53؛ وانظر حسان، تمام، البيان في روائع القرآن – دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني (القاهرة: عالم الكتب، ط: 1، 1413ﻫ/1993م)، ص221؛ عروي، محمد إقبال، “الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين” في (مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد الخامس والثلاثون، رجب 1422ﻫ/أكتوبر 2001م)، ص7.
38. ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تعليق محمد منير عبده آغا الأزهري (بيروت: دار الكتب العلميَّة، ط: 1، 1420ﻫ/2000م)، مج: 2، ج: 4، ص83.
39. ابن القيم، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، بدائع الفوائد (دمشق: دار الفكر، د.ط، د.ت)، مج: 2، ج: 4، ص9.
40. ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص83.
41. الزركشي، البرهان، ج: 1، ص394.
42. انظر الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو (بيروت: دار الفكر المعاصر، ط: 3، 1419ﻫ/1998 م)، ص219؛ الشوكاني، محمَّد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط: 6، 1415ﻫ/1995 م)، ص59؛ سعد، محمود توفيق محمد، إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني (د.م: مطبعة الأمانة، ط: 1، 1412ﻫ/1992 م)، ص73 وما بعدها.
43. انظر الغزالي، المنخول، ص219؛ ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق ودراسة علي محمد معوض وعادل عبد الموجود (بيروت: عالم الكتب، ط: 1، 1419ﻫ/1999 م)، ج: 3، ص135-136؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ص46-48.
44. ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص95.
45. المصدر السابق، ج: 1، ص97-98.
46. المصدر السابق، ج: 1، ص123، نقل بتصرف.
47. انظر القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع القرآن العظيم (د.م: مركز بحوث السنة والسيرة، د.ط، 1997 م)، ص219.
48. انظر حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتب، ط: 3، 1985 م)، ص165.
49. انظر عروي، “الوظيفة الترجيحية للسياق”، ص16.
50. الشاطبي، الموافقات، مج: 2، ج: 4، ص569-573.