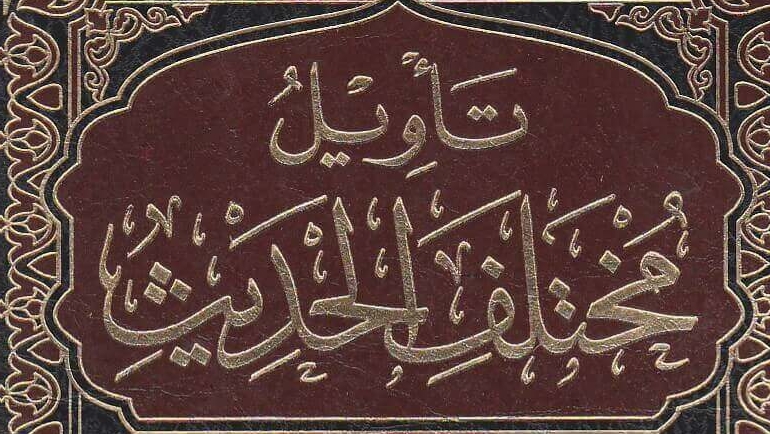لم يقتصر فن ما بعد الحداثة أو الفن المعاصر على خلخلة أساليب التعبير البصري وتقويض المعايير الإستتيقية الأكاديمية فحسب، بل كانت تداعياته أبعد أثرا، إذ مست أيضا مواثيق تلي الأعمال الفنية التي تنتسب إلى أفق الحداثة. فهل استطاع الفن المعاصر أن يؤسس لجماليات ما بعد الحداثة؟ وأن يدشّن بالتالي إستتيقا مغايرة للتلقي الفني؟
أولا: في ماهية الفن المعاصر
لا يفيد توصيف الفن المعاصر أي معنى مرتبط بالعصر، ولا يدل على ما هو عصري أو راهن أو على ما يمتُّ بصلة إلى زماننا المعاصر أو إلى مقام الهنا والآن، إنما يُلمع كما تقول الباحثة السوسيولوجية نتالي هاينيك (N.Heinich) إلى جنس فني مخصوص[1]. فهو ليس توصيفا زمانيا كرونولوجيا، بل هو تجنيس إستتيقي أو “براديغم جمالي يتسم بسمات مخصوصة”[2] بالنظر إلى كل من البراديغمين الكلاسكي والحداثي.
لهذا، فإذا كان الفن الأكاديمي أو الكلاسيكي يقوم على بلاغة التمثيل التشخيصي لمعطيات العالم الفيزيقي، ولا ينفك عن قواعد النسبة والمنظور والتجانس، وإذا كان الفن الحداثي يحتفي بذاتية المبدع، ويخلخل معايير الميثاق الميمي الذي ينهض عليه التشخيص الفني الأكاديمي، فإن الفن المعاصر يذهب أبعد من البراديغمين السالفين، إذ يقع كما تقول هاينيك على “الحدود القصوى للفن كما تم تصوره في “الفن الحديث” أو “الفن الكلاسيكي”[3].
مما يعني أنه لا يكتفي بتقويض معايير الأنموذج الكلاسيكي وكسر بنياته ومواضعاته، إنما يمضي في تجربة إستتيقية قصوى تسوقه إلى خلخلة مفهوم الفن ذاته وليس قواعد إنتاجه وتلقيه حسب. الفن المعاصر أو ما بعد الحداثي ليس مقولة زمنية كرونولوجية، بل هو مقولة تجنيسية ترادف إبدالا جماليا جديداً من أبرز مقوماته الفنية أنه تجربة قصوى، وخرق للحدود والأجناس الفنية. ومن ثمة فالأثر الفني الذي نَسِمُه بوسم المعاصر يقوم تحديدا على “خرق حدود الفن كما يدركها الحس المشترك”[4].
غير أن كل خرق (transgression) في الفن المعاصر لا يعتبر محض هدم لقاعدة أو تدمير لمواضعة أو تقويض لبنية، بل هو بالأولى تجربة حدود، أو تجربة قصوى تمحو الحدود المكرّسة بين الفن واللافن. وعبر تجربته الإستتيقية القصوى يدشن الفن المعاصر، كما يقول ييف ميشو (Y.Michaud)، “نظاما فنيا جديدا تحلّ فيها الإستيتقا محل الفن”[5]، ويتبخر فيه الفن أو يرتد إلى حالة غازية (à l’état gazeux) وتسدُّ فيه الإنشاءات والإنجازات (Performances) والتجارب البصرية الحية محل الأعمال الفنية.
إذا كان الفنان الحداثي يصر في تقويضه لأحداثيات البراديغم الكلاسيكي على منح عمله الفني ملمح الفرادة والجدة والتميز في التركيب والأسلوب والرؤية، وإذا كان هذا الفنان الحداثي ينزع باسم الفرادة الذاتية إلى التوسل باستراتيجية الخرق (transgression)؛ التي تقوم على “رج القواعد وتقويض المعايير، وابتكار أساليب إبداعية غير مطروقة ولا مسبوقة، فيمكن اعتبار خرق حدود الفن في البراديغم المعاصر ضربا من المضاعفة القصوى لفرادة الفنان”[6].
تماما مثلما يمكن اعتبار الفن المعاصر ضربا من المضاعفة القصوى والتكثيف الجذري للمشروع التقويضي الحداثي.
لهذا، فلا حرج أن نعتبر براديغم الفن المعاصر تدشينا لأفق بعدي للحداثة أو تأسيسا لحداثة بعدية أو لما بعد الحداثة. وهذه التجربة الإستتيقية القصوى التي تتجاوز حدود الفن كما تم التواضع عليها في البراديغمين الكلاسيكي والحداثي، والتي ندعوها فنا معاصرا أو ما بعد حداثي، لا تقوض منظومة التقليد، إنما تفكك أيضا “تقليد الجديد” حسب تعبير هارولد روزنبرغ.
في بحثها عن الفرادة أخذت الحداثة الإستتيقية صورة تقويض لأسس الأنموذج الكلاسيكي، إذ عملت على تقويض معايير التمثيل الموضوعي والميمي للأشياء عن طريق الاتجاه الانطباعي (مع كلود موني، وإدوار ماني، وأوغست رينوار، وفانسان فان جوغ)، وقوانين تركيب الألوان واستعمالها الكروماتي مع التيار الوحشي (Fauvisme) ممثلا في هنري ماتيس وموريس دوفلامينك (M.de Vlaminck).
وفي سياق استراتيجية التقويض انصرف البراديغم الإستتيقي الحداثي مع تكعيبية بيكاسو وجورج براك وسالفادور ودالي وخوان غريس إلى تشويه الكتل والأحجام، وتقطيعها وتشظيتها وإعادة تركيبها في بنيات وتشكيلات لا أوقليدية، كما عمل على تفكيك معايير موضوعية تشخيص العالم مع التعبيرية، واتجه إلى التعبير عن الأشياء عوض تصويرها وتمثيلها (مع إدوارد مانك E.Munch و فرانز مارك وشاييم سوتين).
وشكك في قيمة الماضي الحضاري البشري من خلال مستقبلية فيليبو طوماسو مارينيتي، وفي جدية وصرامة الممارسة الإبداعية عبر دادائية بيكابيا، وامتلاء العالم وكثافته تكوثر كائناته من خلال مينمالية الباهاوس (Bauhuas) وفرانك ستيلا، كما تخلّص من واقعيته عبر التوسل بالواقعية المتعالية أو السوريالية عند سالفادور دالي وخوان ميرو..
وعبر استراتيجية الهدم هذه، و”جيلا بعد جيل وضع الفن الحديث الأسس المعيارية للفن موضوع أزمة وعمل على هدمها”[7]. وعبر التجريد الغنائي والبنائي الشعري والهندسي حقق نقلة نوعية وجسورة من إبدال جمالي قائم على التقليد والمحاكاة والماثلة الميمية، إلى إبدال جمالي آخر ميسمه انطلاق الذات في التجريب والمغايرة واستغوار أشد القارات فرادة وجِدّة.
وبالرغم من أن الحداثة البصرية لم تكن تكفّ عن الاحتفاء بذاتية الفنان بما هو كوجيطو إستتيقي مطمحه الفرادة، وظلت كحركة طليعية تتغيا الارتقاء بجماليات التلقي وتشذيب الذوق العام، إلا أن الفن الحداثي ظل دون جرأة الفن المعاصر أو الفن ما بعد الحداثي، ودون تجربته التقويضية القصوى.
فلقد خلع الفن المعاصر عن الفنان هالته الطليعية الرمزية، وخلصه من منزعه السولبسي (الأنا وحدي)، ومحا الحدود الفاصلة ومعايير التفرقة بين عالم الفن وعالم المعيش اليومي المبتذل، وناظر بين المعياري والسوقي، والجميل والقبيح، والأثر وانمحائه.
ولئن كان الوازع الذي يحدو الفن الحداثي هو وضع قطيعة مع الماضي، “فإن الفن الذي فرض نفسه في الثمانينات تحت وسم “الفن المعاصر” قد حاول، على حد قول الفيلسوف الجمالي مارك جيمنيز، أن يحدد ذاته بدون إحالة للماضي[8]، حيث جعل من المبتذل والنافق والسوقي والمتلاشي والعادم والغفلي أسانيد جمالية، ونظر إلى “الشارع”، كما يقول ريستاني بوصفه لوحة”، واعتبار أن كل ما فيه من زوائد أو حتى ما يفضل فيه من نفايات قمين بأن يصبح قابلا للعرض جنباً إلى جنب مع الأعمال الفنية المكرسة في البراديغم الكلاسيكي أو البراديغم الحداثي.
إلا أنه لا يتيسر لنا حد ماهية الفن ما بعد الحداثي أو الفن المعاصر إلا “بوضع بعض المعايير وإقامة بعض المتمايزات التي تفصل المجموع الذي نسمه “بالمعاصر” عن كلية الإنتاجات الفنية”[9].
ثانيا: براديغم الفن المعاصر وسؤالي المعيارية والمشروعية
فما هي المعايير الإستتيقية التي تميز الفن المعاصر، إذا صح أن نتحدث عن معايير وعن خلفية إستتيقية في هذا البراديغم الفني؟ وما هي مواثيق وبروتوكولات تلقيه؟ وكيف يستقيم الحديث عن جماليات تلقي الفن المعاصر، علما بأنه جنس تعبيري بصري يقطع مع مفردات الإستتيقا، من قبيل مفردات الجمال، والتجانس والتناسب والمحاكاة.
يتأطر الفن المعاصر، كبراديغم جديد، ضمن النقلة الجذرية التي استعاضت عن نسق الفنون الجميلة (الذي كان يضم الفنون الأكاديمية كالرسم والتصوير الفني والنحت والعمارة والموسيقى والشعر والمسرح والرقص) بنسق الفنون التشكيلية الذي يشمل، كما يقول جيمنيز، “مجموعا متنافراً من الممارسات الفنية التي تمتد من النقش على الخشب إلى المعالجة البيانية، مروراً بالريدي مايد، والمنجزيات، والهابنينغ والأنستلايشن، والبودي آرت…”[10].
كما يتحدد براديغم الفن المعاصر ضمن المنعطف العميق الذي ارتبط بانمحاء “الحدود بين الفن واللا- فن، أي بين الفن و الواقع اليومي”[11].
ومع اعتماد مصطلح الفنون التشكيلية بدل مفهوم الفنون الجميلة تمت خلخلة التصور الكلاسيكي للفن “ونزعت عنه، كما يقول مارك جيمنز، إيحاءاته المثالية والرومانسية الموروثة من القرنين 18 و19”[12]. ومن غير خلخلة لنسق الفنون الجميلة وتقويض حد الفن[13] (une dé-définition)، حسب تعبير المفكر الجمالي هارولد روزنبرغ (H.Rosenberg)، ما كان بمقدور الفن المعاصر أن يكون له موطئ قم في خرائط التشكيل البصري. ويرجع كثير من الفلاسفة والباحثين الجماليين بداية الأزمة الإستتيقية التي قوضت براديغم الحداثة إلى منجز مارسيل دي شامب الذي ينطوي على إرهاصات جنينية قادت في تطوراتها إلى مراقي الفن المفاهيمي، والميناملية (الإقلالية) والبوب آرت (فن الشعب) والتجهيزات، وفن الحدث”[14].
ولم يستوِ الفن المعاصر كبراديغم قائم الذات إلا انطلاقا من نهاية الحرب العالمية الثانية؛ ولم تلتف عليه المؤسسات الرسمية وبعض القاعات الرسمية ويعمل على تكرسيه إلا انطلاقا من ثمانينات القرن الماضي. إلا أن تلقيه العمومي ظل يطرح كثيرا من الإشكالات لاستغلاقه على المتلقي البسيط من جهة، ولملمحه المبتذل (Sa banalité) ولحمولته الاستفزازية أحايين كثيرة.
وأزمة التلقي الجمالي التي خلقها الفن المعاصر جعلت البعض يرفض الاعتراف به والإقرار بمشروعيته إلى حد أن الناقد الفني دانيي سوتيف (D.Soutif) نشر على صفحات “مجلة الفنون الجميلة” الفرنسية مقالا شديد اللهجة، اجترح له عنوان: “لا وجود للفن المعاصر”؛ وفيه يؤكد بلا مواربة قائلا: “إن الدفاع عن الفن المعاصر أو مهاجمته هما أمران خاليان من كل معنى، ما دام أن ما ينعت “بالفن المعاصر” لا وجود له، أو لا يكاد يوجد إلا في مخيلة بعض من يسعى إلى تأسيس منجزه على الإثارة”[15] وعلى خلخلة مواثيق التلقي المكرسة ذاتها. انصرم على نشر مقال دانييل ما يزيد على العقدين من الزمن (1997)، وفي هذه المدة الطويلة نسبيا لم يزدد الفن المعاصر إلا انتشاراً وذيوعاً لكنه لم يزدد في المقابل إلا استفزازا للحس المشترك، وإثارة للذوق العام وزعزعة للميكروكوسم الفني.
كانت إرساءات الفنان الدادائي مارسيل دوشامب هي الانطلاقة الجنينية لما سيسمى فيما بعد بالفن المعاصر، حيث قدمها في صورة مركب من الخامات المجهزة في الفراغ، مثل مبولته وعجلته الشهيرتين، وأعقبتهما أعمال مبتذلة طرحت سجالا كبيراً حول قيمتها الجمالية.
انخرط في السجال الجمالي حول مشروعية الفن المعاصر وجماليات تلقيه استتيقيون وسوسيولوجيون وفلاسفة ونقاد ومؤرخو أفكار مثل ييف ميشو، وجان لوك شاليمو، وجان بودريار، ومارك فيمارولي، ولوك فيزي، ونتالي هاينيك، وفرانسوليوطار، وكاترين مييه (C.Millet) وغيرهم. واشتد السجال على صفحات جرائد يومية، مثل (le Monde وl’Express وles Beaux Arts وArt Press) ومجلات فكرية كـ(Esprit وle Débat) ومجلة (la revue des deux mondes).
فتضاربت المواقف في توصيف الأعمال والإنجازات التي تنسب نفسها لبراديغم الفن المعاصر، أو تحسب منجزها عليه؛ فمن قائل بأن الفن المعاصر هو فن الرداءة وقائل أنه يشمل فنانين بدون فن وأنه “لا قيمة له (nul) رسمي ملفق شائه (truqué)، ويمثل شهادة على تاريخ متهالك ومنهك”[16]. ومن معترض قائل بأنه فن تجريبي جريء، ومغاير، يعبر عن أزمة شاملة على صعيد التراتبيات القيمية والأنساق الأكسيولوجية، ومن قائل، أخيرا، بأنه عنوان عريض على نهاية يوطوبيا الفن”[17].
وبقدر ما يعبر عن تشظ في النسف الاجتماعي بقدر ما يعبر، كما يقول ييف ميشو، “عن تعددية تخص العصر، تعددية مستدامة ولا يمكن إغضاء النظر عنها بأي حال من الأحوال[18]. وخصيصة الفن المعاصر الإشكالية هو أنه بلا ذاكرة، ولا سند مرجعي، ولا أفق انتظار؛ إنه سليل الآن، يتخلق للتوّ وقد يموت للتو، وحجته تكمن في عنصري الإثارة والاستفزاز، وفرادته تتبدى ليس في خروجه عن مواضعات المجتمع فحسب، بل أيضاً في خرقه لتعاقدات ومواثيق الفن، ومرجعياته الإستتيقية الحداثية بدءا بكانط وانتهاء بحلقة فرانكفورت.
يقول جان مولينو في مقالة نشرها بمجلة Esprit: “الفن اليوم، هو أن نقوم بأي شيء”، فكل شخص يمكنه أن يصور أو ينجز عملا تشكيليا، لكن لا أحد بمقدوره أن يكوّن حكما جماليا”[19]. تنبأ مولينو سنة 1991 قائلا “إننا سنجد أنفسنا في المستقبل وقد استغقرتنا وابتلعتنا أو سحقتنا أعمال تنتمي لفن لا صلة له بالجمال، ولا أحد بمستطاعه أن يرسم حدوده”[20].
وبعد مرور أكثر من ربع قرن من نبوءة مولينو ها نحن نجد أنفسنا بالفعل محاطين عربيا وكونيا بمنجز بصري لا نستطيع أن ندرجه ضمن الإستتيقا التي عدّها هيجل “ملكة للجمال”، وليس بمقدورنا أن نعتبره نتاجا للعبقرية، إذا كنا نعتبر مع كانط أن العبقرية هي توليد للمعايير على جهة السلب أو موهبة طبيعية وملكة نظرية تمنح الفن قواعده، ولا يمكن أن نعتبره حدثا أنطولوجيا (Ereignis) مع هايدغر.
ولا يمكن أخيرا أن نتلقاه إستتيقيا ونحكم عليه بالمعنى الكانطي للحكم الجمالي، أي نعده حكما ذوقيا غفلاً من كل ملمح نفعي، مجرداً عن كل غاية، حكما لا يصف موضوعه ولا يسوّغ ولا يبرر إعجابه تجاه موضوعه، أو يحدد مقوماته المعرفية وخصائصه المفهومية لأنه ليس غير تعبير عن إحساس ذاتي مستقل.
إن ما نتلقاه اليوم من أعمال تنتسب إلى براديغم الفن المعاصر يخيب أفق الانتظار الكانطي هذا. فهل يمكن أن نستخلص من ذلك أنها أعمال تشذ عن كل أفق إستيقي حداثي، وأنها تقطع مع جماليات التلقي في الإستتيقا الكانطية، أم أنها تعبر كما قال جان بودريار عن “مؤامرة فنية”[21] ليس إلا؟.. وفي حضرة تلك المؤامرة “لا نجد أي حكم نقدي ممكن، إنما نجد تشاركا وتقاسما للرداءة بالتراضي، وبالدعوى المتبادلة للمآدب والولائم”[22]؟
إن التلقي أو التلقي الفني كما يقول باسرون هو بحسب التعريف فعل إدراك وعملية تأويل”[23]، في حين أن ما يقدمه الفن المعاصر يضعنا إزاء ما تسميه نتالي هاينيك “بالحياد الأكسيولوجي” إن لم يكن إزاء ضرب من استقالة الوعي الجمالي. فتلقي العمل في الفن المعاصر إذ يقوض ثنائية الذات/الموضوع، فإنه يقتضي من المتلقي التعامل مع الفن المعاصر، كبراديغم مغاير، حيث يتحلل الفن من أساسه الصلب الماهوي/الجوهراني، ليرتد إلى الحالة الغازية (E.Gazeux) حسب تعبير ميشو، وليغدو محايثا لكل ممارسة بصرية تبحث عن الجمالية في التقويض والمفارقة والإثارة، وإعادة تشكيل الأحجام والكتل والألوان خارج حدود الفن كما تصورته الإستتيقا.
يقول هارولد روزنبرغ “لقد شبّ الفنان عن طوق الفن وغدا أكبر منه” لهذا فهو يلتمس الجمال خارج حدوده الضيقة خارج اللوحة والمنحوتة؛ فيستثمر الفراغ عبر التجهيز أو الإرساء أي تجهيز حيز من الفضاء لتوقيعه بفرادة شخصية مثيرة، ومحلحلة للذوق العام، كما يستثمر الجسد عبر جعله موضوع مفهمة أو تصور مفهومي يثير دهشة المتلقي وتقززه أحيانا بصورة تجعله بمثابة لوحة متحركة حية وحمالة دلالات. ويستثمر مخلفات التقنية وزوائدها ومتلاشياتها ليعيد منحها ملمحا فنيا.
الهوامش
[1]. Nathalie Heinich, le paradigme de l’art contemporain, Structures d’une révolution artistique, éd Gallimard, 2014, p 21.
[2]. Ibidem.
[3]. Nathalie Heinich, Pour ou contre l’Art contemporain, Propos recueillis par Meryem Sebti, revue dptyk, 23 avril, 2014.
[4]. Nathalie Heinich, le Triple jeu de l’art contemporain : Paris, éd Minuit, 1998, p 55.
[5].Yves Michaud, l’art à l’état gazeux, Essai sur le triomphe de l’esthétique, stock, 2003, p 169.
[6]. Nathalie Heinich, le Triple jeu, opcit, p 123.
[7]. opcit, p 19.
[8]. Mrac Jimenez, la querelle de l’art contemporain, éd, Gallimard, 2005, p 71.
[9]. Anne canquelin, l’Art contemporain, PUF, 1996, p 5.
[10]. Maroc Jimenez, la querelle de l’art contemporain, opcit, p 21.
[11].op.cit, p 20.
[12]. opcit, p 22.
[13]. Harold Rosenberg, la dé-définition de l’art, tr.fr, Nîmes, J. Chambon, 1972.
[14]. Anne Canquelin, l’Art contemporain, opcit, p 75.
[15]. Daniel Soutif, « l’art contemporain n’existe pas », Beaux Arts Magazine, n°155, avril 1997.
[16]. Y. Michaud, la crise de l’art contemporain, opcit, p 17-18.
[17]. Ibid, cf le chapitre VI, « la fin de l’utopie de l’art », p 213-252.
[18]. Y. Michaud, Critères esthétiques et jugement de gout, Nîmes, J. Chambon, 1999, p 12.
[19]. Jean Molino, « l’art aujourd’hui » ,Esprit, ,°173, juillet-août, 1991, p 72.
[20]. Opcit, p 73.
[21] .J. Baudrillard, « le complot de l’art », Libération, lundi 20 mai 1996.
[22]. Ibid.
[23]. J.C.Passeron, E.Pedler, le temps donné aux Tableaux, Marseille, Cercon/Imérec, 1991, pIX.