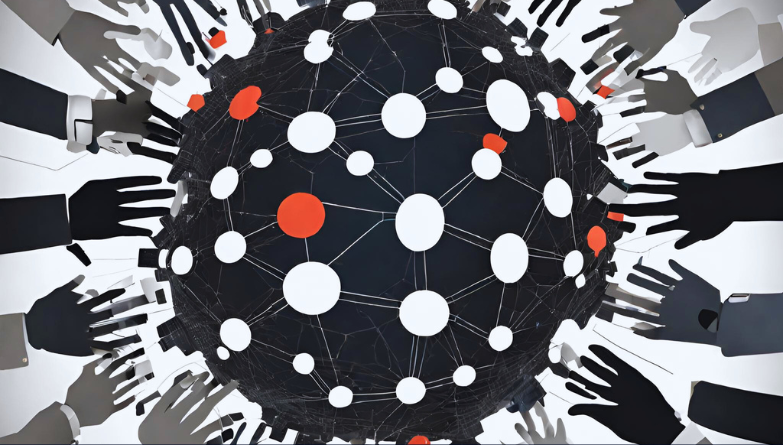ما هي الدراسات الإسلامية ولمن السلطة العلمية أو التأويلية فيها؟ طُرح هذا السؤال كثيراً في العقود الأربعة الماضية، وهو ما يزال مطروحاً بقوة وسيبقى كذلك لسنواتٍ قادمة. فقد بلغ من هول التحديات التي تُواجهُ العرب والإسلام (السني) في المحيط القريب والبعيد، أنها صارت تحدياتٍ للدين الإسلامي ذاته. لكنها قبل أن تصبح كذلك بفعل انفجار الإحيائيات السنية والشيعية في السبعينات من القرن الماضي؛ كان انقلابٌ جذريٌّ يحدث من جانب “المراجعين الجدد” على الأكاديميات التقليدية والمحدَّثة للإسلام والإسلاميات في المجال الغربي. إنما قبل الوصول للحديث في ذلك، دعوني أُقدّم بإيجاز لإشكاليات المجال والمرجعية في عالم الإسلام الكلاسيكي، وبإيجازٍ آخَر لنشوء علم الإسلام وتطوراته في المجال الأوروبي والغربي.
أولا: علوم الإسلام ومفهوم العقل
يعتبر جورج مقدسي أنّ علوم الإسلام في العصر الوسيط قامت على تقليدين متمايزين، تقليد الإنسانويات، وتقليد الإسكولائيات[1]. وهو يقصد بالإنسانويات تلك القاعدة العريضة والمشتركة من علوم اللغة واللسان والمنطق المعروفة عند الإغريق، والتي التقت من خلال الترجمات في القرنين الثاني والثالث للهجرة، مع علوم اللغة والنحو الناشئة بالعربية في تلك الفترة. وكما صارت إنسانويات المنطق والبلاغة أساساً لعلوم العقل التي ظﻫرت ترسيمتها الأُولى بالعربية لدى الكندي (-252ﻫ)، والفارابي (-339ﻫ) باعتبارها تطوراً عن الـ[2](Paideia)؛ فإنها ظهرت في عالم الإسلام باعتبارها قاعدةً لعلوم الشرع، كما تبلورت لدى الخليل بن أحمد(-150ﻫ) في كتاب العين، ولدى الشافعي (-204ﻫ) في الرسالة.
وعندما نتحدث عن السكولائية في سياق علوم العقل، فالمقصود بها البرنامج الدراسي المكوَّن من الخطابة والمنطق والشعر والموسيقى والهندسة والفلك والرياضيات وعلم العدد والعلم الطبيعي وما وراء الطبيعة، والحكمة العملية المكوَّنة من العلم المدني أو الأخلاقيات والسياسيات. أما علوم الشرع؛ فإنّ برنامجها الدراسي جرى تقسيمه إلى علوم وسائل وهي اللغويات واللسانيات وعلوم البلاغة والمقترنة بحفظ القرآن، لتصبح علومُ المقاصد هي التفسير والحديث والفقه وأصوله والكلام. ثم هناك العلوم المُساعدة والتي تباينت بشأنها الآراء مثل المنطق والسيرة والتاريخ إلى آخِر المتفرعات عن علوم الوسائل والمقاصد. إنّ علومَ الشرع بحسب هذه الترسيمة التي تبدو في القرن الرابع الهجري في الفهرست لابن النديم بمقالاته العشر، هي التي حملت في العصور الكلاسيكية عنوان: علوم الإسلام[3].
مقدسي إذن وبخلاف روزنتال[4] يقيم قاعدةً مشتركةً لعلوم العقل وعلوم الشرع في اللغويات واللسانيات وفنون الفيلولوجيا، بينما يرى روزنتال أنّ القواعد المشتركة بين علوم العقل وعلوم النقل تقتصر على الآداب أو التقنيات المشتركة والتي تهب الموضوعات المختلفة صبغتها العلمية. والذي يبدو لي أن مسلمي العصور الوسيطة وسواء أكانوا علماء شرع أوأهل فلسفة، إنما اعتبروا القاعدة المشتركة هي النظر العقلي. وقد اختلفوا منهجياً على مفهوم العقل، وطرائق تدبيريته أو الإفادة منه. والدليل على ذلك رسائل الكندي المتعددة في العقل، ورسالة معاصره المحاسبي (-243ﻫ) المسمَّاة: “مائية العقل وحقيقة معناه”. ففي حين قال الكندي ومن بعده الفارابي إنّ العقل جوهرٌ فردٌ مُدركٌ للأشياءُ بحقائقها ويتفاوت فيه الناس؛ فإنّ المحاسبي اعتبر العقل غريزةً أو نوراً يتساوى فيه جميع الناس، وإنما يتمايزون بالتجربة والعلم والحلم والاكتساب. فالـ (Curriculum) الإسكولائي لدى الإغريق وفلاسفة الإسلام يصطنعه ذوو الحكمة المعطاة من أعلى، بينما تصبح التربية والتعليم في علوم الشرع تثقيفاً وتجربةً وعقلاً مكتسَبا[5].
من الفيلولوجيا إلى التاريخ الثقافي وعلم الإسلام
تأسَّس الاستشراق الذي صار يدعي لنفسه سِمة العلمية على الفيلولوجيا والتاريخ مثل سائر العلوم الإنسانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وبلغ ذروته خلال القرن التاسع عشر مع ظهور أعلامه الكبار في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا. والأعلام الكبار هؤلاء هم الذين فصلوه بالتدريج عن بحوث الصين والهند والشرق الأقصى، ثم ناضلوا ليفصلوه عن علوم نقد العهدين القديم والجديد، وقد نشأ فيما يتعلق بالعربية والإسلام في ظلّهما[6].
لقد لاحظ جورج مقدسي هنا أيضاً أنّه كانت هناك مفارقة بين النهوض الأوروبي والآخر الإسلامي. ففي حين ظهرت الإنسانويات في عالم الإسلام الوسيط قبل البرنامج السكولائي والتعليمي؛ فإنّ السكولائية في عالم الجامعات الأوروبية ظهرت قبل إنسانويات النهضة في القرن السادس عشر وما بعد[7]. وقد كانت لذلك نتائج كبرى على دراسات الاستشراق بعامة والإسلام بخاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
إذ رغم العمل ظاهراً على الفيلولوجيا والتاريخ؛ فإنّ فكرتين رئيسيتين استبطنتا هذا التخصص المتبلور؛ فكرة انحطاط الروح التعليمي والحضاري في الإسلام، وفكرة إخضاع دراسة الإسلام لمقاييس تأمل العهدين باعتبار القرآن والإسلام مشتقَّين منهما من جهة، وربط إمكانيات النهوض بدراسات الإسلام بالتقاليد الكلاسيكية التي نهضت أوروبا الإنسانوية على أساسٍ منها[8].
ولذلك كثرت المؤلفات في أصول القرآن والإسلام، وهل هما يهوديان أو مسيحيان، ومن جهةٍ أُخرى تعليل الانحطاط الثقافي في عالم الإسلام بالتخلي عن التقاليد الثقافية والفلسفية الإغريقية والهيللينية، وسيطرة الجمود بسبب استيلاء أهل السنة في الدين والثقافة، وخنق الفلسفة وتيارات التحرر التي تنتمي بالانتساب أو بالتأثر إلى الثقافات الكلاسيكية. ولذا فإلى جانب نشر مخطوطات الفيلولوجيا والتاريخ، كان هناك انصرافٌ لنشر المؤلفات الفلسفية، بعد أن كان الميراث العلمي العربي قد نُشِرت كثرةٌ من دثائره مترجمةً إلى اللاتينية في القرون السابقة[9].
وعلى هذا فقد ساد في دراسة الإسلام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين ميلان متناقضان: ميلٌ إلى إبراز شدة التشابُه بين الماضيين الأوروبي والإسلامي، وميلٌ إلى إبراز شدة الاختلاف. وفي كلتا الحالتين فقد ظلَّ المحكُّ هو مصائر التقاليد الكلاسيكية في ثقافة المسلمين وحضارتهم. وقد لاحظ “جوزف فان أس” أنه فيما بين “فلهاوزن” و”كارل هاينرش بيكر” ظهر اتجاه التاريخ الثقافي أو المجال الثقافي الإسلامي، وصولاً للمطالبة بإنشاء علم الإسلام باعتباره جزءًا من الحضارة الكلاسيكية، التي ينبغي العملُ على إحياء تقاليدها، كما نهض الأوروبيون من خلال المواريث الإغريقية[10].
وكان ذلك أقصى ما استطاعت التاريخانية بلوغَهُ أو التفكير فيه خلال القرن العشرين، والمَثَلُ على ذلك كتاب آدم متز: “رينسانس الإسلام”، عام 1922؛ والذي رغم مثاله النهضوي الأوروبي، صار نموذجاً للدراسات الإسلامية الجديدة، وهو التعبير الذي كثُر استعماله في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين وحتى أواخر الخمسينات.
ثانيا: ثقافة الأصالة وثقافة القطيعة والمراجعون الجدد
فيما بين مطالع القرن العشرين والستينات منه سادت أُطروحة التاريخ الثقافي باعتبارها رافعةً في النهوض العربي والإسلامي. وكثرت مشروعات المعاجم ودوائر المعارف، والمجامع اللغوية. وفي الجامعة المصرية الأهلية الجديدة ثم الرسمية توارد المحاضرون من المستشرقين الألمان والطليان والإنجليز والفرنسيين للكلام في الفلك والترجمات وتاريخ العلوم العربية المستندة إلى الكلاسيكيات، والآداب وفقه اللغة. واتفق أحمد أمين وطه حسين وعبد الحميد العبّادي على الكتابة في التاريخ الفكري والتاريخ السياسي والتاريخ الأدبي لأزمنة الإسلام الكلاسيكية[11].
ومع هذا الاستمداد أو في امتزاج معه ظهرت أُطروحة الثقافة الوطنية أو القومية التي ما لبثت أن أطلّت على فكرة الثقافة الإسلامية. وكما كان في الوطنيات أصيلٌ ودخيل، فكذلك في الإسلاميات. في الجامعة المصرية، كان الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر فيما بعد (1945-1947) يدرّس مادة الفلسفة الإسلامية، وكان إلى جانبه “ماكس ما يرهوف” و”باول كراوس” اللذان كانا يعملان مثل أجيالٍ من قبل على نقل العرب للتراث العلمي والفلسفي في الأزمنة الكلاسيكية. والشيخ عبد الرازق كتب أيضاً عن الفارابي. لكنه وبخلاف السابقين، ودون أن يخرج على السقف الفلسفي المصطلحي، ذهب في كتابه: “تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية” الصادر عام 1943 إلى أنّ أولويات الأصالة في الثقافة الإسلامية تشير إلى علماء أصول الفقه ثم علماء الكلام ثم التصوف وأخيراً فلاسفة الإسلام المعروفين مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد[12].
في التاريخ الفكري للإسلام اعتبر أحمد أمين في” ضحى الإسلام” المعتزلة هم فلاسفة الإسلام وأحراره الحقيقيون، أما زميله الشيخ عبد الرازق فقد اعتبر علم أصول الفقه هو الأكثر أصالةً، ويأتي المتكلمون والمتصوفة بعد ذلك. فإذا كان كثيرون ما يزالون يبحثون عن العناصر الهيللينية والهندية والبوذية في الكلام والتصوف؛ فإنه لا أحد يُنكر على علماء الأصول عبقريتهم الإبداعية وبحثهم العميق في القواعد الفكرية والمنطقية للاستنباط. وهذا فضلاً عن امتلاكهم أو امتلاك كثيرين منهم دعوى معرفة التراثين الكلاسيكي والإسلامي.
فتحت فكرة التاريخ الثقافي المجال واسعاً للمبادرات وتداخُل التخصصات باعتبار الثقافة عالماً شاسعاً ومفتوحاً على احتمالاتٍ بالغة الروعة. لكنها ما ألْغت فكرتين أُخريين مشكلتين: الإبداع والأصالة. فالإبداع لدى المستشرقين ظلَّ كلاسيكياً في مقولاته وإنجازاته الكبرى من إغريقية وهيللينية، بينما انصبَّ جهد العرب والمسلمين في زمن مصارعة الاستعمار والتغريب على استكشاف الأصالة التي صارت حصراً للذات وقولاً بالإبداع الذاتي، ونفياً للغريب والوارد قديماً وحديثاً. ثم ما لبثت أن التقت مع الإحيائيات الصاعدة التي اعتنقت التطهر والتطهير فانشعبت إلى ثلاث شُعَب: شعبة العودة إلى الكتاب والسنة لاستكشاف ما هو الإسلام، وشعبة نقد التغريب في الأزمنة الحديثة والمتسلل إلى المجتمعات والدول من خلال الاستشراق والاستعمار والغزو الثقافي، وشعبة المطالبة بتطبيق شريعة الإسلام المطهَّرة والمصفَّاة[13].
وارتبطت دعوات الأصالة تدريجياً بأمرين آخرين: العقْدنة؛ إذ صارت إداناتُ الغرب أموراً عقائدية، والأمور العقائدية الأكبر والأهم أُطروحة تطبيق الشريعة، وهي التي جعلت الاجتهاد الفقهي الحر والذي كان قد بدأ بالانتعاش، مسألةً اعتقاديةً في الحِلّ والحرمة والشرعنة. وإذا كانت ثقافة القطيعة هذه مع الغرب ومع التاريخ القريب قد تغلغلت في أوساط المتدينين المهمَّشين والمتعبين والمقبلين على الإحيائيات الدينية؛ فإنها صارت شاملةً للمتدينين وغيرهم عندما دخل فيها الكُتّاب اليساريون والقوميون[14].
وقد كان دخولهم ذا شعبتين أيضاً الحملة على الموروث الديني، والحملة على الغرب الرأسمالي والاستعماري. وإذا كانت ثقافة العقدنة لدى الإسلاميين قد أعلنت عن نفسها من خلال كتب محمد الغزالي وسيد سابق وسيد قطب والقرضاوي؛ فإنّ القطيعة اليسارية و”القومجية” مع الموروث أعلنت عن نفسها في كتب الجابري وأركون وأدونيس وآخرين كثيرين. وقد ظهر ذلك في مؤتمر الكويت عام 1974 عن التراث وضرورات القطيعة معه. وبالطبع فإنهم يقصدون بالتراث والموروث الإسلام كلَّه؛ باعتبار أنهما عائقان مانعان لدخول المسلمين في الحداثة.
وإذا كانت نهضويات التاريخ الثقافي في المجال العربي قد قضت عليها تيارات الأصالة والقطيعة من اليمين واليسار في الحرب الباردة؛ فإنّ الدراسات الإسلامية التي شهدت ولادةً جديدةً من خلال مقولة التاريخ الثقافي في الغرب؛ ظهرت هشاشتها في مناسبتين: مناسبة صدور كتاب إدوارد سعيد: الاستشراق عام 1977، ومناسبة صدور كتابي وانسبورو: دراسات قرآنية، وكرون ومايكل كوك: الهاجرية (Hagarism)؛ فالتاريخ الثقافي الاستشراقي يمثّل في نظر إدوارد سعيد بقايا خطاب استعماري ينبغي أن يزول. أمّا وانسبورو فيعتبر أنّ القرآن ظهر في القرن الثالث الهجري مجموعاً من شذرات، ولذا لابد من إعادة قراءة أصول الإسلام مرةً أخرى بعيون جديدة تماماً. في حين تذهب “باتريشيا كرون” وزميلها إلى أنّ الأخبار عن التاريخ الإسلامي الأول في زمن النبي ونبوته وزمن الصحابة كلها مكتوبة بعد القرن الثالث الهجري للتغطية على الأصول اليهودية للإسلام. ولذلك إذا أردنا أن نعرف شيئاً عن الإسلام الأول، فيكون علينا أن نأخذه من المصادر السريانية والعبرية والبيزنطية المعاصرة لحدث ظهور الإسلام. وما أن جاءت التسعينات من القرن الماضي، حتى كان تيار “المراجعين الجدد” هؤلاء قد سيطر على مراكز نافذة في الجامعات والمعاهد والكراسي والمجلات العلمية.
لقد انتهى اتجاه التاريخ الثقافي في الدراسات الإسلامية في الشرق ثم في الغرب. انتهى في الشرق على أيدي دُعاة الأصالة والقطيعة، وفي الغرب على أيدي نقاد خطاب الاستشراق والاستعمار والمراجعين الجدد[15].
أمّا في المشرق فإن الإسلاميات صارت بحوثاً في الدين والدولة وتطبيق الشريعة مع بعض متعلقات الهوية. وهي لدى اليساريين والليبراليين تحولت إلى إدانةٍ للموروث، واعتبار آنّ الإحيائيات خرجت من رحمه، ولابد للتخلص منها أن نتخلَّص منه. وأمّا في الغرب فقد انقسمت إلى قسمين: القسم الذي يتولاه “المراجعون الجدد” وقد عاد لليهوديات والعنفيات في أصل الإسلام. والقسم الذي يتولاه السوسيولوجيون والأنثروبولوجيون ولذلك صار كلٌّ من غلنر وغيرتز وجيلسنان أعلاماً ومرجعياتٍ في فهم الإسلام لدى الغربيين، بالإضافة إلى المستشرقين الجدد الذين يعملون خبراء أمنيين لدى إدارات الدول في مكافحة الإرهاب! أما تقليديو التاريخ الثقافي فقد صاروا معدودين على أصابع اليدين من مثل مؤلفات هودجسون ومونتغومري وات وفان أس ومادلونغ وجيماريه. وأعمال هؤلاء الكبار الكبيرة سائرة إلى انقضاءٍ بسبب التقدم في السن أو الوفاة، لكن أيضاً بسبب انقضاء الاهتمام.
ثالثا: هل المشهد مُقْبضٌ إلى هذا الحدّ؟
إذا أردنا أن نعرف مدى السوء والضرر الذي نزل بعلم الإسلام أو تخصص الدراسات الإسلامية، فلننظر في كتاب الأستاذ وائل حلاّق الصادر عام 2013 بعنوان: “الدولة المستحيلة”. الأستاذ حلاّق إلى جانب موتسكي الألماني هما الأكثر معرفةً بالتاريخ الفقهي الكلاسيكي. ولحلاّق أعمالٌ جليلةٌ في تاريخ الفقه والأصول. لكنه في كتابه السالف الذكر يضع المسلمين والإسلام وبحجة الاحترام الكبير الذي يملكه لهما في موقفٍ مستحيلٍ بل في موقفين أو بين مستحيلين. فالانضمام إلى الدولة الحديثة أو الدخول فيها بالموروث المحدَّث والساعي للتلاؤم مستحيل. لأنّ الدولة الغربية الحديثة تعتمد مطلقات غير أخلاقية، وتفترض التهميش والإلغاء. ولا يستطيع المسلمون بموروثهم الفقهي والأخلاقي الهائل الدخول فيها بشروطها. بيد أنّ هذا الموروث لا يبلغ من تلاؤمه أن يتمكن من الدخول في الزمان رغم كل الجهد المبذول. ولذلك فإنّ المسلمين لا يستطيعون البقاء حيث هم، محتفظين بإسلامهم وإنسانيتهم، كما أنهم لا يستطيعون الانضمام لزمان الغرب بأي شروط!
لقد عملتُ على قضايا التفكير بالدولة في المجال الإسلامي طوال أكثر من ثلاثين عاماً. ومعرفتي بالفقه وأُصوله، وبعلم الكلام أو علم أصول الدين لا بأس بها. وما توصلْتُ إلى النتائج التي توصل إليها الأستاذ حلاّق. لكنني هنا معنيٌّ بالدرجة الأُولى بإمكان افتكاك الدراسات الإسلامية أو علم الإسلام من الإرغامين: إرغام الإسلاموفوبيا الذي يسود منذ ثلاثة عقود دراسات الإسلام في الغرب وبعض الشرق. وإرغام أو إرغامات اعتبار الدين أو الشريعة مقولات ذات صبغة عقدية تستدعي التطبيق.
لقد ظهرت الدراسات الإسلامية في الغرب وفي ثلاثة بلدانٍ رئيسية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ورغم كل المتغيرات التي حصلت وتحصل، فلا غنى عن الشراكة مع الغربيين في اتجاهاتٍ وتوجهاتٍ جديدة. وذلك لأنّ الغربيين أقاموا، كما في سائر مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤسَّساتٍ ومعاهد بحثية ومجلات علمية ومؤتمرات ومنتديات للتشاور والإنتاج المتبادل والمتداخل[16]. لكننا في حالتنا الحاضرة، وفي حالتهم الحاضرة؛ (أعني الموجات العاتية للإسلاموفوبيا) يُصبح الحديث عن الشراكة المجدية صعباً ويستدعي التأمل والمراجعة. ولذلك فلنبدأ من مجالنا الخاص. نحن محتاجون من أجل تجديد العمل في الدراسات الإسلامية إلى التأهُّل، التأهُل لاستعادة السكينة في الدين، والتخلص من الإسلامين السياسي والجهادي. وهذا شرطٌ تاريخي لأنه يتناولُ العمل مع الجمهور وعليه، وفي الوقت نفسِه العمل مع الدولة وعليها. وهذا العمل الذي ينبغي أن نقوم به نحن العلماء، ويقوم به المثقفون والإعلاميون شديد التعقيد. وذلك لأنه يشمل أمرين متوازيين ومتداخلين: الخروج من اعتبار الإسلام مذهباً أو حزباً سياسياً يعمل على إحقاق الدين بواسطة الدولة أو بقوتها وإرغامها، والخروج من الخوف من الدولة والخوف عليها. وقد سمَّيتُ هذا التمهيد أو الشرط تاريخياً، لأننا لم نقم به من قبل لا في الدين ولا في الدولة.
إنّ العملَ الآخَرَ أو الشرط الآخَر طرائقي وتنظيمي وهو يأتي متزامناً مع الشرط التاريخي. وذلك لأنه يشمل في منحاه الأول العمل على تحويلات المفاهيم التي أحدثتْها الإحيائيات وأحدثها الإستراتيجيون الغربيون عن الإسلام وعن المسلمين. لا يحبُّ المتدينون تعبير الإصلاح الديني لشبهه بالإصلاح البروتسانتي. ولذلك قلت إنّ علينا استعادة السكينة في الدين، بحيث لا يدخُلُ ضمن مشروعه أو أولوياته إقامة الدولة الدينية. وفي الوقت نفسِه علينا أن نعمل على تصحيح التجربة السياسية للدولة الوطنية بحيث تأمن من التغول عليها باسم الدين، ويأمن الناسُ فيها. شيخ الأزهر في إعلان الأزهر[17]، اعتبر الدولة المدنية، أو دولة المواطنة من إنشاء النبي، صلى الله عليه وسلم، في تجربته السياسية بالمدينة المنوَّرة. وهذا كله يتضمن أعمالاً فكريةً واجتهاديةً كبرى لإخراج فقه العيش وفقه الدولة والدين من العقدنة الصاعقة في أذهان الجمهور وأذهان وتصرفات الحزبيات الدينية المسيَّسة.
أما العمل الطرائقي الآخَر فهو العملُ العلمي الفردي، والآخَر المؤسسي. لقد عملتُ أستاذاً للدراسات الإسلامية على مدى خمسةٍ وثلاثين عاماً، ودرّست وكتبْتُ في عشرات الموضوعات، لكنني، من وجهة نظري، لم أبرعْ وأُنتج إنتاجاً فيه بعض الجِدّة إلاّ في مجال التفكير بالدولة أو التفكير السياسي في المجال الإسلامي القديم أو الكلاسيكي. ولذلك فالذي أراه وبعد التوسع في علوم الوسائل ومنها اللغات، علينا العودة للالتزام بالتخصص الدقيق في ستة تخصصات: القرآن وعلومه، وعلوم السنة والحديث، والفقه وأًصوله، وعلم الكلام، والتاريخ الإسلامي، وتاريخ العلوم الإسلامية. وتعلمون أنّ لكلٍّ من هذه العلوم فروعاً وتشقيقات يمكن أن يعمل عليها الشبان الجدد إلى جانب أساتذة الكراسي. وفي قسمٍ أو معهد يمكن أن تكون هناك وظائف للاستشراق أو الدراسات الإسلامية الحديثة أو دراسات للحالات.
إنّ الذي أقصده من هذا الكلام تجربة المعاهد البحثية العليا. والمجال هنا ليس للحديث عن الجامعات الدينية التي يمكن أن تكون فيها كليات، يكون المقصود منها التعليم الديني وتنشئة الأئمة والمدرسين في المعاهد والإعداد لوظائف ومهمات محددة. لكنْ حتى في تلك الجامعات، أنا أرى أن تكونَ هناك معاهد بحثية عليا للماجتسير والدكتوراه وممارسة البحث العلمي. وهي خاصةٌ بالمتميزين الممنوحين. ولستُ أقول جديداً بالطبع. فهذا النوعُ من التنظيم هو السائد في الولايات المتحدة، وبعض الجامعات الأوروبية. لقد عانيتُ من الاضطرار لتدريس كل شيء، ومن تعليم الطلاب مختلف المواد في السنوات الجامعية الأُولى. كما أنني أدرتُ كلياتٍ للدراسات الإسلامية أو للشريعة ومعاهد عليا. وما شهدتُ نجاحاً كبيراً في الكليات، وشهدتُ بعض النجاح في المعاهد، لأنني خرّجتُ بالفعل بعض الشبان المتميزين.
إنني أتصور جذعاً، إذن، من ستة تخصصات في معهدٍ عالٍ فيه ست كراسٍ، ووظائف في موضوعات فرعية ليست كثيرة. وبعكس الكليات، يكون الهمُّ ليس التدريس والتنشئة فقط رغم وجودهما؛ بل البحث العلمي والتدريب. وهذه الفكرة موجودة ومتبعة كما سبق القول، ومضى عليها أكثر من قرن، لكنها مسألة حياةٍ أو موتٍ في الدراسات الإسلامية اليوم. لا أعرف كثيراً عن تجارب الدراسات الدينية في الدول الشيوعية السابقة والحالية. لكنني أعرف أنّ معاناة الإسلام هائلة في المشرق والمغرب، واستعادة الزمام والانضباط والمسؤولية ضرورية لبقاء الدين.
ولذلك فإنّ الجهد ينبغي أن يكون استثنائياً. وستبتسمون، لكنني أزعم أنّ أستاذ الإسلاميات ينبغي في هذا الزمن بالذات أن يكونَ صاحبَ رسالة وليس داعيةً بالمعنى المتعارَف عليه لذلك. ما الهدف من وراء ذلك؟ استعادة الزمام والجدية بالإنتاج المتميز والذي يصنعُ فارقاً في فهم الدين وإفهامه، والوصول إلى التأهُّل للمرجعية أو المشاركة فيها. نريد أساتذةً عظاماً في الفقه والتفسير وعلم الكلام القديم والحديث يُشارُ إليهم بالبنان، ويُقصدون من الشرق والغرب. وبذلك نستطيع صنع شراكات في المدى المتوسط، وصنع مرجعيات في المدى الطويل أو خلال جيل كما يقول ابن خلدون.
يقول ماكس فيبر (1864-1920) في محاضرته: “العلم باعتباره حرفة”[18] إنّ الأستاذ لا ينبغي أن يعمل في العمل العام، كما لا ينبغي أن يسعى لكسب المزيد من الرزق من خارج عمله العلمي. وقد لا يكون الأستاذ الكبير مدرِّساً جيداً، لكن ينبغي أن يُمكَّنَ من تولّي كرسيٍّ للتفرغ للبحث العلمي. العلم عند فيبر (Beruf)؛ أي حرفة، لكنه أيضاً (Berufung)؛ أي رسالة. وقد نصحتُ الزميل المترجم لمحاضرتَي العلم والسياسة أن يترجم (Berufung) بالاحتساب، لكنه أبى عليّ واعتبر ذلك تقعراً وحُوشية!
لقد قرأتُ قبل أيام بحثاً طويلاً وقيّماً لزميلتنا الدكتورة وداد القاضي عنوانه: “قضية المرجعية بين الشرق والغرب، ومستقبل الدراسات العربية والإسلامية”[19] تذكر فيه ضرورة مشاركة الطلاب والأساتذة في المؤتمرات العلمية والمجلات وتبادُل البعثات وسنواتٍ أو شهوراً للتفرغ لبحثٍ معين. وهذه الأُمور عاديةٌ في الغرب وبعض الشرق. لكنّ المهمَّ أنّ هذه الأعمال والنشاطات ووسائل التنمية والتدريب والتأهيل، كلُّها أُمورٌ من أعمال المؤسسات ذات البنية والقوام والاستمرارية عبر أجيال. ونحن لا ينقصُنا المال ولا تنقصُنا القدرة على التميز، وإنما تنقُصُنا سعةُ الأُفُق، وطول النَفَس. وقد عرفت الجامعات الغربية أساتذةً عرباً ومسلمين تميزوا في العلوم البحتة والتطبيقية وحصل بعضهم على جوائز نوبل. لكنّ الباحثين العرب في الجامعات الغربية في الدراسات العربية والإسلامية وعلى كثرتهم وجودة تعليمهم وباستثناءات ضئيلة، ما تميزوا كما تميز زملاؤهم في العلوم الحديثة، ربما لأنهم خضعوا للمسبقات الأيديولوجية والإبستيمية. ولذلك فإنّ لدينا تحديين: تحدي الإتْقان في التخصص، وتحدي الانخراط والتميز والتمايز في شروط وأواليات المرجعية الغربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وهناك شرطٌ ثالثٌ وأخير هو شرطُ الوعي بالتطور الديني والحضاري للإسلام والأمة وعلومه وعلومها. لقد تحدثتُ عن السياقات والتي تقتضي تنظيماً معيناً، وسميتُ الشرط الأول تاريخياً، والثاني ذا الشقين تنظيمياً. وأنا أُسمّي الشرط الثالث (وهو حديثٌ في الوظائف والمهمات والمنهجيات)؛ وعياً بالتقاليد العلمية والحضارية. وأقصِد بذلك أنّ الهدف هو استكشافُ عمق وأبعاد هذا التقليد العريق العلمي والحضاري للاتجاه الرئيسي في الإسلام، والذي صنع هذا التاريخ الطويلَ للدين وللحضارة. وهو تقليدٌ كرهه الإحيائيون والإصلاحيون النهضويون، والكارهُ عاجزٌ عن الفهم والإفهام.
لقد خرجت عليه السلفيات الجديدة باتجاه التأصيل، وخرج عليه العصرانيون باتجاه أوروبا والغرب. وبالطبع فإنّ الانكسارات التي عانى منها التقليد لا تعود للثورة عليه وحسْب؛ بل وللاختلالات البنيوية والزمانية التي تخلَّلتْهُ وأحاطتْ به. إنّ الدراسات الإسلامية الجديدة أو المجدَّدة شرطُها المنهجي والضروري الثالث هو القراءةُ الواعيةُ لهذا التقليد في استتبابه الفقهي والكلامي والثقافي والحضاري، وصولاً إلى تأمل تصدعاته وانكساراته. وإلاّ فكيف يمكن العمل تاريخياً ومنهجياً على الفهم والتقويم وإدراك تحولات المفاهيم وتحويلاتها، وقوانين ومسارات التغيير. وسيقال إنّ في ذلك رجوعاً أوعودةً إلى أُطروحة أو مقولة أو ممارسة: التاريخ الثقافي.
وهذا طموحٌ ما عاد من الممكن وسط الظروف والشروط الحاضرة القولُ به أو ممارسته. فلستُ أربط قراءة التقليد في الحقيقة بمقولة التاريخ الثقافي، على الرغبة في ذلك، بل بالمسار الذي يزدهر للتأويليات بالمعنى المعاصر. فكلُّ قراءةٍ تأويل، وقراءة التقاليد الفكرية والدينية والمفهومية تأويلٌ نقديٌّ من طراز رفيع[20]. فالمنهج الذي نقصد به إلى صنع مستقبل آخر للدراسات الإسلامية هو قراءة التقليد الإسلامي بطرائق نقدية وتأويلية دونما إنكارٍ ولا قطيعة ولا ابتسار، بل من أجل الفهم والتجاوز وفتح الآفاق. نحن محتاجون إلى تأويلياتٍ كبرى في مجالات فهم الإسلام وإفهامه ومشاركة الآخرين في العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلوم فلسفة الدين[21].
لقد تحدث “كارل هاينرش بيكر” عن “علم الإسلام”، بيد أنّ التعبير الذي ساد في حقبة “التاريخ الثقافي” هو تعبير أو مصطلح الدراسات الإسلامية. ولدينا اليوم نوعان من المؤسسات التي تمارس هذا التخصص على اختلاف المقاصد والمناهج: المعاهد والأقسام في الجامعات الغربية عن اللغات والحضارة الإسلامية، والجامعات والمعاهد الدينية والمدنية في العالمين العربي والإسلامي. وفي المعاهد الغربية تسيطر اليوم السوسيولوجيات والأنثروبولوجيات التأصيلية[22]. أمّا في الجامعات العربية والإسلامية فتسيطر العقائدياتُ والاعتذاريات والتسويغيات. والمرادُ وسط الشروط الثلاثة التي ذكرتُها الإتقانُ والانضباط والتأهُّل لأعمالٍ تأويليةٍ كبرى تُسهم في الخروج من العقدنة والإسلاموفوبيا. وفي هذا الوعي والعمل عليه يكمن مستقبل[23] الدراسات الإسلامية، وقسطٌ كبيرٌ من مستقبل الإسلام: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ (الرعد: 19).
الهوامش
[1]. George Makdisi: The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West 1990, 2-15, 121-140
[2] . Werner Jaeger: Paideia, The Ideals of Greek Culture. Translated From the German by Gilbert Hichet, 1-111, 1986.
[3] . جورج مقدسي، Rise of Humanism، م، س، ص2-4. وقارن بمقدسي:
- Makdisi: The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West 1981, 80-85.
[4] . فرانتز روزنتال، مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي، ترجمة: أنيس فريحة 1961، ص14-21. وقارن بنموذج الـcurriculum الفلسفي عند الفارابي في “إحصاء العلوم”:
David C. Reisman: Al- Farabi and the Philosophical curriculum; in: Arabic Philosophy, ed. Adamson and Taylor 2005, 52-71.
[5] . رسائل الكندي الفلسفية. تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدة، 1-2 1950 1/165، 312، 348، والفارابي، رسالة في العقل، نشرة موريس بويج 1983، ص4-10. والمحاسبي، العقل وفهم القرآن، تحقيق: حسين قوتلي 1978، ص201-202. وقارن برضوان السيد، العقل والدولة في الإسلام، في: الأمة والجماعة والسلطة، ط3، 2012، ص182-183، 191-193.
[6]. Dirk Harwig (ed.): Im wollen licht der Geschichte. Die Wissenschaft des Judentums und die Anfänge der Koranforschung 2008 – Suzanne L. Marchand: German Orientalism in the Age of Empire 2009, 74-77, 135-240.
وقارن برضوان السيد، المستشرقون الألمان، النشوء والتأثير والمصائر، ط2، 2016، ص23-40.
[7] . جورج مقدسي، Rise of Humanism، م، س، ص88-96.
[8]. رضوان السيد: المستشرقون الألمان، مرجع سابق، ص15-24.
[9] . رضوان السيد، التراث العربي في الحاضر، النشر والقراءة والصراع 2014، ص75-97.
[10] . Joseph van Ess: From Wellhausen to Becker: the Emergence of “Kulturgeschichte”; in M. Kerr (ed.) Islamic Studies: A Tradition and its Problems 1980, 27-52.
[11]. رضوان السيد: النشر التراثي العربي، الأصول والاتجاهات والدلالات الثقافية؛ في: التراث العربي في الحاضر، م، س، ص89-97، 115-120.
[12] . مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 1943، ص26-38، ورضوان السيد، المستشرقون الألمان، م، س، ص79-80، ورضوان السيد: التراث العربي، م، س، ص115-119.
[13] . قارن برضوان السيد، سياسيات الإسلام المعاصر، مراجعات ومتابعات، ط2، 2015، ص105-128.
[14] . رضوان السيد، الأيديولوجي والمعرفي في تحقيقات التراث العربي وقراءاته؛ في: التراث العربي في الحاضر، م، س، ص119-159.
[15] . قارن بدراستي: ما وراء التبشير والاستعمار، ملاحظات حول النقد العربي للاستشراق؛ في كتابي: سياسيات الإسلام المعاصر، مرجع سابق: ص ص 258-268.
[16] . قارن بمقالة الأستاذة وداد القاضي: قضية المرجعية بين الشرق والغرب ومستقبل الدراسات العربية والإسلامية في العالم الجديد؛ في نشرة د. بلال الأرفه لي لمقالاتها المجموعة بعنوان: الرؤية والعبارة، دراسات في الأدب والفكر والتاريخ 2015 ص27-54.
[17] . في 1 مارس 2017.
[18] . ماكس فيبر: العلم باعتباره حرفة، والسياسة باعتبارها حرفة. ترجمة جورج كتوره، ومراجعة وتقديم رضوان السيد 2012. وانظر بحثاً لي عنوانه: ماكس فيبر، الأخلاق البروتستانتية: سلطة الأيديولوجيا وعلائقها الاقتصادية والاجتماعية؛ في: سياسيات الإسلام المعاصر الطبعة الثانية 2015، ص ص 261-282.
[19] . استشهدت بالبحث من قبل في الحاشية رقم 15.
[20] . قارن على سبيل المثال بـ:
Hastings Donnan (ed.) Interpreting Islam 2002.
[21] . قارن بنايلا طبارة، إشراف: الدراسات الإسلامية أمام تحدي التنوع الثقافي في العالم المعاصر 2017.
[22] . قارن:
Baber Johansen: Islamic Studies. The Intellectual and Political Conditions of a Discipline; in: Penser L’orient. Traditions et actualité des orientalismes français et alleman. Ed. Y. Courbage et Manfred Kropp. 2004, 65-93.
[23] . قارن على سبيل المثال:
Fazlur Rahman: Islamic Studies and the Future of Islam; in Islamic Studies (ed. M. Kerr), op.cit. 125-135.