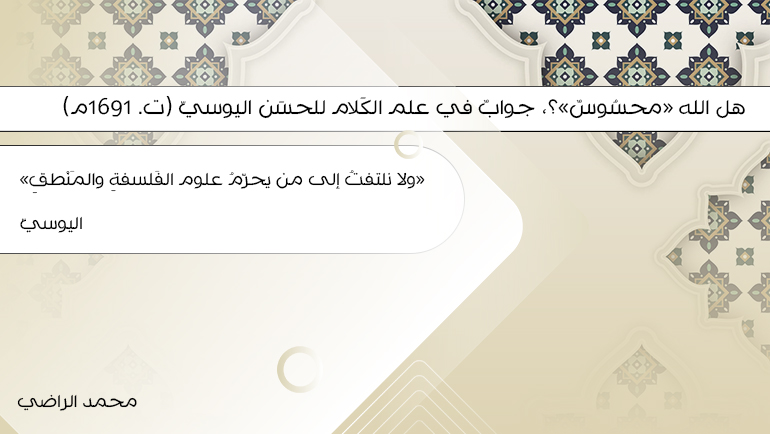نظرات في كتاب «البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها» للدكتور محمد العمري

المؤلف(1):
وُلِد الدكتور محمد عبد الله العُمَري سنة 1364هـ/1945م، وتعلَّم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن وبعض المتون والمنظومات على يد والده، قبل أن يلتحق بالتعليم النظامي غداة استقلال المغرب. وقد حصل على شهادة الدراسات المعمّقة، ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة في الأدب العربي من جامعة محمد الخامس في الرباط. عمل أستاذا للبلاغة وتحليل الخطاب والنقد الأدبي في كليتي الآداب بفاس والرباط، كما عمل في جامعة الملك سعود بالرياض لمدة سنة.
من مؤلفاته:
– تحليل الخطاب الشعري: البنية الصوتية في الشعر.
– الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية.
– في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية.
– البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول.
– أسئلة البلاغة: في النظرية والتاريخ والقراءة (دراسات وحوارات).
* * *
عن الكتاب:
كتاب «البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها» في أصله امتداد لكتاب آخر سبق صدوره للمؤلف بعنوان «الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية»، وقد دفع بمؤلفه إلى وضعه في أول الأمر شيئان: انصراف الناس عن دراسة البنيات إلى الاهتمام بجمالية التلقِّي، مثل القراءة العربية للتراث اليوناني. والثاني: بيداغوجي، نظرا للخلط الحاصل في أمور متعلقة بالبلاغة العربية القديمة خاصة، وتاريخ البلاغة العربية عامة.
وقد جعل المؤلف كتابه في قسمين كبيرين، تحتهما فصول، مع مدخل عام ذكر فيه بعض المقدمات والخلاصات.
أما المدخل العام فتحدث فيه عمّا سمّاه «مَنابت البلاغة وتربتها»، وهي نشأتها وما صاحبها من العوامل التي ساعدت في ظهورها، وبعض (التلاقح) الذي حصل بين الثقافة العربية وغيرها، كالثقافة الفارسية واليونانية والهندية. وكذلك الخلفية الدينية، بالبحث عن وجوه إعجاز القرآن الكريم. ثم البحث في مسائل النحو والمنطق، فكل ذلك كان من عوامل ظهور البحث البلاغي عند العرب.
وفي القسم الأول من الكتاب الذي جعله المؤلف في أصول البلاغة، أورد خمسة فصول:
الفصل الأول: في البلاغة ونقد الشعر، وفيه كلام عن صناعة الشعر، والخصومات الشعرية، والاحتكام إلى الحُكام عند المفاخرة. وفيه أيضا كلام عن البديع ومحاسن الكلام، والبلاغة والاختيارات الشعرية، مع التمثيل لها بحماسة أبي تمام.
الفصل الثاني: البلاغة ومَعيرة اللغة، تحدث فيه المؤلف عن مجاز القرآن، والضرورة الشعرية.
الفصل الثالث: عرض فيه المؤلف لمباحثَ عن تبرير المجاز، والانتقال إلى بيان وجه الإعجاز، أو الدفاع عن القرآن الكريم والردّ على الخصوم، مع بيان إعجاز القرآن الكريم، وأين يقع ذلك.
الفصل الرابع: من البيان إلى البلاغة، عرضَ فيه المؤلف لمشروع الجاحظ في كتاب البيان والتبيين.
الفصل الخامس: القراءة العربية للبلاغة اليونانية، أورد فيه مباحث عن اشتغال العرب بكتابَي أرسطو «فن الشعر» و«فن الخَطابة».
أما القسم الثاني فجعله المؤلف في امتدادات البلاغة، أو النماذج الكبرى لهذه المشاريع البلاغية، وقسمه إلى أربعة فصول:
الفصل الأول: في المحاولات الأولى لبناء بلاغة عامة، تحدث فيه عن مشروع العسكري في كتاب «الصناعتين»، وعن مشروع قدامة بن جعفر في كتاب «نقد الشعر».
الفصل الثاني: في الغرابة الشعرية والمناسبة التداولية، تحدث فيه عن المعنى، وعن كتاب «دلائل الإعجاز» للجرجاني، ثم عن بعض المنجزات الأساسية في البلاغة.
الفصل الثالث: في بلاغة الصحة والتناسب، أو الانتقال من الأصوات إلى المعاني، وظهور إشكال الفصاحة والبلاغة.
الفصل الرابع: في البلاغة المعضودة بالنحو والمنطق، عرضَ فيه لمشروع السكاكي في «مفتاح العلوم»، ومشروع حازم القرطاجني في «منهاج البلغاء».
فهذا عرض موجز لفصول الكتاب كما وضعها مؤلفه، وفيما يلي أُورِدُ نظرات في بعض مباحث الكتاب، أعرضها تحت عناوين مستقلة من غير استقصاء ولا ترتيب لها، وإنما آخذ منها ما رأيت فيه مجالا للنقاش وكان متصلا بعضُه ببعض، لذلك ربما يعتريها أحيانا تقديم وتأخير لجمع النظير إلى نظيره. وقد أودعت فيها بعض التعليقات حيثما لزم الأمر، لئلا يكون ذلك في آخر البحث، فتضيع معه رغبة القارئ في التعليق والبيان وقت الحاجة.
* * *
عنوان الكتاب:
لماذا آثر المؤلف وضع عنوان «البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها» بدل: تاريخ البلاغة العربية، مثلا، كما جرت العادة في مثل هذه التواليف التي هي تأريخٌ لعلم من العلوم، مع أن القصد واحد؟
يمكن النظر إلى هذا الأمر على أن المؤلف آثر «أصولها وامتداداتها» على «تاريخها» للحاجة إلى بيان أن الكتاب يقع في قسمين، الأول عبارة عن أصول البلاغة العربية، أو ما سماه في متن الكتاب «منابت البلاغة وتُربتها»، والقسم الثاني عبارة عن الامتدادات، أو ما سماه «النماذج الكبرى». وفي كلا القسمين يُحب المؤلف أن يكون بمعزل عمّا درجَ عليه مَن قبله من المؤلفين في تاريخ البلاغة، فهو يُريد جعل كتابه مُتّسما بسِمة تميزه عن غيره، فلا يكتفي باستقصاء البلاغة العربية من نشأتها إلى يوم الناس هذا، وإنما يرصد الظواهر الكبرى التي كانت امتدادا لما سيأتي بعدها من الدراسات، أو ما يمكن التعبير عنه بالمُنجز البلاغي، يقول المؤلف: «فاحترمت عمل كل مؤلف فيما اقترحه وما صرح به، ثم حاولت بناء عمله بطريقتي لأقول له، ولنفسي: إن ما صرحت به شيء، وما أنجزته شيء آخر»(2).
هذا، وفي عبارة العنوان إيذان بأن الكتاب ليس تاريخا لتراجم أعلام البلاغة، أو لفنونها، وإنما هو لشيئين: أصل البلاغة، وامتدادها، أو أثر ذلك فيما سيأتي بعده.
مباحثُ أَوَّلِيَّةٌ لنشأة علم البلاغة:
مما يُلاحظه الناظر في الكتاب أن المؤلف لم يستقصِ كثيرا المراحلَ الأولى لنشوء علم البلاغة الذي كان، حسب كثيرين، آراء نقدية صحبت إنشادَ الشعر في أول أمره زمن الجاهلية، كما يُروى عن تقويم النابغة الذبياني لقصيدة حسان بن ثابت عندما أنشده إياها في عكاظ حيث كانت تُضرب له قُبَّة فتأتيه الشعراء لعرض شعرها عليه، أو تقويم أهل المدينة لقصيدة النابغة نفسِه حين وقع في الإقواء، وغير ذلك كثير.
فكانت هذه الآراء النقدية هي النواة الأولى لعلم الشعر، أو علم البلاغة عامة، أو ما استقلّ منه فجُمع تحت مُسمَّى علم البديع، أو ما كان من صنيع العلماء الذين بحثوا في إعجاز القرآن الكريم، وقد مثَّل لذلك المؤلف بكتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى. وفي خلال ذلك أشار المؤلف إلى بعض العوامل التي ساعدت في نشوء علم البلاغة والإبداع فيه، منها:
– الاطلاع على الثقافات الأخرى كالثقافة اليونانية، والثقافة الفارسية.
– البحث عن وجوه إعجاز النص القرآني وتنزيهُه عما يعتري أي نص بشري من النقص والقصور، وأشار إلى الشعر العربي وما يعتريه من الضرورات التي يلجأ إليها الشاعر.
– الاشتغال بمباحث النحو والمنطق (علم الكلام)، فهذا في نظر المؤلف أدى إلى طرح الكثير من الأسئلة البلاغية التي تحتاج إلى بحث وإجابة، فالبلاغة كما يذهب إلى ذلك حازم القرطاجني علم كُلي، وهذه الصفة لا تكتسبها إلا إذا كانت معضودة بالنحو والمنطق في نظر المؤلف.
وقدّم المؤلف قراءات رأى بأنها عُمدة النظر البلاغي في كلام العرب في أوائل نشوء هذا العلم إلى ما بعد تطوره بقليل، وهذه القراءات هي نتيجة للفكر الواعِي بمقاصد المؤلفين في البلاغة، فذكر المؤلف:
– قراءة الفلاسفة العرب لكتاب «فن الشعر» لأرسطو، وذلك بالنظر إليها على أنها استخلاصٌ للكلّيات والقوانين العامة عند كل الأمم، من غير الاقتصار على العرب فقط.
– قراءة ابن وهب الكاتب في «البرهان في وجوه البيان» لكتاب «البيان والتبيين» للجاحظ.
– قراءة المرزوقي لـ«حماسة أبي تمام» في المقدمة التي عقدها على الكتاب وذكر فيها قضية عمود الشعر.
– قراءة السكاكي «لدلائل الإعجاز» للجرجاني.
النص المعياري والنص المتميز:
عرض المؤلف في أثناء مباحث الكتاب لقضية المفاضلة بين النص المعياري والنص والمتميز، فالنص المعياري عنده هو الذي أحاط به القياس، أي: القياس الذي عليه وَضْعُ الكلام العربي، والنص المتميز أو الخاص هو الذي عولج عند اللغويين ضمن مجاز القرآن أو ضرورة الشعر.
قلت: ويمكن اعتبار النص المعياري ما يطلق عليه «النص المغسول»، وهو ما عَرِيَ عن الصور البلاغية ووقع على وضع الكلام العربي وترتيبه، بحيث لا يكون مشتملا على تقديم أو تأخير يوجب إعمال النظر فيه واستخراج علل ذلك، ثم الحكم على مدى بلاغته.
كما يمكن النظر إلى النص المتميز الذي أشار المؤلف إلى أنه الذي عالجه اللغويون ضمن مجاز القرآن، وهنا نقصد النص القرآني الكريم، بحيث ينتفي تفاوت بلاغته، فلا يُحكم على آية بأنها أبلغ من أختها. ثم ما عالجه اللغويون أيضا ضمن ضرورة الشعر، وهذا يقتضي أن ما كان من الشعر في حيّز الضرورة، فهو نص متميز مطلقا، وهذا يصعب القولُ به، إذ جمهور المتكلمين في ضرائر الشعر على أن ما كان منها قبيحا فهو قبيح، وإنْ وقع من شاعر متقدم، وما كان حسنا فهو حسن، وإن وقع من شاعر متأخر.
قال المؤلف عند حديثه عن بحث البلاغيين في مجاز القرآن: «وكل هذا داخل في هَمِّ التنزيه عن الشذوذ والتناقض»(3).
وعندي أن هذا القول ينفي البحث عن بلاغة النص القرآني، فليس البحث عن وجه الإعجاز في النص القرآني مجرد محاولةٍ لنفي التهمة عنه ودفع الرِّيَبِ في كونه وقع بعضُه موافقا لكلام العرب وبعضه شاذا عنه وحسبُ، وإنما هو بحث في إعجاز النص القرآني وعلل تَفَرُّدِه عن جميع كلام البشر أيضا، وغير ذلك مما هو مبثوث في الكتب التي بحثت في هذا الموضوع.
تداخل البلاغة والنقد الأدبي:
من غير الخافي عن الذي يبحث في تاريخ البلاغة أن يعلم أن من الأمور التي ساعدت في نشأة هذا العلم أنه كان نتاجا، في بعض مباحثه، للنقد الأدبي الذي كان مُصاحبا لإنشاد الشعر في أول الأمر. فالشاعر في ابتداء الأمر هو الناقد الأول لشعر، وهنا يمكن أن نُشير إلى الشعراء الذين كانوا يُنقِّحون قصائدهم قبل عرضها على الناس، منهم زهير بن أبي سُلمى وغيره ممن تسمَّوا فيما بعدُ «عَبيد الشعر»، فقد كانوا ينقّحون قصائدهم ويغيرون فيها إلى أن تستويَ تامَّة البناء. وقد أشرتُ من قبلُ إلى عرض الشعراء لأشعارها على النابغة الذبياني في سوق عكاظ، فكان من ذلك حظ وافر من النظر في مراتب القولِ ومنازل البلاغة في الشعر.
وكذلك ما كان من الخصومات الأدبية عامة، وأخص منها نقائض الشعراء الثلاثة: الفرزدق وجرير والأخطل، فقد أسهمت مثل هذه الخصومات في إثراء النظر البلاغي في الشعر العربي.
وقد أكّد المؤلف هذه الفكرة وتبنّاها في كتابه حيث يقول في كلام قريب من هذا الذي نحن فيه: «ليس من الغريب أن تجمُد البلاغة بعد أن صارت تدرس بعيدا عن تاريخ الشعر وما ينتابه من تطورات شكلية عامة أو فِئوية (الأراجيز والموشحات مثلا، بل والزجل أيضا)، وتدرس بعيدا عن المعارك النقدية وتطور مفاهيم النقد. والحال أنها في ارتباط وثيق بهذه المجالات، ارتباط تداخل لا تقارب»(4).
قلت: قد لا نُسَلِّم للمؤلف إدخاله الزجل بين هذه الفنون، فإن كلامَ العامَّة لا يُعْتَدُّ به في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالعلوم، فتطور البلاغة ليسَ مرتبطا بفنّ الزجل الذي عَدَّه المؤلف تطورا لتاريخ الشعر (فئويا). أما ما كان من الأراجيز والموشحات (في الأندلس) فهو أدخلُ في هذا الأمر، إذ هو من فصيح الكلام الذي
أنشأه الشعراء وقدّموا فيه نماذج عالية من البلاغة.
والمؤلف في كلامه هذا كأنه يذهب إلى أن العلوم تحتاج إلى ما يُذكيها ويُشعل فتيلَ البحث فيها لتتطوّر ويُنفى عنها ما لا حاجة إليه، أو ما كان غيرَ نافع. والحق أن المعارك النقدية وما يصحبها من ردود وتعقيبات وأخذ ورَدٍّ وغير ذلك، جديرة بالإسهام في تطور العلم، لا سيما ما كان قائما على مصطلحات يتفرّد بها مذهب عن آخر. فالنقائض الشعرية بين الفرزدق وجرير والأخطل، نتج عنها استعمال مصطلحات هي أَدْخَلُ في النقد منها في البلاغة (بمعنى بلوغ القصد، أو البحث عن محسِّنات الكلام)، فمصطلح «الاجتلاب» مثلا، وهو انتحال الشاعر قولا لغيره وإدخاله في شعره، يَفِي بوَقفنا على الغرض الذي نتحدث فيه، وقد استعمله جرير في شعره، ونفى كونه ممن يصنع ذلك، قال:
أَلَمْ تَعْلَمْ مُسَرَّحِيَ الْقَوَافِي /// فَلَا عِيًّا بِهِنَّ وَلَا اجْتِلَابَا
فهذا مصطلح نقدي، تداخل مع البلاغة، فصار من مباحثها، يُبحث فيه عن بلاغة الشاعر حيث استقلّ بكلامه وعَرِي شعرُه عن كلام مُنتحل ومُجتلب.
ومن هذا كان حديثُ المؤلف عن اختيارات أبي تمام في الحماسة، فصنيع أبي تمام فيها أشبه ما يكون بناقد ينظر في قصيدة، فيميز الحسن ممّا دونه، ويختار ما يراه أنسبَ للمعنى الذي أراده أو بنى عليه البابَ في كتابه. ولذلك يختلف عمل أبي تمام في الحماسة عن عمل غيره، كأبي زيد القرشي في «جمهرة أشعار العرب» أو المفضل الضبي في «المفضليات» أو الأصمعي في «الأصمعيات». فهؤلاء اختاروا ما قام عليه شِبه الإجماع، في الأكثر، على قصائد كاملة مختارة بعينها، لا يُطَّرَحُ منها بيت إلا ما اتفقت الروايات على أنه ليس من القصيدة، وهذا يكثر في الشعر الذي أشبه بعضه بعضا في الوزن والقافية، أو كما قال ابن سلّام الجُمحي في طبقاته: «وليس يُشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المُوَلَّدُون، وإنما عضل بهم أن يقولَ الرجلُ من أهل البادية من وَلَدِ الشعراء أو الرجلُ ليس من ولدهم، فيشكل ذلك بعض الإشكال»(5).
التَّوَسُّعُ في اللغة:
من المباحث التي تكلم فيها المؤلف مبحثُ التوسع في اللغة، وهذا المبحث، كما هو معروف، يشمل كلَّ ما ورد في الكلام لا على سبيل الحقيقة والوضع الأصلي، وإنما على سبيل المجاز أو التجوز، أو التوسع في استعمال اللغة. وتدخل تحته الضرورة الشعرية، أو ما يحتمل الشعر، وهو باب عقده سيبويه في كتابه.
ويدخل في التوسع في اللغة أيضا المجاز القرآني، على الخلاف بين مَن يقول به وبين مَن يَنفيه عن القرآن. فإن المؤلف عرضَ لبعض صور التوسع كما ذكرها سيبويه في كتابه، ومنها قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، والتقدير: واسأل أهلَ القرية. ومنها أيضا: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ: 33]، والتقدير: في الليل والنهار، لأن النهار والليل لا يَمْكُران، وإنما يُمْكَرُ فيهما.
ومثَّل المؤلف لهذا التوسع في الشعر بقول الشاعر:
تَرَى الثَّوْرَ فِيهَا مُدْخِلَ الظِّلِ رَأْسَهُ /// وَسَائِرُهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسِ أَجْمَعُ
وإنما الذي يُدْخَلُ هو الرأسُ، لا الظل.
وقد جعل المؤلف هذه الضرورات ثلاثة أصناف:
1- خرق الوظيفة اللغوية (اللا نحوية):
وهو الخروج عن نظام اللغة وقانونها العام القائم على التواصل من أقرب الطرق وبأوثق الضمانات وأوفرها. يُريد بذلك جوهر نظرية الانزياح التي تجعل (اللا نحوية) خصوصية النظم الشعري.
2- خرق القواعد التطبيقية (خرق الأداة):
يُريد ما يقع من الزيادة والحذف والتقديم والتأخير والنقل…، مع إدخال ما يقع من رفع المنصوب ونصب المرفوع وغير ذلك مما لا يقتضيه الوزن.
3- الخرق الملتبس:
هو الذي يكون بين الصنف الأول والثاني، فلا يرقى فيه الانزياح عن الوظيفة اللغوية إلى خرق القواعد الإجرائية الوظيفية.
قلت: هذا التفصيل كان يمكن التعبير عنه بما عند القدماء من تصنيف الضرورة الشعرية إلى حسنة وقبيحة، وأما ما ذكره المؤلف في الصنف الثاني من إدخال ما يقع من رفع المنصوب ونصب المرفوع وغير ذلك مما لا يقتضيه الوزن، فليس لأحد أن يُجيز فعلَه، فالضرورة تُقدَّر بقدرها في الشعر، فإنما تكون في أشياء اطَّرد ارتكابها من الشعراء مما ليس فيه خرق لقاعدة أو شذوذٌ عن القياس أو خروج عن سَمت العرب في كلامها، كفكّ المدغم، وصرف ما لا ينصرف وغير ذلك مما يدخل تحت مُسمَّى «مراجعة الأصل»، فكأن الشاعر إذْ وقع في ذلك كانَ بمنزلة مَن يُراجع أصلا قديما لا يُستعمل، فأحياه باستعماله إياه.
وقد تكون الضرورة التي لجأ إليها الشاعر لغةً من لغات العرب، فحينئذ لا يُستقبح ما ارتكبه، وإنما يُحمل على لغة من لغات العرب ليست بشائعة الاستعمال.
أو يكون قد أتى في كلامه بغير المشهور، وله وجه في العربية صحيح يُحتاج معه إلى تأويل، فكذلك لا يُحمل كلامه على الضرورة القبيحة التي تُخرجه عن المقبول المستساغ.
وأما رفع المنصوب ونصب المرفوع وما أشبه ذلك، فليس فيه مراجعة للأصل، وإنما هو خرقٌ محضٌ للقاعدة والقياس، لا يقبله الطبع ولا تستسيغه الأذن، وليس هذا موضع التمثيل لكل ما ذكرت، وإنما أوردتُه لبَيان كلام المؤلف، فإنه مُحوج إلى تفصيلٍ يظهر معه وجهُ القُصور فيه.
عمل بعض البلاغيين مع القرآن الكريم:
مما عرض له المؤلف في كتابه حديث ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن» عن مَزاعم الطاعنين في القرآن الكريم، وهو بحثٌ خُصص للرد على اعتراضاتهم على ما جاء في القرآن في زعمهم متناقضا، وقد ردّ ابن قتيبة على هذه المَزاعم في أبواب:
– باب الرد عليهم في أبواب القراءات.
– باب ما ادُّعِيَ على القرآن من اللحن.
– باب التناقض والاختلاف.
– باب المتشابه.
وهي قضايا يرى المؤلف أنها تدخل في أصناف:
1- قضايا تتعلق بضبط النص وانسجامه من حيث اختلاف القراءات والإعراب.
ويدخل فيها اختلاف القراءات، وما ادُّعِي على القرآن من اللحن، وهذا باطل يردُّه أدنى تأمل في كتب إعراب القرآن، فمن علم أن العرب كانت على اختلافٍ في بعض حروفها أدرك أن القرآن نزل على إحدى هذه الحروف، فانتفى القول بوقوع اللحن فيه، إذ مرَدُّه إلى أن ذلك إنما كان مراعاة للسان كل قوم.
وأما القراءات فسَبيلُها ما ذكرتُ في اللحن، وما وُضع من كتب القراءات شاهد على ذلك، بل ما شذ منها أيضا لا يخلو أن يكون لغة من لغات بعض العرب، فإن ادُّعِي الاختلاف في النزول بلغات عدة، فذلك ما كان عليه العرب قبل الإسلام، وكل قوم تلقَّوا القرآن وليس يُحوجهم شيء إلى معرفة ما فيه إذ وقع فيه الاختلاف في بعض الحروف، فليس ذلك مما يُشكل على العربيّ الذي أدرك النزول.
2- قضية انسجام النص، أو ما ادُّعي من التناقض والاختلاف.
وقد تدخل في القضية التي قبلها مما ادُّعي على القرآن من اللحن، فعمل البلاغيين بعدُ قد أجاب عن هذا الادعاء، وأُلِّف في بلاغة القرآن ونظمِه ما لا يُحصى من الكتب، ومَن اطلع عليها أدرك تهافت هذا الادعاء، وظهر له أنَّ كلامَ الله يعلو عن هذا كله، وأَنْ ليس يُدانيه نص بشريّ مهما عَلَتْ بلاغته واستحكم نظْمُه.
3- قضية المتشابه.
وهي قضية الإشكال والغموض في العبارة بسبب تصرّف دلالي أو نحوي.
وهذه الادّعاءات أُجِيبَ عنها بما فيه غُنية لمُريد الحقّ، وللجاحظ في بعض ما كَتَبه من كُتُبه ورسائله كلامٌ في هذا الشأن، فقد أجاب عن هذه المَزاعم التي تولّى كِبْرَها كثيرٌ من الفِرق التي تصدّت للطعن في القرآن، ومن جُملة ما اتخذه الجاحظُ حجةً في إجاباته قضيةُ نظم القرآن، يقول في ذلك: «[…] لأن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبُلغائهم سورة واحدة، طويلة أو قصيرة، لتبين له في نظامها ومخرجها، وفي لفظها وطبعها، أنه عاجز عن مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها، وليس ذلك في الحرف والحرفين، والكلمة والكلمتين»(6).
اشتغال العرب بتُراث اليونان:
مما عرض له المؤلف في أثناء هذه الفصول قضيةُ الترجمة عن الثقافات الأخرى، وهذا أمر تحدث عنه الجاحظ أيضا في بعض كتاباته، وقد راجَ رَأْيٌ يَرَى أن العرب لم يفهموا كتاب أرسطو ولم يتأثّروا به، ومَرَدُّ ذلك، في نظر المؤلف من ناحية، إلى أن الذين ترجموا الكتاب أساؤوا الترجمة، وقصَّروا عن الإحاطة بالمعاني، قال الجاحظ: «ولا بدّ للتّرجمان من أن يكون بيانُه في نفس الترجمة، في وزن علمه، في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلمَ الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتّى يكون فيهما سواءً وغايةً»(7).
قال المؤلف: «وهذا الكلام صِلة لحديثه عن تعذُّر ترجمة الشعر نفسِه بسبب ما تؤدِّي إليه الترجمة من بُطلان معجزته، وهي الوزن»(8).
قلت: وهذا الأمر أَوْقَعُ في الشِّعر والقرآن الكريم منه في سائر أصناف الكلام، فقد علمتَ أن الشعر ينتظمه وزن وقافية، فإن أمكنَ المترجِمَ النقلُ إلى لغة أُخرى ووضعُ قافية جامعة للنص، فإنه يَعْسُر عليه ذلك إِذَا هو أراد حَمْلَه على الوزن، لأن الشعر به يَنْمَازُ عن غيره، فلا سبيل إلى اطِّراح الوزن حينئذ. وأما القرآن الكريم فالشأن فيه أنه نص جامع لا تفاوت بين أجزائه، فلا يصح أن توصف سورةٌ بأنها أبلغ من سورة، أو آية بأنها أبلغ من أختها، ولذلك عدَّ العلماء قضيةَ النظم من خصائص النص القرآني الكريم.
ويُضاف إلى ما ذكرنا أن الكتاب في أصله غيرُ تامٍّ، فقد تنبّه كثيرون إلى أنه قد اعتراه نقص في فصوله، لأن أرسطو كان يذكر في بعض كتاباته أنه تكلم عن مسألة ما في كتاب «فن الشعر»، ولكنها لم ترد فيه، فدلّ ذلك على أن جزءا منه سقط. وقد يحتمل أن يكون من تقصير المترجِم عنه.
وتحسُن الإشارة إلى أن الكتاب في أصله مجموع محاضرات ألقاها أرسطو على طلبته، قال المؤلف: «أمَا وقد بذلنا جهدنا في تقديم هيكل النص، ولو كقضية جديرة بالتأمل، فإننا نشير إلى أن كتاب فن الشعر كان في أصله عبارةً عن محاضرات ألقاها أرسطو على طلبته، ثم جُمعت بعد ذلك في كتاب»(9).
ومثل هذه الكتب قَلَّما يسلم من غموض العبارة وتفرُّق الأجزاء والاستطراد الذي لا يرى القارئ حاجةً إليه، وأحيانا يعتريه انقطاع السياق، أو الانتقال من غير رابط يربط بين العبارات.
ما عمل الشُّراح العرب في كتاب «فن الشعر»؟
مما هو معلوم أن كتاب «فن الشعر» لأرسطو يبحث في القوانين المُطلقة التي تحكم الشعر عامةً، وقد أورد المؤلف قولَ الفارابي في ذلك، وفيه: «فهذه قوانينُ كلية يُنتفع بها في إحاطة العلم بصناعة الشعراء، إلا أن الاستقصاء في مثل هذه الصناعة يذهب بالإنسان في نوع واحد من الصناعة، وفي جهة واحدة»، لذلك كان عمل الشُّراح العرب (الفلاسفة) حَرِيًّا بالنظر إليه والتعرُّف على ما عَمَدوا إلى الاهتمام به، ومن بين هذه الأعمال كما قدّمها المؤلف في كتابه:
– تخليص عمل أرسطو من الخصوصيات والعادات والأمثلة اليونانية.
يُريد المؤلف أن الشُّراح العرب وسَّعوا دائرة القوانين التي وضعها أرسطو لتشمل الشعر العربي، وتركوا ما كان خاصا بالثقافة اليونانية.
– بسط المفاهيم الكلية وإمدادُها بالأمثلة العربية.
بمعنى أن الأمثلة التي وضعها الشُّراح العرب مأخوذة من كلام العرب، لا من كلام اليونان.
المحاكاة في الشعر عند الشُّراح العرب:
المعروف أن كتاب «فن الشعر» قائم على قضية مركزية، وهي المحاكاة، قال المؤلف: «لا يختلف الدارسون المحدثون في تحديد مركز كتاب أرسطو بشكل عام، حتى ولو اختلفوا في التفاصيل والحدود، إنه قيام الشعر على المحاكاة، أو المحاكاة الشعرية»(10).
والمحاكاة عند أرسطو تقع في كثير من الأشياء، منها فن التشخيص والتمثيل والحكاية، ولا يخفى أن الشعر الغنائي لا يدخل عند أرسطو في هذا النسق، فهو شعر غير مُحاكٍ كما يُفهم من غيابه عن الكتاب.
ويمكن التعبير عن المحاكاة بأنها تمثيل أفعال الإنسان باللغة، وفي عكس ذلك قد يصدُق عليها ما يكون من العمل المسرحي، لأنه تمثيل اللغة بالحركات، فهو صورةٌ لِما يُفهم بالضدِّ من المحاكاة عند أرسطو، إنه تمثيل كلام الإنسان بالأفعال.
ويُمكن اختزال هذا الانتقال في مفهوم المحاكاة فيما يلي:
| المحاكاة عند أرسطو: ï المحاكاة عند الفارابي: ï المحاكة عند ابن رُشد: حكاية وفعل ï تصوير ï تغيير |
فقد انتقلت عند الفارابي إلى كونها تصويرا، ومنه التمثيل، أي: تمثيل الأشياء أساسا. فالنحت عنده يدخل في هذا المفهوم، وقد نقل عنه المؤلف قوله: «فإن محاكاة الأمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول، فالذي بفعل ضربان: أحدهما أن يحاكي الإنسان بيده شيئا ما، مثل أن يعمل تمثالا يُحاكي به إنسانا بعينه أو شيئا غير ذلك. والمحاكاة بقول هي أن يؤلف القول الذي يصنعه أو يخاطب به من أمور تحاكي الشيء الذي فيه القول، وهو أن يجعل القول دالا على أمور تحاكي ذلك الشيء»(11).
أما التغيير الذي عند ابن رُشد فقد عَدَّه المؤلف صياغة متقدمة تاريخا وفهما للانزياح الشعري، ويمكننا القول: إن مفهوم التغيير يقابل مفهوم الوضع، فما صحَّ أن يقال فيه: إنه تغيير، لا يصح أن يقال فيه: إنه وضع. فالوضع هو الأصل الأول للكلام، ثم يأتي التغيير الذي يطرأ عليه بعدُ. وهكذا نجد أن التغيير يقع على التشبيه والاستعارة، ويمكن أن يشمل غيرهما إذا نظرنا إلى المعنى العام للانزياح.
أقسام الخَطابة عند أرسطو:
قدَّم المؤلف تصورا عن الأقسام التي انْبَنَى عليها كتاب «فن الخَطابة» لأرسطو، وهو مأخوذ من كلام أرسطو نفسه، وفيه: «ثلاثة أمور تحتاج إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالقول: الأول هو مصادر الأدلة، والثاني الأسلوب، والثالث ترتيب أجزاء القول»(12).
ولكن المؤلف أضاف على ذلك، اعتمادا على عمل البلاغيين القدماء، مكونين غير نصيين، هما: الذاكرة والإلقاء، فبذلك صارت مكونات الخطاب الإقناعي خمسة:
1- الإيجاد: مصادر الأدلة، أو مواضعها، أو جهاتها.
2- ترتيب أجزاء القول.
3- الأسلوب.
4- التذكر، أو الذاكرة.
5- الإلقاء.
ومما يُحمد للمؤلف أنه اقترح تعبيرا آخر للمكون الأول أقرب إلى فهم المتلقِّي، وهو ثقافة الخطيب، قال المؤلف: «يمكن أن نُقايض الإيجاد أو مصادر الأدلة بثقافة الخطيب، لأن أرسطو يقدِّم معرفة خاصة بالأنواع الخَطابية، ومعرفة عامة لكل الأنواع»(13).
قلت: هذا التعبير يمكن أن يُجمع تحتَه كثير مما يُعبَّر به عن المكون الأول، فالإيجاد أو مصادر الأدلة أو مواضعها أو جهاتها، أو الاستحضار، كل أولئك داخل تحت عبارة «ثقافة الخطيب»، فلا بد للخطيب من عُدَّة معرفية تُمكِّنه من إلقاء خطبته على السامعين، وهذه العُدة هي معرفته الشاملة بالموضوع، فالشاعر عند صناعته للقصيدة لا يصنعها وهو خِلْوٌ من المعرفة، وإنما يُبدع ما يُبدعه اتكالا على ثقافته التي يملكها، وأكثر الشعراء يبني على مَن تقدَّم عليه، فالزَّاد الشعري يكون بحفظ كثير من الشعر والبناء عليه عند القول.
هذا، ويمكن إرجاعُ هذه المكونات الخمسة التي أوردها المؤلف على أنها مكونات الخطاب الإقناعي كما عند أرسطو إلى مكونين أساسيين: ثقافة الخطيب، والأسلوب، وبيان ذلك كالآتي:
– أما ثقافة الخطيب فتعبير جامع يدخل تحته الإيجاد ومصادر الأدلة وجهاتها أو مواضعها، والاستحضار، والذاكرة أو التذكر.
– وأما الأسلوب فيدخل تحته ترتيب أجزاء القول والإلقاء، فكل ذلك داخل تحت مُسمَّى إيصال الفائدة للمتلقّي بطريقة ما.
جوهر الخطاب الإقناعي:
يقول المؤلف: «إننا حين ننظر إلى القضية الجوهرية في الخطاب الإقناعي، وهي قضية المقام الخطابي وملاءمة الخطاب للأحوال اعتمادا على ثقافة اجتماعية ونفسية، بما تتضمنه من بحث في العادات والقوانين والشرائع والطبائع والأقيسة والاستدلالات، وعلاقة كل ذلك بالوسائل الأسلوبية …»(14).
قلت: عبارة أهل هذا الفن أوجز من عبارة المؤلف حين قالوا: البلاغةُ مطابقةُ الكلام لمُقتضى الظاهر. فالخطاب الإقناعي هو بلوغ المتكلم مُراده من السامع، وهذا الغرض يمكن التعبير عنه بهذه العبارة.
ثم قال المؤلف بعدها: «… سنُلاحظ أن كتاب فن الخطابة قد دَعَّمَ أيضا مفهوما كبيرا كان يُناسب البلاغة العربية الكلاسيكية المحافظة، هو مفهوم الاعتدال والمناسبة المحققين للوضوح والمتعة الناتجة عن حد أدنى من الإغراب»(15).
وهذا من خصائص الخطاب عامة، وقد عبَّر عنه المؤلف بقوله: «وتقوم هذه الخصوصية الخطابية على وسطية بين الابتذال العامِّي والسموّ إلى الإغراب والغموض الشعري»(16).
وعلى ذلك، يمكن جعل الأسلوب الخطابي في مستويين، مستوى الابتذال بالعبارة إلى العاميَّة، ومستوى الارتفاع به إلى الغموض والإغراب الشعري. لكنَّ هذه التقسيم يُعارض ما قدَّمناه آنِفًا من كون البلاغةِ مطابقةَ الكلام لمقتضى الظاهر، فأيّ كلام ينبغي فيه التَّحَرُّزُ من مُجانبة الصواب المقاميِّ، لذلك وجب أن يكون هناك
مُسْتَوًى وَسَطٌ بين هذه المستويين، وهو ما عبَّر عنه ابن سينا بأنه «المُسْتَوْلِي»، وهو ما وقعَ وسطا بين الأسلوب المنحطِّ إلى درجة المُسترذل، والأسلوب المُوغِلِ في الإغراب، أي: هو ما كان مُطابقا للواقع يعرفه أوساط الناس من غير حاجة إلى إعمال الفِكر فيه.
وللإشارة، فهذا الأسلوب الذي عبَّر عنه ابن سينا بالمُستولي هو الذي سنجد امتداده عند ابن سنان في كتابه «سر الفصاحة»، فإنه انْبَنْى على اطِّراح الألفاظ المسترذلة والحوشية الموغلة في الإغراب.
مشروع السكاكي في «مفتاح العلوم»:
قدَّم السكاكي مشروعه في كتابه «مفتاح العلوم» مبنيا على علمين جعلهما أصلا، هما علم المعاني وعلم البيان، وهما مؤتلفان من مجموع العلوم المشتركة فيما بينها، إنهما تركيب من علوم اللغة والمنطق، تحت مُسمى «علم الأدب»، والغرض من هذا العلم عند السكاكي ما قدَّم به كتابه قائلا: «والذي اقتضى عندي هذا هو أن الغرض الأقدم من علم الأدب لما كان هو الاحتراز عند الخطأ في كلام العرب…»(17).
فدلَّ بكلامه على أن علم الأدب اسمٌ جامع لكل ما يُتوصل به إلى إنشاء الكلام على سَمْتِ العرب، وموافقتهم في قواعدهم، وإنما يكون ذلك بكل علمٍ من شأنه أن يكون مُبَلِّغا لك إلى هذا الغرض.
وقد جعل السكاكي كتابه ثلاثة أقسام:
– قسم في علم الصرف: ويشمل اللفظ المُفرد.
– قسم في علم النحو: ويشمل اللفظ المركب.
– قسم في علمي المعاني والبيان: ويمكن اعتباره تركيبا منهما.
مستويات علم الأدب عند السكاكي:
جعل السكاكي علم الأدب على مستويات يُحددها الغرضُ من تعاطي هذا الفنّ، وقد نقل عنه المؤلف نصا في هذا الشأن، يقول فيه: «واعلم أن علم الأدب متى كان الحاملُ على الخوض فيه مُجَرَّدَ الوقوفِ على بعض الأوضاع وشيء من الاصطلاحات، فهو لديك على طرف الثُّمَام. أما إذا خُضت فيه لِهِمَّةٍ تبعثك على الاحتراز عن الخطأ في العربية وسلوك جادة الصواب فيها اعترض دونك منه أنواع تلقى لأدناها عرق القربة، لا سيما إذا انضم على همتك الشغف بالتلقي لمراد الله تعالى من كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهناك يستقبلك منها ما لا يبعد أن يرجعك القهقرى»(18).
يمكن أن نخرج من هذا النص بمعرفة مستويات علم الأدب التي ذكرها السكاكي في كلامه، فنقول: إنها لا تعدو أن تكون ثلاثة مستوياتٍ: مستوى أدنى، ومستوى أوسط، ومستوى أعلى.
– المستوى الأدنى: يُكتفى فيه بالوقوف على بعض الأوضاع وشيءٍ من الاصطلاحات، وهو مستوى المعرفة الأولية بالموضوع.
– المستوى الأوسط: يُحترز فيه عن الخطأ في كلام العرب، وهو إنتاج نصوص سليمة على سَمْتِ كلام العرب في قواعدهم ومعهودهم في كلامهم، كما ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات.
– المستوى الأعلى: تلقِّي مُراد الله تعالى من كلامه، وهي مزيَّة إضافة للصواب في استعمال لغة العرب.
وقد خلَص المؤلف بعد ذلك إلى الفهم عن السكاكي في شأن علم الأدب، فقال: «الأدب يُساوي عنده، في نظرنا، الخطابَ السليم الناجع. من هذا المفهوم يتحدث السكاكي عن علم الأدب الذي نراه تصورا مبكِّرا لِمَا يُسمى حاليا علم النص. ونجد شبَها قويا بين مفهوم الأدب عنده ومفهوم الثقافة اليوم»(19).
قلت: كونُ الخطاب عنده الخطابَ السليم الناجع، عبارة قاصرة عن المُراد، إذ مُراد السكاكي أكثر من ذلك، فهو قريب مما ذكره المؤلف بعدُ من أن مفهوم الأدب عند السكاكي قريب من مفهوم الثقافة اليوم، لأن كلَّ مشتغل بعلم من العلوم إنما يُنسب إلى ذلك العلم، فيُقال للمشتغل بالنحو: نحوي، وللمشتغل بالصرف: صرفي، وهكذا في كل علم، إلا المتأدب أو الأديب، فإنه لا يصدق عليه الوصف إلا إذا كان مُحصلا لجميع تلك العلوم والمعارف، وقد ذكر مثلَ هذا الكلام مصطفى صادق الرافعي في بعض ما كتبه(20).
المشروع البلاغي لحازم القرطاجني في كتابه «منهاج البلغاء وسراج الأدباء»(21):
قدَّم المؤلف لعمل حازمٍ القرطاجني على أنه تكميلٌ لعمل الحكماء قبله الذين تناولوا موضوع «الشِّعرية»، ناظرا في الكُليات لتوسيع النظرية العامة للشعر لتشمل الشعر العربي أيضا، وذلك بزيادة قوانين تستوعب الخصوصية العربية.
لهذا، لا يُنظر إلى عمل حازم على أنه خوض في جزئيات هذا الفنِّ، وإنما هو مشروع كُلِّي يتجاوز مستوى الظاهر إلى مستوى ما بعد الظاهر، وهو القوانين الكلية، قال حازم: «وقد تكلم الناس في ضروب المطابقات وبسطوا القول فيها، فلا معنى للإطالة، إذ قصدنا أن نتخطى ظواهر هذه الصناعة وما فرغ الناس منه إلى ما وراء ذلك مما لم يفرغ منه»(22).
بعد ذلك أخذ المؤلف في ذكر أقسام كتاب حازم، وهي: اللفظ والمعنى والنظم والأسلوب، قال المؤلف: «وليست هذه الأقسام الأربعة شيئا آخر غير عناصر المحاكاة في الشعر»(23).
وهو ما صرَّح به حازم في كلامه، قال: «والتخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء: من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزن»(24).
فالثاني فرع عن الأول، والرابع فرع عن الثالث، فقد قال حازم: «فالأسلوب هيأة تحصل عن التأليفات المعنوية، والنظم هيأة تحصل عن التأليفات اللفظية»(25).
والأسلوب في نظر المؤلف هو درجة تحول العلاقات الدلالية إلى هيأة مخصوصة متميزة، والنظم هو درجة تحول العلاقات اللفظية إلى أشكال نصية مخصوصة. فالمعاني والألفاظ أمور بسيطة، والأسلوب والنظم أمور مركبة، فهما مستويان في دراسة هذه الصناعة، مستوى الجملة، ممثَّلا في اللفظ والمعنى، ومستوى النص، ممثَّلا في الأسلوب والنظم.
مآخذ المؤلف على عمل حازم:
– التفريق بين اللفظ والمعنى.
– التفريق بين النظم والأسلوب.
– التفريق بين الجملي والنصي.
– تداخل مناهج الكتاب.
وفي هذا القسم الأخير انتقد المؤلف على حازم في كتابه تداخل بعض مناهجه التي جعلها حازم أربعةً تحت كل قسم من أقسام الكتاب، وهو تقسيم في رأي المؤلف «مفتعل غيرُ مقنع»، يؤدي إلى التكرار في بعض أجزائه.
كما انتقد المؤلف على حازم في كتابه طول العناوين التي وضعها، فبعضها يستغرق ثلاثة أسطر، وهو أمر يرجع في نظر المؤلف إلى «محاولة تضمين عدة مداخل في عنوان واحد بالإلحاح دائما على البنية والوظيفة».
قلت: قد لا يكون الأمر كما ذكر المؤلف، فإن التكرار الذي ذكره قد لا يعدو أمورا يسيرة، والحاصل أنَّ ما عدَّه المؤلف تكرارا قد يعُدُّه غيرُه توسُّعا في الموضوع، وهذا أمرٌ مقبول إذا استدعى المقامُ ذلك. وكذلك الشأن في العناوين، فإنها وإن كانت تطول في الغالب، فهي تنطوي على الغرض منها بالتفصيل، فقد يخرج القارئ بمُؤَدَّى الفصل الطَّويل بمجرد قراءة عنوانه.
المنجز: الرؤية الشعرية عند حازم:
يرى المؤلف أن حازما في كتابه حاول الحسمَ في مبحث تعرَّضَ له مَن قبلَه، كالجرجاني وابن سنان، وهو أساس الشعرية، وفيه عرض حازم موقفه من الصدق والكذب في الشعر وتعويض ذلك بالتخييل، يقول: «وإنما احتجت إلى إثبات وقوع الأقاويل الصادقة في الشعر لأرفع الشُّبْهَةَ الداخلة في ذلك على قوم، حيث ظنوا أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة، وهذا قول فاسد قد رده أبو علي ابن سينا في غير ما موضع من كُتبه، لأن الاعتبار في الشعر إنما هو التخييل في أي مادة اتفق، لا يُشترط في ذلك صدق ولا كذب، بل أيهما ائتلفت الأقاويل المخيلة منه فَبِالعَرَض، لأن صنعة الشعر هي جودة التأليف وحسن المحاكاة، وموضوعها الألفاظ وما تدل عليه»(26).
فالتخييل الذي عَدَّهُ حازم واقعا من أمور، هي: المعنى والأسلوب واللفظ والنظم، هو الأساسُ التي تُبنى عليه الشعرية من غير اشتراط صدق ولا كذب، لأن ذلك لا يُطلب من الشاعر، وإنما الذي به يُحكم على الشاعر هو وقوع هذه التخييلات مواقِعَها. لذلك لم يُستحسن الإكثار من الإقناع في الشعر، ولم يُستحسن الإكثار من التخييل في الخطابة، قال حازم: «وينبغي ألا يُستكثر في كلتا الصناعتين مما ليس أصيلا فيها، كالتخييل في الخطابة، والإقناع في الشعر، بل يؤتى في كلتيهما باليَسير من ذلك على سبيل الإلماع»(27).
* * *
* بعض المآخذ على الكتاب:
– حشد كثير من الفصول في سَرد مضامين كتب العلماء، فإن المؤلف عَرَض في كتابه هذا لكثير من كتب العلماء المتقدمين في البلاغة عامة، أو فيما يتصل بها من إعجاز القرآن أو غير ذلك، فتجده يذكر مضامين هذه الكتب في كلام طويل كانت تُغني عنه الإحالةُ على فهارسها، والانتقال مباشرة إلى مناقشة الأفكار.
– البسط الكثير في عرض الأفكار، فإن القارئ يقرأ الكلام الكثير فيجده ينطوي على فكرة يمكن التعبير عنها بأقل مما عبَّر به المؤلف عنها، وقد أشرتُ إلى بعض ذلك في أثناء التعليق على بعض آراء المؤلف في الكتاب.
– بل أحيانا ينقل المؤلف كلاما لبعض العلماء المتقدمين، كابن قتيبة أو غيره، ثم يشرح مضمونه، فتجد كلامه أغمضَ من كلام العلماء الذين نقل عنهم.
– استعماله للخُطاطات في استنتاجاته أو تلخيصاته لمضامين الكلام المتقدم، فتجد هذه الخُطاطات تحتاج إلى شرح يُبَيِّن العلاقة بين عناصرها. وكثرتها لا تعني إحاطة صاحبها بالمعنى أو الموضوع.
ومما يحسُن التنويه به في الكتاب، دعوة المؤلف إلى عدم دراسة علم البلاغة بعيدا عن النقد والخصومات، أو ما يُسمى المعارك الأدبية، ومنها النقائض التي كانت بين جرير والفرزدق مثلا. فإن هذا من شأنه أن يخرج منه القارئ بكثير من الآراء النقدية التي قد تخدم البلاغة، وبه قد يُتَوَسَّعُ أحيانا في عرض المصطلحات والتمثيل لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
(1) انظر سيرته الذاتية الأولى «أشواق درعية»، والثانية «زمن الطلبة والعسكر».
(2) من حوار للمؤلف مع محمد الولي وإدريس جبري، منشور بموقع الدكتور محمد العمري على الشبكة الرقمية.
(3) انظر البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (28).
(4) انظر البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (12).
(5) انظر البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (12).
طبقات فحول الشعراء لابن سلّام الجمحي (1/46).
(6) رسائل الجاحظ، رسالة في حجج النبوة (1/229).
(7) الحيوان للجاحظ (1/76).
(8) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (235).
(9) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (231).
(10) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (232).
(11) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (254).
(12) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (272).
(13) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (273).
(14) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (277).
(15) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (277).
(16) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (278).
(17) مفتاح العلوم للسكاكي (8).
(18) مفتاح العلوم للسكاكي (7).
(19) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (481).
(20) قال في كتابه «تحت راية القرآن» (61): «فقد يُقال للعالم باللغة: لغوي، ولصاحب النحو: نحوي، ولمن يَقرض الشعر: شاعر. وبالجُملة، يُنسب كُلُّ ذي علم إلى علمه، إلا الأديب، فلا علم له إلا مجموعُ تلك العلوم وإحسانُ المُشاركة فيها جميعا».
(21) أُشير إلى أن كتاب «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لحازم القرطاجني وصلنا مبتورا، فقد سقطت المقدمة والقسم الأول، وهذا الأمر يُحوج القارئ إلى الاجتهاد في معرفة ما وقع فيهما من خلال ما وصلنا منه، فالمقدمة يضع فيها المؤلف الخطة العامة للكتاب، وبِضَياعها يضيع شَطر الفهم عن المؤلف.
(22) منهاج البلغاء (46).
(23) البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها (500).
(24) منهاج الأدباء (79).
(25) منهاج الأدباء (327).
(26) منهاج الأدباء (71).
(27) منهاج الأدباء (326).