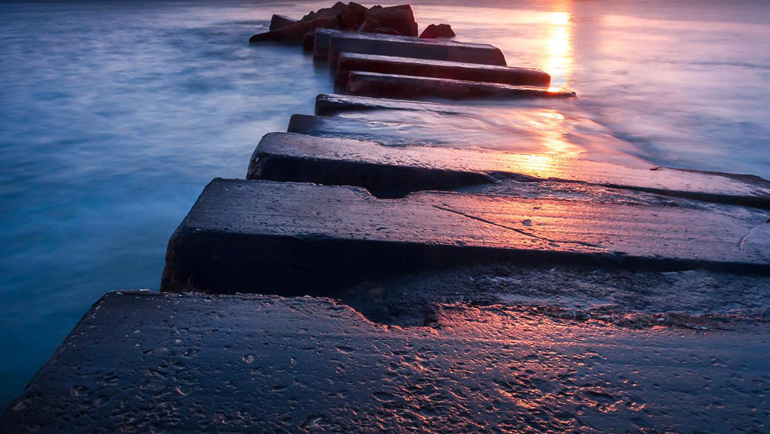
إشكال الثقافة الدينية والواقع الذي نعيشه إشكال عويص ودقيق، ومهمل أيضا… والخطأ طبعا في الإهمال؛ لأن وجود المشكل من طبيعة الحياة ومن ضروراتها، لكن العيب كلَّه في عدم الانتباه إلى المشكل ومناقشته.
بين الثقافة الدينية السائدة وبين ما نعيشه اختلاف كبير، بل تناقض صارخ… ومع ذلك نَغيبُ في ثقافتنا ونستمر معها ولا نفتح أيَّ مجال لربطها بالواقع لكي نرى ما الذي يحتاج إلى الإصلاح: الواقع أم الثقافة أم هما معا؟!
وأود أن أشير إلى بعض العناصر التي تُشكِّل، في نظري، هذه الثقافة السائدة، وإلى عناصر من الواقع المعيش.
أولا: من عناصر الثقافة السائدة
1. فكرة المجتهد
فكرة المجتهد كما كانت متداولة في أصول الفقه ما نزال نرددها وندرسها بنفس التصور والمعنى والدلالة… لا نعترف لأحد بصفة “مجتهد” ولا وسيلة عملية لاكتساب هذه الصفة، وفي ذات الوقت نسند إلى المجتهد كل شيء وحلّ جميع مشاكل الحياة.
وبالإضافة إلى ذلك نتجاهل أن المجتهد بمفهومه الأصولي من المتعذر أن يكون مصدرا لإنتاج الأحكام الملزمة التي تنظم المجتمع في الواقع الذي نعيشه بمرافقه المتشعبة، وملابساته التي سأشير إلى بعضها.
والسؤال هو: لماذا لا نفكر في كل هذا ونعيد التحليل لمصطلح “المجتهد” مفهوما وآثارا؟!
قد يكون للسابقين عندما أسندوا إلى المجتهد أمر صياغة الأحكام الشرعية ما برّروا به هذا التوجه، لكنه في وقتنا الحاضر نعلم علم اليقين أنه من المستحيل أن يُنظَّم المجتمع برأي فرد. وعندما أتحدث عن نظام المجتمع فأقصد به ما يُعرف في الفقه بالمعاملات وليس العبادات.
2. طبيعة الرأي الاجتهادي
العنصر الثاني السلبي، في نظري، في ثقافتنا الدينية هو طبيعة الرأي الاجتهادي، فبالرغم من قول الأصوليين إن الرأي الاجتهادي رأيٌ ظني؛ لأنه مجرد تفسير لنصوص تحتمل أكثر من دلالة، فإنهم عندما عرّفوا الفقه قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية… فوضعوا العلم مكان الظن! وكان ذلك، في اعتقادي، غير دقيق وغير سديد؛ لأنه لو بقي الرأي الاجتهادي على وصفه الأصلي، وهو أنه ظنيٌ، لسهل فتح المجال لمراجعته. لكن عندما نضفي عليه الصفة العلمية واليقينية تبقى مراجعته بعيدة المنال؛ خصوصا بعد أن أضيف إلى هذا الوصف العلمي القول بأن المجتهد إما أنه يكتشف أحكام الله الأزلية، وهذا هو رأي المُخطئة، وإما أن رأيَه يتبَعهُ حكمُ الله، أي عندما يصل المجتهد إلى حكم فإن الله سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، يوافقُ على هذا الرأي، وهذا هو رأي المُصوبة!
أعتقد أن كلا الرأيين كان خطيرا جدا؛ لأن إضفاء صفة حكم الله الأزلي، عند المخطئة، أو الموافقة على رأي المجتهد، عند المصوبة، انتهى إلى الاعتقاد بأن هذه الأحكام هي أحكام الله، وأحكامُ الله لا تُراجع ولا تُناقش، فبالأحرى أن يأتيَ التفكيرُ في تغييرها! وهذا هو سببُ جمود الأحكام الفقهية قرونًا طويلة، وما تزال على نفس النهج. فالوصف كان غير دقيق، إن لم أقل كان خاطئا، وكان يجب أن يبقى رأي المجتهد رأيا ظنيا وفق ما يتفق على ذلك الأصوليون، لكن عندما انقلب الظن إلى علم وإلى اكتشاف لحكم الله، انتقل من وصف “الرأي” إلى وصف “الحكم الأزلي الإلهي”.
3. تمكُّن التقليد
لمّا أضيف إلى وصف الرأي الاجتهادي بحكم الله نشوءُ المذاهب تَمكَّن التقليدُ من الأمة الإسلامية، وأصبح هو السلوك السليم والسائد، وأضيف إلى الإسلام خطأً عندما أُدمج في أصول الفقه بابٌ خاص بالتقليد يُلقّن فيه الدارسون أن كل من لم يصل درجة الاجتهاد ملزمٌ شرعا بالتقليد. فبالرغم من الحديث الكثير عن الاجتهاد سيما منذ ما سُمي بعصر النهضة، أي: أواخر القرن التاسع عشر الميلادي إلى يومنا هذا، حيث أصبح الحديث عنه يملأ الصحف والكتب والدروس والمحاضرات والندوات واللقاءات…، بالرغم من كل ذلك لم يُوجد منهُ شيء؛ لأن مبدأ التقليد ترسَّخ واستولى على عقل الأمة الإسلامية.
وكمثال على ذلك مدونة الأسرة المغربية التي صدرت منذ حوالي أربع سنوات[1]؛ قرأنا مقالات وفتاوى عن الولاية في الزواج، ونفاذ الطلاق المعلَّق أو الطلاق وقت الغضب أو الطلاق بأي صيغة من الصيغ التي يتحدث عنها الفقه، وبصحة عقد زواج ولو لم يُوثَّق… وعندما تُكتب هذه الفتاوى وتُنشر في صحفٍ مغربية وتقولُ للناس هذه أحكام الله… فمعنى هذا أن تلك الأحكام التي صدرت في المدونة هي خارجة عن “أحكام الله”! إنه التقليد الذي أصبح عقيدة غير قابلة للمناقشة وحوار العقل والمنطق.
منذ أيام فقط قرأتُ فتوى تتعلق بتعدد الزوجات. زوج يقول في سؤاله إنه متزوجٌ منذ سنوات بامرأة، ولكنه لم يُرزق ولدا، وعندما عرض نفسه على الطبيب تبين أن الإخصاب لديه ضعيف، ولذلك لم يُرزق ولدا.. وأكَّد أن زوجته تعامله معاملة حسنة، لكن والده قال له تزوج ثانية لعل الله يرزقك بأولاد، وأن زوجته لما علمت بهذا طلبت منه أن يطلقها إذا أراد أن يتزوج ثانية.اهـ. فكان جواب المُفتي (وهذا هو الغريب جدا) أنه قال: التعدد حكمٌ من أحكام الله ولا تدخُّلَ فيه لمخلوق، وزوجتكَ لا حق لها في أن تطالب بطلاق إذا تزوجت.
معنى هذه الفتوى أن ما قررته المدونة هو تدخُّلٌ في أحكام الله ومخالف لها. وهل يقول غيرُ هذا أولئك الذين نسميهم بالتيارات المتطرفة الذين يحكمون على المجتمعات الإسلامية بالكفر، لأنها -في رأيهم- تحكمُ بغير ما أنزل الله..؟! وتقييدُ التعدد موجود في القرآن نفسه، والفقهُ كلُّهُ يقول إن المباح تعتريه الأحكام الخمسة، وفوق ذلك أيضا يقول الفقهُ جميعُه إن لولي الأمر أن يُقيِّدَ المباح. فكيف يُقال إن تعدد الزوجات هو حكم من أحكام الله التي لا تَدخُّل فيها للإنسان، ويَحرم على المرأة الأولى أن تطلبَ الطلاق إذا أُريد الزواج منها!
في الولاية في الزواج والطلاق المعلَّق مثلا أخذت فيهما المدونة برأي فقهي معروف في الفقه منذ قرون، ومع ذلك يستمر الإصرار على الإفتاء بالرأي الذي كان ساريا قبل صدورها.
كلُّ هذا يدل على أن التقليد قد تمكَّن من الأمة الإسلامية إلى درجة مؤلمة بالرغم من الأحاديث التي نقرأها صباح مساء عن الاجتهاد.
4. أدوات التفسير الاجتهادي
عندما نرجع إلى أصول الفقه نجد أنَّ أدوات التفسير الاجتهادي تتعلق بالضوابط المتعلقة بالدلالة اللغوية للنصوص. وهذه الدلالة لا تعني إلا النصوص الخاصة أو الجزئية، ولا علاقة لها بالكليات أو المبادئ العامة؛ فالعدلُ مثلا ليس له دلالة لغوية، وإنما له دلالة عقلية… فكان من المنطق أن الذي يتخصص في أصول الفقه إنما يتخصص كذلك في تفسير النصوص الجزئية دون النصوص العامة (المبادئ) مثل: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)؛ فمفهوم العسر أو اليسر ليس مفهوما لغويا، ولكنه مفهوم عقلي.
عندما تبين أن تلك الضوابط لا تُسعف على التشريع في جميع المجالات، لجأ بعض الأئمة إلى استعمال ما سُميَّ بوسائل الاستدلال كالاستحسان والمصالح المرسلة، أو مبدأ “درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة”… هذه المبادئ ما كان ينبغي أن يكون التقرير فيها من لدن فرد وإن يكن مجتهدا؛ لأن هذه المبادئ العقلية عندما يُراد تطبيقها على الحياة الاجتماعية يتطلب الأمر الكثير من المعرفة بالواقع الاجتماعي وبملابساته، فضلا عن المعارف التي تساعد على تحقُّق مفهوم المبدأ.
فعلى سبيل المثال، نريد أن نُنظِّم عقودَ الكراء. فهل يُتصور أن نسند إلى فرد ليقوم بوضع هذه القواعد التي تحققُ العدالة بين المالك وبين المكتري وتحافظ على مصالح المجتمع؟
ومثلُ ذلك عقدُ العمل الذي تتجاذبه جوانب كثيرة: الموازنة بين حقوق العامل وحقوق رب العمل، وهنالك الجانب الاجتماعي والاقتصادي؛ لأن الأجر مثلا يدخل في التكلفة، والتكلفة يؤديها المجتمع… ثم مجالات العمل؛ فقد يكون هنالك مجالٌ ينبغي أن يشجع الإنتاج فيه؛ لأن المجتمع في حاجة إليه والعكس صحيح.
إذا أردنا أن نضع قانونًا للضرائب… هل يُعقل وهل يتصور أن يُسند إلى فرد “مجتهد” يعتمد مبادئ العدل والمساواة وعدم الظلم صياغة هذا القانون، فيعيّن الحد الأدنى لفرض الضريبة عشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر مثلا! ونسبة الضريبة خمسة في المائة أو أكثر أو أقل! وحدة الضريبة أو تعددها، ضريبة ثابتة أو تصاعدية، المجالات التي ينبغي أن تُُعفى من الضريبة بسبب مصلحة اجتماعية؟!
والخلاصة أن أكثر ما نحن في حاجة إليه من أحكام ونظم تشريعية، مصدرها كليات الشريعة ومبادئها؛ لأن النصوص الخاصة أو الجزئية قليلة جدا، ولاسيما في القرآن الكريم.
إذن، لمَّا تكلم الأصوليون على ضوابط أصول الفقه كان ينبغي أن يقتصر اجتهاد الفرد، باعتباره متخصصا، على استعمال تلك الضوابط.. وهو لا يستعملها إلا في النصوص الجزئية وليس في الكليات. فلما أُعطي لفردٍ إصدار الأحكام في جميع مرافق المجتمع وقع الخطأ؛ فشرعت أحكام لم تكن سليمة، وزاد من آثارها السلبية استمرارُها في الزمن نتيجة تكييف هذا الرأي الاجتهادي بحكم الله الأزلي.
5. المخاطَب بأحكام الشريعة
عندما نرجع إلى أصول الفقه نجد أن المخاطَب بأحكام الشريعة هو الفرد وحده، وهذا في اعتقادي كان خطأ كبيرا. صحيح أن هناك أحكاما موجهة إلى الفرد، وتتجلى بصورة أساسية في العبادات وكثير من أنواع السلوك في مجال المعاملات. لكن مصالح الحياة لا تقتصر على الفرد وحده، وإنما هنالك مصالح للمجتمع.
هذه المصالح التي نسميها بالمصالح العامة أعطاها الأصوليون وصف “فروض الكفاية”. وقصدوا بها جميع مصالح الأمة من الحاجات الأساسية، كتوفير المواد الغذائية وشبكة الطرق وموارد الماء… إلى المرافق التي يُخطط بها المجتمعُ للمستقبل… كلُّ هذه دخلت في فروض الكفاية عند الأصوليين!
فتوفير المواد الاستهلاكية أو ممارسة التجارة والمهن جميعها من نجارة وحدادة… هي من فروض الكفاية. وأكثر من هذا نجد أن “المعرفة” تم إدراجها أيضا ضمن فروض الكفاية. حيث نجد الأصوليين يقولون مثلا بالنسبة للطب والرياضيات وحتى العلوم الشرعية، إن هذه العلوم ليست واجبة على العين ولكن مفروضة على سبيل الكفاية، بمعنى أنها مطلوبة من أفراد الأمة كلِّهم، ولكن على أساس إذا قام بها البعض سقطَ التكليفُ عن الباقي، وبذلك أدمجوها في خطاب التكليف، والذي يعني أن الفرد يخاطَب بها بعد سِنِّ التكليف… فعندما يصل الفرد إلى هذه السن ينظر في مدينته أو في بلده كله ليرى، مثلا، هل هنالك العدد الكافي من النجارين أو الأطباء أو الفقهاء… أو يذهب لتعلم النجارة أو الطب أو الفقه؟[2].
إلى الآن ما نزال ندرس في أصول الفقه هذا التصور، ولا ننظر ما يحدث أمامنا وهو أنَّ تعلّم الطب أو الهندسة وسائر التخصصات الأخرى يتطلب تكاليف باهظة وتخطيطا للتنفيذ يستحيل على الفرد إنجازه.
إننا نقول في أصول الفقه للمسلم: إن ما يطلبه منك الإسلام أيها المسلم عندما تصل إلى سن التكليف أن تنظر ما هي الحاجات داخل المجتمع؛ إذا رأيت خصاصًا في إحداها، ولم يقم بها غيرك، وجب عليك القيام بها…!
هذا المشكل المتعلق بفروض الكفاية كان ضربة قاصمة؛ لأنها حرمت المجتمع من الشعور بالمسؤولية عند بناء مصالحه والتخطيط لمسيرته بين الأمم. بل حتى مرفق “المعرفة” بقي موكولا إلى الأفراد، وهو ما ساعد على انتشار الأمية ورسوخ الجمود والتقليد، وإلى الآن ما نزال أكثر أمم الأرض أمية وفي مؤخرة المجتمع الإنساني معرفة وعلما. وأعتقد أن هذا الجانب التاريخي والثقافي قد ترك بصماته على عقولنا وتفكيرنا.
ولولا نظام الأوقاف لانتهى المجتمع الإسلامي منذ زمن أو كاد؛ فالوقف هو الذي تمكَّن من إنقاذ ما أمكن إنقاذه، وحافظ على تقديم عدد من الخدمات الضرورية للمجتمع الإسلامي؛ بدءًا من المسجد وإصلاح الطرق وإغاثة المسافرين والأيتام والمحتاجين، وفي وقت المجاعة… وهو الذي ساهم أيضا في توفير إمكانيات للراغبين في التعلُّم؛ سواء كانوا مدرسين أو طلبة.
تكييف مصالح المجتمع وحاجاته بفروض الكفاية المخاطب بها الأفراد، تسلسلت منه نتائج سلبية عديدة. من أهمها:
ـ إعفاء الأفراد من أي التزام مالي لبيت المال الذي تتكون موارده من أموال “الكفار”.
ـ الإفتاء بأن أموال المسلم لا تجب فيها إلا الزكاة التي لها مصاريفها الخاصة المعروفة، والذي أجازوا لولي الأمر أخذ “المعونة” قصروها على حالات تمويل الجهاد أو الاستعداد له.
ـ بيت المال لا يصرف منه على المصالح العامة إلا إذا وجد فيه فعلا فائض المال[3].
ـ انقطاع الموارد الخارجية وغياب التنظيم لموارد داخلية شرعية أديا إلى ارتكاب مظالم في الجبايات العشوائية التي التجأ إليها الحكام السياسيون، وهو ما قابله الفقه بإعلان عدم شرعية هذه الجبايات.
هذا الموروث الثقافي هو ما جعلنا إلى اليوم ننظر إلى الضرائب بوصفها غرامة تُلزمُ بها السلطةُ المواطنَ بدون حق[4]… ومما يُصدِّق هذا أننا إلى الآن لا وجود لدينا لجريمة تُسمى في المجتمعات الأخرى بـ”التهرب من الضريبة”.
في الثمانينات من القرن الماضي قُدِّم إلى البرلمان مشروعٌ لتجريم التهرُّب الضريبي، ورُفض من البرلمان مرتين. وفي سنة 1996 تمكَّن المشروع من الدخول إلى البرلمان، الذي ضمنه في القانون المالي 1996–1997 بتقرير غرامة مالية شكليا لحالات محدودة جدا من صور التهرب من أداء الضريبة.
قلنا إن التجريم كان شكليا؛ لأن القانون يقول: ترفع الشكايات بالمخالفات المعاقب عليها إلى وزير المالية الذي يجب عليه أن يعرضها على لجنة خماسية تتكون من قاض يرأسها وعضوين ممثلين لإدارة الضرائب، وعضوين ممثلين للملزمين بالضرائب يختاران من قوائم تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا. ويعين أعضاء اللجنة بقرار للوزير الأول.
بعد استشارة هذه اللجنة يمكن (نعم يمكن فقط) لوزير المالية أن يحيل الشكاية على النيابة العامة المختصة لإثارة المتابعة.
وإلى الآن لم يصدر قرار الوزير الأول بتعيين أعضاء اللجنة السالفة الذكر.
كلُّ هذا يُوضح الثقافة التي توارثناها، وهي أن الضريبة عبارة عن أخذ السلطة مالَ المسلم بدون حق! ولذلك قد تجد الإنسان ملتزما التزاما كاملا بأداء شعائره الدينية، ولكن “التهرب من الضريبة” يعتبره سلوكا عاديا… مع العلم أن في المجتمعات المتقدمة يُعتبر التهرب من الضريبة من الجرائم المُشينة التي تخدش القيم الأخلاقية، وتشكك في الإخلاص للانتماء الوطني. وعدم عناية الفقه بالمصالح العامة؛ تقريرا وتمويلا، ترك للحاكم السياسي مجالا للتصرف العشوائي؛ فنشأت مظالم… وبقي الفقه ينكر هذه المظالم، وسكن في تصور الناس وخيالهم أن كلَّ ما تأخذه السلطة هو جباية ظالم…
لا أقول إن المسؤولية تقع على الفقهاء وحدهم، لكن يمكن القول بأن المجتمع الإسلامي تم “تنويمهُ” بهذا التصور الثقافي الذي يقول بأن هنالك مجتهدا هو الذي يقرر وما على الآخرين سوى التقليد، وأن تحديد مصالح المجتمع وحاجاته وإنجازها موكول إلى الفرد إذا نفذ التزامه أثيب، وإذا لم يفعل أثم هو والآخرون…
6. دور العقل
كما هو معروف في النزاع الأشعري المعتزلي حول مسألة: هل أفعال الله معلّلة… نشأ مبدأ يقرهُ الأصوليون وهو أنَّ العقل لا يُحسِّن ولا يُقبِّح. ونشير إلى أن هذا ليس رأيَ كل الأصوليين، فالعز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام يقول إن مصالح الدنيا يدركها العقل. لكن هذا الرأي بقي هامشيا… وبقي استعمال عبارة “ما قرره الشارع فهو مصلحة” هو المهيمن. صحيح أن أحدا لن يجادل في هذه المقولة، ولكن نسبة كبيرة من التصرفات والوقائع التي نتناقش حولها لم يقل فيها الشارع إن هذه مصلحة أو ليست مصلحة… لم يقل الشارع إن المصلحة أن تكون الهيأة القضائية مكونة من ثلاث قضاة أو من قاض واحد! لم يقل الشارع إن الحد الأدنى من الأجر كذا وكذا! وهذا ينطبق على كثير من الأمثلة كتنظيم عقود الكراء وعقد العمل والضرائب والصحة والتعليم…
فمثلا عندما نريد أن ننظم قانونا للضرائب: هل سنلجأ إلى إحداث ضرائب تصاعدية أم لا؟ هل ستكون الضريبة موحّدة أم متعددة؟ وما هي المجالات التي يمكن أن تُخفَّف فيه الضرائب؟…
مثل هذه الأمور ينبغي أن نستعمل فيها عقولنا شرط أن لا نخرق مبدأ من المبادئ العامة التي نصت عليها الشريعة. ولكن لا نقول إن العقل لا يُحسِّن ولا يُقبِّح.
هذه بعض عناصر الثقافة السائدة، فماذا عن عناصر من الواقع؟
ثانيا: عناصر من الواقع المعيش
1. مفهوم الدولة
أول ما نلاحظ في هذا الواقع أن مفهوم الدولة قد تغير؛ حيث لم تعد عبارة عن أشخاص، وإنما هي مؤسسات ممثلة للمجتمع وتدير باسمه الشأن العام. فلماذا لا نناقش هذه التغيرات التي طرأت على الدولة؟ لا أقول إن كل ما طرأ على مفهوم الدولة صحيح، ولكن ما أقصده هو لماذا لا نواجه هذا الواقع ونناقشه!
2. حدود الدولة
من عناصر الدولة الحديثة قيامها على حدود ترابية وليست على الوحدة العقدية كما كان الأمر من قبل. وبالتالي لابد من أن نقول رأينا في الموضوع… ولا نبقى نتحدث عن “أهل الذمة” و”دار الإسلام” وما إلى ذلك من مصطلحات، بينما الواقع الذي نعيشه شيء آخر.
3. النظام الدستوري
الدولة التي نعيش فيها لها نظام دستوري من مكوناته الجوهرية أنه يقوم على:
أ. “مؤسسات” تتوزع بينها الاختصاصات في تدبير الشأن العام.
ب. تنظيم المجتمع وعلاقات الأفراد وحقوقهم والتزاماتهم يتم بنصوص قانونية صادرة عن المؤسسات المختصة، منشورة وقابلة للإلغاء والتعديل في أي وقت.
ج. أن ما تأمر به هذه النصوص هو “المعروف” وما تمنعه هو “المنكر”.
د. المساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات أيا كانت عقيدتهم الدينية أو الإيديولوجية.
4. اتساع مجال المعرفة
معارف الإنسان اتسعت بشكل غير مسبوق، وتفرَّعت إلى مئات التخصصات، وكلها تساهم في اقتراح وتطوير القواعد المنظمة لمرافق المجتمع وعلاقات أفراده، وهو ما يعني تعذر استقلال تخصص معين وبالأحرى فرد واحد بوضع تلك القواعد وإلزام الآخرين بالتقليد والتنفيذ.
5. النظام الدولي
العلاقات بين الدول تحكمها قواعد أفرزها تطور الفكر السياسي والمفهوم الحديث للدولة، يختلف الكثير منها إلى حد التعارض عن تلك الموروثة عن الدولة الثيوقراطية والعقدية.
6. مركز الفرد وحقوقه والتزاماته
نظام التعايش كان قائما على خضوع الفرد لسلطان المجتمع عقيدة وسلوكا، وفي رسم حدود كل ما له وما عليه. والآن تغير الوضع كثيرا، واتسعت الدائرة التي يستقل فيها الفرد بممارسة ما يشاء فيها من سلوك حتى أصبحت حقوقه وحريته من القيود الأساسية لصلاحية المجتمع في التنظيم والضبط.
7. العلاقة بالمخالف في الدين
كانت العقيدة الدينية أساس بناء المجتمع والعيش المشترك بين أفراده، وكان من التسامح المثالي قبول المخالف في الدين بشروط تمنعه من كثير من الحقوق التي يحتفظ بها المجتمع للمنتسبين إلى عقيدته. وحلت الآن المواطنة محل العقيدة، وتعرضت الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة لمنع أي تمييز بسبب الاختلاف في الدين، وصدرت عن الأمم المتحدة عهود واتفاقيات تقرر نفس المبدأ، صادقت عليها الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
هذه نماذج عناصر من ثقافتنا وأخرى من الواقع المعيش، بينها من التعارض والتضاد ما لا يخفى، ومع ذلك نصر على الاستمرار في إهمال الواقع ورفضه والتمسك بتلك العناصر الثقافية كما هي، ودون مناقشة للواقع ومشاكله.
هذا السلوك يعلم الجميع نتائجه التي وصّلت إلى العنف وخنق الحريات وسفك الدماء، فدعوتنا إلى المشتغلين بالدراسات الدينية تتلخص في تنزيل العناصر التي يقوم عليها فكر أصول الفقه على الواقع الذي يعيشونه، وبيان كيفية هذا التنزيل؛ وكل ذلك بالتحليل المنطقي وأسلوب الإقناع، والوسائل القابلة للتطبيق، وليس بأسلوب التبليغ والوصاية، أو التنظير الخيالي الذي لا صلة له بالواقع[5].
الهوامش
1. بعد أن صادق عليها ممثلو الأمة في البرلمان بالإجماع، وصدرت بظهير من “ولي الأمر” باصطلاح الفقهاء الذين يتفقون على أن أمره “يرفع الخلاف”، ومع ذلك نجد من ينكر شرعية بعض أحكامها التي أخذت فيها بالاجتهاد، أو برأي فقهي مخالف للرأي الذي كان منسوبا إلى المذهب الفقهي المعمول به.
2. أي تعلم أصول ومبادئ هذه المهن والعلوم، أما دقائقها فتعلمها مجرد فضيلة كما يقول الإمام الغزالي: “وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق قي دقائق الحساب، وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه”. إحياء علوم الدين، 1/28.
3. يقول الماوردي: مصارف بيت المال على ضربين: الضرب الأول “يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود… الضرب الثاني أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل، واستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم، فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين، وإن كان معلوما سقط وجوبه عن بيت المال، وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد، وإن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا، أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا، فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم، سقط وجوبه عن الكفاية لوجود البدل”. الأحكام السلطانية، ص: 214.
4. ونتائج هذا الرأي الذي عبر عنه الماوردي لا تحتاج إلى تعليق.
ولم يكن سبب ذلك اقتران فرض الضرائب بدخول الاستعمار، وإشرافه على إصدار قوانينها، وإنما السبب هو الفقه الذي عبَّر عنه المهدي الوزاني بقوله إن العشر يؤخذ من “أهل الذمة والحربيين الكفار، أما المسلمون فليس عليهم إلا الزكاة، هذا الذي نطق به القرآن وجاءت به الشريعة المطهرة”. الفتاوى الكبرى، 12/392.
وما يزكي ما قلناه موقف “العلماء” من ظهير 10 جمادى الثانية 1319 (24/8/1901) الذي أصدره السلطان عبد العزيز نظم به “الترتيب” (الضريبة)، وكيف اعتُمد هذا الظهير سببا أساسيا لتبرير خلعه وتنحيته وإعلان بيعة أخيه السلطان عبد الحفيظ بعد قبوله الشرط الأساسي وهو إلغاء “الترتيب”.
5. في عام 1884 أصدر الفقيه الألماني Ihering كتابا بعنوان “الهزل والجد في علم القانون، هدية عيد الميلاد إلى رجال القانون” انتقد فيه فقهاء مدرسة القانون التاريخية وعلى رأسهم مؤسسها سافيني، الذين يعتمدون في فقههم الأفكار المجردة البعيدة عن الواقع، وممَّا قاله: “إن بناء نظام من الأفكار منقطع الصلة بالنتائج العملية، يشبه تصميم ساعات فنية للزينة لا لقياس الزمن”، وتخيّل أنه مات وأن شبحا مضيئا حمل روحه إلى سماء الأفكار القانونية فعثر هنالك على أساطين فقه الأفكار في ليلة مظلمة بعيدا عن أشعة الشمس، يحاولون أن يستنتجوا من كل فكرة تسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين نتيجة، فصاح فيهم بكل قواه: “عودوا إلى الأرض، عودوا إلى مشاكل الحياة وصراع المصالح وغاية القواعد…”.







