منازل علم القراءات بين مدارج الرواية ومعارج الدراية
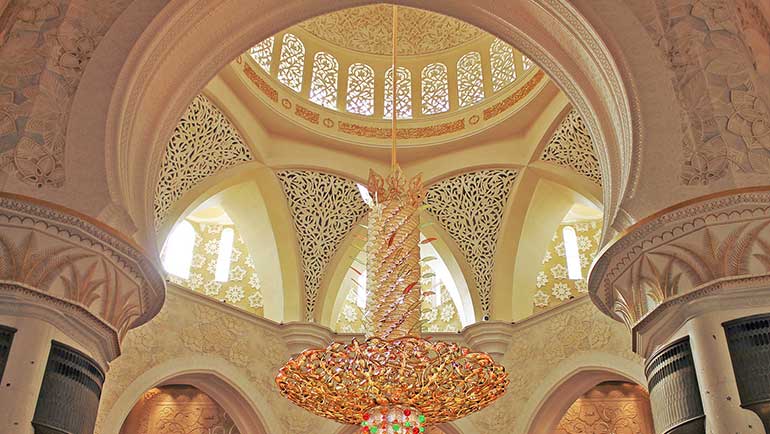
ديباجة:
الحمد لله المفتتح كلامه بحمده، المجري الألسنة به لفظا من عنده، الذي أنزل الكتاب ءايات بينات متلوة بالألسنة، باقية بقاء الأزمنة، محفوظة بتلقن الصدور، منتقلة في المصاحف من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم، محروسة من التبديل والتغيير والذهول، وشرائف صلواته على من شق الإيمان من إيمانه، ويسر القرءان بلسانه، واختير لأدائه وبيانه، صلاة زاكية ترضيه، وتوفي حقه وتقضيه،وعلى آله و صحبه الذين تمهروا في الكتاب، حين تحققوا بالوصفين وتجافوا عن اللحنين، فكانوا الحفظة الراوين، والفهماء الدارين، وعلى من اقتص سبيلهم من تبعهم إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فإنما تشرف الكلم بشرف قربها من الكتاب العظيم، وانتحائها سبيل الوصل بآياته وبيناته.. وهذه كلمة تبتغي من التنزيل الحكيم المودة في القربى، ورقبى المؤمل في العقبى، هذاالتنزيل الذي هو آية الرسالة الخاتمة، أوتيه خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، فهو به أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وإن من بينات هذه الآية وبصائر حجيتها، ومن أعظم المنة على الأمة في تيسير ألسنها بها، أن كان نصها المتلو ترحب جنباته لأَنْ تتعدد هيآت الالتفاظ بحرفه، وتذهب المذهب البعيد في تنوع وجوه نطق كلمه، في تعال متجاف عن مضايق التدابر والتناقض، أو متناكر الإحالة والفساد، بل إنها على وسمها التعددي المتكاثر تسمو في سماء الانسجام والتلفع بغاية التمام، صدقا في خبرها وعدلا في أحكامها، وتبوئ متنه المقروء مقامات سامية من كثار المعاني وكبائر الدلالات في رحاب اللغة والبيان، ومدارك الفقه والأحكام، ومتناول الإنشاء والإخبار.
وتأويل عنوان هذه الكلمة المتواضعة« منازل علم القراءات بين مدارج الرواية ومعارج الدراية» مـحاولة في لم شعث القول في كبر متعلق هذا الدرس القرائي، وتقريب مقاصد مشتمله في مقامي روايته ودرايته، في مسالك الإلقاء في منابره، وسبل التدوين في دفاتره، ومعلوم أن تصنيف مآخذ العلوم إلى رواية ودراية، إنما يرجع بمشروعيته إلى الكتاب الكريم، الذي إليه مرجع المعارف الشرعية وعلوم اللسان العربي؛ فهو بمقتضى كونه نصا، مهيؤ للتلاوة ومتعين للقراءة ومـجعول على سمت النقل والحفظ والتلقي والرواية:﴿اَوَلَمْ يَكْفِهِمُۥٓ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ اَ۬لْكِتَٰبَ يُتْل۪يٰ عَلَيْهِمُۥٓ إِنَّ فِے ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٗ وَذِكْر۪يٰ لِقَوْمٖ يُومِنُونَ﴾ [العنكبوت/51]،ومـجرد تلاوته تعبد وثواب وزكاة، خاصة إذا أخذت تلاوته على ما ينبغي من شرائطها ومقوماتها، ثم هو مطلوب على مراد التدبر ومرام الافتكار والادكار: ﴿كِتَٰبٌ اَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ اُ۬لَالْبَٰبِۖ﴾ [ص/28]،وهذا ترجمة الفقاهة والدراية، الذي يسلم إلى مراقي التزكية والتخلق بخلق القرءان العظيم.
وقد نفث القرءان في روع الأمة روحا وثابة خلاقة؛ لتكون أفئدتها موئلا أمينا لحفظ حرف الكتاب، الحفظ المتناهي في الضبط والإتقان، وتلفى ألسنتها على اللهج المستديم بتلاوة لفظه على منهاج الترتيل والترسيل، وتـجعل معاقل عقولها مراتع خصيبة، تثور فيه معانيه وتأوي فيها ضنائن دلالاته إلى غور سحيق من حر النظر ومعالي الفكر، لتتبرج بعد في زينة العرض وجمال الإلقاء ونظيم التأليف.
فالرواية والدراية إذا: فلقان متلازمان لا يفترقان؛ ولن يستقيم لطالب العلم القرائي وغيره التمثل الأمثل، وتحصيل الأنموذج الأكمل، حتى يصير إلى التشبع بهاتين الخصلتين، ويبلغ من حصيلتهما ـ على الأقل ـ ما يربو على القلتين، إفضاء إلى مقصد رعاية لازمهما، من الانضباط على وفقهما والسير على مقتضاهما، فيصح له عنوان الاندراج تحت قوله تعالى: ﴿اِ۬لذِينَ
ءَاتَيْنَٰهُمُ اُ۬لْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَٰوَتِهِ﴾ [البقرة/120]، ويكون أهلا لوصف العالم: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِے اِ۬لذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر/10]؛ إذ العالم على الحقيقة هو من أوغل في علم القرءان، لأن القرءان الكريم أصل كل علم، إليه مرجع مفرداته وعليه مستند كلياته، وإلا يكن القارئ على هذا المرتسم القويم فإنه يلحقه من العتب واللوم بحسب الإخلال في ذلك.
وقد جرت كلمة أهل الشأن القرائي في الإدلاء بدلالة هذا الأمر، على سبيل الإبانة والوفاء في الإيضاح، وإنما يقع الاجتزاء ههنا بكلمتين لاثنين من كبار أئمته وأساطينه؛ إذ كانا على تمام الكفاية وحسن البلاغ في هذا الموضوع:
أحدهما الإمام أبو عمرو الداني الذي قال في هذا السياق: « وقراء القرءان متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييزا، وهو الحاذق النبيه، ومنهم من يسمعه سماعا وتقليدا، وهو العيي الفهيه، والعلم فطنة ودراية آكد منه سماعا ورواية، وللدراية ضبطها وتفهمها، وللرواية نقلها وتعلمها، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم»[1].
ولصاحب الإقناع عبارة آخذة حظها من الحسن في تصوير تفاوت المراتب بين أهل الرواية والدراية، وذلك إذ يقول :« لكن ليس من أينعت له أيكة العلم فهو يهدب، كمن اقتصـر على رواية إليها ينتدب:
ذلك تمتع بالجنى، وتصرف بين اللفظ والمعنى، ودنا فتدلى، وكشف له عن أسراره فاجتلى.
وهذا خازن أمين أدى، وظرف باطنه عرف نضح بما فيه وأندى، فحسبك منه ما بدا ، وأن تجد على النار هدى، أما إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقت بنضـرته، وحدتك إلى حضرته»[2].
وقد انتظم النسق التعليمي في الكتاتيب والمحاضر في كثير البلدان، وفي بلدنا على وجه الخصوص، على وضع البرنامج التعليمي تتساند فيه مطالب علوم الرواية ـ حفظا ولقنا ـ إلى متون الدراية في مختلف الفنون ـ تبحثا وتفقها ـ؛ طلبا لاستكمال ثقافة القارئ المرجوة، وتحقيقا لحق التلاوة المبتغاة.
وإنما أعرض ههنا لفصول مجملة تجتلى في مساقاتها العامة مآخذ للرواية ومجالات للدراية في هذا العلم، وإنما يضطر العرض إلى الفصل بين المستويين تحت نظر الإلجاء المنهجي، وإلا فالتداخل بينهما قائم، و الفصل بين مطالبهما غير مستجاز ولا متصور، وهو الذي جعل العرض يأتي على المطلوب في قسمين تتصدر أولهما الرواية، وتأتي في عقبه الدراية.
1 ــ مدارج في فصول الرواية القرائية ومسالكها:
أما الرواية القرائية فربما تأتى أن ينظر إلى معالم تجلياتها وكبريات مظاهرها على تصنيف اعتباري في جملة مباحث:
أولا: باعتبار أصل النقل ومـخرجه:
فالقراءات هي وحي كريم، جرى تنزيل مفرداته في راجح القول في المرحلة المدنية، حين رخص للأمة أن تتلو الكتاب بما ينطاع به لسانها من لهجة مردت عليها، لا تستطيع عنها حولا، تحت عين الإقرار النبوي وبصره، وهذا الوحي مشمول بخبر التلقي المنوه به في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّي اَ۬لْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾[النمل/6]، فكان تلقيا مباشرا، وأخذا أمينا، وتحصيلا معصوما من شوب الخطإ وأثارة الخلل.
وقد أعطى هذا التلقي النبوي الإمام الرواية القرائية عنوانها العريض وشعارها العتيد، ورسم لها منهجها الفريد، فكان عنوانها التوقيف، وقوام منهجها القويم القائم هو الإسناد، معصومة من وصمة التقول والتزيد، متعالية عن شائبة الاختراع والابتداع.
وإذا كان معلوما أن «الإسناد من الدين »، وأنه من خصوصية هذه الأمة ومعالم فرادتها، فإن له في هذا العلم مزيد شفوف وفضل فضيلة، يتبوأ بها صدر العلوم الروائية كافة، ولا يمكن المجازفة بإمكان الاستغناء عنه بشبهة شيوع المادة العلمية في دفاتره ومدوناته؛ إذ لا يكتفي فيه بالنقل العام لكلم النص وجمله، حتى يلح في استصحاب خصوصية هيئة اللفظ وضبط كيفية أدائه، في وثاقة بالغة وأمانة عالية ودقة متناهية؛ لذلك تضيق مسالكه عن كثير من طرائق السماع ومراتب الرواية المؤصلة عند المحدثين[3]، ولا يتقبل منها بالقبول الحسن إلا ما ارتسم سبيل العرض والسماع؛ أو عرضا بين يدي الشيخ، أخذا من الأخذ النبوي الأول الذي كان يعتمد منهج العرض والسماع. فإن استجيز غيرهما في تحمل درسه فليس إلا على سبيل المتابعة والاستشهاد، لا بالأصالة والاعتماد، أو لتمام الفائدة ورعيا لحسن العائدة، بما لا يعود على الأصل بالنقض والإبطال، أو التساهل والابتذال.
ثانيا: مراتب الرواية بين الاعتبار وعدمه:
طبيعي، إذ كان مدار الأمر وملاكه في هذا الفن على النقل والسماع، أن تجعل الرواية منه على قاصية الاعتناء، وأن تجتنى من معينها ما يصلح ضابطا للقراءة المعتبرة، وتجتلى في مراتع أبحاثها ما هو مألوف عند أهل الرواية والتحديث من مطالب الرواية والإسناد، وطرائق التحمل والتحميل، وتنقاد فيها الأسمعة القرائية على قانون التصحيح والتضعيف، وتراد فيها نقلة الرواية على مأخذ التعريف والتدليل، والجرح والتعديل، وإن مما ينبغي التنصيص عليه هنا ذهاب القراء ـ صونا لمقام القرءان ـ الذهاب البعيد في التفريق بين التلاوة والحكاية، والقراءة والتحديث، مما لزم عنه ضرورة التفريق بين قرءان مقطوع على مغيبه، هو الذي حقه أن يتلى في المحاريب، ويرسم في الألواح والمصاحف،وتلهجه الألسن على سبيل التعبد والامتثال، وبين نمط من المقروء لم يسعف بما يضمن له استمرار وسم قرءانيته، فبقي لأثارة النسخ في أثره، واحتمال الضعف في مـخرجه، وشذوذ رسمه عن سواد المصحف الإمام، بمنأى عن جادة المتلو، ومعتبر المقروء. غير أنه بقي على هذا النظر، بمحل الاعتداد به في بابة الرواية، ومجال الإفادة الدلالية في آفاقها الواسعة: لغة وفقها وتفسيرا.
ولتقسيم الخلف القرائي: وجوبا وجوازا، وترتيب مستوياته : قراءة ورواية وطريقا، وجه وجيه في تأمل المسيرة الروائية عند القراء، تشهد لهم بالحفل الفسيح والبذل الرائد في هذه الناحية العلمية.
ثالثا:مادة الرواية وموضوعها:
مادة الرواية وموضوعها كلمات القرءان الكريم من جهة تأديتها على وفق المروي المتعدد المأثور، وتجري أحكام الرواية في عرف هذا العلم ومصطلحه منها على صنفين:
الأول: ما يسمى عندهم بـ«الأصول»، وهي الأحكام الكلية العامة التي تجري في نظائر ما ينطبق عليه شرط قاعدتها، اطرادا واستمرارا، والانكسار في بعض مثلها لا يذهب بكلية التقعيد فيها، وأمثلته وفيرة كثيرة كالإظهار الإدغام، والفتح والإمالة، والتحقيق والتسهيل والإبدال والحذف للهمزات…
الآخر: ويترجمونه بـ«الحروف أو الفرش»؛ وهي حروف قرائية متفرقة منبثة في تضاعيف الكتاب، تختلف القراء في طريقة تأديتها من غير أن يكون لها مرجع تقعيدي يصح أن تحال عليه مفرداتها؛ لا لشيء إلا لأنها في أنفسها مفردات عينية، تخبر عن حكمها في خصوص محالها وعند مثول شخوصها، وأمثلة هذا اللون أكثر وأوفر، ومن أقرب الأمثلة عليه: ﴿مَلِكِ يَوْمِ اِ۬لدِّينِ﴾[الفاتحة/3] و﴿نُنشِرُهَا﴾[البقرة/258]و﴿عِندَ اَ۬لرَّحْمَٰنِ﴾[الزخرف/18]وغير ذلك[4].
وقد يتجاذب هذين الضريين ما يصحح الانتساب لهما على صحة حمل ووجاهة تقدير؛ وذلك الكلمات التي لا تحتمل التقعيد لذاتها لتشخص أعيانها، فهي بذلك حروف، ولكن ورودها في تضاعيف القرءان الكريم على معيار التكرر، جعلها متعددة النظائر في أن تتلى على الصورة الأدائية الواحدة، وتجتمع في هيئة النطق المشتركة، فقام لها هذا الوضع مقام التقعيد، فتلحق بهذا الاعتبار بقسم الأصول، وذلك مثل: «هو» و«هي»، وكلمة «قرءان» و«القرءان»، وسين «يـحسب» مستقبلا، وكلمة «التوراة»، وشبه ذلك.
رابعا: مـجالات الرواية وفضاؤها:
وهو فضاء فسيح يأخذ منه الجانب اللهجي خلاقه الوفير، وتتناسل في رحابه ضروب من أنساب الأنحاء النطقية، ناظرة إلى متعلقات متنوعة من وسوم الإعراب، وتصاريف البنيات الصرفية، ويمكن أن نرصد من ذلك مثلا بعض الظواهر الأدائية مثل: اختلاف الأوزان إفرادا وتثنية وجمعا، واختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه ماضيا ومستقبلا وأمرا، وتنوع وجوه الإعراب من التحريك والتسكين وتباعض الحركات، والزيادة والنقصان، والقلب والإبدال، والتقديم والتأخير، واختلاف اللغات من الإظهار والإدغام، والتفخيم والترقيق، والفتح والإمالة.
خامسا: مـحل الإيداع وموطن الصون بين الصدر والسطر:
ليس بخاف أن مما مُنّ به على هذه الأمة، على وجه الخصوصية والتفرد، أن كان تنزيلها كتابا لا يغسله الماء، وأن جعل قرار آيات وحيها في صدور أشرافها ﴿بَلْ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِے صُدُورِ اِ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْعِلْمَ﴾[العنكبوت/49]؛ وكان صدر نبيها الأكرم أشرف وعاء لهذا الوحي الكريم، جمع له على موعود التثبيت الراسخ عريا عن عوارض النسيان والذهول، واستقر في الأمة أن أول علم الذكر إتقان حفظه، وأن التماس أسباب استظهار آي الكتاب حري بالتفاني في تطلبه وابتذال النفس والنفيس في إحرازه،فكان ما كان من أمر الحفظ والحفظة على مسار التاريخ إلى اليوم.
وقامت مدارس شهيرة، ودور للقرءان عديدة، وربط ومداشر ومـحاظر، تمحضت رعايتها لحفظ لفظ الكتاب، والتفنن في تثبيت رسومه ونقش جسوم حروفه، وفرز نص متشابهه.
وعرف للمغاربة حظهم الواسع في هذا المجال، وسطر التاريخ جهودهم بكثير الاعتزاز والفخر، فكانت كتاتيبهم المتكاثرة ومحاضرهم المتناثرة منابر حية ومدارس نافعة، خرّجت الفئام من الحفظة المستظهرين، والتمست لذلك الوسائل المقربة، والمناهج الميسرة؛ فكانت الأنصاص الضابطة لمتشابه التنزيل، والرمزيات المختصرة لطرائق مرويه وتصدير أوجهه، وغيرها مما أفضى إلى تخلق أدب متكامل ونسق متراص في أدبيات تحفيظ القرءان وتلقينه، يصح بكثير من الاعتبار أن يجعل قبلة للاستهداء ومراما للاقتداء.
على أن هيمنة القرءان الكريم على الكتب السوالف، جعله متحققا بوصفها، زائدا عليها من وسوم الكمال ما يجعله على الحظة الخاصة، والخاتمية المتفردة؛ فكان وصفه بـ«الكتاب» إيذانا بأن من حقه أن تتأيد أحرف وحيه ـ إلى جنب حفظه واستظهاره ـ بالتسطير والترسيم؛ فكانت كتابة الوحي لم تنفك عن روايته منذ بدايات التنزل، وتخصص في الأمر كتبة معروفون نيفوا على الأربعين، كانت صحائفهم مع حصائد المشافهات الوثيقة مرجع المشروع الصديقي في جمع آي التنزيل، حين نادى الداعي لذلك، والتقى الجمعان ـ الجمع البكري والجمع العثمانيـ على مشترك عموم القصد الأصلي في حفظ الكتاب، مع اختلاف في الاعتبار التبعي، وجعل الأول مـحل حوالة الآخر ومعتمده، لتجتمع كلمة الأمة على المصحف العثماني، وقد ضم بين لوحيه ما قطع على مغيبه من التنزيل، وانتفى من سواده ما جرى منه مجرى التأويل، واجتهد القومة في كتبه أن يكون على الاشتمال على أحرف الخلاف المعتبرة اشتمال احتمال، اعتمادا على ذريعة ذكية تتجاهل في صورة إملائه نقط الإعجام، حتى إذا ضاقت عن الاستيعاب النسخة الواحدة، ضفت رقعة الرقم لتشمل نسخا رسمية معتمدة، قد أثبت فيها القرءان في صوره الأدائية المعتبرة، وأرسلت نظائره إلى الآفاق لتكون مراجع يتأيد بها حفظ الحفظة، ويمكن اعتبار هذا الحدث أول تدوين منظم موثق للهيئة القرائية، اعتبرت موافقة سواده شرطا لقرءانية المقروء، والتنكب عن سوائه شذوذا مخرجا له عن اعتبار التعبد.
وعرف التدوين القرائي بعد المصحف العثماني مسيرة خلاقة دفاقة، وضع نواتها السبق من المؤلفين الرواة توثيقا لبعض أحرف الخلاف، ليستوي التدوين بملء زمن على مشـروع التسبيع؛ فكان ابن مجاهد مسبع السبعة، وألف في ذلك مصنفه الشهير؛ لتنطلق الحركة التدوينية بعده على سننه التسبيعي، ثم سلك التأليف على إثره طرائق ذللا من التصنيف: تفريدا وتثمينا وتعشيرا، بل اتسع نطاق الأمر ليشمل بعنايته القراءة على اختلاف مراتبها ومستوياتها في شواذها ومشاهيرها ومناسيخها، وما زالت المدونات تترى في هذه الناحية على متنوع الأغراض، إيجازا وتطويلا، تكثيرا وتقليلا،إلى يوم الناس هذا، وتأصل في عرف هذا العلم من جراء كل ذلك أن كان الاحتكام في مسائله وقضاياه يجري على صنفين من المراجع: مرجع الأداء والرواية، وموضع السطر والنص.
سادسا: الرواية بالنظر إلى منازل الحملة ومقامات النقلة:
وإذا سبق التنويه أن عمدة هذا الأمر هو النقل والسماع، فإن الذي يعتلي سنام هذا الأمر، ويعتبر شرطا مكينا في حقيقته أصلا وكمالا هو الشيخ المعلم، والملقن المشافه ؛ إذ هو عنوان العملية التعليمية والمركز المحوري في درسها التلقيني، ومن ثم لم يسلم هذا المنصب على الأحقية والاعتبار إلا لمن كان على الاشتمال الواسع من خلائق الأهلية تحققا بالعنصـريين الذهبيين : عنصر الأمانة والديانة، وعنصر الخبرة والدراية، وقد وصف سيدنا جبريل عليه السلام المعلم الأول بأنه ﴿شَدِيدُ اُ۬لْقُو۪يٰ﴾ [النجم/5]، وأنه ﴿رَسُولٖ كَرِيمٖ ١٩ ذِے قُوَّةٍ عِندَ ذِے اِ۬لْعَرْشِ مَكِينٖ﴾[التكوير/19و20]،وكان المقام النبوي في قاصية علياء الاحتذاء في هذا المهيع التعليمي، كما كانت الإشارات النبوية عبارات دالة على تعيين أهل الاقتدار للتعليم، وتعين عيونهم للانتهاض به على الوجه الرضي: «استقرئوا القرءان من أربعة»[5]، وسارت الأمة على هذا النهج المرسوم، وعلى معياره الموضوعي الانتقائي، فقد تلقي عمل ابن مجاهد بكثير المباركة والتأييد، حين جعل الاختيار التسبيعي تحت عين وازع العدالة، والتحقق بإتقان الرواية والدراية، واعتمد منهج التسبيع في التلقين والتدوين، ليلحق به في الاعتبار كل ما جرى على سمته وتحقق بوسمه، مما أخذ في ناحيته ورعي شرطه.
وقد تحصل لعلماء التدوين بعدُ أن الشيخ المنتحل لصناعة الإقراء لا بد أن يكون على الوفر الكاثر من الصيانة في الديانة، مرتويا من شرعة الرواية حفظا وأداء عن أهل الصنعة، متسع الدراية بما يحتاج إليه من العلوم في سياقات صناعته، وتنزل رتبته بقدر ما يقع له من الإخلال بما ينبغي له تحصيله منها، ورسخ في أدبيات التحصيل أن«على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة، والفهم في علوم القرآن، والنفاذ في علم العربية، والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن، وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم»[6]
2 ــ معارج في فقه الرواية القرائية ومعارف درايتها
يؤسس لفقه الرواية نصوص الكتاب الحاثة على تدبر آيه، والتفقه في أحكامه، وأصل لهذا النظر التدبري الهدي النبوي حديث المدارسة[7]، الحامل في دلالته أن يحف هذا الوحي بما يضمن حفظه لفظا ودلالة، مبنى ومعنى.
وإذا كان متعارفا أن تفسير القرءان يعتبر أم العلوم القرءانية، تجتمع لديه ذرائع من آليات المعارف فاسرة عن معاني الكتاب، فإنه يمكن بنظر صحيح أن نعتبر أن للقراءات القرءانية تفسيرا كاشفا عن حقائقها في مختلف أنساقها اللغوية وآفاقها الدلالية، وهو ما اصطلح عليه بعد بـ«علم توجيه القراءات» أو تخريجها أو تعليلها، وهي أسماء وألقاب لن تنتهي إلا إلى مسمى واحد: هو هذا الذي يراد لهذا العلم بعد إتقان حفظه وإدمان لفظه، من فهم وجوه درايته ولقن متعلق فقاهته ، وليس غرض القول ههنا إلا أن يفلح في الإفضاء إلى أن أرجى سبيل يتهيأ معه للقارئ بلوغ مقامات الإمامة ـ بعد أخذ الرواية أخذ مشافهة وإدمان حفظ واستكثار نقل ـ هو: أن يردف على موروثه الروائي وحصيلته النقلية طائفة من العلوم والمعارف، تبصـره بمضامينها،وتخبره عن بطائن معانيها، ولن تستقيم له فصول القراءة وكثير من مهماتها إلا بتحصيلها، بل إن كثيرا مما يتسامع به في مجالات دراية المقروء، كالاختيار والقياس والترجيح، لن يستباح حرمه إلابعد التسلح بهذه المعارف، فهي عناوين دالة لمن نميت إليه على مدى استضلاعه من هذه العلوم وارتوائه منها.
وهي على تعدد مناحيها ومتعلقها يمكن إرجاعها إلى صنفين اثنين:
الصنف الأول: علوم قرءانية؛ القرءان منه مبدؤها وإليه عودها، وأعني بها: علم المرسوم، وعلم التجويد وعلم المواقف، وعلم الفواصل.
فأما علم المرسوم:
فمعرفة بأوضاع كلمات المصحف حذفا وإثباتا، وقطعا ووصلا،وإبدالا وتصوير همز، وهو من ضروري المعلوم بالنسبة للرواية القرائية؛ يقع لها به الإبقاء أو الإلقاء بحسب دخولها تحت شرطه، أو خروجها عن نصه، كما أن كثيرا من صورها لن يصح لها وجه من غير اعتباره؛ ولذا قال القائل الأول « الخاقاني»:[8]
وقف عند إتمام الكلام موافقا لـمصحفنا الـمتلو في البر والبحر
فلن يصح للقارئ فصل ما كتب على الوصل اتفاقا في مثل قوله: ﴿فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ﴾ في هود[14]، و﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِے﴾[47]، و﴿اِلَّا تَنصُرُوهُ﴾ في التوبة [40]،و﴿أَلَّن نَّجْعَلَ﴾ في الكهف[48]، و﴿أَلَّن نَّجْمَعَ﴾في القيامة[3]، ويكون لاحنا لو فعل ذلك فيما اتفق عليه.
وفي مدونات الرواية القرائية بابات بصرها حديد بالوضع الرسمي، كباب الوقف على أواخر الكلم، والوقف الرسمي لحمزة على الهمز المتطرف، وهاء تأنيث الوقوف ، ومن أعلم صنوف الوقف التي يرى من خلالها مدى دراية القاري بفقه المتلو ما يسمى عند القراء بوقوف الابتلاء..
علم التجويد؛ إذ هو علم بيان لفظ القراءة، وبه قوام صورتها واتضاح صوتها، وهو راع عليم لحرمة الحرف القرءاني، ودليل مبين لصحة النطق به، وعاصم للقارئ من مواقعة اللحن في مفردات الكتاب وتراكيبه، وطريق ناهج في الاستيثاق من مخارج حروفه وصفاتها، لا جرم عد من ضروريات وسائل المقرئ في العبور إلى العلم القرائي والاستمساك بأصوله، واعتبر مما اتفق القراء على لزومه والتزامه، وضرورته وانحتامه في جانبه العملي أصالة، وفي مستواه النظري دراية وتبعا.
علم الوقف والابتداء: أو علم المقاطع والمبادئ، ووسم بأنه أدب القرءان، وكانوا يقولون: «من لم يعلم الوقف لم يعلم ما يقرأ»، وهو «حلية التلاوة وتحلية الدراية وزينة القاري وبلاغة التالي وفهم المستمع وفخر العالم»[9]، وهو ملك المعاني، ومدبر شأن تصاريفها، ولذا كان القارئ مأمورا بإحسان الوقف والابتداء، ووصل ما حقه أن يوصل من المعاني، وفصل ما يتعين فصله منها، وذلك أمر دونه ما دونه من امتلاك ملكة الدراية بعلم العربية، والخبرة بالسياقات القرءانية، ومفاداتها المرادة، وأخبارها المحكية، وأحكامها المفصلة، وتتوهج جذوة هذا المطلب، ويرتقي مناله،ويرتفع قدر صاحبه عند تعاور القراءة وتعاقبها على الهيئات المختلفة التي تتغاير معها المعاني، فتصلح الكلمة وقفا على قراءة، ولا تصلح كذلك على قراءة أخرى، وقد ألفت في هذا الخصوص تآليف تبين عن هذا المسلك، وتستقري فيه مواضعه على سبيل البيان والدلالة، ومما أخصه بالتمثيل هنا تأليف المقرئ الشيخ أبي زيد عبد الرحمن ابن القاضي الموسوم ب: «القول الفصل في اختلاف السبعة بين الوقف والوصل».
علم الفواصل: وسماه ابن مسعود رضي الله عنه:«مسامير القرءان».
والفاصلة كلمة آخر الآية، كقافية الشعر، وقرينة السجع، وإنما تتأكد معرفة القاري بها؛ لما أن كثيرا من ملابسات القراءات قد يغمض التهدي إلى وجه أدائها، إلا اعتمادا على تعيين الفاصلة ومحلها؛ ذلك أن بعض القراء زاد على رسم الخط ستين ياء في رؤوس الآي، وبعضهم أمال رؤوس الآي من بعض السور، وبعض أصحاب الأزرق رقق ما غلظ من اللامات الواقعة في رءوس الآي الممالة؛ فكانت حاجة القارئ وكيدة إلى هذا العلم الذي وضعت فيه التواليف المفردة، والأنظام المفيدة الرائقة.
وأما الصنف الآخر: فهي علوم العربية، والاتساع في علم العربية كما قال ابن الباذش:«يوصل إلى حقيقة معرفة النطق بالحرف على حد كلام العرب، وما تنطق به، وبه يوصل إلى معرفة الوقف والابتداء، وبه يعرف وجه قراءة كل قارئ ورأي كل راء من من أهل الأداء»[10].
وللقراءات تواشج واعتلاق بمعجم غريب القرءان، وتعاقب حركات إعرابه، ووجوه خبره وإنشائه، واتساع لغاته وأصواته، وتصاريف بيانه ووجوه بلاغته، وأنحاء نحوه وبناءات تصريفه، مما لا يسع المجال للتمثيل لها فضلا عن إيجاز القول فيها، فلم يكن مستغربا بعد هذا أن تنال كلمة العتاب والإزراء من تصدر في منابر هذا العلم، وهو من علم العربية براء، وحق أن يدرج بذلك في عداد الأدعياء:
وقال أبو الحسن علي بن عبد الغني الـحُصْري (ت: 488 هـ)[11]
| وأحسِنْ كلام العُرْب إن كنت مقرئًا | وإلا فتخطي حين تقرأ أو تُقري |
| لقد يدَّعي علم القراءة معشـر | وباعهم في النحو أقصـر من شبر |
| فإن قيل: ما إعـراب هذا ووزنه | رأيت طـويل الباع يقصـر عن فتر |
وقال الداني، في صفات من يُؤخذ عنهم العلم :[12]
| وفَهِـم اللغاتِ والإعرابـا | وعلم الخـطأ والصَّـوابـا |
وقال:
| وكل من لا يعرف الإعرابا وربمـا قـد قوَّل الأيـمَّـهْ | فربَّما قد يترك الصوابا مـا لا يجوز وينـال إثمـه |
من أجل ذلك كله، ولتدثر هذا العلم بكثير من وجوه الدراية واغتنائه من فصولها، كان حظيا بكثير من المدونات ، وحق له أن تفسح لمثاراته مكانا معتبرا في استدلالاتها وشواهدها، وأن ترى له مقاما بينا في تقرير مذاهبها وفسر متولى أنظارها ومجتهداتها.
فكتب اللغة والنحو ومعاني القرءان وإعرابه حشد فيها من شواهد هذا العلم وبينات لحونه وقواعد أدائه ماكانت موضع مباحثة ومدارسة، ومناقشة ومفاتشة، ومحل تأييد وتفنيد، وتجريح وترجيح، وهو شاهد ماثل لما يزخر به هذا العلم في وجه درايته من مادة وافرة، ودروس بالغة، حفظت به على اللسان العربي وجوها من النطق كادت تندرس لولاها، وما شغل به مؤرخوا هذا الفن من تسجيل تلك المساجلات بين النحاة والقراء، إنما كان مظهرا باهرا ودليلا ناصعا على غيرة هذه الأمة على كتابها من جهة الفريقين؛ فالقراء ينتفضون انتصارا للرواية كلما جال في خاطرهم أنها مستهدفة بالريبة أو الاستضعاف، بينما هي عندهم على المتانة في النقل والوجاهة في الاعتبار الروائي، بحيث لا يسع في مثلها إلا حسن التقبل وكامل الاعتبار، وهو الموقف الذي أحسن العبارة فيها عنهم الإمام أبو عمرو الداني في كلمته الشهيرة الأثيرة: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرءان على الأفشـى في اللغة أو الأقيس في العربية، وإنما على الأثبت في الأثر والأصح في النقل؛ والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولافشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليها»[13].
والنحاة وأهل اللغة انتصروا للقرءان الكريم حين رأوا من جهتهم أن بعض الهيآت الأدائية لا ترقى إلى مقام اللغة القرءانية في علياء بيانها، وسمو طبقة بلاغتها، أو أنها لا تنقاس على الملهوج العربي، في لاحب الاستعمال وشهير التداول، فشهروا في وجهها سلاح الاستضعاف أو الاستنكار، غير معتقدين لقرءانيتها ولامسلمين بصحة مخرجها.
وحفلت كتب التفسير بالبيان القرائي في مختلف ضرائب التناول القرءاني، ففي أحكامه ورث العلم القرائي تركة تفسيرية تداولها أهل التفسير في سياقات الاستدلال على الوجوه الفقهية لكثير من مسائل العبادات والمعاملات،كما اغترف الدرس العقدي من ملتفظات هذا العلم وما تنبئ عنه من دلالات في مسالكه، وكانت عموم معاني القرءان في اتساع مجالاتها وعريض اهتماماتها واقعة تحت تأثير الهيئة القرائية، وخاضعة لكثير من لطائف دلالتها من غير اعتبار لوثاقة نقلها أو درجة الاعتبار في ثبوت قرءانيتها، واستقر في مأثور القول في هذه الناحية« أنه لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى، لا يوجد في قراءة الآخر، والقراءة حجة الفقهاء في الاستنباط، ومحجتهم في الاهتداء».
لقد حمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وتواردت عليه طوائف مباركة من العلماء المبرزين، تحققوا منه بالوصفين، وهدوا فيه إلى التمهر في الضربين؛ فكانوا راوين دارين، حفظة فقهاء، قراء لغويين، ولعله لن تعزب عن الأذهان أسماء رسخت في سماء هذا العلم على هذا الوصف المكين والمكانة السامقة، فتركوا الأثر الذي لا يبلى في التعليم والتلقين، والتأليف والتدوين، فضلا عما تركوه في سنن الاقتداء من هدي قرءاني أصيل، وديانة رشيدة قويمة، ولعلنا نذكر منهم: القراء العشرة، وأبا عبيد القاسم، وابن مجاهد، وابني غلبون، والحصـري، ومكيا، والداني، والشاطبي، وابن آجروم، وابن بري، والخراز، وابن غازي المكناسي،وأبا عبد الله الهبطي، ومحمدا الإفراني، وعبد الرحمن بن القاضي، ومسعود بن جموع الفاسي، وابن عاشر، والمنجرة الأب، والابن، وأبا عبد الله الرحماني، وابن عبد السلام الفاسي، وأبا القاسم الشاوي الشهير بابن درى…
ولن تعدم الذاكرة أن تستحضر بكثير الشرف والاعتزاز من كانوا إلى العهد القريب نماذج علماء توفرت لديهم خلائق الجمع بين الرواية والدراية كالعلامة الفاروق الرحالي، والشيخ عبد السلام جبران، والشيخ الحسن الزهراوي، والشيخ سيدي محمد أعجلي البوجرفاوي…، والاعتذار الوافر لمن لم تجر به عبارة التمثيل..
وفقنا الله جميعا للاستزادة من التحبب إليه بتوقير كتابه وإجلال مقامه، وإدمان مجالسته، والاستمساك بأهدابه، وتجلية مطلوبه وآدابه، والتخلق بأخلاقه، وعدم الرضا بسرد حروفه دون حفظ حدوده، ولا بإقامة كلماته دون العمل بمحكماته؛إنه ولي ذلك والقادر عليه.
[1]التحديد في الإتقان والتجويد للداني ص69.
[2]الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش، المقدمة ص 8.
[3]يراجع في الموضوع كتاب «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض.
[4]ينظر أبواب الأصول وفرش الحروف من الشاطبية.
[5]عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، ن مسند أحمد، عن عبد الله بن عمرو، 6/301 رقم 6767.
[6] الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: 89.
[7]حديث مدارسة القرآن مع جبريل عليه السلام، ينظر صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي 1/ 8 رقم6، وباب صفة النبي 4/188 رقم 3554.
[8]القصيدة الخاقانية لأبي مزاحم الخاقاني البيت 39.
[9]الكامل 1/473.
[10]نقلا عن القيجاطي من مسائله ص 457.
[11] شرح القصيدة الحصرية لابن عظيمة الإشبيلي: 2/26.
[12] الأرجوزة المنبهة: 168، 171.
[13]جامع البيان للداني 1/51.








بارك الله مجهوداتكم أستاذي
جزاكم الله خيرا أستاذي الكريم على هذه الدرر الثمينة
وبارك لكم في علمكم وعملكم