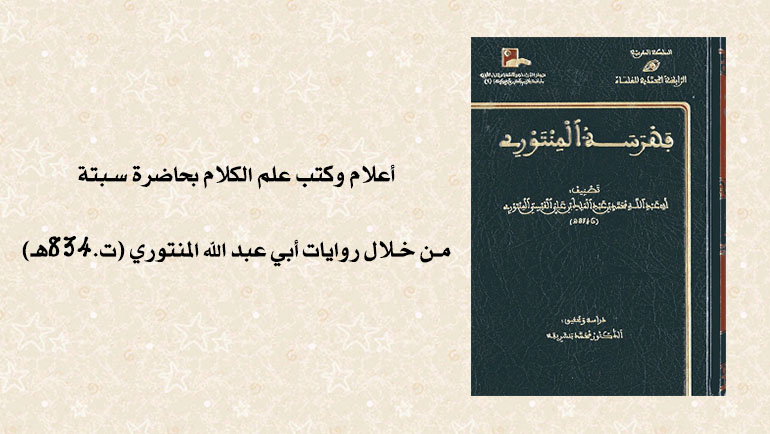لما كان الإسلام آخر الخطابات السماوية إلى الأرض، والكلمة الأخيرة المنزلة على خاتم الأنبياء والرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، اقتضت حكمة الله ومشيئته أن يجعله دين البشرية جميعا، الصالح للمعاش والمعاد، والصالح لكل زمان ومكان مصداقا للهدى القرآني: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ [آل عمران: 19]، وقوله: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ [آل عمران: 85].
ولذلك خص الله الدين بخصائص، وميزه بمزايا لم تجتمع لدين غيره، باعتباره الدين الخاتم، وجعله مليئا بالكماليات، متميزا بالخصائص والصفات، كاملا دائما بدوام الأيام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكان رسوله سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، رسول الإنسانية كلها، والناس جميعا، كما أكد ذلك القرآن الكريم: ﴿قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا…﴾ [الأعراف: 158]. مما خص به الرسول الكريم، وكان بذلك خاتم المرسلين وإمام الأنبياء.
ومن هنا تميز الإنسان على سائر الموجودات والمخلوقات، بالتكريم والتقدير، والعقل والتدبير، ليكون خليفة الله في الأرض، والقائم برسالته فيها، والموجه لمسيرة الحياة.
لذلك رسم الإسلام للإنسانية نظاما محكما، ومنهجا كاملا، لانتظام الحياة، وتدبير أمور الناس ليقوموا بالقسط، وليحيوا حياة دنيوية مستقيمة آمنة، بلاغا للحياة الآخرة، وصراطا لها، مصداقا للهدى القرآني الكريم: ﴿وإن الدار الاَخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون﴾ [العنكبوت: 64].
كما مزج الحق، سبحانه وتعالى، بين الحياتين لارتباط الأولى بالأخرى، فيما أكد الرسول الأكرم، عليه الصلاة والسلام، “ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منها جميعا، فإن الدنيا بلاغ الآخرة، ولا تكونوا كلا على الناس[1].
ولذلك كان الإنسان قطب راحة الوجود، وأساس الحياة، وسيد المخلوقات في شريعة الإسلام التي أحاطته بالرعاية الكافية، والعناية الشاملة، بما ضمن له من حقوق، ورتب عليه من واجبات، حتى تميز ديننا الحنيف بكونه دين حقوق الإنسان بين الديانات جميعا.
الإسلام أكثر الأديان رعاية للإنسان
يعتبر الإسلام أكثر الأديان كلها رعاية للإنسان، وأعظمها عناية به، وتقديرا له، باعتباره خليفة الله في الأرض، وأعظم مخلوقاته في هذا الكون، وهو الذي أعطاه قيمته الحقيقية، واعترف بإنسانيته، وجعله مناط تطور الكون وتقدمه، وتحقيق إرادة الله فيه، ولذلك حمله أمانة الحياة ومسؤوليتها، وأحاطه بكل معاني التكريم، حتى اعتبر الرسول الأكرم “حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة نفسها”[2].
لذلك يعتبر الإسلام في حقيقته وهدفه وتوجيهه للناس، إعلاما وإعلانا إلهيا لحقوق الناس وواجباتهم، وما ينبغي أن يكونوا عليه، منذ خمسة عشر قرنا، من قبل أن تعرف الإنسانية كلها هذه المواثيق البشرية، والمعاهدات الدولية التي تدعو إلى رعاية هذه الحقوق، والتي لم تلق حتى الآن حظها من التطبيق السليم، والرعاية الواجبة، برغم التطور الذي عرفته البشرية، والحضارة التي بلغها الإنسان في عصرنا الحالي، ولا شك أن هذا الإعلان الإلهي يعلو ويسمو على كل المواثيق الوضعية والعهود البشرية لكونه يقوم على الإيمان بالله، وابتغاء مرضاته، ورغبة في ثوابه، وخوفا من عقابه.
كما يقوم على الضمير الديني الموجه لتصرفات الناس في السر والعلن، وفي كل أحوالهم، على مختلف مستوياتهم، وعلى أن ما يفوت ويمضي في الدنيا، لن يفوت في الآخرة، وعند من لا تخفى عليه خافية في الأرض وفي السماء.
وأمر آخر يمتاز به الإعلام الإلهي عن سائر المواثيق الوضعية، هو أنه يرتفع بحقوق الإنسان، فيجعل رعايتها واجبا على المجتمع كله، على قادته وحكامه وقضاته، كما هي واجب على صاحبها، يدافع عنها ولا يتهاون في الحصول عليها، ومن أجل ذلك اعتبرت الشريعة الإسلامية أداء الواجب، قبل تقرير منح الحق والحرية، اعتبارا على أن النهوض بالواجبات ضمان لصاحب الحقوق والحريات العامة لا يستقيم مع التكليف؛ لأن التكليف لا ينفصل معناه عن مفهوم الحريات العامة في الإسلام، إذ أن ثمة تلازما بينهما، فالواجب يقابله حق، ولذلك قيل: لا واجب بلا حق لأن التكاليف حقوق الغير.
خصائص حقوق الإنسان في الإسلام
لذلك كان تقرير حقوق الإنسان وحرياته العامة منشأها التكاليف، وهذه مصدرها الأحكام التي هي مصادر الحريات، لا ذات الإنسان كما هي عند الآخرين[3].
وقد نظم الإسلام الحريات العامة، على اعتبار أن الحرية منشأها التكليف والمسؤولية، لا حرية الانطلاق والفوضى والأنانية والهوى والخضوع لهيمنة الأعراف السائدة والتقاليد الموروثة، وكانت العقيدة الإسلامية أكبر ضمان للحريات العامة لتقييد سلطة الحكم، لكون ذلك مقيدا بالعدل، إذ نظمت الشريعة كيفية ممارستها على نحو معروف، امتثالا لله وطاعة في التكليف، ووفاء بالأمانة التي حملها الإنسان، ولذلك قامت الحقوق على حقائق عقائدية، قبل أن تكون تصرفا سياسيا أو مجرد نظام دستوري.
فكل حرية عامة في الإسلام مظهر للعقيدة والتقوى، قبل أن تكون أمرا آخر، ومن ثم كانت ممارستها عبادة وخلقا، أداء للتكليف المبني على المسؤولية، وذلك ما ميزها وخصصها في الإسلام عن غيرها، وهذا ما جعل الحرية في الإسلام حقا وواجبا معا، يؤكد ذلك أن حق الحياة مصون للإنسان شرعا، غير أنه في نفس الوقت واجب وتكليف تنهض المسؤولية بأدائه والتصرف فيه، ولنضرب لذلك مثلا بحق الحياة نفسه، فإذا كان من حق الإنسان أن يحيا، فإن من واجبه أيضا أن يحيا، أداء لأمانة التكليف وعمارة الدنيا، في ظل العبودية لله وتنفيذ شرعه، فليست حياته حقا خالصا له يتصرف فيه كيف يشاء، وإنما خلق ليؤدي واجبا لنفسه ولغيره، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان واجبا عليه أن يحيا، لأنه لم يخلق عبثا ولا سدى ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى﴾ [القيامة: 35].
لذلك يكون الاعتقاد بثبوت هذه الحقوق شرعا بالتكليف والمسؤولية، هو منطلق ممارستها في المجتمع الإسلامي، تبعا لمفهومها المنوط بالطابع الاجتماعي الإنساني. هذا ولا نعلم تشريعا غير الإسلام، يؤصل من الأحكام العملية، والضمانات الحقيقية، ما يجعل اندماج حياة الفرد في حياة الأمة أمرا واقعا، بحيث يصبح قواما موحدا، كما تندمج الإرادات الفردية، حتى تصبح إرادة معنوية عامة للمجتمع، يتقرر على ضوئها مصيرهم جميعا في حياتهم الدنيوية[4].
ومن أجل ذلك أبادر إلى القول، بأن ما ادعته وتدعيه الدول المعاصرة، من كونها كانت السباقة إلى الدعوة إلى حقوق الإنسان وتقريرها، وأن لها فضل الريادة في تطبيقها ورعايتها غير صحيح، وها هو التاريخ الحضاري والإنساني خير دليل وشاهد، فليس صحيحا أن الإنجليز والفرنسيين كان لهم فضل الريادة والسبق في المطالبة بها، والدعوة إليها في ثوراتهم ومواثيقهم.
فقد تصور الناس نتيجة تأخر المسلمين، وتخلفهم عن السير بمقتضى أوامر دينهم، أن حقوق الإنسان مرتبطة بالعهد الأعظم الأنجليزي ماجنا كارتا” الصادر سنة 1215م، أو ميثاق توم سنة 1737م، أو إعلان الثورة الفرنسية سنة 1789م، أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948م.
ولكن الذي علمته الإنسانية منذ أربعة عشر قرنا، والذي ينبغي أن يعلمه الناس اليوم، أن الإسلام أعلن هذه المبادئ وقررها منذ ظهوره، وكان السباق إلى الدعوة إليها وتقريرها ورعايتها، في أوسع نطاق وأكمل صورة، وأن الدولة الإسلامية على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين من بعده، وقادة المسلمين وعلمائهم، كانوا أسبق إلى تقريرها، وتطبيقها على نحو رائع، وبشكل ما تزال الأمم المعاصرة لم تبلغه، وأن مجرد مقارنة بسيطة بين التشريعات السابقة على الإسلام، وكذا المذاهب اللاحقة عليه، تظهر ريادة الإسلام وأسبقيته في هذا الباب.
إن الإسلام دين حقوق الإنسان التي قررها القرآن، دستور المسلمين وكتابهم العظيم، كما أكدتها السنة الكريمة، وعمل الخلفاء، والعلماء، وتاريخ المسلمين، لقد امتلأ مسمع الدنيا كلها بصوت الرسول، عليه السلام، بالوحي المنزل عليه، يعلم البشرية كلها، ويعلن لها كلها هذه الحقوق في هذا البيان الرائع المعجز: ﴿يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ [الحجرات: 13].
إن القرآن والسنة ظلا دوما المنبع والمصدر لكل حقوق الإنسان وحرياته، وقد حفلت نصوصهما بالمبادئ الإنسانية السامية لتلك الحقوق والحريات، وكان كل منهما مكملا للآخر في تفصيل وتدقيق معجز رائع، وعلى هديهما، سارت دولة الإسلام ومجتمعات المسلمين في مختلف العهود.
وإن أروع مثل للدعوة إلى حقوق الإنسان وحرياته، ومدى ما بلغته من تقرير ورعاية في دين الإسلام، ولدى رسول الإسلام، هي خطبته في حجة الوداع، التي أبى عليه السلام إلا أن يضمنها آخر وصيته للمسلمين، يضمنها دعوته للحفاظ على تلك الحقوق، وصيانتها، والدفاع عنها.
وسنجتزئ هنا بالكلام على حقين من الحقوق الأساسية هما:
- المساواة بين الناس.
- والكرامة الإنسانية.
أولا: المساواة بين الناس
كان من بين الحقوق الأساسية التي شرعها الإسلام، وقررها للناس، وأوجب تطبيقها والعمل بها، حق المساواة الذي يعتبر في شريعة الإسلام أساسا لعلاقات الناس فيما بينهم، ومظهرا من مظاهر العدالة الاجتماعية، وركيزة لكرامة الشخص، واعتبار قيمته الإنسانية.
وقد اعتبر الإسلام مبدأ المساواة عقيدة أساسية يجب أن يدين بها المسلم، وأن يحرص عليها ويتصف بها، ويطبقها في حياته كلها، وجعل ذلك أساسا ومبدأ تقوم عليه حياة الناس، فقال في القرآن الكريم: ﴿يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ [الحجرات: 13]. فالناس جميعا منحدرون من أب واحد، وأم واحدة، وأن تقسيمهم كذلك ليتعارفوا ويتمازجوا ويحب بعضهم بعضا وليتكاملوا لصالح الجماعة كلها والبشرية كلها.
كما قام هذا المبدأ على أمر آخر وهو تمييز الإنسان على سائر المخلوقات، باعتباره أسماها وأكرمها عند الله، (ولقد كرمنا بني آدم)؛ أي تكريم الجنس البشري كله ولم يخص فردا دون آخر. كما شملت عنده المساواة الذكر والأنثى، وهم متكاملون بعضهم من بعض، ولا فضل لأي منهما على غيره، بل الفضل في ذلك للخالق. ﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض…﴾ [آل عمران: 195]، فليس بينهم فرق في جوهر الطبيعة أو في الأصل، وهم جميعا مسؤولون ومثابون أو معاقبون. ﴿يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا﴾ [النساء: 1].
لقد أوجب الإسلام تطبيق حق المساواة والتمسك به في جميع نواحي الحياة، ونادى بالعمل به في الحقوق المدنية، والمسؤولية، والعقاب، وفي جميع الحقوق العامة.
ومن أجل هذا يعتبر الإسلام بني البشر، جميعا، متساوين في طبيعتهم البشرية، ولا تفاضل بينهم بحسب الخلق، أو العنصر، أو السلالة، أو اللون، وإنما هم يتفاضلون، بكفايتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك مصداقا لقوله تعالى: ﴿يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ [الحجرات: 13].
وقد عمل الرسول، صلى الله عليه وسلم، بقوله وفعله طوال حياته، على تطبيق هذا المبدأ الإسلامي العظيم، باعتباره أصلا من أصول الإسلام، وأساسا من الأسس التي يقوم عليها مجتمع المسلمين. وقد أبى في خطبة الوداع إلا أن يؤكد ذلك، ويدعو الأمة إلى التمسك بهذا الحق واعتباره، فقال: (أيها الناس إن ربكم واحد، وإن آباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب)[5].
وقد غضب غضبا لم ير مثله على وجهه، عندما سمع أبا ذر الغفاري يحتد على بلال ويعيره بلونه قائلا: “يا ابن السوداء”، فزجره الرسول ورده بقوله: “يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم”[6].
فاستجاب أبو ذر لأمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، ووضع خده على الأرض، وأقسم أن يطأه بلال برجله توبة وتكفيرا، عما صدر عنه من أخلاق الجاهلية.
وإن أفضلية الإسلام وريادته في هذا المجال، تظهر في أنه لا يقر المبادئ الضالة التي عرفتها الإنسانية قبله، وهذه الجاهلية التي عادت إليها الإنسانية حتى في عصر التمدن الحالي.
لقد شجب الإسلام تلك الامتيازات التي قامت في مجتمع الهنود والرومان واليونان، من تمييز الناس بعضهم على بعض، بحسب العنصر أو الجنس، أو التكوين، ولذلك حرم التفاضل الذي ميز الشعوب عن بعضها، والأوصاف التي أطلقتها على نفسها “كالشعب المختار” و “شعب الله” ومن “شعوب ناقصة”، وأخرى “كاملة الإنسانية” بحسب نشأتها وطبيعتها الأولى، وبالتالي ذلك التمييز الذي قام بين الناس تبعا لتلك الأوصاف، فهذا كله حرمه الإسلام وألغاه، واعتبره جاهلية وانحطاطا للإنسانية عن مكانتها الرفيعة، التي وضعها الله فيها بقوله: ﴿يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء﴾ [النساء: 1]، والتي نادى بها الرسول وطبقها في قوله: “ليس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أحمر فضل، ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى”[7].
وتطبيقا لهذا المبدأ وعملا به، لا يقر الإسلام هذه الدعاوى الجاهلية التي عادت على الظهور، وانتشرت اليوم، من التمييز بين الشعوب حسب ألوانها، واعتبار الرجل الأبيض سيد العالم، وتمييزه في المعاملة وسائر الحقوق عن الرجل الأسود، في التعليم، والوظائف، كما يحصل الآن في بعض الدول الإفريقية وبعض مدن أمريكا مثلا.
إن الإسلام جعل من بلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، دعاة وقادة وحكاما، حتى قال الرسول عن سلمان إنه من أهله وأهل بيته، وهذا هو منتهى التكريم والتقدير للإنسان، باعتباره إنسانا فحسب.
تطبيقات الإسلام لمبدإ المساواة
لعل الإسلام أعظم دين قرر مبدأ المساواة بين البشر في أتم صورة وأكمل وضع، واعتبره الأساس في علاقات الناس بعضهم مع بعض، ورغب في تطبيقه في جميع مناحي الحياة حتى جعله قوام العدالة الاجتماعية، وأساس الكرامة الإنسانية.
ومن هنا شمل تطبيق الإسلام وتقريره لمبدإ المساواة جميع مظاهر حياة الإنسان، سواء فيما يتعلق بتقدير القيمة الإنسانية المشتركة، أو فيما يتعلق بالحقوق، والمسؤولية، والجزاء، أو فيما يرتبط بشؤون الاقتصاد تحقيقا لخير الناس واستقرارهم وسعادتهم، وأحاطه بسياج من الرعاية والحماية من كل انحراف أو عبث أو زيغ، حتى كان مظهرا من مظاهر سمو الدين الإسلامي وسمو تعاليمه، التي حققت للإنسانية وللناس الأمن والطمأنينة والاستقرار.
وسنتحدث على هذه النقط الثلاث لنتعرف على مدى صلاحية الإسلام وفضله في هذا المجال.
1. المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة
ويعني ذلك أن الناس جميعا متساوون في طبيعتهم البشرية؛ إذ أنهم من أصل واحد وطبيعة واحدة ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم﴾ [طه: 55].
وأن ليس هناك فرد أو جماعة تتميز عن غيرها بحسب عنصرها وخلقها الأول، إنما التفاضل يكون بأمور خارجة عن طبيعتهم وعنصرهم وسلالتهم؛ أي على أساس التقوى والعمل الصالح.
2. المساواة في الحقوق والمسؤولية والجزاء
وتقوم هذه المساواة على أساس أن العدل الإسلامي له ميزان واحد، وتطبيق واحد على جميع الناس، في جميع شؤون الحياة، حقوقا، ومسؤولية، وجزاء، انطلاقا من قول الله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون﴾ [المائدة: 8]. ويؤكد هذا المعنى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله: “إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وآيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”[8].
وهو ما ذهب إليه عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موسى الأشعري قائلا: “آس بين الناس في وجهك ومجلسك، وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك”.
كما يحرص على تأكيد ذلك في وصيته للخليفة من بعده بقوله: “اجعل الناس عندك سواء، لا تبال على من وجب الحق، ثم لا تأخذك في الله لومة لائم، وإياك والمحاباة فيما ولاك الله”. كذلك سوى الإسلام بين الناس في حق التعليم، وجعله فرضا واجبا على كل فرد بما ينفعه في دينه وشؤون دنياه، مصداقا لقوله عليه السلام” طلب العلم فريضة على كل مسلم”[9] يدل على ذلك ويوجهه أن أول الوحي دعوة إلى العلم والتربية.
كذلك سوى الإسلام بين الناس في حق العمل، وجعله حقا مشاعا بين الناس، وحث عليه ورغب فيه ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه﴾ [الملك: 15]، ودعاهم أن يمارسوا أعمالهم، ويعودوا إليها إثر الفراغ من صلاة الجمعة كما أكد ذلك القرآن الكريم: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله…﴾ [الجمعة: 10].
وقد عمل النبي في الرعي وفي التجارة لزوجه خديجة قبل أن ينبأ ويرسل إلى الناس، وحبب العمل إلى صحابته ليكسبوا ولا يكونوا عالة على غيرهم، وعندما عاد من غزوة تبوك استقبله معاد وصافحه، فأحس بخشونة يده فقال له: “تلك يد يحبها الله ورسوله”.
ولم تقتصر التسوية بين أفراد المجتمع الإسلامي على المسلمين، بل شملت التسوية بين المسلمين وغير المسلمين مصداقا للقاعدة الشرعية “لهم مالنا وعليهم ما علينا”[10]، فللذميين مالنا من الحقوق، وعليهم من الواجبات ما للمسلمين مثلهم، وعلى الدولة أن تقاتل عنهم كما تقاتل عن رعاياها من المسلمين، بل إن المسلمين وخاصة حكامهم، مطالبون بأكثر من ذلك في مقابل أهل الذمة بحسن المعاملة والحماية، تأكيدا للتوجيهات النبوية الكريمة: “من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة”[11]، ومن ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير نفس، فأنا خصمه يوم القيامة.
التسوية بين المرأة والرجل
لقد أحدث الإسلام بتقرير حق المساواة بين الرجل والمرأة، تغييرا جذريا في الحياة بعد أن ظلمتها الأجيال والأمم، وهضمتها حقوقها، وحرمتها من أبسط الحقوق، واعتبرتها مجرد أداة للزينة والتسلية، وموطئ الشهوة والولد، فقرر الإسلام فيما قرر مساواتها التامة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات، وفي المسؤولية والجزاء، وفي كل مجالات الحياة، فكان بذلك أول من قرر حقوقها وواجباتها وحماها في ذلك، حتى إنه جعل منها خلال عقدين من الزمن ندا للرجل، ومساوية له في جميع الحقوق والواجبات، وعضوا مهما في المجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: “النساء شقائق الرجال”[12]؛ أي أمثالهم.
وما يزال الإسلام بعمله هذا متميزا عن كل الأديان والشرائع، والنظم الحديثة في هذا المجال.
فقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وفي شؤون المسؤولية والجزاء: ﴿من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾ [النحل: 97]. ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ [النساء: 7]. وسوى بينهما في الحقوق المدنية على اختلاف أنواعها، لا فرق بين المرأة المتزوجة وغيرها، والزواج لا يفقد المرأة شخصيتها المدنية، وممارسة كامل حقوقها، والمحافظة على اسمها وشخصيتها، ولم يفرق الإسلام بين الجنسين في الحقوق، لا من حيث تدعو إلى ذلك مراعاة طبيعة كل من الجنسين في الحياة، وما يصلح له، وكفالة الصالح العام، وصالح الأسرة، وصالح المرأة نفسها.
3. المساواة في شؤون الاقتصاد
وقد وضع الإسلام في هذا المجال نظاما دقيقا يحقق تكافؤ الفرص بين الناس في النواحي الاقتصادية، ويذلل لكل فرد سبل الحصول على المال، ويعطي لكل مجتهد جزاء اجتهاده، تحقيقا للتوازن، وتقليل الفروق، وتقريب الناس بعضهم من بعض، وبما يحول دون تضخم الثروات، وتجميعها في يد أو أيد قليلة، وعمل كل ما يجرد المال من حق السيطرة والاحتكار، والتحكم في رقاب الناس.
فقرر في هذا المجال الملكية الفردية وحملها، وذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على المال، وشجع على العمل، وفتح المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق، وعلى أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على التكافل والتعاون والتواصي بالبر والإحسان والعدل، كفالة للضمان الاجتماعي في المجتمع، وتحقيقا لمجتمع الكفاية والعمل، الذي يضمن للناس حياة إنسانية كريمة.
وهكذا نجد أساس النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على:
ـ يقرر الملكية الفردية ويحيطها بسياج من الحماية.
ـ ويذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على المال.
ـ ويشجع على العمل ويعطي لكل مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة.
ـ ويفسح المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق والإبداع والابتكار.
ـ ويحقق تكافؤ الفرص بين الناس.
ـ وينظم وظيفة رأس المال، ويحيطه بكل ما يمنعه من السيطرة والاستغلال.
ـ ويحول دون تضخم الثروات وتجميعها في يد واحدة، بما قرره من إرث، ووصية، وزكاة، وصدقات، وكفارات.
ـ ويجعل ملكية الأشياء الضرورية لجميع الناس ملكية جماعية.
ـ ويبيح نزع الملكية الفردية للصالح العام.
ـ وبذلك قام النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس:
- أن الإنسان غاية لا وسيلة.
- قيام العلاقات الاقتصادية بين الناس على أساس أخلاقي، تحقيقا للتكافل والتعادل والتضامن الاجتماعي.
- تحريم طرق الكسب غير المشروع، وهي التي تقوم على استغلال النفوذ والربا، والرشوة، والغش، والابتزاز، والتحكم في ضروريات الحياة.
- الترغيب في الإنفاق والتصدق بكل ما زاد عن الحاجة من أجل الصالح العام.
- جعل اكتناز المال وعدم إنفاقه في سبيل الله من أكبر المعاصي.
- حق المسلم في الغذاء والكساء والعمل، بغض النظر عن أي اعتبار.
وكفالة الدولة لهذه الحقوق. إن من شأن هذه المبادئ أن تحقق استقرار التوازن الاقتصادي بين الطبقات والأفراد.
وتضييق المسافات بين الناس بتقريبهم مع بعض. وتكفل للجميع حياة إنسانية كريمة، يأمن فيها كل فرد على حياته وأمنه واستقراره[13].
ثانيا: الكرامة الإنسانية
ونتكلم هنا على عنصرين أساسيين هما:
- المفهوم الإسلامي للكرامة.
- ومظاهرها.
- المفهوم الإسلامي للكرامة
انطلق الإسلام في مفهومه للكرامة الإنسانية من نظرته الصحيحة إلى الكون والإنسان، الذي جعله الله خليفة في الأرض ﴿هو الذي جعلكم خلائف في الأرض﴾ [فاطر: 39]، تحقيقا للغاية الكبرى من وجوده، وهي إفراد الله بالعبادة والألوهية، وتحقيقا لاعتباره الحياة الدنيا بلاغا للحياة الأخرى، وعلى أنها فترة اختيار وإعداد ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الاَخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا﴾ [الإسراء: 18 – 19].
ومن هنا كان مفهوم الإسلام للكرامة الإنسانية، أبعد من أن ترتبط بنسب، أو حسب، أو جاه، أو منصب،أو مال بل حصره وحدده في أمر واحد هو التقوى، فالأكثر تقوى هو الأكرم على الله وعلى خلق الله، (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) باعتبار وحدة أصل الإنسان كما أكد ذلك الإمام الشافعي:
الناس من جهة التكوين أكفاء *** أبوهم آدم والأم حواء
فإن يكن لهم في أصلهم شرف *** يفاخرون به فالطين والماء
وبذلك يكون المقياس والميزان في كرامة الناس في الإسلام، هو العمل الصالح لخير الإنسان وخير مجتمعه، وما ينفع الفرد والجماعة والاهتداء إلى الحق والتمسك به والتزامه.
وعملا بذلك وتطبيقا له نص القرآن الكريم على أن الكفر أضاع كرامة ابن نوح، فأغرقه الطوفان مع قوم نوح، بالرغم من دعاء والده وهو من أولي العزم من الرسل ﴿إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح﴾ [هود: 46]، كما حفظ الإيمان كرامة عبد الله بن أم مكتوم حين أنزل الله في شأنه قرآنا، ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى﴾ [عبس: 1-4]، تعليما لرسوله الكريم عندما انصرف عنه، طامعا في إسلام قوم من وجهاء قريش الذين أسقط الكفر كرامتهم.
ومن هنا لا تكون كرامة لمن يغضب ربه، ويخالف عن أمره، ويسعى في الأرض بالفساد، ولو كان جاهه عريضا ومكانته متميزة، مصداقا للهدى القرآني: ﴿ومن يهن الله فماله من مكرم﴾ [الحج: 18].
وهو ما أكده الرسول الأكرم بقوله: “إن العبد لينشر له من الذكر ما بين السماء والأرض، لا يساوي عند الله جناح بعوضة”[14]؛ أي لا كرامة له عند الله، لأنه يخفي حقيقته وعمله عن الناس، ويكون جاهه وشهرته حجة عليه ومسؤولية يتحملها يوم القيامة، مما يؤكد أن الشهرة والجاه والمكانة لا علاقة لها بكرامة الإنسان، إذا لم يكن عمله صالحا يرضي الله عز وجل.
ومن هنا كان مفهوم الكرامة في الإسلام يرتبط بالعفو عن الظلم، والإحسان إلى المسيء، والصفح بدل الانتقام، والسماحة تجاه أفراد المجتمع الإسلامي.
كما يتنافى هذا المفهوم السامي للكرامة في الإسلام مع كل تجبر، أو طغيان، أو احتقار للناس، أو استعلاء على الخلق، للعرف الجاهلي الذي ساد ويسود اليوم بين الناس، من أن الانتقام من الناس، والشدة عليهم، والتعالي، والتجبر، صفات تثبت قوة الإنسان ومركزه وكرامته، وهي أخلاق وصفات شجبها الرسول الأكرم وحمل عليها في قوله: “بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، وبئس العبد عبد تجبر واعتدى، ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سها ولهى، ونسى المقابر والبلى، بئس العبد عبد عثى وطغى، ونسي المبتدأ والمنتهى، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله[15]، كما يؤكد هذا المعنى السامي للكرامة الإنسانية في الإسلام الحديث الشريف الصحيح: “المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا ثلاث مرات، وهو يشير إلى صدره الشريف، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله”[16].
مظاهر الكرامة الإنسانية في الإسلام
لقد جعل الله الإنسان أرقى وأكمل المخلوقات، وخصه بالمزايا، وميزه بكمال الصفات، كما أودع فيه من العقل، وحسن الإدراك، وكمال التمييز، وجميل الصورة والخلق، كما أكد ذلك القرآن الكريم وفصله في آياته وسوره بقوله: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ [التين: 4]، ﴿خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير﴾ [التغابن: 3]، ﴿ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾ [الإسراء: 70].
فكان العقل الذي ميز الله به الإنسان هو أسمى مظاهر تكريمه، والآية الناطقة الدائمة على كرامته، وبه ساد على العوالم الأرضية، وبه اطلع على ما شاء الله من العوالم السماوية، والآيات الكونية، التي أدركها وما زال يدركها مستقبلا مما يتيح الله له إدراكها، وسبر أغوارها، والإطلاع عليها. كما كرمه بالكلام والإفصاح، وتعلم اللغات، والكتابة والنطق، وعلمه ما لم يكن يعلم، مصداقا للهدى القرآني: ﴿الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان﴾ [الرحمن: 1-4]، ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما﴾ [النساء: 113].
ومن مظاهر تكريمه وكرامته تسخير الكون له، وجعله مجالا لتعلمه وكشوفه وإبداعه، سخر له ما في السموات وما في الأرض، وهداه إلى التفكير بعقله، وإدراكه، والسعي بعمله وكفاحه إلى الغوص في أسرار الكون، والبحث فيها، واستجلاء آفاقها، فحقق هذا التقدم المذهل، وتوصل إلى هذه الكشوف والاختراعات التي سمت بحياة الإنسان وبقدره، فحقق بها إرادة الله فيه كما أكد ذلك القرآن الكريم. ﴿وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه﴾ [الجاثية: 13]، بل ذهب القرآن إلى أبعد من ذلك من مظاهر كرامة الإنسان وتكريمه، أن أنبأه الله بأنه سيكشف المجهول، وسيخترق الآفاق والفضاء، وسيقطع المسافات والأبعاد الكبرى في أقصر الأوقات، وسيركب السماوات الطباق، أنبأ الإنسان والمسلمين بخاصة بذلك قبل مئات السنين، وقبل أن تصل الإنسانية إلى ما وصلته اليوم من كشوف علمية، واختراق الفضاءات العليا كما جاء في القرآن: ﴿فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق﴾ [الانشقاق: 16-19]، وهو ما فهمه العلماء المسلمون بعد نزول القرآن بزمن قليل، حتى ذهب الإمام الطبري: “على أن المراد من هذه الآيات أن الإنسان سيركب سماء بعد سماء”، أو كما وصفها القرآن بالسبع الطباق”[17]، وهو المعنى الذي ذهب إليه الإمام الرازي بقوله: “بإمكان ذلك وتحققه مهما كان خارقا على يد الإنسان، استنتاجا من قوله تعالى: ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء﴾ [العنكبوت: 22]، أي إمكان وصول الإنسان إلى السماء لارتياد الفضاء، لأن الله فرض لهم قدرة فيكون لهم صعود في السماء[18] وهو سبق إسلامي علمي قبل ألف عام، وقبل أن يصبح هذا الأمر حقيقة علمية، مما يؤكد التوفيق بين قيم الدين وقيم العلم في شريعة الإسلام.
ومن مظاهر هذه الكرامة للإنسان، تقرير الإسلام لمختلف حقوق الإنسان التي تكفل خلافته عن الله في الأرض، وقيامه بالمسؤوليات، المنوطة به في الحياة، والعمل بما يحقق سعادته في الدارين، وكان في مقدمة تلك الحقوق حقه في الحياة الذي يعتبر أصل الحقوق، بما يتضمنه هذا الحق من المحافظة على حياته، وعدم الاعتداء عليها، وعدم التفريط فيها، وقد عصمت الشريعة دم الإنسان، وحرمت قتله مصداقا للهدى النبوي “كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه”[19]، واشترطت أن يكون صحيح الجسم، سليم العقل، حسن الخلق.
لذلك كانت محافظة الإنسان على نفسه، واحترامه لنفس غيره، تقديرا منه لحق الحياة الذي تقره الأديان، وتصونه الفطرة، وتحميه الشرائع. واعتبرت الشريعة الخروج على ذلك ظلما وضلالا يؤدي إلى النار.
وقد شدد الإسلام في الدعوة إلى الحرص على المحافظة على الكليات الخمس. ومن مظاهر هذه الكرامة الإنسانية حرص الإسلام على احترام آدمية الناس، وعدم إهدارها، باسترقاقهم واستعبادهم وظلمهم، لأن الإنسان وجد حرا ليبقى حرا، كما أكد هذا المعنى السامي في الإسلام عمر بن الخطاب بقوله: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتكم أحرارا”[20]
وبهذا يتأكد أن الإسلام كان أول دين إلهي نادى بحقوق الإنسان، وله الريادة في تقريرها وإيجابها، وأنه تميز بالربط بين الحقوق والواجبات، وأول من ساوى بين الرجل والمرأة في تاريخ البشرية، وجعل مصدر هذه الحقوق والواجبات إلهيا، بتشريعها وإيجابها عن طريق الوحي في القرآن الكريم، كما أكدها الرسول، وأصلها وطبقها، ودعا إلى تطبيقها واحترامها في السنة النبوية الشريفة، وسيرته الطاهرة، حتى كانت خطبة حجة الوداع دعوة كريمة، ووصية خالدة للأمة الإسلامية بالحفاظ على تلك الحقوق وصيانتها والدفاع عنها.
وقد آن للمسلمين في عصر صحوتهم الإسلامية التي انطلقت مع القرن الهجري الجديد، أن يعودوا إلى دينهم فيبنوا على أركانه ومبادئه وقيمه، دولهم وأنظمتهم، ومؤسساتهم ومجتمعاتهم، ففي ذلك خيرهم وصلاحهم، وفلاحهم وقوتهم، لأن الإسلام هو هويتهم وقدرتهم، ولا سبيل سواه لهم، مصداقا لقول عمر بن الخطاب: “نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا”.
وإن أجمل ما نختم به هنا، هذا التوجيه السامي لأمير المؤمنين الحسن الثاني، في رسالة القرن الهجري الجديد، التي وجهها إلى شعبه وإلى سائر المسلمين، فقد قال فيها: “لنعقد العزم على تأدية رسالتنا بأداء حقوق الله وحقوق العباد، وعون عشاق الحرية على التحرير والخلاص في كافة أرجاء البلاد، ولاسيما إخواننا الأماجد من أبناء شعب فلسطين المجاهد، وقبلتنا الأولى وقدسنا الشريف الخالد، ولنقف على قدم الاستعداد، بكل ما يلزم من العدة والعتاد، واثقين بحقنا متمسكين في نفس الوقت بديننا معتزين بحضارتنا، حريصين على حفظ مقوماتنا، والدفاع عن كياننا، ملتزمين في حياتنا اليومية بآداب عقيدتنا، وتعاليم شريعتنا، ولنتسلح لمواجهة مسؤولياتنا الثقيلة والمتنوعة في هذا العصر، باكتشافات القوة الفكرية التي هي “قوة العلم”، وأدوات القوة المادية التي هي قوة السلاح، وطاقات القوة الروحية التي هي قوة الأخلاق، ولنجعل شعارنا اليومي الدائم، العلم النافع، والعمل الصالح، والإنتاج المستمر، والكسب المشروع، والرقي المطرد، والتنافس المحمود، والسير الدائم إلى الأمام، وضرب المثل لبقية الأقوام، ولنحول دنيا الإسلام الواسعة التي لا تغيب عنها الشمس، إلى “مسجد كبير” نعبد الله جميعا في محرابه، ونقوم فيه بالخلافة عن الله في الأرض طبقا لما جاء في كتابه، ولنجعل من القرن الجديد حلقة ذهبية في تاريخ الإسلام المجيد”[21].
د. يوسف الكتاني

(العدد 13)
الهوامش
- أخرجه ابن عساكر عن أنس، وصححه السيوطي.
- رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، 2/1297.
- حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي، للدكتور فتحي الدريني، مجلة نهج الإسلام، ص: 32، عدد ذو الحجة 1401، أكتوبر 1981.
- حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي، ص39.
- رواه الإمام أحمد في المسند، ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد للهيثمي، 3/266. كشف الأستار، 2/435.
- أخرجه البخاري في صحيحه، 1/13، ط: دار الفكر.
- رواه الطبراني في الكبير، مجمع الزوائد للهيثمي، 3/272.
- أخرجه البخاري في صحيحه، 5/97.
- رواه ابن عبد البر في العلم عن أنس، والبيهقي في شعب الإيمان، انظر مختصر شرح الجامع الصغير للشرنوبي، 2/89.
- من رسالة خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس ولاة كسرى على ألوية العراق عندما هم بفتحها.
- رواه الخطيب في التاريخ، انظر مختصر الجامع الصغير، للشرنوبي، 2/269.
- رواه الإمام أحمد في المسند، 6/256. وأبو داود، 1/61. والترمذي في سننه، 1/74 و75. والدارمي في سننه، 1/195.
- انظر تفصيل ذلك في كتابنا، معالم إسلامية، ص: 33-36.
- رواه العراقي في المغني، والقاري في الأسرار المرفوعة. انظر معجم أطراف الحديث، 3/109.
- رواه الترمذي في سننه، 4/50.
- رواه أبو داود في سننه، ج 2، 488. والزبيدي في الإتحاف، 7/533.
- انظر تفسير الطبري، الجزء الثلاثون، سورة الانشقاق. وهو المعنى الذي ذهب إليه الإمام الرازي بقوله: “بإمكان حدوث ذلك وتحققه مهما كان خارقا.
- راجع تفسير الرازي، مفاتيح الغيب، سورة العنكبوت.
- أخرجه مسلم في صحيحه، البر والصلة، ب 10، رقم 32. والإمام أحمد في المسند، 2/277 و 360. والترمذي، ح 1927.
- سيرة عمر بن الخطاب، لابن الجوزي.
- رسالة أمير المؤمنين بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري، ص: 20-22