
ما يميّز العصر الحديث هو نهاية الإيديولوجيات (أو اليقينيات الصلبة)، واختراق روح المساءلة والنقد كل المجالات، وخاصة المجال الديني. وقد ساهمت التكنولوجيات الحديثة مساهمة كبيرة في زيادة وتيرة التغيير والتطور، واعتناء الإنسان بالشأن الديني وبمكانته وبمصيره في زمن العولمة (مسألة الهوية مثلا وهي تصير في اتجاهين متعارضين)، مما انعكس ارتباكا وعدم طمأنينة لكثرة ونوعية المسائل/التحديات المطروحة والتي أظهرت قصر الفكر الإسلامي وضعف الأجوبة/الحلول المقترحة.
ومن جانب آخر، أضحى قبول الإجابات للتحديات المطروحة مربوطا ارتباطا وثيقا بمدى نهلها من المعرفة الحديثة ومعقوليتها في التفاعل مع القضايا الإنسانية، وبمدى رجوعها إلى أهل الاختصاص والمتمكنين من المعرفة الجديدة ومن أدواتها. أنتجت هذه الوضعية تكريسا لمفهوم النسبية (سبقها بفترة قصيرة مفهوم النسبية الفيزيائي الأينشتايني)، نسبية الخطاب الديني (نصا وممارسة) ونسبية المعرفة ككل، وأعطت قيمة كبيرة للحرية الفردية وللمسؤولية الشخصية في مقابل إضعاف الانسجام الاجتماعي والأحقية التاريخية (باسم العائلة، العشيرة، العنصر العرقي، الدولة، إلخ).
ومحصلة هذه التحولات المختلفة هو انفتاح الإيمان الديني على التفكير النقدي، وتكريس إمكانية التمييز العقلاني والاختيار الشخصي مع محاولة تجاوز الإيمان التقليدي المبني على ضرورة الخضوع لهيمنة التقاليد والتراث. “هكذا عدّ الدين بمختلف إنتاجاته الرمزية وتجلياته وطقوسه ونصوصه ظاهرة من جملة الظواهر الأخرى الممكن درسها والممكن إخضاعها إلى السؤال الفلسفي والتفكير العلمي الرصين الذي ينأى عن الرؤية اللاهوتيّة بتجلياتها المختلفة والمتنوعة، وصار الدين بعدما كان يفسّر كل الظواهر عرضة بدوره للتفسير والمساءلة، كما أضحى تحليل التجربة الدينية تحليلا أنثربولوجيا في علاقتها بالمقدس وبالنسيج الاجتماعي وبالأطر الثقافية والممارسة الطقوسية”[1].
من هذا المنطلق سنسعى في هذه المقالة إلى التطرق إلى النموذج المعرفي الذي حاول إنشاءه النبي إبراهيم، عليه السلام، وتكريسه معتمدين على العنصر التأويلي التي تسمح به الآيات القرآنية، محاولين تجاوز البعد البياني/اللغوي الذي تعول عليه أكثرية التفاسير التقليدية لقصة إبراهيم. وهذا المنحى ليس تنقيصا من قيمة البعد البياني/اللغوي بقدر ما هو وعي بالمقتضيات المعرفية التي تتطلبها المرحلة الحالية التي هي مرحلة تحدّ معرفي بالأساس.
ومن هذا الباب فقد حاولنا، قدر الاستطاعة، الإجابة على هذه الأسئلة:
ـ هل يمكن أن نستخرج من القصص القرآني نموذجا معرفيا؟
ـ هل قصة إبراهيم، عليه السلام، تقدم لنا مثالا معرفيا وهل يمكن أثبات ذلك؟
ـ هل إذا كان إبراهيم من أولي العزم من الرسل وهو أبو الأنبياء، فلماذا هو الرسول الوحيد الذي حباه الله تعالى باسم خليل الله واعتبره أمة لذاته؟
ـ ما الذي يميزه عن الأنبياء الآخرين حتى يتمتع بهذه المنزلة الخاصة والحصرية؟
الم يكن لبعض الرسل وأنبياء آخرين نفس السلوك والأخلاق التي تمتع بها إبراهيم حتى يحرموا كلهم من هذه المنزلة، أم أن هذه الحظوة التي تمتع بها إبراهيم لم تكن مقتصرة على الجانب الأخلاقي فحسب؟
ـ هل إبراهيم، عليه السلام، هو الرسول الوحيد الذي صبر على البلاء وعلى الكفر، وقدم من التضحيات الكثير فكان مثالا للصبر والفداء حتى قال الله تعالى في حقه: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ (الممتحنة: 4)، أم أن لإبراهيم خاصيات جعلته يتميز بها عن كل الأنبياء والرسل إلى درجة أنه كان في نفس الوقت أبو الأنبياء، وخليل الله، وأمة؟
ـ هل يمكن أن نستخرج نموذجا معرفيا من خلال تجارب إبراهيم، عليه السلام، من تعامله مع الظواهر الكونية ومع الظواهر الاجتماعية (أبيه وقومه وأهله والملك)، أم هي قصص للعبرة وللقدوة الأخلاقية في مقابل الجحود والعناد والتعصب والتقليد الأعمى.
ـ هل هنالك خط ناظم يحكم التحرك الإبراهيمي ينم عن منهج متماسك أم هي مجرد تفاعلات/تجارب مختلفة يجمعها البعد الأخلاقي الدعوي كما تروج له أغلبية ما كتب عن إبراهيم.
ما شدنا في التجارب المختلفة التي قام بها إبراهيم أنه يبدو وكأنه رسول في طور التعلم والبحث. فهو لم تأته رسالة تؤذن ببداية مهمته الدعوية، بل كان يبني رسالته بتفاعلاته مع الظواهر الكونية والاجتماعية، يعني أن إبراهيم نموذج تجلت فيه إرادة الله وبيانه الهادي إلى تأسيس منهج نبوي جديد، وهو ما يمكن أن نسميه المنهج العقلي أو “الشك المنهجي[2]. فإبراهيم لم يصبح رسولا فجأة، بنزول الوحي عليه، بل أصبح رسولا بإتباع عملية تعليمية، وتدريب عقلي معين، تفاعل فيه مع العديد من الظواهر.
أولا: تجربة إبراهيم مع الظواهر الكونية
قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام: 76-80).
تبين لنا هذه الآيات كيفية تعامل إبراهيم مع الظواهر الكونية؛ فالله تعالى يقول في أول هذه الآيات أن الغاية من هذه التجربة الإبراهيمية هو أن يكون خليله من الموقنين. والموقن هو اسم فاعل من أيقن، يعني متأكدا، عالما، مؤمنا، متحققا. وتؤكد الآية أن إبراهيم هو الذي سيريه الله ملكوت السّماوات والأرض حتى يصبح متأكدا/متحققا من ملك الله ولم يقل “وكذلك نري قوم إبراهيم ملكوت السّماوات والأرض وليكونوا من الموقنين”؛ فهذا الخطاب ليس موجها لقوم إبراهيم.
وهذه التجربة ليست لإقناعهم ببطلان اعتقاداتهم وفساد عقائدهم من خلال إدعاء إبراهيم مشاركتهم عبادة الكواكب والنجوم، ومن ثم استدراجهم لتناقض عقلي/منطقي أساسه الظواهر الكونية، وإنما هو تأكيد على المنهج التجريبي الرياضي الذي سيتوخاه إبراهيم للوصول إلى التأكد من الله وليس من وجوده.
إذن إبراهيم، الذي يدرك أن هنالك إلها للكون، سينظر إلى هذا الكون. ومع أنه ينظر إليه كل يوم، إلا أنّ هذه المرة تعد بداية جدية للإجابة عن أسئلة طالما حيّرته مرتبطة بصدق/كذب المعتقدات المتفشية في مجتمعه؛ فالمجتمع الإبراهيمي كان يؤمن بالخوارق والمعجزات وخاصة بالظواهر غير العادية التي تغّير/تعطّل الظواهر الكونية كدليل قدرة الآلهة وسلطتها على الكون وعلى الإنسان. فالتجربة التي سيقوم بها إبراهيم لها علاقة بالآلهة التي كانت تعبد في زمانه وفي مجتمعه.
فقد أثبت علم الحفريات الحديث أن المنطقة التي كان يعيش فيها إبراهيم (مدينة أور وما جاورها) في الألفية الثالثة قبل الميلاد (يعتقد أن إبراهيم ولد حوالي سنة 2166 قبل الميلاد) أن كل دولة/مدينة أصبح لديها آلهة محلية، تختلف في ذلك عن جيرانها. من أهم الآلهة المحلية التي كانت تعرف في منطقة آور في تلك الفترة يمكن ذكر: إله القمر (نانا/سين)، إله الشمس والحق والعدالة (أوتو/شمش) وإله الخصوبة والحرب (كوكب الزهرة).
ويعتبر توجه إبراهيم نحو السماء كخطوة أولى في منهجية البحث عن الصفات الإلهية متماهية مع التصور المتفشي في تلك الفترة، حيث كانت السماء تتمتع بأولوية خاصة في التصور الديني، وتحمل الصفة الإلهية بما أنها مصدرا للأمطار التي تتجمع في الأنهار، وبالتالي تسمح بري الأراضي الزراعية فهي، إذن، رمز للحياة.
وما كثرة الآلهة التي كانت تعبد في تلك الفترة إلا تجسيدا للاعتقاد الراسخ أن قوى كونية مختلفة تسير الإنسان، وتتحكم في كافة مظاهر حياته وبالتالي في مصيره. ويمكن اعتبار هذه الفترة أنها تمثل تطورا في التصور الديني بما أن هذا التجسيد للآلهة يرمز إلى البعد الفكري/المادي للدين.
فقد تم تجاوز المرحلة البدائية التي كان فيها الدين يعبر عنه عن طريق اعتقادات ورسوم (أغلبها للحيوانات)، وممارسة السحر (مرحلة الصيد)، نحو مرحلة أكثر تطورا بدأ فيها الفكر الديني يأخذ منحى جديدا (مرحلة الزراعة). فقد أصبح الإنسان يرى أن هنالك علاقة مباشرة بين ما هو مادي/نفعي وما هو فكري، بين الإنتاج الاقتصادي/الزراعي والقوى الطبيعية، وأن سعادته في الدنيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى رضا هذه القوى عنه[3].
سيتجه إبراهيم عند بداية تجربته المعرفية للتأكد من الصفات الإلهية إلى أهم وأقدس الكواكب في السماء وهو كوكب الزهرة، إله الخصوبة والحرب، إله الحياة (الإنسانية والطبيعية) وقاهر الأعداء. ولكن وعكس الإيمان التقليدي المبني على التلقي، سيقوم إبراهيم بتفعيل منهج عقلي (Rational Process) هو بالأساس ذو صبغة تحليلية ببعد نقدي/مقارن؛ فمن جهة، لم تتنزل على إبراهيم أية رسالة أو كتاب مسطور حتى يصل إلى مرحلة اليقين (ليكون من الموقنين)، ومن جهة أخرى، بقي له الكتاب المنظور الذي من خلاله يمكن له أن يتأكد من قدرة الله ومن صفاته. والكتاب المنظور يتمثل في الظواهر الكونية التي توجه إليها إبراهيم في أول تجربة معرفية للوصول إلى أن يكون من الموقنين كما خطط له الله.
إذن أول مظاهر رفض إبراهيم لألوهية الكوكب المقدس هو نسبيته، فأفوله (غيابه، خموله) هو علامة على عدم قدرته على أن يكون مطلقا: بارزا/حاضرا في كل زمان ومكان. إذا للتخلص من فكرة ألوهية الكوكب كان يجب على إبراهيم استعمال علم المنطق: النسبي عكسه المطلق، والكل أكبر من الجزء. فأفول الكوكب هو دليل على نسبيته والتي لا تستطيع أن تضاهي الكل/المطلق. ولكن إبراهيم مازال في هذه المرحلة يرى أن الله يمكن أن يتجسد في الأشياء، وأن قدرته وذاته وتمظهراته هي شيء واحد. وهو مازال مرتبكا، مازال يظن أن بعض الكواكب يمكن أن يكون لها قدرة على تحديد مصير الإنسان.
ولكن لماذا هذه التجربة الأولى مع كوكب الزهرة لم تكن كافية للوصول إلى نتائج نهائية وتمنع تكرار نفس التجربة مع كوكب آخر/ كوكب القمر. ما الذي دفع إبراهيم إلى اعتبار القمر كوكبا لا تنطبق عليه نفس قوانين المنطق التي طبقها على كوكب الزهرة للتأكد من عدم صلوحيته لأن يكون إلها. هل لأنه أحد الآلهة التي تحظى بمكانة مميّزة عند قومه، أم لأنه تنطبق عليه قوانين مغايرة للتي تنطبق على إله الخصوبة والحرب، كوكب الزهرة؟
يعتبر القمر سيد الحكمة ورئيس مجمع الآلهة في كل التاريخ القديم لوادي الرافدين. وهو بالدرجة الأولى إله البدو، فهو دليلهم وحاميهم في الليل عندما يقومون برحلاتهم في أوقات عديدة من السنة. والقمر هو أبو كوكب الزهرة وسيد الشهور (نانا: رجل السماء). فيبدو أن ذكر كوكب القمر في القرآن إثر كوكب الزهرة للدلالة على مبدأ التمايز المبني على علاقة أفقية وأخرى عمودية.
فالعلاقة الأفقية هي علاقة أزواج أو تزاوج، فمن جهة كان البشر في ذلك الزمن وفي تلك البقعة يعتقدون أن هنالك آلهة إناث (كوكب الزهرة) ومن جهة أخرى هنالك آلهة ذكور (كوكب القمر). والعلاقة العمودية هي علاقة أب بابنته (القمر هو أبو كوكب الزهرة). إذا أفول كوكب القمر ورفض هذا الأفول هو عبارة عن رفض لمبدأ التزاوج، وتكريس لمبدأ التوحيد. الإله الذي يفتش عنه إبراهيم لا يستطيع أن يكون في علاقة مع أي إله آخر، لا أب ولا ابن ولا ابنة ولا زوجة. يجب أن يكون متعال على كل العلاقات ذات الطابع الإنساني/الطبيعي (الأبوة والبنوة، والتزاوج) ومهما بلغ من حكمة فحكمته متجاوزة للقمر، سيد الحكمة. ورغم وصول إبراهيم إلى هذه المرحلة المتطورة مقارنة بالمرحلة الأولى، إلا أنه مازال لم يتجاوز مرحلة التجسيد، مرحلة دمج الذات بالصفات وبالقدرة الإلهية.
فقد وصل إلى قناعة أنه يوجد إله مطلق، كلي، واحد، لا يضاهيه أحد، ولا تنطبق عليه قوانين الظواهر الطبيعية والإنسانية، ولكن لا يزال يفتش عنه في السماء، ويريد أن يتأكد من وجوده عبر رؤيته رأي عين. وهو رغم أنه يقرّ أن المنهج العقلي الاستدلالي محدود وبحاجة إلى هداية خارجية حتى لا يظل ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾. ولكن وفي الوقت نفسه، هو لا يلغي أو يقزم هذا المنهج العقلي الاستدلالي، بما أنه سيقوم بتجربة ثالثة وأخيرة يتجه فيها إلى كوكب الشمس باستعمال نفس المنهج الرياضي/المنطقي.
ومرة أخرى، يواصل إبراهيم تمرينه العقلي حتى يكون من الموقنين. وهذه المرة سيتوجه نحو الشمس ابن إله القمر وأخو إله الزهرة. فهو رمز السلطة، ولأنه ينير الظلمة فهو إله العدالة والحق والشرائع. وسيعتبر إبراهيم الشمس إلها بناءً على أنه أكبر من القمر ﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾. وأكبر هو اسم تفضيل من كبر يفيد المقارنة أو الإطلاق. إذا الإله الذي يفتش عنه إبراهيم يجب أن يكون أكبر من كل شيء، أهم من أيّ شيء آخر.
والمقارنة بين القمر والشمس تحتم ضمنيا الاعتراف بالظاهرة الكونية المتمثلة في تداول الليل والنهار وتضادهما. ولكن أفول الشمس وإنكار ذلك من طرف إبراهيم على نفسه وعلى قومه هو تعبير عن رفض مبدأ التعاقب بين الأشياء، حتى وإن كان الذي يعقب أكبر وأهم وأعظم من المعقوب. فالإله الإبراهيمي لا ينطبق عليه مبدأ المقارنة والتعاقب والتضاد. فهو متجاوز لكل هذه الصفات ولكن في نفس الوقت لا يستطيع إبراهيم تحديده.
فالتجربة الإبراهيمية في هذه المرحلة هي تجربة سلبية، تنكر ألوهية الكواكب التي كانت تعبد في تلك الفترة لقصورها عن التعبير عن صفات الله، وهي في نفس الوقت تجربة مرت جزئيا إلى المرحلة الإيجابية، المرحلة التي من المفروض أن تحدد صفات الله، وأن تفصل هذه الصفات عن القدرة المطلقة الإلهية. فإبراهيم يقر بقدرة الله، بأن الله هو خالق السماوات والأرض، وأنه سيبقى ثابتا على هذا الاعتقاد (حنيفا) ولن يتبع طريق المشركين.
ففي ختام هذه التجربة تم فصل الله عن كل التمظهرات الطبيعية، وتم تجريده عن التجسيد الذي تتصف به الآلهة الأخرى (الزهرة والقمر والشمس)، ثم تم تجريده من الخصائص التي تحرك الآلهة المتعددة: التضاد، التناوب، التزاوج، إلخ. ولكن هذه التجربة العقلية التي أدت إلى إيمان إبراهيم بقدرة الله وبصفاته (أو بغياب الصفات التي تنطبق على الآلهة الأخرى) هي في حاجة إلى تصديق.
صحيح أن إبراهيم انطلق من أساس عقلي/منطقي للوصول إلى الإيمان بالله، ولكن هذا الإيمان هو في حاجة من جانبه أيضا إلى أساس عقلي/علمي، إلى رؤية قدرة/مشيئة الله التي تتجاوز كل قدرات الآلهة الأخرى؛ فإله إبراهيم له قدرة فعلية على تغيير الأشياء إن أرادت مشيئته ذلك، على عكس الآلهة الأخرى. ويجب أن يتأكد بنفسه من هذه القدرة/المشيئة حتى يمر من التصور العقلي/المنطقي للإله إلى التصور التصديقي/الإيماني المبني، هو نفسه، على تجربة مادية.
ولذلك، وفي نفس السياق المنهجي العقلي الاستدلالي، سيطلب إبراهيم من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، ليس كانبهار بمعجزة خارقة للعادة بل ليتحقق من تطابق قدرة الله مع مشيئته. فالتمشي المعرفي الإبراهيمي لا يؤمن بالخوارق والمعجزات، بل هذه الأشياء الخارقة للعادة والوهمية يمكن أن تهدم كل المنهج العقلي الذي يعتمده إبراهيم للتعامل مع الظواهر الطبيعية ومع القدرة الإلهية. ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: 259).
فالمراحل السابقة التي مر بها إبراهيم أوصلته إلى العلم بأن الله موجود (ولذلك لم يطلب أن يرى الله)، ولكنه يريد أن يربط هذا العلم بعملية التصديق المبنية على التجربة التقريرية. فالعلم غير المثبت بالتجربة المادية يبقى علما نظريا أو فلسفة، يصعب الاقتناع به وإقناع الآخرين به. ولذلك عندما سيسأل الله إبراهيم هل يشك في قدرته على إحياء الموتى، سيكون الرد الفوري لإبراهيم أنه لا يشك في تلك القدرة نظريا، ولكنه يريد أن يعيش تجسيد تلك القدرة في تجربة تتفوق على كل التجارب الطبيعية والاجتماعية، تجربة مادية متفوقة على كل التجارب التي يمكن أن تؤتيها الآلهة الأخرى، فيراها رأي عين حتى يطمئن قلبه.
فهو، بعد عملية تجريد لفكرة الإله التي قام بها إثر أفول الكواكب المتعددة، يطلب من الله تجسيد لقدرته/مشيئته حتى لا يبقى إيمانا نظريا وذلك بتحقق تجربة إحياء الموتى. مرة أخرى إبراهيم يريد أن يقر مكانة العقل في العملية الإيمانية، بالمرور من النظري إلى العملي، من التجريد إلى التجسيد، من القدرة إلى المشيئة. وستتحقق هذه المشيئة عبر إعادة بعث لأجزاء مختلفة من طير واحد (أو من طيور مختلفة) تم توزيعه على جبال مختلفة وعاد إلى إبراهيم ساعيا بعد أن قام بدعوته.
المهم في هذه التجربة أن إبراهيم هو الذي يقوم بها، فهو مشارك إيجابي وليس مشاهد سلبي لقدرة/مشيئة الله. فهو الذي يقوم بكل مراحلها، فالتجربة العقلية العلمية تتطلب من صاحبها أن يواكب كل مراحلها، وأن يتأكد بنفسه من شروطها، ومن بيئتها ومن نتائجها. وهي تجربة تتوسع في المكان (أفقيا وعموديا) وفي الزمان فأجزاء الطير وضعت في أماكن متباعدة (البعد الأفقي) وعلى أعالي الجبال (البعد العمودي)، وأنه تطلب وقتا معينا لتوزيعها.
هنا ينتهي الجزء الذي يستطيع إبراهيم أن يتصرف فيه، أن يهيمن على مكوناته. وهنا يبدأ لقاء قدرة الله مع مشيئته في هذه التجربة. فعملية إحياء الموتى هي عملية متجاوزة للزمان والمكان، متجاوزة للمفاهيم الأنطولوجية المكونة للإنسان، بما أن الطير سيبعث آنيا بعد أن تم توزيع أجزائه فوق الجبال حتى يستطيع إبراهيم أن يدعوه وأن يأتي مسرعا/ساعيا.
فإبراهيم لن يشهد كيفية رجوع الروح إلى الطير، بل سيشهد نتيجة هذه العملية. فهذا الجزء من التجربة ليس له أية علاقة بالمنهج العقلي العلمي عند تحققه وهو متجاوزا له (هذه من صفات الإله)، ولكن نتيجته هو الذي يغرس/يكرس البعد الإيماني/التصديقي. ومن هنا مطلوب من إبراهيم أن يعلم أن الله متجاوزا لكل المفاهيم التي قام باستعمالها عند تجربته الأولى وفي نفس الوقت متجاوزا للمكان والزمان عبر آنية البعث. وهنا يتحقق طلب إبراهيم للتحقق من عملية البعث التي ستصبح متاحة لكل إنسان في يوم البعث.
إذا أردنا على هذا المستوى أن نلخص منهجية إبراهيم المعرفية، يمكن القول أنها منهجية خاضعة بالأساس إلى علم الرياضيات (الذي يعتبر عملية تجريد التجريد، وقانون عدم التناقض، والعلاقات المنطقية) بما أنه يغلب عليها البعد الرياضي/الاستقرائي عند توجهه نحو عالم الطبيعة للبحث عن صفات الله. وبتوجهه هذا واجه الآلهة التي كانت مهيمنة على العقلية الإنسانية في تلك الفترة، الآلهة التي يكتنفها الأفول بما أنها تخضع للقوانين والسنن الطبيعية.
فإبراهيم سيطبق التمشي الرياضي المتمثل في مراقبة الظواهر الطبيعية واختبارها، من خلال ادعاء فرضية، ثم مراقبتها، وفي الأخير تأكيدها أو تفنيدها. ولكن ككل حل لمعادلة رياضية يسبقها بديهيات Axiom(s) والتي من دونها يستحيل حلحلة أية مشكلة رياضية، فبديهيات إبراهيم تتمثل أولا في قدرته على التمييز بين الكواكب والآلهة Identification، وخاصة إمكانية تمظهر الإله في آلهة مختلفة لاختلاف خصائصها، وثانيا القدرة على تصنيف الأشياء Classification حسب مكانتها في السماء ومقارنتها فيما بينها[4] ﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾، وثالثا رفض أن يكون مجموع العناصر المعنية بالمعادلة الرياضية تقبل أن يكون مجموعها يساوي الصفر f(x)=0)∑)، مما يعني أن كل عنصر يلغي نفسه أو أن عنصر آخر يقوم بإلغائه (مفهوم أفول الآلهة الذي ينطبق على كل كوكب فيلغي كل كوكب/إله نفسه (مبدأ التناوب) أو مجموع الكواكب/الآلهة تلغي بعضها بعضا (مبدأ التضاد).
بعد هذه التجربة التحليلية/الاستقرائية للظواهر الطبيعية، وبعد عملية التجريد للآلهة المتجسدة في الكواكب، يستنتج إبراهيم استحالة حلحلة المسألة بالمقاربة الرياضية البحتة، وأن العملية الإيمانية/التصديقية تتطلب مقاربة تكميلية هدفها طمأنة القلب ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾؛ فإبراهيم في بحثه عن التأكد من قدرة/مشيئة الله وحتى يكون من الموقنين بها سيطلب مشاهدة عينية (تجسيد) لهذه القدرة المتمثلة في عملية الإحياء الآنية. ورغم أن هذه العملية هي فوق عادية، إلا أنها تخضع في جزئها الأكبر عند تحققها للتجربة الرياضية أيضا. فإبراهيم يمسك بكل مراحل التجربة ويصبح هو القادر على إعطاء الأمر لعملية الإحياء. والطيور (لن نضيع وقتنا في شرح إن كانت طيورا أو طير واحد، وما نوعها، وما لونها، إلخ.) بعد أن عادت إلى الحياة لم تطر إلى حالها في اتجاهات مختلفة، بل توجهت سعيا نحو إبراهيم الذي أصبح المحور المركزي لتجربة الإحياء (فالطير تعلم من قام بمناداتها وإحيائها). فقدرة/مشيئة إبراهيم النسبية على إعادة الحياة إلى الموت هي من قدرة/مشيئة الله المطلقة لإعادة الحياة إلى الموت. فقد تم خلال هذه التجربة تحويل لقدرة الله ومشيئته إلى قدرة إبراهيم ومشيئته حتى تتم عملية الإحياء. فالمشاركة الفاعلة والحية لعملية الإحياء تمنع كل إمكانية للتأويلات المختلفة، وللشك وللوهم وللخرافة بما أن المعقول تطابق مع المحسوس، عالم الحقيقة تطابق مع عالم الغيب.
في هذا الجزء الثاني من التجربة الإبراهيمية، وإثر عملية التصنيع حتى يصبح إبراهيم نبيا من خلال تثبيت المنهج الرياضي/الاستقرائي للنظر إلى الكون والمنهج الإيماني/التصديقي للوصول إلى حقيقة قدرة/مشيئة الله، سيبدأ إبراهيم مشواره في الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الله، والتخلي عن الآلهة المتعددة متوجها من الخاص إلى العام (الأب/الملك/القوم)، من سلطة العائلة، إلى السلطة السياسية ومن ثم إلى سلطة المجتمع.
فإبراهيم سيتوخى مبدأ الجدل العقلي الذي أساسه المنهج التشكيكي/النقدي عندما سيتوجه بدعوته إلى المكونات المختلفة لمجتمعه. وقد قام القرآن الكريم بعرض بطريقة وجيزة وبليغة للمواقف المختلفة التي عاشها إبراهيم في حياته والتي تمثل الجوانب المختلفة لمنهج دعوته عند توجهه إلى الفئات المختلفة من الناس، وكيفية أقلمة خطابه مع كل فئة منها حتى تتماشى مع مستويات تفكيرها وتصوراتها ومعتقداتها.
فالقرآن الكريم من خلال القصص الإبراهيمي يؤسس للتواصل الجدلي كإستراتيجية لبناء الملكة الحجاجية مما يسمح بالوصول إلى الحقيقة. فالحجاج في التصور القرآني متأصل في التكوين الأنطولوجي للإنسان ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾، وهو الذي يسمح بالوصول إلى المعرفة، ومن ثم إلى الحقيقة. ولذلك يتعين علينا من جهة، فتح الباب أمام الاختلاف على مصراعيهما يتطلب منا الاعتراف بوجود الآخر وليس إلغائه أو إقصائه، ومن جهة أخرى اعتبار أن هنالك طرق مختلفة للوصول إلى المعرفة/الحقيقة.
فإبراهيم، بعد المرحلة التكوينية الأولى، مرحلة “بناء الفكرة” التي سمحت له بالوصول إلى تجاوز فكرة التجسيد المادي للإله، ومن بعدها التأكد من قدرته/مشيئته المطلقة من خلال طلب مشاهدة عملية إحياء الموتى، فإنه سيمر إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة لا تقل أهمية عن الأولى، مرحلة “الدفاع عن الفكرة”.فبعد التأكد من وجود الإله في إطلاقيته والمتجاوز لكل الآلهة الأخرى في قدراتها (الفاقدة للقدرة/المشيئة المطلقة)، سيمر إبراهيم إلى العالم النسبي، إلى عالم مقارعة الأفكار والمعتقدات بأفكار ومعتقدات أخرى، إلى عالم المساءلة النقدية والمجادلة العقلية.
ثانيا: تجربة إبراهيم مع الظواهر الاجتماعية
1. دعوة إبراهيم لأبيه
يمكن اعتبار الجدال الذي تم بين إبراهيم وأبيه أول لبنة لهذا المنهج. فقد قال تعالى في سورة مريم: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ (مريم: 40-48)
تؤسس مجادلة إبراهيم لأبيه لعلوية العلم وأسبقيته، في مقابل التقوقع على العلاقات العائلية وما يمكن أن تؤدي إليه من سلطة الأب على الأبناء ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ حتى وإن كان هذا العلم نسبي ﴿قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ﴾ (ولم يقل جاءني العلم). وعلى هذا الأساس، فإن إبراهيم سيدعو أباه إلى إتباعه، إلى التصديق/الإيمان بهذا العلم، ومن ثم قلب العلاقة لتصبح من الأب نحو الابن.
إذن، أساس العلاقة الإيمانية هو ما توصل إليه الإنسان من علم وليس العائلة أو العشيرة أو القبيلة (القرابة الدموية). وأن باتباع هذا العلم نصل إلى النتائج الصحيحة، وإلى الحقيقة بأقصر الطرق؛ ﴿فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾. وهي الدعوة التي سيدعو بها كل مسلم في سورة الفاتحة عند كل صلاة ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾. وأن عدم إتباع هذا الطريق إهدار للوقت وللجهد ﴿لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ واتباع للوهم والخرافة والجهل ﴿مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾؛ لأن هذه القيم السلبية هي التي يكرسها الشيطان ويدعو إليها بتغييب السمع والبصر.
ولكن الأب يقر بأن العلاقة بين الأب والابن تتوسطها علاقة إذعان للقوى الطبيعة المتجسدة والمشتتة في الآلهة المختلفة وأنه مستعد للتضحية بهذه العلاقة (بين الأب والابن) إن لم يمتثل إبراهيم للمنهج الشيطاني (كذلك من القيم السلبية لهذا المنهج استعمال الرجم والهجر حتى مع أقرب الناس). ولكن ورغم هذا الجفاء، فإن إبراهيم لن يقطع هذه العلاقة كلية مع أبيه (سيعتزله ولن يهجره) (الهجر؛ هو الترك والإعراض والقطع) (الاعتزال؛ هو الابتعاد والتنحّي) وسيدعو الله أن يغفر له.
وهنا يبرز تفوق المنهج الذي يدعو إليه إبراهيم المبني من جهة على العلم الذي آتاه، ومن جهة أخرى، على السلام: ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ﴾، السلام الذي هو عنوان علاقته بالآخرين، وأساس حركته في الكون في مقابل المنهج الشيطاني الذي يدعو من جهة، إلى عدم استعمال العقل (باسم التقاليد، وأحقية معرفة الآباء عن الأبناء) ومن جهة أخرى، تكريس العنف والنكران كحل لمشكلة الإيمان/التصديق.
2. دعوة إبراهيم للملك
قال تعالى في سورة البقرة ، حاكياً محاجة إبراهيم، عليه السلام، مع الملك : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: 257).
أما المناظرة التي تمت بين الملك وإبراهيم فمحورها إدعاء الملك الألوهية لنفسه، وأنه قادر أن يضاهي إله إبراهيم في القدرة/المشيئة. فالمجادلة بين إبراهيم/الملك، والمتكونة من مرحلتين، تنطلق من التباس أو من سوء فهم. ذلك أن إبراهيم، متسلحا بالتجربة التي عاشها عندما طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، سيقوم بتأكيد نتيجة هذه التجربة ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ كتحدّ لقدرة الملك، منتظرا منه أن يقوم بنفس التجربة إن كان قادرا على ذلك.
لكن الملك سيفهم هذا التحدي على أنه تحدي لسلطته السياسية التي من مشمولاتها القدرة على إعدام الأشخاص من عدمها، وليس قدرة على الإحياء من عدمها. يمكن فهم هذا اللبس في فهم التحدي الإبراهيمي أن أصحاب القرار (الملوك/الأمراء/الرعاة) يشاركون الله في الجمع بين القدرة والمشيئة في حالات معينة (نسبيا). وأن هذه القدرة متأتية من الصفات المتأصلة في الإنسان؛ منها صفة الحرية (حرية أخذ القرار) وصفة القوة (قوة تطبيق ذلك القرار). فهذه الصفات يشارك فيها الإنسان الله سبحانه وتعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾.
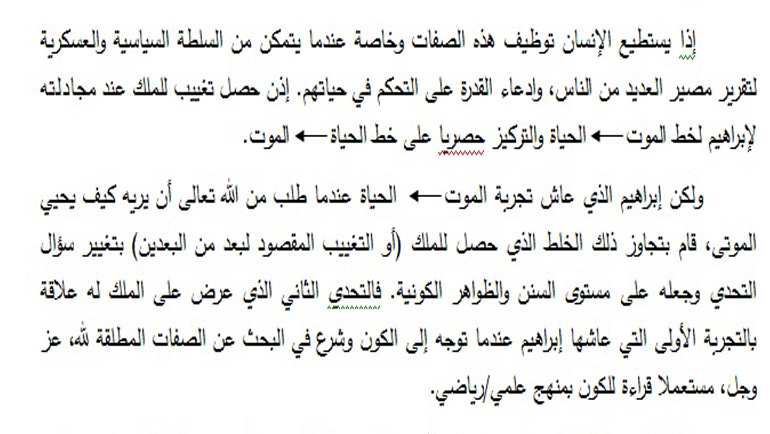
وهذا التحدي لا يقبل بعدان، بل هو طرح واضح وجلي ذو بعد واحد، يجعل الملك على مستوى القدرة المطلقة لله القادر، ويطلب منه الجمع بين القدرة والمشيئة في نفس الوقت لتغيير سنّة من سنن الكون. فبالنسبة لإبراهيم فإن الله تعالى هو الذي سنّ هذه السنن الكونية (الله يأتي بالشمس من المشرق)، وهذه بديهة من البديهيات (Axiom)، وعلى الآخر إثبات العكس (Reductio ad absurdum). إذ قام إبراهيم عند مناظرته للملك بالمرور من المنهج الإيماني/التصديقي (حتى يثبت الملك أنه إله فيجب أن يحيي الموتى ليطمئن قلبه) إلى المنهج العلمي/الرياضي (حتى يثبت الملك أنه إله يجب أن يأتي بالشمس من المغرب ليقر له القدرة/المشيئة المطلقة).
3. دعوة إبراهيم لقومه
قال الله تعالى في سورة الشعراء: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء: 69-77).
تتعدى المناظرة بين إبراهيم وقومه المستوى النظري (المبنية على طرح سؤال، والإجابة عنه كما كان في حالتي أبيه والملك) لتمر إلى التحدّي على مستوى الواقع المحسوس. فقوم إبراهيم متمسك بنفس التصورات الدينية التقليدية التي عرفها منذ عهد الآباء، ولن يتخلّى عن هذه المعتقدات لأنه وجد فيها أجوبة لأسئلته المتعلقة بالقوى الطبيعية المسيطرة على قدراته والمتجسدة في آلهة مختلفة يمكن التعامل معها كل على حِدة.
فهو يتعامل مع هذه الآلهة كما يتعامل الأطفال مع الآباء، آلهة تدّعي التمتع بمعرفة نسبية/مطلقة (نسبية لأنها في ميدان معين فقط، ومطلقة في ذلك الميدان) والقدرة على تغيير الواقع مما يحتم على الإنسان أن ينحني أمامها وأن يتوسل إليها، أن يتضرع، وأن يتقرب إليها حتى وإن تتطلب ذلك التضحية بنفسه أو بإنسان آخر (تقديم قربان من إنسان أو حيوان). فنموذج هذه العلاقة بين الآلهة والإنسان يتمظهر كالتالي:
آلهة متعددة متجسدة (معرفة وقدرة نسبية/مطلقة) <———> إنسان (غياب للعقل وتكريس للتقاليد)
بينما النموذج الذي يدعو إليه إبراهيم هو كالتالي:
إله واحد مجرد (علم وقدرة/مشيئة مطلقة) <———–> إنسان (تكريس للمنهج العلمي/الرياضي وللمنهج الإيماني/التصديقي)
فالعلاقة التي يدعو إليها إبراهيم هي علاقة ذات اتجاهين (<——>) على عكس العلاقة بين الآلهة والإنسان من منظور قوم إبراهيم. فبقدر ما يتقرب الإنسان إلى الله، يتقرب الله إليه، وبقدر ما يتمكن من العلم، يتعرف على الله ويتحصل على جزء من علم الله، وبقدر ما يتمكن من فهم السنن الكونية باستعمال المنهج العلمي/الرياضي، بقدر ما يتمكن من هذه السنن، ويوظف الكون لحل مشاكله.
ولكن العلاقة التي يدعو إليها قوم إبراهيم هي علاقة ذات اتجاه واحد، حيث الإنسان يتقرب إلى آلهة متعددة فاقدة لكل قدرة/مشيئة للتجواب معه (لا تسمع ولا تبصر) ولا تستطيع أن تحل أدنى مشكلة من مشاكله (لا تنفع ولا تضر) بما أنها لا تتمتع بأي علم.
ولكن قوم إبراهيم رفضوا المرور إلى هذا التصور المنهجي/المعرفي الأكثر تطورا متمسكين بالتصور الوهمي الخرافي الذي جبلوا عليه: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ومتعللين بقوة التقاليد وما تمثله من استقرار وأحقية، في مقابل التغيير الذي طلبه منهم إبراهيم والذي يفتح على تصور مغاير لما يعرفونه: ﴿أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾ ومعتبرين أن ما يدعو إليه إبراهيم ليس له أية جدية بما أنه من جهة، لا يسمح بعلاقة مباشرة ومجسدة بين الإنسان والآلهة؛ (رفض لمبدأ تجريد وجود الإله/الآلهة)، ومن جهة أخرى، معرفة الآباء والأجداد تطغى/لها أسبقية على العلم النسبي وعلى معرفة الأبناء؛ (رفض لمبدأ أن المعرفة ليست بالضرورة مرتبطة بالسن، وأنه يمكن تجاوز سيرورة تكوّنها بتدخّل خارجي).
إذن، التحدّي المطروح بين إبراهيم وقومه ليس تحدّ إيماني/ديني فحسب، بل هو تحدّ معرفي/سلطوي (كما كان التحدّي بين إبراهيم وأباه، وبين إبراهيم والملك). فالمعرفة/العلم بالنسبة لإبراهيم متأصل في إله مجرد يمثل المطلق، لا يحدّه مكان ولا زمان ﴿رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ وقد تمكّن من جزء من هذه المعرفة/العلم مما سمح له بالتفوق على المكونات المختلفة لمجتمعه ودعوتهم لتغيير تصوراتهم المنهجية/المعرفية حتى وإن تطلب ذلك جعلهم في وضعية تناقض منطقي (a logical contradictory situation) باستعمال الكيد ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾.
فاستعمال الخدعة والمكر من أجل إثبات أحقية المنهج الإبراهيمي وتفوقه لا يضر بهذا المنهج، فالوسيلة تبرر الغاية. الكيد في هذه الحالة هو أحسن السبل لأن نثبت للآخر أنه يعيش في حالة تناقض ولكن لا يقر بذلك أو لا يشعر به. والكيد هو أقصر الطرق للوصول إلى الحق، وربما الاعتراف به لمن ينكر المجادلة العقلية ويصر على الخطأ.
سيقوم إبراهيم بالتخلص من كل الآلهة المتجسدة في تماثيل مختلفة بتكسيرها إلا كبيرا لهم؛ (وكبيرهم، هنا، تحتمل معنيين: تم تكسير كل التماثيل إلا أكبرهم حجما، أو إلا أكبرهم قيمة بمعنى الذي يمثل إله كلّ الآلهة). إذا عملية جعل التماثيل جذاذا إلا كبيرا لهم هي محاولة للدفع بمنهج قوم إبراهيم إلى أقصى مداه الحسي في التعامل مع الواقع والذي يدعي أن هذه الآلهة قادرة على السمع والبصر، ومن ثم الاطلاع على كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية.
وتفعيل هذا المنهج يترتب عليه تفعيل الجدلية ذات البعدين التي يدعو إليها إبراهيم: تفاعل من الإنسان نحو الآلهة، وتفاعل الآلهة مع الإنسان، مما يعني قدرة أحدهم على الأقل (في هذه الحالة أكبرهم) أن يطلع القوم على ما يحدث، بمن قام بالتخلص من بقية الآلهة، والتي هي عملية ضرب للبعد الرمزي والقدسي للألوهية. فالذي قام بهذا الفعل الشنيع الخطير قام بهدم كل الأسس الأنثروبولوجية التي تمثلها العلاقات السائدة في المجتمع: ضرب أساس التواصل الاجتماعي والديني بين الناس والآلهة (البعد العمودي)، الحط من البعد التاريخي والرمزي الذي تمثله علاقة الأجداد بالآباء بالأبناء (البعد الأفقي)، وتفنيد صفات الآلهة التي تقول بأنها مطلعة على كل ما يحدث في المجتمع والكون وخاصة أنها قادرة على معرفة الحقيقة (السمع والبصر، النفع والضر).
مرة أخرى سيستعمل إبراهيم المنهج العلمي/المنطقي (كما قام بذلك مع الملك)، ولكن هذه المرة متموقعا من وجهة نظر معتقدات قومه، مقترحا قدرة الآلهة (أو على الأقل واحدا منها) على معرفة الحقائق كبديهة (Axiom)، ثم المرور إلى اقتراح حل للمسألة يرضي الجميع ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾.
إذن، وكما كان على الملك إثبات أنه إله بتغيير/تحويل سنة من سنن الكون، كان كذلك على قومه إثبات أن كبير الآلهة قادر على معرفة الحقائق التي غابت عنهم. ليس على إبراهيم أن يقدم أي دليل مادي مباشر (معجزة أو كتاب) لإثبات وجود الله (قدرته/مشيئته)، ولكن على الآخر إثبات أن ما يعبده هو الإله الحق، أو كما يقال في المجال القانوني، على الآخر إثبات عبء التهمة (The burden of the charge).
وأمام هذه الوضعية سيوضع القوم أمام استحالتين؛ استحالة الرجوع إلى الآلهة لحل المسألة: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾، واستحالة الإيمان بإله إبراهيم (المرور إلى تجريد فكرة الإله والتخلص من تعدده/تشتته). فمكانة التقاليد وقوة التجسيد لا تساعد كثيرا على المرور إلى تكريس المعرفة والتجريد رغم أن القوم توصلوا في قرارة أنفسهم إلى قناعة أن منهجهم باطل: ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ وأنه مبني على الوهم/عدم استعمال العقل: ﴿أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ وأن نتيجته هو الظلم: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
وكحل لهاتين الاستحالتين لم يبق إلا التخلص من إبراهيم؛ التخلص من المشكلة عن طريق تغييبها حتى يتسنى نصرة الآلهة، آلهة غير قادرة أن تنصر نفسها بنفسها: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾. وعلى غرار تجسيد فكرة الألوهية في تماثيل مادية، يقوم تصور قوم إبراهيم الحسي على ضرورة تجسيد الفكرة في شخص، وأنه يكفي التخلص من الشخص حتى يتم التخلص من الفكرة. فآلهة قوم إبراهيم غير قادرة على مواجهة الأفكار التي لا تتماشى معها (ماديا ومعنويا)، فهي تحتم التجانس الفكري حتى تستطيع أن تتواجد وأن تهيمن. وهنا تبرز، من جهة، المكانة الجوهرية للتقاليد التي عادة تسهر على التجانس الفكري والديني، ومن جهة ثانية، المكانة الأساسية للتجسيد التي ترمز إلى وجود علاقة مباشرة ومحسوسة تهيمن فيها الآلهة على الإنسان بقدرتها على تحريك القوى الطبيعية وتوظيفها لخدمة المؤمنين منهم.
إذا أمام هذه المعضلة أصبح من الضروري التخلص من إبراهيم بحرقه في النار أمام الناس: ﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾. صحيح أنه كان يجب معاقبة إبراهيم، ولكن كان يجب أيضا أن يشهد الناس المناظرة ومآلها حتى لا يخطر لشخص آخر تحدي الآلهة ومن وراءها تحدي التصور التقليدي الديني والخروج مظفرا وبدون عقاب.
إذن، عملية الحرق لها بعد تربوي بالأساس (أو كما يقول القرآن عملية صنع: ولتصنع على عيني) حتى لا يخطر لأحد التمرد عن التصور العام المتفشي في المجتمع. وعملية الحرق تعد دليلا على استحالة أن يغير إبراهيم تصوراته (لذلك لم يتم سجنه أو لم يطلب منه مغادرة المدينة)، وأن هذه التصورات تمثل تهديدا حقيقيا يمكن أن تأتي على منظومة التصورات الدينية/الفكرية/التقليدية المتفشية في المدينة برمتها. إذن، فكل مشكلة جذرية تقتضي حلا جذريا. ثم إن استعمال النار يعد رمزيا نقيضا لاستعمال الماء. فالماء يمثل الطهارة التي تسمح بالتنصل والرجوع عن الشيء بعد أن يتم غسل الجسد أو بعض أعضائه، أما النار التي تلتهم الجسد لتجعله رمادا فلا تعطي فرصة للرجوع عن الشيء، فهي تمثل الطهارة الكاملة والنهائية والمدمرة في نفس الوقت. والنار عندما تشتعل في جسد الإنسان تلتهمه بسرعة وبعنف، وهي تبث الرعب والخوف في قلوب مشاهديها.
هذا هو المشهد الذي سيواجهه إبراهيم؛ نار متوهجة ومتعطشة لإطعامها بجسد غير طاهر، متمرد عن الآلهة ومشككا في قدراتها، أمام جمهور من الناس شاهد على الخطيئة العظمى التي لا تغتفر والمستفيد الأول من التخلص من إبراهيم ومن يربك منظومة التقاليد ومكانة الإنسان في الكون. وهنا سيتم تدخل القدرة/المشيئة الإلهية لجعل النار تتحلى بأحد مكونات نقيضها لتكون بردا وسلاما. مما يدل على أن النار أصبحت مكونة من عناصر مناقضة لذاتها دون بلوغ مداها حتى تكون سلاما (أو هو تفعيل لأحد العناصر الموجودة أصلا في النار والمكونة لها)..
فمن جهة لم يبلغ البرد المنبعث من النار مداه المدمر ومن خلال شدة البرد، ومن جهة أخرى، تم التخلص من الرعب والخوف الذي تخلفه النار عادة (خاصة في نفس المحترق). المهم أن هذه الحادثة ليست غايتها إبراز القدرة الإعجازية لإله إبراهيم، بقدر ما هي التزام من الله بعدم التخلي عن رسله وقت الشدة والمحن. فالمنهج الإبراهيمي لا يقبل وجود الخوارق والمعجزات، هو منهج علمي/رياضي بامتياز، يعتمد على المجادلة والمناظرة لإقناع الآخر، والذي أساسه استعمال العقل للوصول إلى الإيمان.
فإبراهيم لم يدع قومه لحضور موقعة النار حتى يتأكدوا من قدرة/مشيئة الله على تخليص عبده من النار ومن نتائجها التدميرية مما يحتم الإيمان بهذه القوة الخارقة للعادة. إنما نجاة إبراهيم من لهيب النار كان نتيجة بعدية لقرار قبلي اتّخذ من قبل القوم للتخلّص منه ومن التصور/التهديد الذي يمثله. إذا الغاية ليس إثبات الإعجاز وإنما نجاة الرسول؛ صاحب النموذج/العقلي. لو كان غاية هذه الواقعة هو إثبات قدرة الله الإعجازية لقام إبراهيم بجمع القوم لمناظرة يكون أساسها مبارزة (وليس المجادلة المبنية على الحجة العقلية) و تكون غايتها تغيير/تبديل أحد السنن الكونية (ما يعبر عنه بالسحر أو الإعجاز) كما قام بذلك موسى مثلا. ولكن المنهج الإبراهيمي يرفض هذا التمشي، ويجعل الآخر هو الذي يحتم عليه إثبات قدراته الإعجازية المتناقضة مع الأساس العقلي (كما طلب ذلك إبراهيم من الملك).
4. تعامل إبراهيم مع رسل الله
يتبادر لنا مما تم تحليله أعلاه، أن منهج إبراهيم النبوي لا يضاهيه منهج نبوي آخر. فهو النبي الوحيد الذي يبحث عن الله ولم يبدأ مشواره برسالة، ولا بكتاب ولا بنزول ملك عليه. فنبوته هي صيرورة تعلم وبحث عقلي، بعيدة كل البعد عن الإيمان المباشر والآني الذي يحصل عادة مع الرسل (خاصة أولي العزم منهم) حيث تأتيهم رسل ربهم تبلغهم بأنهم تم اصطفاؤهم/اختيارهم كأنبياء لله. فكأن إبراهيم اختار أن يكون نبيا، وتصادفت إرادته مع اختيار الله له كنبي. وهذا المسار لم يحصل بتاتا مع نبي آخر. ولذلك يصفه الله بالخليل. والخليل هو الصديق الخالص.
والصداقة الخالصة عادة تأتي من جانبين، من طرفين قررا أن يكونا صديقين. إذا كانت هنالك رغبة من إبراهيم لمعرفة الله، للوصول إلى الله، فقد كانت أيضا مشيئة/رغبة من الله لجعل إبراهيم نبيا. ولذلك سيجعل الله إبراهيم يفتش عنه (في السماوات) وسيسمح له أن يطلب إثباتا لقدرته/مشيئته (إحياء الموتى) حتى يطمئن قلبه إلى درجة المشاركة الفعلية في العملية برمتها. وسيرافق الله إبراهيم في كل خطواته لإثبات وجود الله للآخرين من خلال المجادلة العقلية، رافضا الدخول في مبارزات إعجازية، خارجة عن السنن الكونية.
فحتى عندما ستمر رسل الله في طريقها إلى قوم لوط، لم يكن يعلم إبراهيم لا بصفتها ولا بالغاية من مرورها: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ (هود: 68-74).
وسيكون تعامله مع رسل الله تعاملا عاديا/بشريا مبنيا على حفاوة الكرم بالزائرين. فبنفس المنهج العقلي الذي يتعامل به إبراهيم مع الله ومع الناس، سيتعامل الله به مع إبراهيم خليله. ولذلك لن يبلغ الله إبراهيم قبليا أنه سيرسل إليه رسلا يبشرونه ويبلغونه بمهمتهم، بل سيكتشف إبراهيم من خلال تعامله مع زائريه أنه في حضرة رسل الله (بما أنه سيرى أن أيديهم لا تمتد إلى الأكل)، بل وسيخاف منهم: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾.
ويبدو أن امرأة إبراهيم ضحكت من حال إبراهيم؛ فهو نبي الله ويخاف من رسل الله ولا يعلم بمجيئهم. زد على ذلك أنها استغربت أنها سترزق بابنها (إسحاق) وهي عجوز وستعيش طويلا لترى ابن ابنها (يعقوب). وهذا الاستغراب ليس له علاقة بقدرة الله، بل بمشيئته. فهي تعودت على أن تعيش المنهج الإبراهيمي الذي يؤمن باحترام السنن الكونية الإلهية، وعدم الاعتماد على الخوارق والمعجزات، ومن هذه السنن أن لا تلد المرأة العجوز، ولا أن ترى هي وبعلها الشيخ حفيدهما في هذا العمر المتقدم. في مقابل هذا التعجب الإنساني هنالك تعجب رسل الله. فتعجب رسل الله من تعجب زوجة إبراهيم مفاده أنها لا تدرك أن إبراهيم له حظوة خاصة عند الله (فهو خليله)، وأن هذه المكانة الخاصة تجعل من إبراهيم وأهله (أهل البيت) يتمتعون برحمة وبركات لا حد لها. إذا ليس هنالك إعجاز، بل هي رحمة من الله أن رزق إبراهيم وزوجه ابنا على الكبر وأن هذه السلالة ستكون فيها بركات إلى يوم البعث.
وحين سيرجع إبراهيم إلى رشده بعد الفزع الذي عاشه من جراء معرفته أن ضيوفه هم رسل الله (الفزع ليس من جراء لقاءهم المباشر، بل نتيجة لعلمه بصفتهم)، سيعود إلى المجادلة العقلية مرة أخرى إثر علمه بالعذاب الذي ينتظر قوم لوط. وهنا نتساءل لماذا يجادل إبراهيم في قوم لوط، وهو لا يعلم حيثيات الدعوة التي قام بها لوط، إلى الحد الذي سيدعو الله إبراهيم إلى الإعراض عن هذه المجادلة، وأن قراره قد أخذ في هذا السياق، وأن مجادلته لن تغني عن العذاب الذي ينتظرهم شيئا. ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ (هود: 75).
وهنالك سؤال آخر يطرح في هذا الإطار: لماذا تم إلحاق عذاب شديد بقوم لوط، ولم يلحق أي عذاب بقوم إبراهيم (حسب ما نعلم من الوحي القرآني)؟ ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (هود: 80-82).
يبدو لنا أن منهجية تعامل إبراهيم مع قومه تختلف كلية عن منهجية تعامل لوط مع قومه (لن نخوض كثيرا في حيثيات هذه المنهجية الأخيرة التي تتطلب بحثا لذاتها). فإبراهيم كان يتعامل مع قوم غير قادرين على تجريد فكرة الإله، ويعتمدون التقاليد كأساس للعلاقات بين مختلف مكونات المجتمع. إذن كانت هنالك مشكلة شرك (تجسيد) مرتبطة بالمستوى المعرفي/العقلي للمجتمع، الذي كان يرفض أن يمر إلى مستوى أكثر تطورا من المعارف الإنسانية (تجريد). فكأن تجربة إبراهيم هي في الأخير محاولة/اختبار (Test/Attempt) لفكرة سابقة لأوانها لن تتحقق إلا بعد تطور الإنسانية معرفيا ودينيا من خلال الدعوات المختلفة التي ستلي دعوة إبراهيم. تجربة غايتها إنشاء النموذج المركّز في النبي نفسه، ولذلك هو أمة لذاته: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ (النحل: 120)، وهذا النموذج لن يتحقق في أقصى مداه إلا مع نهاية خط النبوة، بدعوة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وتصبح من ثم أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس:﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: 110). مع العلم أن فعل كان في الماضي (كنتم) يفيد انتماء إبراهيم إلى هذه الأمة، وهو أول لبناتها، وليس فعل ماضي يفيد الحاضر كما يفسّر عادة.
بينما تعامل لوط مع قومه على أساس دعوتهم لترك الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من قبل وليس على أساس ترك الشرك: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ (الأعراف: 79-80). وهذا النوع من الفاحشة مهدد لتواصل العنصر الإنساني على الأرض، ومهدد لمبدأ الزوجية الذي وضعه الله كأساس لعلاقة الرجل بالمرأة، وللوجود نفسه: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (الذاريات: 49). إذن كان على قوم لوط ترك الفاحشة حتى وإن كان مستواهم المعرفي يقبل الشرك. وعدم الامتثال لهذا الأمر تطلب نزول عذاب شديد بهم.
خاتمة
يبدو جليا من التحليل الذي قمنا به أن إبراهيم يتحرك من خلال منهجية معرفية للتفاعل مع الكون ومع الظواهر الاجتماعية. فهو، كما ذكرنا، يتعامل مع هذه الظواهر ببعدين: بعد علمي/رياضي وبعد إيماني/تصديقي. وعلى هذا الأساس حاول إبراهيم القيام بقطيعة إبستيمولوجية/معرفية مع التصور الذي كان طاغيا في عهده، والذي يقول بتعدد الآلهة وتشيئها، والمتمثل في تجسيدها وتموضعها الزمكاني.
وقد حاول إبراهيم من خلال وضع هذه المنهجية تطوير وسائل التحليل الاستقرائي من خلال النظر إلى الظواهر الطبيعية والتحليل الجدلي/النقدي من خلال النظر إلى الظواهر الاجتماعية. فقد كانت الإنسانية في فترة إبراهيم في المرحلة الأسطورية (تجسيد للآلهة وإعطاء تصور مادي لوجودها من خلال تأصيل تاريخي لها يعتمد على تغلبها على قوى خارقة للعادة)، مرحلة الإنسان الزراعي، الذي كان يواجه بالاعتماد كلية على الآلهة لحل مشاكله. فهذا الإنسان كان يؤمن بقوى خفية تستطيع أن تسير/تغير الظواهر الكونية، فوقف حائرا مغلوبا على أمره أمامها، ولم يحاول إدراك العلل والأسباب لهذه الظواهر، ومن ثم لم يملك إلا أن يتصور أن لكل ظاهرة من ظواهر الكون والحياة إله يسيرها ويتحكم فيها. فجاءت دعوة إبراهيم لدفع الإنسان نحو استعمال العقل، لتحرير قدراته من هذه القوى الخفية التي تعيق تحركه وفهم الكون ومكانته فيه.
فالمنهجية المعرفية التي حاول إبراهيم غرسها في مجتمعه (والتي ستؤتي أكلها ولو بعد حين) هي منهجية مبنية على:
ـ جدلية النسبي/المطلق (كل الظواهر الكونية والاجتماعية ظواهر نسبية تعود إلى المطلق الذي خلق السموات والأرض).
ـ معرفة الإله (الذي ينفع ويضر) يمر عبر المنهج العلمي/الرياضي (من أساسياته السمع والبصر).
ـ قدرة/مشيئة الله تتمظهر في السنن الكونية والاجتماعية.
ـ قدرة/مشيئة الله تتجاوز المبدأ الذي يحرك السنن الكونية والاجتماعية: التناقض، التزاوج، التضاد، التناوب، التكامل، إلخ.
ـ استحالة تحدّ الله في سننه الكونية (لا أحد يستطيع تغييرها وحتى الله التزم ألا يغيرها) –> يمكن اكتشافها من خلال المنهج الاستقرائي.
ـ إمكانية تغيير السنن الاجتماعية بتفعيل أسوئها باسم التقاليد (تغييب للمنهجين) أو إتباع أحسنها (استعمال للمنهجين للوصول إلى أحسن النتائج بأقصر الطرق) –> يمكن الدفع نحو تغييرها من خلال المنهج الجدلي/النقدي.
ـ أن المنهج العلمي/الرياضي والمنهج الإيماني/التصديقي لا يتناقضان بل يتكاملان ويمكن استعمال كلاهما عند التوجه إلى السنن الكونية وإلى السنن الاجتماعية.
الملفت للانتباه في هذه المنهجية التي أصّل لها إبراهيم أنها تؤمن بالحوار وبأخلاقياته، وأنها حولته إلى واقع معاش وإلى طريقة في الحياة. فالمنهجية الإبراهيمية هي حركة وتوجه تنظّر لواقع معرفي يضغط لديمومة الظاهرة الحوارية حتى وإن لم تثمر في إبانها. وهي تدعو الآخر إلى التخلص من القيود المختلفة (رغم أنه يستحيل التخلص من كل القيود) ومن أهمها التقاليد، ليصبح الحوار ضرورة اجتماعية فكرية تربوية..
وهي منهجية لا تركز على البعد الأخلاقي والديني للحوار بالأساس (التحمّل والصبر على معتقدات وآراء الآخرين، الحلم وسعة الصدر، إلخ)، وإنما تؤسس لحوار عقلاني معرفي هادف يتبلور في محيط فكري جدلي غايته الوصول إلى الحقيقة من خلال إحداث نقلة نوعية.
وأخيرا وليس آخرا، وعلى إثر ما كتبه حيدر حب الله، نتساءل نفس السؤال: هل يمكن اليوم تفعيل جزء من منهجية إبراهيم في الواقع الإسلامي، الداعي إلى التخلص من تقليد الآباء (العشيرة والقبيلة والثقافة العامة السائدة في المجتمع وغيرهم) والمنادي بإعادة النظر في أصول المعتقدات الدينية لإنتاج بناء اعتقادي مصدره عقل الفرد ؟ أم أننا سنواجه بثقافة تمنع الفرد المسلم من الدخول في تقويم ذاتي لمعتقده، وتنتقد بشدّة التبريرات المعطاة للأفراد في تكوين بناهم العقدية والفكرية[5].
الهوامش
[1]. محمد حمزة، أفق التأويل في الفكر الإسلامي: بحث في المرتكزات والتحولات والبدائل، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، وتونس: دار محمد علي للنشر، ط1، 2011، ص9.
[2]. محمد عثمان الخشت، “الشك المنهجي” وتأسيس عصر ديني جديد، على الرابط الإلكتروني:
http://www.elwatannews.com/news/details/702922
[3]. بلخير بقة، أثر ديانة وادي الرافدين على الحياة الفكرية سومر وبابل 3200-539 ق. م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، الجزائر، 2009، ص31-41، على الرابط الإلكتروني:
http://www.abualsoof.com/INP/Upload/pdf/BELKHIR_BEGHA.PDF.pdf
[4]. محمد شحرور، الفصل الثالث، نظرية المعرفة القرآنية، على الرابط الإلكتروني:
[5]. حيدر رحب الله، مسألة المنهج في الفكر الديني: وقفات وملاحظات، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 2007، ص25.







