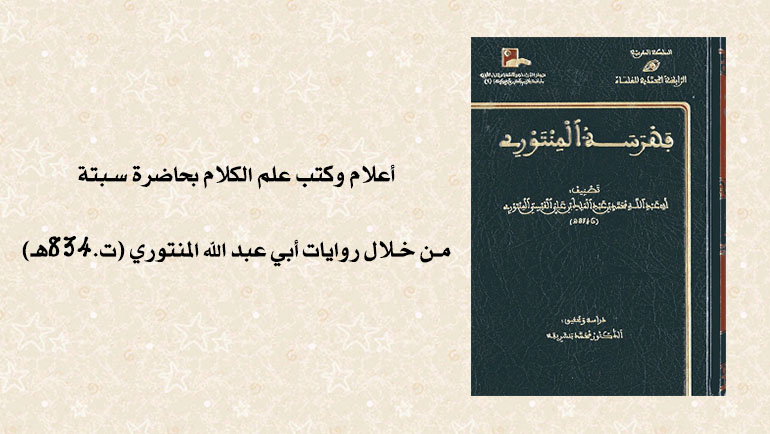فقه الواقع، سياق خارجي ومقامي للنص.. بحث في معادلة (فقه الواقع) لـ(فقه النص) في تنـزيل وتكييف الأحكام

أولا: اعتبار الواقع أصل شرعي وممارسة تاريخية
إن حقيقة استخلاف الله تعالى للإنسان وتكليفه بمهمة التعمير والسعي في الأرض بالإصلاح والصلاح، والاعتبار بأحداث الماضي تجنبا وتفاديا لمزالق الحاضر والمستقبل، كل ذلك يفيد أن لواقع الإنسان، الذي هو مجال استخلافه وعمرانه، وميدان حركته وفعله، دورا مهما وحاسما في أداء هذا الإنسان لمهامه تلك، المنوطة به كمكلف مخاطب بالعلم بأحكام التكليف والعمل بها. ومادام علمه وعمله بها اجتهاديا كسبيا أو قل كدحيا، فإنه قد زود بقدرات مؤهلة لتبوء هذا المقام الذي قالت عنه الملائكة، بعد أن قال الله تعالى لها: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾، ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء﴾ (البقرة: 29).
فتعليم الإنسان الأسماء، وحمله الأمانة، ودعوته إلى السير في الأرض والضرب فيها للاعتبار والإبصار.. هو من مقومات فقه الإنسان لواقعه، كما دل على ذلك قوله تعالى: }قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين{ (النمل: 71). وقوله تعالى: }قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين{. (ءال عمران: 137).
هذا الوعي بهذه الحقائق، جعل عقيدة التوحيد في عصور ازدهار الإسلام الأولى تمتد إلى واقع الناس لتشمله في كنفها وتصبغه بصبغتها بحيث تدور أحكامه العملية وآدابه وفنونه وعمارته وتمدنه وعلومه وحضارته في فضائها الرحب. لكن لما آلت القوة إلى الضعف، والازدهار إلى الانهيار، ثم الانبهار بما لدى الغير من الأمم الأخرى. تقلص التوحيد إلى البعد الإيماني التغييـبي المحض، وانفلت الواقع من أن يكون مشمولا بهذا الأصل العظيم، ثم بعد ذلك من أصول الأحكام العلمية والعملية معا إلا ما نذر. فلم ينم في الأمة فقه أحكامي لصيق بالواقع قابل للتجدد باستمرار مع تجدد الواقع نفسه، بحيث تتكيف أحكامه مع هذا الواقع بحسب نوازله ومستجداته؛ إذ لا يكفي فقه النص بمعزل عن فقه الواقع مادام النص والواقع متلازمين أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومادام سياق النص لا معنى له إلا بارتباطه بسياق الواقع لأنه لأجله نـزل تكليفا وإصلاحا وترشيدا وتصويبا. وفي القرآن الكريم من الأمثلة والأحكام وقصص الأنبياء مع أقوامهم ما يكفي لتقرير هذا التلازم وجعل الواقع سياقا من سياقات فهم النص، لنقل هو سياق خارجي أو مقامي.
فدعوات الأنبياء والرسل إصلاح لواقع فاسد كلا أو بعضا. ولهذا كان الربط كثيرا في القرآن الكريم بين التكليف بالرسالة وبين مظاهر الفساد في الواقع المراد إصلاحه. ويكفي نموذجا لذلك أن نذكر قوله تعالى في شعيب عليه السلام: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ (هود: 83-84). ودائما في الاصطفاء الحصري للرسل والرسالات هناك ارتباط وثيق بين سياق النص وسياق الواقع اقتضى أن يكون لكل قوم هاد وبلسانهم ليبين لهم. ﴿إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾ (الرعد: 8). ﴿وإلى عاد أخاهم هودا﴾ (هود: 50). ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبا﴾ (هود: 83).﴿وإلى ثمود أخاهم صالحا﴾ (هود: 60). وكذلك شأن نوح وإبراهيم ولوط… ﴿وما أرسلنا من رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾ (إبراهيم: 5). فلما انتهى الاصطفاء إلى الكونية والعالمية كان لسياق الرسالة شأن آخر، مستوعب ومطلق بإطلاق وامتداد الأزمنة والأمكنة والأسرة البشرية، مما يجعل الفقه في السياقين متكاملا يعدل أحدهما الآخر ويحيل عليه، فكلاهما دال على أنه الحق، وعلى حقيقة التكليف في الحال والمصير في المآل. يدل على ذلك أيضا نـزول القرآن منجما على مدى ثلاث وعشرين سنة، وأخذه الناس بالتدرج في الأحكام، وإعادة ترتيبه على غير أسباب نـزوله، وخصوصيات المرحلة المكية والمرحلة المدنية.. وغير ذلك مما هو من خصوصيات رسالة الختم والهيمنة والتصديق.
إذا انتقلنا إلى السنة النبوية نجدها واقعا عمليا متحركا بأحكام القرآن “قرآن يمشي بين الناس”. كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والمشي والحركة سياقات مقامية حالية للأحكام، تتكيف بمقتضاها لتواكب على الدوام تطورها في أحوالها المتغيرة، سلما وحربا، قوة وضعفا، استقامة وانحرافا، خيرا وشرا، صلاحا وفسادا… وقد أثر عنه عليه السلام أنه كان يجيب السائلين بحسب أحوالهم وما يصلح لها. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: “أي المسلمين خير، وفي رواية، أفضل”، فاختلفت الأجوبة باختلاف السائلين وأحوالهم ومناسبة السؤال. فكان مما أجاب به: “خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده” أخرجه البخاري. وفي رواية: “رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه”، وفي رواية: “مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره” مسند الإمام أحمد. وفي البخاري أيضا أنه، صلى الله عليه وسلم، سئل: “أي الجهاد أفضل” فأجاب: “كلمة حق تقال لإمام جائر”، وفي رواية “أفضل الجهاد حج مبرور”. وننقل هنا نموذجا أكثر وضوحا في الواقعة التي رواها أبو هريرة، رضي الله عنه، قال: “بينما نحن جلوس عند النبي، صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا وفي رواية قال: ما أملك رقبة غيرها، وضرب على صفحة رقبته. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا وفي رواية: هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. فقال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا وفي رواية قال: والذي بعثك بالحق مالنا من طعام. قال أبو هريرة: فمكث النبي، صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي، صلى الله عليه وسلم، بعرق فيها تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي، صلى الله عليه وسلم، حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك (أخرجه البخاري ومسلم). والحديث أغنى من أن يعلق عليه، إذ هو ناطق بفقه النبوة حكما وحكمة ورحمة وتيسيرا.. جعلت من كان تجب عليه الكفارة مستفيدا منها مراعاة لحاله وواقعه.
إن الوقائع من هذا القبيل في السنة والسيرة النبوية كثيرة، ويكفي أن نذكر منها كذلك واقعة أخرى كانت تهم كيان الجماعة المسلمة آنذاك؛ أقصد صلح الحديبية وشروطه التي بدت مجحفة للصحابة رضي الله عنه، وفقه النبي، صلى الله عليه وسلم، في تقديره للواقعة وما ستؤول إليه؛ إذ كان من شروط هذا الصلح:
ـ تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة اسمه كنبي ورسول؛
ـ رد من أسلم من قريش وقدم إلى المدينة؛
ـ ألا يرد من ذهب إلى قريش؛
ـ عدم الدخول إلى مكة تلك السنة. وستأتي معنا نماذج أخرى توضح سياقات التنـزيل بين فقه النص وفقه الواقع.
بعد النبي، صلى الله عليه وسلم، حرص الخلفاء الراشدون على منهجه في الفقه وإدارته بين فقه الواقع من جهة وفقه النص من جهة ثانية، على اختلاف بينهم في التطبيق والتنـزيل. من ذلك محاربة أبي بكر الصديق لمانعي الزكاة وجداله مع عمر، رضي الله عنه، حول مشروعية هذا القتال. ومن ذلك اجتهادات عمر، رضي الله عنه، في قطع يد السارق عام المجاعة، وفي توزيع أراضي العراق على الجند، وفي سهم المؤلفة قلوبهم، وفي الزواج من الكتابيات… وفقه كثير من الصحابة الذين تتلمذوا على بيت النبوة ومن أخذ عنهم من علماء وفقهاء الأمة هو على هذا المنوال الذي يعمد إلى الجمع في فقه الأحكام بين الواقع والنص مما أثمر حضارة مزدهرة شامخة بعلومها ومعارفها وفنونها وآدابها وأخلاقها.. قادت العالم قرونا من الزمان.
ثانيا: عناصر ساهمت في غياب أصل ومصدرية الواقع: الجمود والتقليد والصورية والتجريد
الجمود والتقليد علة من العلل الفكرية الطارئة على الأمة، وأخطارها لا تكمن فقط في كونها توقف حركية وفعالية العقل المسلم الذي أنيط به واجب التفكر والتدبر والاعتبار والفقه والتعقل والاجتهاد والتجديد.. في العلم بالدين والعمل به مما هو منصوص نصا في الكتاب والسنة، بل تعدى الأمر ذلك إلى توقف مواكبة حركة الفقه الشرعي للواقع المتغير المتجدد. فالأصل في الفقه، باعتباره فهما عن الله تعالى في كتابه، أن يؤطر بالشرع الخالد حركة الواقع ومستجداته ونوازله في كل زمان ومكان.
لكن عندما تتوقف حركة الفقه عند قرن معين فتعمد إلى استهلاك مقرراته ولزومها وعدم الخروج عليها، فههنا يتم عزل الفقه عن الواقع، فيغدو الفقه شيئا والواقع شيئا آخر. وهذا واضح في عصرنا الآن حيث ما زالت تدرس بيوع ومعاملات مالية وقضايا أسرية واجتماعية وسلمية وحربية، وغيرها بمقررات فقه سابق وبألفاظه واصطلاحاته القديمة مما يجعله عاجزا عن التأطير والمواكبة ومستعصيا على الفهم والاستيعاب. كما يجعل حركية تنـزيله كما هو تسفر عن آفات وكوارث وطامات فردية أو اجتماعية؛ فكثير من الحروب والخصومات والمشكلات الدائرة الآن هي نتيجة فهم وفقه سيئ للواقع من جهة، ونتيجة استصحاب أقوال وفتاوى جامدة أو قيلت في سياقات تاريخية معينة.
ولهذا نقول إن التحرر من آفة الجمود والتقليد واكتساب مهارات الاجتهاد والتجديد كفيل بتحريك العقل المسلم من جديد لجعله مواكبا لحركة الزمان والمكان؛ ضابطا لسياقات الواقع والفقه قادرا على تحقيق مناطات التنـزيل.
فليس للتقليد أصل في الكتاب ولا في السنة ولا عرف عند الصحابة، وكل ما ورد بخصوصه من ألفاظ إنما هو على غير المعنى والمراد الذي تم تداوله فيما بعد. إذ جرى اللفظ على أصله اللغوي كما تذهب إلى ذلك المعاجم. فعند ابن فارس1: “القاف واللام والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء، والآخر على حظ ونصيب. فالأول التقليد، تقليد البدنة وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي. وأصل القلد الفتل… ويقال قلد فلان فلانا قلادة إذا هجاه بما يبقي عليه وسمه. والأصل الآخر القِلد: الحظ من الماء”.
وعند ابن منظور2: “القلادة ما جعل في العنق… ومقلد الرجل موضع نجاد السيف على منكبه، وقلده الأمر ألزمه إياه”.
ولم يخرج استعمال القرآن ولا استعمال السنة النبوية عن هذه الدلالات اللغوية، أي أنهما لم يحددا مضمونا أو مدلولا شرعيا للتقليد كما شاع وتطور بعد ذلك، أي التقليد في الدين من غير حجة ولا برهان.
وقد ضعف العلماء بعض الآثار الدالة على هذا المعنى وأبطلوا دلالتها متنا وسندا*. هذا فضلا عن مخالفتها لصريح نصوص الكتاب والسنة في العلم والتعلم والسؤال والفقه والتفقه والاجتهاد والتجديد. وتواتر آثار ونقول كثيرة عن الصحابة والسلف عموما من العلماء والفقهاء في ذمه باعتباره “بدعة عظيمة” و”بدعة شنعاء” و”بدعة شيطانية” طرأت في الأمة ولم تكن في سلفها الصالح.
وآيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة في الباب تنهى عن الإتباع السيء والمذموم الذي لا يقوم على حجة أو برهان. ولهذا اعتبر التقليد بدعة ظهرت بعد الأجيال الثلاثة خصوصا، وهناك من أوصلها إلى الأئمة المؤسسين للمذاهب باعتبار أنهم المقلدون بهذه الدرجة أو تلك. فنجد ابن حزم يتحدى دعاة التقليد بقوله: “فنحن نسألهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة -عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين- واحدا قلد عالما كان قبله فأخذ بقوله كله ولم يخالفه في شيء، فإن وجدوه ولن يجدوه والله أبدا لأنه لم يكن قط فيهم – فلهم متعلق على سبيل المسامحة. وإن لم يجدوه فليوقنوا أنهم أحدثوا بدعة في دين الله لم يسبقهم إليها أحد. وليعلموا أن عصابة من أهل القرن الرابع ابتدعوا في الإسلام هذه البدعة الشنعاء إلا من عصم الله منهم”3.
التحدي نفسه بألفاظه تقريبا نجده عند ابن القيم حيث يقول: “إنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا واحدا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا.
ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين. فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم”4.
أصبح التقليد بعد عصر الأئمة خصوصا، ظاهرة. وهو وإن أطل برأسه في عهدهم لدرجة أحوجتهم إلى النهي المشدد عنه وإلى الأخذ من الكتاب والسنة وتقديمهما على كل قول غيرهما5 فإنه انتشر بعد ذلك انتشارا غدا فيه هو المهيمن على حركة الفقه والاستنباط من النصوص، بحيث انحسر الاجتهاد وهو أصل أصيل وانتشر التقليد وهو طارئ دخيل.
وكل ما تداوله المقلدة بعد ذلك على لسان الأئمة هو في أصله محدود محدودية الآية الآمرة بسؤال أهل العلم في حال عدم العلم والمعرفة بالحكم. ﴿فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾. فانقلب الأصل وهو العلم فرعا، والفرع وهو عدم العلم أصلا.
يقول ابن القيم موضحا: “إن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم ولا سوغوه البتة، بل غاية ما نقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله. ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم… (ف) التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى”6. ويقول ابن الجوزي:”إن في التقليد إبطالا لمنفعة العقل، لأنه خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلام”7.
الآفة الثانية لا تقل خطورة عن الأولى، آفة الصورية والتجريد، فإذا كانت المشكلة الأولى تعكس جمود الفقه ومن ثم عدم قدرته على مواكبة الواقع، فإن المشكلة الثانية تعكس نمو فكر أو قل كلام لا علاقة له بالواقع أصلا، ونقصد بالدرجة الأولى هنا علم الكلام أو أصول الدين، وبعده بدرجة أقل، علم أصول الفقه.
ليس هذا الحكم عاما شاملا، إذ لا يخفى أن بداية العلم الأول كانت لها علاقة بمشكلات وتحديات عرفها واقع الأمة، وعرفتها عقيدة الأمة. حيث انبرى للدفاع عنها والرد على الخصوم في قضايا التوحيد والإيمان وأفعال العباد وغيرها بمختلف المناهج، عقلية ونقلية. لكن كما يذهب مؤرخو هذا العلم على اختلاف بينهم في التقدير لبدايات التحول عن هذا المسار، بعد القرن الثالث أو الرابع أو الخامس، فإنه ما من شك أن توغل الفكر الفلسفي اليوناني والأقيسة المنطقية والفكر الصوري المسيحي، قد لعب دورا كبيرا في نقل هذا العلم عن قضايا واقع الأمة إلى التجريد والصورية. لدرجة، كما يقول ابن خلدون، اختلطت فيها الطريقتان، طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة. وحيث التبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم8.
يضاف إلى هذا أن كثيرا من الفرق التي تشعبت وتناسلت بشكل ملفت للنظر لمجرد خلافات جزئية وبسيطة، مما يعرضه علينا مؤرخو الفرق أو الملل والنحل*. حيث وصل بعضها إلى عشرين فرقة فرعية داخل الفرقة الأم كما هو شأن الشيعة والمعتزلة وبشكل أقل الخوارج وغيرها.. وحيث انتقل الصراع وفي القضايا نفسها إلى الذات، فتشعب الخلاف النظري والافتراضي إلى درجة من الغلو والفسوق شغلت الأمة وأنهكتها، وجعلت أهم علم فيها كان بإمكانه أن يطور فلسفتها العقدية في ارتباطها بالواقع وفي تأطيرها لأحكام وحركة الفقه والفكر، جعلته سلبيا ومنعزلا عن تلك الهموم والقضايا. وعلما مضرا أكثر منه نافعا بعد أن استنفد أغراضه كما قيل.
فأصبحت حركة الواقع لا علاقة لها بالعقيدة، وحركة الفقه وتنـزيل الأحكام منفصلة كذلك عن أطرها العقدية وأشبه ما تكون بمساطر وبنود شكلية عارية أو شبه عارية عن منطلقاتها ومقاصدها ومآلاتها.
يقول د. النجار واصفا هذا الحال: “الانحدار العام الذي أصاب الفكر الإسلامي، أصاب أيضا الفكر الكلامي، فأصبح ينـزع منـزع التجريد الذي ينشغل به عن مجريات الواقع المتعلقة بالأصول العقدية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجادلات نظرية في المسائل القديمة. واحتجاجات تتعلق بتحديات ماضية وميل إلى التأليف والترتيب للآراء والمقولات السابقة في نسق منطقي مدرسي حتى إنه ليمكن القول إن الصلة كادت تفقد بين هذا الفكر وبين واقع المسلمين الذي لم يخل في أي عصر من تحديات داخلية وخارجية تهدد مرجعيته العقدية”9.
ولا يختلف علم أصول الفقه عن هذا السياق خصوصا بعد أن استقر التقليد والجمود على ما استقر عليه في إطار المذاهب، ولم تبق حركة التأصيل والاستنباط وتفعيل القواعد عملا متجددا مواكبا للتطورات والمستجدات. بل إن صورية وتجريدية هذا الأصل، وإن كانت أخف من سلفه.. تغذت كذلك من الأقيسة والحلول المنطقية والتوسع فيها منذ وقت مبكر تصنيفا وتأليفا وتعريفا، لدرجة جعلت الإمام الغزالي صاحب (معيار العلم) و(القسطاس المستقيم) يذهب إلى أن “من لا يحيط بهذه المقدمات المنطقية فلا ثقة له بعلومه أصلا”10.
ثالثا: دور الواقع في بناء فقه التنـزيل وتكييف الأحكام
تقدم معنا الحديث عن انفصال الشرع عن تأطير الواقع، وأن مجالات عدة بقيت بعيدة عن توجيهاته. وهذا مؤثر دون شك بشكل أو بآخر في منهجية تنـزيل الأحكام على هذا الواقع إذا ما قدر لهذه الأحكام أن تعود لدورها من جديد.. وذلك بسبب غياب فقه الواقع طوال قرون الانحطاط في الأمة -تقريبا-، لما بقي الفكر والفقه مجردين عن عنصر الواقعية في الفهم والتنـزيل. وهذا من أخطر المشكلات التي تواجه الفكر الاجتهادي التجديدي الإصلاحي المعاصر، مشكلة رد الاعتبار لـ واقعية الأحكام الشرعية بما في ذلك خلفياتها العقدية من خلال التحقق بفقه الواقع، وقبله بفقه الشرع، لتحقيق مناطات التنـزيل.
إن “الفقه الإسلامي لم تدم جولة مده الحي طويلا إذ سرعان ما آل أمره إلى التقليد والاكتفاء بما اجتهد فيه كبار الأئمة في التنـزيل، كما أن علم أصول الفقه تكاد تكون حركته الإنتاجية قد توقفت مع الشاطبي، وهو ما كان سببا في ضعف فقه التدين عند المسلمين، إذ انحسر رافده التطبيقي المتمثل في الفقه المتنامي كما انحسر رافده التنظيري المتمثل في الحركة التطورية لأصول الفقه “11. والناظر إلى معظم التعاريف الأصولية، كما يقول النجار -يجد أنها فعلا كانت تقوم على أساس الفهم لا على أساس التنـزيل، والبحث عن طرق الاستنباط أكثر من البحث عن طرق التطبيق كان هذا قبل الشاطبي وبعده”.
إن تمحيص التعريف في مختلف صيغه وعلى تتالي الأعلام والأزمان للمنهج الاستنباطي دون إشارة للمنهج التنـزيلي، يدل على الروح العامة المسيطرة على أصول الفقه، وهي روح المنهجية الفهمية. وأن المنهجية التنـزيلية ليست قواما أساسيا لهذا العلم، وإنما هي مندرجة في سياق منهجية الفهم التي هي قوام هذا العلم عند سائر الأصوليين..12.
يقول الإمام الشاطبي واصفا العمل الاجتهادي في تنـزيل الحكم على ما يليق به من الأفعال بحسب الحالات “هو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وازن واحد كما أنها في العلوم والصنائع كذلك… فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها وقوة تحملها للتكاليف وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها. ويعرف التفاتها إلى الخطوط العاجلة أو عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف”. وعنه كذلك أنه “لا يصلح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أنه يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين”13. وعنده في المقدمة الخامسة، أن “كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها لم يدل على استحسانه دليل شرعي؛ وأعني (يقول) بالعمل، عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. والدليل على ذلك استقراء الشريعة: فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، ففي القرآن الكريم ﴿يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (البقرة: 188)؛ فوقع الجواب بما يتعلق به العمل، إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال: لم يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى”14، ومن هذا أيضا السؤال عن الساعة، وصفات البقرة…
وذهب ابن القيم إلى أنه “لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما؛ فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والثاني؛ فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه إلى معرفة حكم الله ورسوله… ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله”15. وذكر العلماء في المجتهد “إذا اجتهد.. في حكم واقعة وبلغ إلى حكمها، ثم تكررت تلك الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب تجديد الاجتهاد… وقيل يلزمه تجديد النظر لعله يظفر بخطأ أو زيادة المقتضى…، وقال القاضي الروياني في كتابه روضة الحكام: إذا اجتهد لنازلة فحكم أو لم يحكم، ثم حدثت تلك النازلة ثانيا فهل يستأنف الاجتهاد؟ وجهان (أي في المسألة)، والصحيح: إن كان الزمان قريبا لا يختلف في مثله الاجتهاد، لا يستأنف في مثله الاجتهاد، وإن تطاول الزمان استأنف..”16.
فـ “ليس الاجتهاد في التفهم والاستنباط، إذن، بأولى من الاجتهاد في التطبيق إن لم نقل إن قيمة الاجتهاد عمليا إنما تنحصر فيما يؤدي من ثمرات في تطبيقه تحقق مقاصد التشريع وأهدافه في جميع مناحي الحياة”17. و”المجتهد الحق هو الذي ينظر إلى النصوص والأدلة بعين وينظر إلى الواقع والعصر بعين أخرى حتى يوائم بين الواجب والواقع ويعطي لكل واقعة حكمها المناسب لمكانها وزمانها وحالها”18، و”هكذا ينبغي أن تكون الفتوى، يزدوج فيها فقه الدين وفقه الحياة. وبدون معرفة الناس ومعايشتهم في واقع حياتهم ومشكلات عيشهم، يقع المفتي في متاهات أو يهوم في خيالات… فهو لا يعرف إلا ما يجب أن يكون دون ما هو كائن..”19.
وقد تعقب د. القرضاوي العلماء، وخاصة منهم ابن القيم، فيما ذهبوا إليه من “تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف..”، وكونه مبنيا على الاستدلال من السنة، وأما القرآن فلم يستدل به أحد على ذلك. حيث قال مستدركا: “ويلوح لي أن من يدقق النظر في كتاب الله يجد فيه أصلا لهذه القاعدة المهمة، وذلك في عدد من الآيات التي قال كثير من المفسرين فيها: منسوخة وناسخة. والتحقيق أنها ليست منسوخة ولا ناسخة وإنما لكل منها مجال تعمل فيه، وقد تمثل إحداهما جانب العزيمة والأخرى جانب الرخصة، أو ككون إحداهما للإلزام والإيجاب والأخرى للندب والاستحباب، أو إحداهما في حال الضعف والأخرى في حال القوة.. وهكذا”20.
واستدل لذلك بجملة نصوص، نذكر منها قوله تعالى: ﴿يأيها النبيء حرض المومنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن تكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾ (الأنفال: 66)، وقوله: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين﴾ (الأنفال: 65).
والمعنى كما يقول صاحب المنار، رخصة خاصة بحال الضعف لما كان عليه المؤمنون في الوقت الذي نـزلت فيه هذه الآيات. وهو وقت غزوة بدر…،(فـ) لما كانت للمؤمنين القوة كما أمرهم الله تعالى أن يكونوا في حال العزيمة، كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أكثر وينتصرون عليهم. وهل تم لهم فتح ممالك الروم والفرس وغيرهم إلا بذلك؟ وذهب بعض المفسرين إلى أن آية العزيمة من هاتين الآيتين منسوخة بآية الرخصة التي بعدها بدليل التصريح بالتخفيف فيها الآن خفف الله عنكم.
ولكن الرخصة لا تنافي العزيمة ولا سيما وقد عللت هنا بوجود الضعف، ونسخ الشيء لا يكون مقترنا بالأمر به. والظاهر أن الآيتين نـزلتا معا… فقد تبين أن الآية الأولى عزيمة أو مقيدة بحال القوة، والثانية رخصة مقيدة بحال الضعف. ومعنى هذا أن الآية الثانية تشرع لحالة معينة غير الحالة التي جاءت لها الآية الأولى، وهذا أصل لتغير الفتوى بتغير الأحوال. ومثل ذلك آيات الصبر والصفح والعفو والإعراض عن المشركين ونحو ذلك مما قال فيه كثير من المفسرين: نسختها آية السيف. فالحق أن لهذه الآيات وقتها ومجالها، ولآية السيف وقتها ومجالها كذلك”21.
ومن الحديث ما تقدم من نهيه صلى الله عليه وسلم ثم إباحته لادخار لحوم الأضاحي وتعليله النهي بـ”الجهد” الذي أصاب الناس و”الدافة التي دفت”، “القوم الذين وفدوا على المدينة من خارجها” والإباحة بارتفاع ذلك. ومثل هذا، النهي عن زيارة القبور ثم إباحتها وغير ذلك مما شابهه، وليس من هذا شيء في باب النسخ. قال القرطبي في حكم الادخار: “هو حكم ارتفع لارتفاع علته، لا لأنه منسوخ، وفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته، فالرفع بالنسخ لا يحكم به أبدا، والمرفوع لارتفاع علته يعود بعود العلة. فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم”22. وقد عاد إلى هذا النهي علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في خلافته اعتبارا لما تقدم من ارتباطه بعلته وجودا وعدما.
ومهما يكن فإن الأصوليين قد “تناولوا قضايا أصولية ذات صلة شديدة بمنهج التطبيق وإن يكن من خلال الاستنباط، مثل مباحث الاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصلاح والعرف.. وكلها تنـزع إلى استنباط الحكم الشرعي بناء على الوقائع الجارية في الحياة… إلا أن هذه الطرق هي نفسها محل اختلاف بين الأصوليين في القبول والرفض والذين يقبلونها منهم لم يتوسعوا فيها بالتحليل والتوجيه التطبيقي بما يفضي بها إلى رسم منهاج تطبيقي واضح بين، إنما ألحقوها بالأدلة الشرعية الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي أخذت الحيز الأكبر من البحث ولم تظفر معها هذه الأدلة الملحقة إلا بالقليل من الاهتمام”23. كما لم تظفر مباحث أخرى ذات منـزع تطبيقي مباشر عند الأصوليين إلا باهتمام عرضي بسيط، وهي التي اهتم بها الشاطبي اهتماما كبيرا، كمبحث اعتبار مآلات الأفعال، ومبحث تحقيق المناط، والإفتاء وقواعده وشروطه = فقه النوازل وغير ذلك…
وقد التمس د. النجار أسبابا لضمور منهج التطبيق عند الأصوليين حصرها في ثلاثة رئيسية:
- “أن الحاجة إلى الفهم أسبق من الحاجة إلى التطبيق منطقيا وزمنيا، فكان الفهم تبعا لذلك فائزا بأولوية الجهد في التنظير المنهجي الذي اخترعه الشافعي”.
- “أن من طبيعة التطبيق التوالي والتدرج؛ إذ الأحداث والنوازل تجد تباعا بتقدم العمران، أما الفهم فإنه ضرورة ناجزة..”.
- انحسار حركة التعمير الحضاري إذ “لم يحدث من مستجدات الأوضاع التعميرية ما يحمل الفكر الفقهي بثرائه وتشعبه على الاجتهاد في التطبيق إلى التنظير المنهجي لهذا الاجتهاد “24.
وإذا أمكن التسليم بالعنصرين الأولين، فالعنصر الثالث يبقى محفوفا بكثير من التحفظات تجعله لا يحمل على إطلاقه، ذلك أن وضع الأمة مهما كان منهارا ومنحطا فإنه لم يخل من امتداد وتوسع وظهور أشكال من العمران والاجتماع وأنماط من الفكر والحكم لم يستوعبها ويؤطرها الاجتهاد الفقهي بما يضمن بقاءها ضمن المجال العقدي والتشريعي السليم ولو بنسب معينة. أما في العصور المتأخرة، الحديث والراهن خصوصا، فإن الهوة في ذلك قد كبرت ومساحة الخلف بين الفهم والتنـزيل قد اتسعت وأضحت من المشكلات الكبرى والأسئلة المحرجة أمام الاجتهاد الفقهي والفكري المعاصر.
ثم إن ما ندعو إليه بخصوص اعتبار الواقع والفقه فيه كعامل من العوامل الحاسمة في التنـزيل والتطبيق وفي التدين عموما، بعيد كل البعد عما يعرف بـ”النـزعة الواقعية” التي تغالي في اعتبار الواقع لدرجة تجعل منه أصلا وحيدا للمعرفة. أو في أحسن الأحوال أصلا أولا محددا ومقرا لأحكام الدين نفسها دون تمييز فيها بين ما هو قطعي ثابت وما هو ظني متحرك*. إن “تأسيس الفهم العقلي لنصوص الوحي القطعية على معطيات الواقع بمستجداته.. (قد) يؤول (إذ لم يكن منضبطا بضوابط) إلى منع ما كان أمرا وإيقاع ما كان نهيا…، والواقع الذي تؤول إليه أوضاع الإنسان ليس بالضرورة متطورا نحو الأفضل في جميع مجالاته… فما آل إليه الإنسان من تقدم نحو اكتشاف الحقيقة في مجال الكون وما ترتب عليه من وسائل الرفاه، واكبه أسوأ ما عرف الإنسان من تظالم وبغي وسحق للكرامة الإنسانية… وما تعارف عليه الناس من أعراف وعادات وما ساد فيهم من قيم أدرجت كلها تحت روح العصر مخلوط فيها الحق بالباطل والرشد بالضلال…. كيف يمكن للواقع إذا بما فيه من مظاهر الباطل المألوف المحمود أن يصبح قيما على النصوص القطعية يقوم فهمها على أساسه… الحال أنه يمكن منطقيا ترتيب نتيجة معاكسة تماما إذا ما قلنا: إن ضروب الباطل والشقاء التي يزخر بها الواقع الإنساني هي التي كان سببا فيها غياب الإفهام التكليفية في نصوص الوحي..25.
وحتى بالنسبة للتأويلات التي تبتغي مقاصد الوحي وأهدافه الكبرى، ثم تتوسل إلى ذلك بالوسائل المختلفة المبررة واقعيا، نجد أن النص لا يسمح لها بذلك، فـ”الوحي جاء لتحقيق مقاصد فعلا، لكنه جاء يرشد أيضا إلى أساليب تحقيق تلك المقاصد في نصوص ظنية أو قطعية. وكما جاء الوحي ملزما بتحقيق المقاصد جاء ملزما أيضا بسلوك الأساليب المحددة في النصوص..”26.
ولهذا فإن “الأحكام التي يمكن أن يؤثر فيها الواقع هي الأحكام المستندة إلى الأدلة الظنية، أما تلك المستندة إلى الأدلة القطعية فلا أثر للواقع في تكييفها..”، وحتى التفاعل الحاصل بين الواقع وبين الأحكام الفقهية المستندة إلى أدلة ظنية والمتجلي فيما استنبطه وأسسه علماء الأصول من قواعد كالعرف والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والضرورة.. نجدهم قد وضعوا لهذه القواعد ضوابط حتى لا تستغل أو توظف على غير وجهها الصحيح والسليم. “فاشترطوا في العرف أن يكون مطردا أو غالبا، وأن لا يكون مخالفا لنص شرعي كأن يحل حراما أو يحرم حلالا.. وأن لا يعارضه تصريح بخلاف تصرفات الناس ومعاملاتهم..، وفي المصلحة المرسلة أن تدخل في إطار المقاصد الشرعية العامة.. وأن لا تكون معارضة لنصوص الكتاب والسنة.. وأن لا تفوت مصلحة أهم منها..، وفي سد الذريعة إذا كان الواقع في ذاته مصلحة لكنه يؤدي إلى مفسدة، فإن الفعل المستند إلى ذلك الواقع يصبح ممنوعا سدا لتلك الذريعة. وعلى هذا يكون تأثير الواقع المبني على سد الذريعة في الأحكام الفقهية تأثيرا عكسيا، فيصبح ذلك الواقع ممنوعا ولو كان موافقا في ظاهره للنصوص الشرعية..”27، وقس على هذا باقي القواعد أو الأصول المقررة عندهم.
وما تمكن ملاحظته بخصوص إحاطة الفكر الأصولي للواقع وآلات أو وسائل فهمه والتعاطي معه والانفتاح عليه، بجملة من الضوابط والشروط الرامية إلى توجيهه وحمايته من الانحراف إلى إفراط أو تفريط، هو إغفال تطوير وبلورة تلك الأصول أو القواعد بالشكل الذي يواكب في حركية استيعابية الواقع ومستجداته. وهذا ما يجعل الدعوة في الفكر المعاصر ملحة أمام ازدياد ضغط نوازل الواقع المستجدة المعقدة والمركبة إلى “اجتهاد واسع بمنهج الاستصلاح… وإلى اجتهاد استحساني واسع، وذلك لأنه واقع مؤثر تتعدد فيه العوامل والأسباب وتتناقض فيه المؤثرات بين استمرارية دينية ورواسب تاريخية من الانحطاط وغزو ثقافي من ثقافة الغرب وحضارته..”28. وأيضا إلى “القياس الإجمالي الأوسع أو قياس المصالح المرسلة، فهو درجة أرقى في البحث عن جوهر مناطات الأحكام، إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع التي تنـزل فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث الأولوية والترتيب..”29. ثم “إذا جمعنا أصل الاستصحاب مع أصل المصالح المرسلة تتهيأ لنا أصول واسعة لفقه الحياة العامة في الإسلام..”30.
بقي لنا أن ننظر في المقترحات التي يقدمها الفكر المعاصر بخصوص منهجية التنـزيل والتطبيق والمشكلات المتعلقة بها، وسنركز فيها على نموذج اعتنى أكثر من غيره بهذا العمل كما اتضح -ربما- من خلال كثير من الإحالات عليه؛ أقصد د. عبد المجيد النجار*. ويمكن أن ننطلق في بناء نظرية الكاتب من تصوره لفقه الواقع كعنصر من العناصر المهمة لفقه الدين نفسه وفقه تنـزيل أحكامه. “فقد يحصل فهم الدين ولكن لا يحصل تطبيق الدين = أي التدين”. ولهذا فإن “إنجاز التدين في الواقع الزمني محتاج إلى فقه خاص زائد عن فقه الدين وهو فقه التدين”، ثم لئن كان الدين “دائرا على العلاقة بين مصدر الدين قرآنا وحديثا وهو منضبط في خصائصه ومواصفاته، وبين العقل المدرك وهو منضبط في قانونه الإدراكي..(فإن) التدين يدور على العلاقة بين عناصر ثلاثة، تضم إلى جانب العنصرين السابقين عنصر واقع الحياة الإنسانية، وهو عنصر شديد التعقيد في أسبابه وتفاعلاته وملابساته، فكان بذلك متأبيا عن الانضباط المنطقي المطرد نـزاعا إلى الخصوصيات المستأنفة بحسب تغاير الظروف والأفعال… وقد أشار الشاطبي إلى هذا المعنى فيما سماه بالاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وقال فيه: إنه اجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة”، “وعلى هذا الاعتبار فإن فهم الواقع الإنساني يغدو عاملا بالغ الأهمية في التدين، ولا يقل أهمية عن فهم الدين نفسه، فهما الشرطان المتلازمان في مرحلة الفهم، اللذان يعتبران الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الدين في الواقع، أي في سبيل تحقيق التدين”31. ولا يخفى أن أول السبل إلى فهم الواقع باعتباره شبكة علاقات اجتماعية وإنسانية هو الانخراط فيه ومعايشة الناس والوقوف على مشكلاتهم.. والاستعانة في تحليل ذلك وفهمه بالعلوم الإنسانية المختلفة، اجتماعية ونفسية واقتصادية وغيرها.
وبما أن عملية الفهم أو الفقه منوطة بدرجة أولى بالعقل والجهد الذي يبذله في علاقته بالنص من جهة والواقع من جهة أخرى، فإن من أهم الخطوات التي ينبغي تحديدها كذلك هي مهمة العقل هذه. وهي “ذات مرحلتين متكاملتين، ولكنهما مختلفتان بالنوع، هما: مرحلة الفهم ومرحلة التنـزيل الواقعي. ومرحلة الفهم تتعلق بتعامل العقل مع الوحي في مظهره النصي لتبين المراد الإلهي… إلا أن حصول الفهم ليس بكاف في حصول التنـزيل، بل لابد من مهمة عقلية أخرى لعلها أعسر من الأولى، ذلك لأن الصورة الذهنية التي حصلت في العقل هي صورة مجردة يندرج تحتها ما لا ينحصر من أفعال الإنسان الممكنة الوقوع على امتداد الزمان والمكان… تحيط بها اعتبارات وظروف تجعلها مختلطة متشابهة متقاربة… بحيث تستلزم جهدا عقليا مهما تمييزا بين الأجناس وردا لكل فرد إلى جنسه لينطبق عليه الحكم الإلهي الموضوع له..”.
وتحدث الكاتب عن الأسس العامة لمنهج التطبيق: حيث يقتضي “تطبيق الأحكام على الوقائع لتحقق مقاصدها منهجا مخصوصا يتقوم بأسس غير أسس الفهم” من أهمها:
ـ التجزئة والأفراد: فـ”إذا كان الحكم الشرعي يحصل في الفهم كليا عاما بمنهج التجريد، فإن المجتهد عند تطبيق ذلك الحكم في واقع الحياة ينبغي أن ينحو به منحه التجزئة والإفراد في الموضوع الذي سيطبق عليه، ذلك أن الواقع هو أعيان مشخصة متمثلة في أفراد من الناس وأفعال تصدر عنهم وأحداث ونوازل فردية وجماعية تتوالى على الزمن… وبعض الأفراد والأجزاء من الواقع قد تحيط بها ظروف وملابسات تجعل إجراء الحكم الكلي عليها مثل مثيلاتها من نوعها أو جنسها مفضيا إلى الحرج والمشقة وربما الفساد، فيتعطل مقصد الحكم وهو تحقيق المصلحة”32.
ـ تحقيق المناط: وهو “أساس منهجي متفرع عن منهج التجزئة، ولكنه مختص بمعان مميزة… قال فيه الإمام الشاطبي: “معناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي ولكن يبقى النظر في تعيين محله.. ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر”، فكان لابد من تبين “ما هو داخل في نوع الحكم الذي بين يديه من تلك الأفراد أو في جنسه فيكون مناطا له يجريه عليه، ويخرج من ذلك ما يشتبه لأول النظر أنه داخل في ذلك النوع أو الجنس وهو في الحقيقة ليس كذلك”33.
ـ تحقيق المآل: فـ”الأحكام الشرعية في إطلاقها قدِّر فيها تحقيق مقاصدها المنتهية في أنواعها القريبة إلى المقصد الأعلى وهو مصلحة الإنسان، وذلك حينما تصبح مطبقة في واقع الحياة”، و”أفراد أخرى من الأفعال والأحداث قد تحيط بها ظروف وملابسات في ذات فاعليها أو أزمانها أو علاقاتها بأفعال وأحداث غيرها تجعلها حين يجري عليها الحكم الشرعي لنوعها لا يتحقق لها المقصد الشرعي، بل قد يحصل من تطبيقه الضرر من حيث أريدت المصلحة”34.
يتحدث الكاتب في هذا السياق أيضا عن دور العقل في تنـزيل الوحي، إذ “كما يكون الخطأ في فهم النص مفضيا إلى تعطيل مقاصد الشارع في الخلق، فكذلك الأمر بالنسبة للتنـزيل..”، وترجع أسس التنـزيل عنده إلى أصلين:
- العلم بمقاصد الأحكام؛ أي التبصر “بالمقصد الذي من أجله سيقع التنـزيل فيكون تحققه سببا في التنـزيل وعدمه”، “وجماع المقاصد تحقيق مصلحة الإنسان وخيره في الدنيا والآخرة” والمقاصد كلية عامة تندرج إلى مقاصد جزئية كما تقدم..*.
- العلم بالواقع؛ أي الأفعال الإنسانية التي يراد تنـزيل الأحكام عليها وتوجيهها بحسبها.. ويستلزم ذلك استخدام جملة من وسائل المعرفة المتعلقة بالإنسان كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد والإحصاء… فـ”كما أن الجهل بمقاصد الشريعة يفضي إلى فوات مصلحة الإنسان في تنـزيل الأحكام، فإن الجهل بالواقع الإنساني يفضي إلى نفس النتيجة”35.
ويحدد الاجتهاد في التنـزيل في مكان آخر من خلال ثلاثة عناصر، لا تكاد تخرج في الواقع عن العناصر المتقدمة في الأسس العامة لمنهج التطبيق، أي التجزئة والأفراد وتحقيق المناط وتحقيق المآل، أو قل هي متممه ومكمله لبعض جوانبها إن تكن هي نفسها من جميع الوجوه، وهي:
- الاجتهاد في تحقيق النوع: نوع الحكم ونوع الفعل نظرا للتشابه الواقع بين كثير من الأفعال، فـ “الحكم الذي ينطوي عليه النص يتجه إلى أجناس الأفعال كاتجاه المنع إلى السرقة والزنا والخمر… وتصرفات الإنسان تشتمل على أنواع متعددة تشبه أن تكون مشمولة بالأوامر والنواهي المتجهة إلى تلك الأجناس، فاختلاس الدرهم من جيب أحد المارة والسطو على بنك.. واغتصاب حافظة… تشبه أن تكون مشمولة بحكم السرقة… وهذا التقارب في صور الأعمال والتشابه بينها في انتسابها إلى نفس الجنس يقتضي من العقل أن يحقق في هذه الأنواع المتشابهة..”36.
- الاجتهاد في تحقيق الأفعال المشخصة: “فالأنواع التي وقع التحقيق فيها يندرج تحتها من آحاد الأفراد من الأفعال مالا يحصى عددا ولئن كانت مشمولة بنوع واحد إلا أنها في ذاتها متغايرة بالتشخيص..”، وهذا يقتضي من العقل “أن يحقق هذه الأفعال المفردة من حيث أحداثها وأسبابها ودوافعها ونتائجها وآثارها..”، حادثة استحواذ على مال مثلا، هل تنتمي إلى سرقة أو غصب أو حرابة أو استرداد حق.. الخ37.
- تنـزيل الأحكام: وهو ثمرة اجتهاد العقل في تحقيق الأفعال الواقعية في إطار النوع ثم في إطار التشخيص. وقد تقدم معنا نص الشاطبي حول العمل الاجتهادي في تنـزيل الحكم على ما يليق به من الأفعال بحسب الحالات و”فيما يصلح به كل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وازن واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك..”. ثم إن “هذا العمل العقلي في تنـزيل الأحكام عمل اجتهادي خالص لا يداخله التقليد بوجه من الوجوه، إلا أن يكون اعتبارا بأحكام سابقة من المفتين والعلماء أنـزلوها على أحداث ونوازل متشابهة على وجه التفقه للاستفادة في تحصيل ملكة التنـزيل لا على وجه الاستفادة في ذات التنـزيل على النوازل المشابهة..”38.
فهذه لمحة جد مختصرة عن واحد من المشاريع المتداولة في فكرنا المعاصر لا نـزعم أنه الأجود، لكنه الأكثر اشتغالا بالموضوع وإثارة لقضاياه وإشكالاته، تأصيلا وتبويبا وتفريعا واقتراحا… وطرقا لكل مدخل علمي يعيد لأصل الواقع اعتباره الشرعي في فهم وتنـزيل الأحكام بما لا يقل عن فهم النص نفسه وربما أكثر لأنه على الواقع يراد تنـزيله.
الهوامش
- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (قلد).
- ابن منظور، لسان العرب، مادة (قلد).
*من ذلك حديث: “من قلد عالما لقي الله سالما”، قال فيه الألباني: لا أصل له. وقد سئل عنه الشيخ رشيد رضا رحمه الله، فأجاب في مجلة المنار بقوله: “ليس بحديث”. الألباني: سلسة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة. المكتب الإسلامي. ط: 1/1399. ج: 2/ص29. رقم: 551. ومن ذلك آثار عن الصحابة ضعفها ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام. انظر مج 2. ج: 6/ص97. وكذلك الشاطبي في الاعتصام ج: 2/ص359. دار الفكر. مكتبة الرياض الحديثة. وفي الموافقات. ج: 4/ص169.
- ابن حزم، الإحكام، ح: 6/146.
- ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين. ج: 2/ص 208.
- انظر مثلا قول الشوكاني في القول المفيد:”فلا حيا الله هؤلاء المقلدة الذين ألجأوا الأئمة الأربعة إلى التصريح بتقديم أقوال الله ورسوله على أقوالهم لما شاهدوهم عليه من الغلو المشابه لغلو اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم”. ص58.
- انظر أيضا نهي الأئمة عن تقليدهم وأمرهم باتباع الدليل من الكتاب والسنة في:
. ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ج: 20/ص211 وما بعدها.
. ابن القيم: إعلام الموقعين. ج:2/ص:200.
. الشاطبي: الاعتصام. ج:2/ص200.
. الدهلوي: حجة الله البالغة. ج:1/ص:41.
- ابن القيم، إعلام الموقعين، ج: 2/ص260.
- ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص81.
- ابن خلدون: المقدمة، ص430-431.
* انظر مثلا: مقالات الإسلاميين للأشعري. والملل والنحل للشهرستاني. والفصل لابن حزم. والفرق بين الفرق للبغدادي… خصوصا وأن بعضها (كالفرق بين الفرق) نـزع إلى حصر الفرق في اثنين وسبعين فرقة حرصا على مطابقتها مع الحديث الوارد في الباب.
- عبد المجيد النجار: مباحث في منهجية الفكر الإسلامي. ص148.
- الغزالي: المستصفى، ج:1/ص10.
- النجار: في فقه التدين/ج:1/ص:35-36.
- النجار: فصول في الفكر الإسلامي.. ص171.
- الشاطبي: الموافقات/ج: 3/ص83-84.
- الشاطبي: الموافقات، ج: 1/46 ومابعدها، وانظر أيضا تفصيلا لذلك في المقدمة السابعة، ج:1/ص60 ومابعدها.
- ابن القيم: أعلام الموقعين، ج:1/ص:87-88.
- الزركشي: البحر المحيط، ج:8/ص354-355.
- الدريني: المناهج الأصولية. ص5.
- القرضاوي: من أجل صحوة راشدة.. ص45.
- القرضاوي: الفتوى بين الانضباط والتسيب، ص40.
- القرضاوي: المدخل لدراسة الشريعة، ص202 وما بعدها.
- القرضاوي: المدخل لدراسة الشريعة، ص203-204.
- ننظره في المرجع نفسه، ص206- 207. وانظر كذلك: د. جمال الدين عطية: أثر تغير الواقع في الحكم، تغييرا واستحداثا. مجلة المسلم المعاصر، ص15-ع: 59/1411-1991. والمقال مرصود لمعالجة مسألة تغير الحكم وفقا لشروطه الذاتية وكذا الموضوعية، أي لتغير الواقع وما يستحدث فيه من قضايا ونوازل، مستثمرا في ذلك جملة معطيات من مثل: محدودية النصوص ولا محدودية الوقائع، القطعي والظني، الرخص والعزائم، الاجتهاد والتجديد، المقاصد العامة والمصلحة…، ص33-55.
د. سعيد بن سعيد العلوي: الاجتهاد والتحديث، دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب. حيث عرض لأشكال من الاجتهادات التي يميلها واقع العصر الحديث، وخاصة من خلال أجوبة وفتاوى العلامة الحجوي الثعالبي الفاسي التي تعكس فعلا مادة حيوية وفقها حركيا مستجيبا لتطلعات وقته.
23. النجار: فصول في الفكر الإسلامي، ص179-180.
24. نفسه، ص183-184. وانظر أيضا: في المنهج التطبيقي، ص29-35.
*انظر في هذا مثلا ما تقدم عند حسن حنفي في دعوته إلى الانطلاق من (الأرض) بدل (السماء) وجعله للواقع (أصلا) أولا للمعرفة التي ينبغي أن تكيف عليها الأحكام الدينية نفسها. وكذلك بعض تأويلات د. الجابري المتعلقة بالظروف المحيطة ببعض أحكام الحدود، كحد السرقة وحد الزنا وغيرها.. هذا بغض النظر عن اتجاهات تتنكر أصلا للمعرفة الدينية وتحصر اهتمامها في الواقع وحده، والتي أعرضنا عنها جملة لخروجها عن أغراض هذا الحديث.
25. النجار: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، ص101-102.
26. نفسه، ص97.
27. انظر محمد جميل: الواقع وأثره في الأحكام الفقهية. بحث مخطوط، ص19 وما بعدها.
28. النجار، في المنهج التطبيقي، ص79.
29. الترابي: تجديد الفكر الإسلامي، ص84.
30. نفسه، ص85.
* يعتبر كتابه(في فقه التدين فهما وتنـزيلا) محاولة جادة من المحاولات النادرة في بناء صياغة نظرية متكاملة لمنهج الفهم في الدين، ولمنهج الفهم في الواقع، ولمنهج التنـزيل والإنجاز. لكن وللأسف طوي هذا العمل كما طويت أعمال سابقة من اهتمامات الفكر المعاصر.
31. النجار: في فقه التدين، ج:1/ص:32-33. وأيضا ص122. وأيضا ص121-122. وص125. كذا عرضه للتجربة التاريخية في فهم الواقع، في جيل والتابعين والأئمة وعلماء الأمة من حيث انخراطهم في هذا الواقع ومعايشتهم له ووقوفهم على علله ومشكلاته. وقد تقدم لنا مع الكاتب أن فشل كثير من الحركات الإصلاحية إنما كان قصورها في تمثل الواقع الإنساني الذي تهدف إلى إصلاحه، وفي امتلاك تصور عميق لطبيعة وعناصر تكوينه.
32. النجار: في المنهج التطبيقي، ص23-24.
33. نفسه، ص26.
34. نفسه، ص27.
*انظر أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، حيث ذكر منه مسالك الاجتهاد المقاصدي: – كون النصوص والأحكام بمقاصدها – الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة –جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقا- اعتبار المآلات.. ص249 وما بعدها. وأيضا تحديدا لطرق معرفة المقاصد من خلال نظرية الشاطبي في: فهم النصوص وفق مقتضيات اللسان العربي – الأوامر والنواهي – المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية – سكوت الشارع – الاستقراء.. ص241 وما بعدها.
35. النجار: خلافة الإنسان، ص109-114.
36. نفسه، ص115.
37. نفسه، ص116-117.
38. نفسه، ص119. وتنظر له أيضا: فصول في الفكر الإسلامي.. ص189-232. حيث عرض لنفس العناصر لكن هذه المرة من خلال (أصول المنهج التطبيقي عند الشاطبي) في أربعة عناصر كبرى: الامتثال للأمر الإلهي -تحقيق الأحكام- التحقيق في حصول المقاصد الشرعية – التحقق في مآلات الأفعال.