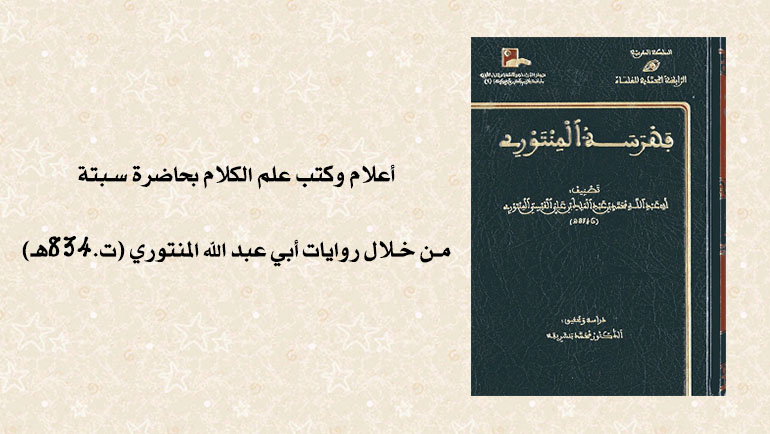توطئة
عكست الأمة الإسلامية في عالميتها الأولى نموذجا حيا في تواصلها مع الغير، سواء من الشعوب التي انضوت تحت لوائها أو الأقليات التي عاشت في كنفها أو الأمم المخالفة لها. فمن خصائص هذه الرسالة أنها خطاب عالمي كوني متسع لكل البشرية على اختلاف الثقافات والحضارات والهويات. ينحو إلى الإبقاء على الغنى والتعدد والتنوع في العطاء البشري باعتباره ملكا وإرثا مشتركا بين الإنسانية جمعاء، حيث كان التمثل للقيم الإنسانية والكونية والعالمية في رسالة الختم والاصطفاء الشامل في أعلى مستوياته. إلا أن هذا المد الثقافي والحضاري والديني المستوعب، أخذ في الانحسار والانطواء لدرجة انتفت معها إمكانات التواصل والتفاعل مع الشعوب والأمم الأخرى، وانكفأت الأمة إلى أوضاع وأنماط ثقافية وفكرية يهيمن عليها التحيز للمقولات المذهبية والفرقية وفق قواعد من الجمود والتقليد صارمة تحول دون استئناف النظر والبناء التجديدي والاجتهادي الذي يعيد للأمة وعيها الكوني بذاتها وبرسالتها.
في هذه الورقة نحونا إلى التركيز على ظاهرة التحيز في العلوم الإسلامية ذاتها، وكيف أن هذا التحيز كانت له تأثيرات سلبية على تطور ثقافة الأمة وعلى تفاعلها مع غيرها أخذا وعطاء وعلى الإبداع الحضاري فيها. حيث كان التركيز في البداية على ثلاثة أصول كبرى مؤطرة لفلسفات العلوم، ومشكلة للرؤية فيها، وممكنة من التواصل والتفاعل الكوني، حيث يمكن للأمة أن تساهم هداية وإرشادا وتقويما وتسديدا. أصل “التوحيد” وما يؤسس له من وحدة دينية ووحدة كونية ووحدة بشرية، وما يضفيه على العلوم والمعارف من غائية وقصد. وأصل “العدل” المؤهل للأمة إلى مقام الشهادة والخيرية بالحق، والنافي لكل أشكال الظلم والجور والطغيان. وأصل “الحرية“ الذي يسمح ببناء الاعتقادات والتصورات على قناعات لا على إكراهات، بما يضمن استمرارها وفعاليتها، وبما يوفر ويتيح من فرص الاجتهاد واستئناف البناء.
وبما أن الثقافة هي خلاصة وجماع العلوم والمعارف والأفكار المغذية لها، فقد ركزنا على مظاهر التحيز في بعض العلوم التي شكلت تاريخيا ولا تزال روافد لهذه الثقافة، واعتبرنا أن الإنتاج داخل فرق ومدارس ومذاهب مستقلة بأطرها المرجعية والمنهجية، والتي شكلت أنساقا معرفية “مغلقة” على ذاتها، قد حالت دون تفعيل إمكانات الأمة الكونية في التواصل الثقافي والحضاري مع الأمم والشعوب الأخرى، وساهمت بشكل أو بآخر في إنتاج ثقافة التقليد والانكفاء على الذات والاكتفاء بما لديها.
وهذه كلها أمور وقضايا معارضة لفلسفة الدين نفسه، من حيث عالمية رسالته وكونيتها وإنسانيتها وعلميتها وشمولها واستيعابها.. وكلها مداخل تفتح آفاقا للتفاعل والتواصل واسعة جدا. لكن منهج التحيز لم يتعامل مع النص/الوحي المؤسس للمعرفة باعتباره شاهدا بالحق على هذه المعرفة، وإنما تعامل معه باعتباره شواهد تبرر معرفة تأسست خارجه وبدأت بالتدريج وبفعل التداول التاريخي تحتل مكانه.
تعتبر الورقة كذلك أن التحرر من هذه الآفات المتجذرة في العلوم والثقافة سبيل من أهم السبل لإعادة بناء فكر إسلامي إنساني عالمي وعلمي فاعل ومنتج، تتجسد فيه خصائص الرسالة لا مشكلات التاريخ، حيث بإمكانه أن يتحول إلى قوة اقتراحية كبيرة تسهم في علاج كثير من مشكلات الحضارة الإنسانية المعاصرة التي تنكبت طريق الوحي وتمركزت حول ذاتها تدمرها ومن حولها إنسانا وطبيعة، في غرور بقيم إنتاجية واستهلاكية صارمة لا تراحم فيها.
إن الاقتران والارتباط السليم والمتين بالوحي يخرج على الفور الإنسان المستخلف الرسول، السوي المزكي. ويجعله يشيد عالم عمرانه وحضارته وعلومه ومعارفه برشد وصواب. فهو كما قال عنه منـزله جل وعلا: ﴿يهدي للتي هي أقوم﴾ (الاِسراء: 9)، و﴿يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام﴾ (المائدة: 18)؛ إذ كل آية فيه دعوة إلى فعل أو ترك، إيماني أو عملي؛ أي أن ثمة حركية وفاعلية دائمة في عالم الإنسان شبيهة بحركية الكون المنتظمة. تماما كما تجلى ذلك في المرحلة التأسيسية النموذجية الأولى، حيث كان التلقي فالعلم فالعمل، ولم تكن الحاجة إلى تدوين علوم وتقعيد قواعد ووضع ضوابط.. قائمة أصلا. فكل ذلك كان فكرا وسلوكا ممتزجا، وأيمانا وعملا متصلا. فلما دعت الحاجة إلى ذلك ودونت العلوم، كان الأصل في هذه العلوم أن تنعكس فيها خاصية الوحي هذه، فتكون مزكية للإنسان وبانية للعمران ومؤهلة للأمة إلى مقامات الشهادة والاستخلاف والخيرية. لكن الذي حصل العكس، حيث لم يعد للعلم وللعلوم دور البناء والتحريك ولا الوساطة الشفافة التي تربط الإنسان بالأصل وتحيله عليه. وحيث هيمن الجمود والتقليد والسكونية والتكرار والصورية والتجريد.. وكانت النتيجة وما تزال، منذ قرون خلت، التأخر والانحطاط وغلبة النـزعات والأهواء.
ثمة، إذن، مشكلة في الفهم والتصور، أو قل في الرؤية. ومشكلة في الاستمداد والتنـزيل، أو قل في “المنهج“، تستدعيان تضافر الجهود لاستئناف البناء التجديدي والإصلاحي التغييري، الجذري والعميق، الذي ابتدأه علماء من سلف الأمة وخلفها على هذه الواجهات جميعها. فأمة “اقرأ”، لا يمكنها أن تلج عالم الشهود الإيماني والحضاري من جديد إلا من حيث ابتدأته، من بوابة “العلم“.
فعلوم القرآن، مثلا، ليس كما اشتهرت تاريخيا وفي المقررات الدراسية، فهذه أقرب إلى التأريخ للقرآن منها إلى فقهه واستنباط العلم منه. وإن كان بعضها لا يخلو من ذلك وهو قليل، فثمة دوائر أساسية مهمة منسية ومهملة لا تزال غفلا. فالقرآن الكريم حديثًًًُُُُُُ نص، خطاب بلسان عربي مبين. وحديث عن الأنفس، الإنسان المكلف المستخلف. وحديث عن الآفاق، الكون المسخر مجال الاستخلاف.. ولكل دائرة علومها الخادمة لها، وكل تلك العلوم قرآنية. وبتعبيرنا، شرعية أو إسلامية؛ إذ يستوي الناظر المتفقه في آيات النص وفي آيات الأنفس وفي آيات الآفاق، فكلها دلائل على الحق مرشدة وهادية إليه في الكتاب المسطور كما في الكتاب المنظور، بينها وحدة بنائية نسقية تنتهي إلى أصل التوحيد وليس للإنسان إلا السعي الدءوب والبحث المنتظم الحثيث في الكشف عنها والاهتداء بها. لكن نال بعضها من البحث والتراكم إلى حد التضخم والأعراض المرضية ما تال، وبقي البعض الآخر يعرف فقرا مدقعا تستجدي فيه الأمة غيرها من الأمم، بل وأضحى وغدا مدخلا من مداخل استضعافها واستتباعها.
في الأصول المؤسسة للتواصل والنافية للتحيز
لقد شادت الثقافة الإسلامية لنفسها نماذج شامخة إبان عالميتها الأولى، تجلت في مختلف المجالات، وهيمنت هيمنة تكاد تكون مطلقة في سائر علومها وفنونها وآدابها ولغتها وقيمها، هيمنة ليست بالمعنى الواحدي النمطي، وإنما بالمعنى التعايشي التعارفي الذي يسمح لغيره بالوجود رغم الاختلاف الملي والإثني، تماما كما يسمح لتشكله الذاتي أن يتنوع ويغتني بتقاليد وآداب وفنون تختلف باختلاف العمق الآسيوي والعربي والإفريقي والأوروبي. هذه الحضارة في هذا الطور، انطلقت من أصول كبرى منحتها إمكانات هائلة للتحرر من أشكال كثيرة من التحيز وخاصة أصل “التوحيد“ الذي يعكس وحدة الخالق ووحدة الخلق ووحدة البشرية.
فعبادة الله وحده (توحيد الخالق) تحرير من كل مظاهر الاسترقاق والخضوع التي يفرضها إنسان على إنسان، وارتفاع نحو مقامات علوية تزكي النفس وتشحذ فاعليتها للعطاء أكثر في محيطها. التوحيد الذي وحد القبائل فجعل منها أمة على هذا الأساس العقدي: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾ (البينة: 5)، ﴿وما خلقت الجن والاِنس إلا ليعبدون﴾ (الذاريات: 56). واتسع هذا المفهوم (الأمة) ليستوعب أمما أخرى في كيانه الرحب.. وهكذا كل من اقتدى بالأمة “التي تؤم الناس” في التوجه إلى القبلة كان مشمولا باللفظ في معناه المستوعب وذلك بكل تجليات التوحيد الممكنة، من وحدة سياسية إلى وحدة اجتماعية إلى وحدة ثقافية إلى وحدة جغرافية… وهي أشكال من التوحد لم يبق لها في ثقافتنا المعاصرة للأسف ارتباط بأصل التوحيد المهيمن والموجه.
أما وحدة الخلق فهي الوحدة الكونية بسننها ونواميسها، وآياتها المختلفة. الكون مجال استخلاف الإنسان وعمرانه، حيث عليه السياحة الدءوبة للاستكشاف والتعرف على الآيات التي تساعده على بناء وتطوير حضارته وعلومه ومعارفه وكذلك ثقافته. فلا شيء من الإنسان إلا الجهد الذي يبذله للتعرف على الآيات ﴿اِن في خلق السموات والاَرض، واختلاف اليل والنهار ءلايات لأولي الاَلباب﴾ (ال عمران: 190) ﴿ومن ـاياته أن تقوم السماء والاَرض بأمره﴾ (الروم: 25). وهذا التعرف ينبغي أن يكون بمنهج الآيات نفسه، في انضباطه واطراده وبرهانه… وبكل ما يمكن من التعرف والاتصال السليم بهذا الكون، حتى يعطي من خباياه وكنوزه تماما كما يتزود المقبل على آيات النص بمختلف العلوم والإشكالات واليقين ليحصل التجاوب والعطاء المتبادل. وإلا كان الناظر وهو لا يبصر من الآيات شيئا كالذين قيل فيهم ﴿وكأين من ـاية في السموات والاَرض يمرون عليها وهم عنها معرضون﴾ (يوسف: 105). والناس على كوكبهم الأرضي الصغير ويسبحون في الفضاء الفسيح، يحكمهم منطق ركاب السفينة في المثال الرائع الذي ضربه النبي -صلى الله عليه وسلم- في تحمل المسؤولية ونفي العبث والتحيز الأعمى للمصلحة الخاصة ولو أدى ذلك إلى هلاك الجميع. عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا[1].” هناك، إذن، تفاعل بين السنن الدينية والكونية، ومعادلة بين الوحي المنظور في آياته والوحي المقروء في آياته، وأي إهمال لأحدهما لحساب الآخر يحدث على الفور خللا في المعادلة والتفاعل الراشد.
أما “وحدة البشرية“ التي تنفي كل أشكال التحيز الإثني والملي، فتنطلق من مبدأ التعارف بين الشعوب ﴿يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير﴾ (الحجرات: 13). ومن مبدأ اعتبار البشرية أسرة واحدة ممتدة، عن أبي نضرة قال، حدثني من سمع خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: “أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال؛ أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال؛ أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. ثم قال؛ أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟[2]“، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنوا آدم وآدم من تراب، لينهين أقوام فخرهم برجال أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من العجلان التي تدفع بأنفها النتن[3].”
إن الأصل في الثقافة الإسلامية أن تستثمر عالمية وشمولية رسالتها التي ابتدأت بقوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الاَقربين﴾ (الشعراء: 213)، وامتدت إلى ﴿لتنذر أم القرى ومن حولها﴾ (الشورى: 5)، لتنتهي إلى قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (الاَنبياء: 106) ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا﴾ (سبإ: 28). وفي النصوص المتقدمة معيار التفاضل “التقوى”، وهو مفهوم كلي مجرد قائم على أساس تزكية الإنسان بتخليصه ما أمكن من حظوظ نفسه لتحسين علاقته بالله تعالى وبالناس أجمعين.
هذه الوحدة التي شملها القرآن المجيد طورا بندائه: ﴿يأيها الناس﴾، وطورا بندائه: ﴿يا بني ءادم﴾. وعندما يخصص القرآن طائفة معينة فلاعتبار معين خاص به ﴿قل يا أهل الكتاب﴾، ﴿قل يأيها الكافرون﴾، ﴿يأيها الذين ءامنوا﴾.. كما أن التنوع في إطار هذه الوحدة البشرية أمر ضروري لها ولهذا كانت فيها أمم وشعوب مختلفة: ﴿ولو شاء ربّك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربّك، ولذلك خلقهم﴾ (هود: 118). ولذلك أيضا كانت سنن التدافع والتعارف والجدال بالتي هي أحسن لتحقيق التكامل والرشد. ونجد القرآن الكريم يضرب لذلك نماذج رائعة ليس في البحث عن نقاط التواصل مع الآخر فحسب، بل أحيانا بخلقها والمبادرة إليها بدافع الرغبة المأجورة في البيان والتبليغ. نجده في أماكن يقرر تحريف أهل الكتاب لكتبهم (تبديلا وكتمانا ونسيانا…) ثم يدعوهم إلى الكلمة السواء ويدعو إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن. نجده يقرر تجبر وتأله فرعون واستخفافه قومه، ثم يرسل إليه موسى وهارون ليخاطباه بالقول اللين لعله يذكر أو يخشى. نجده يقرر ضلال أقوام وجرمهم ثم يعرض محاورتهم في سياق بديع، يقربهم ولا يبعدهم فيجعل الذات “شريكة” معهم في هذا الضلال كما يجعلهم “شركاء” في الهداية مع إشعار كل طرف بمسؤوليته الخاصة: ﴿وإنّا وإياكم لعلى هدى اَو في ضلال مبين، قل لا تسئلون عمّا أجرمنا ولا نسئل عمّا تعملون﴾ (سبإ: 24-25).
والمفروض في فقه التعامل مع الآخر أن يستبعد كل التصنيفات التاريخية التي كانت محكومة بظروف حرب مرافقة لحصار الدعوة كدار الكفر والإيمان، ودار السلم والحرب. فالغرب الآن فيه أزيد من ثلاثين مليون مسلم؛ أي ما يعادل مجموع دويلات كثيرة في العالم الإسلامي. كما ينبغي تجاوز ثنائيات فكرية وسياسية كثيرة جعلتها المركزيات الغربية المعاصرة عوائق وموانع أمام التواصل والتفاعل الإيجابي بين الشعوب ومنها (الأنا والآخر، الحداثي والماضوي، الشرق والغرب، الشمال والجنوب، الإسلام والغرب..).
يضاف إلى أصل التوحيد أصل “العدل“؛ العدل الذي أمر به الحق سبحانه: ﴿إن الله يامر بالعدل والاِحسان﴾ (النحل: 90)، وألزم به كل من حكم بين الناس: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ (النساء: 57)، بما في ذلك نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم: ﴿وأمرت لأعدل بينكم﴾ (الشورى: 13)، فالعدل ميزان لا يجوز فيه الظلم مهما كانت ملة الآخر وعرقه وجنسه واختلافه: ﴿ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ ( المائدة: 9). وإنما استحقت الأمة الشهادة على الناس لأصل العدل الذي أنيط بها، وهو الوسط والخيار الذي دلت عليه الآية: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس﴾ (البقرة: 142). وقد حفظ لنا التاريخ صورا رائعة من عدل المسلمين في صدر الإسلام كان من المفروض أن تكون روافد داعمة للنموذج الثقافي الإسلامي في تدافعه وتعارفه الكوني المعاصر. لكن للأسف، انهارت تلك الصور مع انهيار منظومة القيم، ليس في عالم الإنسان فحسب، بل وفي التعامل مع الأشياء كذلك، بدءاً من المحيط/المجال الصغير بأزهاره وثماره، إلى الكون/الفضاء الكبير ببحاره وأفلاكه وطبيعته وكل شيء فيه، حماية له من التلويث والتخريب والعبث وهو الاتجاه الذي تسير فيه بجنون منظومات الإنتاج والربح والاستهلاك في الغرب الآن.
الأصل الثالث هو “الحرية“، هذا الأصل العظيم الذي ميز الله تعالى به الإنسان وجعله من طباعه النفسية والاجتماعية. كما لا يمكن أن يكون هناك اجتهاد وإبداع دون فضاء من الحرية، ومتى انتشر الاستبداد بمختلف أشكاله وأنواعه كان مقدمة تستبع الانهيار لا محالة، وهذا ما عرفته كثير من النظم والحضارات قبل الإسلام وبعده. والحرية بقدر ما هي تحرر نفسي ذاتي من كثير من القيود السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية، وباصطلاحنا (تحيزات سلبية مغلقة) من أجل تواصل أفضل، هي كذلك تحرير لطاقات الإبداع والاجتهاد التي بها تستأنف الحضارة بناءها والثقافة غناها. ولما نـزل القرءان، حرر الإنسان من كثير من الاعتقادات الساذجة والتصورات الضيقة والانتماءات المحصورة، وفتح بصره وبصيرته على آفاق كونية وإنسانية أشمل وأوسع. وجعله لا يبني قناعاته وتصوراته إلا على منهج الآيات؛ أي البراهين والحجج التي تجعله مطمئنا ومبصرا في اختياره. فكل الآيات الداعية إلى التفكر والتدبر والنظر والتعقل والاعتبار والإبصار.. وما إليها، هي تعبير بالغ الإلحاح عن ضرورة فسح المجال أمام الاجتهاد وحركية العقل في فضاء من الحرية وتخليص حثيث للإنسان من كل مظاهر التحيز السلبي الذي لا تسنده آية.
فكان تحرير عقل وقلب الإنسان بالإيمان، وكما قيل: “كمال الحرية في كمال التوحيد”. ولم يأت الإسلام داعيا إلى التحرر فحسب، بل كان ملتزما بمبدأ الحرية إلى أقصى مداه. ليترك للإنسان حق الاختيار في الإيمان به أو عدم الإيمان به: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر﴾ (الكهف: 29) دون إلزامه باعتقاد معين أو حمله عليه قسرا ﴿لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي﴾ (البقرة: 255). بل قد يصل الأمر أحيانا إلى حد العتاب لشخص الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحرصه على إيمان قومه: ﴿اَفأنت تكره الناس حتى يكونوا مومنين﴾ (يونس: 99)، ونظير هذا كثير في القرآن الكريم. فبعد بيان الحق المسند بالآيات تترك إرادة الإنسان حرة في الاختيار مع تحمل كامل المسؤولية بعد البيان.
وهذا الأصل هو الذي تعلمه الجيل الأول في مدرسة النبوة وساسوا به الناس، وقد طارت في الآفاق مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”. ولهذا اعتبر الكواكبي -رحمه الله- في كتابه: “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” غياب الحرية بفعل الاستبداد والاستعباد جوهر التخلف والانحطاط الثقافي والحضاري عند المسلمين؛ لأنه ببساطة يقتل روح المبادرة في الإنسان فيحوله من إنسان عَدْلٍ إلى إنسان كَلٍّ غير قابل للبذل والعطاء والاجتهاد، ينحصر عالم حضارته وثقافته، بل ووجوده في الحيز النمطي الضيق الذي يرسمه له المستبد به فلا يكاد يبصر من العوالم الأخرى شيئا. إنه الاستبداد نفسه الذي أجهض معظم حركات الإصلاح والتغيير التي ظهرت في الأمة قديما وحديثا وحاولت الانفكاك كلا أو جزءا عن رواسب الوهن والجمود والتقليد التاريخي أو الراهن.
نحن، إذن، -فيما تقدم على وجازة القول فيه- أمام أصول مؤسسة لثقافة التواصل، والعطاء الكوني، ثقافة يجعلها أصل التوحيد داخل وحدة دينية وكونية وبشرية مشتركة بمنهج الآيات في الحجاج والإقناع. ويجعلها أصل العدل شاهدة على الناس، ويزودها أصل الحرية بقوة الإرادة في البناء والعطاء المستمر. ثقافة تتجلى فيها خصائص الرسالة التي أنجبتها من توحيدية ربانية وإنسانية وكونية وواقعية وشمولية واستيعاب… وغيرها. كذلك كانت هذه الثقافة وكانت الحضارة في عصور الازدهار الأولى، ولنترك شاهدا أجنبيا يحكي لنا صورة دالة على مسافة التأخر بين ماضينا وحاضرنا بمقياس الزمن النفسي والثقافي، وكيف انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، وتم تبادل المواقع بين مؤثر ومتأثر، لما ارتخت سواعد الأمة عن الإمساك بالأصول والسنن البانية فأسلمتها لسواعد أخرى ثم انـزوت إلى الظل.
تنقل لنا المستشرقة الألمانية “زيجرد هونكة“ شكوى أحد الآباء الروحيين النصارى، ممن كانوا شهود عيان في الأندلس على قوة جذب المد الروحي والفكري العربي الذي سقط ضحيته رعايا (النصارى) طوعا وعن طيب خاطر، إنه أسقف قرطبه (ألقارو) الذي راح يجأر بشكواه بكلمات مؤثرة تصور بلواه: “إن كثيرا من أبناء ديني يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين، ليس ليدحضوها، وإنما ليتقنوا اللغة العربية ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم. وأين نقع اليوم على النصراني –من غير المتخصصين- الذي يقرأ التفاسير اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا الذي يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة، والأنبياء ورسائل الرسل؟ واحسرتاه! إن الشبان النصارى جميعهم اليوم، الذين لمعوا وبزوا أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي! إنهم يتعمقون دراسة المراجع العربية باذلين في قراءتها ودراستها كل ما وسعهم من طاقة، منفقين المبالغ الطائلة في اقتناء الكتب العربية وإنشاء مكتبات ضخمة خاصة، ويذيعون جهرا في كل مكان أن ذلك الأدب العربي جدير بالإكبار والإعجاب! ولئن حاول أحد إقناعهم بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون باستخفاف، ذاكرين أن تلك الكتب لا تحظى باهتمامهم! وامصيبتاه! إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم، فلا تكاد تجد اليوم واحد في الألف يستطيع أن يدبج رسالة بسيطة باللاتينية السليمة، بينما العكس من ذلك لا تستطيع إحصاء عدد من يحسن منهم العربية تعبيرا وكتابة وتحبيرا، بل إن منهم من يقرضون الشعر بالعربية، حتى لقد حذقوه وبزوا في ذلك العرب أنفسهم[4].” ولنترك للقارئ التأمل في النص وفي تغير وتبدل الأحوال. ولنتساءل لماذا وكيف وقع هذا التحول بهذه الدرجة الكبيرة؟ وإن كنا قدمنا بعض الإجابات السريعة فيما تقدم، فإننا نود أن نركز فيما يلي على إجابات أخرى أساسية ومكملة لها، وطيدة الصلة بموضوعنا حول التحيز الذي أصاب كيان الثقافة الإسلامية وحال دون استمرار إشعاعها وعطائها وتفاعلها الكوني وحال بينها وبين أصولها المؤسسة فجعلها رهينة تجارب ومعطيات تاريخية لا تكاد تنفصل عنها.
من مظاهر الانهيار الثقافي والحضاري في الأمة، الدخول في طور الانكماش والتحيز (تشخيصات من خلال نماذج)
لعل من أبرز عوامل انحسار المد الثقافي والحضاري في الأمة هو الانقلاب الذي وقع على مستوى الوعي والفكر الاجتهادي الذي كان سائدا في الأمة في أجيالها الثلاثة وحتى عصر الأئمة “المؤسسين” أصحاب المذاهب، ليركن الناس بعد ذلك إلى الجمود والتقليد، وحيث استكملت الفرق والمذاهب بناءها، فغدا التحيز للمقولات والتعصب لها ولو كانت مرجوحة وضعيفة السمة الغالبة في العصور اللاحقة، وسحب البساط كليا من تحت كل حركة اجتهادية تجديدية والتي غدت استثناءات نادرة بعد أن كانت أصولا مؤسسة. إننا نعتبر مظاهر التحيز التي غدت بنيوية ومزمنة في كيان الثقافة الإسلامية وتجلت في علوم كثيرة منها، مسؤولة إلى حد كبير عن تقليص دائرة الرؤية إلى طبيعة الرسالة ووظائف وتكاليف الأمة، وهي تكاليف جماعية منوطة بالأمة تماما كما أنيطت التكاليف الفردية بالأفراد. لكن غلبة الفقه والنوازل الفردية والمصالح السياسية الخاصة وانحسار الرؤية الكونية الإنسانية… كل ذلك عطل الاهتمام بشيء اسمه “فقه التكاليف الجماعية“ الذي كان من المفروض أن يسهم في الحفاظ على كيان الأمة وعلى عطائها ودورها التشاركي والتفاعلي مع الغير..
وقبل أن نعرض لبعض النماذج، نشير كذلك إلى أن هذه العلوم إنما نشأت حول النص، لكن تداولها التاريخي أبعدها عنه وبدل أن يكون شاهدا عليها تنبثق منه تصورا ومنهجا، أصولا وفروعا تدور معه حيث دار، تعكس خصائصه وقيمه ومعانيه التي تمنحها قوة البقاء والعطاء في ساحة التدافع الكوني. بدلا من ذلك، نجد أن النص تحول فيها إلى شواهد، وقرئ قراءات عضين، وأضحى حلبة استشهاد واستدلال على مقولات ناجزة وتصورات قائمة لا ينقصها إلا شواهد قرآنية أو حديثية. وهكذا كان التحول والانتقال من “أصول تؤسس المعرفة إلى أصول أسستها المعرفة.” وأدى ذلك إلى استقلال تلك العلوم، فأضحت كيانات مغلقة بكامل طقمها المفاهيمي لا تكاد تنفتح على بعضها، فكيف تنفتح على غيرها لتحقيق مراد النص ومقصده. وقد شهد التاريخ حالات صراع واحتراب حادة، بسبب التحيزات المضمرة أو الصريحة والتي كان العامل السياسي حاضرا فيها، كذلك تغليبا لجانب على آخر.
آفة أخرى تنضاف إلى ما تقدم وهي أنه لم ينظر في بناء هذه العلوم إلى مصادر المعرفة في تكاملها، بحيث تعتمد بشكل متواز نصا وعقلا وواقعا، فغالبا ما نجد هيمنة جانب على آخر، الأمر الذي يبرر تضخم نـزعات نصية مغلقة على حساب العقل ودوره في التدبر والتفكر والاجتهاد، وعلى حساب الواقع ودوره في تكييف الأحكام. أو تضخم نـزعات عقلية أو واقعية على حساب إرشاد النص وهدايته وتصويبه وتسديده، فهو المطلق وما عداه نسبي متغير. ساعد على ذلك أيضا تصنيف العلوم إلى عقلية ونقلية، وظاهرة وباطنة، وعادية وتعبدية، وشريعة وعقيدة، والتمييز بين علوم دينية شريفة وعلوم دنيوية وضيعة مما زهد الطلاب في هذه الأخيرة فضاعت بذلك حضارتهم ودالت دولتهم ولم يستطيعوا نصرة دينهم..
ولئن كانت هذه التقسيمات محكومة بظرفيات تاريخية نشأت فيها فرق ومدارس معينة، ومحكومة بتبسيطات منهجية تربوية تعليمية، فإن تداولها التاريخي للأسف جعلها تستقر على ما هي عليه من غير إدراك لناظم ينتظمها إلى أصل كلي مهيمن ومصدق.
نلاحظ كذلك أن دوائر هذا التحيز متعددة ويمكن رصدها من زوايا مختلفة:
ـ من جهة تعظيم وتشريف كل طائفة لعلمها ومعارفها التي هي عليها وهي من صنع أيديها وعقولها فتحولت بذلك إلى أصل والباقي تبع لها.
ـ من جهة التفرق إلى طوائف ومذاهب شتى داخل العلم إلى حد التطاحن والتبديع والتفسيق والتكفير.
ـ من جهة استقلال كل علم بمفرداته واصطلاحاته ومناهجه وكأنه كيان مكتمل العدة والعتاد لا علاقة له بغيره إلا من حيث تبعية هذا الغير له.
ـ من جهة هيمنة مظاهر التجريد والصورية والتكرار ولنقل التاريخية على مباحث هذه العلوم وانحسار الفقه العملي والواقعي المتجدد بتجدد الزمان والمكان… الخ.
وقد ساهم ذلك كله في انفراط الناظم المنهجي الذي يربط دوائر العلوم كلها بالوحي الملهم والمسدد. الذي بإمكانه أن يقوم مظاهر التحيز والقصور فيها، ويحدد نسب التكامل والتواصل فيما بينها ومع غيرها من العلوم الإنسانية والطبيعية، كما يجدد فاعليتها ويضمن استمراريتها بما يزودها من طاقة وقوة دفع لا تنضب؛ لأنها تمتح من معين مطلق ولا متناه من الإمكانات.
ولنبدأ نماذجنا هذه بالأصل الأول وهو “علم أصول الدين“ مع نص له دلالات كثيرة، يقول الشريف الجرجاني في مقدمة شرحه كتاب “المواقف” للإيجي: “إن أنفع المطالب حالا ومآلا، وأرفع المآرب منقبة وكمالا، وأكمل المناصب مرتبة وجلالا وأفضل الرغائب أبهة وجمالا هو المعرفة الدينية والمعالم اليقينية؛ إذ يدور عليها الفوز بالسعادة العظمى والكرامة الكبرى في الآخرة والأولى. وعلم الكلام في عقائد الإسلام من بينها، أعلاها شأنا وأقواها برهانا وأوثقها بيانا وأوضحها تبيانا، فإنه مأخذها وأساسها وإليه يستند اقتناصها واقتباسها، بل هو كما وصف به رأسها ورئيسها[5].” عندنا هنا اختزال للعلوم الدينية في علم الكلام أو العقائد، ولو توقف الأمر هاهنا لهانت المسألة، لكن عندما نلج مباحث هذا العلم وفرقه ومذاهبه وأحزابه، نجد أن جهودا عظمى أنفقت على مدى أجيال وقرون في تاريخ الأمة لم تعد عليها بنفع يذكر، بل بتحويل ساحة الصراع إلى الداخل بعد أن كانت موجهة إلى درء شبهات الخصوم، ومن تم إحداث الشرخ الهائل في كيان الثقافة الذي أقعدها إلى الأرض وحول فيها وجهة البحث التي كانت تؤهل الأمة إلى الإمامة إلى وجهة ذات أنفاق وسراديب تشدها إلى الخلف.
يبين لنا صاحب “الملل والنحل”، عبد الكريم الشهرستاني تحيز أصحاب المقالات إلى مقالاتهم مهما ضعفت وصغرت، وحرصهم الشديد على التميز بها وكونهم لا يستندون إلى منهج في تعديد الفرق. فليس لهم أصل أو نص أو “قاعدة مخبرة عن الوجود” و”ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عُدَّ صاحب مقالة، وإلاّ تكاد لا تخرج المقالات عن حد الحصر والعد”. فلما كان لابد “من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة، ويعد صاحبه صاحب مقالة”، اجتهد الشهرستاني –كما يقول- “على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير” حتى حصرها في “أربع قواعد هي الأصول الكبار” وهذه القواعد كما عددها هي (الصفات والعدل فيها)، (القدر والعدل فيه)، (الوعد والوعيد والأسماء والأحكام)، (السمع والعقل والرسالة والإمامة)، وكل قاعدة تندرج تحتها جزئيات كثيرة. وحصر كذلك كبرى الفرق الإسلامية في أربع (قدرية، وصفاتية، وخوارج، وشيعة) وتتشعب كل فرقة إلى أصناف تصل إلى ثلاث وسبعين فرقة[6].
وهذا الرقم هو الذي تمسك به أكثر “عبد القاهر البغدادي“ في تعداده للفرق الكلامية بمطابقة كاملة لا تخلو من تكلف مع تركيز بالغ على “الفرقة الناجية” ومن هو مشمول بالنجاة فيها ومن ليس بمشمول من الفرق المبتدعة الأخرى؛ كل ذلك استناداً إلى حديث تفرق الأمة والفرقة الناجية. فعد من الفرق اثنتين وسبعين ليجعل “الفرقة الثالثة والسبعون هي أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث دون من يشتري لهو الحديث، وفقهاء هذين الفريقين وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلموا أهل الحديث منهم كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته، وعدله، وحكمته، وفي أسمائه وصفاته، وفي أبواب النبوة والإمامة، وفي أحكام العقبى، وفي سائر أصول الدين. وإنما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكام، وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق وهم الفرقة الناجية (…) فمن قال بهذه الجهة التي ذكرناها ولم يخلط إيمانه بشيء من بدع الخوارج والروافض والقدرية وسائر أهل الأهواء فهو من جملة الفرقة الناجية إن ختم الله له بها، ودخل في هذه الجملة جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري أهل والظاهر[7].”
ولسنا بصدد تتبع صحة الحديث، وقد فعل البعض، ولا بصدد تتبع تعداد الفرق وانسجامها مع الرقم سواء كان دالا على الكثرة أم على الحصر. ولكن قضايا كثيرة قيل فيها الاتفاق وهي محل نـزاع وتعصب للرأي أو الأثر بين أصحاب المذاهب المذكورة لدرجة التفسيق والتكفير. ولنبق داخل دائرة “الكلام” لننقل عن محقق “مقالات الإسلاميين” لأبي الحسن الأشعري، قوله بأن “الحنابلة حاولوا أن يمنعوا الخطيب البغدادي (توفي 413ﻫ) من دخول المسجد الجامع ببغداد؛ لأنه كان يذهب مذهب الأشعري، وكان أكابر الأشاعرة في ذلك العهد يضطهدون ويساء إليهم. وقد تحاملت الحنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوي النفوذ وهو القشيري (توفي 514ﻫ) ووقع بسبب ذلك قتال في الشوارع واضطر القشيري إلى ترك بغداد[8]“، بل رغم بيان الإمام الأشعري الذي جاء فيه: “قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل –نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون، ولمن خالف قولُه قولَه مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال[9].” رغم ذلك لم يسلم متابعة وتضييقا من أهل الحديث، وكما قال المحقق: “والظاهر أن أهل الحديث لم يتقبلوا أبا الحسن الأشعري لما ظهر بمذهبه هذا الذي حاول به أن يوفق بين مذهب أهل السنة والعقل بما كان يتوقع، إما لأن نشأته في أحضان المعتزلة لم تكن لتزيل عنه أوهامهم وشكوكهم، وإما لأنهم يمقتون مذاهب المتكلمين ولا يقبلون أن يلفظوا بعبارة من عباراته[10].” وقس على هذا الخلاف بين الشافعية والأحناف خصوصا بما حبلت به كتب الكلام والفقه والأصول.
في علم آخر كعلم الحديث، مثلا، نقرأ ما ذكره الخطيب البغدادي في شرف هذا العلم وتفضيله على غيره لارتباطه بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشرف أهله تبعا لذلك. يقول: “وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليفته، والواسطة بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث. فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمومون عليه، والعدول حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته (…)، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله، ولا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم…[11].”
فهذا النص كسابقه من حيث الانتصار لهذه الفئة، وإن حاول البغدادي –رحمه الله- نفي التحيز عن هذه الفئة وإلصاقه بالفئات الأخرى فقد كان في الواقع يثبته ويقرره. ولا شك أن كثيرا من المحدثين عظماء ونوادر قل أن يجود الزمان بمثلهم بما حباهم الله من ملكة الحفظ والفهم وخدمة الحديث الشريف كالإمامين البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم –رحمهم الله-. لكن الانتساب إلى الحديث لا يخول كل تلك الأفضلية والشرف على من تبقى. وإلا فما قدر وشرف المشتغل بالتفسير وهو ينسب إلى القرآن الكريم. وقدر وشرف القراء وهم ينسبون إلى القرآن الكريم. وهذا بالفعل ما يشير إليه الإمام السيوطي في مقدمة “الإتقان في علوم القرآن” الذي جعله مقدمة لتفسيره وأثنى عليه ثناءً بالغا، وأهميته طبعا هي من أهمية مادته الدائرة حول القرآن الكريم، يقول: “وبعد فإن العلم بحر زخار لا يدرك له من قرار، وطود شامخ لا يسلك إلى قننه ولا يصار، من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولا، ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلا، كيف وقد قال تعالى مخاطبا لخلقه: ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾ (الاِسراء: 85)، وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأبان فيه كل هدى وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج منه الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام، ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولي الفكر والاعتبار إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها[12].” وكل كلام السيوطي حق في القرآن الكريم لكن -وكشأن السنة النبوية- ليس كل مشتغل بعلومه يعطي كل كنوزه وأسراره. أو يرفع من قدره ومقامه على من سواه ممن يشتغل بعلوم أخرى تتعلق بالإنسان أو الكون والطبيعة أو غيرها من الخلائق والآيات البينات في الكتاب المسطور كما في الكتاب المنظور.
ونختم هذه النقول بنقل عن الإمام الشوكاني في “إرشاد الفحول” يبين لنا تحيزه كذلك لعلم الأصول بجعله إياه مركزا وقطب رحى، يقول: “وبعد فإن علم الأصول لما كان هو العلم الذي يهوي إليه الأعلام والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين، كما تراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول، مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول، تقصر عن القدح في شيء منها أيدي الفحول وإن تبالغت في الطول. وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعا في الرأي رافعا له أعظم راية، وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية[13]“، والنص واضح في تقريراته ومبالغاته لا يحتاج إلى مزيد من التعليق والبيان..
فإن قيل، هذه ديباجات عادية يستهل بها العلماء كتبهم فيكون فيها عادة شيء من التحيز إلى العلم الذي برعوا فيه أكثر. قلنا هذه ديباجات تمارس استقطابا حادا على قارئها وخصوصا من المتعلمين، فترسخ لديهم مع استقرارها بالتداول التاريخي ومناهج التلقين التقريرية دونية العلوم الأخرى. كما تؤسس في هذه العلوم ذاتها تمركزا حادا في مصطلحاتها ومفاهيمها التي اختلط فيها الأصيل بالدخيل أو وجهت دلالاتها وجهات مختلفة ومتحيزة كذلك. فعلم الكلام له قاموس اصطلاحي خاص (الجواهر، الأعراض، الأجسام، القدم، الحدوث، واجب، الوجود، ممكن الوجود، الذات، الصفات، الأفعال…). والأصل في هذا العلم أن يزكي النفس والذات البشرية بالإيمان. ويقال مثل هذا في كثير من اصطلاحات الفقهاء والأصوليين والصوفية وغيرهم؛ إذ بدل أن تقرب العلم فتفيد به وتيسره، تغربه وتعسره وتفقده مقصده الأصل، وهو كونه خادما لأصل وليس أصلا.
إن تمركز العلم على ذاته يجعله يقلص إمكان انفتاحه على غيره من العلوم. وإن كان ممكنا في فترات تاريخية ما، أن يكون المفسر محدثا وأصوليا وفقيها ومتكلما، وأن يجمع إلى ذلك علوم طبيعية وكونية أو إنسانية، فإن هذا في أوج انحطاط الأمة الثقافي والحضاري لم يعد ممكنا البتة مع بلوغ الشرايين الرابطة والموصلة حالة من الانسداد مؤلمة، وإن كانت التخصصات الدقيقة الآن، لدى الغربيين بالأصل ثم لدينا بالتبع، قد أنهكت المعرفة والثقافة وأفقدتها خصائص وقيم التواصل والتكامل والتكافل الحقيقي، وباتت الحاجة ملحة إلى ضروب من التركيب جديدة بعد عمليات التفكيك المتمركزة حول نماذج معينة والمدمرة للثقافة والقيم الإنسانية. فإن ثقافتنا غير مؤهلة للقيام بشيء من ذلك وإن كانت أصولها تدعو إلى ذلك. فظاهرة التحيز في العلوم لزمتها ظاهرة سلبية أسوأ وهي التكرار والاجترار في كل علم، ظاهرة ملحوظة بشكل بارز في هذه العلوم إلى الآن ومساهمة بشكل أساس في الوهن الثقافي والحضاري العام. هذا مع استثناء الجهود والإضافات النوعية وإن ندرت كصنيع الإمام الشاطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن خلدون، وابن رشد.. وغيرهم، إلى المدارس الإصلاحية الحديثة في شرق العالم الإسلامي وغربه. لكن “لا يمكن للعلوم أن تكون رافدا للنهضة الحضارية والثقافية في الأمة ومساهمة في المعمار الكوني، وحركة التجديد والإبداع فيها استثناءات منقطعة وليست أصلا مطردا، خصوصا إذا علم أن هذا الانقطاع يمتد عبر قرون كتلك التي تفصل الشاطبي عن الشافعي وكتلك التي تفصلنا عن الشاطبي وقل مثل ذلك في باقي الاستثناءات الأخرى.”
فعلم الأصول مداره عموما على رسالة الإمام الشافعي يبعد قليلا أو يقترب بحسب هذا المذهب أو ذاك لكن حول القضايا نفسها دون تجديدات جوهرية تراعي التحولات النوعية والكمية داخل كيان الأمة وخارجها والتي تحتاج إلى أن تكون مشمولة بهذه الأصول. وخاصة قضايا الحقوق والحريات والعلاقات والأمن وغيرها. وعلم الحديث مداره حول مقدمة ابن الصلاح شرحا واختصارا ونظما دون القدرة على تحويل الحديث إلى مصدر للمعرفة والحضارة، مغذي لكل العلوم وفق تصنيف موضوعي جديد، مثلا، ليس بالضرورة هو التصنيف الفقهي وحده. وعلوم القرآن تدور على البرهان والإتقان، وما تعلق بتاريخ القران أكثر من نصه والدربة على الفقه فيه والاستنباط منه والاستعانة في ذلك بالمعارف والعلوم الحديثة. وأصول الدين أو علم الكلام مداره كذلك على مقالات الإسلاميين تقترب أو تبتعد، لكن ليس إلا في تزكية اتجاه الفرقة والتحيز، دون القدرة على إعطاء مفهوم التوحيد في بعده الإيماني التوقيفي أبعادا أخرى تم إهمالها وفصلها عن هذا الأصل وهي إنما منه انبثقت. فوحدة الأمة الاجتماعية والسياسية والثقافية هي من وحدتها العقدية، وعلوم الكون والإنسان التي تعكس وحدة الخلق، هي دليل وبرهان التعرف على الخالق وتوحيده. وكذلك دوران الفقه على تاريخ المذاهب الفقهية وقلًّ أن نجد جهة تعمل على تكوين وتخريج فقهاء يجتهدون لعصرهم ولا يغتربون في عصور غيرهم. فلا ندرس ولا ندرس من العلوم إلا تواريخها، أما جوهر العلم وإنتاجه فهذا أبعد ما يكون.
وفي جملة، فإن الثقافة الجامعة لهذه العلوم والمعارف التي ذكرنا نتفا منها لم يمارس فيها ضرب من التجديد في بنياتها العميقة بالشكل الذي تستعيد به فعاليتها وتستأنف به رسالتها. وما ينبغي التنبيه إليه هنا، هو “أننا لا ننطلق في هذه الدعوة من منطلق عدمي ينفي الجهود السابقة ويحجب الصور المشرقة والاجتهادات المبذولة في هذا العلم أو ذاك، أو يقلل من قدر ومكانة علماء وسلف الأمة. بل هي دعوى ودعوة مبنية على اعتراف واستئناف. اعتراف بكل الجهود السابقة وخاصة الكتب ذات الطابع المؤسس والمؤثر كالتي ذكرنا نماذج منها؛ إذ لولا هذه الجهود لما أمكن النظر إلى ما بعدها أو استشرافه فالفضل الأول إليها. وأما الاستئناف فلأنه الأصل، تجديدا واجتهادا وتفكرا وتدبرا بما يحقق تدين الإنسان في هذه الأمة واستخلافه وشهادته وخيريته وتحققه بالتكاليف المنوطة به فردا وجماعة.”
خاتمة
نعتقد أن هذه الأمة استنادا إلى وحي ربها المنـزل في كتابه العزيز ما تزال تملك من القدرة على التغيير والتأثير ما ملكته في السابق، وتملك من القدرة على الإصلاح ما به أصلحت الناس ابتداء. وإن كنّا ركّزنا في البحث على مشكلات الأمة في ذاتها وفي تواصلها، فللنهوض بها مجددا لتواصل أفضل وخصوصا في عالم لم يعد له قصد ولا معنى من الوجود بعد أن دالت كل فلسفاته الوجودية، فلم يبق منها إلا أثر، وتلاشت كينونة الإنسان تحت آلات الإنتاج والربح والاستهلاك الرهيبة. وهنا يمكن للأصل التوحيدي في كل أبعاده أن يعطي لحياة الإنسان معنى ولأفعاله قصدا وغاية. كما يمكن لأخلاق وقيم رسالة الختم أن تزود العلم والعقل بالرشد والصواب في علاقتهما بالكون والإنسان، فيعمرا ولا يدمرا ويحييا ولا يفنيا، وأن ترد للإنسان باعتباره ذاتا وكينونة، مركزه كمنتج للثقافة وصانع للحضارة وليس هامشا من هوامشها. بحيث تستثمر في ذلك نظريات الاستخلاف والتسخير.. وفلسفة العمران والتعمير.. انطلاقا من رؤية قرآنية كلية لفلسفة الوجود الإنساني وللعلوم والمعارف الميسرة وللكون المسخر.
نعتقد أخيرا أن انخراط الثقافة الإسلامية في القضايا الكونية والإنسانية المشتركة بإمكانه أن يلعب دورا مهما في تحريرها من التحيّزات المختلفة، خاصة إذا اصطحبت في هذا الانخراط نفسا إصلاحيا تجديديا ذاتيا وفق المنظور الذي ألمحنا إلى صور منه، انطلاقا من الأصول الكلية المستوعبة (التوحيد والعدل والحرية). واستشعارا بالقدرة على العطاء في الأفق العالمي لافتقاره إلى ما نملك ولا يملكه، كافتقارنا ونحن في حالة الضعف إلى ما يملك ولا نملكه.
هوامش
1. رواه البخاري: كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. حديث رقم 2361.
2. مسند أحمد، حديث رجل من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، رقم: 22978.
3. مسند أحمد، حديث رقم 8519.
4. زيجريد هونكه، الله ليس كذلك، مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام-ألماني الاتحادية، ترجمة غريب محمد غريب، ط2 /محرم 1419ﻫ – أبريل 1998م، ص33. وانظر كذلك كتابها القيم: “شمس الله تسطع على الغرب”. وفي السياق نفسه انظر مثلا: منتجمريوات: فضل الإسلام على الحضارة الغربية. وأندريه مايكل: الإسلام وحضارته… وغيرها من الدراسات المنصفة.
5. انظر: المواقف للإيجي بشرح الجرجاني (مقدمة الشارح)، تحقيق عبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الجيل، ط1، (1412ﻫ/1997م)، ج1، ص5-6.
6. الشهرستاني، الملل والنحل، بيروت: دار الفكر، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، ص12-13.
7. البغدادي، الفرق بين الفرق، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، (1405ﻫ/1985م)، ص19-20.
8. أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محي الدين بن عبد الحميد، ط2، (1389ﻫ/1969م)، مكتبة النهضة المصرية، ج1، ص26.
9. المرجع نفسه، ج 1، ص24.
10. المرجع نفسه.
11. الخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث، (انظر المقدمة).
12. السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، بهامشه إعجاز القرآن للباقلاني، عالم الكتب، ج1 ص2-3.
13. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، ط4، (1414ﻫ/1993م)، ص10-16.