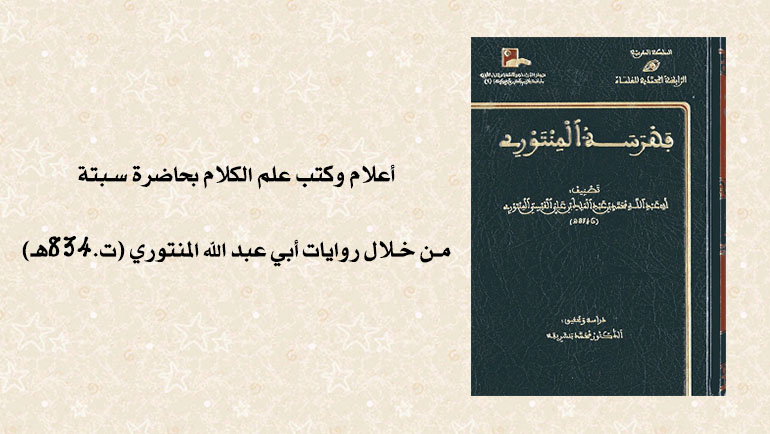مطالع السعد بحلول شهر رمضان وتزكية أنفاس العبد

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلوات ربنا وسلامه على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين.
وبعد؛
فقد كتب ربُّنا سبحانه على نفسه الرحمة واللطف واختص بالعظمة والكبرياء والملك، إذْ جعل بيننا أنبياء بشـرا مرسلين، قال الله جلَّ وعلا: لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلى المْومِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسولاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [آل عمران 164] ، فأجزل العطايا وأوفاها أن ابْتَعَثَ الله سبحانه رسلا وأنبياء سفراء السماء إلى الأرض تَقُومُ في الناس واعتباراً واستذكارا، كما أَلْقى سبحانه في الأرض عوالم معرّفة تنطق بربوبيَّته وإلهيته، وبَثَّ مشاهد دالّة تعرب عن آثار هدايته وتدعو إلى الرشد واقتفاء معالم شريعته وحجته، قال الحافظ أبو عمرو الداني (ت 444 ه): (إنَّ الله سبحانه قد احتجَّ على عباده برسله، كالسفراء بينه وبين خلقه، وقطع عذْر الدلالة على صدقهم بما آتاهم من الآيات وقاهر المعجزات … وأنزل عليهم الكتاب وشرع الشـرائع وفرض الفرائض وختم النبوة برسالة محمد أمينه وصفيّه خاتم النبيين كما قال عز وجلّ: (رُسُلاً مُّبَشِّـرينَ وَمُنذِرينَ لِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [ [النساء 165] [الرسالة الوافية ص 51].
وعليه؛ فاعتقادات أنبياء الله ورسله – فيما له تعلق بالأحوال الدينية التعبدية- وما تنطوي عليه قلوبهم وأفئدتهم مُتْرعة علماً ويقيناً منزَّهة عن شوائب الغفلة والريب والحيرة فيما أُمرت بتبليغه وتأديته …، بل هم من وراء الغاية في الاعتناء بأنباء الآخرة وقوانين الشـريعة ومعارف الدين والدنيا، إذ عمدة منصب النبوة والرسالة ناهض على البلاغ والإعلام والتبيين [الشِّفا للقاضي عياض ص 659] والقطع عن يقين وتسليم أنَّ العبودية جوهرة كنهها الربوبية، وأنَّ الله تعالى قد اتَّخذ رسله عباداً قبل أن يتخذهم أنبياء مصطفَين أخيار، فكم لله من لطْف سَرِيٍّ خَفيّ وكَمْ له من كَرم مَليٍّ حَفِيّ، ثم هذا أوان الشـروع في المقصود، فنقول وعلى الله الاعتماد:
قال الله تعالى: [شَهْرُ رَمضَانَ الَّذي أُنزِلَ فيه القُرآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مّنَ الْهُدى وَالْفُرْقَان] [البقرة 185].
فلفظ (شَهْر) في الآية الكريمة أصْلُهُ مِن شَهَرَ الشَّـيْءَ أظْهَرَهُ، وهو لِكَوْنِهِ مِيقاتًا لِلْعِباداتِ والمُعامَلاتِ وسائر القربات وألوان الطاعات، ثم صارَ مَشْهُورًا بَيْنَ النّاسِ معروفاً لديهم، وأما لفظ (رَمَضان)؛ فهو عَلَم لِلشَّهْرِ المَعْلُومِ أو المُدَّةُ المُعَيَّنَةُ الَّتِي ابْتِداؤُها رُؤْيَةُ الهِلالِ، والخَلِيلُ بن أحمد (ت 170ه) رحمه الله يَقُولُ: إنَّهُ مِنَ الرَّمْضِ – مُسَكَّنَ المِيمِ – وهو مَطَرٌ يَأْتِي قَبْلَ الخَرِيفِ يُطَهِّرُ وجْهُ الأرْضِ عَنِ الغُبارِ، ووجه التشريف والتكريم الذي استحقه شهر رمضان إنما لحقه وامتدّ إليه من تنزل القرآن من رب الملكوت والأكوان فالقرآن ورمضان قرينان حجيجان شفيعان للمؤمن عند ربه، وفي الحديث عن عبدِ الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (الصيامُ والقرآنُ يشفعان للعبدِ يومَ القيامةِ، يقول الصيامُ: أي ربِّ منعتُه الطعامَ والشهوةَ، فشفِّعني فيه، ويقول القرآن: منعتُه النومَ بالليل، فشفعني فيه، قال: فَيُشَفَّعان) [أخرجه الإمام أحمد 6626، والحاكم 2036 وغيرهما]، وعليه؛ فالصوم ولزوم جادته قائم على منابذة عوادي الأهواء ومنافرة نوازع الشهوات ومدافعة سلطان الشيطان وقهر نوازغه …، وذلك حتى تصفو نفس العبد وتزكو مشاعره وتتهذّب حواسه، ويصح لأجل ذلك بنيان الجسد وتخشع حبّة القلب …. فالشفاعة المرادة في هذا المقام تتمثل في جَيْئة الصيام والقرآن وهما يحاميان ويدافعان عن صاحبهما من العذاب والنكال والخسـران والبوار من شدة الصحبة والملازمة الفعلية في الدنيا المسلمة لنفحات الآخرة ونعيمها السرمدي … ومما يزيد مكانة الصيام علوّا وفضلا ورفعة قدر وسمو حال ونبل مكانة؛ نسبةُ الله عز وجل له إليه دون سائر الطاعات والقربات من الشعائر العلنية المكشوفة الظاهرة كما في الحديث القدسي الذي يحكيه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عن ربه عزوجل إذ قال: كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخُلفة أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك … الحديث [أرجه البخاري (1904)، مسلم (1151)]، والمعنى فيه؛ أن الصوم قد خرج واستثني عن جملة أعمال الخير والبر التي تتضاعف فيها الحسنات، لما كان الصوم من عمل السر بين العبد وربه هو وحده سبحانه الذي يقدره ويجزي عليه، إذ لم يكله إلى أحد من الملإ الأعلى أو ملائكة قدسه بل تولى الجزاء عليه بنفسه سبحانه، فلذك خصه به ونسبه لذاته العلية، وما نُسب إلى العظيم الكبير والتصق بذاته سبحانه فإنه لا يكون إلا جزيل الثواب عظيم الأجر …، فكل ذلك وغيره منة من الله على العبد الخاضع الذي ترك ما تشتهيه نفسه وتتوق إلى نيله ونواله احتسابا لله وابتغاء مثوبته وطمعا في رضاه والله لا يضيع أجر المحسنين …
ثم إن القرآن الكريم وهو كتاب الله عز وجل؛ معدن الهداية ومنبع الحكمة، وملجأ الخلق ونبراس الأمة وميزان تصـرفهم، وأَحْدث الكتب عهْداً بالرحمان، تفرّعت من أصله أسماء عَليَّة، وتشكلتْ بمعاني أنواره صفات جليَّة؛ فسماه الله سبحانه قرآنا وفرقانا وهدى ونورا، كما جعله عز وجل كتابا مبينا وصراطا مستقيما وذكرا حكيما، ثم أشاد بمنزلة حملته من حفظته، ونوَّه بمرتبة وُعاته وسَدَنته وعرف بهم وبأقدارهم ومنازلهم، فقال عز في عليائه : (كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) [آل عمران/ 79]، إذْ وصْف الربانية [1] أخص ما ينتسب به العبد إلى مولاه جل وعلا من بعد النبوة، فلأجل ذلك خُصَّ أصحابه ومُتعاطوه من بين الخلْق، فكانوا أهل الله وأشراف أمته، اجتباهم من بريّته وأكرمهم بمنقبة الانتماء إلى أفضل رسله، فقال سبحانه في محكم تنزيله: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله) [فاطر / 32]، والتوريث هنا بمعنى الإعطاء والتمليك، وذلك لأنَّ الأمة المحمدية لم ترث القرآن عن أمة تقدمتْها، وإنما خصها الله سبحانه به، فعبر هنا عن ذلك بصيغة الماضي لتحققه والإشارة به إلى حسن منقلب أهله، كما عبّر سبحانه في غير الأمة المحمدية بمثل (وَرِثُواْ الْكِتَابَ) [الأعراف / 169] وما إليه، ولحْظ الفرْق بين الإطلاقين دالٌّ على فَرْق ما بين المقاميْن وعُظْم ما بين المنزلتيْن، قال برهان الدين البقاعي (ت 885 ه): (وهذا الإيراث للمجموع؛ لا يقتضـي الاختصاص بمن يحفظ جميع القرآن، بل يشمل من يحفظ منه جزءا، ولو أنه الفاتحة فقط، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لم يكن كل واحد منهم يحفظ جميع القرآن، ونحن على القطع بأنهم مصطفون) [2]ولذلك فإنَّ من لطيف بلاغات القرآن الكريم في في التركيب والنظم؛ أن قدم (الظالم) على (السابق)، وإن كان أضعف في التقدمة والأحقِّية في ترتيب الذكر أو التنويه بالقدر، وذلك إظهارا للكرم مع (الظالم)، لأنه حال اقترافه وزلته يصير كسيف البال منكسـر القلب مشتّت الهم والعزم …، إذ النقص والتقصير غير مُنفكَّيْن عن جبلَّة الإنسان وخلْقه، لأنهما مُستولييْن على طبيعته – ابتداءً – مهْما علم أو فقه، وذلك سرّ تقديم الأدنى (الظالم لنفسه)؛ لأنه الأكثر الأغلب، كيلا يَحْصل اليأس ويَسْتطيل حبْل القنوط، وهذا النوع، أي المفرّط المتهاون في توفية ما لزمه من واجب الحق والتنزُّه عن سُبل الكبائر أو ماشابه، فهذه طائفة المرجَئون لأمر الله، ومنهم (المقتصد) أي الذي خلط صالح العمل بسيِّئه، أي استوى على المنزلة الوسطى، وذلك لأنه لم يبذل الجهد كله للبعد عن النوع الأول والتجافي عن ساحته، ولكنه اجتنب سبيل الكبائر ونَكَب عن صراطه، ومنهم (سابق بالخيرات)، فأولئك السابقون بالقربات والطاعات، الموفون المقام حقه العارفون لقدْره وغايته، إذ كلما ازدادوا قربا سَمَتْ بهم هممُهم في الازدياد من صالح العمل وخالصه، قال البرهان البقاعي (ت 885 ه): (وختم بالسابقين؛ لأنهم الخلاصة، وليكونوا أقرب إلى الجنات، كما قدم الصوامع في سورة الحج، لتكون أقرب إلى الهدم، وأخَّر المساجد لتقارب الذكر، وقدم في التوبة السابقين، عقيب أهل القربات من الأعراب، وأخر المرجئين، وعَقَّبهم بأهل مسجد الضِّـرار، وقدم في الأحزاب المسلمين، ورقَّى الخطاب درجة درجة إلى الذاكرين الله كثيرا، فهو سبحانه تارة يبدأ بالأدنى وتارة بالأعلى؛ بحسب ما يقتضيه الحال) [3]، ثم هؤلاء أهل الخلاصة السابقون؛ ليس في قوتهم – فيما جرت به العادة – أو في كسبهم واجتهادهم أن يَبْلغوا ما بلغوا أو يُدركوه، إلا بإذن الله سبحانه، فهو صاحب القدرة التامة والعظمة العامة، والفعل بالاختيار وجميع نعوت الكمال، ثم لأنَّ السابق كلَّما علا مقامه في السَّبْق؛ قَلَّ حظُّه من الدنيا والتعلُّق بحُطامها، حتى يرى الجاهلون أنه مضيِّع لنفسه قاهرٌ لها أو ما شابه.
وعليه؛ ففواضل كتاب الله تعالى وعوائده، أشهر من أن تستقصـى وتستوعَب، ثم منزلة أهل القرآن المُديمين النظر في ظاهره وباطنه، والمُمْعنين في إقامة حروفه ولزوم باب حدوده؛ أَعَزُّ من أن تُحْصر، ولأجل ذلك تكاثرت تآليف العلماء في لفِّها ونشـرها، وبسطها وتعريفها، منذ القرون الأولى، استقلالا وتضمينا، تلخيصا وتوسيطا وتطويلا، رعْياً لمقتضـى الحال، وجرْيا مع متقلِّب الشأن والبال، ك فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224ه)، وفضائل القرآن وتلاوته لأبي الفضل الرازي (ت 454 ه)، وغيرهما عَديدٌ مَديد، ليس غرضنا التقصِّـي لتفصيل جزئيات كل ذلك أو تحصيل صوره وتفريعاته، وإنما حظُّنا التنبيه بما تحصل معه الغُنية للمريد والكفاية للمستزيد، والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابع.