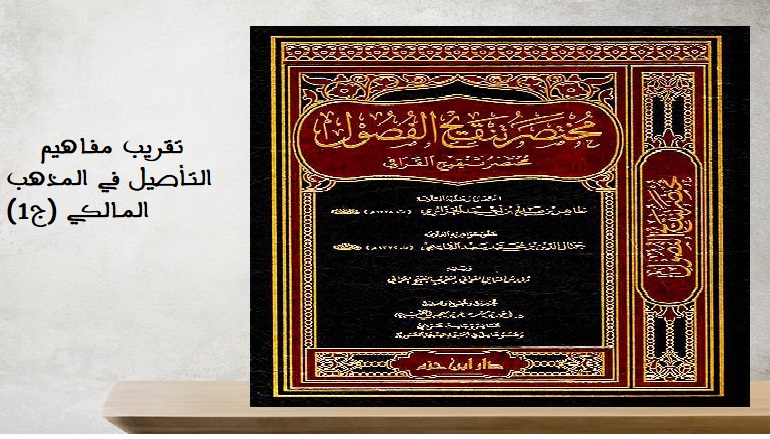لكل مقام مقال مثل عربي يدخل بنا مباشرة إلى "بنية السياق" من باب التراث الإسلامي، بعيدا عن استدعاء "قبعة أسلوبية" نسجتها أيد كثيرة، وبألوان متناقضة في أغلب الأحيان تبدأ من "سوسير" ولا تنتهي عند "تشو مسكي"، إن قراءة النص من "نافذة" خارجية لا يعني انفصالا عن عالم النص بقوانينه الخاصة، حيث يحلق المتلقي في لا نهائية مزعومة، فيتجـرد النص من عالمه "مؤلفا ولغة" ويستبدل المتغير بالثابت حيث يتم "تغييب" النصوص "وتذويب" الدلالات، وكأن "حداثة" "الفوضى" أو "فوضى الحداثة" هي جوهر البنيوية والتفكيكية أو هي جوهر القراءات المعاصرة.
إن مدخلا عربيا إسلاميا إلى "بنية السياق" يعني أننا منذ البداية ننبه إلى أمرين:
الأول: "أننا حينما نستخدم مفردات الحداثة الغربية ذات الدلالات التي ترتبط بها داخل الواقع الثقافي والحضاري تحدث فوضى دلالية داخل واقعنا الثقافي والحضاري، وإذا كنا ننشد الأصالة فقد كان من الأحرى بنا أن ننحت مصطلحنا الخاص بنا، النابع من واقعنا بكل مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية[1]، بل والنابع أيضا من قوانيننا اللغوية وخصائصنا الحضارية حتى لا ينطق النص بما يتجاوز المراد.
الثاني: حينما يتعلق الأمر بالنص القرآني تصبح الحداثة ليست مجرد لعب حر باللغة، بل إنها بالمفهوم الغربي إسقاط "للمقدس المعرفي"، حتى يمكن "تسييله" في نهر التجربة الإنسانية باعتبارها فردا له عالمه المتميز وليس "كلا إنسانيا" له قواسم مشتركة، وكان نصر أبو زيد واضحاً وصريحا في الوصول بهذه الحداثة إلى غايتها متكئا على أبحاث أستاذه "حسن حنفي" بحيث تصبح المعادلة عنده من الواقع إلى النص لأن الواقع هو الأصل ولا سبيل لإهداره، من الواقع تكون النص ولغته وثقافته وصيغت مفاهيمه، فالواقع أولا والواقع ثانيا والواقع أخيرا، وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول كليهما إلى أسطورة[2].
ولأن "منهج القراءة السياقية" عند "نصر أبو زيد" يقفز على علم الأصول عند المسلمين بدعوى تجديده، كان طبيعيا أن يصب جام غضبه على الإمام الشافعي، حتى يروج لقراءات متغيرة ونسبية تقوم على ما أسماه السياق التاريخي الاجتماعي الخارجي للنصوص، والسياق الدلالي الداخلي للنصوص، ولن أدخل في جدل حول منهج أراد له صاحبه أن يكون قراءة علمية للنصوص، واكتشف أغلب ناقديه أنه موقف أيديولوجي في الأساس يعمد إلى تجريد النص من مصدره المتعالي ليصبح مجرد خطاب لغوي تحكمه قوانين ثقافية خاصة في منجزاتها اللسانية المعاصرة.
وهذه الورقة الموجزة تأتي في مطلبين:
المطلب الأول: منهج السياق عند الشافعي وصلته بالمقاصد
دراسة السياق تعتبر جزءا من البناء الأصولي العام، وهذا مكانها الطبيعي في خارطة العقل التشريعي الإسلامي، لها إرهاصاتها منذ العصر الإسلامي الأول في مرحلتي الوحي والصحابة، واستمر الاهتمام بها حتى يوم الناس هذا[3]، ومنهج السياق عند الشافعي مرتبط بجهده التأسيسي لعلم الأصول، ومباحثه التأصيلية لبيان القرآن والسنة، ومنهج السياق ليس عارضا في كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي بل إنه من المفاهيم الحاكمة لضبط عملية الاستنباط، ولم يعد خطاب النهي يتحدد في ألفاظه بل وأيضا يتمدد في معانيه، وإذا النص المجرد هو خطاب الله فإن تعلقه بأفعال المكلفين يجعل تنزيله من فضاء التجريد إلى امتثال التكليف، يعني تحوله من "نظام" يتجاوز حدود الزمان والمكان، إلى "أحكام" لها جغرافيا وتاريخ، وحتى يتحول "النظام" إلى "أحكام"، لابد أن يكون توصيف الواقع متطابقا تماما مع ما أوجبه النظام، وفي دائرة "النظام" يتم البحث عن مقاصد الشارع وفي دائرة "الأحكام" يتم النظر إلى مآلات الأفعال فالحل والحرمة يتعلقان "بالنظام"، و"الأمر" و"النهي" يتعلقان بالأحكام، وعندما تتحرك أفعال المكلف طاعة أو معصية، تعلو "سلطة النظام" لحماية "متعلق الأحكام".
ولقد كان الإمام الشافعي في الرسالة حريصا على انفتاح الخطاب على ما هو أوسع من دائرته اللغوية لأن سياق الكلام بتعبير "الشافعي" لا تتحقق شروطه[4] بعيدا عن حال المخاطب بماله من تأثير على دلالات النص الظاهرة والباطنة، من هنا جاء مفهوم البيان عند "الشافعي" يستوجب السياق لفظا ومعنى ويستوجب أيضا العلاقة بين "النظام" و"الأحكام"، بما يفرض ترتيبا للأدلة لا ينفصل فيه العقل عن النقل، ومعجما للدلالات ومفاهيمها لا يبتعد فيه النص عن الاجتهاد، وظلت المسافة واحدة بين الثابت "في النظام" والمتغير من "الأحكام". من هنا يصح القول إن فكرة "البيان" تعد ركنا أساسيا في النظرية الأصولية عند الشافعي وكما قيل بحق أصبحت فكرة البيان التي كانت، قبل الشافعي، عفوية لا تخرج عن الفهم المباشر للمعنى، مفهوما نظريا موصولا بوضعية تأويلية جديدة وقد تجلى ذلك المفهوم في رسالة "الشافعي" من جهات ثلاث: حد البيان والمخاطب به وصولا إلى كيفيته.
أ. حد البيان: يقول "الشافعي" والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، وفي ذلك إحالة على جانبين:
أصل ثابت يتعلق بجوهر الدين وحدوده من مباح أو متعذر، وحلال أو حرام.
وفرع متحول يتصل بمسايرة الأحكام لتغير أحوال الناس وتجدد أوضاعهم مع ضرورة معرفة حكم الفرع الطارئ من خلال الأصل الثابت.
ب. المخاطب بالبيان: يقول "الشافعي" فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. إن تلك المعاني على اختلافها أصولا وفروعا جامعها هو واحد هو اللسان العربي، وبحكم تمكن المخاطب من أسرار لسانه ولطائفه فإنه لا يضل سبيله في تلك الفروع المتشعبة التي قد تحجب عنه الأصول، بل إن اللغة التي نزلت بها تلك المعاني لهي خير سند له على الاهتداء إليها على اختلاف درجاتها في الوضوح، بإخراجها من حيز القوة والكتمان إلى حيز الإنجاز والبيان، فلئن اتخذ "الشافعي" فكرة البيان أرضية لمنظومته الأصولية فإنه توسل، كما هو ملاحظ من كلامه، بالمعرفة باللسان أي بما قرره علماء اللغة أمثال "سيبويه" وشيوخه بشأن الزوج لفظ/معنى، في تركيز منهجه في استنباط المعاني والأحكام من النص.
ج. كيفية البيان: لقد طرح الشافعي قضية "الكيفية" من خلال تعديده لوجوه البيان التي يمكن إجمالها في ثلاث: بيان القرآن، وبيان السنة، والبيان بالاجتهاد تأويلا وقياسا وبيان السنة يظهر تقسيم يعتمد المعنى، ويفصل بين السنة التشريعية والسنة غير التشريعية.
والرأي عندي أن فكرة "عقل المعاني" بأبعادها المقاصدية، هي التي وسعت دائرة اللفظ المعجمي في الخطاب الأصولي، ليكون مكتنز الدلالات، ومتعدد المستويات، وبهذا قد يكون اللفظ أحادي المعنى، وقد يكون متعدد المعنى[6]، وقد يكون مقاصدي المعنى، بل إن ظاهرة التعدد في المعنى من خلال تجاوز المعنى اللغوي جعل البحث عن المقاصد وتوظيفها جزءا من منهج السياق عند "الشافعي"، من هنا يصح ما قاله البعض من أن الشاغل الرئيسي "للشافعي" هو بيان المعنى من خلال قراءة الأمثلة في ضوء الأصول، إن منهج ذلك البيان هو الاستنباط، وموضوع ذلك الاستنباط هو المعنى وتحديدا "القصد"، في سير تدريجي نحو فك معضلة الفهم ضمن خطة تأويلية تستمد تماسكها من تماسك المنظومة الأصولية بذلك يتحقق فهم مسائل الشرع في ظل تحولات يعيشها الناس في دينهم ودنياهم، ويتضح في إطار الاستنباط الذي سار "الشافعي" على دربه أن اللفظ والمعنى قضية يتجاذبها اتجاهان في صلب المنهج نفسه، اتجاه لغوي معياري موصول بتعامل عالم الأصول مع قضايا اللسان استعانة بها على بلورة الأحكام، لذلك اعتبر التمكن من اللسان شرطا لتوفر آلة التحقيق في المعارف.
واتجاه عقلي قائم على البحث عن البرهان الموصول بمباشرة المسائل الشرعية، ما تشابه منها وما اختلف، وفق منطق الفكر ومنهج الاستدلال، وبذلك يحيل عالم الأصول تلك المسائل ذات الطابع العملي إلى مسائل معرفية على صلة وثقى بقضايا تقبل النص وتأويله وفق هذا المدخل أو ذاك من أجل محاصرة المقصد، وبذلك يتوجه الاستنباط من قضايا اللفظ والمعنى في ذاتها إلى منشئ النص وما يريده من اللغة فيحضر معنيان: معنى اللغة في ذاتها أي ضمن دلالتها الحرفية، والمعنى الذي يريده منشئ النص أن يحمله اللغة بأسلوب معين وفق قرائن لفظية كانت أو سياقية، فيكون جهد المتأول التردد بين المعنيين لاستشراف القصد ومن ثم لمعرفة الحكم استنباطا[7].
وهذا التحليل مقبول في مجمله لكنه ينبغي أن يفهم في حدود "عقل المعاني" عند "الشافعي" وهي في إيجاز ما يلي:
- أن المعنى مهما اتسعت دوائره لا ينبغي أن يتجاوز قوانين اللغة ذاتها وإلا كان معنى نافرا يرغم النص على منطوق لم يتناوله من قريب أو بعيد، ولا يكتفي "الشافعي" بإعلاء قوانين العربية وقواعدها بل يرفعها لتتسنم الذروة بين اللغات بحيث لا يباح للمسلم أن يتعامل بغيرها، وهذا حكم قيمي يندمج في صلب نظرية المعرفة الشرعية عند "الشافعي"، وقد يبدو ذلك غريبا عند المعاصرين الذين يفصلون مجال المعرفة عن مجال القيم.
- إن فهم المعنى عند "الشافعي" لا يقوم فقط على قاعدة "المعقول"، إنما على ما تقتضيه اللغة من فهم "لكتاب الله"، فالقرآن، كما يقول الشافعي، على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر، وأي لبس يظنه البعض في هذا السياق يجد مفاتيح فهمه ورصده في إعلاء "القطعي" على "الظني" في منهجية "الشافعي" الأصولية وأهم ما في تراث الشافعي الأصولي هذا الجمع المحكم بين السياق في ميادينه اللغوية، والسياق في مجالاته الزمانية والمكانية، وفي فضاء غاياته ومقاصده، ولا شك كما قيل: "أن المنهج السياقي ببعديه: البعد اللغوي الداخلي والبعد الخارجي المُقامي، يقدم بين يدي فهم النص الشرعي نسقا من العناصر التي تقوي طريق منهجه وتفسيره والاستنباط منه، لأن العلم بخلفيات النصوص وبالأسباب التي تكمن وراء نزولها أو ورودها يورث العلم بالمسببات، وينفي الاحتمالات والظنون غير المراده، ويقطع الطريق على المقاصد المغرضة التي لم يردها الشارع الحكيم ولم يرُمها، ويصحح ما اعوج من أساليب التطبيق كاقتطاع النص من سياقه. والاستدلال به معزولا عن محيطه الذي نزل فيه[8]. وقد أشرنا في مطلع البحث إلى فكرتي "النظام" و"الأحكام" والنظام لا نعنى به أكثر من الحكم بالمعنى الأصولي، والأحكام لا نعني بها أكثر من الحكم عند الفقهاء، ولكن غايتنا من وراء فكرتي "النظام" و"الأحكام" القول بأن "النظام" مطلق كغيره من سنن الله في الكون، وهو مغلق على ذاته يفهم ويكتشف ولكنه لا يتعدد ولا يتغير، أما "الأحكام" فهي وصف لفعل، وبعيدا عن الثابت والمتغير في الأحكام الشرعية، فإنها عند التنزيل ترتبط بفعل مفرز محدد له عناصره وأركانه، فالواقع في صيرورته الزمانية والمكانية لابد من أن يتطابق مع عناصر الأمر والنهي في الحكم، وعند الاختلاف يتراجع "الحكم" ليمارس النظام "سلطته" في إدخال الواقع تحت "كونية النظام" حيث لا أفعال بلا أحكام في دنيا الناس وهذا ما أكده "الشافعي" أكثر من مرة في "رسالته" الأصولية.
المطلب الثاني: منهج السياق عند الشاطبي وصلته بالمقاصد
ينتمي الإمام "الشاطبي" الفقيه المالكي إلى مدرسه المتكلمين الأصولية، وهي مدرسة أسس لها وأقام بنيانها الإمام "الشافعي" في العقد الأخير من القرن الثاني الهجري، وعلى الرغم من طول المساحة الزمنية التي يقطعها مؤرخ الفكر بين القرن الثاني حيث عاش "الشافعي" المتوفى عام 204 هـ، وبين القرن الثامن حيث عاش ورحل الشاطبي المتوفى عام 790ﻫ، فالقرون الستة ليست بالأمر الهين، فمنذ رسم الإمام "الشافعي" الملامح الأساسية لعلم أصول مكتمل المباحث، لم تبدأ دورة جديدة لهذا العلم إلا على يد "الشاطبي"، ليس بإضافاته الرائعة في الجانب المقاصدي وإنما من خلال دعوة متكاملة إلى تجديد علم الأصول قائمة على نظرية معرفية يمكن القول أن "الشاطبي" انفرد بها، وعليها ارتفع إنتاجه العلمي حتى في مجالات اللغة والنحو. "لقد قدم للناس، كمل يقول الجيلاني المريني[9] ، أصول الفقه على أنه مادة علمية يستوعب جملة من الكليات والقواعد الشرعية واللغوية التي بواسطتها يفهم الفقيه معنى النص الشرعي ومقاصده وعلله... وهذا يعني أن الرجل قد استفاد جيدا مما وصله من عطاء فقهي وأصولي خلفه من سبقوه، من لدن الصحابة، رضوان الله عليهم، إلى شيوخه الذين أخذ عنهم علم الشريعة، حتى نضج في فكره هذا العلم الجليل "أصول الفقه" واكتملت معالمه وآفاقه، وتبلورت قواعده وأسسه، فراح يكتب بمنهاج يقوم على أساس إبراز هذه القواعد والأسس إبرازا علميا تنظيريا مؤطرا قاصداً".
لقد انطلق البحث اللغوي عند الشاطبي لتحقيق أمرين:
الأمر الأول؛ عملي وهو إبراز عناصر الثبات في البنية الأصولية مستهدفا بذلك، كما يقول بحق عبد المجيد الصغير، "تفويت الفرصة على كل من يريد تأويل النص "إيديولوجيا" ليشهد لصالح اختياراته"[10].
الأمر الثاني؛ علمي أساسه البحث في الدلالات وضبطها من أجل الوصول إلى مقاصد الشريعة، فالفهم لا يتوقف عند اللفظ المجرد بل هو دعوة إلى الانفتاح على المراد الذي يلزم به مقتضى الحال.
والرأي عندي أن الإمام "الشاطبي" في معالجته لمفهوم السياق بدأ بالسياق اللغوي باعتباره مدخلا عضويا للسياق المقاصدي، وكما قيل "فقد انطلق الإمام الشاطبي من أن عناية العرب إنما كانت بالمعاني المبثوثة في الخطاب، وأن المعاني نوعان: إفرادية تقوم على اللفظة مجردة عن سياقها وتركيبها، وتركيبية تقوم على ضم المعاني الإفرادية والعبارات إلى بعضها تأدية للمعاني والمقاصد، وأن ما يُعبء به هو المعنى التركيبي دون الإفرادي، ولا يؤبه بالافرادي إلا في حدود المعنى التركيبي، فكان هذا تأكيدا منه لكون الدلالة القصد متحكمة في الصيغ والأساليب اللغوية، وكون الألفاظ والصيغ خادمة للمعاني، وهي مقصود العرب في لغتها[11].
وقد أحسن "فريد الأنصاري" صنعا عندما انطلق من هذه المسلمة في ضبط خصائص وضع التعريف الأصولي عند الشاطبي حيث يمكن إجمالها فيما يلى:
- إجراء الصيغة على عادة العرب في التعبير فلابد كما يقول الشاطبي "في فهم الشريعة من إتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة.
- التعريف بالأمر المحسوس أو الظاهر" وعلى هذا وقع البيان في الشريعة، كما قال عليه السلام "الكبر بطر الحق وغمط الناس" ففسره بلازمة الظاهر لكل أحد.
- ضبط المعنى قبل المبنى "فالاعتناء بالمعاني، كما يقول الشاطبي، المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود".
- ضبط المعنى التركيبي قبل المعنى الإفرادي "وذلك بتوجيه التعبير نحو كلي المعنى ابتداء، دون السقوط في بيان الجزئي الذي ربما شذٌ عن كليه فيضيع المقصود[12] والرأي عندي أن نظرية السياق في بنية الشاطبي الأصولية تتحدد ملامحها بهذه الخصائص، بل إن هذه الخصائص ينبغي أن تتحكم في أي منهج للسياق يدرس به النص الإسلامي، لأن عالم الحداثة الغربية أنتج "منهجا سياقيا" مغلقا على النص وعلاماته وعلاقاته، منفصلا عن مصدره وزمانه ومكانه، وكأن اللغة مجرد حروف.
"والشاطبي" بهذه الخصائص هو امتداد طبيعي لنظرية "الشافعي" الأصولية، وكلاهما يؤسس لمنهج في السياق تدور في أفقه مجموعة علوم منها علم أسباب النزول، وعلم المناسبات، وعلم المناسبة الشرعية، وعلم الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من علوم لها مكانتها في تراثنا العربي الإسلامي، وسوف تثري المنهج السياقي الإطلالة العميقة، على علم اجتماع المعرفة، وعلم اجتماع الفقه، وعلم اجتماع اللغة، وعلم اللغة التاريخي، وبعض نتائج اللسانيات الحديثة، دون أدلجة للمناهج خاصة في ظل أزمات تعيشها "اللسانيات المعاصرة"، فما كتبه "ليونارد جاكسون[13] "عن "بؤس البنيوية"، هو بؤس يمكن تعميمه على اللسانيات المعاصرة من حيث فشلها في تفسير وقائع اللغة ذاتها، إن أية محاولة لفهم النص الإسلامي بعيدا عن نسق معرفي يمتد بجذوره إلى النص الإسلامي ذاته، هي محاولة محكوم عليها بالعقم، ولا ضير من الحديث عن موتها حتى قبل أن تولد.
الهوامش
1.عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، الكويت 1998، ص34.
2. نصر أبو زيد، نقد الخطاب الديني، القاهرة 1992. ص99 ويراجع لتأصيل أفكار أبو زيد، حسن حنفى: من النص إلى الواقع مركز الكتاب للنشر، القاهرة 2005 وخاصة جزء 2 ص517، وقد سبق لنا مناقشة هذا الكتاب في لقاء أعده المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية وراجع أيضا رؤية حسن حنفى لانجاز نصر أبو زيد في كتاب حوار الأجيال دار قباء مصر 1998 خاصة ص409-513 وفي القراءة الخاطئة لانجاز الشافعي راجع لنصر أبو زيد: الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، القاهرة: دار سينا للنشر،1992.
3. وهي محل دراسات وأطروحات انظر على سبيل المثال نجم الدين الزنكي، نظريه السياق: دراسة أصولية، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية معارف الوحي بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا سنة 2003م.
4. الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، مصر، ص580.
5. أحمد الوردنى، قضية اللفظ والمعنى، دار الغرب الإسلامي، 2004، ج 1، ص217-218 والإحالات التي أشار إليها في كتاب الرسالة للشافعي.
6. المرجع السابق، ص290.
7. المرجع السابق، ص293-294.
8.عبد الرحمن بو درع، منهج السياق في فهم النص، الدوحة، كتاب الأمة عدد: 111 لسنة 1427ﻫ، ص26.
9. الموافقات، مجلة المعهد الوطني العالي لأصول الدين، العدد: 1 لسنة 1992، ص200.
10. الفكر الأصولي وإشكالية السلطة في الإسلام، بيروت: دار المنتخب العربى، ط1، 1994.
11. صالح سبوعى، النص الشرعي وتأويله، كتاب الأمة، الدوحة، عدد:117 سنة 1428ﻫ، ص52.
12. فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ط1، المغرب 2004، ص185-189 باختصار.
13. ليونارد جاكسون، بؤس البنيوية، ترجمة: ثائر ويب، دمشق 2001، ص23