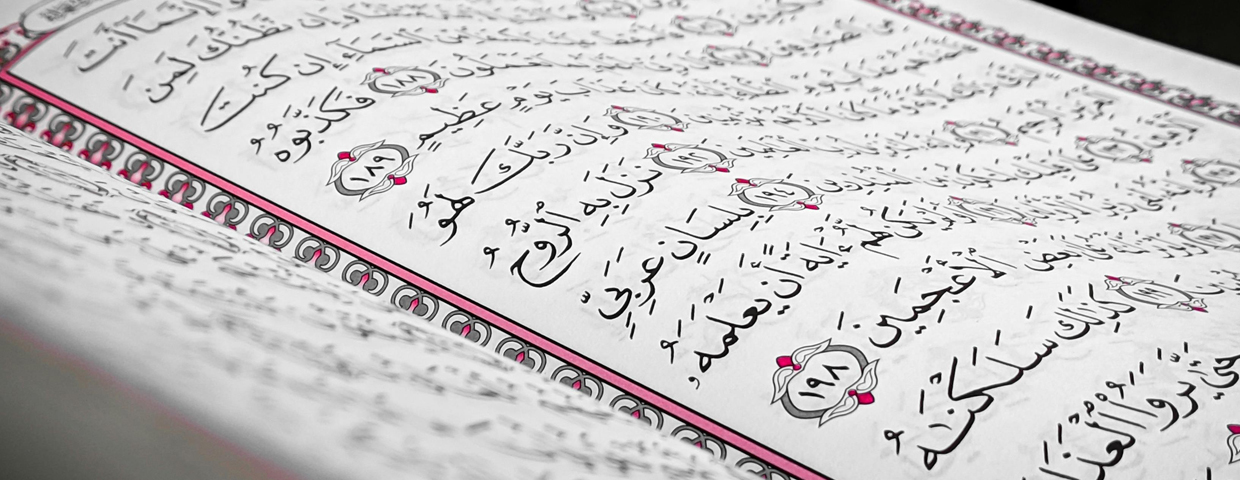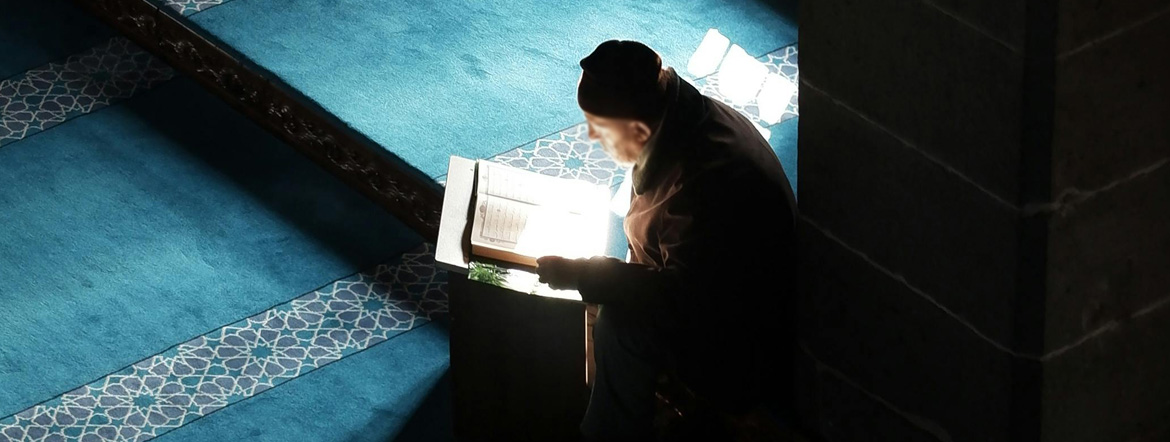لغة القرآن وبلاغته من خلال كتاب: «معارج التفكر ودقائق التدبر» تأملات في الآيات الكونية من سورة التكوير «الحلقة السابعة والعشرون»
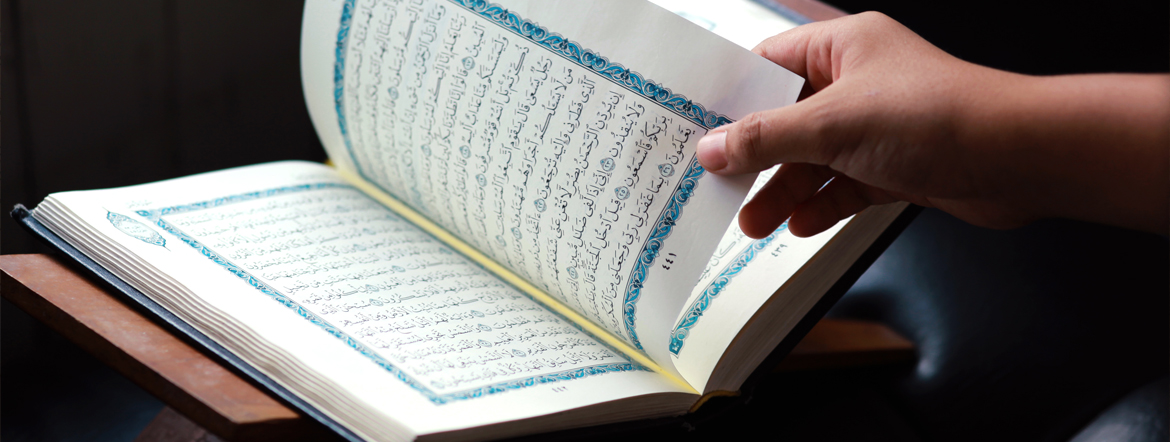
هذا هو الدرس الثاني من دروس سورة التكوير يؤكد أن القرآن كلام الله المنزل حقا وصدقا، وأن محمد بن عبد الله الذي يبلغه عن ربه هو رسول الله حقا وصدقا، وبهذا يتم الترابط بين درسي السورة.
الدرس الثاني:
يشتمل على تأكيد صدق الرسول فيما يبلغ عن ربه، وتأكيد كون القرآن كتابا ربانيا يتنزل من لدن رب العالمين، ويبلغه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمين الوحي جبريل عليه السلام، في حالة كون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كامل الوعي، في حواسه الظاهرة والباطنة، ويشتمل على بيان أن القرآن أنزله الله ليكون هداية وذكرا لجميع العالمين حتى تقوم الساعة. [1]
ولما كان السياق للترهيب، وكان الأليق بآخر عبس أن يكون للكفرة، وكان أعظم ما يحضره الكفرة من أعمالهم بعد الشرك التكذيب بالحق، وأعظمه التكذيب بالقرآن، وذلك التكذيب هو الذي جمع الخزي كله للمكذب به في قوله: «قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَه»[عبس: 17] الذي السياق كله له، وإنما استحق المكذب به ذلك؛ لأن التكذيب به يوقع في كل حرج، مع أنه لا شيء أظهر منه في أنه كلام الله لما له من الرونق والجمع للحكم والأحكام والمعارف التي لا يقدر على جمعها على ذلك الوجه وترتيبها ذلك الترتيب إلا الله، ثم وراء ذلك كله أنه معجز، سبب عن هذا التهديد قوله مقسماً بما دل على عظيم قدر المقسم عليه بترك الإقسام بأشياء هي من الإجلال والإعظام في أسنى مقام، فقال تعالى: «فَلَا أُقْسِمُ» [2] فيقسم الله عز وجل بعدد من آياته في كونه، على أن القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم على قومه مبينا لهم أنه يتنزل عليه من عند الله، ويمليه عليه أمين الوحي جبريل عليه السلام، هو في الحقيقة والواقع كتاب منزل من عند الله، يحمله رسول كريم من الملائكة، ويبلغه قولا ملفوظا مسموعا بالأذن لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات التي أقسم بها الله عز وجل في السورة هي ثلاثة:
- آية النجوم الخُنَّسِ الجواري الكُنَّس.
- وآية الليل إذا عسعس.
- وآية الصبح إذا تنفس.[3]
الآيات الكونية الثلاثة:
أولا: آية النجوم الخنس الجواري الكنس.
دل عليها قول الله عز وجل: « فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّس الْجَوَارِ الْكُنَّس »[التكوير: 15-16]فــ«الفاء» استئنافية، و«أقسم» فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر، تقديره: أنا، و«بالخنس» متعلق بــ«أقسم»، و«الجواري» نعت أو بدل، و«الكنس» نعت للجواري[4] والخنس وصف لموصوف محذوف هي النجوم[5]، والخُنَّس جمع خَانِسٍ وخَانِسَةٍ، وكذلك الكُنَّس: جمع كَانِسٍ وكَانِسَةٍ، والمعنى فأقسم، و«لا» مؤكدة. والخُنَّس ههنا أكثر التفسير يعني بها النجوم، لأنها تَخْنِسُ أي: تغيب لأن مَعَنا «واللَّيْلِ إِذَ اعَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ»[التكوير: 17-18]، ومعنا «بالخُنَّس» و«الكُنَّس» في النجوم أنها تطلع جارية، وكذلك تَخْنُسُ، أي: تغيب، وكذلك تكنس تدخل في كناسها، أي: تغيب في المواضع التي تغيب فيها، وقيل: الخُنّس ههنا يعني: بَقَر الوحش وظباء الوحش، ومعنى خُنَّس: جمع خَانِس، والظِّباء خُنَّسٌ والبَقر خُنَّسٌ، والخَنَسُ: قِصَر الأنف وتأخره عن الفم، وإذا كان للبقر أو كان للظباء فمعنى الكنس أي: التي تكنس، أي تدخل الكِنَاس وهو الغُصنُ من أغصان الشجر.[6]
والاستهلال بالقسم في هذا المقطع من السورة تمهيد للنفوس البشرية للحديث عن حقيقة إيمانية كبرى تتعلق بالقرآن الكريم لكونه وحيا من عند الله تعالى نزل به أكرم ملك على أعظم رسول، ولأن فاء التفريع بمثابة وصلة وأداة انتقال بين أمرين بينهما ارتباط ما فقد اقترن القسم هنا بها؛ لتفريع القسم وجوابه على الكلام السابق للإشارة إلى ما تقدم من الكلام هو بمنزلة التمهيد لما بعد الفاء فإن الكلام السابق أفاد تحقيق وقوع البعث والجزاء وهو قد أنكروه وكذبوا القرآن الذي أنذرهم به، فلما قضي حق الإنذار به وذكر أشراطه فرع عنه تصديق القرآن الذي أنذرهم به وإنه موحى به من عند الله، فالتفريع هنا تفريع معنى وتفريع ذكر معا، وقد جاء تفريع القسم لمجرد تفريع ذكر كلام على كلام آخر[7]، كقول زهير: [8]
فَأَقْسَمْتُ بالبَيْتِ، الذي طافَ حوْلَهُ //// رِجالٌ بَنَوْهُ، من قُرَيشٍ، وَجُرْهُمِ
يقول: حلفت بالكعبة التي طاف حولها من بناها من القبيلتين، وجُرْهم: قبيلة قديمة تزوج فيهم إسماعيل، عليه السلام، فغلبوا على الكعبة والحرم بعد وفاته عليه السلام، وضعف أمر أولاده، ثم استولى عليها بعد جرهم خزاعة إلى أن عادت إلى قريش، وقريش اسم لولد النضر بن كنانة[9]. وعقب نسيب معلقته الذي لا يتفرع عن معانيه ما بعد القسم وإنما قصد به إن ما تقدم من الكلام إنما هو للإقبال على ما بعد الفاء، وبذلك يظهر تفوق التفريع الذي في هذه الآية على تفريع بيت زهير: ومعنى «لا أقسم» إيقاع القسم، وقد عدت «لا» زائدة، والقسم مراد به تأكيد الخبر وتحقيقه، وأدمج فيه أوصاف الأشياء المقسم بها للدلالة على تمام قدرة الله تعالى.[10]
ويهدف القسم في القرآن الكريم إلى تحقيق أغراض منها:
1- تحقيق الخبر وتوكيده، ليكون أوقع في التَّلقي وأرجى للقبول، كقوله تعالى: «وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» [يونس: 53]. وقوله تعالى: «فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» [الحجر: 92].
2 - بيان شرف المقسم به، وعلو قدره، حتى يعرف الناس مكانته عند الله ورفعة منزلته لديه، كالقسم بحياة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في قوله تعالى: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ» [الحجر: 72]، وكقوله تعالى مبينا شرف القرآن وقدره: «وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ» [ص: 1].
3 - توجيه النظر إلى الآيات الكونية، والمشاهد الطبيعية، للتوصل منها إلى خالقها، والتأمل فيها تأملا يبين مبلغ نعمتها، وأنها غير جديرة بالعبادة، وإنما الجدير بالعبادة هو خالقها، وذلك كالقسم بالسماء وبنائها، وبالنفس وخلقها، في قوله تعالى: «وَالسَّماءِ وَما بَناها» [الشمس: 5] «وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها» [الشمس: 7] وقال تعالى: «وَالنَّجْمِ إِذا هَوى» [النجم: 1] منبها بقوله: هوى- أي غاب وسقط- إلى أنه لا يجوز أن يعبد، لأنه مخلوق وعرضة للغيبة والزوال[11]، ونقل السيوطي في كتابه «الإتقان» عن أبي القاسم القشيري أنه قال: القَسَم بالشّيء لا يخرج عن وجهين: إما لفضيلة، أو لمنفعة؛ فالفضيلة، كقوله تعالى:« وَطُورِ سِينِينَ وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ» [التين: 2 - 3] والمنفعة كقوله تعالى: «وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ» [التين: 1][12]، وقد جاءت صيغة القسم في الآية بقوله «لا أُقْسِمُ» وهي من التراكيب المشهورة عند العرب في القسم يراد بها تأكيد الخبر والدلالة على تحقق مضمونه، ثم نتدبر آيات القسم في الكتاب المحكم، فيهدينا إلى اطراد مجئ آيات «لا أقسم» وضمير المتكلم فيها لله تعالى: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ»[الواقعة: الآيات: 75 -76-77 ]، وقوله تعالى: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ»[الحاقة: الآيات: 38-39-40]، وقوله عز وجل: «فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ» [المعارج: 40]، وقوله تعالى:«لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ» [ القيامة:الآيات: 1-2-3-4]، وقوله تعالى: «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» [التكوير: الآيات: 15-16-17-18-19]، وقوله في سورة الانشقاق: «فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» [الانشقاق: الآيات: 16-17-18-19]، وقوله تعالى: «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ» . [البلد: 1-2] ولو يأت فعل القسم، في القرآن كله، مسنداً إلى الله تعالى بغير «لا» هذه، كما لم تأت «لا» النافية مع فعل القسم مسنداً إلى غيره تعالى؛ وإنما جاءت «لا» الناهية في آية النور «لَا تُقْسِمُوا»[النور: 53].[13]
وجاء فعل: « أقسم» منفيا بحرف النفي «لا» مراعاة لاقتضاءين، أحدهما يقتضي القسم بهذه الآيات الكونية، والآخر لا يقتضي القسم بها، لأن المخاطبين إبّان التّنزيل في معظمهم لا يدركون عظمتها، فلا فائدة ترجى لديهم من القسم بها، فاستدعت مراعاة ما يقتضي القسم بها ذكر فعل القسم، وذكر الآيات الكونية التي اختار الله أن يقسم بها في هذه السورة. واستدعت مراعاة ما يقتضي أنه لا فائدة ترجى من القسم بها، نفي فعل القسم بحرف النفي «لا» فكان هذا الإجراء من المبتكرات البيانية القرآنية البديعة[14]. ولما اجتمع الاقتضاءان: اقتضاء القسم، واقتضاء عدم القسم، كان الحل البديع أن يأتي النص بعبارة «لا أقسم»، فمن صفات النجوم التي أقسم الله بها أنها خُنّس، وأنها جَواري، وأنها كُنّس، وجاء استعمال الوصف التشبيهي كناية عن النجوم دون ذكر اسمها إيثارا للإبداع البياني المركب من استعارة وكناية، أما الخنوس فهو اختفاؤها في النهار، مع وجودها في منازلها ومجاريها، كما تختفي الظِّباء بين الأشجار في أكنستها عن أعين طلاب صيدها أو افتراسها، ووصفها بأنها خُنّس، وبأنها كُنّس، استعارة قائمة على تشبيه اختفائها في النهار باختفاء الظباء في أَكْنِسَتِها، وتشبيه مواقع النجوم بأكنسة الظباء، وهي استعارة بديعة قائمة على تشبيه دقيق، ثم اسْتُخْدِمَت هذه الاستعارة كناية عن النجوم.[15]
وجاء الجمع «الخُنَّس، الكُنَّس» على وزن فُعَّل بضمّ الفاء وتشديد العين؛ دلالة على تكثير القيام بالفعل، فهي تختفي وتظهر كثيرا لا مرة واحدة، وأقسم سبحانه بها؛ لبيان عظمتها وارتفاع رتبتها، ولما في حركاتها من إحكام صنع الله وبديع نظامه في هذا الكون الفسيح، فهي تختفي طورا وتظهر طورا منذ آلاف السنين، وذلك من الدلائل العظيمة على قدرة مُصَرِّفِها ومُجْريها، وقد أدى الجناس دوره في إبراز جوانب هذا المشهد، فنسمعه وهو يقرع الآذان بصوته الهامس بين «بالخنس، الكنس» وهو جناس لاحق؛ والجناس اللاحق هُوَ مَا أبدل من أحد ركنيه حرف من غير مخرجه وَلَا قريب مِنْهُ، فَإِن كَانَ من مخرجه سمي مضارعا، والمرَاد بالمضارع ههُنا المشابه نَحْو: « وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ»[الأنعام: 26]، واللاحق كـ «اليَمين» و «الثَّمين»[16]، وازداد التجنيس هنا روعة وجمالا بالتزام النون فيهما قبل السين، وهو فن سماه ابن أبي الإصبع (الالتزام)، ووصفه في هاتين الآيتين بأنه « تُعجز الفصحاء عنه أشد تعجيز، لمجيئها سهلة منسجمةً كما ترى؛ فسبحان المتكلم بهذا الكلام»[17]. وفي صفة النجوم في قوله تعالى: « فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الجَوَارِ الكُنَّسِ» يرى الشريف الرّضي أنهما استعارتان؛ فأما الخُنَّس فالمراد بها التي تخنِسُ نهارا وتطلُع ليلا، والخنَّس جمع خانس وهو الذي يقبع ويستسرّ، ويخفى ويستتر، وأما الكُنَّس فجمع كانس، وهو أيضا المتواري المستخفي، مشبَّها بانضمام الوحشية إلى كناسها، وهو الموضع الذي تأوي إليه من ظلال شجر والتفاف خمر، وجميعه كنَّس، فشبه تعالى انقباع النجوم في بروجها بتواري الوحوش في كُنُسها.[18]
إن عالم النجوم التي تعتبر شمسنا نجما متوسط الحجم من نجومه التي لا تحصيها المخلوقات، عالم عظيم مدهش محير لأولي الألباب، والبحث فيه، والتفكر فيما انبث فيه من آيات الله الجليلة لا بد أن يهدي المتفكرين المنصفين إلى الإيمان بالخالق الرب جل جلاله، والإيمان بعلمه المحيط بكل شيء، وحكمته العظيمة، وقدرته التي لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الأرض، وإتقان صنعه البالغ ذروة الكمال، فالقسم بالنجوم هو في الحقيقة قسم بصفات الله الجليلة التي تعتبر النجوم إحدى ظواهر خلق الله لكونه.[19]
ثانيا: آية الليل إذا عسعس:
دل عليها قول الله عز وجل: « واللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ»[التكوير: 17] يقال لغة: عَسْعَسَ اللّيل إذا أقبل، وعسعس إذا أدبر، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، وهو ابتداء الظلام في أوله، وإدباره في آخره[20] فهو من الأضداد، والآية تحمل عليهما جميعا، لأن ظاهرة الليل عند إقباله وعند إدباره متشابهة، وهي تلفت نظر أهل البحث العلمي إلى قضية علمية تنظيمية فيها إتقان وحكمة من قضايا نظام الكون البديع، وهي تدل على أن الله جل جلاله عليم قدير حكيم، وهي أثر من آثار دوران الأرض حول نفسها تجاه الشمس، ولهذا يتطابق إقبال الليل مع إدباره، وللإيجاز في اللفظ اختيرت كلمة عسعس الدالة على الأمرين معا [21]، ثم عطف القسم بــ «اللَّيْلِ» على القسم بــ «الكواكب» لمناسبة جريان الكواكب في الليل[22] وعقب على القسم بالنجوم بالإقسام بالليل وقيده بوقت العَسْعَسَة، وعسعسة الليل اختلف في معناها، فنجد أكثر المفسرين ذهبوا إلى أنها وقت إدبار الليل وانتهاء ظلمته وذهابه[23] وذلك نظير إقسامه تعالى بإدبار الليل وإسفار الصباح في سورة المدثر في قوله تعالى: « وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَر وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَر»[المدثر: 33-34] ففي إدباره زوال الغمة التي تغمر نفوس الأحياء بانسدال الظلمة وانحسارها، وقيل أقبل بظلامه [24] وفي هذا المقام يقول ابن القيم: والأحسن أن يكون القَسَمُ بانصرام الليل، وإقبال النَّهار عقيبه من غير فَصْل، فهذا أعظم في الدلالة والعبرة، بخلاف إقبال الليل وإقبال النَّهار، فإنَّه لم يُعرف القَسَمُ في القرآن بهما، ولأنَّ بينهما زمنٌ طويلٌ، فالآيةُ في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فَصْلٍ أبلغ، فذكر -سبحانه- حالةَ ضَعْفِ هذا وإدباره، وحالةَ قوَّةِ هذا وتنفُّسِهِ وإقباله؛ يطردُ ظلمةَ الليل بتنفُّسِهِ، فكُلَّمَا تنفَّسَ هَرَبَ الليلُ وأدبر بين يديه[25]، وحجة اختلاف العلماء في تفسير عسعس أنها من الأضداد وتدل على الإقبال والإدبار عند العرب، يقول ابن الانباري: وعَسْعَسَ حرف من الأَضْداد. يقال: عسعس اللَّيل، إِذا أَدبر، وعسعس إِذا أَقبل.[26]
إن من براعة التعبير القرآني اختيار الكلمة الملائمة للسياق ذلك أنه يصح حمل الكلمة على كلا المعنيين؛ فيكون القسم بالليل في حال إقباله وإدباره معا، وفي ذلك قمة البراعة في المعنى مع الإيجاز في اللفظ، وهو ما نسبه ابن عاشور إلى المبرد، قال ابن عطية: قال المبرد: أقسم الله بإقبال الليل وإدباره معا، وبذلك يكون إيثار هذا الفعل «عسعس» لإفادته كلا حالين صالحين للقسم به فيهما لأنهما من مظاهر القدرة إذ يعقب الظلام الضياء ثم يعقب الضياء الظلام، وهذا إيجاز.[27] وفي التعبير عن الليل بالإدبار استعارة مكنية، فقد شبه الليل بإنسان يقبل ويدبر، ثم حذف المشبه، وأخذ منه شيئا من لوازمه، وهي لفظة عسعس، أي: أقبل وأدبر[28]، و أكثر ما أقسم الله به من المخلوقات هو «الليل»، حيث جاء القَسَم به في ستِّ آياتٍ مباركات؛ وهي:[29]
1 - في سورة [المدثر: 33]: «وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ».
2 - في سورة [الانشقاق: 17]: «وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ».
3 - في سورة [التكوير: 17]: «وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ».
4 - في سورة [الفجر: 4]: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ».
5 - في سورة [الشمس: 4]: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا».
6 - في سورة [الليل: 1]: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى».
ثالثا: آية الصبح إذا تنفس:
ولما كان ربما ظن ظان أن ما نقص بالظلام عن صلاحية الإقسام يتأهل ذلك بزواله، قال نافيا لذلك: «وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ»[التكوير: 18] والتنفس كما قال الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني يأتي بمعنيين: الأول: استمداد النَّفَس، أي: أخذ الرِّيح وإدخاله إلى الرئة، ومعلوم أن كل ذي رئة هو متَنَفِّس. والثاني: الزِّيادةُ والامْتِدادُ والاتِّساعُ، يقال لغة: تَنَفَّسَ النَّهْرُ، إذا زاد ماؤُه. ويقال: بين الفريقين نفس، أي: متسع، ويقال: تَنَفَّسَ الصُّبْح، إذا تَبَلَّجَ وامتدَّ واتَّسَع ضوؤه حتى يصير نَهارا بَيِّنًا. ويقال تَنَفَّس النَّهار، إذا امتدَّ وطَال، وهذا المعنى هو المناسب للآية، باعتبار أنه المعنى الذي ينسجم مع: « واللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ» فكلاهما ظاهرتان من ظواهر إتقان حركة دوران الأرض حول نفسها، في اتجاه الشمس، وهي الحركة التي ينتج عنها ظاهرتا الليل والنهار[30]. ونجد الإعجاز في اختيار الألفاظ لمواضعها، ونهوض هذه الألفاظ يرسم الصور على اختلافها، ألا تشم رائحة المعنى قوية من كل هاتين الكلمتين «عَسْعَسَ وتَنَفَّسَ»، ألا تشعر أن الكلمة تبعث في خيالك صورة المعنى محسوسا مجسما دون حاجة للرجوع إلى المعاجم؟ وهل تستطيع أن تصور إقبال ظلام الليل وتمدده في الآفاق بكلمة أدل من عسعس، أو هل تستطيع أن تصور انفلات الضحى من مخبأ الليل وسجنه بكلمة أروع من تنفس، بل هل تجد في معاجم اللغة أدق من هاتين الكلمتين في التعبير عن هذين المعنيين؟ فتأمل ما توحي به كلمة تنفس من تصوير هذه اليقظة الشاملة للسكون بعد هدأة الليل، فكأنما كانت الطبيعة هاجعة هادئة، لا تحس فيها حركة ولا حياة وكأنما الأنفاس قد خفت حتى لا يكاد يحس بها ولا يشعر، فلما أقبل الصبح صحا السكون، ودبت الحياة في أرجائه[31]، وعطف عليه القسم بالصبح حين تنفسه، أي انشقاق ضوئه لمناسبة ذكر الليل، ولأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العالم. ويرى الطاهر بن عاشور أنه يمكن إجراء الاستعارة على أنها مكنية أو تصريحية، فيقول: والتنفس: حقيقته خروج النفس من الحيوان، أستعير لظهور الضياء مع بقايا الظلام على تشبيه خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة المُصَرَّحة، أو لأنه إذا بدا الصباح أقبل معه نسيم فجعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسيم بالأنفاس.[32] وعلى هذا يكون حمل الآية على الاستعارة التَّصريحية باستعارة خروج النفس شيئا فشيئا لخروج النور عند انشقاق الفجر على طريق التدريج، ثم اشتق من التنفس بمعنى خروج النفس «تنفس» وهو خروج النور عند انفلاق الصبح، ويكون فيها مجاز عقلي بإسناد فعل التنفس إلى الصبح، وفي ذلك بيان لأهمية هذا الزمن في احتوائه لهذا الحدث، وإشارة إلى أنه عنصر هام فيه، وفي هذا المنحى يقول شهاب الدين الخفاجي: « وفي كيفية التجوّز قولان أحدهما: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسا له على المجاز، وقيل: تنفس الصبح، والثاني: إنه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي جلس بحيث لا يتحرّك، واجتمع الحزن في قلبه فإذا تنفس وجد راحة فهاهنا لما طلع الصبح كأنه تخلص من ذلك الحزن فعبر عنه بالتنفس، فعلى الأوّل فيه استعارة مصرحة بجعل ما يهب معه من النسيم نفساً للطفه وللاستراحة به وأسند إلى الصبح مجازاً لمقارنته له ففيه استعارة مصرحة، وتجوّز في الإسناد ولو جعل مكنية وتخييلية حسن بأن يشبه الصبح بماش وآت من مسافة بعيدة، ويثبت له التنفس المراد به هبوب نسيمه مجازاً على طريق التخييل»[33]، ويشير الرماني إلى الأثر النفسي الذي ينشأ من التصوير بالاستعارة في قوله تعالى: «وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ» وتنفس ها هنا مستعار، وحقيقته إذا بدأ انتشاره، وتنفس أبلغ منه، ومعنى الابتداء فيهما، إلا أنه في التنفس أبلغ لما فيه من الترويح عن النفس[34]، ويذكر الشريف الرضي أن الآية من الاستعارات العجيبة والتنفس ههنا عبارة عن خروج ضوء الصبح من عموم غسوق الليل، فكأنه مُتَنَفِّس من كرب أو مُتَرَوِّح من هم، ومن ذلك قولهم: قد نُفِّس عن فلان الخناق؛ أي انجلى كربه، وانفسح قلبه، وقد يجوز أن يكون معنى إذا تنفس أي إذا انشق وانصدع، من قولهم: تَنفَّس الإناء إذا انشق، وتنفست القوس إذا انصدعت، وهذا التأويل يخرج اللفظ من باب الاستعارة.[35]
وقد أدركت الدكتورة عائشة بنت الشاطئ في أسلوب القسم القرآني أن القسم بالواو، غالباً أسلوب بلاغي لبيان المعاني، بالمدركات الحسية، وما يلمح فيه من الإعظام، إنما يقصد به إلى قوة اللَّفت، واختيار المقسم به تراعى فيه الصفة التي تناسب الموقف، وحين نتتبع أقسام القرآن في مثل آية الضحى، نجدها تأتي لافتة إلى صورة مادية مدركة وواقع مشهود، توطئة بيانية لصورة أخرى معنوية مماثلة، غير مشهودة ولا مدركة، يماري فيها من يماري: فالقرآن الكريم في قسمه بالصبح إذا أسفر، وإذا تنفس، والنهار إذا تجلى، والليل إذا عسعس، وإذا يغشى، وإذا أدبر، يجلو معاني من الهدى والحق، أو الضلال والباطل، بماديات من النور والظلمة، وهذا البيان المعنوي بالحسي، هو الذي يمكن أن نعرضه على أقسام القرآن بالواو[36]، ويقوي هذا الإيحاء الاستعاري ويؤكد أيضا اختيار القرآن في هذا الموضع لفظة الصبح بدلا من الفجر مثلا، إذ توحي بتألق الضوء وسطوعه وانتشاره بحيث لا يؤدي هذا الإيحاء لفظ الفجر أو أي لفظ آخر يتناغم مع المعنى الذي تقدم على النحو الذي يؤديه مثل لفظة الصبح، والإيقاع الموسيقي الذي تنطوي عليه الاستعارة يزيدها حياة وجمالا، نلحظ ذلك في الفاصلتين «عسعس وتنفس» اللتين أحدثتا إيقاعا يعمق المعنى الذي رمت إليه الآيتان، فلفظ «عسعس» مؤلف من مقطعين: عس عس، وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل يعس في الظلام بيده أو برجله لا يرى! وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع، ومثله : «والصُّبْحِ إذَا تَنَفَّسَ »، بل هو أظهر حيوية وأشد إيحاء والصبح حي يتنفس، أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي، وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيراً لهذا التعبير عن الصبح، ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس! ثم يجيء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب المتفتح. [37]
وبين عسعسة الليل وتنفس النهار تناغم بديع ومقابلة جميلة، فإقبال ظلام الليل حيث يسكن كل متحرك ويختفي معه كل ظاهر يقابله انتشار ضوء النهار وظهور نوره ليبدد ذلك الظلام فيتحرك كل ساكن ويظهر كل مختف، وكلتا المفردتين قد وضعت في مكانها الصحيح الذي هو أحق بها، فقد أوحت كل منهما بجرسها عن معناها؛ فنجد السين المكررة وخفة وقعها في الأذن توحي بظلال النعومة وراحة النفس، وفي عسعس وتنفس يخيل إليك هذه الحياة الوديعة الهادئة التي تنفرج عنها ثناياه، وهو يتنفس، فتتنفس معه الحياة، ويدب النشاط في الأحياء، على وجه الأرض والسماء.[38]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
[1] معارج التفكر ودقائق التدبر، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، 1/ 398 .
[2] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، 8/ 340 .
[3] معارج التفكر ودقائق التدبر، 1/ 418.
[4] إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، 8/ 236.
[5] معارج التفكر ودقائق التدبر، 1/ 420.
[6] معاني القرآن وإعرابه للزجاج، شرح وتحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي، خرج أحاديثه: ذ. علي جمال الدين محمد، 5/ 226.
[7] التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، 30/ 152.
[8] شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق فخر الدين قباوة، ص: 14، دار الفكر المعاصر: بيروت-لبنان، دار الفكر: دمشق-سورية، الطبعة: 2002، وانظر شرح المعلقات السبع، حسين بن أحمد بن حسين الزَّوْزَني، ص: 139.
[9] شرح المعلقات السبع، حسين بن أحمد بن حسين الزَّوْزَني، ص: 139، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1423هـ - 2002 م.
[10] التحرير والتنوير، 30/ 152.
[11] الواضح في علوم القرآن، مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو، ص: 207-208، دار الكلم الطيب/ دار العلوم الانسانية – دمشق، ص: 207-208، الطبعة: الثانية، 1418 هـ - 1998م.
[12] الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 4/ 55، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 1394هـ/ 1974 م.
[13] الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ، ص: 283، دار المعارف، الطبعة: الثالثة.
[14] معارج التفكر ودقائق التدبر، 1/ 419.
[15] معارج التفكر ودقائق التدبر، 1/ 421.
[16] الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، ص: 275، مؤسسة الرسالة – بيروت.
[17] بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري، تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف، القسم الثاني، ص:227-229.
[18] تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشريف الرضي، تحقيق وتقديم: د. علي محمود مقلد، ص: 349-350، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان.
[19] معارج التفكر ودقائق التدبر، 1/ 422.
[20] معاني القرآن وإعرابه للزجاج، 5/ 226.
[21] معارج التفكر ودقائق التدبر، 1/ 422.
[22] التحرير والتنوير، 30/ 154.
[23] جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، 24/ 255، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
[24] معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير البغوي، البغوي الشافعي، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، 5/ 217، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1420 هـ.
[25] التبيان في أيمان القرآن، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، ص: 191، دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1429 هـ.
[26] الأضداد، أبو بكرالأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ص: 32، المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، 1407 هـ - 1987 م.
[27] التحرير والتنوير، 30/ 154.
[28] إعراب القرآن الكريم وبيانه، 8/ 240-241.
[29] التبيان في أيمان القرآن، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، ص:22، دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1429 هـ.
[30] معارج التفكر ودقائق التدبر، 1/423.
[31] قبس من البيان القرآني، محمد حسن شرشر، ص: 47-48، الطبعة الأولى: 1403هـ/1983م.
[32] التحرير والتنوير، 30/ 154.
[33] حَاشِيةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي، الْمُسَمَّاة: عِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الرَّاضِى عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، 8/ 328، دار صادر – بيروت.
[34] النكت في إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة: ذخائر العرب (16)]، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني، تحقيق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام، ص: 90، دار المعارف بمصر، الطبعة: الثالثة، 1976م.
[35] تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشريف الرضي، تحقيق وتقديم: الدكتور علي محمود مقلد، ص: 350، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان.
[36] التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ، ص: 25-26، دار المعارف – القاهرة، الطبعة: السابعة.
[37] في ظلال القرآن، سيد قطب، 6/ 3841-3842.
[38] التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص: 73 .