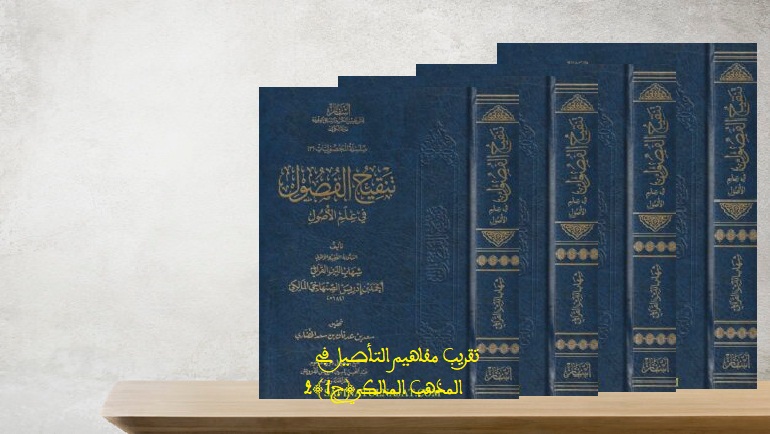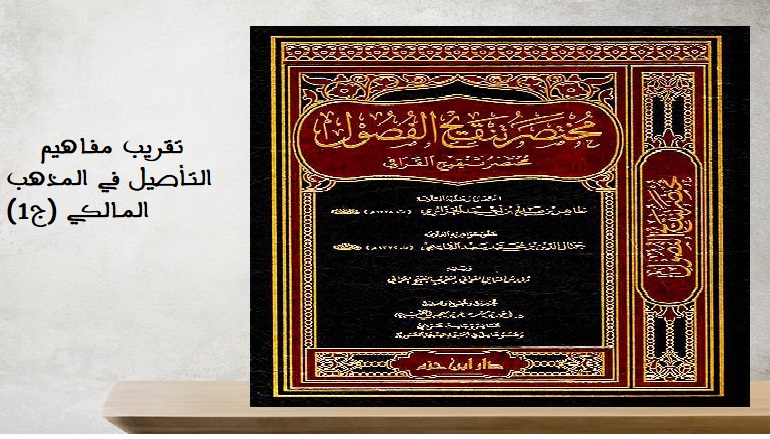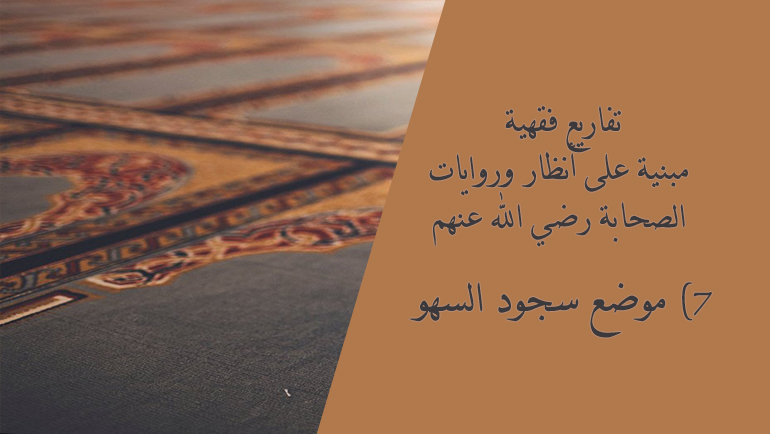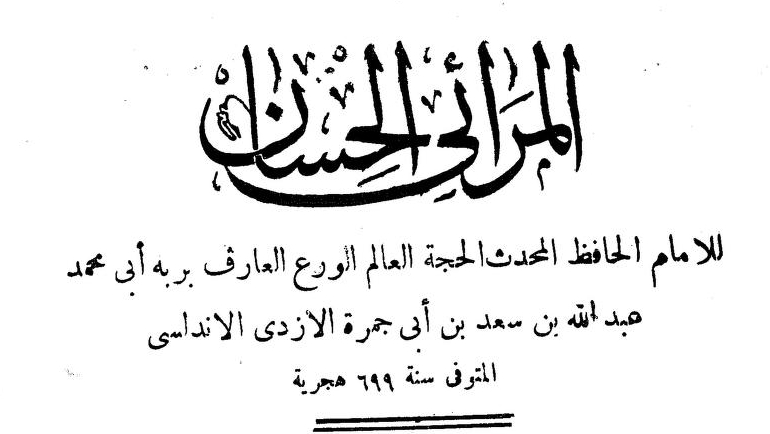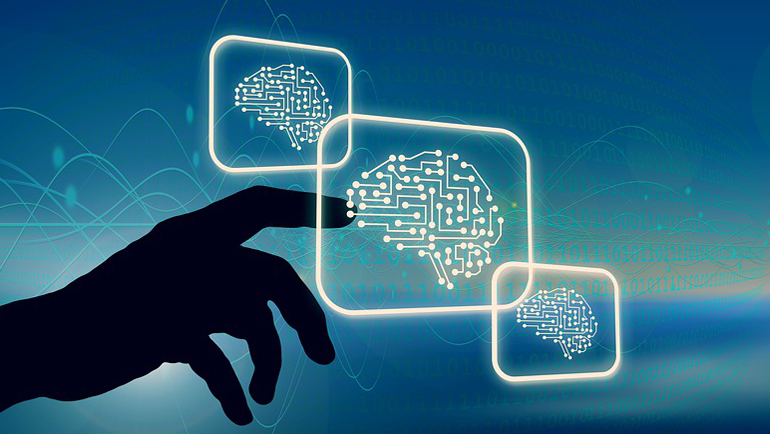تقريب مفاهيم التأصيل في المذهب المالكي(ج1)3
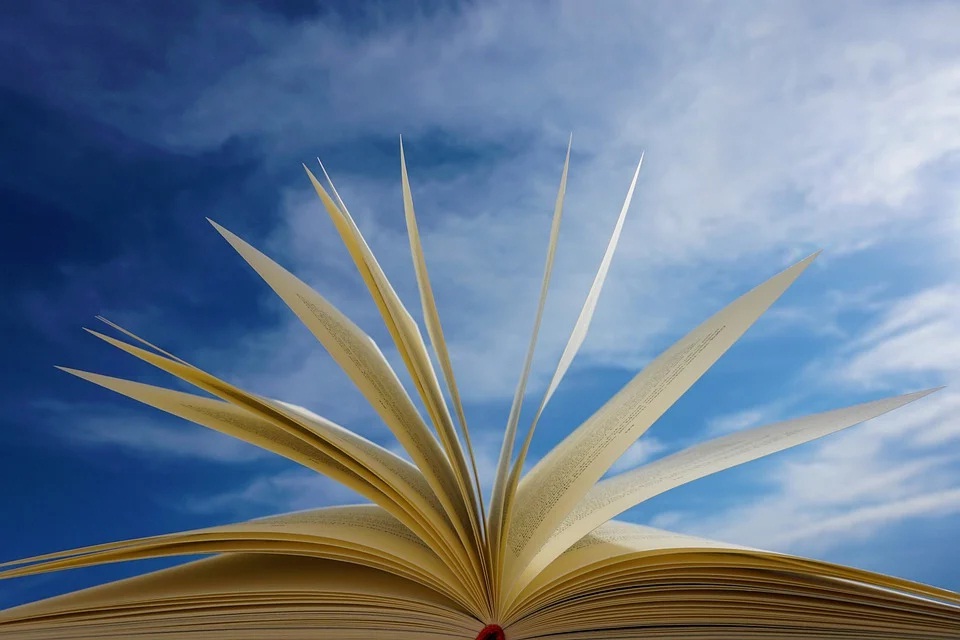
- دور السياق في تحديد دلالة الخطاب الشرعي:
لقد كان الأصوليون على وعي تام بالدور الفعال الذي يقوم به السياق في تحصيل دلالات الخطاب الشرعي، شأنهم في ذلك شأن سائر الدارسين القدامى ممن عني بتحليل الخطاب كالبلاغيين والمفسرين، فالسياق يعتبر "من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته"[1].
ويقرر الغزالي أن الخطاب إن تطرق إليه الاحتمال "فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف كقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"[2]، والحق هو العشر، وإما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى: "والسماوات مطويات بيمينه"[3]. وقوله عليه السلام: "قلب المومن بين أصبعين من أصابع الرحمان". وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين، يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر حتى توجب علما ضروريا بفهم المراد أو توجب ظنا"[4].
ويرى الشوكاني وهو بصدد الحديث عن قرائن المجاز، -والمجاز من الأسباب الموجبة للاحتمال- " أن القرينة إما خارجة عن المتكلم والكلام، أي لا تكون معنى في المتكلم وصفة له، ولا تكون من جنس الكلام، أو تكون معنى في المتكلم أو تكون من جنس الكلام، وهذه القرينة التي تكون من جنس الكلام إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه، بأن يكون في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة، ثم هذا القسم على نوعين، إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه كما لو قال: كل مملوك لي حر، فإنه لا يقع على المكاتب مع أنه عبد ما بقي عليه درهم، فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث إنه مقصور على بعض الأفراد. أما القرينة التي تكون لمعنى في المتكلم فكقوله سبحانه: "واستفزز من استطعت منهم"[5] الآية فإنه سبحانه لا يأمر بالمعصية. وأما القرينة الخارجة عن الكلام فكقوله: "فمن شاء فليومن[6]، فإن سياق الكلام وهو قوله: "إنا أعتدنا" يخرجه عن أن يكون للتخيير(...)، فانحصرت القرينة في هذه الأقسام. ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية وقد تكون حسية وقد تكون عادية وقد تكون شرعية، فلا تختص قرائن المجاز بنوع من هذه الأنواع دون نوع"[7].
كما نجده في موضع آخر من كتابه يحدد وظيفة السياق في التبيين والتعيين: "أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات، وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره"[8].
أما الشاطبي فقد أبان عن وعي عميق بمسألة السياق حين قرر أن التعرف على مقاصد الخطاب "إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك كالاستفهام لفظه واحد، ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكـلام جملة أو فهم شئ منـه"[9].
كما يتجلى هذا الوعي أيضا في تقريره اعتماد أسباب النزول في تحديد المعاني المقصودة للخطاب القرآني، حيث إن معرفة الأسباب "من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال"[10]، كما "أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع"[11].
وبعد أن استعرض جملة من الأمثلة والشواهد التي تثبت المدعى وتزيد المسألة إيضاحا[12] خلص إلى أنه: "لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات"[13].
أسباب النزول إذن إطار سياقي صريح ينبغي تنزيل الخطاب على مقتضاه حتى تنفهم للمتأول مداليله. وإضافة إلى هذا المعطى المقامي يشير الشاطبي إلى أن السياق يقتضي النظرة الشمولية للخطاب، إذ يتعين على الناظر فيه وصل أجزائه بعضها ببعض، آنذاك يتحصل لديه معناه المقصود مادام الخطاب الشرعي وحدة لا تجزؤ فيها، وكلا موصولة أجزاؤه بعضها ببعض حيث لا انفصال فيه، وبناء على ما ذكر يرى الشاطبي: "أن المساقاة تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم، الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره ، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف ، فإن فرق النظر في أجزائه ، فلا يتوصل به إلى مراده ، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم ، فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام ، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد"[14].
ومن طريف ما جاء به الشاطبي في هذا المجال دعوته إلى اعتبار السياق المقصدي للخطاب أو باصطلاحه المساق الحِكْمِي (بكسر الحاء)، وحاصله ضرورة اعتبار العلل ووجوه الحكم الجزئية والكلية مما يصب في مجرى المقاصد الشرعية، "وهذا السياق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع"[15].
من خلال هذه البيانات تتضح أهمية السياق في تقليص الاحتمالات الواردة على الخطاب وذلك بترجيح أقواها وأقربها إلى مقصود المتكلم، فهو أمر ملازم للأقوال الطبيعية ملازمة قوية، والـتأويل السليم لهذه الأقوال لا يتهدى إليه الفقيه المحقق دون الاستناد إلى مقتضيات السياق، لأنه يورث مدلول الخطاب اقتضاءاته الاستعمالية، ولأن الفهم والإفهام يتعذران دون مراعاته.
الهوامش:
[1]- بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، 0-9/41، دار الكتاب العربي، بيروت، ( د ط ت).
[2] - الأنعام، 141.
[3] - الزمر، 67.
[4] - المستصفى، ص 185، ط 1، 1993، دار الكتب العلمية، بيروت.
[5] - الإسراء، 64.
[6] - الكهف، 29.
[7] - إرشاد الفحول، ص 53 وما يليها، تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري، ط 4، 1993، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
[8] - إرشاد الفحول، ص 275.
[9] - الموافقات،3/358.
[10] - الموافقات، 3/358.
[11] - نفسه، 3/359.
[12] - الموافقات، 3 / 260-259.
[13] - نفسه، 3/ 261- 260.
[14] - الموافقات، 3/ 310-309.
[15] - الموافقات، 3/ 205.