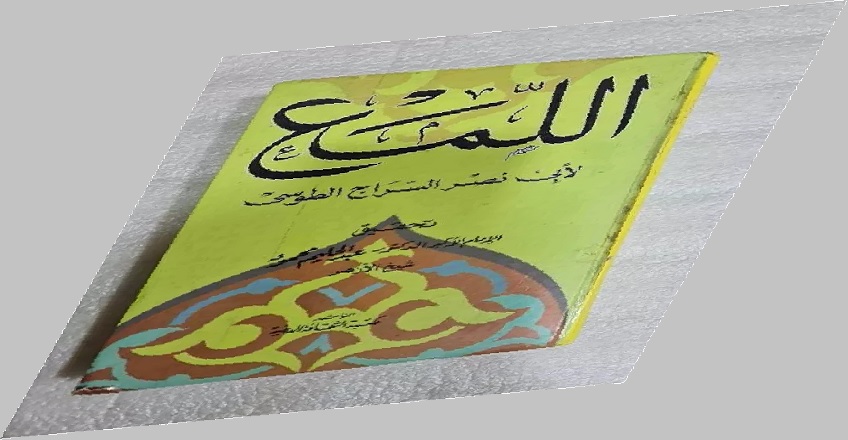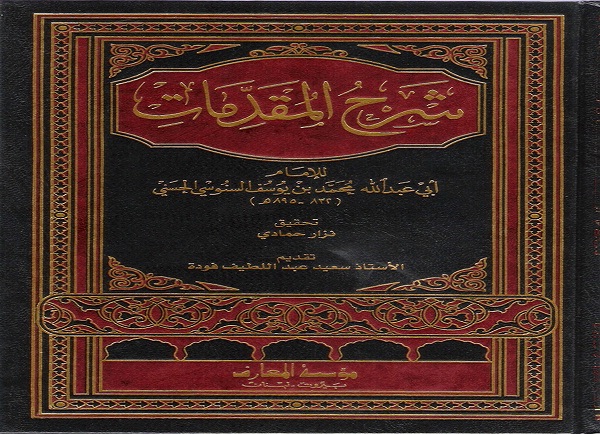
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رضي الله عنه مبينا
أصول الكفر والبدع:
"ص: (وأصول الكفر والبدع سبعة:
- الإيجاب الذاتي: وهو إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليل أو الطبع من غير اختيار.
- والتحسين العقلي: وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفةً عقلاً على الأغراض: وهي جلب المصالح ودرء المفاسد.
- والتقليد الرديء: وهو متابعة الغير لأجل الحمِيّة والتعصب، من غير طلب للحق.
- والربط العادي: وهو إثبات التلازم بين أمر وأمر، وجوداً وعدماً، بواسطة التكرر.
- والجهل المركب: وهو أن يجهل الحقَّ، ويجهل جهله به.
- والتمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل.
- والجهل بالقواعد العقلية: التي هي العلم بوجوب الواجبات، وجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، وباللسان العربي: الذي هو علم اللغة والإعراب والبيان).
ش: يعني أن اعتقاد واحد من هذه الأمور قد ينشأ عنه كفر مُجمع عليه، وقد تنشأ عنه بدعة يُختلف في كفر صاحبها."
"أما الأصل الأول: وهو الإيجاب الذّاتي، أي: اعتقاد أن الذات العليّة سبب في وجود الممكنات لا بالاختيار، بل بطريق العلّة أو الطبيعة، فلاَ إشكال في كفر من يعتقد هذا؛ لأن مِن لازِم هذا المذهب إنكارُ القدرة والإرادة الأزليّتين، ومن لازِمه قدم العالم، ومن لازِمه تكذيب القرآن في قوله تعالى: ﴿وربّك يخلق ما يشاء ويختار﴾ [القصص: 68]، وقوله جل وعلا: ﴿بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء﴾ [المائدة: 64] ونحو ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنة.
والفرق بين العلّة والطبيعة، أن العلة تقتضي معلولها وتلازمه ولا يمكن انفكاكه عنها أصلاً، والطبيعة تقتضي مطبوعَها عند توفّر الشّرائط وانعدام الموانع، وقد يتخلّف عنها المطبوع لتخلُّف شرطٍ أو وجود مانع.
وهذا المذهب ظاهر الفساد؛ فإن البرهان القطعيّ قد دلّ على وجوب القدم لمولانا –جل وعلا- ووجوب الحدوث لكل ما سواه، ودلّ أيضاً على استحالة حوادثَ لا أوّل لها، فتعين على سبيل القطع واليقين أن المولى –تبارك وتعالى- إنما أوجد العالم بطريق الاختيار، لا بطريق اللزوم في الأزل –وهو طريق التعليل-، ولا بطريق اللزوم فيما لا يزال- وهو طريق الطّبْع- إذا قُدِّر تخلف شرطٍ أو وجود مانعٍ في الأزل لوجود العوالم؛ لأنه لو تخلف شرطها في الأزل لم يمكن أن توجد أبداً؛ لنقل الكلام إلى ذلك الشرط فيلزم فيه التسلسل، ولو وُجد لها مانع من وجودها في الأزل لكان ذلك المانع قديما فيستحيل عدمه، والعوالم قد توقفت على عدمه، فلا يمكن وجودها أبداً.
وأما الأصل الثاني: وهو التحسين العقليّ، فقد نشأ عنه كفر صريح مجمع عليه: وهو كفر البراهمة؛ فإنهم أنكروا النّبوات، وكذبوا الرسل – صلوات الله وسلامه عليهم- فيما بلّغوه عن المولى – تبارك وتعالى- من إيجاب الركوع والسجود، وإباحة ذبح البهائم للأكل ونحو ذلك، وذلك كله قبيح عندهم، يستحيل أن يُشرِّعه الحكيم.
ولو تأملوا أدنى تأمل لعرفوا فساد رأيهم؛ لأنه لو قبُح ذلك في حكمه –تعالى- لقبُح في فعله – جلّ وعلا-، ومن المعلوم قطعاً أن المولى –تبارك وتعالى- قد يجعل شخصاً بمرض أو كِبَر على هيئة الراكع أو على هيئة الساجد، بل قد يسلُبُه عقله حتى يصدر منه ما هو أعظم من هذا من كشف العورة وأكل العَذِرة وسائر النجاسات والتلطخ بها، فإذا كان له –تعالى- أن يفعل ما يشاء، فله –جلّ وعلا- أن يحكم في عبيده بما يشاء.
ولو توقفت أفعاله وأحكامه – سبحانه- على الأغراض لزِم احتياجه – تعالى- إلى الأفعال ليحَصّل بها غرضه، وذلك ينافي جلاله وعظمته ووجوبَ غناه – جل وعزّ- عن كل ما سواه.
ونشأ عن هذا الأصل الفاسد بدعة المعتزلة في إيجابهم مراعاة الصلاح والأصلح للعباد في حقه تعالى، وكون الأحكام الشرعية تابعة للتحسين العقلي وتقبيحه ونحو ذلك من بدعتهم.
وأما الأصل الثالث: وهو التقليد الرّديء، فقد نشأ عنه كفر صريح مجمع عليه وهو تقليد الجاهلية آباءهم في الشرك وعبادة الأصنام، وتقليدُ عامة اليهود وعامة النصارى لأحبارهم في إنكار نبوة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من كل تقليد في كفر صريح.
ونشأ عنه بدعة مختلف في كفر صاحبها، كتقليد عامّة المعتزلة والمرجئة والمجسِّمة لقدمائهم فيما دانوا به من هذه البدع، وقد سبق ما في ذلك من الخلاف.
واحترزنا بالتقليد الرّديء من التقليد الحسن، كتقليد عامّة المؤمنين لعلمائهم في الفروع.
واختُلف في تقليد عامّة المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدّين هل يكفي ذلك أم لا ؟ وكثير من المحققين قالوا: إن ذلك كافٍ إذا وقع منهم التصميم على الحقّ، لا سيما في حقّ من يعسُر عليه فهم الأدلة.
وأما الأصل الرابع: وهو الرّبط العادي، فلاشك أنه قد نشأ عنه كفرٌ صريح مجمع عليه، ككفر الطبائعيين القائلين بقدم الأفلاك وتأثيرها بطِباعها في العوالم الأرضية، وكفر الجاهلية المنكرين للبعث وأحوال الآخرة بسبب الاغترار بالرّبط العاديّ.
ونشأ عنه بدعةٌ مختَلف في كفر صاحبها، كبدعة من اعتقد حُدوث الأسباب العادية وتأثيرها بجعل الله – تعالى- فيها قوة لذلك، ولو شاء لم تؤثر، وقد سبق ما في ذلك من الخلاف.
وأما الأصل الخامس: وهو الجهل المركَّب، وهو اعتقاد أمرٍ على خلاف ما هو عليه، فلا شك أنه سبب للتمادي على الكفر إن كان ذلك الكفر هو الذي وقع الجهل باعتقاده، كجهل الفلاسفة باعتقادهم قدم الأفلاك، واعتقادهم تأثير الإله بطريق التعليل ونحو ذلك من كفرياتهم، وهو أيضاً سببٌ في التمادي على البدعة إن كانت تلك البدعة هي التي وقع الجهل باعتقادها، كجهل القدرية باعتقادهم استقلال الحيوانات بإيجادها أفعالها الاختيارية، واعتقادهم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح في حق المولى – تبارك وتعالى- ونحو ذلك من سائر البدع الاعتقادية.
وإنما كان الجهل المركب سبباً وأصلاً للتمادي على الكفر والبدعة؛ لأجل عدم شعور صاحبه بجهله، واعتقاده الصّواب والحق في جهله. ومن كان على هذه الصفة فإنه لا يطلب الخروجَ عن جهله؛ لأنه هو الصراط المستقيم عنده، وإذا اتفق أن يجيء من يشككه في معتقده ويرده إلى ما هو الحقّ في نفس الأمر يمتنع من الاستماع له ومن قَبُول قوله، بخلاف الجهل البسيط – وهو عدم إدراك أمر من الأمور- فإن صاحبه يطلب العلم بما جهله إن شعر بعدم إدراكه، وإن غفل عن ذلك وجاء من ينبهه لطلب العلم بذلك، أو جاء من يعلمه ما جهله، فإنه يُجيب إلى ذلك ويقبله؛ لما جُبلت عليه النفوس من النفرة عن الجهل البسيط، ومحبة تحصيل العلم بما ليس معلوماً لها.
وسبب الجهل المركّب: وثوق النفس من العقليات بما ليس برهانيا من الأدلة، وتحسين الظن بما تستبدّ به من أنظارها واستنباطها، لا سيما عندما تظهر لها الإصابة للحق في بعض أنظارها، فتزهو وتعجب حينئذ، وتقيس سائر أنظارها على ذلك النظر الذي من المولى الكريم –تبارك وتعالى- فيه بالتوفيق لإدراك الحق فضلا منه – جل وعلا-، فعوقب هذا الناظر بالحرمان وعدم التسديد في سائر الأنظار لتكبره وإهماله شكر نعمة درك الصواب التي انفرد بإسدائها المولى جل وعلا، وليس للعقل ولا لفكرته ولا للدليل الصحيح – مادةً وتركيباً- فيه تأثير البتّة، لا بطريق التولد ولا بطريق التعليل، وإهماله لزوم التواضع والفقر إلى المولى الكريم – جلا وعلا – في كل نظر يقع بباله، قال جل من قائل: ﴿سأصرف عن آياتيَ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق﴾ [الأعراف:146]. ويكون أيضاً هذا الجهل المركب في الشرعيات كما يكون في العقليات، ويكون من المقلّدين كما يكون من النّاظرين.
وأما الأصل السادس: وهو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل، فلا خفاء في كونه أصلا للكفر والبدعة؛ أما الكفر فكأخذ الثّنوِيّة القائلين بألوهية النور والظلمة من قوله تعالى: ﴿الله نور السماوات والأرض﴾ [النور:35] أن النور أحد الإلهين، واسمه "الله".
ولم ينظروا إلى استحالة كون النور إلها لأنه متغير حادث يوجد وينعدم، والإله يستحيل عليه التغيّر والحدوث، ويجب له القدم والبقاء.
وإذا كان كذلك وجب حمل الآية على خلاف ظاهرها، إما مع التفويض إلى المولى –تبارك وتعالى- في تعيين المراد منها، وهو مذهب السلف في جنس هذه الظواهر، وإما مع تعيين معنىً تصح إرادته بهذا اللفظ في لغة العرب؛ لأن القرآن نزل بألسنتهم، وهو مذهب إمام الحرمين وكثير من الأئمة، ولهم في ذلك تأويلات مذكورة في كتب التفسير، من جملتها أنه يحتمل أن يكون اللفظ خرج مخرج الاستعارة أو التشبيه البليغ، بأن جُعل العدمُ كظلمة استتر فيها وجود الكائنات من السماوات والأرضين وما بينهما، ولما توقف خروجها من العدم إلى الوجود في ذواتها وصفاتها على إيجاد المولى العظيم –تبارك وتعالى- لها، كما توقف ظهور الأشياء المستترة بالظلمة على انتشار النور عليها، أطلق بهذا الاعتبار على المولى – تبارك وتعالى- أنه نور السماوات والأرض، أي هو – جل وعلا- المظهر للسماوات والأرضين ولجميع الكائنات بخلقه لها أولاً وإمدادها ثانياً بإبقاء ذواتها بما وَالى عليها من تعاقبات الأعراض المتكاثرة كثرة لا يحصي عددها إلا هو – جلا وعلا-، فلولا المولى العظيم –تبارك وتعالى- بما نشر على وجود الممكنات من أنوار قدرته وإرادته وعلمه، لوجب بقاؤها في ظلمة العدم أبد الآباد، ولهذا إذا طوى – سبحانه- على هذه العوالم ما نشر على وجودها من نور تعلق صفاته بإبقائها وإمدادها خربت وفنيت ودخلت في ظلمة عدمها الذي كانت عليه أوّلاً، حتى يقابل أيضاً وجودها بأنوار قدرته وإرادته وعلمه عند البعث والنشأة الثانية، فتصبح حينئذ ترفل في أثواب وجودها ذاهبة جائية، كلّ صائر إلى ما حكم به المولى العظيم –جلّ وعلا- وأراده في أزله، فصحّ إذاً أن يُقال على طريق مجازات لغة العرب واستعاراتها وتفنُّنها في بليغ تشبيهاتها: ﴿الله نور السماوات والأرض﴾ [النور:35].
ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿الله نور السماوات والأرض﴾ (النور: 35) أنه به–تعالى- ظهرت أنوارها الحسية من شمس وقمر ونجوم وسراج، وأنوارها المعنوية كعلوم الملائكة وعلوم الأنبياء والرسل والأقطاب والأولياء والصالحين والعلماء وأحوالهم السّنية التابعة لتلك العلوم والمعارف.
والمعنى أن تلك القلوبَ والجوارحَ إنما استنارت بتلك العلوم والأحوال والأعمال بإنارة المولى العظيم لها بذلك، لا بحوْلها وقوّتها، فهو –تعالى- إذاً نوّرها.
ومثل هذا المجاز والتشبيه مألوف اليوم في عرْف الناس؛ يقولون فيمن توقّف عليه أمور البلدة وتصرفات أهلها بطريق السداد والعافية: فلان هو نور هذه البلدة، أي: به استنارت وظهرت محاسنها. والله - سبحانه وتعالى- أعلم بمُراده.
وأما البدعة الناشئة عن تقليد مجرّد ظواهر الكتاب والسنة فكثير جدّا، كأخذ المجسمة الجسمية من ظاهر قوله تعالى: ﴿لِـمَا خلقتُ بيديّ﴾ [ص:75] ونحوه، والاختصاص بجهة فوقٍ بطريق التحيُّز وعمارة الفراغ، كاختصاص الأجرام من قوله تعالى: ﴿على العرش استوى﴾ [طه:5] وقوله تعالى: ﴿يخافُون ربَّهم من فوْقهم﴾ (النحل: 50) ونحو ذلك، وكأخذهم أيضاً الجِسمية والجهة والانتقال بالحركة والسكون من قوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربُّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل" [أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، والإمام مالك في موطئه].
ومشكلات الكتاب والسنة كثيرة جدّاً، وقد صنف العلماء في جمعها والكلام عليها تصانيف، والضابط الجُملي في جميعها أن كل مشكل منها مستحيل الظاهر فإنه ينظر فيه، فإذا كان لا يقبل التأويل إلا معنًى واحداً وجب أن يُحمل عليه، كقوله تعالى: ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ [الحديد: 4]؛ فإن المعيّة بالتحيّز والحلول بالمكان مستحيلة على المولى –تبارك وتعالى-؛ لأنها من صفات الأجسام، فتعين صرف الكلام عن ظاهره، ولا يقبل هنا إلا تأويلاً واحداً دلّ عليه السّياق، وهو المعية بالإحاطة علماً وسمعاً وبصراً.
وإن كان يقبل من التأويل أكثر من معنىً واحدٍ، كقوله تعالى: ﴿تجري بأعيننا﴾ [القمر:14] وقوله جل وعلا: ﴿لِـما خلقت بيديّ﴾ (ص:75) وقوله تعالى: ﴿على العرش استوى﴾ [طه:5] ونحوه، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
-المذهب الأول: وجوب تفويض معنى ذلك إلى الله تعالى، بعد القطع بالتنزيه عن الظاهر المستحيل، وهو مذهب السلف. ولهذا لما سأل السائل مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: ﴿على العرش استوى﴾ [طه:5] قال في جوابه: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن مثل هذا بدعة"، وأمر بإخراج السائل. يعني –رضي الله عنه – أن الاستواء معلوم من لغة العرب ومحامله المجازية التي تصح في حق الله تعالى، والمراد في الآية منها أو من غيرها ممّا لم نعلمه مجهول لنا، والسؤال عن تعيين ما لم يرد نصّ من الشرع بتعيينه بدعة، وصاحب البدعة رجل سوء تجب مجانبته وإخراجه من مجالس العلم؛ لئلا يُدخل على المسلمين فتنةً بسبب إظهار بدعته.
- المذهب الثاني: جواز تعيين التأويل للمشكل، ويرجّح على غيره مما يصح بدلالة السياق أو بكثرة استعمال العرب للفظ المشكل فيه، فتُحمل العين على العلم أو البصر أو الحفظ، وتحمَل اليد على القدرة أو النعمة، ويحمل الاستواء على القهر والغلبة، وهذا مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة من العلماء.
- المذهب الثالث: حمل تلك المشكلات على إثبات صفاتٍ لله تعالى تليق بجلاله وجماله، لا يُعرَف كنهها. وهذا مذهب شيخ أهل السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه.
قلت: والظاهر أن من احتاط وعبّر فيما يذكره من تأويل لذلك المشْكل بلفظ الاحتمال، فيقول: يحتمل أن يكون المراد من الآية أو الحديث كذا، فقد سلِم من التجاسر وسوء الأدب بالجزم بتعيين ما لم يقم دليل قطعيّ على تعيينه، والله أعلم.
وأمّا الأصل السابع: وهو الجهل بالقواعد العقلية وباللسان العربي وفنّ البيان، فلا شك أن الجهل بذلك قد يجرّ إلى الكفر، كفَهْم بعضهم مذهب النصارى بتركيب الإله، وأن عيسى –عليه السلام- جزءٌ منه، من قوله تعالى: ﴿وروح منه﴾ [النساء: 171]، بجعل "مِن" للتبعيض، ولا شك أن معه جهلين:
- أحدهما: بالقواعد العقلية؛ إذ لو عرف أن هذا المعنى يستلزم حدوث الإله؛ للزوم مشابهته للحوادث في التغيّر والافتقار إلى المخصِّص بمقدار مخصوص من المقادير المركَّبة، ويستلزم انعدام حقيقة الألوهية بالكلية؛ لأنه إذا كان عيسى – عليه السلام- حلّ فيه جزء من الإله فقد انعدم إذاً الإلهُ؛ لوجوب انعدام الحقيقة المركَّبة بانعدام جزئها، وعيسى– عليه السلام- إنما حصل فيه جزء من الإله، وجزء الإله ليس بإله، فقد انعدم إذا الإله بالكلّيّة.
- الثاني: جهلهم باللغة العربية، حيث حصروا معنى "مِن" في التبعيض، فيلزمهم أيضاً أن يفهموا التبعيض منها في قوله تعالى: ﴿وسخَّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه﴾ [الجاثية:13] كما فهموه في قوله تعالى: ﴿وروحٌ منه﴾ [النساء:171]. ولو كانوا عارفين باللغة العربية لفهموا أن "مِن" في قوله تعالى: ﴿وروحٌ منه﴾ [النساء:171] ليست للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية، أي: وروحٌ جاءت منه تعالى خَلقاً واختراعاً، كما أن معناها ذلك في قوله تعالى: ﴿وسخَّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه﴾ [الجاثية: 13].
ومن الجهل باللغة العربية أخذ الجسمية وأعضائها في حقه –تبارك وتعالى – من قوله – جلا وعلا-: ﴿يا حسرتى على ما فرّطت في جنب الله﴾ [الزمر:56]، وقوله تعالى: ﴿لما خلقت بيدي﴾ (ص:75) ونحوهما، ومن عرف اللغة العربية ومارس استعمالات العرب فهِم أن الجنْب والجانب يستعملان كثيراً بمعنى جهة الحقوق؛ إذ كثيراً ما يقول الإنسان: فرّطت في جنْب فلان أو جانبه، والمراد: التفريط في جهة حقّه، وليس مراده قطعاً البدنَ ولا أجزاءَه، وعليه يخرج قوله تعالى: ﴿على ما فرّطت في جنب الله﴾ [الزمر:56]، أي: في جهة حقوقه وأوامره ونواهيه. وكذا يعرف من خالط اللغة العربية أن اليد كما تستعمل في الجارحة المخصوصة، تستعمل في القدرة والنعمة.
ومن الجهل بقواعد الإعراب جعل بعض المعتزلة جملة "خلقناه" من قوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ [القمر:49] في موضع الصفة لـ "شيء" ، حتى أخذ من مفهوم الصفة أن هناك شيء غير مخلوق لله –تعالى- وهو أفعال الحيوانات الاختيارية على مذهبهم الفاسد، ولو عرف قواعد الإعراب لفهم أن جملة "خلقناه" لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنها مفسّرة للعامل في "كلَّ" من باب الاشتغال، فيؤخذ حينئذ من تعميم الخلق لكل شيء بطلان مذهب القدَرية.
ومن الجهل بفن علم المعاني والبيان أخذ المعتزلة تعليل أفعال المولى –تبارك وتعالى- بالأغراض من قوله –جلا وعلا-: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات:56]، فجعلوا اللام للتعليل حقيقة. ولو خالطوا فن البيان لعرفوا أن الآية من باب الاستعارة التبعية، وأنه شبّه التكليف بالعبادة في ترتّبه على الخلق بالعلة الغائية التي تترتّب على الفعل ويُقصد الفعل لأجلها، فجُعلت العبادة – أي: التكليف بها- لأجل هذا الشّبه علةً غائية بطريق الاستعارة، فتبع ذلك استعارة اللام الموضوعة للتعليل حقيقة، ودخلت على العبادة للدلالة على العلة المجازية.
وكذلك من الجهل بفن علم المعاني والبيان اعتقاد صدور حوادث من غير المولى –تبارك وتعالى-، كاعتقاد زيادة الإيمان من سماع آية من القرآن أخذاً من قوله تعالى: ﴿وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً﴾ [الأنفال: 2]، وستر العورة من اللباس أخذاً من قوله تعالى: ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم﴾ [الأعراف: 26]، وإثارة الرياح للسحاب ونشرها أخذاً من قوله تعالى: ﴿الله الذي يُرسل الرياح فتثير سحاباً﴾ [الروم:48] ونحو ذلك مما هو في القرآن والسنة كثير، ومن خالط فن البيان عرف أن إسناد الفعل في جميع ذلك من باب الإسناد المجازي العقلي، وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له، غير ما هو له في الظاهر عند المتكلم.
وإذا عرفت أن الجهل بهذه العلوم يوقع صاحبه في كفر أو بدعة، تعين على من له قابليّة لفهمها أن يجتهد في تحصيلها، ومن ليس له قابلية لفهمها وجب عليه أن يتعلم ما هو فرض عين من علم التوحيد، ومهما سمِع من الكتاب والسنة ما يقتضي ظاهره خلاف ما عرف في علم التوحيد، قطع بأن ذلك الظاهر المستحيل غير مرادٍ لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لذلك الكلام معنىً صحيحاً وتأويلاً ممكناً مليحاً، ويؤمن على سبيل القطع بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقّ لا تناقض فيه ولا اختلاف ولا باطل فيه ولا جهل ولا وهم ولا حيْد عن الصواب ولا غلط ولا انحراف، ولا يضرّه بعد ذلك الجهل بالمراد لأن القلب محشوّ باعتقاد تنزيه المولى تبارك وتعالى وتنزيه رسله عليهم الصلاة والسلام عن كل نقص وخلل وفساد، وبالله تعالى التوفيق.