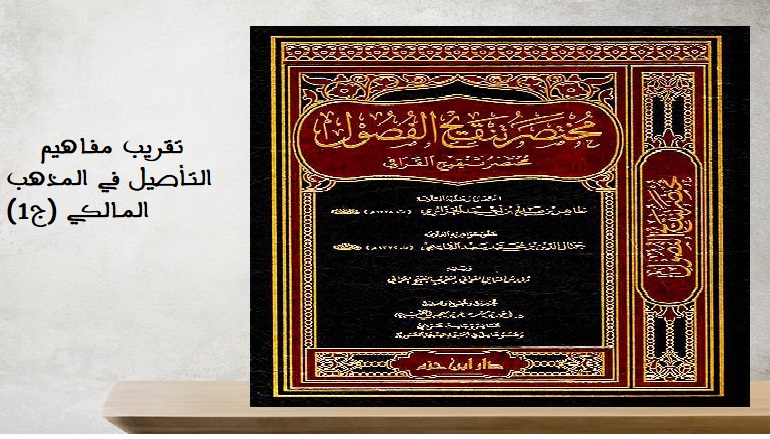إن إدراك مقاصد الشريعة وفهم أسرارها له مدخل عظيم في فهم أحكامها، وفي استنباط المزيد من هذه الأحكام وتنزيلها في واقع الناس على اختلاف الأزمنة والأمكنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك ما يُدرك به صلاح هذا الدين الخاتم لكل زمان ومكان وإنسان.
يقول الإمام الشاطبي عند بيان عصمة الشريعة وذكر وسائل حفظها: "وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزَّلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك، وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو احتيج في إيضاحها إليه. وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة.[1]"
وإذا كانت معرفة مقاصد الشريعة بهذه الأهمية في ما مر من العصور، فإنها أصبحت في عصرنا أشد أهمية، وأضحت الحاجة إليها أكبر؛ لأن فهم هذه المقاصد هو الباب الذي يفتح أمام المسلمين آفاقا جديدة في مجال تنزيل الفقه على الواقع الذي أصبح أكثر تعقيدا تحت ضغوط المستجدات وكثرتها، كما أن فهم علل الأحكام ومقاصدها من شأنه أن يجيب عن أسئلة كثيرة مما يتعلق بمعرفة المسلم لذاته في علاقته بمحيطه، وفق ما يريده له خالقه، وبذلك يعود المسلمون إلى دورهم الحضاري الرائد، ويتمكنون من تحقيق العيش الكريم في ظل تشريع رحيم يحقق لهم مصالحهم في معاشهم ومعادهم.
وإذا كان لمقاصد الشريعة هذه الأهمية، فإن معرفة مقاصد الخلق لا تقل أهمية عنها، وذلك لدورها في تعرف الإنسان لدوره ورسالته في هذا الوجود، مما يساعده على السير وفق ما يرضي خالقه وخالق الوجود كله.
ولا أعني هنا بالخلق ما يراد في علم المقاصد بمقاصد المكلفين، إنما الخلق هنا هو الخلق بمعناه المصدري، ومقاصده هي تلك التي ورد ذكرها في مجموعة من النصوص القرآنية والحديثية منها قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56)، وقوله عز من قائل: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).
وإذا كانت الآية الأولى تبين القصد من الخلق، فإن الآية الثانية يفهم منها أن التعارف علة في خلق الناس شعوبا وقبائل مختلفة، ولذلك أمر الله به كغاية من غايات هذا التنوع في الخلق. فهل يكون التعارف مقصدا من مقاصد الخلق والشريعة معا، خاصة إذا علمنا بأن مقصدي الخلق والتشريع قد يجتمعان، يقول بديع الزمان النورسي: "الشريعة الإلهية اثنتان: وهما آتيتان من صفتين إلهيتين، والمخاطب إنسانان وهما مكلفان بهما.
أولاهم: الشريعة التكوينية الآتية من صفة الإرادة الإلهية، وهي الشريعة والمشيئة الربانية التي تنظّم أحوال العالم، الإنسان الأكبر، وحركاته التي هي ليست اختيارية. وقد يطلق عليها خطأ اسم الطبيعة. أما الأخرى: فهي الشريعة الآتية من صفة الكلام الإلهي، هذه الشريعة تنظم أفعال الإنسان الاختيارية، ذلك العالم الأصغر. وتجتمع الشريعتان أحياناً معاً[2]."
ولكي نحكم بصحة هذا الأمر أو بطلانه لابد من المرور بعدة مراحل منها:
ـ عرض كون التعارف مقصدا شرعيا على طرق معرفة المقاصد، لتحديد كيفية التوصل إلى اعتباره مقصدا أو عدم اعتباره كذلك.
ـ يقول الغزالي في المستصفى: "فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ" ويقول الشاطبي: "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مصالحها في الخلق[3]."
ـ معرفة الأحكام الشرعية المفضية إلى اعتباره مقصدا، إن صح هذا الاعتبار، لكي يخرج من مجرد كونه علة لخلق الناس على الشكل المذكور في الآية الكريمة.
ـ إذا ثبت اعتباره مقصدا، أو غلب هذا الافتراض، ففي أي نوع من المقاصد يمكن إدراجه؟ ثم هل هو مقصد لذاته أم أنه وسيلة يتوصل بها إلى مقاصد شرعية معتبرة من الشارع؟
ـ تحديد الفئة المعنية به؛ بمعنى: هل الخطاب به خاص بدائرة المسلمين بعضهم مع بعض، أم أنه يتعداهم إلى غيرهم من غير المسلمين؟
وخلال ذلك لابد من بيان المقصود بالتعارف، هل هو مجرد معرفة الإنسان قبيلة وانتماء غيره كما جاء في معظم كتب التفسير، أم أن له معنى إضافيا قريبا مما يراد به اليوم عند إطلاقه في مجال الاجتماع؟
طرق معرفة المقاصد
لخص الشيخ ابن عاشور طرق معرفة المقاصد من كلام الشاطبي قائلا: "ولقد جاء الشاطبي في آخر كتاب المقاصد من تأليفه الموافقات بكلام أرى من المهم إثبات خلاصته باختصار، قال: بماذا يعرف ما هو مقصود الشارع مما ليس مقصودا له"، ثم قال ناقلا كلام الشاطبي عن هذه الطرق ومختصرا له: "فنقول: إن مقصد الشارع يعرف من جهات:
إحداها؛ مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، فإن الأمر كان أمرا لاقتضائه الفعل، فوقوع الفعل عنده مقصود الشارع، وكذلك النهي في اقتضاء الكف.
الثانية؛ اعتبار علل الأمر والنهي، كالنكاح لمصلحة التناسل والبيع لمصلحة الانتفاع بالمبيع.
الثالثة؛ أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فمنها منصوص عليه ومنها مشار إليه، ومنها ما استقرىء من المنصوص فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما ذلك شأنه هو مقصود الشارع[4]."
غير أنني عند الرجوع إلى كلام الشاطبي وجدته يذكر طريقا رابعا لم يذكره ابن عاشور، وهو قوله بعد كلام طويل، وتفريع للجهة الثالثة من جهات الكشف عن المقاصد: "والجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع: السكوت عن شرع التسبب، أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له، وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
أحدهما: أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقدر لأجله؛ كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك؛ فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها، وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم؛ كجمع المصحف، وتدوين العلم، وتضمين الصناع، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من نوازل زمانه، ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها؛ فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعًا بلا إشكال؛ فالقصد الشرعي فيها معروف من الجهات المذكورة قبل.
والثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان؛ فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودًا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه؛ كان ذلك صريحًا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع؛ إذا فهم من قصده الوقوف عند ما حدّ هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه[5]".
ثم ختم كلامه قائلا عن هذا النوع:" وهو أصل صحيح، إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها، ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل، فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع؛ فبطل[6]."
واعتبر هذا النوع من البدع، ومثل له بسجود الشكر في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.
أما الشيخ الطاهر بن عاشور فقد اعتبر طرق إثبات المقاصد متمثلة في:
ـ استقراء الشريعة في تصرفاتها، وهو على نوعين: أعظمها استقراء الأحكام المعروفة عللها؛ لأن استقراء العلل الكثيرة يؤدي إلى حصول العلم بمقاصد الشريعة. وأما النوع الثاني فيكون باستقراء علل الأحكام التي تشترك في علة بحيث يحصل اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع.
ـ أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي.
ـ السنة المتواترة، ومن هذا الطريق المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي، صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم علم بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين، وإليه يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة، وأمثلته كثيرة منها في المعاملات مشروعية الحبس التي ظهرت في المدينة من أعمال الرسول ونسائه وأصحابه، ومثاله في العبادات كون خطبة العيدين بعد الصلاة.
ومنه المتواتر العملي الذي حصل للصحابة من تكرر مشاهدة أعمال الرسول، صلى الله عليه وسلم، بحيث يستخلص من مجموعها مقصدا شرعيا[7]."
إن استقراء نصوص الشريعة من جهة، والأمر الواضح بالتعارف والتآلف في القرآن الكريم والسنة المتواترة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، كلها تثبت أن التعارف مطلوب شرعا، قد يكون طلبه لذاته، وقد يكون لغيره كما سيأتي.
غير أنني قبل الكلام عن الأدلة التي تبين مكانة التعارف من مقاصد الشريعة، أتوقف عند توجيه جليل من هذا الشيخ المقاصدي الحكيم؛ أقصد الشيخ الطاهر بن عاشور، يقول: "على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويعيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل والتسرع في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه خطر عظيم[8]."
ثم يقول: "فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علما قطعيا، أو قريبا من القطعي، وقد يكون ظنا، ولا يعتبر ما حصل للناظر من ظن ضعيف أو دونه، فإن لم يحصل له من عمله سوى هذا الضعيف فليفرضه فرضا مجردا ليكون تهيئة لناظر يأتي بعده كما أوصى رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال: (فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)[9]."
وعملا بتوجيه الشيخ، فإن كلامي في إثبات التعارف مقصدا شرعيا سيكون فرضا أفترضه، ولغيري تقييمه ثم تقويمه.
هل التعارف مقصد شرعي؟
إنه من المعلوم أن الغاية من خلق الإنسان تتمثل في الخلافة في الأرض وعمارتها بالعبادة والعمل النافع، وأن الله تعالى خلق الإنسان لهذه الغاية العظمى وزوده بالإيمان والعلم والبيان، ليتمكن من القيام بهذا الدور الذي خلق من أجله كما هو مبين في كثير من آيات الذكر الحكيم، أذكر منها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا ءادَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (البقرة: 29-32).
وقوله سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءانَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (الرحمن: 1-2).
فهاهنا، إضافة إلى الإيمان، سلاحان لا ضرورة لهما بدون تواصل مع الغير، ولا تواصل بدون تعارف؛ إذ ما فائدة البيان إن لم يكن بغرض التواصل مع الآخر، ومن أين يأتي العلم إن لم يُتلق عن الغير ويُتوارث.
لكن ما المقصود بالتعارف وما حدوده وما غايته؟
ـ مفهوم التعارف في القرآن الكريم
لقد ورد من مادة (ع ر ف) في القرآن الكريم ثمانية وعشرون استعمالا في واحد وسبعين موضعا، منها الفعل من المعرفة بتصاريف متعددة، والفعل من التعريف والاعتراف، ومنها العرف والمعروف.
أما التعارف فلم يرد إلا في موضعين اثنين هما قوله سبحانه في سورة يونس: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ الآية: 45. وقوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ الآية: 13.
وآية سورة يونس ورد تفسير التعارف فيها بمعان مختلفة منها:
ـ أن التعارف كان في الدنيا ثم انقطع بالحشر، وعليه معظم المفسرين: قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب، كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما بينهم، ثم انقطعت المعرفة، وانقضت تلك الساعة."
ـ أن التعارف بمعنى المعرفة؛ أي يعرف كل أحد صاحبه يوم القيامة، جاء في تفسير ابن أبي حاتم: "يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ" قَالَ: "يَعْرِفُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ لا يُكَلِّمُهُ يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وقال في التحرير والتنوير: "والتعارف: تفاعل من عَرف، أي يعرف كل واحد منهم يومئذٍ من كان يعرفه في الدنيا ويعرفه الآخَر كذلك."
ـ أن المقصود التعارف عند الخروج من القبور ثم تنقطع المعرفة، جاء في بحر العلوم للسمرقندي: "(يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ) قال الكلبي: يعني: يتعارفون بينهم حين خرجوا من قبورهم، ثم تنقطع عنهم المعرفة فلا يعرف أحد أحداً، وقال الضحاك: يتعارفون بينهم حين خرجوا، وذلك أن أهل الإيمان يبعثون يوم القيامة على ما كانوا عليه في دار الدنيا من التواصل والتراحم، يعرف بعضهم بعضاً محسنهم لمسيئهم، وأما أهل الشرك فلا أنساب بينهم يومئذ، ولا يتساءلون."
ـ أن المشركين يتعارفون ولكن لا أثر لهذه المعرفة يومئذ، قال الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير الآية: (يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيَعْرِفُ الْآبَاءُ الْأَبْنَاءَ، كَالْعَكْسِ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَارَفَةَ لَا أَثَرَ لَهَا، فَلَا يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شَيْئًا، كَقَوْلِهِ: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا).
ـ أن المعرفة هي مجرد الرؤية والتعرف الخاطف، جاء في أيسر التفاسير؛ (أي ليرى بعضهم بعضاً ساعة ثم يحول بينهم هول الموقف).
ـ يبدو من سياق الآية، والله أعلم، أنها تخبر عما يحدث يوم الحشر؛ إذ سيتعارف الناس بمصائرهم، فيدرك الكفار مدى خسرانهم عند اطلاعهم على مصير المؤمنين، كما يرضى المؤمنون عن سعيهم عند اطلاعهم على مصير الكفار، ذلك أن الله تعالى بعد أن ذكر هذا التعارف قال: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ)، ذلك أن التعارف بينهم يستبعد أن يكون عائدا لما قبله وهو قوله: (ساعة من نهار)؛ لأن الغرض من هذا التحديد هو بيان قصر الحياة الدنيا التي أفنوها في ما يرديهم في دار الخلد، وهم لا شك لم يضيعوها في التعارف بينهم، وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الأحقاف: 34).
وانطلاقا من هذا الفهم للآية الكريمة يظهر أن التعارف بين الناس لمعرفة كل فرقة مصير الأخرى مقصود؛ لأن الغرض منه حسرة الكفار والزيادة في تعذيبهم بما يرونه من نعيم الجنة التي حرموا منها بأعمالهم، ونصوص القرآن الكريم التي تنطق بهذا المعنى كثيرة منها قوله عز من قائل: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءامَنُواْ انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورا، فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ (الحديد: 13).
وكما جاء في سورة الصافات عند تصوير نعيم المؤمنين: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ. قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. فَاطَّلَعَ فَرَءاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ﴾ الآيات من 51 إلى 56.
يتحصل، إذن، أن الآية الوحيدة التي أشارت إلى التعارف في الدنيا هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).
هذه الآية هي إحدى آيات سورة الحجرات، التي تعد بحق سورة الأخلاق، فهي سورة قد اشتملت من بدايتها إلى نهايتها على الدعوة إلى مبادئ المعاملات الصحيحة البانية للمجتمع الإيماني السليم المتماسك، وقبل الآية، محل الدرس، وردت مجموعة من الأوامر والنواهي التي تهدف كلها إلى حفظ جماعة المؤمنين من كل دواعي الفرقة والاختلاف، من ذلك:
ـ التحذير من التقدم بين يدي الله ورسوله ومخالفة أوامرهما: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: 1).
ـ الدعوة إلى التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيء وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (الحجرات: 2).
ـ التحذير من تصديق أخبار الفاسقين التي قد تنشر الفتن بين صفوف المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).
ـ الدعوة إلى الإصلاح بين المتخاصمين: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).
ـ تأكيد مبدأ الأخوة التي يجب أن تكون هي أساس العلاقة بين المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10).
ـ النهي عن كل ما يكدر صفو هذه الأخوة، وينشر الفرقة ومن ثم الضعف داخل صفوفهم، ومن ذلك السخرية، واللمز، والتنابز بالألقاب، وسوء الظن، والتجسس، والغيبة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ، بِيسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ﴾ (الحجرات: 12).
ـ وقبل أن تختم السورة ببيان الفرق بين الإيمان والإسلام، جاءت الآية مخاطبة للناس جميعا بدعوتهم إلى التعارف بينهم، ومبينة أن أساس التفاضل بينهم عند الله خالقهم هو التقوى دون أي شيء آخر من تلك الامتيازات الدنيوية النابعة من أصل خلقهم، والراجعة إلى تدبير اللطيف الخبير.
دراسة الآية:
عند الرجوع إلى فهوم المفسرين للآية الكريمة وتفاسيرهم لها، نجدهم يربطونها بسبب نزولها، ويقصر معظمهم معنى التعارف فيها على مجرد معرفة أنساب وقبائل بعضهم بعضا، جاء في تفسير مقاتل بن سليمان: "نزلت في بلال المؤذن، وقالوا: في سلمان الفارسي، وفي أربعة نفر من قريش، في عتاب بان أسيد بن أبى العيص، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وأبى سفيان بن حرب، كلهم من قريش، وذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما فتح مكة أمر بلالاً فصعد ظهر الكعبة وأذن، وأراد أن يذل المشركين بذلك، فلما صعد بلال وأذن. قال عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي قبض أسيد قبل هذا اليوم، وقال الحارث بن هشام: عجبت لهذا العبد الحبشي، أما وجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا هذا الغراب الأسود، وقال سهيل بن عمرو: إن يكره الله شيئاً يغيره، وقال أبو سفيان: أما أنا فلا أقول، فإني لو قلت شيئاً لتشهدن علىّ السماء ولتخبرن عنى الأرض.
فنزل جبريل على النبي، صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقوله، فدعاهم النبي، صلى الله عليه وسلم [...] فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿يا أيها الناس﴾؛ يعنى بلالاً وهؤلاء الأربعة ﴿يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى﴾ وعنى آدم وحواء ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً﴾؛ يعنى رؤوس القبائل ربيعة ومضر وبنو تميم والأزد ﴿وَقَبَآئِلَ﴾؛ يعنى الأفخاذ بنو سعد، وبنو عامر، وبنو قيس، ونحوه ﴿لتعارفوا﴾ في النسب.
وقال القرطبي: ونزلت الآية في أبي هند[...]: أمر رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً﴾ الآية. قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. وقوله في الرجل الذي لم يتفسح له: ابن فلانة، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من الذاكر فلانة؟" قال ثابت: أنا يا رسول الله، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انظر في وجوه القوم" فنظر، فقال: "ما رأيت؟" قال رأيت أبيض وأسود وأحمر، فقال: "فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى"، فنزلت في ثابت هذه الآية.
وقال الطبري: "وقوله: ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ يقول: ليعرف بعضكم بعضا في النسب، يقول تعالى ذكره: إنما جعلنا هذه الشعوب والقبائل لكم أيها الناس، ليعرف بعضكم بعضا في قرب القرابة منه وبعده، لا لفضيلة لكم في ذلك، وقُربة تقرّبكم إلى الله، بل أكرمكم عند الله أتقاكم.
وقال ابن كثير في تفسير: ﴿لِتَعَارَفُوا﴾؛ "أي ليحصل التعارف بينهم، كلٌ يرجع إلى قبيلته."
وقال النيسابوري في تفسير الآية: "ثم بين الحكمة التي من أجلها رتبهم على شعوب وقبائل وهي أن يعرف بعضهم نسب بعض فلا يعتزى إلى غير آبائه فقال: ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾؛ "أي ليقع بينكم التعارف بسبب ذلك لا أن تتفاخروا بالأنساب."
أما التفاسير المعاصرة فقد توسع بعضها في ما يفهم من الآية الكريمة، فنجد، مثلا، في تفسير المنار عند الحديث عن مقاصد القرآن: "الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ مِنْ مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ الْإِصلَاح الِاجْتِمَاعِي الْإِنْسَانِي وَالسِّيَاسيُّ الَّذِي يَتَحَقق بِالْوَحَدَاتِ الثَّمَانِ: وَحْدَةُ الْأُمة؛ وَحْدَةُ الْجنسِ الْبَشَرِي؛ وَحْدَةُ الدين؛ وَحْدَة التَّشرِيعِ بِالْمُسَاوَاةِ فِي الْعَدْلِ؛ وَحْدَةُ الْأُخُوَّةِ الرُّوحِيَّةِ وَالْمُسَاوَاةِ فِي التَّعَبُّدِ؛ وَحْدَةُ الْجِنْسِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ؛ وَحْدَةُ الْقَضَاءِ؛ وَحْدَّةُ اللُّغَةِ ثم يقول: (الْأَصْل الثَّانِي)؛ الْوَحْدَة الْإِنْسَانِية بِالْمُساوَاة بَيْن أجْنَاسِ الْبشَرِ وَشُعوبِهِمْ وَقَبَائِلِهمْ، وَشَاهِدُهُ الْعَام قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾[10]."
ـ وقال أبو زهرة عند تفسير الآية الأولى من سورة النساء ومقارنتها بآية الحجرات: "وهذا النص يشبه قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾. بيد أن النص الذي نتحدث عنه يثبت أن الذكر والأنثى من طبيعة واحدة، ويثبت في مضمونه الصلة الرحيمة التي تربط الناس جميعا، وما ينبني عليها من تعاطف وتواد وتراحم، والنص الآخر يبين وجوب التعارف الذي هو الطريق للتراحم والتواد، فهنا بيان الغاية، وهنالك بيان طريقها."
وقال الزحيلي مفسرا الآية الكريمة: "والمعنى أيها البشر إنا خلقناكم جميعا من أصل واحد من نفس واحده من آدم وحواء فأنتم متساوون؛ لأن نسبكم واحد، ويجمعكم أب واحد وأم واحدة فلا موضع للتفاخر بالأنساب، فالكل سواء ولا يصح أن يسخر بعضكم من بعض ويلمز بعضكم بعضا، وأنتم إخوة في النسب. وقد جعلناكم شعوبا؛ (أمة كبيرة تجمع قبائل) وقبائل دونها لتتعارفوا لا لتتناكروا وتتحالفوا، والمقصود أن اللَّه سبحانه خلقكم لأجل التعارف، لا للتفاخر بالأنساب[11]."
وجاء في التفسير الميسر: "وجعلناكم بالتناسل شعوبًا وقبائل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضًا[12]."
وقال سيد قطب في تفسير الآية الكريمة: "يا أيها الناس، والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم من ذكر وأنثى، وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل، إنها ليست التناحر والخصام، إنما هي التعارف والوئام، فأما اختلاف الألسنة والألوان، واختلاف الطبائع والأخلاق، واختلاف المواهب والاستعدادات، فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي التعارف للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات"، ثم يقول: "إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم، ويعرف به فضل الناس ﴿إن أكرَمَكُمْ عنْدَ الله أتقاكُمْ﴾.. والكريم حقا هو الكريم عند الله، وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾[13]." ثم بين أن هذه القاعدة هي التي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي، أو المجتمع الإنساني العالمي الذي تحاول البشرية أن تحققه دون أن تتمكن من ذلك.
يلاحظ أن التعارف عند سيد قطب لا يعني فقط معرفة الأنساب أو الأشخاص، بل عبر عنه بمرادفه عنده كما يظهر وهو لفظ "الوئام"، كجعل الغاية من التعارف هي "النهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات"، وهذا على خلاف ما فسر به عند المتقدمين. فمن أين جاءت هذه الإضافة في معنى التعارف؟
عند الرجوع إلى المعاجم اللغوية وجدت معظمها تعرف مادة (عرف) بالعلم، وتذكر من المادة عدة استعمالات منها المعرفة بمعنى يقارب العلم بالشيء، وعرف الدابة، والعريف بمعنى القائم على أمور القوم، والعراف، والمعروف، والعرف بكسر العين بمعنى الصبر.
جاء في المصباح المنير في مادة عرف: عَرَفْتُهُ: عرفة بالكسر، و"عِرْفَانًا" علمته بحاسة من الحواسّ الخمس و"المَعْرِفَةُ" اسم منه ويتعدى بالتثقيل فيقال عرفته به فعرفه وأمر عارف وعريف؛ أي معروف، وعرفت على القوم أعرُف من باب قتل عرافه بالكسر فأنا "عارف"؛ أي مدبر أمرهم وقائم بسياستهم وعَرُفتُ عليهم بالضم لغة فأنا "عريف" والجمع "عُرَفَاءُ" [...] وأمرت "بِالعُرْفِ"؛ أي "بِالمَعْرُوفِ" وهو الخير والرفق والإحسان... وعرف الدابة الشعر النابت في محدبِّ رقبتها[14]."
وجاء في لسان العرب: العرفان: العلم، قال ابن سيده: ويَنْفَصِلانِ بتَحْديد لا يَليق بهذا المكان، عَرَفه يَعْرِفُه عِرْفة وعِرْفاناً وعِرِفَّاناً ومَعْرِفةً واعترفه [...] ورجل عَروف وعَرُوفة عارِفٌ يَعْرِفُ الأَمور ولا يُنكِر أَحداً رآه مرة. والهاء في عَرُوفة للمبالغة والعَريف والعارِفُ بمعنًى مثل عَلِيم وعالم [...] رجل عارِف؛ أَي صَبور [...] والتعريفُ الإعْلامُ والتَّعريف أَيضاً إنشاد الضالة وعرَّفَ الضالَّة نَشَدها [...] وقد تَعارَفَ القومُ؛ أَي عرف بعضهُم بعضاً [...] والعُرْفُ والعارِفة والمَعروفُ واحد ضد النكر وهو كلُّ ما تَعْرِفه النفس من الخيْر وتَبْسَأُ به وتَطمئنّ إليه[15]."
وفي معنى المعروف عند ابن منظور وجدت لفظ الاطمئنان، وهذا اللفظ أصل من أصلي مادة عرف كما ذكره ابن فارس، قال: "العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدلُّ أحدُهما على تتابُع الشيء متَّصلاً بعضُه ببعض والآخر على السكون والطُّمَأنينة. فالأوّل العُرْف: عُرْف الفَرَس. وسمِّي بذلك لتتابُع الشَّعر عليه. ثم قال: "والأصل الآخر المعَرِفة والعِرفان. نقول: عَرَف فلانٌ فلاناً عِرفاناً ومَعرِفة. وهذا أمر معروف. وهذا يدلُّ على ما قلناه من سُكونه إليه؛ لأنَّ مَن أنكر شيئاً توحَّشَ منه ونَبَا عنْه.
ومن الباب العَرْف، وهي الرَّائحة الطيِّبة. وهي القياس؛ لأنَّ النَّفس تسكُن إليها. يقال: ما أطيَبَ عَرْفَه. والعُرْف: المعروف، وسمِّي بذلك لأنَّ النفوس تسكُن إليه [...] ويقال: النَّفس عَروف، إذا حُمِلت على أمرٍ فباءت به؛ أي اطمأنَّت [...] والعارف: الصابر، يقال أصابته مصيبةٌ فوُجِد عرُوفاً؛ أي صابراً.
من خلال النماذج السابقة يتضح أن مادة (ع ر ف) يدور بعض معانيها على الاطمئنان، وهذا هو الذي ينسجم مع لفظ التعارف بالمعنى الذي يحقق التواصل ويكون في بعض مراحله من لوازم القيام بالخلافة في الأرض وتعميرها، ويرتبط بعدة مقاصد مقررة في الشرع.
وتفصيل ذلك:
- إنه من المعلوم أن استمرار وجود النسل الذي هو وسيلة تعمير الأرض والخلافة فيها لا يتم إلا بالزواج بين الذكر والأنثى، ولا زواج بدون تعارف، بل إن أهم أسس العلاقة بين الزوجين هي المودة والرحمة والسكن، والاطمئنان الذي عليه مدار التعارف مدخل في كل هذه المعاني الثلاثة.
هذا وقد يكون الزواج وسيلة للتعارف على نطاق أوسع كما استثمره النبي، صلى الله عليه وسلم، في زيجاته المتعددة التي قصد منها، من ضمن ما قصد، توسيع دائرة علاقاته مع مختلف القبائل والبيوت العربية، كما دعا إلى استثماره في حثه على الزواج بالأغراب.
هذا، ومعلوم من جهة أخرى أن حفظ النسل هو أحد الكليات الخمس التي لا تستقيم الحياة بدونها كما هو مقرر في كتب المقاصد. فالتعارف إلى هذا الحد وسيلة لمقصد مقرر في الشريعة بطرق مختلفة، أو لعله من المقاصد التابعة حسب ما يفهم من كلام الشاطبي، يقول: "للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، مثال ذلك النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على المقصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج، والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية [...] وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح؛ فمنه منصوص عليه أو مشار إليه، ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك المنصوص، وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي، ومقو لحكمته، ومستدع لطبه وإدامته، ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف، الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل؛ فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا، كما روي من فعل عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب طلبًا لشرف النسب، ومواصلة أرفع البيوتات، وما أشبه ذلك؛ فلا شك أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائغ، وأن قصد التسبب له حسن. وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق[16]."
- إن حفظ الدين من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والدين إنما وصل للناس بالتبليغ من مبلغه الأول الرسول، صلى الله عليه وسلم، ثم من ورثته الذين هم العلماء ثانيا، ثم وصل إلى الشعوب من خلال التعارف بين عموم المسلمين وغيرهم ممن أسلموا من خلال مختلف المعاملات مع المسلمين، وبهذا تحقق معنى عالمية الإسلام وشمول رحمته للبشرية كلها حسب ما جاء في قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (الأنبياء: 106)، ولذلك راسل النبي، صلى الله عليه وسلم، ملوك زمانه وخاطب كل من وصل إليه بدعوته، معرفا بنفسه ورسالته كما هو ثابت في كتب السنة والسيرة النبوية المطهرة. ولم يكن شيء من ذلك ليتم بدون تعارف.
بل إن من أصول العقيدة وأركانها: الإيمان بالرسل، ولكي يتم هذا الإيمان ويكمل، عرَّفَنا القرآن الكريم بمعظم الرسل والأنبياء وأقوامهم من خلال القصص القرآني المبثوث في كتاب الله تعالى بشكل كبير. وهذا القدر من التعارف بين الشعوب يظل مطلبا أساسا في كل العصور في سبيل التعريف بالرسالة الخاتمة الموجهة للناس جميعا.
- إن حفظ النفس لا يقوم إلا بتوفير قدر من الضروريات في المسكن والمطعم والملبس، وهذا لا يتأتى لإنسان مهما كانت قدراته أن يحققه لنفسه دون الاستعانة فيه بغيره، ولذلك خلق الله الناس مختلفين في القدرات والمهارات حتى ينتفع بعضهم بما عند البعض الآخر ويتعاونوا ويتبادلوا الخدمات بما يحقق مصالحهم كما بينه قوله سبحانه: ﴿اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً، وَرَحْمَت رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (الزخرف: 31).
يقول الشاطبي متحدثا عن قسمي الضروريات، عند بيانه أن الضرب الثاني، وهو ما ليس فيه للمكلف حظ عاجل مقصود، ينقسم بدوره إلى قسمين، يقول: "فالحاصل أن هذا الضرب قسمان؛ قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة، كقيامه بمصالح نفسه مباشرة. وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير، كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد، والاكتساب بما للغير فيه مصلحة، كالإجارات، والكراء، والتجارة، وسائر وجوه الصنائع والاكتسابات، فالجميع يطلب الإنسان بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير، خدمة دائرة بين الخلق، كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا حتى تحصل المصلحة للجميع[17]."
ويقول أحد الدارسين المعاصرين مقررا أن حفظ الدين هو المقصد الأصل، وأن غيره من الكليات إنما هي مقاصد تابعة له: "فبهذا اتضح أن هذه المقاصد تابعة وخادمة للمقصد الأصلي كما قلت، وهو الدين؛ إذ لا يقوم ذلك ولا يتدين الإنسان إلا إذا أكل وشرب وتزوج، وآوى إلى مسكن، ولبس ما يقيه الحر والبرد، وذلك يكون بالتعاون مع الغير بالصناعة والتجارة وغير ذلك، فصار كل ذلك مقاصد تابعة للمقصد الأصلي الذي من أجله خلق الإنسان[18]". فما ذكره من أمور بها تحفظ باقي الضروريات من زواج، وتعاون على الصناعة والتجارة لا يتصور في الذهن دون تعارف كما سبق بيانه.
- من المقرر عند العلماء أن حفظ العقل هو من المقاصد الضرورية، وحفظ العقل من جانب الوجود يكون بالدعوة إلى طلب العلم والثناء على العالم والمتعلم، والدعوة إلى التفكر والتأمل ومن ذلك السير في الأرض، وكل هذه لا تتم بدون تعارف.
- وأخيرا فإن كلية المال هي المقصد الخامس من المقاصد الضرورية، وتحصيله لا يتصور في العقل دون تعارف، سواء في معناه البسيط الذي يعني ما يتملكه الإنسان لتستقيم حياته ولا تتوقف كامتلاكه للقدر الضروري من المأكل والملبس، أو بمعناه العام الذي جاءت الشريعة للحفاظ عليه وإنمائه بمختلف المعاملات باعتباره عصب الحياة ومصدر قوة للأمة، وهذه المعاملات التي راعت فيها الشريعة مجموعة من الضوابط، فإنها كلها إنما تتم بين ناس متعارفين ليس فقط بأشخاصهم، بل بصفاتهم التي تشجع على الثقة بينهم وإقامة علاقات من شأنها أن تزيد المال نماء وتداولا بين فئات المجتمع، سواء من خلال المبادلات التجارية، أو من خلال الزكاة والصدقة وهما أيضا لا يمكن أداؤهما بدون قدر قليل أو كبير من التعارف.
إلى هذا الحد تقرر أن التعارف وسيلة من أهم وسائل قيام الضروريات الخمس وحفظها. لكننا بالرجوع إلى النصوص القرآنية والحديثية نجد أن التعارف مقصد تضافرت جملة من الأحكام على تحقيقه، منها:
ـ الحث على صلة الرحم كما دلت على ذلك نصوص قرآنية وحديثية عدة.
ـ مؤاخاة النبي، صلى الله عليه وسلم، بين المهاجرين والأنصار، ثم بيان جزاء المتآخين في الله ومصيرهم كما جاء في عدة أحاديث؛ منها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: "رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا[19]."
ـ الدعوة إلى الإصلاح بين المتخاصمين كما سبق في سورة الحجرات.
ـ بيان قيمة تأليف الله تعالى بين القلوب المتنافرة، واعتبار ذلك نعمة من الله على المؤمنين، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمُ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (ءال عمران: 103).
ـ اعتبار العرف في التشريع عملا بما تعارف الناس عليه ما لم يكن عرفا فاسدا يخالف الشرع، كما هو مقرر في محاله من المباحث الأصولية.
ـ الدعوة إلى التعاون بين المؤمنين للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل قوله سبحانه: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (ءال عمران 104)، وقوله عز من قائل: ﴿وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة : 72).
ـ الدعوة إلى التكافل بين المؤمنين، والتكافل لا يتصور إلا بتعرف أحوال المحتاجين؛ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى[20]."
كان هذا عما يفهم من اعتبار التعارف بين المسلمين أمرا مطلوبا في الشريعة الإسلامية. فماذا عن التعارف بين المسلمين وغيرهم من الأمم والشعوب؟
بالرجوع إلى الآية الكريمة من سورة الحجرات، نجد أن التفاسير القديمة تكاد تخلو من الدعوة إلى التعارف بين المسلمين وغيرهم، على الأقل بشكل صريح، لكن كلمة الشعوب لها دلالة خاصة بيَّنها المفسرون، من ذلك: قول ابن عطية: "والشعوب: جمع شعب وهو أعظم ما يوجد من جماعات الناس مرتبطاً بنسب واحد، ويتلوه القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الأسرة والفصيلة: وهما قرابة الرجل الأدنون؛ فمضر وربيعة وحمير شعوب، وقيس وتميم ومذحج ومراد، قبائل [...] وقريش ومحارب وسليم عمارات، وبنو قصي وبنو مخزوم بطون، وبنو هاشم وبنو أمية أفخاذ، وبنو عبد المطلب أسرة وفصيلة، وقال ابن جبير: الشعوب: الأفخاذ. وروي عن ابن عباس الشعوب: البطون، وهذا غير ما تمالأ عليه اللغويون. قال الثعلبي، وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في العرب، والأسباط في بني إسرائيل[21]."
يؤخذ من كلام ابن عطية وغيره من اللغويين والمفسرين أن الشعب هو أعظم ما يوجد من جماعات الناس مرتبطاً بنسب واحد، وقد تكون كلمة الشعب بالنسبة للعجم مقابلة للقبيلة عند العرب. وبناءً على هذا المعنى؛ فالدعوة إلى التعارف في آية سورة الحجرات تعم الناس جميعا من مسلمين وغيرهم، وليس فيها ما يخصص الخطاب ويقصره على المسلمين سواء من جهة اللغة أو من جهة السياق المقالي للآية أو من جهة السياق العام للتشريع:
فمن جهة اللغة؛ قد تبين أن الشعب هو التجمع العظيم من الناس بغض النظر عن كونهم عربا أو مسلمين أو غير ذلك، خاصة أن آية التعارف افتتحت بقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾ خلافا لما سبقها في السورة من الآيات التي كان الخطاب فيها للمؤمنين خاصة.
ومن جهة سياق الآية؛ فإن الله تعالى تحدث عن كل الفروق التي يمكن تصورها بين الناس، فذكر الذكورة والأنوثة، ثم ذكر الشعوب والقبائل، وذِكْرُهما معا يدل على أن الشعب غير القبيلة، وقد يكون أعم منها بحسب ما يفهم من ترتيب الفروق في الآية، هذا إضافة إلى ما سبق بيانه من أن سورة الحجرات اشتملت على الدعوة إلى طاعة الله ورسوله، ثم بينت أسس التعامل بين المسلمين وضوابطه، فيحتمل وفق هذا الترتيب أن يراد بهذه الآية بيان الضوابط التي ينبغي أن تحكم معاملة الناس عامة بعضهم بعضا، وأن كل هذه الفروق لا قيمة لها في ميزان الله تعالى، بل إنما قصدت هذه الفروق لما يعود بالنفع على الناس من تعارف وتعاون، أما عند الله تعالى فأساس التفاضل بين الناس بمختلف أجناسهم وانتماءاتهم إنما هو التقوى وحده، وهذا ما يشهد له افتتاحها، خلافا لجميع آيات السورة، بقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾ من جهة، ودلت عليه نصوص قرآنية وحديثية متعددة من جهة ثانية، منها ما قاله النبي، صلى الله عليه وسلم، في خطبة حجة الوداع.
إلا أن لقائل أن يقول: إن حديث خطبة حجة الوداع كان الخطاب فيه موجها إلى المسلمين وحدهم، وسبب نزول آية سورة الحجرات أيضا يوجه معنى الآية نفس الوجهة؛ إذ خاطب الله تعالى المسلمين الذين كانوا يختلفون من حيث اللون والجنس والقبائل، ودعاهم إلى التعارف لا إلى التنافر بسب الاختلافات الموجودة بينهم، وهنا نحتكم في الإجابة عن هذا الأمر إلى السياق العام للتشريع.
بالرجوع إلى السياق العام للتشريع نجد أن الرسالات السماوية التي بينت للإنسان دوره وواجباته تجاه خالقه، إنما بلغها رسل الله وأنبياؤه لمن يعرفون، وأكثر من ذلك، فإن الرسالة الإسلامية الخاتمة رسالة عالمية، فكيف تتحقق هذه العالمية دون تبليغها للعالمين، وكيف يتم تبليغها دون معرفة مسبقة بالمبلغ إليهم. وقد عرفنا أن الله تعالى دعا النبي إلى مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وأن النبي، صلى الله عليه وسلم، كانت له معاملات مختلفة مع أهل الكتاب ومع الكفار أيضا، في حدود ما يعين على تبليغ رسالته، قال الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى: ﴿إن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم﴾ قال: "وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ، جَلَّ وَعَلَا، فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي جَعْلِهِ بَنِي آدَمَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ هِيَ التَّعَارُفُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَتْ هِيَ أَنْ يَتَعَصَّبَ كُلُّ شَعْبٍ عَلَى غَيْرِهِ، وَكُلُّ قَبِيلَةٍ عَلَى غَيْرِهَا، قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، فَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ: لِتَعَارَفُوا لَامُ التَّعْلِيلِ، وَالْأَصْلُ لِتَتَعَارَفُوا، وَقَدْ حُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ؛ فَالتَّعَارُفُ هُوَ الْعِلَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْحِكْمَةِ لِقَوْلِهِ: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، وَنَحْنُ حِينَ نُصَرِّحُ بِمَنْعِ النِّدَاءِ بِالرَّوَابِطِ الْعَصَبِيَّةِ وَالْأَوَاصِرِ النِّسْبِيَّةِ، وَنُقِيمُ الْأَدِلَّةَ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ، لَا نُنْكِرُ أَنَّ الْمُسْلِمَ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِرَوَابِطَ نِسْبِيَّةٍ لَا تَمُتُّ إِلَى الْإِسْلَامِ بِصِلَةٍ، كَمَا نَفَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، أَنَّ عَطْفَ ذَلِكَ الْعَمِّ الْكَافِرِ عَلَى نَبِيِّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مِنَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [93\6]؛ أَيْ آوَاكَ بِأَنْ ضَمَّكَ إِلَى عَمِّكَ أَبِي طَالِبٍ.
هذا، ويضاف في هذا السياق إقرار الاختلاف بين الناس في نصوص قرآنية وحديثية عدة، مع الدعوة إلى استثمار هذا الاختلاف في تبادل المنافع وفي تحقيق التكامل بين الناس، مع دعوة المسلمين إلى تعلم لغات غيرهم حتى يسهل التواصل بينهم.
ـ ضوابط التعارف بين المسلمين وغير المسلمين:
إذا ثبت أن التعارف بين المسلمين وغيرهم مطلوب شرعا، فإنه ينبغي أن يضبط بضوابط تجعله يحقق مصالح المسلمين، ويدفع الضرر عنهم، ومن جملة هذه الضوابط:
ـ أن يكون منطلق هذا التعارف من ندية كاملة بين الطرفين حتى يتبين الحق وأصحابه.
ـ أن يكون هدف المسلمين من هذا التعارف هو تبليغ الدين للناس كافة وتعريفهم به.
ـ أن يكون من أهداف التعارف الإضافية الحصول على ما عند الآخر من معرفة ونفع لقوله، صلى الله عليه وسلم، في ما رواه عنه أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا[22]."
ـ أن يبتعد المسلم ممن لم يحصلوا قوة الفهم والمعرفة بالدين عن كل ما يُخاف منه على دينه وعقيدته، يقول أحد الدارسين: "كما أن الإسلام حرم المفسدات المعنوية للعقل من مخالطة المستهزئين، أو مطالعة ما يفسد العقل أو يشككه في دينه، أو يخلط عليه الحق بالباطل، من النظريات والمذاهب الهدامة المشككة في دين الله، والهادفة إلى إخراج الناس من دينهم وصدهم عن سبيل الله تعالى، ولهذا لما رأى النبي، صلى الله عليه وسلم، صحيفة من التوراة في يد عمر غضب، لما يؤدي ذلك إلى إفساد العقل المسلم، واختلاط الحق بالباطل[23]."
ـ أن يكون التعارف مع الآخر مبنيا على الحوار البناء بعيدا عن التعصب للرأي الشخصي الذي قد يصيب وقد يخطئ، وأن ينطلق في حواره من الأمور المشتركة، وأن يترك لغيره التوصل إلى الحق والاعتراف به منطلقا في ذلك مما تعلمناه من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (سبإ: 24).
قال الزحيلي في تفسير الآية الكريمة: "فلا سبيل إلى تصويب كل منا، فإما أن نكون نحن أو أنتم على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، والآخر مخطئ مبطل. وهذا أسلوب فيه لطف وأدب، لاستدراج الخصم إلى أن ينظر في حاله وحال غيره، ويستعمله العرب لإعطاء الحرية للمخاطب بأن يتأمل ويعلن عن قناعة أنه مخطئ وغيره مصيب، كما يقول الرجل لصاحبه: قد علم اللّه الصادق مني ومنك، وإن أحدنا لكاذب[24]."
ما يقصده الزحيلي من هذا الأسلوب يتعين اتباعه في أمور الاعتقاد، أما في غير ذلك فيتبع كما هو عن قناعة بأن الصواب يحتمل أن يكون مع أحد الطرفين فعلا دون سابق تعيين، على قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
الخلاصة
مما سبق يتضح أن التعارف مطلوب شرعا، وأنه قد يكون منه ما هو ضروري كما سبق عند الحديث عن علاقته بالكليات الخمس، وقد يكون منه ما هو حاجي عندما يتعلق بالعلاقات التي يقوم بها المسلم مع المسلمين ضمن تبادل المنافع من تجارة وصناعة وغيرهما، وقد يكون منه ما يتعلق بتبادل المعرفة في مجالات يشق على المسلم الاستغناء عنها مما سبقنا غير المسلمين إلى اكتشافه كما هو الحال بالنسبة، مثلا، لوسائل الاتصال، ومجال البحث العلمي في ميدان الطب وسائر ما يدخل في باب الحكمة التي يطلب من المسلم المواظبة على طلبها ومحاولة الظفر بها.
كما يمكن أن يكون التعارف من التحسينيات عندما يتعلق، مثلا، بالتعرف على عادات الأمم في العيش، والاعتبار بأحوالهم، وتعرف عظمة الخالق من مخلوقاته وعظيم صنعه، والاطلاع على مختلف مكونات الحضارة من خلال السياحة المباحة التي أمرنا بها الله تعالى في نصوص كثيرة كقوله تعالى في غير ما آية: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾.
هذا، وإن لم يكن التعارف مقصودا لذاته، فهو من المقاصد التابعة، أو ما سماه بعض الدارسين بالمقاصد الوسائل، حيث قال:" تنقسم المقاصد باعتبار أنها غاية أو وسيلة لغاية أخرى إلى قسمين مقاصد غائية، ومقاصد هي وسائل:
1.المقاصد الغائية
وهي التي تمثل غاية نهائية ليس بعدها غاية، وذلك كمعرفة الله تعالى، فهي غاية الخلق وتعلم التوحيد، ومثل دخول الجنة، فهي مقصد وغاية الخلق من التعبد لله رب العالمين بعد إجلاله وتعظيمه.
2. المقاصد الوسائل
وهى التي تكون غاية لأمر وفي نفس الوقت وسيلة لغاية أخرى فتعلم العلوم الشرعية وسيلة لغاية ومقصد وهى معرفة الأحكام الشرعية، وهذه مع أنها غاية إلا أنها وسيلة لغاية وهى التعبد لله تعالى بهذه الأحكام الشرعية والتزامها، وإقامة الطاعات، وهى الأخرى غاية وفي نفس الوقت وسيلة لغاية أعلى وهى الحصول على رضا الله تعالى وثوابه والنظر إلى وجهه الكريم في الجنة.
فاتضح أن المقاصد غايات ووسائل نسبية، فهي بالنسبة لما يوصل إليها غاية، وبالنسبة لما توصل إليه وسيلة[25]."
وإذا لم يتكرر في القرآن الكريم الأمر بالتعارف بشكل صريح، كما في سورة الحجرات، فقد عرفنا أن في الشريعة مجموعة من الأحكام كان التعارف علة لها، إضافة إلى أن ما كان من المقاصد داخلا في المعاملات التي للمكلف فيها مصلحة وميل فإن الله لم يوجبه بناء على أن النفس تشتهيه كما نبه إلى ذلك الشاطبي بقوله: "قد تحصَّلَ إذن أن الضروريات ضربان:
أحدهما: ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود، كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله، في الاقتيات، واتخاذ السكن، والمسكن واللباس، وما يلحق بها من المتممات، كالبيوع، والإجارات، والأنكحة، وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية.
والثاني: ما ليس فيه حظ عاجل مقصود، كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية". ثم قال: فأما الأول: فلما كان للإنسان فيه حظ عاجل، وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه، وكان ذلك الداعي قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك، لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه، بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب، بل كثيرا ما يأتي في معرض الإباحة، كقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة: 275)."
ثم قال عن الضرب الثاني: "مع أنا لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعا الترك لأثموا؛ لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب، فهذا من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الاكتساب، حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبعي أوجبه الشرع عينا أو كفاية، كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب، وما أشبه ذلك."
ثم قسمه إلى قسمين، قال: "فالحاصل أن هذا الضرب قسمان: قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة، كقيامه بمصالح نفسه مباشرة. وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير؛ كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد، والاكتساب بما للغير فيه مصلحة، كالإجارات، والكراء، والتجارة، وسائر وجوه الصنائع والاكتسابات، فالجميع يطلب الإنسان بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير، خدمة دائرة بين الخلق، كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا حتى تحصل المصلحة للجميع.
ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النفس المباشر، وهذه حكمة بالغة، ولما كان النظر هكذا، وكانت جهة الداعي كالمتروكة إلى ما يقتضيه، وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم، بل هو على الضد من ذلك أكدت جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنيا، والإبعاد بالنار في الآخرة؛ كالنهي عن قتل النفس والزنى...[26]."
يلاحظ أن التعارف يدخل ضمن ما للمكلف فيه حظ عاجل، لما سبق بيانه، وهو يدخل ضمن القسم الثاني؛ لأنه يؤدي إلى تحقيق مصالح الإنسان بواسطة الغير، لنقص الإنسان وسعيه دائما إلى تكميل نقصه بما عند الآخر، وفق سنة الله في الخلق التي اقتضت اختلاف الناس في المواهب والقدرات والطاقات، حتى يكون سعيهم دائما ودؤوبا نحو التكامل في الأدوار، فكان التعارف مقصودا من مقاصد الخلق والتشريع معا، والله تعالى أعلم.
الهوامش
[1]. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، 2/61.
[2]. النورسي، كليات رسائل النور، اللوامع، ص876.
[3]. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، م، س، 2/8.
[4] . الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص56.
[5]. الموافقات، م، س، 2/409-5/410.
[6]. المصدر نفسه، 2/6-414.
[7] . مقاصد الشريعة، م، س، ص17-19 بتصرف.
[8] . المرجع نفسه، ص378.
[9] . المرجع نفسه.
[10] . تفسير المنار عند تفسير الآية 2 من سورة يونس.
[11]. التفسير المنير، ج26، ص259.
[12]. من تأليف عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
[13]. سيد قطب، في ظلال القرآن، 6/3348.
[14] . الفيومي (توفي 770)، المصباح المنير، عرف.
[15] . ابن منظور (ت 711)، لسان العرب، عرف.
[16] . الموافقات، م، س، 2/396-397.
[17] . الموافقات، م، س، 2/181.
[18] . محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا، ص287.
[19] . الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما وهذا لفظ الموطإ.
[20] . مسند الإمام أحمد من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، وجاء في المعجم الأوسط والكبير للطبراني بألفاظ متقاربة.
[21] . المحرر الوجيز، 5/153.
[22] . أورده والترمذي، وقال عنه:"هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ" كما أورده بقريب من هذا اللفظ ابن ماجة، وضعفه الألباني.
[23] . محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا، م، س، ص315.
[24] . التفسير المنير، م، س،.
[25] . محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا، م، س، ص288.
[26] . الموافقات، م، س، 2/180-182.