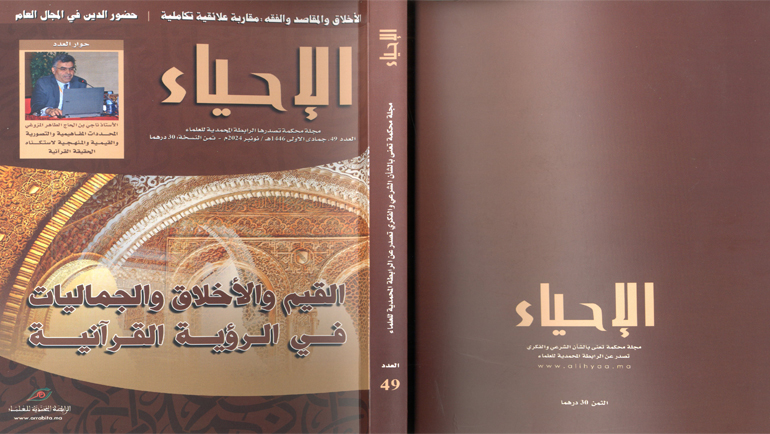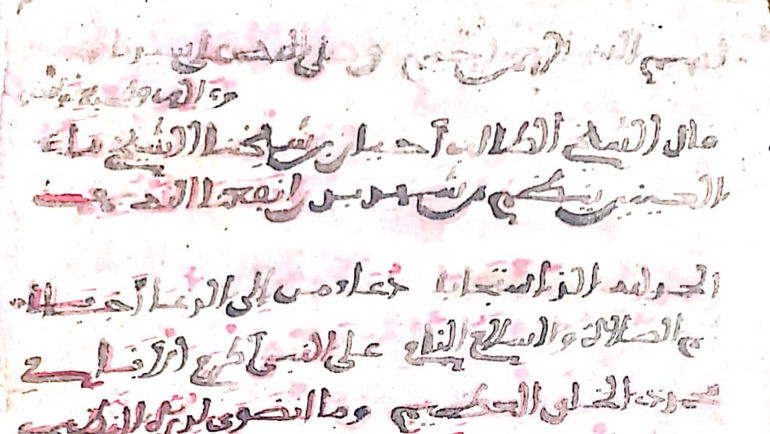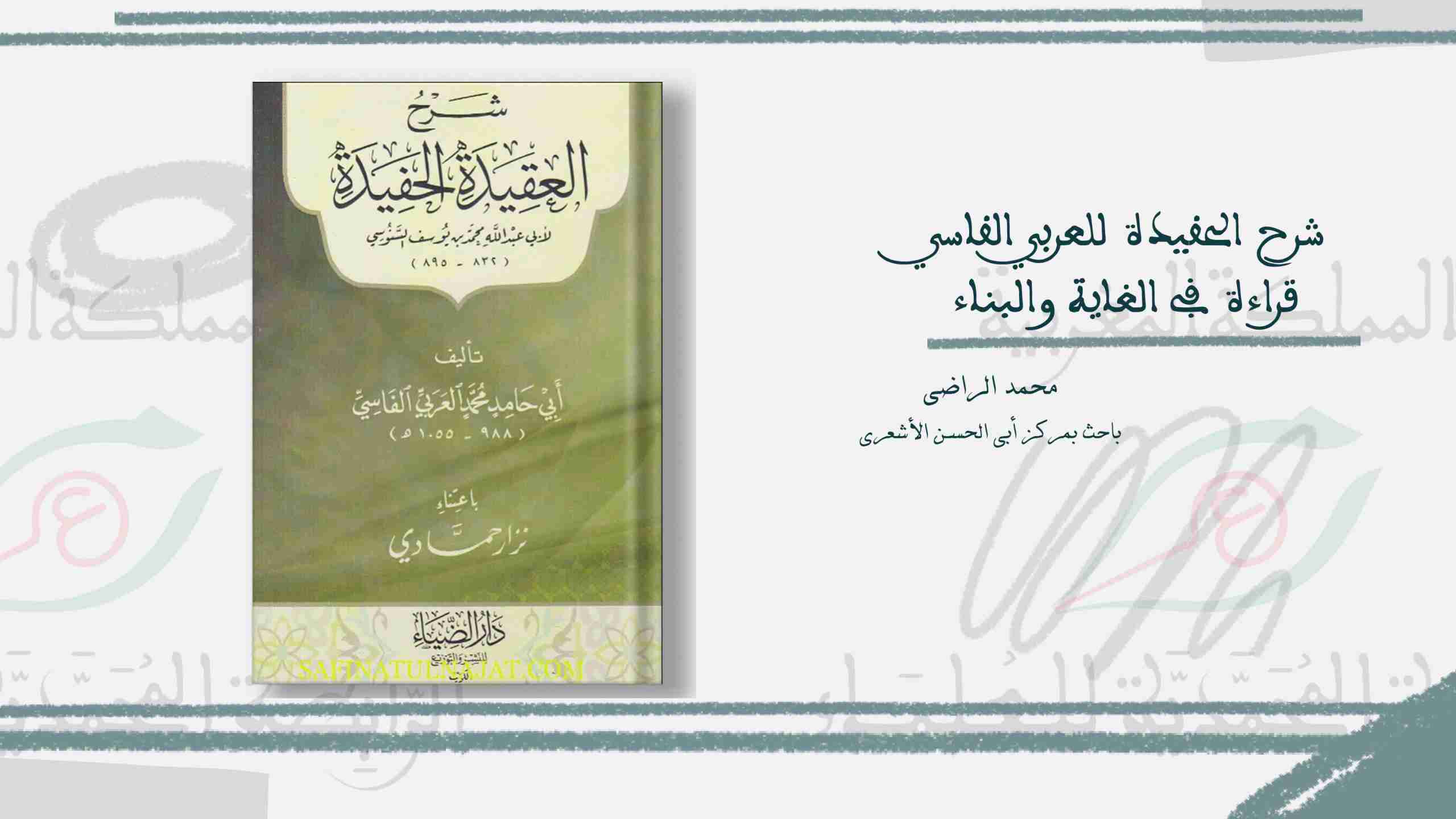معالم الأصالة والإبداع في الشروح والتعاليق العلمية المتأخرة (أعمال شمس الدين الخفري 956 هـ/1550م)

المؤلف: جورج صليبا
الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 2015 م، 169 ص.
نشير بداية إلى أن الكتاب في أصله عبارة عن محاضرة ألقاها المؤلف باللغة الإنجليزية بمقر مؤسسة الفرقان بلندن بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2012 وقد نشرت الصيغة الإنجليزية على شكل كتيب صغير. أما عن الصيغة العربية التي بين أيدينا فليست ترجمة للنص الإنجليزي، وإنما هي عبارة عن إعادة صياغة للنص الأصلي، بقصد ملاءمته مع "الخلفية المعرفية" للقارئ العربي حسب رأي المؤلف[1]، ولكي يكمل ويتمم النواقص التي تعتري النسخة الإنجليزية ويصحح الهفوات التي طالتها. لذا يمكن القول بأنه "إذا ما قورن [النص العربي] بالنص الإنجليزي تراه أغزر مادة؛ إذ حجمه الحالي، بحلّته العربية، يكاد يكون ضعف حجمه بالإنجليزية تقريبا. وهو الآن أكثر تناسقًا مع الكلمة العربية المكتوبة البعيدة بعض البعد عن لهجة الخطابة المتبعة في المحاضرات"[2]. أما في ما يتعلق بالرسوم التوضيحية المرفقة بالكتاب فقد بقيت هي نفسها في النسختين مع اختلاف طفيف يتعلق بإعادة رسم بعضها كي تُلائِمَ الصيغةَ العربيةَ من الكتاب.
يشير المؤلف في مقدمة الكتاب إلى أن المؤرخين قد دأبوا على تقسيم التاريخ الفكري للحضارة العربية الإسلامية إلى أربع مراحل كبرى، وهي كالتالي: مرحلة أولى سابقة على ظهور الإسلام ومتزامنة مع نشأته، مرحلة ثانية تبتدئ بنشأة الإسلام وتنتهي بقيام الدولة العباسية، ومرحلة ثالثة سُميِّت بـ"عصر الإسلام الذهبي"، وقد ابتدأت مع قيام الدولة العباسية وانتهت بنهاية هذه الدولة على يد المغول سنة 656 هـ/1258م. أما المرحلة الرابعة فهي ما اصطُلح على تسميتها بـ"عصر الانحطاط"، وقد اختلفت وتضاربت الآراء حول أسباب وعوامل هذا التراجع الفكري والتدهور العلمي. يأخذ المؤلف بعد ذلك في الحديث عن بعض الآراء والمذاهب التي ذهبها المؤرخون في تفسير أسباب هذا "الانحطاط" مع ذكر لمجموعة من مظاهره وكذا التعليق عليها (الآراء) من خلال مساءلتها عن طريق بعض المعطيات التاريخية والحقائق العلمية الواضحة، ونذكر في ما يلي عن هذه وتلك بعض الأمثلة. يُرجع بعضهم المؤرخين أسباب التدهور إلى الغزو المغولي الذي أتى على البلاد والعباد، لكن المؤلف يؤكد أنه رغم الطابع السلبي الذي خلفه الغزو المغولي على حيوية الفكر الإسلامي، إلا أن ذلك لا يسوغ القول بأن هذا الفكر قد انطفأت جذوته بعد هذا الغزو، والشاهد على ذلك هو تلك الآثار الفكرية (الكتب المخطوطة) المُنجزة في فترات تاريخية لاحقة على الغزو المغولي والتي لا يزال عدد منها محفوظا حتى يومنا هذا في مُعظم مكتبات العالم، والجدير بالذكر أنها "تشير إلى مرونة تلك الحضارة ومقدرتها على استعادة لَمِّ شملِها وإعادة بناء ذاتها رغم العثرات والكوارث التي ألمّت بها..."[3]. هذا في حين ذهب بعض المؤرخين إلى أن السبب لم يكن خارجيا بقدر ما كان داخليا، وقد تجلى في تلك الصراعات الداخلية والتقلبات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الحضارة العربية الإسلامية آنذاك. ويعمل هؤلاء المؤرخون على تعزيز قولهم بانتقاء بعض المظاهر المعينة للتأكيد على "أن السبب الرئيسي لبدأ عصر الانحطاط لابد وأن يكمن في ظهور الفورة العارمة للفكر الديني الذي رفع رايته الإمام حامد الغزالي (555 هـ/1111م) بكتابيه الشهيرين 'إحياء علوم الدين' من جهة... و'تهافت الفلاسفة' من جهة أخرى".[4] ويستدل هذا الفريق من المؤرخين على رأيهم بمستويات مختلفة، فنجدهم يؤكدون ضآلة الإنتاج الأدبي بعد الفترة التي عاش فيها الغزالي، إضافة إلى الاستشهاد بظهور بعض الأنماط الأدبية التي تتميز بـ"لغتها المصطنعة" كفنّ المقامات. كما أشار المؤلف إلى بعض المظاهر الأخرى لهذا الانحطاط من خلال تساؤلات استنكارية، حيث أشار إلى الدور السلبي التي لعبته بعد المدارس في قتل "التفكير الخلاّق المستقل" لصالح 'برامج دراسية تُحفظ عن ظهر قلب'، هذا بالإضافة إلى انتشار الحركات الصوفية التي تدعو –حسب أولئك- إلى تعطيل الأساليب العلمية القائمة على القوانين الطبيعية والإشادة بـ"الغيبيات" و"الشطحات الروحية"...
يعمل المؤلف بعد ذلك -في سبيل الاعتراض على هذه الآراء- على محاولة إعادة تصويب الكيفية التي يجب من خلالها النظر إلى هذا العصر، بعبارة أخرى فإنه يعمل على "إعادة تصويب منهج البحث' حسب تعبيره، حيث يشير إلى أن جل تلك الآراء تنطلق من أحكام مسبقة أصبحت اليوم بمثابة مسلمات غير قابلة للمساءلة أو المناقشة، ومفادها أن الحضارة الإسلامية ازدهرت فقط لمدة قرنين أو ثلاثة لتشهد عصر انحطاطها ابتداء من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلاديين. لكن السؤال الذي ما فتئ يطرح نفسه هنا هو التالي: كيف يمكن أن نفسر ذلك "الإنتاج الضخم" الذي شهدته تقريبا جميع العلوم وتوزع على مناطق جغرافية مترامية الأطراف من الحضارة العربية الإسلامية واللاحق لفترة الغزالي/ فترة الانحطاط؟ لا يتحدث المؤرخون في كثير من الأحيان عن هذا الإنتاج العلمي، وحتى إن هم ذكروه فإنهم لا يذكرونه إلا على سبيل التمثيل به على مظاهر ذلك الانحطاط، حيث يعتبرن أنه لم يكن سوى تكرار لما سبق أو شرحا لما تقدم من إنتاج فكري وتعليقا عليه.
إن العودة إلى التراث الفكري المكتوب (المخطوط) في هذه الفترة والمبثوث في جل مكتبات العالم ليَشْهَدُ على خلاف ذلك، لذا لابد لنا من العودة إلى هذه المصادر عينها إن نحن أردنا لحكمنا أن يكون دقيقا وذا مصداقية. وهذا لم ليس بالأمر الهين ولا اليسير، إذ يُقر المؤلف بضرورة تضافر الجهود وتعاضد السواعد كل في مجال تخصصه، وعندها يمكن لنا أن نقرر مدى إبداعية وأصالة الإنتاجات اللاحقة على فترة الغزالي من اجترارها وتبعيتها لما سبقها. أما في ما يخص مجال اختصاص المؤلف، وهو تاريخ العلوم الفلكية (وخصوصا بنظريات حركات الكواكب)، فقد ثبت له بعد عشرين سنة من البحث والتمحيص في نظريات حركات الكواكب أن هذه الفترة تفوق أصالة وإبداعا جميع الفترات السابقة لهذا العصر (أي عصر الانحطاط)، وبذلك يمكن القول دون مُشاحة أن الفترة اللاحقة للغزالي كانت "بحق وجدارة فترة العصر الذهبي الأكثر إنتاجا للنظريات الفلكية في الحضارة الإسلامية"[5]. بل إن المؤلف ليذهب أبعد من ذلك حين يَعمد إلى اتخاذ الشروح والتعليقات، التي نُظر إليها سابقة كمظهر من مظاهر عصر "الانحطاط"، كنقطة ارتكاز يبين من خلالها وبالدليل الملموس مدى الإبداعية والأصالة التي انطوت عليها هذه الشروح، وليبرز في الآن نفسه أن هذا النمط من الكتابة والتأليف كان هو النمط "الطبيعي" الذي يلجأ إليه الكتاب آنذاك للتعبير عن أفكارهم وآرائهم المتسمة بالإبداعية والجدة.
يختار الكاتب لهذا الغرض واحدا من علماء الهيئة "المبدعين"، وهو "شمس الدين الخفري" 956 هـ/1550 م، الذي بقي مغمورا إلى أن كشف المؤلف عن عبقريته من خلال مجموعة من المقالات التي بين فيها مدى الجدة والأصالة التي ميزت إسهاماته في مجال علم الهيئة. كان هذا العالم يهدف، شأنه شأن باقي علماء الفلك الإسلاميين، إلى إدخال تعديلات على علم الفلك اليوناني قصد تفادي الهفوات التي كانت تعتريه. ورغم ما أدخله هؤلاء من تعديلات على الفلك البطلميوسي إلا أنهم كانوا على وعي تام بأن الإصلاحات التي يجب إدخالها كانت نسبيا أهم وأكثر بكثير مما تم حتى ذلك الوقت. وقد تمثلت المعضلة الأساسية التي واجهتهم في ضرورة إيجاد هيئات رياضية جديدة، غير بطلمية، تتلاءم مع الأرصاد وتساهم في التنبؤ بمواقع الكواكب للزمن الذي أرادوا، ولابد لهذه الهيئات أن تبقى منسجمة مع الكوسمولوجيا الأرسطية التي كانت مهيمنة على مجمل العصر الوسيط.
ضَمَّن الخفري معظم أفكارهِ المبدعة تعليقاته وشروحه التي كتبها كتعقيبات على أعمال كلٍّ من بطلميوس ونصر الدين الطوسي والجرجاني والشيرازي، وكان يهدف إلى جعل هذه الشروح بمثابة "مقدمات" لعمل آخر سيختم به مسيرته في علم الهيئة، وهو كتاب "حلّ ما لا ينحل" الذي لا يجب النظر إليه كشرح ضمن باقي الشروح العلمية، حيث طمح الخفري منذ البداية إلى جعله بمثابة "عصارة" أو"زبدة" لأعماله الفكرية السابقة. بعبارة أخرى، فقد أورد الخفري في هذا الكتاب جُل الأفكار "النقدية الإبداعية" التي سبق وأن ضمّنها شروحه وتعاليقه السالفة، بل إنه لم يقف عند حد نقد ومراجعة ما ألفه غيره، بل إنه كان يعود لآراء وأفكار سبق أن قدمها بنفسه ليمحصها وينتقدها، سواء كانت من بنات أفكاره أو من إبداع غيره.[6]
يأخذ المؤلف بعد ذلك في استفاضة الحديث عن الدور المهم الذي لعبه نصير الدين الطوسي في تاريخ علم الفلك بعد إدخاله لما سيُعرف بعد ذلك بـ"مزدوجة الطوسي" قصد حل أبرز إشكال كان يعترض الفلك البطلميوسي، وهو الجمع بين الحركة الدائرية المنتظمة وما تؤكده عملية الرصد من تأرجح للكواكب، أي إقبالها وإدبارها. كما يشير المؤلف بعد ذلك إلى امتداد هذه النظرية خارج سياق الثقافة العربية الإسلامية حيث نعثر عليها مرة أخرى لدى أحد مؤسسي علم الفلك الحديث، وهو الفلكي الشهير كوبرنيكوس في كتابه "دوران الأفلاك السماوية"، عاملا المؤلف في نفس الآن على تقديم بعض الأدلة على تأثر كوبرنيك بمزدوجة الطوسي. رغم أهمية إسهام هذا الأخير إلا أنه واجه بعض العوبات التي لم يستطع إيجاد حلول لها أو تجاوزها، حيث يشير في خاتمة كتابه "التذكرة" إلى عجزه عن حل الإشكالات التي تتعقل بحركات كوكب عطارد، وهذا الأمر لن تتم وضع حلول له إلا مع عالم فلكي آخر هو شمس الدين الخفري.
كان الخفري على وعي تام بأنه يستكمل مشروعا سبق أن دُشِّن قبله بقرون، لكن عبقريته تتجلى في استطاعته تركيب علاقات هندسية تبرر ما يلاحظه الراصد من حركات الكواكب، وبذلك فقد تمكن من الجمع بين التصور الكوسمولوجي الذي سبق أن تبناه بطلميوس وبين نتائج الأرصاد التي تم تحصيلها منذ زمن بطلميوس إلى حدود تلك اللحظة. وسيقدم أربعة حلول لمشكلة عطارد تتميز كلها بمطابقة النتائج الرياضية لنتائج الأرصاد. ولا يعني حديث المؤلف على الحلول التي قدمها الخفري لعطارد أن هذا الأخير لم يقدم حلولا لباقي "الكواكب العلوية"، أي زحل والمشتري والمريخ والزهرة، ولكن المؤلف اختار نموذج عطارد لما يبدو فيه من وضوح لأصالة وإبداع الخفري، أي إنه مجرد اختيار إجرائي وشاهد أمثل على عبقريته الفذة.
سيؤلف الخفري إضافة إلى كتاب "التكملة في شرح التذكرة" كتابا آخر سماه "منتهى الإدراك في مدرك الأفلاك" وهو بمثابة شرح لشرح، أي إنه شرح على كتاب التحفة الشاهية لقطب الدين الشيرازي الذي يشرح فيه بدوره كتاب التذكرة لنصير الدين الطوسي. ويذهب المحاضر إلى أن اختيار الخفري لشرح الشرح كان مقصودا، وكأنه أراد أن يبرز لنا كيف أنه يستطيع أن يتفوق على آخِرِ ما كُتِب وآخر ما تَمَّ التوصل إليه من خلال تمكنه من تجاوز الصعوبات التي وقف عندها سابقوه. وكما سبق أن ألمحنا فإن الخفري كان يعي تماما أن ما قدمه "لم يكن شرحا وتفسيرا واجترارا لما جاء سابقا على ألسنة القوم. فالشعور العميق بأنه يؤلّف عملا جديدا لم يُسبَق إليه واضح جدا ولا يحتاج إلى تكرار هنا".[7] كما يدل أيضا عنوان كتابه الأخير، وهو المسمى "حل ما لا ينحل"، على أن الخفري كان واعيا تمام الوعي أنه يأتي بجديد لم يُسبق له إلى حدود تلك اللحظة.
لم يعمد الخفري في كتابه ذاك إلى ذكر المسائل الابتدائية التي كان قد أوردها في كتب الشروح، وإنما يفترض هذا الكتاب ويقتضي من القارئ إلماما بالشروح السالفة، ومن الراجح أن طابع الكتاب المتخصص والمعقد بالنسبة لطلبة العلم العاديين كان وراء عدم انتشاره وغياب نسخ مخطوطة كثيرة منه. كما أشار المؤلف أيضا إلى الكيفية التي نظر بها الخفري إلى طبيعة ودور الرياضيات بالنسبة لعلوم الطبيعة، حيث نظر إليها من جهة تناسقها كلغة وصفية، وبذلك فإن الرياضيات لا تهتم بطبيعة الظواهر بقدر ما تتهم بوصفها فقط. وبذلك فهو عندما يقدم أكثر من هيأة رياضية لوصف حركات الكواكب فإنه يعتبرها متكافئة (الهيئات الرياضية) في ما بينها وإن اختلفت في كيفية الوصف والتنبؤ، "ففي ذهن الخفري، جميع هذه الحلول الرياضية تفي بالمطلوب فعلا وتصف كيف يوافق الحساب العيان وكلها على نفس المستوى من الصحة إذ لا فضل لواحد من الحلول على الحلول الأخرى وليس بينها حلٌّ وحيدٌ لا يجاريه حل آخر".[8] بل إن الخفري ليذهب لحد القول بأن الحلول الصحيحة "لا نهاية لها" مقدما أمثلة عديدة على الكم الكبير الذي يمكن أن يستنبطه علماء التعاليم من الأدوات الرياضية. لهذا يُقرّ المحاضر بأن "هذه النظرة الجديدة إلى الرياضيات، ودورها في إطار علوم الطبيعة تكاد تبدو بمنتهى الحداثة، ولم يكن يتوقعها أحد من قبلُ".[9]
لذا يمكن القول ختاما أنه لن يكون من الانصاف أن نصف هذه الفترة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بالانحطاط والتدهور الفكري والعلمي، فقامة علمية من قامة شمس الدين الخفري تثبت من خلال إسهامها المميز والمبتكر في علم الهيئة أن فعل التجديد والإبداع لم ينقطع حتى في هذا العصر الذي سُمي من قِبل بعض المؤرخين بـ"عصر الانحطاط".
[1] - يقول المؤلف: "... فالقارئ العربي مثلا لا يشارك عادةً في الأبحاث التي تزخر بها اللغات الأوروبية ولذلك لا تتراكم لديه المفاهيمُ الأساسية والمصطلحات والمحطات الفكرية التي تكوّ الخلفية المعرفية لأي علم أو حقل معرفي حيث تكون هذه المصطلحات بمتناول القارئ الأوربي بشكل بشكل بديهي. ولكنها عندما تتُرجم تُصبح بحاجة إلى إعادة صياغة بالنسبة لقارئ اللغة التي يُتَرجَم العمل إليها". معالم الأصالة، ص 17.
[2] - جورج صليبا، معالم الأصالة والإبداع في الشروح والتعاليق العلمية المتأخرة، ص 18.
[3] - نفسه، ص 21.
[4] - نفسه، ص 23
[5] - نفسه، ص 32.
[6] - نفسه، ص 60.
[7] - نفسه، ص 118.
[8] - نفسه، ص 160.
[9] - نفسه، ص 163