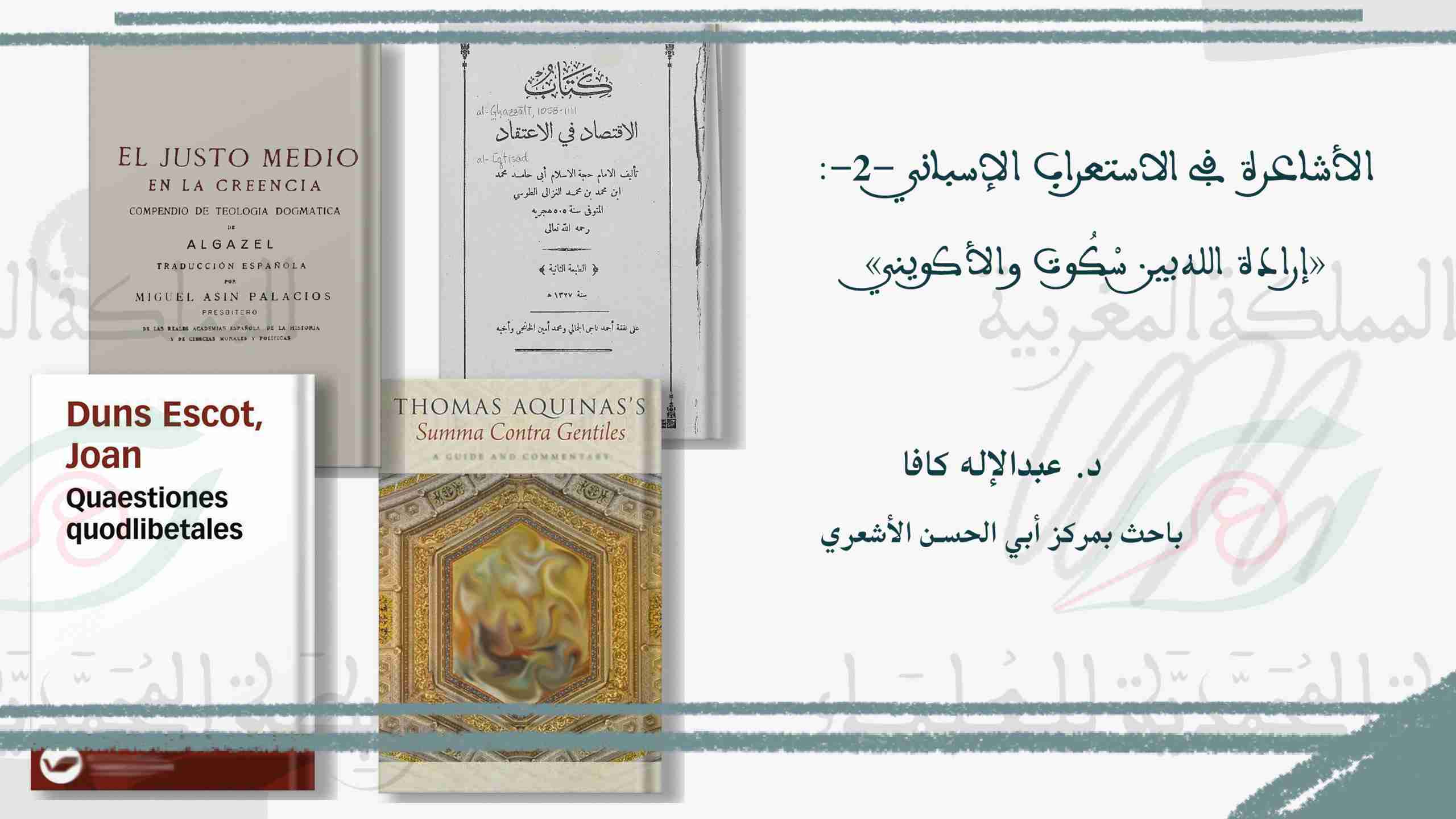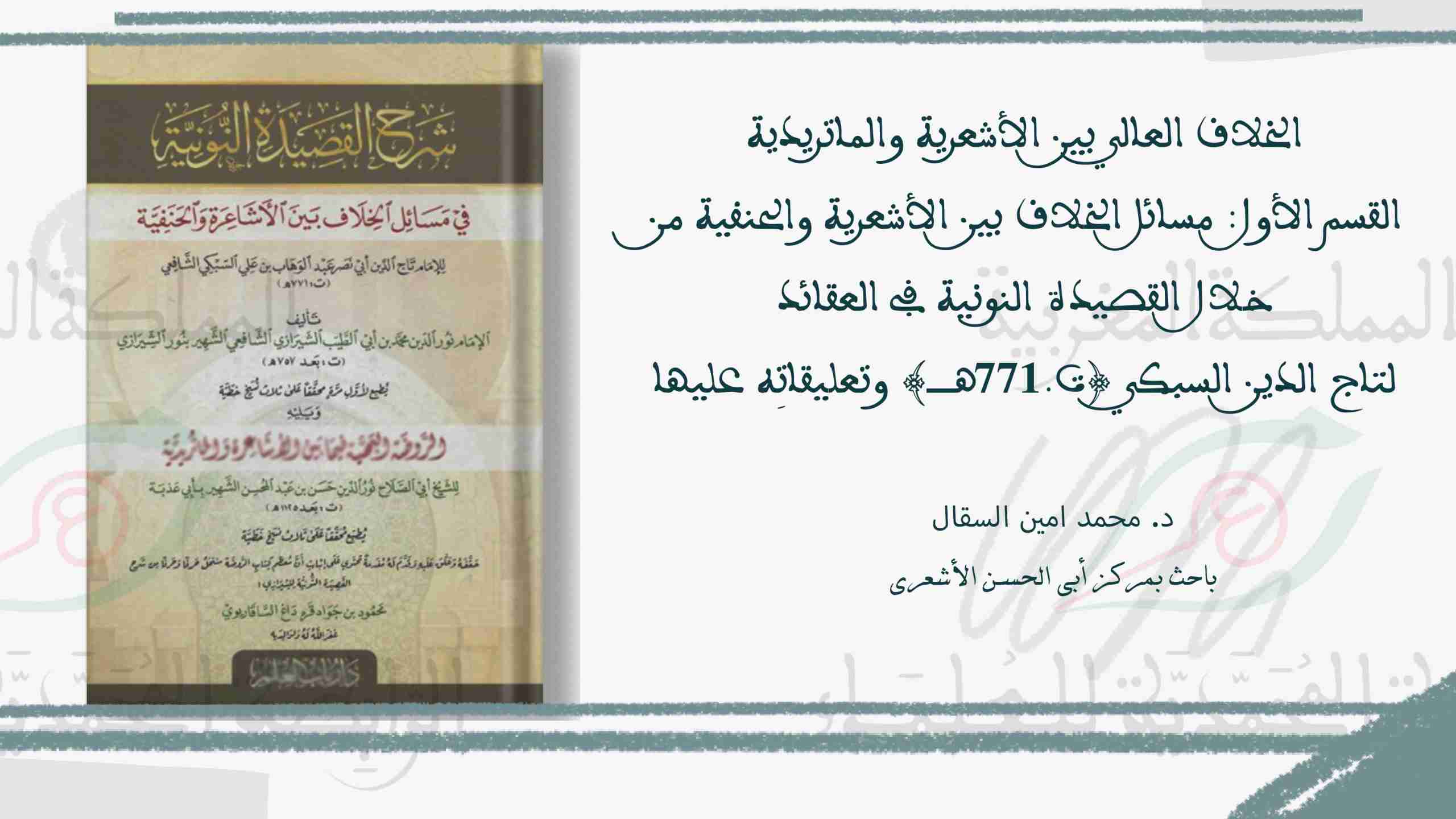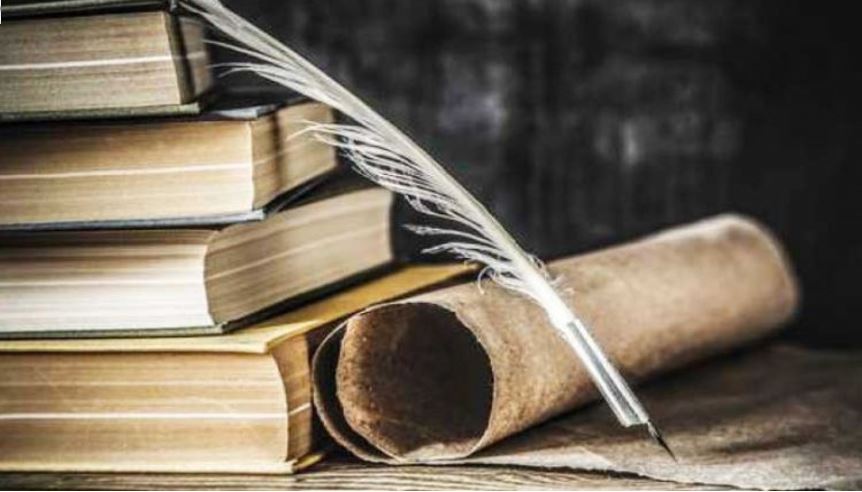معالم استلهام روح فلسفة المناظرة الإسلامية.. منزلة النقد الحواري من العقل التشاوري

من الحقائق الثابتة في نطاق فلسفة العلوم وتاريخ المعرفة أن النقد (Critique/cism) المستمر أصل من أصول الحياة الإنسانية الواعية، وشرط من شروط حركية الواقع البشري في مختلف مجالات ونظم القيم والاجتماع والمعرفة، وأصناف التفكير والإنجاز والتصرف. وتبعا لهذا يغدو النقد ممارسة عقلانية ونمطا فكريا تفكيكا استنطاقيا. وبما هو مساءلة وتحليل ومراجعة للأفكار والوقائع والأفعال التي تنطلق من معايير معينة، ووفق شروط محددة، فإنه يتيح –من ضمن ما يتيحه- خلق سياقات معرفية جديدة، ومناخات ثقافية متباينة، ومساحات فكرية مغايرة، ومن ثمة الإسهام في الانفتاح على آفاق جديدة للنظر، واختلاق مهمات عديدة للعمل؛ "فتاريخ الفكر البشري كما مثلته الحضارات القديمة والحديثة هو تاريخ النقد بامتياز. فالنقد هو أداة التحول والانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى، ساهمت فيه كل الحضارات، وأسسه الأنبياء والمفكرون والعلماء. النقد شرط الإبداع، والإبداع شرط التقدم والنهضة[1]."
وعندما نقول "النقد" فالمقصود ذلكم المفهوم المتنقل بين مختلف المجالات، المرتحل عبر كل شبكات المفاهيم وأساليب النظر والعمل، وليس النقد بمفهومه التقليدي الزائل، من حيث كونه بحثا عن الهفوات والسقطات، وإصدار أحكام القيم بقصد الهدم والنقض: أي من حيث هو "فعل" ضيق المسار، وحيد الوجهة، وعليه فهو يبتعد عن موضوعه أكثر مما يقترب منه.
إن مفهوم النقد كما نريد توضيحه هاهنا، مفهوم محايث لتفكير الإنسان ونظره، وممارسته وفعله. إنه يلحق مفاهيم وتصورات الفكر والعمل والسلطة والمجتمع والدين بحثا عن مناطق المسكوت عنه والمحتجب واللامفكر فيه. ومن ثمة الكشف عن "اللامعقول" في عقولنا، وعن المعقول في "اللامعقول[2]" عبر إحلال الاعتراف محل الإقصاء، ووضع "الممكن" موضع "القائم" (الكائن) على سبيل التفكيك والتحليل، والقراءة والتأويل.
إن المطلب الأساس من عقد هاته "الألفة النقدية" مع الشيء أو الفكرة إذن، مطلب مزدوج: ليس التهرب من الاقتراب الحقيقي من الظاهرة (الموضوع)، ولا الاقتراب من التهرب الفعلي منها، إنه الاقتراب من الموضوع والابتعاد عنه، والاتصال به والانفصال عنه في الآن نفسه.
فالانخراط في "الظاهرة" –أيا كان نوعها- واقتحامها ضرورة لكل فعل نقدي لأجل مقاربتها عن قرب، وفهمها كما هي، وتفكيكها بشكل منسجم، فيما الانفصال عنها يجعل معاينتها والكشف عن تناقضاتها وتعارضاتها (الداخلية) أمورا ممكنة.
نمطان من النقد
بعيدا عن المدارس النقدية المعروفة، وتيارات النقد الموجودة، وبعيدا، أيضا، عن علومه وموضوعاته (نقد الدين، نقد المجتمع، نقد الإيديولوجيا، نقد المذاهب، نقد النصوص الأدبية، نقد الفكر، نقد النقد...إلخ)، يمكن التوقف اعتمادا على نظر لغوي –تداولي- عند توجهين نقديين أساسيين تثوي خلفهما فلسفتـان متعارضتـان:
الأول: نقـد مونولوجـي (نسبـة إلـى المونولـوج: Monologue: أي الحوار الأحادي)؛ وتوجهــه فلسفة الوعي (أو فلسفة الذات).
فيما الثاني: "نقد حواري" وتوجهه فلسفة التواصل (La philosophie de communication)
1. النقد "المونولوجي"
هو "فعل" (Acte) مركوز في نطاق عقلانية منكفئة على نفسها، مكتفية بذاتها. فالمعرفة المتولدة عنه أقرب إلى السكون والثبات منهما إلى غيرهما، لكونها صادرة عن نظر أحادي ومنطق دوغمائي وثوقي لا يؤمن إلا بما يعرف تقديسا وتمجيدا، أو اجترارا وتكرارا. مما يقوض إمكانات تفاعل هاته الذات مع غيرها، وتواصلها مع ما سواها، بقصد التجديد والتطوير أو التحويل والتحوير. ومن ثمة تتقوى دواعي الاستئثار في نفس صاحبها، ويبتعد عن التعاون والمشاركة المأصولين بروح وطبيعة الجماعة. لذا يكون مقام إنتاج المعرفة النقدية، هاهنا، مقاما استعلائيا انعزاليا مقطوع الصلة بمفهومي الاتفاق والتداول اللذين تقتضيهما المعرفة (عامة) اقتضاء، ويقرهما العقل الجمعي إقرارا.
ولعل "التصور الوهم" الكامن وراء هذا النمط النقدي منبن على مبدإ كون البحث عن الحقيقة لا يتأتى إلا في حيز وعي ذاتي فردي مجرد ومنعزل، باعتباره وعيا مستقلا بذاته، قادرا على بلوغ الحق والوصول إلى الصواب[3]."
ولا يخفى هنا، ما لهذا التوجه من آفات ونقائص ناتجة، تحديدا، عن تعطيل "قاعد في التحاور والتذاوت" من حيث هما شرطان أساسيان من شروط وجود الذات وخصيصتان من خواصها الاجتماعية والمعرفية.
على هذا الأساس فـ"الناقد المونولوجي" وهو يمارس التفكير (النقد) في موضوع من المواضيع، أو ظاهرة من الظواهر أو قضية من القضايا، ويقلب نظره فيها، قراءة وتفسيرا وتحليلا، لا يعدو أن يكون، إما موظفا لمفاهيم الإذعان والولاء وميكانيزمات التماهي والتطابق (الاتفاق المطلق)، وإما مقدسا للأنا، معتقدا بطهرانية الذات التي هي –في نظره- مركز الحقيقة ومصدر اليقين (الاختلاف المطلق).
وفي كلتا الحالتين فهو يقرأ بعقلية اليقين التي لا تقبل باقتسام الحقيقة ولا حتى الاشتراك في البحث عنها. إنه لا ينظر إليها إلا على نحو ما "يعتقد"، ولا يفسر الأشياء إلا وفق ما يراه، بمنأى عن المحاججة العقلانية والمحاورة الديمقراطية اللتين تجعلا النقد بناء للإمكان وليس تكريسا للكائن (القائم)، من خلال نبذ المختلف واستئصال الآخر معرفيا ومعنويا، مخافة خوض المغامرة النقدية (الفكرية) بما تستلزمه من تحرر وانفتاح وحوار، وما قد ينجم عن ذلك من تكسير أصنام الأفكار الموروثة، وخرق سياج المواقف الثابتة، والآراء المتراكمة، بوصفها تشكل مجد الذات وقوتها ومناعتها التي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تضعف أو تهتز.
وتبعا لهذا تغدو "العقلانية المونولوجية" أقرب ما تكون إلى القاعدة التصورية الحاملة "للعقل الأداتي" (Raison instrumentale) من جهة اتحادهما في الخصائص الآتية:
ـ النظر إلى الواقع من منظور التماثل وإبعاد أي اهتمام بالخصوصيات؛ أي البحث عن السمات المتطابقة في الأشياء وإهمال الصفات المميزة لظاهرة عن أخرى؛
ـ تفتيت الواقع إلى أجزاء غير مترابطة دون إعادة تركيبه إلا من خلال نماذج تبسيطية اختزالية، مسنودة –غالبا- بنظر ضيق ومنطق متخشب؛
ـ السقوط في النسبية المعرفية والأخلاقية والجمالية، مما يؤدي إلى بروز حالة من اللامعيارية الكاملة التي لا تقود إلا إلى تقبل الأمر الواقع، والتمسك بالوضع الكائن، مما يعني تثبيت دعائم الأفكار والمعتقدات والعلاقات السائدة، من جهة، وكبت أية نزعات إبداعية قد تتجاوز ما هو مألوف، أو تنفتح مع ما هو ممكن[4].
إن النقد المونولوجي –كما العقل الأداتي- يبدو عاجزا عن قراءة الواقع كما يجب، واستنطاق النصوص على نحو معقول مقبول، أو الاقتراب من الظواهر اقترابا فعَّالا ومنتجا، بل إنه غير قادر حتى على التواصل مع ما سواه المختلف عنه، المغاير له، لانتفاء شرط التحرر عنه أولا، ورسوخ مبدإ الوثوقية والمطابقة فيه ثانيا. وغير خاف أن "الحرية" و"الاختلاف" مدخلان أساسان لكل فعل تواصلي، ومنطلقان مركزيان لأية علاقة حوارية مجدية، بل إنهما ميزتا الفكر نفسه، فالفكر حر بطبيعته حتى في أشد الظروف الاجتماعية والسياسية قهرا وتسلطا؛ والعقل بطبيعته –الحرة الاختلافية- يسأل قبل أن يجيب، ويتساءل قبل أن يستلهم، ويتشكك قبل أن يحكم، بهدف التشكيك في الوضع القائم، معرفة وسلوكا من أجل تصور رؤية أكثر دقة وأكثر قربا من ماهيات الأشياء والظواهر، وربما عللها[5].
وكلها أمور لا تحقق إلا في سياق تواصلي، وفضاء حواري، ونطاق تفاعلي، كشروط لممارسة نقدية حوارية قوامها التخطي والتجاوز عوض التماهي والتطابق، والتحويل والتحوير، بدل الترديد والتكرار.
2. النقد الحواري
قبل أن نباشر القول في تطبيقات المفهوم ومفعولاته، ودلالاته وأبعاده، نود الإشارة إلى بعض التأصيلات التاريخية والمعطيات السياقية المرتبطة به، حرصا على مبدإ الأمانة العلمية الموصولة بالذات من جهة، وحفظا لقيمة الاجتهادات والأطروحات المقرونة بالغير، من جهة ثانية.
فمفهوم "النقد الحواري" ليس مفهوما جديدا في مجال التداول الثقافي لدرجة يمكن تصوره من منتجات الفكر الحداثي المحض، كما أنه ليس قديما لحد يجوز عده من منجزات "الفكر التاريخي" الصرف. إنه مفهوم حداثي تنظيرا وتصورا، كما أنه تاريخي تراثي أجرأة وتطبيقا، (على نحو ما توحي بذلك العديد من الممارسات التخاطبية التواصلية الضاربة في القدم من قبيل محاورات أفلاطون وأرسطو عجميا، ومناظرات المتكلمين والفقهاء عربيا).
وعلى هذا الأساس فـ"التفاعل الحواري" مع النصوص وقراءتها وفق "منطق تحاوري" قد يكون سلوكا معرفيا سبق فيه التطبيق التنظير، وتميز فيه الحضور العملي عن التجلي الإدراكي (المعرفي)، لكون اللغة حوارية بطبيعتها، تفاعلية بجوهرها. وعليه من يريد قراءة منتجات الفكر الإنساني بعقلية أحادية، ويقاربها وفق "منطق مونولوجي"، كأنما يتحدث لغة غير إنسانية، أو يعيد كتابة المقروء بحروف غير آدمية، لا يفهمها إلا هو، ولا يستوعبها إلا جهاز اللغو (الخاص) عنده.
وإذا صح، عقلا وواقعا، إسناد "الحوارية" –باعتبارها خصيصة صميمة في الكلام- إلى كل جهد نقدي وتفاعل لغوي، على سبيل الارتباط واللزوم، صح معه كذلك، توثيقا وبحثا، أن الحوارية (Dialogisme) –بوصفها نظرية نقدية- عائدة إلى الأديب والفيلسوف الروسي ميخائيل باختين. ذلك أنه أصدر في أواخر العشرينات من القرن الماضي ثلاثة مؤلفات على قدر كبير من الأهمية أحدثت ارتجاجا في الأوساط الثقافية يومئذ. وعدت منعطفا نوعيا في مسار تطور الفكر الحديث، وهي: (الفرويدية: 1927)، و(المنهج الشكلي في الدراسات الأدبية: 1928) ثم (الماركسية وفلسفة اللغة: 1929).
وما يميز هذه المؤلفات جميعها طابع مشترك تمثل في نقدها للتوجيهات النظرية الحديثة السائدة في مجالات علم النفس والأدب واللسانيات. وقد مكن هذا الطابع النقدي من إرجاع تلك التوجيهات إلى منزعين متصارعين:
أولهما: يغرق في "الموضوعية المجردة"، كما الحال بالنسبة إلى السيكولوجيا (علم النفس) واللسانيات البنيوية، أو في "الشكلانية الضيقة"، كما هو الأمر في المناهج الشكلانية لدراسة الأدب.
وثانيهما: يبالغ في "الذاتية المثالية" كما هو حاصل في "الفرويدية" واللسانيات المثالية، أو في "الإيديولوجية الضيقة" على نحو ما هو متداول في المناهج الإيديولوجية[6]؛ الأمر الذي جعله (باختين) يتصور العلم –إنسانيا كان أو طبيعيا- ممارسة تخاطبية قائمة إما على "المونولوجية" (Monologisme) أو على "الحوارية" (Dialogisme).
بيد أن ما ينبغي التنبيه إليه في هذا الإطار أن باختين تحدث عن الحوارية في الخطاب الروائي تحديدا، ونظر لها في المجالين الفكري واللغوي، لكنه لم يتحدث عن "النقد الحواري" بشكل صريح. وعليه فهذا المفهوم، كما هو شائع اليوم، يجد مرجعيته الأساسية في كتابات "تودوروف" في مرحلة ما بعد البنيوية (Trans-structuralisme)، وقد تمثلت ذروتها الفكرية في كتابيه: "فتح أمريكا[7]" و"نحن والآخرون[8]." فيما بلغت ذروتها المعرفية والنقدية في كتابه: "باختين: المبدأ الحواري[9]."
ومجمل هاته المؤلفات يمكن موضعتها في مجال "تاريخ الأفكار" منظورا إليه من زاوية "فكر الاختلاف"، الذي يعد نقد ونقض أوهام المركزية العرقية والفكرية، في السياق الغربي، منطلقه وغايته.
ويتحدد مفهوم الحوارية بنفيه المزدوج لـ"منطق التراتبية" الذي يبرر الإعلاء أو الحط من شأن صوت أو رأي أو فكر لحساب آخر، من جانب، ولـ"منطق المركزية" الذي يولد في ذات المرء التوهم بأن آراءه ومواقفه وأفكاره هي المعيار في التعاطي والتناول[10]، من جانب آخر. بمعنى أن الحوارية أو النقد الحواري ليس ضد "فكرة الحقيقة"، بأي حال من الأحوال، وإنما يتغيى من "منطلق فكر الاختلاف تغيير وضعها أو وظيفتها تغييرا يجعلها مبدأ منظما للتفاعل مع الآخر[11]"، وقراءة منتوجه الثقافي أيا كان هذا الآخر وذلك المنتوج. مما يدل على أن "قضية الغيرية" (Altérite) تشكل الموضوع المركزي في التصور الحواري وفي فكر الاختلاف عموما. وما من شك أن "فعل" إعادة الموضعة، على نحو ما ذكر، جهد ينطوي على معنى "تجاوز" أو "رفض الفكر" الذي يدعي امتلاك الحقيقة، ويروم فرضها على الغير. بحكم أن "حقيقته" هاته يمكن أن تتحول إلى "معتقد" موثوق به (Dogme) يبرر القمع أكثر مما يحفز على الحوار والتواصل مع الآخر المختلف. ومن هناك إنشاء قاعدة تفاهم تكون منطلقا للوصول إلى الحق المشترك (بفتح الراء) في البحث عنه، المتعاون في شأنه.
وتبعا لهذا فإن "الحقيقة" المقصودة هاهنا حقيقة تداولية جماعية، مصدرا ومآلا، مقترنة بمقام تعاوني (Cooperative Context) قوامه التناقش والتباحث والتدافع (الكلامي)، وغير هذا مما يقوي دواعي التعاون في النفس، ويضعف أسباب الاستئثار فيها. إنها حقيقة (معرفة) صادرة عن "نظر متعدد" مسنود بـ"عقلانية تواصلية (Communicationnelle Rationalité)، لارتكازها على علاقات محددة بين ذوات متعددة متفاعلة تواصليا.
غير خاف مدى قرب النقد الحواري (أو التلقي الحواري) في هذا الجانب، من مقتضيات "فلسفة التواصل" التي تم الاستغناء في نطاقها –بشكل مطلق- عن احتمال كون الذات الإنسانية بوعيها المفرد، قادرة على الوصول إلى أية حقيقة مطلقة، مهما بلغ نفاذ بصيرتها ومستوى تعقلها. إن المرء، وفق هذا التصور، مدعو إلى أن يرى الواقع من حيث كونه مبنيا على نزعة جماعية تستدعي تعاون الجميع، ومشاركة الكل، ائتلافا واتحادا، في إيجاد الحلول (الفكرية والسياسية والثقافية وغيرها) ذات الصلة بالجماعة: أي بما هو رد جماعي على متطلبات المجتمع، وتشارك "تذاوتي" (Intersubjectivity) لسد حاجات الناس.
وليس من نافلة القول، التنبيه في هذا المقام إلى واحدة من أمهات الإسهامات العربية في تاريخ الفكر العربي، والتي كان لها الدور الحاسم في إنشاء وحفظ وتداول المعارف في مختلف الحقول والمجالات الفكرية التي أبدع فيها العقل العربي، يتعلق الأمر بـ"المنهجية التناظرية" التي ارتضاها الأولون، في فترة من فترات التاريخ العربي الإسلامي وخاصة القرنين الثالث والرابع الهجريين، سبيلا للإبداع التراثي، تعبيرا عن وعي مبكر بأن "الحق لا سبيل إلى اقتناصه بغير إجماع العقلاء على طلبه، ومساهمتهم جميعا في إنشائه وبنائه[12]." وهذا الذي أشار إليه طه عبد الرحمن بمصطلح "المعاقلة" التي كانت تسد في الفكر العربي القديم مسد "العقل" في التراث اليوناني.
ولا يدل المصطلح عنده إلا على"فعل جمعي للعقل يشارك فيه الكثيرون ولا ينفرد به الواحد[13]": أي أنها حالة تكتسب بالتعاون والتشارك على إظهار الصواب وتحقيق الاتفاق.
ولهذا فـ"منهج المناظرة" هو الذي يسمح للجماعة بالتفكير والإنتاج كجماعة ضمن هذا الوضع الخاص ومقتضياته المباين، ولا شك، لصور التفكير الفردي المتوحد. وتحقيقا لهذا المقصد الأسمى أوجد "علم المناظرة" حاملا جملة من الطرائق والتقنيات منطقية وخطابية، باسطا عددا من الضوابط والمبادئ منهجية وأخلاقية، باعتبارها قوانين مسلكية يتحقق بفضلها تنسيق "الأنظار" الفردية وتنظيما تنظيما منسجما ينمو به "المعقول" درجة تلو أخرى، ويرتقي طورا بعد طور.
وإذا انكشف هذا الأمر انكشاف قرب "النقد المونولوجي" من "العقل الأداتي" والتفكير الأحادي سليلي فلسفة الوعي (أو فلسفة الذات)، أمكن تقريب النقد الحواري والتفكير المتعدد (الجماعي) من عقل آخر مغاير، لن يكون سوى "عقل تواصلي نقدي" مركوزة أصوله في "فلسفة التواصل"، لاتحادهما معا، في السعي إلى تخطي الذات إلى "التذاوت"، والانغلاق إلى الانفتاح، والجمود والتحجر إلى الحركية والتطور. فضلا عن إحلال "التصور النسبي" للقضايا والظواهر والأفكار محل "التصور الإطلاقي" لها. من منطلق أن كل شيء قابل للمساءلة، وأية "حقيقة مهيأة للمباحثة، شريطة الانضباط "لإيتيقا المناقشة الحجاجية"، كما يسميها يورغان هابرماس[14]؛ أي لأخلاقيات الحوار الإقناعي والتفاعل الحجاجي المستند إلى الاعتراف المتبادل والتدافع المتكافئ المتعادل.
إن النقد الحواري، كما العقل النقدي التواصلي، قادر على تجاوز الذات الضيقة والإجراءات والتفاصيل المباشرة والأمر الواقع وفق "رؤية تجاوزية". فهو لا يذعن لما هو قائم ويتقبله، وإنما يمكنه القيام بجهد تأويلي تحويلي إزاء الأفكار والممارسات والعلاقات، والبحث في جذور الأشياء وأصولها، وفي المصالح الثاوية وراءها والأبعاد المرتبطة بها؛ الأمر الذي يجعل الجهد النقدي الحواري من هذه الجهة جهدا "تفكيكيا" بامتياز.
وفي مقابل هذا يمكنه كذلك القيام "بجهد تركيبي إبداعي. فهو قادر على التمييز بين ما هو جوهري وما هو عرضي. وعلى صياغة نموذج ضدي، لا انطلاقا من المعطي فحسب، وإنما مما هو متصور وممكن في آن واحد. ويمكن على أساسه تغيير الواقع، [لذا تغدو] أمام الإنسان إمكانية تجاوز ما هو قائم دائما، انطلاقا من إدراكه لما هو ممكن داخله، بمعنى أنه يفتح باب الخلاص والتجاوز على عكس التكيف والإذعان للأمر الواقع[15]"، على نحو ما هو الحال في النقد المونولوجي والعقل الأداتي، الذي يتعسر عليه إدراك الحقيقة وتنوع معانيها وتعدد زوايا النظر إليها، لعدم إيمانه بمشروعية الاختلاف ومبدإ التباين والتغاير أساسا لممارسة التفكير، ومنطلقا للتحاور والتشاور، لذا لا مجال لإمكان، أو محاولة، زحزحة الحقائق "عن وضعها المعطى سلفا" أو "المبتغى آنيا ومستقبلا"، إلى وضع "الأفق المشترك" لكل بحث ونظر.
3. تهافت العقلانية "المونولوجية"
قد لا يبعد عن الصواب التشديد على أن سيادة "العقلانية المونولوجية" وغياب المرتكزات الفكرية والمعرفية للحوارية، علة العلل لجل الأزمات الثقافية والاجتماعية التي ترهق المجتمع العربي كلية، من حيث هو مجتمع مطوق بأصناف شتى من "الخطاب الدوغمائي"، وبخاصة في الحقل الثقافي الذي تحتكره الخطابات الإيديولوجية، وتسوده التوترات والنزاعات الإقصائية.
فالمشكلة الكامنة في هذا الصنف من الخطاب، وقبله في نظام التفكير الذي يصدر عنه، كونه ينصب حجبا كثيفة حوله تمنعه من رؤية الواقع كما هو، مما يجعله تفكيرا نمطيا (Typique) يرفض "التحديث" والتغيير في نظرته للآخر. لذا يبقى حبيس النظرة المتعالية إلى الذات التي تتمسك برؤية الغير كما ترى هي بلا أدنى تغيير. إنه (الآخر/الغير) عندها كما هو، لا يتغير في طريقة تفكيره وقناعاته وأخلاقه، وبقية أموره. وعليه فهي نظرة جامدة نهائية متحجرة، غير قابلة للتشكل بطريقة جديدة تتخلى بعض قناعاتها وأحكامها المسبقة[16].
ولا ريب أن من مآزق وآفات هذا النمط التفكيري كونه أحادي الاتجاه، وحيد المنحى والمسلك، فأفقه لا يتسع لأي بعد آخر، حيث تختزل القضايا في قضية واحدة، وتكثف القراءات ضمن قراءة فريدة، وتنصهر الحقائق في بوثقة "حقيقة" جامدة، هي تلك التي يعتقدها ويمارسها ويدافع عنها، وفق منطق التعالي، وشعور النرجيسية، وعقيدة الوثوقية (الدوغمائية)، التي يستحيل معها تعدد الرأي أو المذهب أو الموقف، فالآخر، هاهنا، إما صديق أو عدو، موال أو معارض، والمسألة الفلانية إما خير مطلق أو شر محض، وغير هذا من صور التفكير التي لا تقبل العكس، ولا تستوعب التناقض، وحساب الاحتمالات المتعددة. وممارسة التفكير على هذا النحو، وقراءة الواقع على هذا النهج ليس إلا تمجيدا للذات، وتضخيما للنفس، وتقديسا للأنا، إمعانا في إقصاء الآخر وعدم الاعتراف به، وتملصا من الإقرار له بالحق في المخالفة.
فـ"كثيرا ما يحدث أن يفهم فرد (ما) نصا (ما) على جهة غير مرادة، وغير محصور المراد فيها، وهو يحصر المراد فيها ثم يتبناها كفهم أولي ونهائي "للنص". ولا يكتفي بذلك، بل يخطئ من يفهم غير فهمه، وربما انطلق من التخطيء إلى الإنكار والتهجم الذي قد يصل إلى الإضرار بالناس مصالحهم، معتقدا أنه يقوم بالواجب الإنساني، ويؤدي دوره التنويري، وهو في الحقيقة إنما يحاول قهر الناس على فهمه الخاص والخاطئ لا غير، ولا صلة لما يفعل بإحقاق الحق ولا إنكار المنكر[17]"، وليس ثمة تعسف على الثقافة والناس أكبر من هذا، ولا هناك قتل للفكر والوعي أعظم من ذاك.
4. نحو عقلانية تشاورية
إذا صح ادعاء كون لا أحد بمقدوره امتلاك الحقيقة ما دام أنه غير معصوم، ولا بإمكانه إنتاج فكر "كامل" ومطلق بحكم حقيقة نسبية ماهيته الإنسانية، صح معه كذلك، أن الأفكار لابد أن تأخذ طريقها على نحو تداولي وتواصلي بين المتحاورين على قاعدة المناقشة "المعقولة" التي تروم إغناء الفكرة وتصويب الموقف بمنأى عن صور التهجم، ووجوه الهياج، وصنوف الانفعال، التي تثوي وراءها، غالبا، مواقف لا تتعاطى مع الآخر إلا بوصفه نقيضا وخصما، ولا تقرأ في أفكاره إلا ضلالا وجهلا.
وعلى هذا الأساس فإن من اللازم ألا يستثنى شيء من الحوار ويبعد عن النقاش؛ لأن "ما نعتبره مسلمات أو بديهيات أحيانا، قد يتأكد في أحيان أخرى أنه كان مجرد أوهام، فالبديهيات تحتاج هي أيضا إلى إعادة نظر من أجل الكشف عن مكامن الوهن فيها. والحقيقة التي تحتاج إلى إعادة نظر تنتهي أن تكون حقيقة مطلقة وتتحول إلى وجهة نظر قد تصيب وقد تخطئ. وإذا آمنا بأن ما نملكه من أفكار تبقى قابلة للمراجعـة، فإنه لا شيء عندئذ يمنع من الاعتراف بخطئها إذا تبين ذلك، بل يصبح من العناد واللا إنصاف الإصرار على أفكار أصبح واضحا أنها مغلوطة[18]."
وليس القصد هاهنا التنقيص من شأن القيم العليا، أو التشكيك فيه، ولا المس بالأصول والثوابت. فمهما يكن من أمر، تبقى غاية ومقصدا للذات الجمعية النزيهة، وللوعي الإنساني النزيه، وللنضال البشري البريء، فالكل يحلم بالعدالة، والكل يرغب في الحرية، والكل ينبذ التخلف والقهر، ويطمح للتقدم والتطور. وما من شك أنه إذا أخلص الجميع لهذه القيم وآمن بهذه المثل، فإن المصلحة الفردية المناقضة لمصلحة الجماعة تنتهي أن تكون، حينئذ، هدفا بذاتها، وغاية في جوهرها. وهذا هو معنى "التواصل الفكري" الذي يروم معالجة ضعف الأفكار، وفساد المواقف. وإذا أمكن التأسيس لـ"ممارسة تشاورية" تشترشد بالعقل الآخر، وتنتفع بقدراته، فإنه من البديهي أن تغيب أية وصاية قد يدعيها (أو يمارسها) البعض على الأفكار والرؤى، والفضائل والقيم. كما أنه من الطبيعي أن تزول عقلية الاستبداد ومنطق الاستئصال، سواء كان ذلك باسم العقيدة أو باسم الملة، أو المذهب أو الحزب، أو باسم أي صنف من أصناف الإيديولوجيا دينية أو دنيوية.
إن ترسيخ "الممارسة الشورية"، غير المنفكة، عن التواصل العقلاني، والاحتكام إلى ثوابت المناقشة والمحاججة سبيل إلى فضح الأوهام المزيفة وكل أنواع الخداع المبثوثة في أنماط شتى من الخطابات الفكرية والأدبية والسياسية والإيديولوجية وغيرها. كما أنه مدخل لتعرية الذات من نرجسيتها وأنانيتها وقداستها. ومتى تحقق ذلك يغدو الرهان هو تكوين فضاء جديد للنمو البشري والعمل الحضاري، بحيث ينتقل من الأنا "النخبوي والوحداني" إلى "النحن التعددي والتواصلي" الذي يستند إلى "عقلانية تداولية" ومنطلقات حوارية أساسها التعدد والتنوع، والشراكة والاعتراف والتركيب والتجاوز[19]؛ إذ كل ذات مستقلة مدعوة لإبداء رأيها في القضايا المعروضة للنقاش، معنية بالإسهام في الفضاء العام. ووفق هذا "الأنموذج التداولي[20]" تغيب مختلف أشكال الهيمنة والاحتكار والتعصب للرأي الواحد، فيعلو آنئذ سلطان الحوار، ويرتفع منسوب النقاش دلالة على حياة العقل وحركية الفكر؛ لأن العقل الذي لا يحاور عقل ميت، والفكر الذي لا يناقش فكر جامد. وتبعا لهذا فإغلاق باب الحوار نزوع إلى "منطق التعالي"، ونكوص عن الواجب الجماعي، ومنع للنفع المتعدي إلى الغير على سبيل التشارك والتفاعل، ومتى اجتمعت هذه النقائص في ذات إلا صيرتها ذات ميتة، مبالغة في الاعتزاز بالنفس، مفرطة في التعصب تجاه الغير، مغالية في البعد عن الناس، معْرضة عن سمع صوت الآخر، راغبة عن قضاياه وهمومه وانشغالاته، كما عن إسهاماته.
على سبيل الختم
حاصل الكلام من جميع ما تقدم إن النقد الحواري أو التواصل العقلاني أو التواصل التشاوري، كتجليات لعقلانيات متكاثرة –متعددة الصور متوحدة الجوهر- من قبيل "العقلانية الحوارية" و"العقلانية التواصلية" و"العقلانية التشاورية" و"العقلانية التداولية" وغيرها. كل ذلك أضحى ضرورة عصرية تفرضها وقائع وظروف العالم الجديد بما هي شروط ملائمة لهاته الممارسات أكثر مما هي أسبابه وعلله.
فما أحوج المجتمع اليوم للإفادة من هذا التوجه في تدبير الشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسية، طالما أنه غدا "الحق" غير مقدور عليه بغير الجماعة التي تتشاور فيه، وتتباحث في صوره ووجوهه، ودلالاته وأبعاده. لقد تعددت مسالكه وتشعبت سبله لحد أصبحت "الحقائق" شتى، وصارت اليقينيات عدة، تبعا لأهواء الأنظار المفردة، ورغبات العقول المتوحدة، وتنظيرات الذوات المنعزلة. فاختلط الحق بالباطل، وتداخل الأصل مع الفرع، واندمغت الحجة بالشبهة، وغير هذا مما جعل الشك مركوزا في النفوس، منغرسا في العقول، متمكنا من القلوب. فساد عدم الاطمئنان، وتفشى سوء التفاهم، وعم شر العنف وبأس التنازع والتباغض بدل التقارب والتواصل.
ولا مخرج من هذا التيه، فيما يبدو، إلا بتنسيق الأنظار الفردية، والتقريب بين العقول المتباعدة، والتشارك بين الذوات المختلفة المتنافرة؛ إذ لا قيمة لشيء إلا إذا قلبته العقول الكثيرة، ولا وزن لأمر إلا إذا أبدعت فيه الفهوم العديدة. أما عهد القرار المتفرد والإبداع المتوحد فغير منتظَر رجوعه، ولا مأمول انبعاثه.
الهوامش
1. حسن حنفي، فلسفة النقد ونقد الفلسفة، (كتاب جماعي). مركز دراسات الوحدة العربية، ط1. 2005، ص8.
2. علي حرب، الماهية والعلاقة: نحو منطق تحويلي، بيروت: المركز الثقافي العربي، لبنان. ط1، 1998. ص45.
3. حسن مصدق، النظرية النقدية التواصلية، البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 2005. ص74.
4. عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دمشق: دار الفكر، سوريا. ط2002، ص91-92.
5. حسن حنفي، المرجع السابق، ص9.
6. محمد الحيرش، تداوليات التخاطب عند ميخائيل باختين، تطوان: مجلة كلية الآداب، المغرب. 1990، ص117.
7. ترجمة بشير السباعي، سينا للنشر، 1992.
8. لم يترجم إلى اللغة العربية على الرغم من قيمته الكبيرة.
9. Todorov, T. Mikhail Bakhtin: Principe dialogique. Seuil. Paris. 1981.10. معجب الزهراني، "نحو التلقي الحواري"، مجلة قوافل، النادي الأدبـي، الرياض - السعودية. مج: 4. ع: 7. 1996. ص45.
11. Todorov, T. Mikhail Bakhtin: Principe dialogique. P8.
12. رشيد الراضي، "عقلانية المناظرة في التراث العربي"، مقال على شبكة الإنترنت.
13. طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، البيضاء: المركز الثقافي. ط: 2000. ص157.
14. Habermas,J. (1987). Théories relatives de la vérité. op.cit. p322.
15. عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ص147.
16. للتوسع ينظر: محمد العليوات، تأملات في نظام التفكير، مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، 2007، ص49 وما بعدها.
17. المرجع نفسه، ص51-52.
18. قاسم شعيب، تحرير العقل الإسلامي، المركز الثقافي العربي. ط1، 2007، ص116-117.
19. علي حرب، أزمنة الحداثة الفائقة، بيروت: المركز الثقافي العربي، لبنان. ط1، 2005. ص187.
20. للوقوف على المعالم الأساسية لهذا الأنموذج يحسن الرجوع إلى:
Bernstein, J. (1984). The Frankturt School: Critical Assessment. 6 vol. Londres. Rautledge.