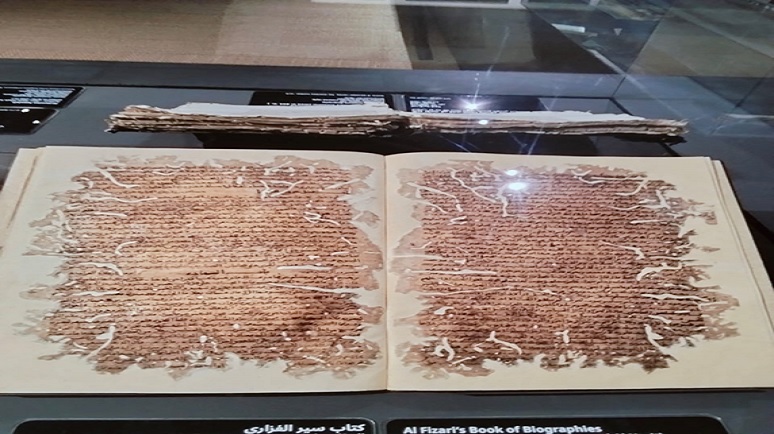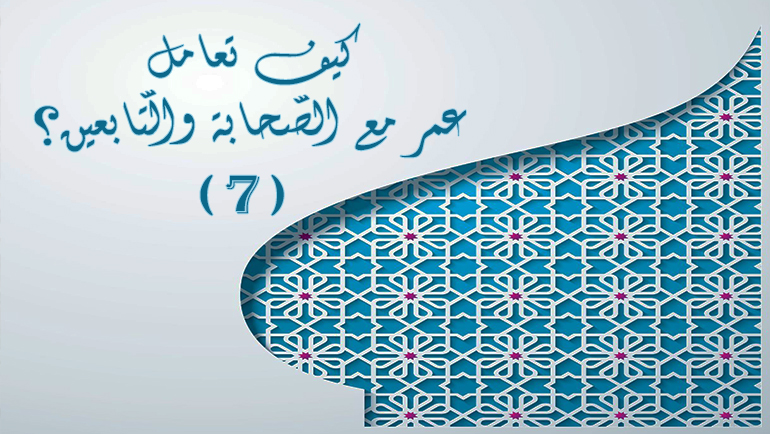يعتبر محمد إقبال أحد أهم المفكرين المسلمين غير العرب الذين كانوا يتمتعون برؤية قرآنية فلسفية شاملة([1]) غايتها تجديد التفكير الديني. فمحاولته لتجديد الفكر الإسلامي لم يكتب لها التواصل والتراكم المعرفي لتغيير الواقع الإسلامي واعتمادها كإحدى المساهمات الجادة والمهمة لإخراج العالم الإسلامي من الغياب الحضاري الذي يعيشه.
ويعد ضعف التواصل مع مشروع محمد إقبال وعدم قدرة التعامل معه، مؤشرا على الأزمة المعرفية العميقة التي يعيشها الفكر الإسلامي المعاصر الذي يتحاشى الخوض في التصورات الفلسفية، بما أن الفلسفة هي زندقة وتؤدي إلى الكفر حسب ابن تيمية والتيارات السلفية المعاصرة([2]). زد على ذلك التأملات الصوفية التي تصبغ أفكار محمد إقبال والتي لا تلقى قبولا في جل تصورات الإسلام التقليدي. كذلك هنالك رفض لاستعمال الشعر وتحويله إلى حكمة وحركة تغيير حضاري.
لكن ورغم هذه المؤاخذات على فكر محمد إقبال، إلا أن كتابه "تجديد الفكر الديني في الإسلام"([3]) يعتبر من أولى المحاولات التي عالجت موضوع "التجديد" كمنظومة متكونة من عناصر مترابطة لا يمكن فهم إحداها إلا في ضوء إدراك المعنى الفلسفي للعناصر الأخرى. وضمن هذه المحاولة التجديدية لمحمد إقبال، لا يمكن إدراك جوهر روح الإسلام بمنأى عن فهم جوهر الفكر الغربي وخاصة بمنأى عن نقد أخطاء الحضارة الغربية وانزلاقاتها المادية. فاطلاعه الواسع على التاريخ الإسلامي، وتمكنه من الفكر الغربي سمحا له بتشخيص حالة العالم الإسلامي المنفصل عن ذاته وعن واقعه من جهة، وباقتراح تصور يكون أساسه إعادة بناء "الذات الإنسانية" والذي لن يتم إلا بربط الإنسان بالقرآن وبالكون من جهة أخرى. إذن هو مشروع مصالحة مع العصر ومع الدين ومع العلم، وخاصة هو مشروع استنهاض لعزائم الإنسان المسلم ليعيد حركة التغيير إلى مسارها الصحيح؛ مسار البناء الحضاري الذي لن يتحقق إلا من خلال إنسان أعاد الثقة في نفسه وتخلص من أزمة الاغتراب والتقليد التي تكبل فكره وتشل قواه وتثبط عزائمه.
من هذا المنظور، سنحاول في هذه الورقة أن نغوص في أعماق فلسفة محمد إقبال المتأصلة في التصور الفلسفي المعرفي القرآني حتى نستفيد من أفكاره التجديدية التي ستساعدنا على الإجابة على السؤال الذي يشغل حيزا كبيرا من الفكر الإسلامي منذ عصر النهضة: كيف يمكن لنا أن نبني حضارة مواكبة لعصرها، روحها القيم الإسلامية، أساسها إنسان "مستخلف" في الكون، شعارها تحقيق مفهوم النبوة، ومدارها حرية الفعل والإبداع؟
إذن هي محاولة لاستجلاء فلسفة محمد إقبال التجديدية، وللتطرق إلى المسائل التي تم طرحها للخروج من الأزمة الحضارية الراهنة، بشقيها الإسلامي والغربي.
توضيحات
في الحقيقة ومن الوهلة الأولى، اتضح لدينا أن كتاب "تجديد التفكير الديني في الإسلام" ليس من الكتب التي يسهل قراءتها، لذا لا يكفي مطالعته مرة واحدة. فالمزج بين البعد الفلسفي والتفكير الديني والنظريات العلمية من جهة، والمرور من التصور الإسلامي إلى التصور الغربي عبر عرض أهم أفكار فلاسفة/حركات هاتين الحضارتين من جهة أخرى، يتطلب من القارئ تركيزا فائقا وانفتاحا على الآخر وحدًّا أدنى من المعرفة بكل هذه المجالات.
وبعبارة أخرى؛ بما أن المنهج المتوخى من طرف محمد إقبال هو منهج الباحث عن الحقيقة وليس المالك لها، فهو يضع نفسه، منذ أول وهلة، في حالة انفتاح عقلي على الكثير من التصورات والنظريات. وهذا المنهج لا ينطلق من فراغ، بل هو متشرب من الدين الإسلامي ومتشبع بالفلسفة الإسلامية، لكنه في الوقت نفسه ينهل من مجالات أخرى من شأنها أن تثريه وتطوره وتجدده بل وتصححه.
هذه الصعوبة في إدراك تصور محمد إقبال ذو الأبعاد المختلفة والمتشعبة ترافقها صعوبة أخرى: أغلبية المفاهيم التي تؤسس لنظريته الفلسفية القرآنية هي نفسها متحركة، لا تقبل الثبات ولا تعترف بالجمود وبالوضع النهائي. فالعناصر المكونة للمنظومة الإقبالية متغيرة في معانيها ومفاهيمها بما أنها تحاول أن تدرك/تفهم الواقع الذي هو متغير بالأساس. ولذلك سنرى خلال تحبيره لكتابه، أن هذه المفاهيم يتم تعبئتها بدلالات معينة في فصل، وبدلالات أخرى في فصل آخر. تعبر هذه الطريقة في التعاطي مع المفاهيم عن ثراء فكري وعمق لغوي ورمزي تتميز به رؤية الكاتب وعن التزامه بالتصور الذي يؤمن به وهو أن العالم في نمو مطرد، يحتم مواكبته بأقلمة هذه المفاهيم مع هذا النمو.
وإذا أردنا أن نخوض أكثر في المنهج الذي توخاه محمد إقبال، فيمكن أن نعتبر بأنه منهج تحليلي نقدي بنائي مقارن. فالكتاب مفعم بالمناقشات والتحليلات الفكرية والفلسفية، الدقيقة والعميقة، سواء المتصلة بالعالم الإسلامي أو بالعالم الغربي. وهي مناقشات وتحليلات فلسفية وفكرية تفتح الباب من جديد على العلاقة بين حضارتين انقطعت الصلة بينهما منذ حقبة ابن رشد. وهي في الوقت نفسه مقاربة نقدية لأفكار ومقولات كانت تمثل في عصر محمد إقبال جوهر العالم الحديث، وخاصة الغربي منه.
فهو لم يُفتن بتلك الأفكار، على عكس ما حصل لكثير من المفكرين المحسوبين على العالم الإسلامي، بل ناقشها وفككها ليعيد بناءها/صياغتها ضمن تصوره الفلسفي الإسلامي، المؤمن بضرورة التفاعل مع الحداثة المعرفية، والواعي بأن العقلانية الناقدة هي وحدها القادرة على إعادة الاعتبار للإنسان المسلم([4]). فلم يكن بناؤه نقديا تفكيكيا فحسب، على غرار مدرسة ما بعد الحداثة، بل كان يصدر عن تصور للإنسان وللتاريخ عماده رسالة الإسلام، بوصفها رسالة للإنسانية قاطبة، قادرة على الحركة الفعلية ليس لاعتبارات دينية بحتة؛ لأننا مسلمون فيجب أن نكون نحن أصحاب الريادة الحضارية، وإنما كتحقق لصيرورة المعرفة والفعل الإنسانيين.
وغني عن القول أن من الأفكار المهمة والجوهرية التي تمثل الخيط الناظم للتصور الإقبالي هي فكرة "التجديد". فهذه الفكرة نجدها تسيطر على كل ما خطه محمد إقبال، وتأسس لعملية بنائه الحضاري، وتسكن كل بيت من أبياته الشعرية وتنير قراءته النقدية للتاريخ الإسلامي والغربي.
ذلك إن "قيمة التجديد داخل أية أمة تكمن أولا في منحها القدرة على الحركة والإبداع، وهي صفة تكسب المجتمع صيانة قيمه الحضارية، وأيضا يمنح المجتمع الأدوات والوسائل العملية لكي يعيش الحاضر ويرسم رؤاه المستقبلية، وما إشكالية الأصالة والمعاصرة التي تعيشها المجتمعات في سياق مراجعاتها لمسار تطورها إلا تحت رحمة وجود أو غياب هذا الفعل، ونقصد به فعل التجديد الحضاري"([5]). فالتجديد بالنسبة لمحمد إقبال هو نقطة البداية وأساس البناء وغاية التطور.
ويبقى مفهوم التجديد بالنسبة لمحمد إقبال غير مواز لمفهومي الإصلاح والاجتهاد. فهو يتعداهما ضمن رؤية فلسفية دينية تتجاوز المجال الفقهي-العملي الذي يهتم به المجتهد، والمجال السياسي-التربوي الذي يعتكف عليه التصور الإصلاحي. فحسب أحميدة النيفر، فإن "ما اقتضاه مجال التجديد عند إقبال تمثّل في مراجعات فكرية وعقدية أعادت النظر في مسائل كبرى؛ كالوحي والنبوّة والدين والزمان والمعرفة والإنسان.
ومن جهة أخرى كان التجديد عنده ممنهجا بطريقة يعسر اعتبارها مقطوعة عن جذورها الإسلامية رغم أن همّها الأساسي بقي الإجابة عن متطلبات الفكر وكشوفات المعرفة الإنسانية في لحظتها الحديثة. ومن ثم كان التجديد أفقا مغايرا أثراه التفاعل مع الآخر، لكن غايته كانت حفز المسلم على الوعي بذاته"([6]).
انطلاقا من هذه الملاحظات، سنمر عبر أهم المفاهيم التي أثثت نظرية محمد إقبال ومنها: الفلسفة، الدين، العلم، الألوهية، ختم النبوة، الزمان، الطبيعة، التاريخ وغيرها من المفاهيم.
منظومة "الفلسفة-الدين-العلم"
من أهم الأشياء التي كانت تؤرق محمد إقبال هي وضعية الإنسان في العالم الإسلامي، بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، وانقسامه على نفسه إلى اتجاهات وأفكار متباينة ومتصارعة. فقد دخلت العديد من الفلسفات والمفاهيم الغربية، منها العلمانية التي أصبحت مرجعية فكرية وقانونية، مما دفع ببعض المثقفين إلى تبني الأفكار الغربية كأساس للولوج إلى عالم الحداثة وإصلاح العالم الإسلامي ومنظومته الفكرية. وللإجابة على هذا التحدي فقد ارتأى محمد إقبال "بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناءً جديدًا، آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام، إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطوّر في نواحيها المختلفة" (ص 4).
كما اعتبر أن الحل للخروج من هذه الحالة العويصة التي وصلت إليها الحضارة الإسلامية هو الرجوع إلى الأساس، إلى البعد الفلسفي للدين الإسلامي، وإعادة صياغته بطريقة جديدة مع الانفتاح على ما وصلت إليه المعرفة الإنسانية الحديثة من تطور علمي. هذا هو الطريق الوحيد للخروج من المادية التي يعيشها العالم الحديث، والانبهار بالمظهر الخارجي البراق للثقافة الأوروبية الذي قد يشل تقدم المسلمين وخاصة الشباب منهم (ص 15).
ففي عملية إعادة البناء الحضاري، يرى إقبال أنه لتخطي عجز الإنسان وقصوره، يجب أن نفهم طبيعة الكون، والمكانة التي يشغلها هذا الإنسان فيه ونوعية السلوك الذي يتفق مع مكانته في هذا الكون. أسئلة جوهرية، ليس ممكنا الإجابة عنها بدون الرجوع إلى تصور فلسفي، بما أن الفلسفة هي "روح البحث الحر"، وهي التي تضع كل سند موضع الشك (ص 7).
غير أن الفلسفة تبقى قاصرة عن الوصول إلى كنه الحقيقة القصوى بما أن ديدنها هو التفكير العقلي البحت، والإنسان في حاجة إلى عقيدة، بما هي "نظام أو مجموعة من الحقائق العامة لها تأثير في تكييف الخلق، إذا صدق الاعتقاد بها، وفهمت فهما واضحا قويّا" (ص 8).
ومع ذلك فإن الدين، من حيث هو عقيدة، يعد في أشد الحاجة إلى أساس عقلي لمبادئه الأساسية؛ لأنه يسعى إلى التوفيق بين المتضادات الموجودة في عالم التجربة، وإلى تبرير أحوال البيئة التي يجد الإنسان نفسه محاطا بها. وهو ما جعل محمد إقبال يعتبر أن الفلسفة الدينية هي الطريقة المثلى للتعبير عن الإنسان، باعتباره كائناً يكتمل فيه الفكر بالبداهة، كما تكتمل الفلسفة بالدين، ويكتمل الدين بالفلسفة.
ويعتبر هذا التكامل بين الدين والفلسفة هو سبب رفض محمد إقبال للفلسفة اليونانية، محملا إياها مسؤولية عدم فهم القرآن ووضع غشاوة عليه، رغم أن الفلسفة اليونانية مثلت قوة ثقافية عظيمة في التاريخ الإسلامي، ووسعت آفاق النظر العقلي عند مفكري الإسلام. فقد اقتصرت هذه الفلسفة على عالم الإنسان وحده (سقراط) وقدحت في الإدراك الحسي الذي اعتبرته لا يفيد اليقين (أفلاطون)، مما جعلها غير قادرة على التجاوب مع روح القرآن الذي يدعو إلى النظر إلى كل الظواهر الطبيعية والاعتبار منها (الرياح، الليل، النهار، السماء، النجوم، النمل، النحل، إلخ) والذي يرى أن الحواس هي من أجلّ ما أنعم الله به على الإنسان. إذن، منذ الوهلة الأولى، اتسمت فلسفة محمد إقبال بمعارضتها للفلسفة اليونانية، فلسفة أوقعت أكثر من مفكر مسلم في تناقض مع روح القرآن، مثل الغزالي الذي كان ينظر للتشكيك الفلسفي (والذي قضى على المذهب العقلي وأقام حدا فارقا بين الفكر والبداهة) وابن رشد القائل بخلود العقل الفعّال (متأثرا بأرسطو).
إن الخاصية البارزة لفلسفة محمد إقبال هو جانبه الديالكتيكي المتكون من مفاهيم متغيرة المعاني حسب الوضعية التي يتم توصيفها. ففلسفته لا تقبل الجزئيات المتنافرة والقاصرة على تصور وحدة واحدة. وكثرة الجزئيات المتنافرة والتي لا نقدر على ردّها إلى وحدة واحدة تمنع العقل من الوصول إلى إدراك قاطع وتجعلنا عاجزين عن تصوّر عالم واحد متماسك لكثرة الجزئيات.
ذلك أن "الفكر من حيث طبيعة جوهره ليس قارًا معطلاً، بل هو متحرك فعّال يتكشّف إذ يحين الوقت عما فيه من لا نهائية، مثله مثل الحبّة تحمل في طيّاتها من أول الأمر وحدة الشجر الكاملة على أنها حقيقة ماثلة... ومعاني هذه المعيّنات ليست في وحدتها الذاتية، بل الكل الأكبر، الذي هي له مظاهر معينة.
وهذا الكل الأكبر، إذا استعملنا المجاز الوارد في القرآن المجيد، هو نوع من "اللوح المحفوظ" يشتمل على جميع إمكانيات المعرفة التي تتعيّن بعد، على أنها حقيقة ماثلة تظهر في سلسلة من التصورات المتناهية يبدو في الزمان المتجدد أنها واصلة إلى وحدة ماثلة فيها بالفعل، والواقع هو أن حضور اللانهائي الكلّي في حركة الفكر هو الذي يجعل التفكير النهائي ممكنا" (ص 14).
إذن، بالنسبة لمحمد إقبال، الجزئيات تكوّن الكل، والكل يحمل في طياته جميع جزئياته المتحركة والفعالة، مما يجعل جميع إمكانيات المعرفة النهائية متمثلة في الكل اللانهائي. وكثرة الجزئيات لا يجب أن تعيق العقل عن تصور/إدراك وحدة الكل كواحد متماسك. بصيغة أخرى، ليس هنالك خط متسلسل وحتمي للفعل وللحركة وللفكر، كل نشاط يحمل في طياته في كل لحظة زمانية إمكانات لا متناهية لأنشطة أخرى. الفكرة الأساسية من هذا التصور هو أن كل حركة تولد/تحمل حركة لا متناهية، متحركة وفاعلة، تفتح على مستقبل ممتلئ بالإمكانات اللانهائية، لم يقرر قبليا ولا بصفة حتمية. هذه الفكرة تقطع جذريا مع التصور اليوناني القديم ومع التصور التقليدي الإسلامي وحتى مع جزء من العلم الحديث.
فإخفاق الفلسفة اليونانية متأت من تناولها الحقيقة بالنظر العقلي من دون مجابهة العالم الخارجي واعتمادها على التفكر النظري المجرّد من القوة، كحركة فاعلة، (ص 23). أما إخفاق التصور التقليدي الإسلامي يرجع لاعتماده على تصور جبري للقضاء والقدر يكاد يُجهز على الإرادة والفعالية الإنسانيين، واعتباره العالم مغلقا، مستقبله مقررا، وتصوره أنه تقدير سابق غير قابل للتغيير لنمط من الحوادث المعينة (ص 96). وأما العلم الحديث، وخاصة علم النفس الحديث الذي في لتقليده للعلوم الطبيعية المادية، قال: "بأن نشاط النفس عبارة عن سلسلة تصورات ومعان يمكن تحليلها في النهاية إلى وحدات من الإحساسات... ومثل هذا الرأي يؤدي حتما إلى فرضية قوية تؤيد تفسير الشعور تفسيرا آليًّا" (ص 127).
ولكن، وفي خضم هذه المنظومة الفلسفية ذات العناصر الفاعلة المتحركة، كيف ينظر محمد إقبال إلى الدين؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نولي وجوهنا شطر الفصل الأخير من الكتاب، والذي يحمل عنوان: "هل الدين أمر ممكن". بالنسبة لمحمد إقبال، الحياة الدينية تزيد "في طموح الإنسان إلى الاتصال المباشر بالحقيقة القصوى، وهنا يصبح الدين مسألة تمثل شخصي للحياة والقدرة، ويكتسب الفرد شخصية حرة، لا بالتحلّل من قيود الشريعة، ولكن بالكشف عن أصلها البعيد في أعماق شعوره هو" (ص 214).
والدين بهذا المعنى هو التصوف، ولكن ليس في نزعة العقل للزهد في الحياة، وإنما أساسه التجربة التي تسعى سعيا صادقا لتوضيح الشعور الإنساني. إذن، ومن منظور الحركة الفاعلة، يرى محمد إقبال أن الدين هو الطريقة الجدية الوحيدة للبحث عن الحقيقة، التي تحرر الذات المبدعة وتكشف لها عن تفردها ومرتبتها الميتافيزيقية، مما يسمح بتقدمها ورقيّها واتصالها بالذات الحق. فهذا التصور للدين هو محاولة لتجاوز النزعة العقلية البحتة الطاغية على الفلسفات الأوروبية الحديثة، كما عرفها مثلا "لانج" أو "نيتشه"، والتي تخلت عن النزعة الروحية الشعورية عند الإنسان.
وبالنسبة لمحمد إقبال، تبقى قيمة العمل أهم قيمة تصدر عن الإنسان لتهيئة الذات لكي تكون صالحة للاتصال المباشر بالحقيقة القصوى عن طريق العمل الفردي، وأيضا عن طريق العمل الجماعي؛ (كالصلاة الجماعية اليومية). فالتجربة العملية الدينية الفاعلة هي التي تسمو بالذات الإنسانية فوق مجرد التأمل، ليصبح منتهى غاية الذات ليس أن ترى شيئا، بل أن تصبح شيئا (ص 231). والجهد الذي تبذله الذات حتى تكون شيئا هو الذي يسمح لها أن تقول: "أنا أقدر" (كانط) عوض أن تقول: "أنا أفكر" (ديكارت). هو تجاوز للسلبية التي يعبِّر عنها التأمل أو التنافس الوحشي اللذان قضيا على وحدة الحضارة الروحية لبناء موقف إيجابي، حيث يساهم الدين والعلم في إقامة مجتمع إنساني ذي طابع أخلاقي يسعى إلى الحقيقة الإلهية.
ولتحقيق البعد العلمي للدين ولتطبيق تعاليمه، يجب اختبار نتائج وحيه عن طريق العبادة والصلاة؛ فالصلاة لا تهدف فقط إلى معرفة تشبه التأمل، بل هي فعل من أفعال التمثل التي تتجاوز التفكير المجرد. "فالعقل في تفكيره يلاحظ فعل الحقيقة ويتقصى آثاره، ولكنه في الصلاة يتخلى عن سيرته بوصفه باحثا عن العموميات البطيئة الخطو، ويسمو فوق التفكير ليحصّل الحقيقة ذاتها، لكي يصبح شريكا في حياتها شاعرا بها" (ص 108-109).
وبمعنى آخر؛ الصلاة هي مكملة للنشاط العقلي، بما أن كل طلب للمعرفة وكل تأمل في الطبيعة تأملا علميا هو في جوهره صورة من صور الصلاة. فهي تسمح بتخليص النفس من آثار الآلية الموجودة في النوم والعمل حتى تتحقق حريتها. فالقرآن يقر بأن النفس الإنسانية قادرة على اختيار أفعالها، ولذلك هي تعيش حالتي الارتفاع والانخفاض. فالصلاة تساعد النفس الإنسانية على بقاء القدرة على حرية الاختيار في الفعل بوصفها عاملا ثابتا لا يتناقص في حياة النفس (ص 129).
ولا ينسى محمد إقبال تذكيرنا، من خلال منظومته الديالكتيكية، بأن الصلاة على المستوى الفردي هي إثبات للذات وإنكار لها في نفس الوقت، وأما على المستوى الجماعي فهي إحساس بالمساواة الاجتماعية وقضاء على الشعور الطبقي وشعور بوحدة الجماعة عبر اختيار قبلة واحدة لصلاة المسلمين (ص 111-112).
إذن، وحتى نحوصل التصور المعرفي لمحمد إقبال، والتصور الذي تعبر عنه منظومته (الفلسفية-الدينية-العلمية): لتجديد التفكير الديني يجب الانطلاق من الفلسفة الروحية، وإعادة بنائها بناء جديدا يسمح بتحرير عقل الإنسان. والمكوِّن الثاني لهذا الإطار هو الدين الإسلامي حيث إن الذي يربطه بالفلسفة هو البعد العقلي الذي يتحلى به القرآن الكريم. فالقرآن يركِّز على الإيمان ولكنه، في الوقت نفسه، يعطي مكانة كبيرة لمنهج الملاحظة والتجربة لتغيير الواقع المحسوس والموضوعي عبر العمل مما أدى إلى وضع أساس العلم الحديث. إذن، يرد هنا محمد إقبال على كل من ينكر مساهمة المسلمين في التطوير الحضاري الإنساني عبر الرجوع إلى الفلسفة اليونانية فقط، أو الادعاء أن البروتستانتية كانت وراء ظهور العالم الحديث (كما فعل مثلا ماكس فيبر).
فالدين يبقى الرابط الأساسي والضروري بين الفلسفة والعلم، ولا يجب التخلص منه أو تقليص مكانته في العالم الحديث؛ لأنه هو القادر الوحيد على إشعال جذوة الإيمان القوي الصادق اللازم لبناء حضارة إنسانية (على عكس العقل المحض الذي أدى إلى حضارة فاقدة لوحدتها الروحية، مما جعل من أوروبا أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسان)، وهو تعبير عن الإنسان كله في اتصاله بالحقيقة.
الألوهية والطبيعة والزمان
يعتبر مفهوم "الألوهية" بالنسبة لمحمد إقبال مفهوما إيجابيا جوهريا، فهو "يمثل الحقيقة الأولى ومنبع كل القضايا الأخرى، بل إن مشكلة الإنسان والعالم والطبيعة ما هي إلا تجلي للحقيقة الأولى والكلية"([7]). ولا يمكن إدراك مفهوم "الألوهية" إلا بربطه بمفهومي الطبيعة والزمان، في إطار (فلسفي-ديني-علمي). فبعد أن يعرض تصورات العديد من التيارات والمفكرين المسلمين والغربيين في هذا الموضوع وينقد أفكارهم([8])، يؤكد لنا محمد إقبال أن الذات الإلهية مطلقة، ولا يمكن للعقل استيعابها إلا من خلال أهم صفة ندرك بها الأشياء ألا وهي النور؛ لأنه أقرب الأشياء إلى المطلق، وسرعة انتشاره لا يمكن أن يفوقها شيء، وهو ما أكده العلم الحديث (هذا ما يذكره القرآن في سورة النور عندما يصف الله بأنه نور على نور، وليس كمثله شيء).
ولكن كيف يكون الله مطلقا وهو ذاتا، والذات تقتضي الفردية، والفردية تقتضي التناهي؟ فالفردية تميل إلى معارضة التوالد، كما يقول الفيلسوف الفرنسي "برغسون"، ولكن هي في الوقت نفسه تتوالد حتى تتجدد وتحافظ على الحياة. إذن، تحمل هذه الفردية في طياتها خصيمها نفسه. ولكن الذات الإلهية لا يمكن أن نتصورها متضمنة لغيرها كما تؤكده سورة "الإخلاص". ولا يمكن أن نتصورها متناهية بمعنى التناهي المكاني، فلا يوجد زمان ولا مكان يحيطان بالذات الإلهية. "فالذات الأولى، إذن، ليست لا نهائية بمعنى اللانهائية المكانية، كما أنها ليست متناهية بمعنى التناهي المكاني للذات الإنسانية التي يعزلها البدن عن غيرها من الذّوات. ولا نهائية الذات الأولى تتألف مما فيها من إمكانيات غير متناهية في القدرة على الخلق، والكون، على الصورة التي نعرفها، ليس إلا تعبيرا جزئيا عن هذه القدرة" (ص 81).
إذا كانت الطبيعة "غيرا" بالنسبة للإنسان ومواجهة له، إلا أنها بالنسبة للذات الإلهية لا يصدق عليها معنى "قبل" و"بعد"، بما أن هذه الطبيعة ليست ذاتا منفصلة عن الذات الإلهية، ولا هي على مسافة منها ليصبح هنالك فراغ بينهما. فالزمان والمكان والطبيعة هي مفاهيم يضعها العقل الإنساني للوصول إلى إدراك قدرة الذات الإلهية الخالقة الحرة، قدرة لا متناهية على خلق للحوادث مستمر غير منقطع، في عالم ينمو بشكل لا يعرف التوقف كما جاء في الكتاب الكريم: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ (فاطر: 1).
وبما أن الكون بكافة جزئيّاته يُعد نتيجة للحركة الإلهية؛ فالزمان يسمح للإنسان بإدراك هذه الحركة والمساهمة في تغيير الكون عن طريق العمل، تحويل ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، والفكر الطليق من كل قيد (العلم). فالحركة الإلهية تعكس فعل الخالق الذي يتجلى في كل ذرة من ذرات الكون، وهذه الذرة مهما ضؤلت في ميزان الوجود، فإنها تعبر عن روح أو ذات ترتقي في سلم الوجود درجة درجة إلى أن تبلغ كمالها في الإنسان، ولذلك قال القرآن إن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد (ص 89).
ويعتبر محمد إقبال أن الزمان الإلهي زمان مجرد تجرُّدًا تامًّا من صفة المرور والانصرام لا يقبل التجزؤ والتوالي والتغيّر (صيرورة من غير تعاقب لا تعرف ماضيا وحاضرا ومستقبلا)، بما أن الذات الإلهية لا تستند إلى قبلية الزمان وهي قادرة على رؤية جميع المرئيات وسماع جميع المسموعات بفعل واحد من أفعال الإدراك. "وهكذا فالزمان الإلهي هو الذي يصفه القرآن بأنه "أمّ الكتاب" الذي جمع فيه في آن مفرد فوق الأزل تاريخ الكون كله محررا من شباك العلة والمعلول" (ص 93). أما الزمان الذرّي الموضوعي (المجزأ والقابل للقياس) فهو ينشأ من الحركة التي تتجه من العلم إلى العمل. والتجربة الشعورية الذاتية هي التي تستطيع أن توفق بين تقابل الزمان السرمدي (الديمومة المحضة) المتجاوز للإدراك العقلي والزمان المركّب من أجزاء متناهية والمدرك بفاعلية العقل.
وكما أن الزمان الإلهي هو زمان مطلق، فإن العلم الإلهي هو كذلك علم مطلق؛ بمعنى أنه فعل من أفعال الإدراك مفرد غير قابل للتجزئة، حيث يحيط علم الله مباشرة بكل التاريخ في كل لحظة على اعتباره نظاما لحوادث معينة. إلا أن محمد إقبال يرفض هذه الرؤية السلبية للعلم الإلهي، لأنها تعبر، حسب رأيه، عن عالم مغلق، بما أنه مقرر مستقبلا، ومقدر سابقا غير قابل للتغيير، وهو ما يشبه فكرة القضاء والقدر التي تحدد اتجاهات الله الخالقة تعيينا لا رجعة فيه (ص 96).
فالعلم الإلهي لا يمكن أن يكون مجرد مرآة تنعكس فيها صور للموجودات ولمستقبلها؛ لأن هذه الرؤية تنتقص من حرية الذات الإلهية، ولا تستطيع أن تتصور أن العلم الإلهي قوة حية خالقة. فالمستقبل "يوجد وجودا سابقا بوصفه إمكانا محتملا أي بالقوة، لا بوصفه نظاما مقررا لحوادث لها شكل معيّن" (ص 97)، وهو ليس صورة شمسية لحوادث سبق بها القضاء، لأنه في الأخير لا يصبح لمفهوم الخلق الإلهي أي معنى ولا لمجال الإبداع والحرية الإنسانية أي قيمة.
في الوقت نفسه، يؤكد محمد إقبال أن ظهور ذوات قادرة على الفعل التلقائي غير المتنبئ به، يتضمن تحديدا لحرية الذات المحيطة بكل شيء، ولكن هذا التحديد هو اختيار من الذات الإلهية الخالقة التي اصطفت بعض الذوات المتناهية لتقاسمها الحياة والقوة والاختيار. وهذا الاصطفاء يدخل في باب الحكمة والإرادة الإلهية التي يقدمها القرآن على أنها الفضل الذي بيد الله ويؤتيه من يشاء. وهذا الفضل ينعكس خاصة في قصة آدم وفي هبوطه من الجنة.
فالقرآن حرر الإنسان من النظرة المتشائمة وخلصه من الحية التي تطبع قصة آدم وحوى ببعد جنسي كما هو في الموروث القديم، ورفع من قيمة الإنسان إلى أن جعله خليفة لله. والقرآن يذكر أن الأرض أصبحت مستقرا ومتاعا لآدم وزوجه كعقاب لعصيانهما أمر الله بعد أن أزلهما الشيطان (بالنسبة لمحمد إقبال كان منع الأكل من شجرتين: شجرة المعرفة وشجرة الخلد التي تسمح بالتكاثر والقوة)، عكس العهد القديم الذي يلعن الأرض نتيجة لعصيان آدم. وبالنسبة لمحمد إقبال، "قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لا صلة لها بظهور الإنسان الأول على الكوكب، وإنما أريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان من بداية الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفسا حرة قادرة على الشك والعصيان، وليس يعني الهبوط أيّ فساد أخلاقي" (ص 103).
ويستنتج محمد إقبال من قصة آدم أن الحرية هي شرط فعل الخير، وشرط فعل الشر كذلك. والمعصية الأولى التي قام بها الإنسان كانت أول فعل تتمثل فيه حرية الاختيار والإرادة، والتي لم تكن مبنية على قاعدة حتمية الفعل، وهذا سر ثقة الله في آدم وسبب مغفرة معصيته. والذات الإنسانية حتى تبقى على ذاتها يجب أن تنشد المعرفة والتكاثر والقوة، التي من أجلها أخرج من الجنة. ولن تستطيع الذات الإنسانية أن تجني هذه الثمار إلا من خلال بطء الكد والمعاناة والتجربة والخطأ، وليس عن طريق العجلة. فبتمرده عن أمر الله، تأكد الإنسان أنه لن يستطيع أن يحقق الخلود والملك الأبدي. ولم يبق له من سبيل إلا أن يحقق نوعا من الخلود الجماعي بالتكاثر والتوالد.
ومع ذلك، "علينا أن نفهم أنه مهما كان الدرس الذي يمكن أن نتعلم من ذلك التمرد على الله، فإن هذا الدرس لا يمكن إلا أن يكون درسا منسجما مع قدره، مع الأمانة التي حملها، ومع مسؤولية وجوده كشخصية، في ظهور طبيعته التي تحدِّد موقعه في مقدمة الخلق وتمنحه فضل خلافة الله"([9]). ومن هذا المنظور، يمكن أن ندرك عبء الأمانة التي حملها الإنسان على عاتقه وأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها؛ فلا يمكن حمل هذه الأمانة إلا من خلال الصراع المتبادل بين الذوات المتعارضة والحرة، وفوز الخير في النهاية على الشر.
وبالعودة إلى مفهوم "الألوهية"، يقول محمد إقبال: إنه لا يمكن تصور الذات الإلهية ذاتا مفصولة عن حقيقة وجود الإنسان والعالم اللذين يمثلان مظهرين من مظاهر وحدة الوجود ويعبران عن قدرتها المطلقة. ووجود الله هو من ذاته وليس من غيره، وهو وجود أزلي مطلق يستحيل تصوره تصورا كاملا، فهو كما يقول القرآن: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. ويبقى أن هذا التصور لمفهوم الألوهية ليس تصورا مجردا مطلقا (مما يجعل منه فكرة غير مفهومة ولا يمكن إدراك حقيقتها) وهو كذلك ليس مجسدا كلية (مما يجعل منه شيئا كباقي الأشياء المحسوسة).
وهكذا لا نستطيع معرفة الله إلا من خلال ما يمكن أن تتصف به الذات الإلهية؛ فالاتصال بالذات الإلهية لا يتم إلا من خلال صفاتها التي لا يدركها إلا العقل عبر معرفته بالطبيعة، فهي بناء من حوادث أو منهج منتظم من السلوك في حركة دائمة لا تعرف السكون. وهي وسيط يجعل المعرفة بالذات الإلهية ممكنة كما يصفها القرآن بتعبيره الرائع "سنّة الله" (ص 71).
إذن، بالنسبة لمحمد إقبال، لا يمكن الرد على التصور المادي العصري للإنسان وللطبيعة إلا باكتشاف سنن الله المتحققة في طبيعة حية وفي نمو مطرد، ويصبح إدراك حقائقها هي إحدى مراتب معرفة الذات الإلهية والحقيقة المطلقة. وفي آخر التحليل، نرى كيف أن منظومة محمد إقبال المعرفية والمتمثلة في (الفلسفة، الدين، العلم) تجسدت في غضون تحققها الواقعي إلى (الاستخلاف، الألوهية، السنن الكونية)؛ حيث أن البعد الزماني يسمح للذات الإنسانية المستخلفة في الكون بإدراك حركة تغيير الطبيعة غير الساكنة (سنن الله التي هي صفة من صفات الألوهية) من خلال توجيه العلم إلى العمل.
"ختم النبوة" والبعد التاريخي
تعتبر فكرة "ختم النبوة" من العناصر التي تتسم بالأصالة والتجديد في منظومة محمد إقبال القرآنية التجديدية، وهي تشغل مساحة هامة من فكره الفلسفي والديني. وينبهنا مصدق الجليدي إلى أن هذا المفهوم يختلف "عن المفهوم الكلاسيكي للختم الذي يشير إلى الاكتمال ضمن منطق تأبيد الوصاية على عقل الإنسان... (بل) هذا الختم يعبر، عكس ذلك تماما، عن معنى ارتفاع الوصاية عن عقل الإنسان"([10]).
ويرى محمد إقبال أن مفهوم ختم النبوة مرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الوحي كظاهرة طبيعية كونية؛ فـ"الوحي" في القرآن صفة عامة من صفات الوجود، وهو ليس حكرا على الإنسان، بل هو صفة تتسم بها كل مكونات الوجود. ولكن هذه الصفة لا تتحقق بنفس النسبة وبنفس الدرجة، بل هي تختلف في مراحل تدرّجها في الوجود وتطورها بقدر ما تختلف حقيقة وطبيعة الوحي. فمثلا البشرية عند مرحلة الطفولة كانت في حاجة إلى أحكام واختيارات وأساليب للعمل حتى يتسنى لها الاقتصاد في التفكير الفردي والاختيار الشخصي. ولكن مع ختم النبوة، أمكن للإنسان أن يبلغ مرحلة الرشد، مرحلة العقل الاستدلالي، ظهور ملكة النقد والتمحيص، حيث أصبح سيِّدا لبيئته، متجاوزا بذلك العالم القديم عندما كان التفكير المجرّد، والإيحاء، والفطرة، والمعتقدات الدينية الغامضة، يمنعونه من أن يكون له سلطانا على العالم المحسوس.
إذن لا يجب على الإنسان "أن يبقى متصلا بالوحي إلى الأبد في كل ما يجب أن يعرفه لأن طبيعة البيئة التي يعيش فيها بما تمتاز به من قوى، تفرض عليه سلوكا جديدا قائما على يقظة من نوع آخر واستنهاض قدرات كامنة فيه إذا ما أراد أن يكون إنسانا متجها إلى تحقيق وجوده لا أن يتلقى دائما الحقيقة بل يشارك في صناعتها بجهده"([11]).
وعلى عكس من يرون أن الإنسانية مرت بثلاث مراحل متعاقبة عند تطور العقل البشري: مرحلة الطفولة، ومرحلة المراهقة، ومرحلة النضج العقلي (هذا ما نظّر له، مثلا، الفيلسوف وعالم اللاهوت الألماني لسنج)، فإن محمد إقبال يرى أن تاريخ الإنسانية ينقسم إلى ما قبل "ختم النبوة" وإلى ما بعده. ومن هذا المنظور، يمثل نبيّ الإسلام الرابط/القطيعة بين العالم القديم الذي هو مصدر رسالته، والعالم الحديث. وحتى تتحقق المرحلة الجديدة، تم استيعاب مصادر أخرى للمعرفة مبنية على العقل الاستدلالي وعلى التجربة (يعد القرآن الأنفس والآفاق مصدرا للمعرفة). ويؤكد محمد إقبال، "إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوّة نفسها" (ص 149).
إذن، هو تغيير نوعي وقطيعة إبستيمولوجية، أثرت تأثيرا كبيرا في الصيرورة التاريخية للإنسانية، وسمحت للإنسان بالانعتاق من كل أنواع الوصاية التي تحتِّم عليه الاعتماد إلى الأبد على مقود يُقاد منه. ولكن "ختم النبوة" لا يعني، بأي حال من الأحوال، أن غاية الحياة أصبحت إحلال العقل محل الشعور إحلالا كاملا من جهة، ولا أن النبوة قد انقطع وجودها بوصفها حقيقة من حقائق الحياة من جهة ثانية، وإنما فكرة "ختم النبوة" كان لها الفضل في دفع الإنسان للتحلي بروح النقد العلمية وبالحرية المصاحبة لها، مما سمح بفتح سبلا جديدة للمعرفة. زد على ذلك أن القرآن الكريم لم يتوان على التأكيد مرارا أن الآيات الدالة على الذات الإلهية تتجلى في الأنفس وفي العالم الخارجي المحسوس، بعد أن تمّ تجريد هذا الأخير من القوى الخارقة للعادة التي كانت تسكنه حسب ثقافات ما قبل "ختم النبوة".
ويعتبر محمد إقبال أن مفهوم "ختم النبوة" هو الذي دفع المسلمين لتجسيد روح الثقافة الإسلامية في التاريخ عن طريق الثورة العقلية التي سمحت بتطوير المنهج الاستقرائي-التجريبي، الذي ادعى الغرب أنه هو مبتكره خلال مرحلة النضج العقلي التي ميزت فلسفة الأنوار. وهذا التجسيد التاريخي لـ"ختم النبوة" سمح للعقل بالانتقال من الوجود إلى الصيرورة، وذلك بإدخال عنصر الزمان في تصورنا للكون، محولا الثابت إلى متغير (فكرة التطور) مما ساهم في إنتاج العديد من العلوم والعلماء (البيروني، الخوارزمي، ابن مسكويه، ابن الهيثم، الطوسي، ابن إسحاق، الطبري، إلخ).
وهكذا، "فإن جميع خطوط التفكير الإسلامي تتجه إلى تصور الكون متحركا متغيِّرا" (ص 164). إذن، أصبح البعد التاريخي (أو بتعبير القرآن "أيام الله" والتي تمثل أحد ثلاث مكونات المعرفة التي نوه بها القرآن مع السنن الكونية ("آيات الله") والرياضة الروحية ("تقوى الله")، هو إعلان بداية مرحلة "ختم النبوة"، مما نتج عنه أن كل الأمم أصبحت مسؤولة على أعمالها وترتّب عليه مبدأ المحاسبة في الآخرة، وانجر عنه أن الأمم الخالية أصبحت مصدرا للاعتبار من تجاربها ومادة لدراستها دراسة علمية باعتبارها كائنات عضوية (وابن خلدون في هذا الميدان مدين بجانب كبير مما كتبه إلى ما استوحاه من القرآن).
ولكن القرآن في تركيزه على التاريخ، بوصفه مصدرا من مصادر المعرفة الإنسانية، لم يقلصه إلى مجرد العبرة المستقاة من الحوادث التاريخية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده على مبدأ النقد التاريخي عبر التدقيق في رواية الحقائق. وبذلك يكون القرآن قد دفع العقل الإنساني نحو تغيير نوعي وجذري تكون فيه العلوم مبنية على النقد التاريخي وعلى التجربة (الملموسة أو المستنتجة من التدبر في تجارب الآخرين) فاتحا الباب لتحقق فعلي لـ"ختم النبوة". فإدخال عنصر الزمان في التصور التاريخي والذي ساهم القرآن فيه مساهمة كبيرة سمح من جهة بتصور الوجود كحركة مستمرة، يجب أن يعقلها الإنسان في كدحه إلى الله وفي تحرره من القيود السابقة، وفي تحقق البعد الأنثروبولوجي للإنسان من جهة أخرى، بإقرار وحدة الأصل الإنساني ووحدة الوجود ومشاركة الناس في حركة التاريخ بوصفها حركة جمعية مستمرة وفي تطور دائم لم تقدر خطواتها من قبل (ص 167-168). وبهذا المعنى، فـ"ختم النبوة" هو "سيرورة معرفية تاريخية لا تنقطع فهي ضرب من البنائية المفتوحة وليست مجرد حدث تاريخي حصل لحظة انقطاع الوحي. ولذا علينا أن نمعن باستمرار في مزيد تكريس هذا الختم؛ أي مزيد استبدال التقليد بالفهم وإرادة التجديد والفعل في العالم والتاريخ... (وهذا) التاريخ لا يتغيّر فقط بالأفكار. بل بجدل الأفكار مع الواقع"([12]).
وحتى نستسيغ أكثر ما كتبه محمد إقبال عن "ختم النبوة"، وندرك مدى الأفق الذي أراد دفع الإنسان أن يصل إليه بتحرره من كل أنواع القيود والوصاية، يجب مقارنته بمفهوم "موت الإله" لنيتشه وبمفهوم "دين الخروج من الدين" لمارسيل غوشيه. فبالنسبة لنيتشه لا توجد مركزية للعالم، والإنسان جزء من الطبيعة ولا يوجد فارق جوهري بينه وبين كل الكائنات الأخرى، وهو جزء من حركة المادة ولذلك هو خاضع لها.
وإذا كان ماركس يرى بأن صراع الطبقات هو محرك التاريخ، وإذا كان فرويد يرى بأن الغريزة الجنسية هي الدافع الأساسي والمحرك للإنسان، فإن نيتشه يعتبر أن "إرادة القوة" هي المحرك للتاريخ وللتحولات الاجتماعية والأخلاقية والعلاقات بين الأفراد بمختلف مستوياتهم. فنيتشه يرى أن "إرادة القوة" تعني القضاء على المقدس والحق والخير والمطلق واليقين، مما أدى به إلى ادعاء التخلص من الأخلاق الدينية ومن اليقين المعرفي، ومن ثم تأسيس كل فلسفته العدمية على مفهوم "موت الإله".
لقد كان من البديهي التوصل إلى هذا الادعاء بعد أن حلّ الله الأب في ابنه عيسى. "لا يقدر الفكر المسيحي الإيجابي أو المضاد (النقدي) على ختم النبوة والإبقاء على الله حيا لا يموت، ولذلك لا فكاك له من ورطة الوصاية المتواصلة على العقل وعلى الضمير الإنساني، إلا بقتل الله، فادعى الأسلاف صلب المسيح وبقاءه في الإله حيا، أي رفع الحلول وتعويضه باتحاد روح المسيح بروح الله. أما الأخلاف فقد ادّعوا موت الإله نفسه (نيتشه)... إلههم مات (قتلوه مرتين ابنا وأبا، ماديا ورمزيا، وفق الرواية المسيحية أو المناهضة للمسيحية) لأنه ولد ميتا (عقيدة التثليث والحلول والخطيئة الأصلية المزمنة...)"([13]). إذن، تم التخلص من الإله عبر قتل مضاعف: قتل الابن وقتل الأب، وذلك حتى يتحرر الإنسان من كل القيود الأخلاقية ويصبح "إرادة قوة" محضة.
أما بالنسبة لمارسيل غوشيه، فهو يعتبر المسيحية "دين الخروج عن الدين" بمعنى أنه الدين الوحيد الذي استطاع أن يندمج في الحداثة وأن يكيِّف عقائده مع معطيات ومستلزمات العالم الديمقراطي. أما الأديان الأخرى، فقد استحوذت السياسة فيها على الشأن المقدس وكرسته لتوظيفاتها البراغماتية وللاستغلال الإيديولوجي، مهمشة بذلك الإمكانات الهائلة التي يحتويها الدين في تقوية الاجتماع البشري وتكريس المنظومات القيمية والخلاص الأخروي والتسامح بين الأفراد وتحرير الإنسان والمجتمع من الاستلاب المادي والروحي([14]). فالخروج عن الدين هو خروج عن عالم اجتماعي كان الدين فيه هو المنظم البنيوي للروابط الاجتماعية وللشكل السياسي (تجسد في نظام "الملكية" حيث كانت السلطة تهبط من فوق) وللمجال الاقتصادي والثقافي. فمتطلبات تحرير الإنسان من السلطة المطلقة الفوقية حتمت فصل الدين عن السياسة، مع جعل هذا الأخير المجال المشترك لتفاعل الأشخاص بناء على عقد اجتماعي، وتقليص الدين إلى المجال الفردي لضمان حرية الأديان والطوائف والجماعات الدينية من دون وصايا من الدولة، مما يضمن عدم تسييس الدين وتديين السياسة واستقلال كل منهما عن الآخر.
إذن، بالنسبة لمارسيل غوشيه، فإن الديانة المسيحية باعتبارها عقيدة التجسيد، عقيدة تؤسس لتعويض "الإلهي" بـ"الإنساني"، كانت نتيجتها "نزع القداسة عن العالم"([15]). هذه الأطروحة لا تعني اختفاء الدين والإيمان، بل تعني زوال الدين البنيوي الذي ينعكس على كل مناشط الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية، حتى يتسنى إشاعة روح العلمانية الكامنة منذ البدء في الدين المسيحي وإتاحة الفرصة للإنسان للاعتماد على عقله في تفسير العالم. فالخروج عن الدين؛ (كمنظم بنيوي مؤسساتي) للدخول في التاريخ (سيادة دولة القانون) عبر ترسيخ العلمانية والعقلانية والحرية الفردية في لم يتحقق إلا في "الاستثناء المسيحي" فقط.
من خلال قراءة مفهومي "موت الإله"، و"دين الخروج عن الدين" يمكن أن نرى في مفهوم "ختم النبوة" لمحمد إقبال ردا وتجاوزا لفكرة التخلص من الإلهي حتى يتحقق الإنساني؛ ففي التصور الإسلامي، الإلهي والإنساني ليسا في صراع وجودي بحيث لا يوجد إلا مكان واحد لأحدهما. فإقبال يؤكد أن الإلهي يدفع الإنساني دفعا حثيثا لتحقيق ذاته من خلال استعمال عقله وتفعيل قيم التحرر الفردي والمجتمعي إلى درجة تكريس مفهوم "الاستخلاف" كدرجة رفيعة ضد مفهوم الدين كمؤسسة بنيوية. فمن خلال مفهوم "الاستخلاف" وعبره ينتصب الإنسان سيدا للعالم ومحركا للتاريخ، بعيدا عن كل تضاد مع الله أو عبودية ساذجة له.
فمفهوم "ختم النبوة" يتجاوز ما دعا إليه نيتشه من موت للإله حتى تتحقق "إرادة القوة" بالتخلص من المقدس، ويتعدى ما نظّر له "مارسيل غوشيه" من "دين الخروج عن الدين" حتى تتحقق إنسانية الإنسان، وذلك بموضعة الذات الإنسانية في جدلية أنطولوجية ذات وجهين: "الوجه المفارق المتعالي الذي يكون فيه الإنسان أمام الله الخالق المستخلف والوجه الإنسي للإنسان بوصفه صانعا للمعنى، ومحققا له من خلال الشروط التاريخية والفكرية الموضوعية"([16]). إذن، هي دعوة مباشرة إلى الإنسان المسلم لإثبات وجوده من خلال سيطرته على الكون، "إرادة القوة"، ولكن انطلاقا من قناعة أن هذا الكون هو آية للخالق وأن دوره هو أن يقوم بـ"ربط الإثبات العلمي الواقعي بفكرة أخرى وهي إعادته إلى الغايات النهائية لوجوده وهو الله"([17]).
"الإنسان الكامل" وحركة التغيير
يرى محمد إقبال أن الإسلام يعتبر الكون حركة متغيرة، وهو كذلك حركة ثقافية جديدة أساسها "التوحيد"، وغايتها جعل هذا المبدأ عاملا حيا في حياة البشر العقلية والوجدانية. ولا يمكن معرفة الذات الإلهية إلا من خلال الآيات الدالة عليها التي نراها في التنوع والتغير. ولذلك لما جاء الإسلام أكد على مبدأ الحركة والتغير. فالعالم بالنسبة لمحمد إقبال ليس صنعا مكتملا، بل هو ينمو. وهذا النمو هو الذي يكسب العالم المعنى الكامل لحقيقة وجود الكون الذي لم يخلق عبثا: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الدخان: 36-37). فالكون، إذن، لم يوجد من أجل الوجود، "وإنما وجوده متجه إلى تحقيق غايات ومعنى الغاية التي يجب البحث عنها لا تعني الوصول إلى حقيقة ثابتة ومدركة بالعقل تمثل نهاية الشيء ولا يكون إدراكنا للطبيعة بما تحتويه من حقائق مادية هي الغاية من الاعتبار والنظر... وإنما يجب فهم الغاية بما يتجاوز التصور المادي لأننا أمام انفتاح على الحقيقة غير المتناهية وهي الذات الأولى لتصبح غاية الكون هي ما تريده الذات المطلقة وإرادتها اللامتناهية والمتجلية في الكون([18]).
ولكن هذا التغير بالنسبة لمحمد إقبال ينضوي في تصوره الديالكتيكي للظواهر، ولذلك هو ليس تغيرا مستمرا لا يعرف ثباتا، بل هو يشتمل على مبادئ أبدية تسمح بتصوّر للحق الذي يقوم عليه كل مجتمع لينظم حياته ويضبط أموره. "ومن الجلي الواضح أن كتاب الإسلام المقدس، بما له من هذه النظرة، لا يمكن أن يكون خصما لفكرة التطور، على أنه ينبغي ألا ننسى أن الوجود ليس تغيرا صرفا فحسب، ولكنه ينطوي أيضا على عناصر تنزع إلى الإبقاء على القديم" (ص 197).
ويبقى أساس حركة التغير لبناء الإسلام هو "الاجتهاد" الذي نص عليه القرآن في آية مشهورة: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (العنكبوت، 69). ولكن أهل السنة، رغم أنهم سلّموا بمبدأ الاجتهاد من ناحية إمكانه النظري، إلا أنهم أنكروا تطبيقه العملي منذ أن وضعت المذاهب وأحاطوه بشروط يكاد يستحيل توافرها في فرد واحد (ص 176). فمغالاة بعض العقليين في أفكارهم ومحاولة الحفاظ على الوحدة الاجتماعية الإسلامية واستقرار الإسلام عَطَّلاَ حركة الاجتهاد باستخدام ما للشريعة من قوّة مقيّدة ملزمة. وقد ساهم التصوف التزهدي، عبر التفرقة بين الظاهر والباطن وتكريس نزعة من اللامبالاة بالظاهر والنواحي الاجتماعية وتهميش خير العقول الإسلامية، إلى حدٍّ كبير في تردِّي الأوضاع، لا ننسى أيضا الدمار الذي ألحقه التتار ببغداد، وفتور الأساس الذي ورد في القرآن والذي يرى أن الحياة في جوهرها متغيرة.
وقد دفعت هذه الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية إلى اضمحلال قيمة الفرد وقوته، فـ"الجماعة التي يسودها التنظيم الزائد يتلاشى فيها الفرد من الوجود تلاشيا تاما؛ إذ هو يجني قطاف كل ما حوله من تفكير اجتماعي، ولكنه يفقد روحه هو. ولهذا فإن تبجيل التاريخ الماضي تبجيلا زائفا وبعثه المصطنع ليس علاجا لانحلال شعب من الشعوب" (ص 179).
ولمقاومة الميل المبالغ فيه لتنظيم المجتمع والاحترام الزائف للماضي، ليس هنالك من حل إلا تنشئة أفراد ذوي فردية قوية، تتجلى فيهم أعماق الحياة، مما سيمكنهم من إنشاء مقاييس جديدة تتجاوز الجمود، وترجع إلى روح الإسلام الداعية إلى التغيير وإلى الحركة. وقد ضرب محمد إقبال عدة أمثلة لأفراد حاولوا تغيير الأوضاع في العالم الإسلامي، مثل: ابن تيمية، والسيوطي، ومحمد ابن عبد الوهاب، والتجربة التركية في العصر الحديث. فتركيا بالنسبة لمحمد إقبال هي الأمة الإسلامية الوحيدة التي استيقظت من الركاد الفكري ونادت بالحرية العقلية وانتقلت من العالم المثالي إلى العالم الواقعي (ص191).
ويرى محمد إقبال أننا في حاجة اليوم إلى ثلاثة أمور يستطيع الإسلام أن يساهم في تفشيها وأن يسهر على تحققها لإتمام عملية التجديد والتغيير اللازمة للخروج من المأزق الذي وصلت إليه الإنسانية: "تأويل الكون تأويلا روحيا، وتحرير روح الفرد، ووضع مبادئ أساسية ذات أهمية عالمية توجه تطور المجتمع الإنساني على أساس روحي. ولا شك في أن أوروبا في العصر الحديث قد أقامت نظما مثالية على هذه الأسس، ولكن التجربة بيَّنَتْ أن الحقيقة التي يكشفها العقل المحض لا قدرة لها على إشعال جذوة الإيمان القوي الصادق، تلك الجذوة التي يستطيع الدين وحده أن يشعلها" (ص 212).
فأوروبا أنتجت مثالية كانت سببا في إنشاء ذات ضالة همها استغلال الآخر، مما جعل القارة الأوروبية أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسان. أما الإسلام، فهو يدعو إلى الديمقراطية الروحية، القائمة على "ختم النبوة" وعلى المبادئ النهائية للإسلام التي تتحدث إلى الناس من أعماق الحياة الروحية ومن الوجود، مما يترك آثارا عميقة في النفوس ويدفع إلى إعادة بناء الحياة الاجتماعية على ضوء الأهداف القرآنية. ولن تتحقق هذه المبادئ النهائية للإسلام إلا في "الإنسان الكامل".
فبالنسبة لمحمد إقبال، يجسد مفهوم "الإنسان الكامل" المسلم القوي بعقيدته وإيمانه، الدائم العمل لإثبات وجوده وتغيير واقعه. إذن، هو الإنسان الذي لم يعد بحاجة إلى نبوة جديدة، بما أن هذه النبوة أصبحت شاملة ومطلقة فأدركت الحاجة إلى إلغاء نفسها بنفسها في عالم فقد كل صبغة تقديسيّة بتشيئة (القطع مع السحر والمعجزات وأصحاب القدرات الخارقة للعادة والمهدي الذي سيخلص العالم في آخر الزمان). وقد دعم هذه الفكرة احميدة النيفر، فبالنسبة إليه "لا يكون الإنسان كاملا حين يهيمن على الطبيعة ويُخضعها ولا كاملا حين يُلغي الكمال المطلق ذلك القطب الذي يمكنه من اكتشاف كماله النسبي. إنما كماله حين يصبح غرضه تحرر حركة العالم والحياة وتساميها، وحين يدرك أنه صاحب مكان حقيقي في صميم القدرة الخالقة. عندئذ يؤول كماله إلى إمكان تصور عالم أفضل وتحويل ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون"([19]).
هنالك بالنسبة لمحمد إقبال ترابط عضوي بين "ختم النبوة" وإمكانات المستقبل اللامتناهية والزمان و"الإنسان الكامل". فمنظومته (الفلسفية، الدينية، العلمية) نراها هنا تتحول، عبر حركة التغيير الدائمة وحرية الفعل، إلى (الإنسان الكامل، ختم النبوة، إرادة القوة). وتخضع هذه المنظومة إلى التصور القرآني للوجود الذي يقول بأن الخلق يزداد ويرتقي بالتدرج. وتفضي هذه المنظومة الفكرية التجديدية إلى أن لا شيء يمكن أن يعوق الإنسان في استعمال عقله وحكمته، وحل مشكلاته الخاصة على ضوء الأوضاع المستحدثة والأحوال المتغيرة. عبر هذا المنهج، يمكن إعادة تفعيل مشروع "ختم النبوة" كتحقيق "للإنسان الكامل" إيذانا ببداية عصر جديد يسيطر فيه على العالم بفضل "إرادة القوة" الكامنة فيه، إنسانا خالدا قادرا على الإبداع والتطور على كل المستويات من خلال معرفة ذاته والله والكون.
تعليقات واستنتاجات
تمثل النقاط التي تعرضنا لها أعلاه أهم مكونات المنظومة الفكرية التي قدمها محمد إقبال في كتابه "تجديد التفكير الديني في الإسلام". فبالنسبة للكاتب، يُعدّ التجديد داخل أي مجتمع أحد أبرز مقومات التطور الحضاري. فالمنظومة التي تتموضع فيها كل مفاهيمه هي منظومة ثلاثية الأبعاد: (فلسفية-دينية-علمية). وفي الوقت نفسه تعكس هذه المنظومة رؤيتها المتحركة للكون: من جهة، فهي ترى أن الزيادة المطردة هي صفة أساسية للكون، ومن جهة ثانية، تعتمد عند قراءتها للنص القرآني على مستويات متعددة للتأويل تنفتح على إمكانات مستقبلية لا متناهية للتجربة الوجودية.
وهي كذلك منظومة لا تنطلق من التصور الإسلامي لتنتهي إليه، بل هي منفتحة على الآخر، تتفاعل معه، تقوم بعملية إثراء لما قام بتطويره، من باب أن كل الحضارات تساهم في التطور الإنساني، ويجب الاستفادة منها ونقدها في نفس الوقت. وعلى عكس ما ينادي به العديد من العلماء أو المفكرين الإسلاميين، يمثل البعد الفلسفي أحد أهم الأبعاد التي تساهم في بلورة رؤية عميقة ومنهجية لإدراك حقيقة الدين الإسلامي وكنه المفاهيم التي يريد تحقيقها في الواقع. فمحمد إقبال يستهل كتابه بالتأكيد على "أن التفكير الفلسفي ليس له حَدّ يقف عنده، فكلما تقدمت المعرفة، وفتحت مسالك للفكر جديدة، أمكن الوصول إلى آراء أخرى" (ص 4-5). فإعادة تجديد الفكر الديني، وإعادة تفعيل مصادر الثقافة الإسلامية يجب أن يصاحبهما إعادة صياغة لفلسفة يكون أساسها تصور للكون والله والإنسان يستوعب ما وصلت إليه العلوم المعاصرة.
وتبقى غاية هذا التجديد هو أن تعي الذات الإنسانية قدراتها، فهي أساس كل حالات الإبداع والابتكار، وهي القادرة على إصلاح ذاتها بإعادة الثقة إلى نفسها وتحديد الإيمان الصحيح، وبالرجوع إلى القيم الأصيلة للثقافة والمعرفة الإسلامية مع إعادة غربلتها في ضوء المناهج والاكتشافات الحديثة. فبالنسبة لمحمد إقبال، هذا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها من جهة الحضارة الإسلامية، حيث الاغتراب والتقليد هما سيدا الموقف، ومن جهة ثانية، الحضارة الغربية، حيث المادية والانحطاط الأخلاقي هما المسيطران على بعديها الفكري والثقافي.
إذن، لا سبيل إلى التشبث بمرحلة ذهبية عاشها العالم الإسلامي ويتعيّن الرجوع إليها للخروج من الأزمة الحضارية، ولا سبيل إلى الانبهار بمنتوجات الحضارة الغربية المادية والفلسفية والعلمية، ولا سبيل إلى تقفي مستقبل تم خطه قبليا ولم يبق إلا الانصياع إليه. بل هي إعادة قراءة، بعيدا عن كل عمليات التوفيق والتلفيق والصراع، لما قامت بتطويره حضارتان، كل منهما تعيش أزمة عميقة حسب ظروفها وتاريخها الخاص بها. أزمة لا يمكن الخروج منها إلا بتحقق إنسية الإنسان، يكون أساسها البعد الروحي الذي ضاع في خضم التحولات العميقة التي عاشتها الحضارتان الإسلامية والغربية، بُعدا روحيا بعيدا عن الرهبنة التي نادت بها المسيحية، وبعيدا عن التصوف السلبي الذي نادى به الفكر الإسلامي في فترات انحطاطه، بُعدا روحيا يعيد التوازن إلى الإنسان ويجعله يحقق مبدأ استخلاف الله في الكون.
وتبقى وجهة منظومة محمد إقبال هي التغيير والتجديد الحضاري من خلال استيعاب الأنا والآخر([20])، بكثير من التقدير والاحترام، وتوظيفهما لصياغة نظرية في معنى الوجود، تكون متحررة من الاعتقادات السلبية والهدامة؛ كالتواكل والخنوع والاستسلام، ومنغمسة في المفاهيم الايجابية والبناءة؛ كالقوة والعلم وقيم التوحيد.
فـ"الإنسان الكامل" الذي بشر به محمد إقبال هو إنسان يتحرك في الكون بكل حرية (حريته من حرية الله لأنه خليفته)، يسعى إلى تحقيق القيم العلمية بعيدا عن القيم المادية الصرفة، ليصبح العلم ذاته والكون بأسره صورة لقيم وجودية روحية متعالية. ولتجسيد هذا "الإنسان الكامل"، الذي هو محور عملية البناء الحضاري، تؤسس فلسفة محمد إقبال لعملية صناعة الإنسان، صناعة تتطلب إعادة صياغة مفاهيم عديدة (تعرضنا للبعض منها أعلاه)، لتفتح على إدراك جديد ومبدع لمفاهيم أخرى؛ كالفعل الحر وموقع الحرية في فهم حقيقة الإنسان، ومعنى القدر وعلاقته بالمعنى الحقيقي للحرية، ومفهوم الذات النهائية وعلاقتها بالذات اللانهائية في كون لا يقبل الثبات، ومفهوم "ختم النبوة" وعلاقته بحقيقة الاستخلاف في الكون.
إنّنا بصدد مفاهيم فلسفية متشعبة ندر التطرّق إليها في التصور الإسلامي خاصة الحديث منه، تعكس مدى ثقافة محمد إقبال وحدة رؤيته التجديدية وعمقها، وهي الرؤية التي أدركت أن التغيير يتطلب الرجوع إلى الأساسيات، وإعادة قراءة عصرية لفكر ديني تآكل إلى حد أنه أصبح خارج التاريخ.
لا ريب أنّنا عندما نقوم بتحليل مشروع محمد إقبال فإننا نجده مشروعا تجديديا بالأساس. يدعو إلى استعمال العقل النقدي لبناء إطار منهجي بأدوات ابستيمولوجية ومعرفية عصرية، مما جعل عبد الجبار الرفاعي يصفها بأنها تتميز "بكفاءتها النظرية، وهندستها التركيبية، وغناها بحشد وفير من معطيات العلوم الإنسانية الحديثة"([21]). وهي في الوقت نفسه، منظومة تتوافق مع المبادئ القرآنية، تدفع المسلم إلى إعادة تأويل القرآن والعمل به، لتصبح "غاية الدين هي الإنسان الذي ينبغي أن يصنع المعنى متخطيا فرديته ومواجها قصوره في إدراك الحقيقة الكلية"([22]).
الملفت للانتباه أن هذه المنظومة لم تسقط في فخ أدلجة الدين، عبر تحويله إلى إيديولوجيا، بحصره في جوانبه العملية والعلمية، أو التركيز على الإعجاز العلمي، وعلى الجوانب الاجتماعية والسياسية، كما نادى بذلك جمال الدين الأفغاني بتركيزه على الإصلاح السياسي، وعلى المناحي الثقافية والتربوية، كما نادى بذلك محمد عبده بتركيزه على الإصلاح التربوي الثقافي، مما سمح بتفادي تقويض معانيه الرمزية وأبعاده الغيبية واختزاله في تفسيرات سطحية ضيقة، وإفراغه من مضمونه الروحي الباطني.
إذا هي منظومة تحاول أن تحافظ على توازن دقيق وحساس بين مفاهيم متحركة في عالم متحرك، عند التركيز على أحدها، نخل بكل النظام ونسقط في التبسيط أو في الحركة غير الفاعلة، غير المبدعة، التي لا تساهم في إعادة البناء الحضاري. فالفلسفة بدون دين وعلم هي تصور نظري يمكن أن يفضي إلى المقولات المنطقية الفضفاضة (الفلسفة اليونانية مثلا)، والدين بدون فلسفة وعلم هو رياضة باطنية يمكن أن يفضي إلى الخروج عن العالم وإهدار العقل (التصوف السلبي مثلا)، والعلم بدون فلسفة ودين هو محاولة للسيطرة على قوى الطبيعة لا يمكن أن تفضي إلا إلى المادية (الحضارة الغربية المعاصرة مثلا).
ويبقى أن قيمة هذه المنظومة مرتبطة بتحققها في الواقع، من خلال المنهج التجريبي، الذي عماده الأساسي الذات الإنسانية. وتحصل أقصى درجات تحققها عند "ختم النبوة"، لتصبح (الإنسان الكامل-ختم النبوة-إرادة القوة) هي إحدى التمظهرات التي من خلالها نرى حركة الحرية والعمل. وتحصل أقصى درجات تجلياتها عندما يصبح الإنسان خليفة الله في الكون، لتصبح (الاستخلاف، الألوهية، السنن الكونية) هي إحدى التمظهرات التي من خلالها نرى حركة الزمان والحياة الروحية المتعالية.
إننا بإزاء منظومة تتشكل من ثلاثة أبعاد؛ ولها تمظهرات مختلفة حسب متطلبات تحققها. وهي منظومة منفتحة على مصير الإنسان وعلى إمكانياته اللامتناهية، التي غايته الاتصال بذات الحق العليا بما يكشف عن تفرد الذات المتناهية ومرتبتها الميتافيزيقية الرفيعة في هذا الكون. إذن، هو مشروع إعادة تفعيل للنبوة الحقيقية بعد تراجع مكانتها في الفكر الإسلامي لحساب مكانة التصوّف الذي أهمل بصفة عملية الوعي النبوي في بعديه الروحي والوضعي، حيث تم التخلي عن الفعل الحضاري لحساب الرياضة التأملية الطامحة لمقام الشهود، والذي لخصه محمد إقبال في قولة أحد كبار المتصوفة عن معراج النبي إلى السماوات العلى ثم رجوعه إلى عالم الأرض "قسما بربي لو بلغت هذا المقام لما عدت أبدا".
ومن هذا المنظور وكمثل على عدم قدرة إدراك رؤية محمد إقبال ذات الأبعاد والتمظهرات المختلفة، لا نظن أن ابن غزالة على حق عندما ادعى، على إثر ماجد فخري، أنه يوجد لدى إقبال نزوع كثيف للاقتراب من الاتجاه العلمي في عملية تفسير وتأويل بعض الحقائق الفلسفية (نزعة علموية ظلامية). فبالنسبة إليهما، لم يفرق محمد إقبال بين التصور الإسلامي أو القرآني للإنسان والكون والذي يعبر عن الحقيقة الدينية، وبين التطور العلمي النسبي الذي يعبر عن الحقيقة الظنية.
ولذا، لا يجب رهن المقدس والغيبي لحالة العلم المتغيرة التي يمكن تصحيح بعض مناحيها نتيجة اكتشافات جديدة. يبدو لنا أن منظومة محمد إقبال الثلاثية الأبعاد والتمظهرات والمنهج المتحرك الذي أخضعه لها هي التي كانت وراء سقوط ابن غزالة وماجد فخري في هذا الخطأ. فقد أحدث محمد إقبال توازنا بين مكونات رؤيته والتمظهرات التي تمر عبرها منظومته؛ فهي تمنع أن يطغى عنصر على العناصر الأخرى، وهي تعتبر كل قراءة للنص القرآني هي قراءة غير ثابتة ومتغيرة، وتعتبر أن العلوم العصرية هي علوم نسبية ومتغيرة. ومحمد إقبال، كما نبهنا إلى ذلك أعلاه، هو ضد التفسيرات المشطة للقرآن الكريم والتي تلتمس البعد الإعجازي العلمي لبعض الآيات تماشيا مع الاكتشافات والنظريات المعاصرة. "فإذا كان إقبال يتعامل تقريبا مع الكتاب المنزّل بصفته مصنفا علميّا له رموزه، إلا أن الرموز بالنسبة إليه لا تفكك إلا بعديّا، بعد أن تكون النظرية قد أنتجت"([23]).
فليست القضية بالنسبة إليه قضية إضفاء طلاء علمي على بعض الآيات القرآنية حتى يبدو القرآن متماه مع العلوم العصرية، بل هو موقف مبدئي منفتح على النظريات العلمية ونقدها انطلاقا من أرضية فلسفية-دينية. هذه القراءة العلمية تسمح أيضا بتعديل البعد الفلسفي-الديني على ضوء السقف المعرفي الذي وصلت إليه الحضارة الإنسانية. هذا بالضبط ما يدعو إليه القرآن نفسه عندما يدفعنا إلى النظر في الكون واستخلاص السنن المنبثقة منه.
الخاتمة
إن هذا العمق والتجريد هو الذي لم يسمح لفلسفة محمد إقبال بالانتشار في العالم الإسلامي؛ لأن هذا الانتشار كان يتطلب مستوى معين من التفكير والإدراك والاستيعاب لم يكن متوفرا عند التفكير الديني المهيمن في تلك الفترة. فرؤيته التجديدية الحضارية، ومنحاه الفلسفي ذو الطابع الشمولي الذي يجمع بين أصول الإسلام، ومنهج الفلسفة الغربية، جعلا مشروعه مهمشا ومحاصرا إلى فترة طويلة. فالتربة الفكرية كانت مهيأة لهيمنة التصور الأصولي الذي كان يرى أن حل الأزمة يتلخص في إزالة الفكر الإسلامي من الشوائب التي عكرت صفوه. وأصدق تعبير على هذا التوجّه أتى من مفكر هندي آخر، أبو الأعلى المودودي، حين قال: "التجديد في الحقيقة عبارة عن تطهير الإسلام من أدناس الجاهلية، وجلاء ديباجته حتى يشرق كالشمس ليس دونها غمام". وهو تيار يرى أن سبب تقهقر العرب والمسلمين وضعفهم يعود إلى أنهم هجروا تعاليم الإسلام الصحيحة، وافتتنوا بحضارة الغرب وبأفكاره. وتتبنى معظم أدبيات هذا التيار، حيث أنها من جهة تنادي بـ"العودة إلى الذات" جاعلة منها أساسا محوريا لمشروع النهضة الحضارية، ومن جهة ثانية، ترفض التعامل مع الآخر وخاصة الغرب وتدعو إلى مواجهة فكره ومنهجه مواجهة شديدة.
إن الفاصل الأساسي بين نظرية محمد إقبال وما يدعو إليه الفكر الديني التقليدي، وخاصة السلفي منه، هو الطابع الثبوتي الذي يصبغ تصورات الأخير مقارنة بالطابع الحركي الذي يؤسس له الأول. فقد تأثر خطاب الديني التقليدي، منذ القرن التاسع عشر، بالوضعية الاستعمارية التي كان يعيشها العالم الإسلامي، مما جعله يكرس جهده لرد الاعتبار للدين والتراث وجعله لا يقترح أي حلول/ردود للتحديات/الإشكاليات التي فرضتها عليه الحداثة إلا كموقف رجعي ودفاعي صرف قوامه التقليد والاستعمال الجامد للتاريخ. و"يرى الأستاذ طارق البشري أن الدعوة الإسلامية ظهرت في أواخر العشرينات كدعوة لاسترداد الأرض المفقودة أو الأرض المغزوة بالمعنى العقائدي الحضاري السياسي، ولذلك ظهرت كدعوة لمطلق الإسلام... فالخطاب السياسي المعادي للاستعمار له حضور بارز ضمن نسيج هذا الفكر... وتحول في أغلبه إلى نزعة خطابية مثالية، هدفها تمجيد الماضي وتجاهل الحاضر"([24]). إذن جزء من هذا الفكر الثبوتي له مبرراته الظرفية الاستراتيجية، وأما جزؤه الآخر فهو متأت من تصور للنص القرآني، حيث أنه يُرى كحاو على سور مفصّلة ومنفصلة تتضمن مجموعة من الآيات والمفاهيم والأحكام (تتمحور أكثريتها حول العبادات والمعاملات)، واهتمامه بالمسائل الكبرى كالوحي والنبوة والدين والزمان والمعرفة والإنسان ضعيفا أو غائبا تماما. بينما "الرؤية التجديدية الحداثية تنظر إلى القرآن بوصفه نصا ذا بنية متميزة ومنطق داخلي وأن به علاقات بينية تربط مختلف الدلالات ضمن حقول ودوائر مفاهيمية واضعة بذلك تراتبية للمعاني المميزة للخطاب القرآني"([25]).
ويبدو أن الأوضاع بدأت مؤخرا تتغير حيث ظهر خطاب جديد يحاول الإجابة عن التحديات المطروحة على الفكر الإسلامي المعاصر، خطاب ذو توجه تجديدي حضاري شامل، بما أن الأزمة إنسانية وعامة في جوهرها، تيار لا يقتصر على خطاب اجتهادي يخص قضية معينة في ذاتها، أو دعوة إصلاحية لمقاومة الجمود والتخلف والتبعية للغرب على أهميتها. ومع مواصلة اهتمامه واطلاعه على الفكر الغربي العلمي، فإن هذا التيار التجديدي يرنو إلى تفكيك الإشكاليات وإعادة تركيبها بانتهاج المنظور المتآلف والنقدي (l’approchesynthètique et critique) مما يسمح بتجاوز النماذج الاختزالية أو الجزئية أو السطحية، ويساهم في توعية الإنسان المسلم بقضاياه وفي تحديد الغايات الكبرى التي يسعى إلى بلوغها. ومن هؤلاء المفكرين المهتمين بالفعل الحضاري المتحرك والفعال، والذين يمكن أن ننعتهم بورثة أفكار محمد إقبال التجديدية (أو على الأقل جزء منها)، نذكر على سبيل المثال مالك بن نبي وعبد الوهاب المسيري ومحمد أبو القاسم حاج حمد وفضل الرحمن وطه عبد الرحمن ومحمد مجتهد الشبستري وعبد الكريم سروش. كل هؤلاء المفكرين المجددين، وغيرهم، ساهموا مساهمة فعالة في تعميق فهمنا للعوامل الجوهرية التي تقف وراء البناء الحضاري، انطلاقا من فهم للواقع المعاصر ومن محاولات تأويلية جديدة للقرآن ومن مكانة الإنسان في الكون([26]).
الهوامش
([1]) للأسف، نشأت فلسفة محمد إقبال في بيئة بعيدة كل البعد عن الثقافة الفلسفية، وظهرت وكأنها مقطوعة الصلة عن بيئتها الثقافية. فقد عبر فضل الرحمن عن هذه الوضعية بالقول بأنه: "لابد أن نلاحظ بأن المسلم يظل متخلفا، خاصة في حقل الفكر البحت، أو الثقافوية الفلسفية. وليس من قبيل الصدفة ألا تعرف الحداثة الإسلامية أي طالب جاد للفلسفة، في طوال العالم الإسلامي وعرضه، يمكن الافتخار به سوى محمد إقبال"، انظر: فضل الرحمن، الإسلام وضرورة التحديث، نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية، بيروت: دار الساقي، 1993، ص110.
([2]) رحمة عثمان محمد فضل الكريم، موقف التيارات السلفية من الفلسفة المعاصرة، على الرابط الإلكتروني:
http://omerhago.blogspot.ae/2013/09/blog-post_19.html
([3]) هذا الكتاب هو عبارة عن محاضرات ألقاها محمد إقبال باللغة الإنجليزية، ما بين عامي 1928-1929م، تلبية لطلب الجمعية الإسلامية في مدراس بالهند، وأكملها في مدينتي حيدر أباد وعليكرة الهنديتين، وصدرت في كتاب باللغة الإنجليزية مع بداية ثلاثينيات القرن العشرين، وترجمت إلى اللغة العربية وصدرت في القاهرة مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. كما أن هذا الكتاب يمثل آخر مؤلفاته غير الشعرية والذي سمح له بأن ينال شهرة كبيرة حيث شرح فيه فلسفته وأفكاره وتأملاته. ويعتبر زكي الميلاد أن هذا الكتاب: "واحدا من أثمن ما أنتجته المعرفة الإسلامية في العصر الحديث" وهو متعجب أنه "بعدا عن التداول والاهتمام، وإلى اليوم لم يتغير وضعه الذي كان عليه من قبل، حيث مازالت المعرفة به محدودة للغاية، وقليلون الذين تعرفوا على هذا الكتاب، واطلعوا عليه، حتى من المثقفين أنفسهم، ومن طلبة العلم كذلك". انظر: زكي ميلاد، محمد إقبال وتجديد التفكير الديني في الإسلام، على الربط الإلكتروني:
http://iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArticle&ArticleID=691
([4]) أحميدة النيفر، الإنسان والزمان في منظومة محمد إقبال التجديدية، على الرابط الإلكتروني:
http://www.kalema.net/v1/?rpt=879&art
([5]) محمد الصادق بن غزالة، فلسفة التجديد الحضاري في فكر محمد إقبال، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في فلسفة الحضارة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2013، ص28.
([6]) أحميدة النيفر، الإنسية وحداثة القراءة القرآنية: من إقبال إلى طه عبد الرحمن، على الرابط الإلكتروني:
http://www.hurriyatsudan.com/?p=57374
([7]) محمد الصديق بن غزالة، فلسفة التجديد الحضاري في فكر محمد إقبال، م، س، ص59.
([8]) فمثلا، ترى النزعة المادية؛ كالفلسفة الماركسية والتصور العلمي المادي ونظرية التطور، أن حقيقة وجود الله هي مجرد فكرة صنعها العقل، ولا يمكن أن تكون حقيقة موجودة في الخارج، وهي تعطي للمادة صفات الألوهية.
([9]) سليمان بشير ديان، الإسلام والمجتمع المفتوح، الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبال، م، س، ص68.
([10]) مصدق الجليدي، ختم النبوّة بديلا عن موت الإله أو بناء الحداثة في السياق الإسلامي، على الرابط الإلكتروني:
http://www.anfasse.org/index.php/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/2611-2010-07-04-16-25-19
([11]) محمد الصديق بن غزالة، فلسفة التجديد الحضاري في فكر محمد إقبال، م، س، ص79.
([12]) مصدق الجليدي، أنوار من أجل رؤى حداثية أصيلة، استراتيجية معرفية في مواجهة الجهل المقدّس والعلم المدنّس، تونس: الدار المتوسطية للنشر، 2014، ص53.
([13]) مصدق الجليدي، ختم النبوّة بديلا عن موت الإله أو بناء الحداثة في السياق الإسلامي، على الرابط الإلكتروني:
http://www.anfasse.org/index.php/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/2611-2010-07-04-16-25-19
([14]) يوسف محسن، مارسيل غوشية: استكشاف العلاقة بين الدين/الديمقراطية، على الرابط الإلكتروني:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182403
([15]) السيد ولد أباه، الدين وموانع الديمقراطية، على الرابط الإلكتروني:
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=73465
([16]) احميدة النيفر، الإنسية وحداثة القراءة القرآنية: من إقبال إلى طه عبد الرحمن، م، س.
([17]) محمد الصديق بن غزالة، فلسفة التجديد الحضاري في فكر محمد إقبال، م، س، ص90.
([19]) احميدة النيفر، الإنسان والزمان في منظومة محمد إقبال التجديدية، م، س.
([20]) يعتبر عبد الجبار الرفاعي أن البيئة الهندية التي عاش فيها محمد إقبال، حيث أنها بيئة زاخرة بتنوع الأديان، واللغات والتقاليد، والعادات والثقافات وتتسم باستعدادها لقبول الآخر والتعايش معه، ساهمت في إفادته "من المعارف الإنسانية بغض النظر عن مصدرها، سواء كانت غربية أم شرقية، ولم يصدر في مواقفه الفكرية من معايير عقائدية أو إيديولوجيا اصطفائية تنفي الآخر". انظر: عبد الجبار الرفاعي، محمد عبده ومحمد إقبال: رؤيتان في تحديث التفكير الديني، على الرابط الإلكتروني:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104347
([21]) عبد الجبار الرفاعي، محمد عبده ومحمد إقبال: رؤيتان في تحديث التفكير الديني، م، س.
([22]) احميدة النيفر، الإنسان والزمان في منظومة محمد إقبال التجديدية، م، س.
([23]) سليمان بشير ديان، الإسلام وضرورة التحديث: نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية، م، س، ص124.
([24]) عبد القادر بخوش، معالم مدرسة التجديد الحضاري في الفكر الإسلامي المعاصر: بن نبي والمسيري، على الرابط الإلكتروني:
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=693:ma3alem
([25]) احميدة النيفر، الإنسية وحداثة القراءة القرآنية: من إقبال إلى طه عبد الرحمن، على الرابط الإلكتروني:
http://www.hurriyatsudan.com/?p=57374
([26]) لم نتعرض لهؤلاء المفكرين لأن تركيزنا بالأساس كان على منظومة محمد إقبال، وإن ما قدموه من أفكار هو خارج نطاق هذه الورقة. ولكن نأمل أن نقدم دراسة وافية ومستفيضة مستقبلا لما اصطلح على تسميته بـ"مدرسة التجديد الحضاري".