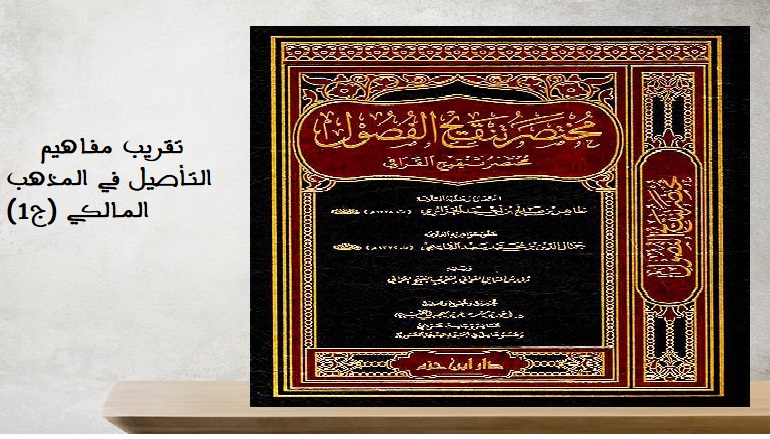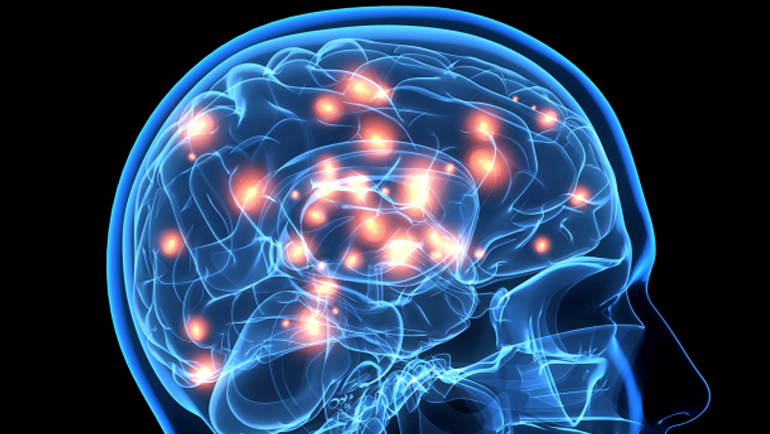
يستبطن التطرف بما هو تجاوز لحد الاعتدال، غُلوًّا وتشدُّدًا وتنطُّعًا، وهي جميعها أوصافٌ مذمومة جرى النهي عنها شرعا بصيغ مختلفة أثرت عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: "إياكم والغلو في الدين"[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون"[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشددوا على أنفسكم"[3].
وعلة النهي عن هذه الأفعال أنها تهدد باختلال أسس النظام الاجتماعي، وتصدع السلم الأهلي للأمة والجماعة، كما تفضي إلى تعسير دين الرحمة والتنفير منه، من خلال تكليف الخلق بما لا طاقة لهم به.
ولمواجهة هذه الظاهرة، اعتمد الإسلام نهجا في التبليغ والدعوة والمناصحة واضح المعالم، يقوم على "الحكمة والموعظة الحسنة": مصداقا لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: 125).
إن إيديولوجيا العنف والتطرف، تعبر عن شذوذ فكري تصوري، وانحراف منهجي عن جادة الهدي الإلهي، مهما كانت المبررات. كما تقوم على جهل مركب بأصول الدعوة، وذهول مريع عن منهجها ومقاصدها وفلسفتها؛ جهل بأن الأصل في الإيمان؛ العلم والإرادة والاختيار الحر، مصداقا لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: 255)، ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف: 29)، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: 99)، ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ﴾ (الغاشية: 21-22).
ولابد، بهذا الصدد، من استحضار أن الأصل في الخلق الاختلاف، المفضي إلى التعارف والتعاون، وأن الأصل في النبوة، إشاعة الرحمة ومكارم الأخلاق؛ "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"[4]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 106). وأن إيمان المرء لا يتحقق إلا بحبّه لأخيه الإنسان وإيثاره ونصحه، وحسن الظن به، والتماس الأعذار له؛ "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"[5]، ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر: 9).
كما لابد من استحضار أن مآل الخلق في الآخرة، موكول إلى رحمة الله وواسع علمه، فقبول الأعمال غيرُ مرهونٍ بظاهرها وحدهُ مهما حسُنت، وإنما هو مرهون بما يكنّه القائمون بها من سرائر ونيات..
ولا ريب أن النزوع للتطرف، والتوسل بأساليب العنف والإرهاب، لا يختص به مجتمع دون آخر، ولا حضارة أو ثقافة دون غيرها، ولا دين دون سواه. فمن خلال استقراء العديد من التجارب، نلحظ أن هذا النزوع يحكمه عاملان أساسان؛ يتمثل أولهما في الشعور الوثوقي بامتلاك الحقيقة، ويتجسّد ثانيهما في السعي للتماهي مع الجماعة المصطفاة بحثًا "يوتوبيًا" عن المعنى والكرامة والعزة والقوة والوحدة والتضامن والصفاء والخلاص.
فما يوحد الحركات المتطرفة، أنها تفتقر للوعي الضروري بمقاصد الدين، والتمييز ضمنه بين دائرة الأمور العقدية التوقيفية، التي تستوجب القطع والتسليم والتوقف، والأمور الدنيوية التوفيقية المصلحية، التي تستوجب النظر والاجتهاد، والموازنة والترجيح، كما تفتقر هذه الحركات للوعي بتعدد السياقات واختلافها، وما يقتضيه كل ذلك من تنسيب للمواقف والأحكام، كما تتّسم بعجزها المزمن عن إجراء التسويات والتوافقات اللازمة مع الذات ومع الآخر.
إن الرابطة المحمدية للعلماء حينما تصدّت لمقاربة هذه الظاهرة المدمّرة، إنما تصدّت لها بقصد التحليل والتفسير، سعيا للفهم، واقتراح ما تراه مناسبا من علاج، انطلاقا من كونها أكاديمية للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي، وليس بقصد الإدانة فحسب. وقد قاربت الرابطة هذه الظاهرة بعد إجراء أبحاث ضافية حولها، طبيعةً ومنشأً وتطورًا، وتجميع ما تمكنت من الوصول إليه من مراجع وآراء ورؤى وخبرات حول الموضوع، بتنظيم العديد من الفعاليات العلمية (ندوات، ورشات، ملتقيات، ملفات علمية، تثقيف بالنظير، برامج تكوينية، شراكات، تفكيك للخطاب المتطرف...).
وفي هذا السياق جرى التساؤل عن:
ـ ما هي العوامل والمحددات الذاتية والموضوعية، التي تحمل طائفة من الناس على المفاصلة وقطع الجسور مع واقع مجتمعاتها، تمهيدًا لمعاداتها وإعلان حرب شاملة عليها، بأساليب عنيفة، بعد تكفيرها وتفسيقها؟
ـ ما هي المحددات السيكولوجية والسوسيولوجية؛ الثقافية والاقتصادية والسياسية، وما هي العوامل الداخلية والخارجية، الوطنية والإقليمية والدولية الحاكمة لهذه الظاهرة والمغذِّية لها؟
فأخطر ما يمكن أن يتهددنا في ظل هذه الفتنة العمياء؛ هو أن تختلط علينا المذاهب، وتختلّ لدينا المعايير، وتصاب بوصلة وجهتنا بالجنون والعبث، وتستغرقنا مجريات الأحداث، ودهاليز الفوضى ومتاهاتها، وهو الأمر الذي يجعلنا ننهج نهج التشمير لمواجهة التدمير، والتفكير والتدبير، لمواجهة التمزق والتتبير.
ووجه المفارقة ألا تكون استجابة الأمة في مستوى التحديات التي تواجهها، وأن تخطئ وجهة معركتها، وتجهل هوية أعدائها، فترتد على ذاتها، تدميرًا وتعطيلاً لقواها الذاتية.
إن الجماعات المتطرفة، عادة ما تستغل القلق الوجودي، والفراغ الروحي والنفسي، من خلال نزعتها الطهرية والوثوقية، ووعودها بتقديم حلول جذرية وناجزة، للأوضاع القائمة، التي يتم وصمها بالفساد والزيف، والظلم والانحلال والجاهلية..
ومع أن مزاعم ووعود هذه الجماعات لا تنطلي تلقائيا على الكافة، إلا أن هناك أشخاصا ممن لديهم القابلية النفسية للاستجابة لخطابها، وبوجه خاص من ضمن فئة الشباب، ممن يصدرون عن معيارية أخلاقية حدية صارمة، ويعبرون عن مشاعر الاستهجان والنفور من الازدواجية بين القول والفعل، بين الواقع والمثال، وكذا من غياب القدوة.. في ذهول تام عن الطبيعة المركبّة والنسبيّة للواقع الاجتماعي والسياسي، والحقيقة الإنسانية.. وهو الأمر الذي نبَّهَ إليه كل من الإمام العز بن عبد السلام (ت 660ﻫ) والإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت 790ﻫ) من خلال نفيهما لوجود مصلحة مطلقة أو مفسدة مطلقة وخالصة في المجال الحياتي..
وهنا يبرز الدور الحاسم لإشاعة الوعي النقدي، واستيعاب الحقيقة الدينية ضمن منظور مقاصدي، في أبعادها التاريخية والأنثربولوجية والسوسيولوجية والسيكولوجية. وكذا مسؤولية كل من الدولة والمجتمع، على توفير الوسائل والشروط اللازمة للتأطير الديني والثقافي والتربوي والرياضي والفني للمجتمع وبوجه خاص للشباب.
وهو الأمر الذي انتبهت إليه الرابطة المحمدية للعلماء، منذ أن استأنفت نشاطها، حيث خلصت إلى أن الاهتمام بالتنشئة الدينية السليمة للشباب، من المداخل الأساسية لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف. بعد أن تساءلت عن المصادر التي يستمد منها الشباب معرفتهم الدينية، وتبين لها أنه لابد من تعزيز فرص التلقي الديني القويم والآمن، حيث إنّ أكثر ما يوجه من معارف عبر القنوات القائمة، لا يصل إلى جمهوره الحقيقي. وأن الثورة المعلوماتية في زمن الفضائيات جعلت وظائف التبليغ تستلزم قدرًا غير يسير من النباهة والإبداع والمتابعة، في مراعاة وثيقة لاحتياجات الشباب وانتظاراتهم، وكذا متابعة مستدامة لما يوجه إليهم من مضامين تكتنز ما تكتنزه من ألغام فكرية واعتقادية ونفسية، في أفق دحضها وتقديم بدائل قوية عنها.
وانسجاما مع ما سلف، فإن قوة وفاعلية الاجتماع السياسي لأي بلد من البلدان، إنما تنبعان من مدى وعي هذا الاجتماع بتناقضاته واستيعابه لسلبياته، واستبطانه لوسائل علاج أدوائه وتجاوز أزماته. ذلك أن دينامية المجتمع، ومستوى الحصانة الذاتية التي يتمتع بها، يشكلان العنصر الحاسم والناجع في التصدي لكل الانحرافات الفكرية والسياسية التي من شأنها أن تواجهه. كما أن حصانة ومناعة وقوة أي نظام اجتماعي إنما تنبع، أول ما تنبع، من مدى رسوخ وفاعلية وصدقية مؤسسات الحكامة والتدبير فيه، وكذا من مدى تماسك وحيوية مشروعه المجتمعي والوطني، والنجاعة في التعريف والإقناع به.
فمما يميز الحركات المتطرفة، كونها تشكل مجتمعًا أخويًا مصغّرًا، متضامنًا ومتماسكًا، يستمد جاذبيته مما يعد به أصحابه الناس من وعود، وما يمنونهم به من أماني، وما يحاولون إضفاءه من معنى على حياتهم، بالنظر المقارن إلى واقع يرفضونه ويتوهمون أو يدَّعون رفضه لهم، وبالتالي فعلى أهمية معرفة طبيعة هذه الحركات، وما تقوم عليه من تصورات وتمثلات وعقائد وأفكار، فإنه لابد من الوقوف أيضا على طبيعة النظام الاجتماعي والسياسي والتعليمي التربوي والقانوني والثقافي الذي يبرّر لهؤلاء قيامهم باستقطاب الأفراد للبحث عن المعنى خارجه، والبحث عن الكرامة والوحدة والعزة والصفاء في منأى عنه!
وهو ما يؤكد أن النجاح في إرساء أسس دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون والحريات والمعرفة والعلم، المتشبعة بقيم الإسلام وهديه، كفيل بأن يسهم بدوره، في إلجام منازع التطرف والغلو إلى أقصى الحدود.
فكلما سادت منظومة القيم القرآنية، في الاستخلاف والتعمير والشورى والحرية والمساواة والعدل والتعاقد والتعارف والمآخاة والتسامح والاختلاف والغيرية، وشكلت قوام الاجتماع السياسي والحضاري والنظام العمراني للأمة، ينعدم النزوع إلى مفاصلة الجماعة ومنابذتها بحثا عن ملاذ بديل.
حري بالتنبيه في هذا المقام، أنه كلما استفحل فقر المجتمعات الإنسانية من الوجهة الاقتصادية/المادية، والمعنوية/الرمزية، والأخلاقية/الجمالية، ازدادت إمكانية نزوع أفرادها للتطرف والتعصب، ما يجدر بذل كل الجهد المستطاع لاستدراكه.
ورغم كل الآثار المباشرة لهذه الإيديولوجية الإرهابية، التي أساءت لفريضة الجهاد أيما إساءة، وأفقرت مغزاها وفلسفتها الحضارية العميقة إلى أبعد الحدود، إلا أن المآلات البعيدة لهذه الفتنة بما أحدثته من صدمة وخلخلة مزلزلة للبنيات الذهنية والتاريخية للمسلمين، وبما أثارته من مراجعات عميقة للذات يتعين أن يتم توجيهها للاضطلاع بدور "المصل" فتشكل رغم كل الجراحات والتمزقات والابتلاءات المترتبة عنها، والتي لازالت سارية، حافزًا لبلورة وعي إسلامي حضاري جديد، ينخرط المسلمون تدريجيًّا من خلاله وفي ضوئه، في عصرهم بإيجابية وفاعلية أكبر..
وهو الوعي الذي تعمل الرابطة المحمدية للعلماء، بكل ما أوتيت من قوة ووسع، لتمثله وإشاعته وتنزيله في دنيا الناس، من خلال مختلف فعالياتها العلمية والتأطيرية، تحث الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.
الهوامش
[1]سنن ابن ماجة، كتاب المناسك، بَاب قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ.
[2] صحيح مسلم، "كتاب العلم"، بَاب "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ".
[3]. سنن أبي دواود.
[4]. رواه: أحمد، ومالك، والبخاري في "الأدب المفرد"، والحاكم، والبيهقي في "الشعب"، وعند بعضهم: "لأتمم صالح الأخلاق". انظر: "المسند" (17/80/رقم8939- تكملة شاكر "جامع الأصول" (4/4)، "السلسلة الصحيحة" (1/75).
[5]. صحيح البخاري، الإيمان (13).