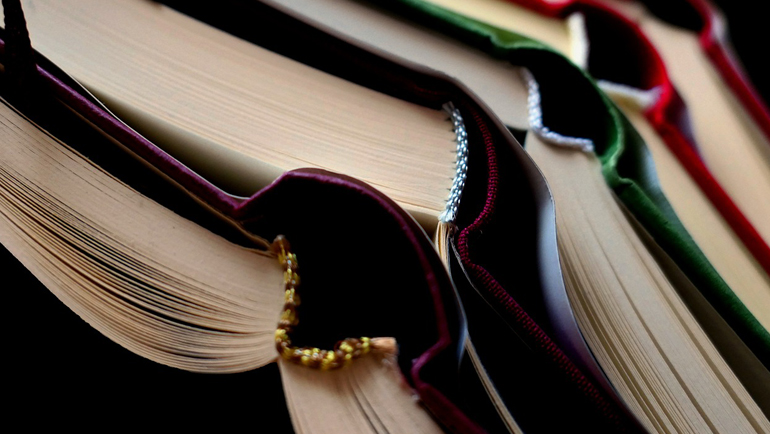جَور الصَّنعة الإعرابيّة على البَيانِ القُرآنيّ والحاجَةُ إلى نَحو جَديدٍ
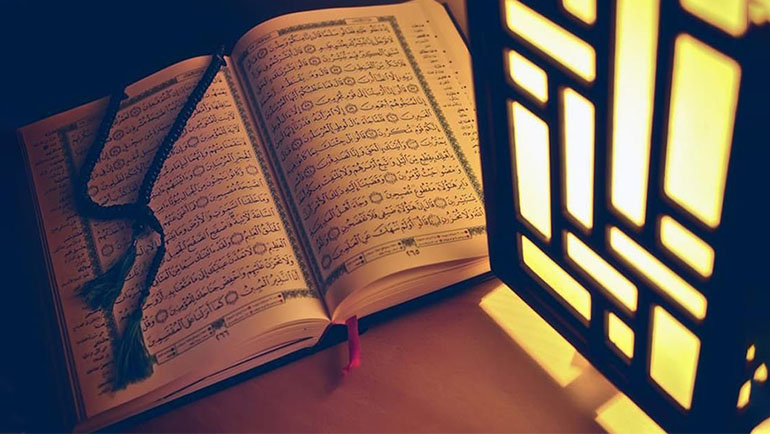
تمتلئُ كُتُبُ التّفسيرِ بِما لا يَكادُ يُحْصى من التَّخْريجاتِ النَّحْويّة و الأعاريبِ المُقَدَّرَة ، التي أثْقَلَ بِها كَثيرٌ من المُفَسِّرين كاهِلَ الآياتِ القُرْآنيّةِ ، ممّا هي في غِنىً عنه ، حيثُ أثاروا مُشْكلاتٍ نحويّةً قدَّروها تقديرًا ، و فَرَضوا على النّصوصِ البليغةِ قَواعدَ و مُقَرَّراتٍ مُتَكَلَّفَةً .
من ذلك قولُهم في قولِه تَعالى : «وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» إنّ اللاّمَ في (وَ لَسَوْفَ) إن كانت للقسَم لا تَدْخُلُ على المُضارِع إلاّ مع نونِ التّوكيدِ ، و إن كانت للابْتِداءِ فإنّها لا تدخُلُ إلاّ على جملةِ المبتدَإِ و الخبر ، فإذا كانت الآيةُ لا تستجيبُ للقاعدةِ النّحويّةِ فإنّه يتعيَّنُ تقديرُ ما به تَسْتَقيمُ الصَّنْعَة ؛ فقد ذَهَبَ جارُ الله الزّمخشريّ في “الكَشّاف” (1)، إلى أنه «لا بُدَّ من تَقديرِ مبتدإ محذوفٍ، وأن يكونَ أَصلُ العبارة : و لأنت سوفَ يُعطيك ربُّك فَتَرْضى» [سورة الضحى:5] ، وإلى مثلِ ذلك ذَهَبَ أبو حيّانَ النّحويُّ المُفَسِّر في كِتابِه “البَحْر المُحيط” .
فالعِبارةُ القُرآنيّةُ على قدرٍ كبيرٍ من البَيانِ و البلاغةِ ، و لا تَحْتاجُ إلى تَقْديرِ لفظٍ مَحذوفٍ أو تأويلٍ أو زِيادةٍ أو نُقصان ، و هي حُجّةٌ في ذاتِها و أصلٌ تُعْرَضُ عليه كلُّ قاعدةٍ لُغَويّةٍ ، و لا تَحْتاجُ إلى تَقْديرِ أصلٍ مَوْهومٍ نَقيسُها عليه .
وممّا ذَكروه أيضًا في الآيةِ نفسِها ، قولُهم : كيفَ تجتمعُ لامُ التّوكيدِ مع سوْفَ التي تُفيدُ التّسويفَ والمُماطَلَة؟ و الجوابُ أنّ العَطاءَ حاصلٌ لا مَحالةَ، و لا يَتَخَلَّفُ و إن تأخَّرَ لِما في التّأخيرِ من مَصلَحة. والظّاهرُ أنّ حسَّ العربيّةَ ومألوفَها، يقضي بأنّ العبارةَ القرآنيّةَ ، تُفيدُ أنّ البيانَ يتّسقُ هنا و يتكاملُ بلفظِ “سوفَ” ، إيناسًا للرّسولِ صلّى الله عليه و سلَّم ، بأنّه كانَ و سَوْفَ يظلُّ موضعَ عنايةٍ من ربِّه سُبْحانَه (2).
وممّا ذكَروه أيضًا أنّ “إذا الشّرطيّة” لا تدخُلُ على الجملةِ الاسميّةِ، وهي واردةٌ في كثيرٍ من آياتِ القرآن ، نحو قولِه تعالى : «إذا السّماءُ انْشَقَّت» [الانشقاق: 5] ، فتأوّلوها بأنّ الاسْمَ المرفوعَ هو فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ يُفَسِّرُه المَذكورُ ، و التّقديرُ : إذا انشقَّت السّماءُ انشقّت، والحقيقةُ أنّ تقديرَ أصلٍ مَوْهومٍ لهذه العِبارةِ ، لا يُصلِحُ العبارةَ و لا يُقيمُها ، و لكنّه يُخْرِجُها عن أصلِها و سَلامَتِها وجَمالِها، ولا يميزُ بين “إذا الشّرطيّةِ” التي دَخَلَت على الفعلِ ، و “إذا الشّرطيّة” التي دَخَلَت على الاسمِ المرفوع؛ فلكلِّ مَقامٍ مقالٌ، و لكلِّ لفظٍ مَعنى .
والأمثلةُ على تأويلاتِ النُّحاةِ للعباراتِ القُرْآنيّةِ أكثرُ من أن تُحْصى ، امتلأت بها كُتُبُهم و تَفاسيرُ كثيرٍ من المُفَسِّرينَ ذَوي المَنْزع النّحويّ .
الحاجة إلى “نحْوٍ عربيٍّ جديد”:
هكذا حجبَ عنّا النّحاةُ –من خلالِ قواعِدِهم القاصرة– كثيرًا من القيم اللّغويّة والبلاغيّة التي تمتلئ بِها القراءاتُ القرآنيّةُ و نُصوصُ الحديثِ النّبويّ و كثيرٌ من الموادِّ اللّغويّة المبثوثة في بطونِ كتبِ اللّغةِ و الأمثالِ و الأخبارِ، وبنوا على الوارِدِ من الشّواهدِ ، ففرضوا بقواعدِهم الصّارمةِ غرْبَةً على لسانِ العربِ و على المتكلّمين الذين خَلَفوا من بعدِهم على مرِّ التّاريخ .
ولقد أصبحْنا أمام هذا الوضعِ الذي أَلزَمت به قواعدُ النّحاة لسانَ العربِ، وإزاءَ هذه الغربةِ التي فرضتْها عليه ، في حاجةٍ إلى “نَحْوٍ جديدٍ” يفكُّ الطّوقَ عن اللّسانِ ويُحرِّرُه من قيودِ القواعدِ الصّارِمةِ ، و يُطْلِقُ العنان لمادّةٍ لغويّةٍ ضخمةٍ، ما زالت حبيسةَ المصادِرِ .
وقد تنبّه كثيرٌ من العلماءِ منذ القديم إلى قصورِ هذه القواعد، منهم شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّةَ، وفخر الدّين الرّازي المفسِّر ، و أبو حيّان النّحويُّ الأندلسيّ صاحبُ تفسير “البحر المحيط” ، و أبو عمرو الدّاني المُقْرِئ ، و ابنُ حزمٍ الظّاهريّ صاحب “الفصلِ بين الأهواءِ و الملل و النّحل”، و الحريري صاحب “درة الغوّاص في أوهام الخواصّ”، و ابنُ المنير صاحب “الانتصاف من الكشّاف”، وجلال الدّين السّيوطي صاحب “الاقتراح في أصول النّحو”، وغيرُهم …
و نادى كثيرٌ من الباحثين المعاصرين بوضعِ نحوٍ جديدٍ للعربيّة يُدرِج في الاستشهادِ النّصوصَ الكثيرةَ التي أهمَلَها النّحويّون [نادى كثيرٌ من الباحثين بوضعِ نحوٍ جديدٍ للعربيّة يُدرِج في الاستشهادِ النُّصوصَ الكثيرةَ التي أُهْمِلت من قبل النّحويّين (3).
أجَل، نادَوْا بوضع نحو جديد للعربية يُدرجُ في الاستشهاد النصوصَ الكثيرةَ التي أهمَلَها النحويونَ، ويوسِّعُ القواعدَ حتّى تُصبِحَ ذاتَ طاقةٍ استيعابيّةٍ عاليةٍ ، و قدرةٍ وصفيّةٍ و تفسيريّةٍ لِلِسانِ العربِ شاملةٍ ، و ليس هذا النّحوُ الجديدُ سوى إعادةِ بناءٍ لنحوِ النّحاةِ المألوفِ و إجراءِ تعديلٍ واسعٍ في قواعدِه التي تصطدمُ بالنُّصوصِ اللّغويّةِ الفصيحةِ كالقراءاتِ السبعيّةِ ، حتّى يستقيمَ و يسهلَ تحصيلُه و تعلُّمُه [انظر مواطن الاتّفاق بين قواعد النّحاة و بين القراءات القرآنية ونماذج من الحديث النّبوي، ومواطن الاختلاف و التّعارض، وضرورة تعديل القواعدِ وتوسيعِها حتّى تعبّرَ بصدقٍ عن اللّسان العربيّ، وفَكَّ عنها طوق الغربةِ الذي فُرِضَ عليها منذ قرون… واقْتِراحاتٍ منهجيّةً أوردَها الأستاذان أحمد مكّي الأنصاري وإبراهيم السّامرّائي في كتابَيْهِما المذكورينِ آنفًا. ثمّ إنّه يمثِّلُ أعلى مراتبِ القواعدِ فصاحةً وبيانًا ؛ لأنّه يتأسّسُ على لغةٍ نالت حظًّا وافرًا من التّهذيبِ والصّقل، والتّشذيبِ والتّصفية والتّطويرِ ، حتّى أضحت على رأسِ اللّهجاتِ العربيّةِ الفصيحة (4)، وأصحِّها نُصوصًا وأوثقِها سَنَدًا ومتنًا وأدقِّها تعبيرًا عن المقاصدِ القريبة والبعيدة (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش :
(1) الكَشّاف عن حَقلئق التّنزيلِ وعُيون الأقاويل: جار الله محمود بن عُمَر الزّمَخشريّ، دار الفكر ط.1 / 1397-1977، 4/219
(2) انظر في تفصيلِ هذا المعنى: التَّفْسير البياني للقرآن الكريم: د. عائشة عبد الرّحمن، دار المعارف، القاهرة، ط.5 / 1397-1977، 1/40-41
(3) انظرْ كتابَ: نظريّة النّحو القرآنيّ أحمد مكّي الأنصاري، في اتِّجاه وضعِ خطّةٍ عمليّةٍ لتطبيقِ “نحوٍ قرآنيّ” بعد تعديلِ القواعدِ التي تحتاج إلى تعديلٍ حتّى تُسايرَ النّصَّ القرآنيَّ المُحْكَم. وكتابَ: من سعة العربية / هل من “نحوٍ جديد ؟” إبراهيم السّامرّائي ، ص:205.
(4) ذكر عُلماءُ اللّغةِ قديمًا ورُواةُ الشّعرِ والعارِفون بلغات العربِ وأيّامِهم ومحالهم أن قُرَيْشًا أفصحُ العربِ ألسنةً وأصفاهم لغةً، وكانت وفودُ العربِ يفدون إلى مكّةَ للحجّ ويتحاكمون إلى قريشٍ في دارِهم. وكانت قريش مع فصاحتِها وحسنِ لغاتِها ورِقّة ألسنتِها إذا أتتهم الوفودُ من العربِ تخيّروا من كلامِهم و أشعارِهم أحسنَ لغاتِهم ، فاجتَمع ما تَخيّروا من تلك اللّغاتِ إلى سلائقِهم التي طُبِعوا عليها، فصاروا بذلك أفصحَ العرب . انظر: الصّاحبي في فقه اللّغة لابن فارس، والمزهر للسيوطي.
(5) انظر ما ذكره أ.د. فخر الدّين قباوة عن “النّحو القرآني” في حديثه عن وظيفة القرآن الكريم في الدّرس النّحوي وتكوين المهارات اللّغوية، في كتابه: المهاراتُ اللّغويّة و عُروبةُ اللّسان: 93-…