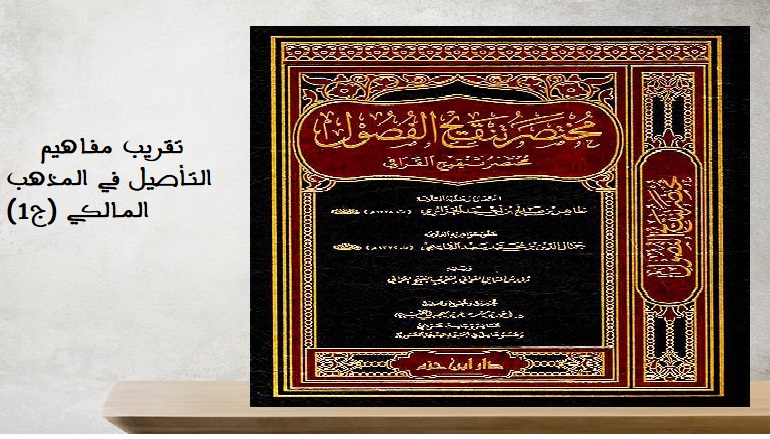إن من تمام التفضل والإنعام أن منّ الله تعالى علينا بنعمة الإسلام وخلقنا بهدي القرآن، وجعل من تمام ذلك التخلق: التحقق بالبيان لمعرفة أدلة الأحكام والتمييز بين الحلال والحرام.
ومعلوم أن استدرار المعاني الشرعية من دوالها الفقهية من آكد ما تتغياه العملية الاجتهادية. لذا بات لزاما على الناظرين في شرع الله أن يستفرغوا الوسع لضبط مناهج الاستمداد من الوحي.
وقد أدى ذلك الاستفراغ إلى ظهور أنماط من الاستدلال تروم التحويم حول إصابة القصد من التكليف.
والقول بالقصدية يستدعي ثنائية الشارع والمكلف، وهو ما درجت عليه الأبحاث المقاصدية.
ولما كانت معظم التكاليف الشرعية لها استمداد من علم العربية[1] فقد أولى حذاق هذه الشريعة ذلك العلم ما يستحق من العناية، واستعانوا على ما هم فيه بالقواعد الخادمة لقضايا المعاني والألفاظ. وأدى إغراقهم في ذلك إلى التعلق بالجوانب الإجرائية. فبقي الموضع مفتقرا إلى استحضار الأبعاد القصدية في علم العربية وهو ما سيعمل الموضوع على بيانه من خلال مقدمة تحتها أربع مسائل.
ـ أما المقدمة فتصدق على مسمى المقاصد اللغوية.
ـ وأما المسائل فستعنى بتجلية تلك المقاصد بما يلزم من الأمثلة الفقهية.
فأقول والله المستعان:
إن المراد بالمقاصد اللغوية ما يتقوم به نشد الأهداف الدلالية القائمة على الأصول السماعية والقياسية القاضية بتوجيه المعاني الإفرادية والتركيبية وفق ما جرى به العمل عند العرب في عرف لسانها وطرق تصريف أساليبها بناء على أن "القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن ينظر فيهما إلا عربي"[2]، قال الشافعي رحمه الله: "وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح جمل الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها"[3].
ووجه التحقق من جماع تلك المعاني وتفرقها استحضار أعراف الخطاب ومقاصده "فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن ثمّ عرف، فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه"[4].
ولا سبيل إلى درك مقاصد اللغة إلا برد أولها على آخرها، وآخرها على أولها؛ لأن "معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال"[5].
ووجه ذلك الرد أن نعتبر الشريعة كالصورة الواحدة، قال ابن حزم في الإحكام: "والحديث والقرآن كله لفظة واحدة، فلا يحكم بآية دون أخرى، ولا بحديث دون آخر. بل يضم كل ذلك بعضه إلى بعض، إذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض، ومن فعل غير هذا فقد تحكم بغير دليل"[6]، ولا شك أن الأخذ بهذا الاعتبار يفضي إلى الوقوف على المقاصد العامة للخطاب. فقد نبه الغزالي على أن القدر الذي ينبغي أن يبلغه المجتهد في اللغة يتحدد بمدى إدراكه لمقاصدها[7]، ومما انبنى على ذلك ضرورة استحضار مقاصد المستعمل للغة اقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قيم رحمه الله: "كان الصحابة أفهم الأئمة لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مقصوده ومراده"[8].
والقاعدة كما في عبارة ابن رشد الجد: أن دلالات الألفاظ "إنما تحمل على ما يعلم من قصد المتكلم بها"[9].
وقد تبعه على ذلك ابن الجوزية عندما ميز بين الطالب للقصد والواقف عند دلالة اللفظ فقال: "فالناظر العارف في الشريعة إنما يقول: ماذا أراد، واللفظي يقول: ماذا قال"[10].
وبه يعلم أن القول بالمقاصد اللغوية مسألة مسلمة في بابها عند أهلها المتحققين بها، فكانت بهذا الوصف هي الأصل الذي يتوقف عليه العلم بالوحي. وقد تعلقت بذلك الأصل أمور خادمة. والقاعدة أن الحق الحاكم على الخادم أن يكون تابعا له لا أن يعود عليه بالكر والإبطال.
ولقد اختلفت تلك الخوادم باختلاف العلوم والأغراض. وترتب عنها ظهور أنماط من القواعد أدى الاحتكام إليها إلى ضرب من الإجرائية التي تجافي في كثير من الأحيان المطلوبات الخبرية.
وهذه دعوى بحاجة إلى إقامة الحجة عليها صحة أو فسادا.
وسأعمل على تجليتها بصور فقهية من خلال المسائل الآتية:
1. مسألة تتعلق بدلالتي الأمر والنهي
إذ عليهما تتوقف معرفة الأحكام والتمييز بين الحلال والحرام، ولا خلاف بين علماء الشريعة في أصل دلالة الوجوبية لصيغة الأمر، إلا أن مقاصد الاستعمال وجهت تلك الدلالة إلى أمور منها:
2. عدم اقتصارها على إفادة الوجوب. فصيغة "افعل في عرف اللسان تدل على معاني أخرى كالإباحة والدعاء والتهديد والتكوين"[11] وغيرها، بل قد تدل على النهي كما ذهب البعض مستشهدا بقوله تعالى: ﴿فاعبدوا ما شئتم من دونه﴾ (الزمر: 14).
أ. عدم اختصاصها بالإنشائية، فقد يستفاد الوجوب من الخبرية كما يستفاد الخبر من الإنشائية.
ومثال الأول قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (البقرة: 226).
ومثال الثاني قوله سبحانه: ﴿فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴾ (التوبة: 83).
قال الفخر الرازي: "صيغة الأمر هنا، المراد بها الإخبار عن الذين تخلفوا عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأنهم يضحكون قليلا وسيبكون كثيرا"[12].
ولا خلاف بين علماء الشريعة في إفادة النهي للتحريم، واختلفوا في علاقته بدلالة الأمر، فذهب صاحب الكافية إلى "أن كل أمر نهي وخبر، وكل نهي أمر، وكل خبر أمر ونهي"[13].
كما اختلفوا في أولوية الأخذ بطرفي الفعل والترك في دلالتي الأمر والنهي.
فذهب بعضهم إلى أن "اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"[14].
وخالف في ذلك ابن تيمية فقال: "إن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات"[15].
بقي أن أشير إلى أن حضور القصد الدلالي في باب الأمر يدعو إلى بحث علاقته بالإرادة.
ولما كان الآمر الأول هو الله تعالى، فقد عقد الأصوليون مبحثا لتجلية موقع تلك الإرادة في الأوامر الشرعية، وخلصوا إلى البيان التالي:
"مراد الله تعالى من الخلق ما هم عليه من طاعة ومعصية:
فيأمر بما لا يريد في حق العاصي.
ويريد ما لا يأمر به وهو المعاصي من العصاة.
وفي حق المطيع مراده منه ما أمره به.
فما يفترق الأمر من الإرادة، والإرادة من الأمر إلا في حق العصاة"[16].
3. مسألة تتعلق بعلاقة العام بالخاص
لقد أفضت المسائل المحصلة من مبحث العام إلى الالتزام بضرب من القواعد تؤول إلى أمور منها:
أ. أن دلالة العام استغراقية وذلك للاحتراز عن القول بالبدلية في المطلقات.
ب. أن للعموم صيغا تدل بالاستغراق على الأفراد الداخلة في مفهومها دفعة من غير حصر.
ج. أن دلالة العموم ظنية لقبولها مبدأ التخصيص، وهو ضرب من الاحتمال ومما انبنى على ذلك أمران:
أحدهما: يتعلق بتنوع عرف اللسان في أوجه استعمال العمومات وهذا ما عبر عنه الشافعي بقوله: "وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن تخاطب بالشيء عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، ويستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره"[17].
ومن صور إطلاق العام وإرادة الخاص، قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون﴾ (البقرة: 5).
فلفظ "الذين" من صيغ العموم. لكن المقصود منها فئة من الكفار الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون تحقيقا لصدق خبر الشارع.
ومن أمثلة الاستغناء بعرف اللسان عن قواعد التخصيص من العام قول السيد لكبير عبيده: "اضرب كل من في الدار" فإن المأمور يعلم بضرورة خروج السيد من المأمور به دون حاجة إلى أن يسمع منه ما يفيد التخصيص بالاستثناء وهو قوله: "إلاّ أنا".
والأمر الثاني: يتعلق بأن إجراء قواعد العام بإطلاق قد يفضي إلى ضروب من الإشكالات.
وصورة المسألة: أن الأصوليين قرروا أن المفرد المحلى بأل من صيغ العموم القابل للتخصيص، ومثاله قوله سبحانه: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ (المائدة: 4).
ذلك أن لفظ "الميتة" عام خصص بقوله، صلى الله عليه وسلم،: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"[18]، والدم مثله في الإفرادية والتحلية، وفي معرض حديثهم عن قوله تعالى: ﴿إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ (الأنعام: 146)، عادوا ليعتبروا الدم في الآية الأولى مطلقا حتى يستقيم لهم القول هنا بالتقييد.
ووجه الإشكال هو تردد قولهم بين العموم والإطلاق وهو خلف فما أدى إليه مثله.
وليستقيم القول بحرمة الدم المسفوح وحلية غيره دون الوقوع في ذلك الخلف يمكن إجراء الاستدلال على النحو التالي:
أ. أن دلالة المنطوق في الآية الثانية تحرم الدم المسفوح، فكانت دلالة المفهوم بخلافه.
ب. أن المستفاد من مفهوم المخالفة هو حلية الدم غير المسفوح أي: المتجمد في العروق وغيرها، يشهد له قوله، صلى الله عليه وسلم،: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال"[19].
وبه يعلم أن الوقوف مع ما تقرر في بعض القواعد عند الإعمال، قد يوقع في تخلف الاطراد عند الاستدلال.
4. مسألة تتعلق بدلالة المطلق
من المقرر عند أهل الأصول والعربية أن دلالة المطلق شمولية بدلية للاحتراز عن القول
بالاستغراقية في دلالة العام، فهي بهذا الاعتبار من النكرات التي تدل على الفرد الشائع في الجنس عند النحاة. وعلى الماهية بلا قيد عند الأصوليين.
وفرق ما بين الفرد والماهية له تعلق بما يترتب عنه من أحكام فقهية.
وصورة المسألة ما إذا قال لزوجته: "هي طالق إن وضعت بنتا" فلما أتمت حملها وضعت بنتين.
فعلى مذهب من اعتمد الفردية لا تطلق لخروجها إلى الزوجية.
وعلى مذهب من استند إلى الماهية تطلق لتحققها في الفرد وغيره وعندي أن إعمال المقاصد اللغوية أقرب إلى مذهب القائلين بالماهية وهو المطلوب.
5. مسألة تتعلق بدلالة الالتزام
وبابها المنطوق غير الصريح، وأنواعها: الاقتضاء والإيماء والإشارة.
أ. ففي الاقتضاء عرضوا لقوله تعالى: ﴿وسئل القرية﴾ (يوسف: 82)، واتفقوا على أن المراد سؤال أهل القرية، إلا أن النحاة بنوا قولهم على العلم بالمحذوف، كما بنى البلاغيون قولهم على المجاز العقلي.
أما الأصوليون فقالوا بالاقتضاء؛ أي أن النص يقتضي إضمار مقدر تستقيم به الصحة العقلية.
والذي عليه المحققون أن العربي يفهم بمعهود اللسان أن المقصود هو سؤال أهل القرية دون حاجة إلى إضمار أو مجاز.
ونظير قوله سبحانه: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (النساء: 23). إذ بالسابقة يعلم المكلف أن الحرمة تنحصر في الجماع وما أشبه، ولا تنصرف عند السامع إلى مجالستهن أو السفر معهن مما يدخل في العادات والمباحات.
ب. وفي الإيماء عرضوا لقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (المائدة: 40)، واتفقوا على أن فاء التعقيب في الآية دلت بالإيماء على أن علة القطع هي السرقة.
وهذا تخريج به نظر لطرو الاشتراك على دلالات الحروف، لذا وجدنا من وجه المسألة بقاعدة أخرى هي: "تنزيل الحكم على المشتق مؤذن بعلية مصدر الاشتقاق".
فالمشتق في الآية هو السارق، والحكم هو القطع، والمصدر المشعر بالعلية هو السرقة.
ونظير هذا في الحديث قوله، صلى الله عليه وسلم،: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل"[20]، فالمشتقات في نص الحديث هي اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول.
والحكم هو رفع المؤاخذة عنهم، والمصادر المشعرة بالعلية هي: النوم والصغر والجنون.
ج. أما دلالة الإشارة فقد مثلوا لها بقوله سبحانه: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (البقرة: 186).
دل بالإشارة على جواز صوم من أصبح جنبا، وفي هذا تكلف لنهوض دلالة المنطوق عليها كما في حديث عائشة رضي الله عنها [21].
ولا معنى للعدول عن العبارة إلى الإشارة؛ لأنه من باب تقديم الأدنى على الأعلى، والقاعدة أن العمل بالأقوى أولى وأحرى.
ومصدر القوة في العبارة يكمن في منطوقها المتضمن لمقاصد اللغة ومعانيها التي لا يفهم الحكم إلا بها.
وضابط العمل بمسالك الاستمداد هو أن نتلمسها من طرقها عند أهلها المتحققين بها، ولا خلاف بينهم في أن رأسها وسنام أمرها هو العلم باللسان الذي نزل به القرآن.
ولا شك أن مسمى اللسان لا يحصل العلم به إلا بالتضلع من علوم العربية. ومعرفة أعراف مستعمليها وأوجه تصريفهم لأساليبها، وذلك لا يتأتى إلا باستحضار المقاصد العامة للخطاب، وجعلها في مجالي الفهم والاستنباط حاكمة. وما عداها من القواعد والشواهد خادمة، ولله ذر الشاطبي إذ قال: "لابد لمن أراد الخوض في علم القرآن والسنة من معرفة عادات العرب في أقوالها ومجاري عاداتها حالة التنزيل من عند الله والبيان من رسوله، صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل بها موقع في الإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة"[22].
هذا ما يسر الله تقييده بشأن مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الهوامش
1. قال الشاطبي عنها: " ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك... بل المراد جملة علم اللسان" ينظر الموافقات، 4 / 114.
2. الموافقات، 3 / 31.
3. الرسالة، 50.
4. الموافقات، 2 / 82.
5. نفسه، 3 / 347: ومما يعين على ذلك الأخذ بالمقتضيات العامة للخطاب من جهة نفس الخطاب أو طرفيه أو سياقاته المختلفة بناء على أن القرائن لا تبلغها غايات العبارات كما نص على ذلك الجويني في البرهان، 1 / 374.
6. الإحكام لابن حزم، 3 / 118.
7. ينظر المستصفى، 2 / 352.
8. إعلام الموقعين، 1 / 219.
9. مقدمات ابن رشد، 2 / 430.
10. إعلام الموقعين، 3 / 219.
11. مثال الإباحة، قوله تعالى: "إذا حللتم فاصطادوا"
مثال الدعاء، قوله تعالى: "اهدنا الصراط المستقيم".
مثال التهديد، قوله تعالى: "اعملوا ما شئتم".
مثال التكوين، قوله تعالى: "كونوا قردة خاسئين".
. التفسير الكبير، 6 / 50.12
. الكافية في الجدل، ص: 32.13
14. صحيح مسلم رقم الحديث من كتاب الحج، 2380، ولفظ الحديث: "فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
15. مجموع الفتاوى، 20 / 85.
16. نفائس الأصول، 5 / 325، ومثال أمره بما لا يريد قوله تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا ءلادم فسجدوا إلا إبليس..." الآية.
17. الرسالة، 52.
18. سنن الترمذي كتاب الطهارة، رقم: 64.
19. سنن ابن ماجة، رقم الحديث: 3209 من كتاب الصيد، ولفظ الترمذي: "أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".
20. سنن النسائي كتاب الطلاق، رقم الحديث: 3378.
21. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بمن اتقى" صحيح مسلم، كتاب الصيام، رقم: 1109.
22. الموافقات، 3 / 261.
أهم المصادر المعتمدة
• القرآن الكريم، رواية ورش. • الإحكام لابن حزم الظاهري. • إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية. • التفسير الكبير للفخر الرازي. • الرسالة للشافعي. • سنن ابن ماجة. • سنن الترمذي. • سنن النسائي. • صحيح مسلم. • مجموع الفتاوى لابن تيمية. • المستصفى للغزالي. • المقدمات الممهدات لابن رشد الجد. • الموافقات للشاطبي. • نفائس الأصول للقرافي.