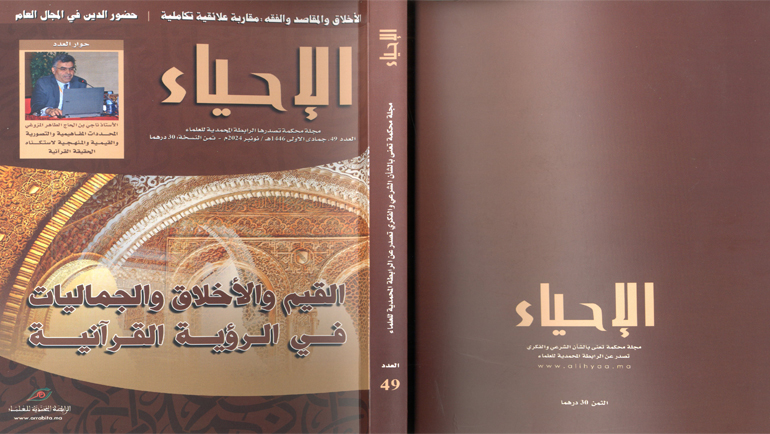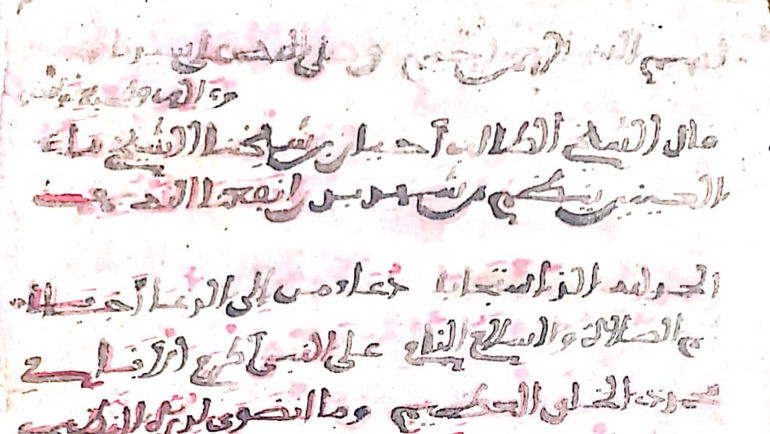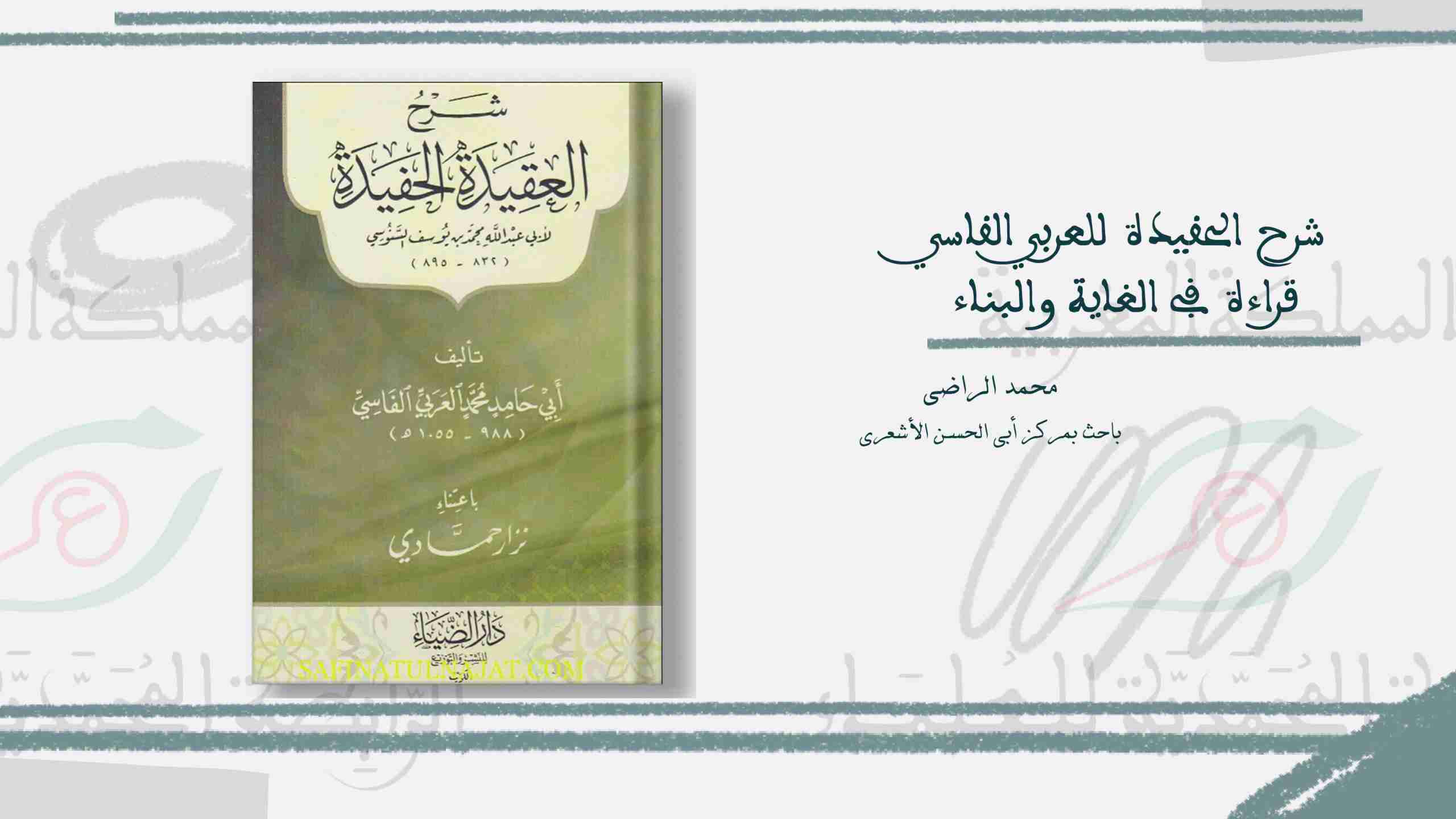المساءلة المعرفية التوحيدية ضرورة أنثروبولوجية وممارسة سيميائية.. “قراءة في المشروع الفلسفي لطه عبد الرحمن”

يُعد الفيلسوف المغربي "طه عبد الرحمن" واحدا من كبار الفلاسفة العرب المعاصرين الذين بلوروا فكرا فلسفيا إسلاميا يعبر بعمق عن هوية الإنسان العربي المسلم، ويشخص أزماته المعرفية والثقافية والحضارية، ويستشكل علاقته بالآخر ائتلافا واختلافا، مركزا وهامشا، تفاعلا وتصارعًا، استعمارًا واستثمارًا، ويقدّم البدائل النماذجية الفاعلة للخروج من وضعيات: التخلف الفكري، والترهّل الأخلاقي، والتقاعس العلمي، وكل أشكال القهر والهدر الاجتماعي والسياسي والحضاري، إلى وضعيات؛ التخلّق الفكري، والتألّق العلمي، والتراحم الاجتماعي.
ولعل تميز الطرح الفكري للرجل يعود إلى إحساسه العميق بأن الأمة الإسلامية تمتلك رأسمالا معرفيا ورمزيا لم يستثمر لحدّ الآن الاستثمار الأمثل الذي يخرجها من غيابات الجهل والفوضى والاضطراب ويخلّصها من آصار الانحرافات النفسية والضلالات السياسية؛ إذ حرصت الدول الاستعمارية الكبرى على أن تستنزف الرساميل المادية لهذه الأمّة، وتشككها في انتمائها وهوّيتها ومرجعيتها وتطمس معالم وآثار رأسمالها المعرفي وتفقدها الثقة فيه بإشاعة مختلف الأطروحات العدمية التي تقوّض الأسس والمبادئ والمرجعيات، وتزرع الشك والقلق في كل تفاصيل الوجود وأشكال المعرفة، بحيث لا يعود هناك يقين ولا حقيقة ولا اطمئنان.
ولذلك حرص "طه عبد الرحمن"، من خلال مشروعه، على تفكيك البنيات المفهومية الكبرى التي يستبطنها المشروع المعرفي الغربي، والكشف عن المسلمات المركزية التي تتحكم في حراكه الثقافي و الحضاري، وترسم رؤيته للإنسان والتاريخ والعالم.
وهذا بغية معرفة كيفية التعامل المنهجي الوجودي مع الآخر، وإنزاله المكانة الحضارية التي يستحقّها، وفي الوقت ذاته تنسيبه والحدّ من مركزياته وشوفينياته، للتخلّص من كل مستويات التابعية له.
يقول "طه عبد الرحمن": "لقد قام النمط المعرفي الحديث منذ نشأته في مطلع القرن السابع عشر على أصلين اثنين يقضيان بقطع الصلة بصنفين من الاعتبارات التي يأخذ بها كل متديّن؛ أما الأصل الأوّل، فيمكن أن نصوغه كما يلي: "لا أخلاق في العلم"؛ مُقتضى هذا الأصل أنّ لكل واحد، أو جماعة، أن يضع بنيان نظريته بحسب ما شاء من القرارات المعرفية والإجراءات المنهجية ماعدا أن يجعل فيها مكانا للاعتبارات التي تصدر عن التسليم بقيم معنوية مخصوصة أو عن العمل بقواعد سلوكية معينة.
وأما الأصل الثاني، فيمكن أن نصوغه كما يلي: "لا غيب في العقل"؛ مقتضى هذا الأصل أن لكل واحد، أو جماعة، أن يُركّب من العلاقات ويقيم من البنيات ما شاء عدا أن تكون بعض العناصر المرتبطة بهذه العلاقات أو الداخلة في هذه البنيات لا تفيد تحقيقات التجربة الحسّية ولا تقديرات العقل المجرّد في الإطاحة بكنهها أو بوصفها[1]."
ولقد أورث هذا النمط المعرفي الحديث أزمات مزمنة، أفرغت العالم من محتواه القيمي والأخلاقي والرمزي، "فالتقدم العجيب للمعارف [صاحبه] تقهقر للمعرفة بفعل هيمنة الفكر المجزّأ أو المقسم على حساب كل نظرة شمولية. وهكذا، فنمو حضارتنا، والقول لإدغار موران، يقودنا إلى تخلّف ثقافي جديد، وإلى تخلّف عاطفي، ولم يعد الناس قادرين على إيجاد جواب عن حاجتهم للتواصل الإنساني، والمحبة، والاجتماع، وإلى تخلّف أخلاقي في ظل تقهقر المسؤولية والتضامن[2]."
وأخطر هذه الأزمات التي جذّرها العقل الانفصالي التجزيئي هي "أزمة الصدق"، و"أزمة القصد"، مما أثر تأثيرا جسيما على العلاقة بين الأقوال والأفعال، والمنطلقات والغايات، وخلق اضطرابا وتشويشا في المنظومة السلوكية البشرية.
ومن ثم، فـ"النمط المعرفي الحديث غير مناسب إن لم يكن غير صالح للتوسّل به في بناء معرفة إسلامية حقيقية؛ لأن مناهجه العقلية ونتائجه العلمية تنبني على أصلين؛ أحدهما؛ فصل العلم عن الأخلاق، ويتفرّع عليه مبدأ الموضوعية الجامدة ومبدأ التساهل المسيّب، والثاني؛ فصل العقل عن الغيب، ويتفرع عليه مبدأ السببية الجامدة ومبدأ الآلية المسيّبة؛ لذا، يحتاج المتخلِّق إلى الدخول في تخليق يمدّه بنمط معرفي بديل محفوظ من هاتين الآفتين:
آفة الانقطاع عن الأخلاق وآفة الانقطاع عن الغيب؛ ولا تخليق أوفى بهذا الغرض من التخليق المؤيَّد؛ إذ يمكِّن من ربط العلم بالعمل عن طريق الكون مع الصادقين كما يُمكِّن من ربط العقل بالغيب عن طريق الأخذ بالمقاصد، ذلك أن هذين الطريقين: "الكون مع الصادقين"، و"الأخذ بالمقاصد" يولّدان في نفس المتخلّق فاعلية تعيد إليه تكامله المادي الروحي، فينهض إلى تطهير نفسه من الطبقات العقلية والعلمية الموروثة عن النمط المعرفي المتداول كما تعيد إليه رسوخ وحدة النظر والعمل، فينهض إلى تجديد المعرفة تجديدا يزداد فيه عملا بعلمه وكمالا بعقله، فيكون علمه نافعا وعقله كاملا[3]."
ومهما تعالت الأصوات الفكرية التي تدعوا إلى التعامل الفاعل مع الحضارة الغربية، ومحاولة الاستفادة من معارفها وتقنياتها وبرامجها عبر آليات النقد والتصحيح والمراجعة، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد حراك على السطح لا يستطيع أن يُجاوزه إلى العمق، فـ"الآفات التي [ حملتها] حضارة "اللوغوس" إلى الإنسان... [كـ] "النقص"، و"الظلم" و"التأزّم"، و"التسلط"، والتي تؤذي الإنسان في صميم وجوده الأخلاقي بما ييأس معه من الصلاح في حاله والفلاح في مآله، لا يمكن أن يخرج منها أهلها بمجرّد تصحيحات وتعديلات يُدخلونها على هذا الجانب أو ذاك من هذه الحضارة المتكاثرة.
نظرا لأن هذه التقويمات المحدودة ليست في قوة هذه الآفات الشاملة، حتى تقدر على محو آثارها وسوءاتها الأخلاقية؛ ولا أدلّ على ذلك من أنّهم لا يكادون يفرغون من إجراء هذه الإصلاحات أو تلك حتى تظهر لهم من تحتها إفسادات أتوها من حيث لا يشعرون، فيقومون إلى إصلاحها، فيجدون مرة أخرى من الإفساد ما وجدوا من ذي قبل، وهكذا من غير انقطاع.
وهذا يعني أن أخلاق السطح لا تنفع في الخروج من آفات العمق، بل لابد في ذلك من طلب أخلاق العمق، وهذه، على خلاف الأخرى تدعونا إلى الشروع في بناء حضارة جديدة لا يكون السلطان فيها لـ"اللوغوس"، وإنما يكون فيها لـ"الإيتوس"؛ (أي الخلُق)، بحيث تتحدّد فيها حقيقة الإنسان، لا بعقله أو بقوله، وإنما بخُلُقه أو فعله؛ فلا مناص إذن من أن نهيّئ الإنسان لحضارة "الإيتوس"، متى أردنا أن يصلح في العاجل ويفلح في الآجل[4]."
وهذا هو المدخل الأساس الذي تقوم عليه نظرية المساءلة عند "طه عبد الرحمن". فما طبيعة المساءلة؟ وما حدودها؟ وكيف تتميز المساءلة المعرفية التوحيدية عن غيرها من أنماط المساءلات الأخرى؟ وبأي معنى تكون المساءلة ضرورة أنثروبولوجية وممارسة سيميائية؟ وقبل أن نخوض في الإجابة عن هذه التساؤلات، يجدر بنا أن نوضح أوّلا طبيعة النسق المعرفي التوحيدي.
1. في مفهوم النسق المعرفي التوحيدي
المتأمل في تاريخ الفكر الغربي والمستقرئ لوحداته وأبعاده، يجده محكوما بمشكلات مزمنة على مستواه التجريدي المفهومي، منطويا على ثغرات كبرى انعكست باتولوجيا على متخيل الإنسان الغربي وذهنيته وأورثته قلقا مرجعيا لا يريم، فما إن يستقر على مرجعية معينة حتى تهوي عليها معاول الهدم ومطارق التفكيك.
إن تاريخه الفكري هو تاريخ "القطيعة بين الله والإنسان، والأخلاق والمنفعة، والأفكار والوقائع، وهو ما أوصل الشطح إلى حدّ العبثية العادمة والمعدمة حتى أعلن عن موت القيم والحقيقة والأخلاق والأمل والله والإنسان، وها نحن اليوم على أعتاب إعلان موت العالم[5]."
ولا يخفى على المتخصص في الشأن الفكري، ما يعانيه العقل العربي اليوم من جرّاء الاختراق الرموزي لمنظومته الفكرية الثقافية وتشكيكه في أسسه المرجعية، وتعرضّه لأبشع أشكال العنف الرمزي الممنهج؛ القائم على فلسفة الإمبريالية المفهومية والمقولاتية التي تبسط هيمنتها الكلية على سوق المعرفة والعلم والخطاب، ولم تترك الفرصة لهذا العقل العربي يسترجع أنفاسه، ويستبين طريقه ووجهته ويحدّد معالم خارطته الفكرية والوجودية.
ومن ثم بقي يلاحق تسارع هذه الأمشاج المنهجية ويطارد أشباحها وميثيولوجياتها بخطى متعثّرة، آملا في الوصول إلى سرابها العلمي، و"لا عجب أن يأخذ النسيان [نسيان الكينونة] يتداعى عند هذا الإنسان الأفقي بعضه إلى بعض، حتى يبلغ أقصى مداه، فلا يعود يذكر أنه مخلوق، فضلا عن أنه لم يُخلق عبثا، ولا حتى أنه إلى زوال محتوم إلى حين أن يأتي أجله على حين غِرّة، ويا ليته نسي ووقف عند حدّ نسيانه، بل إنه يمكُر ليل نهار من أجل أن يرى غيره ينسى مثلما نسي متوسّلا بكل أدوات النسيان، ترغيبا وترهيبا[6]."
لقد كان العقل الغربي خلاّقا على مستوى إنتاج المعرفة الأفقية والتقنية، وابتكار الشبكات المنهجية التحليلية والتفكيكية، فأنتج منظومات قرائية جدّ متطورة على مستوى الأمبريقية النصية والوضعانية الخطابية والإثنوغرافيا الثقافية، وغيرها...، ولكنه فشل فشلا ذريعا في بناء المنظومات الروحية والأخلاقية والقيمية على المستوى العمودي الكوني، فكلما استقرأنا التاريخ المفهومي للكائن الغربي انكشف لنا عري الأنساق المعرفية التي شيّدها حينا من الدهر. إنها في معظمها أنساق مادية صلبة أو أنساق مائعة حلولية، أو مجهولة المصدر والأصول والهوية لا نعلم حدود مرجعياتها ولا طبيعة منطلقاتها ومبادئها؛ فهي تنوس بين اللوغوس المادي الكوني والكاوس العدمي.
ولا ريب أن المرجع الوحيد الذي وضع حدًّا لهذا التخبط المفاهيمي والضلال المنهاجي والغيّ القرائي هو (القرآن الكريم)، ليس كمرجع وكتاب ديني بالمعنى السطحي، وإنما ككتاب معرفي منهاجي يستهدف بناء النسق الوجودي والمعرفي والقيمي للإنسان، وإمداده بالمنهاج المتكامل والمتوازن الذي يمارس به حراكه في العالم، ويخلّصه من آصار كل أشكال الاستعباد والاستتباع والكلالة التي كبّلته عبر التاريخ.
ولقد "أثّر التصور [القرآني] الجديد للإله الأسمى بعمق في بنية الرؤية للكون كلّيا؛ ذلك أن نظاما توحيديا ذا مركزية إلهية قد تأسس للمرة الأولى في تاريخ العرب [وتاريخ الإنسانية]، نظاما يحتل مركزه الإله الواحد الوحيد بوصفه المصدر المتفرّد لكل الأنشطة الإنسانية، ولكل أشكال الكينونة والوجود في الحقيقة.
وهكذا أصبحت كل الأشياء الموجودة والقيم رهنا بإعادة تنظيم كاملة، وتوزيع جديد. إنّ كل عناصر الكون بلا أي استثناء، اجتثت من تربتها القديمة وأعيد زرعها في حقل جديد، وقد خُصّص لكل عنصر من العناصر موقع جديد، وارتبطت بعلاقات جديدة فيما بينها. كما أنّ المفاهيم التي كانت سابقا غريبة تماما عن بعضها قد أدخلت في علاقات صميمية، والعكس صحيح؛ أي أن المفاهيم التي كانت مترابطة بقوة في ما بينها في النظام القديم أصبحت منفصلة في النظام الجديد[7]". وهذه هي المساءلة المعرفية الجذرية التي اعتمدها القرآن الكريم، بمعنى تفكيك منظومة المفاهيم السائدة وإعادة تركيبها بما ينسجم وبنائية الكون وعمرانية الوجود؛ منطلقا وحراكا ومآلا.
كما أن "الاعتراف بمكانة الله بوصفه الإله المتفرّد للكون كلّه، في عالم الموجودات فوق الطبيعية، قد جرّد... كل ما يدعى بـ (الآلهة) من واقعيتها كلها.
إنها مجرّد أسماء لا تقابلها كينونة حقيقية توجد خارج اللغة. وبمصطلحات علم الدلالة الحديث، علينا أن نقول إن كلمة "إله" (الجمع: آلهة) عندما تستعمل للإشارة إلى أي إله غير الله ذاته، فإنها ليست سوى كلمة لها معنى إيحائي (connotation) لا معنى حرفي (dénotation). إننا نقرأ في سورة (يوسف): ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهاَ أَنْتُمِ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ الآية 40.
وإلى جانب ما يُدعى بالآلهة ثمة... أيضا أنواع قليلة أخرى من الكائنات فوق الطبيعية التي كانت تُعبد وتُخشى وتُبجّل، بدرجات متفاوتة بحسب الأماكن والقبائل، وهي:الملائكة والشياطين والجن. وهذه كلها اتخذت مكانتها واندمجت في النظام الجديد للتصور [القرآني] للعالم مع بعض التعديل الأساسي الذي يأخذ بالاعتبار منزلتها الموقرة ووظيفتها في الهيكل التنظيمي العام[8]."
فالقرآن كنسق معرفي توحيدي يُحدث نوعًا من الضبط التصوري لمختلف البراديغمات البشرية، وهو محكوم على مستواه المرجعي باستراتجيتي؛ الاستيعاب والتجاوز للمناهج الصادرة عن تجربة الوعي البشري؛ الاستيعاب بمعنى "التضمين" الذي يبدو مضمرا "مكنونا"، فليس بالضرورة أن يأتي التضمين نصّا قاطعا. والتجاوز بمعنى "الصيغة الكونية" لهذه المناهج العلمية بحيث لا تنتهي إلى التوظيفات الوضعية الحتمية (الدوغمائية) فتفقد قدرتها العقلية المفجرّة للوعي الإنساني والمجدّدة له، وتتقلّص دون إمكانيات العطاء العلمي الكامن فيها.
ففي كل هذه المناهج المعرفية المعاصرة عطاء علمي بحكم أنها مستمدة من تفاعلات الإنسان بمحيطه الطبيعي الاجتماعي وعبر وسائل فحص متقدّمة، غير أن المشكلة تطفح دائما حين يختزل البعض هذه المناهج التي تحمل "إمكانيات الوعي" إلى "مطلق وعي" مقيّد إلى حتميات ضيّقة بطريقة لاهوتية؛ فيستلب قدرتها على التجدد والعطاء العلمي الموصول باستمرارية النقد والاكتشاف، ويَحُول دون تطوّرها باتجاه الصياغة الكونية لمعطياتها العلمية بالمستوى الذي يرقى بها عن المتعلقات الضيّقة في تجربة الإنسان، التي أسلمته إلى أزمات حضارية مأساوية ومتكرّرة[9].
ويكشف لنا القرآن في عمقه الإبستيمولوجي عن برنامج خلاّق للاسترجاع المعرفي النقدي (المساءلة) لا يكاد يبلغه الحفر الأركيولوجي المعاصر تجاه الموروث البشري؛ إذ يتضمّن تعرية الحقول الثقافية الميثية والخرافية التي استلبت حقائق تلك الكتب السماوية وحقائق النبوّات. فالقرآن باسترجاعيته النقدية لقصص الماضي إنما يكشف، في الواقع، عن عيوب المنظومات الفكرية والثقافية أو عن الأشكال الإيديولوجية الماضوية التي قدّست بعقليتها الإحيائية الظواهر الطبيعية وتعاملت معها في صور فردية، وألبست النبوّات تفسيرات خرافية-أسطورية، فألّهت الطبيعة والبشر مما أعجزها عن التعاطي العقلي والموضوعي مع الوجود الكوني بأسره[10].
وكل الأنساق التي أنتجها الفكر الغربي؛ سواء كانت أنساقا كتابية إبداعية؛ (ملاحم، دراما، رواية...)، أو أنساقا فكرية واصفة؛ (فلسفة، نقد، مناهج...) لم تستطع الفكاك من مأزق (اللوغوس/الميتوس)، (الفيزيس/الأنثروبوس)، ولم نعثر إطلاقا على تصوّر توحيدي تركيبي يقوم على جدلية الغيبي والشهودي، أو جدلية؛ (الغيب، الإنسان، الطبيعة) كثلاثية تفاعلية تقوم على الفصل والوصل والمسافة..
فـ"حقيقة الإنسان هي أنه كائن حي ذو طبيعة متعدية، لا قاصرة؛ إذ يحيا حياة موسّعة أشبه بحياتين متلازمتين، أو قل متزاوجتين، منها بحياة واحدة؛ إحداهما عبارة عن عالم من المرئيات يتواجد فيه ببدنه وروحه؛ والأخرى عبارة عن عالم من المغيّبات يتواجد فيه بروحه؛ ففي هذه الحياة الموسّعة، يجد الإنسان نفسه موصولا بالغيبي وصله بالمرئي في كل عمل يأتيه؛ لأن الغيب لا يخلو منه وجه في كل شيء مرئي؛ إذ خلو الغيب عن أي شيء في العالم المرئي أمر محال؛ لأن حفظ هذا الشيء متحقق ومستيقَن، ولا يحفظه إلاّ الغيب؛ ولولا هذا الحفظ الغيبي، لذهب مع ذهاب الرؤية عنه[11]."
ولذلك، حين ننظر إلى المفاهيم الأساسية التي تؤطر نظرية الأنساق؛ كالتفاعل والعضوية والوظيفية والعلاقة والاختلاف والهرمية، والتكوينات والتحويلات والتنازعات والتوازنات...[12]، في ضوء جدلية؛ (الغيب، الإنسان، الطبيعة)، نجدنا نحتاج إلى إعادة مفهمتها من جديد؛ لأنها تفتقد إلى الروح المفهومية التوحيدية التي تقوم على مفهوم التوحيد الذي يجسد المولّد الدلالي لكل المفاهيم التي تتناسل منه وتعود إليه..
وهو مفهوم لا يقوم على التطابق أو التماهي أو الحلول أو الإلغاء أو الواحدية، بقدر ما يقوم على المسافة والتركيب والاستيعاب والانفتاح والتجاوز، و"الثنائية الأساسية [في النسق المعرفي التوحيدي] هي ثنائية الخالق (المُنزّه عن الإنسان والطبيعة والتاريخ) والمخلوق. وهي ثنائية فضفاضة تكاملية؛ إذ إن الإله مفارق للعالم إلا أنّه لم يهجره ولم يتركه وشأنه، وينتج عن هذه الثنائية الأوّلية ثنائيات تكاملية عدّة من أهمها ثنائية الإنسان والطبيعة، التي تفرض انفصال الإنسان عن الطبيعة، وأسبقيته عليها، واستحالة ردّه إليها، وتفسيره في إطارها؛ لأن الإله خلقه وكرّمه واستخلفه في الأرض، ووضعه في مركزها. ولكن هذا لا يعني أنه مالك الطبيعة، فهو خليفة فيها وحسب، استخلفه الله فيها لإعمارها من قبل خالقها؛ (أي أنّ ثمّة حيّزًا طبيعيا مستقلا عن الإنسان، وإن كان من حق الإنسان أن يتحرّك فيه)[13]."
وثنائية (الإنسان/الإنسان) التي تقوم على التدافع والتآلف، أو الاختلاف والتشابه، أو التباين والتعارف...، فهناك دائما مسافة بين طرفي الثنائية تتيح لكل طرف أن يستوعب الآخر ويتجاوزه، أو ينفتح عليه ويحاوره، ويعيد بناء ذاته ومجال حراكه عن طريقه.
وهذا التصور يخلّص الفكر من الاضطراب المعرفي والمنهاجي الذي وقع فيه، ويزيل غشاوة العمى المفاهيمي عن بصيرة المفكرين، ويفتح لهم آفاق رؤية ابستيمولوجية تركيبية، لا تقف عند حدود الوعي الصوري بالذات والموضوع فقط، بل تصنع الجدل الخلاق والحوار الفاعل بين العوالم اللامرئية والعوالم المرئية، بين الخالق والمخلوقات، بين الذهني والواقعي، بين اللغوي وما فوق اللغوي.
وسيكون "التوحيد" هو مفهوم المفاهيم الذي تتولد منه أنساق العقل، وأنساق النص/الخطاب، وأنساق الثقافة، وهذا في مقابل مفهوم "اللوغوس" في الثقافة الغربية الذي يطرح مشكلات معقّدة مع الحقيقة واليقين والمثال والواقع. والتوحيد هو الذي يحلّ مشكلات التناقض والمفارقة والانفصام التي تعترض سبيل العقل، ويعقلن الثقافة بما يتيحه من خصائص إبستيمولوجية[14] تنظم الحراك الأنثروبولوجي للبشر وتدبّر كونهم السيميولوجي التواصلي. بحيث تُتاح الفرصة للمختلف والهامشي، ولكل الكائنات مهما كان حجمها وقيمتها أن تظهر وتبرز وتكشف عن وجودها وتزاحم الكائنات المركزية، دون أن يضرّ طرف بالطرف الآخر أو يقصي أحدهما الآخر.
2. استراتجية المساءلة؛ من المساءلة الراديكالية إلى المساءلة المسؤولة
كثيرا ما نجد عبارات؛ المساءلة، التساؤل، السؤال،... في الكتب الفكرية والفلسفية العربية المعاصرة، التي تصدح، في كل مرّة، أن مشكلة العقل العربي الإسلامي هي مشكلة منهجية بالدرجة الأولى. وبالتالي، لابد من إعادة النظر في المنظومة المنهجية، وتأصيل المنهج الذي يتلاءم وخصوصيات العقل العربي الإسلامي والقيم الثقافية التي يُنتجها وينتج في سياقها في الوقت ذاته. ولكن قلّما نجد انتباها إلى المصطلحات البؤرية، وتقليب النظر بعد النظر فيها؛ إذ يُنظر إليها وكأنها في عداد البداهات المتعارف عليها والتي يحسن السكوت عليها، فلا يعرف القارئ المقصود من فعل المساءلة في حدّ ذاته، وما هي الطريقة والوِجهة التي تحرّك هذا الفعل المعرفي الوجودي؟ وهل كل سؤال هو مساءلة؟ ما طبيعة المساءلة؟ ما هي مستوياتها؟ ما هي عوائقها؟
إنّ "المساءلة" ليست مجرد استفهام، وإنما هي علم قائم بذاته. إنها إستراتيجية مَنْهَجة مستديمة للمعرفة، وبنيَنة للوجود، ومفاوضة مستمرة لتموضعات الموجود، ونظر حصيف في مسار الفكر وهو يولّد مفارقاته، وينتج أزماته باستمرار، وتأمل فصيح في تقلبات اللغة وتعرّجاتها وهي تولّد الفروق والشقوق، وتمارس العصيان والعقوق على قواعد النحو وقوانين الصرف.
وهذا ما انتبه له الفيلسوف "طه عبد الرحمن"، وهو يؤكد في مجمل مشروعه على تهافت وموت الفلسفة الخالصة التي حنّطت الفكر وأخمدت روحه الإشارية والتخييلية والتمثيلية وفصلته عن مرونته التأثيلية، فلا مساءلة من دون تأثيل، و"لا حياة للفلسفة العربية ما لم يقع فيها وصل العبارة بالإشارة في كل مستوى من مستويات القول الثلاثة، أي وصل الاصطلاح بالتأثيل على مستوى المفهوم، ووصل التقرير بالتمثيل على مستوى التعريف، ووصل الاستنتاج بالتخييل على مستوى الدليل، لأن في هذا الوصل وصلا للقوتين معا: "العقل" و"الخيال" ولا حياة لفكر الإنسان بغير اجتماعهما وتقادحهما[15]."
ويعد المفكر البلجيكي "ميشال مايير" (Michel Meyer) المؤسس الفعلي لعلم المساءلة أو نظرية المساءلة (problématologie) في المجال التداولي الغربي، وهذا العلم هو« مبدأ للقراءة يجوز تطبيقه على ميادين شتى... به نميّز بين السؤال والجواب، بين "الإشكالاتي" وغير "الإشكالاتي"[16]."
وبه يمكننا أن نتحدث عن نحو (Grammaire) للخطابات، ولتاريخ تشكلّها وتداولها، وفهم القوانين المتحكمة فيها. وإذا كان "التاريخ نسيج اختلافات واختلالات بين الأحداث الماضية والأحداث الجديدة[17]"، فإن علم نَحْوِ هذه الخطابات هو نحوية الاختلافات الموجودة في قلب علاقات الذوات مع بعضها، ومع الآخر، ومع موضوعاتها وقضاياها والنصوص التي تنتجها أو تتلقاها وتتداولها.
إنّ فعل المساءلة هو ضرورة أنثروبولوجية تنبثق من الإحساس التراجيدي الذي يعانيه الإنسان وهو يخوض معترك الحياة، ومن الانشطار الذي يعيشه لحظة صياغة نصوصه وخطاباته ومواجهته للآخر؛ حين تتجاذبه ثنائيات: (المثالية/الواقعية)، (التناهي/اللاتناهي)، (المطلق/النسبي)، (الوعي/اللاوعي)، (الأنا/الآخر)... فمن الجدل الرابض في ثنايا هذه المتضادات يتخلّق الحسّ السوسيوتاريخي بالوجود، ويأتي السؤال مسكونا بهاجس التغيير والتبديل، والتحوير والتطوير، ومدفوعا برغبة التجاوز.
وهي أيضا، وعي ابستمولوجي متدرّع بأدوات النقد والحفر والتفكيك والتأويل، كي يخلّص الفكر من دوغمائياته، ومن استنامته في "كنف جوانية المقايسة، والمطابقة، والهوية، والوحدة، والأصل، والشمولية، والكليانية، وغيرها من المناطق المغلقة للميتافيزيقا... والإيديولوجيا [التي شيّدت] صرح سؤال الهوية والماهية والجوهر والكينونة وسواها من الأسئلة المتمركزة على سؤال الذات، سؤال شمولية العقل الأداتي أو التواصلي، فغابت حقول المحايثة والتعدّد والاختلاف. وكانت النتيجة، سيطرة السؤال التاريخي لإقليم كان ذات يوم مجرّد اسم مثل غيره من أسماء الأقاليم، ثم أضحى مفهوما بالقوة وفق ما اقتضته إيديولوجيا التمركز على الذات[18]."
وهو في الأخير ممارسة سيميائية بامتياز؛ إذ يشتغل على العلامات وما تتركه من أعراض في جسد النصوص والخطابات، ومن آثار في أقاليم الفكر والمتخيّل، منقبا عن المعنى الحي، مقوّضا لكل البناءات التي تحاصره وتوصد الأبواب عليه، وتحوّله إلى كائن ميتافيزيقي متعال. فالمساءلة "لا تقف عند معنى ما بعينه إلاّ لكي تغادره إلى سواه من المعاني في تفارق مستمر واستقلال لا يهدأ، فالسؤال اختلاف عن الجواب، بوصفه ينهض في كل مرّة بذاته، مستقلا عمّا تراكم من معرفة[19]."
ولذلك، حين نتأمل في طبيعة المساءلة المؤطّرة للمشروع المعرفي الغربي منذ مطلع القرن العشرين، بل منذ الهجوم الفلسفي الذي شنّه "فريدريك نيتشه" (Friedrick Nitzsche) [1844م-1900] في نهاية القرن التاسع عشر على معاقل الحداثة والعقلانية، نجدها مساءلة مسكونة بالمستويات الثلاثة؛ الأنثروبولوجي، الابستمولوجي، السيميولوجي، وممجّدة لروح الاختلاف والانفتاح والتنوّع.
فالمشروع التفكيكي لـ"جاك دريدا" (Jacques Derrida) [1930م-2004م] كان يسعى إلى إعادة النظر في الوضعية الأنثروبولوجية للكائن البشري الغربي، الذي اعتقد ردحًا من الزمن أن الطبيعة أسبق من الثقافة، وأن الصوت أصل والكتابة فرع أو مكمل (Supplément). كما مارس عملية تقويض (Déconstruction) لمركزية العقل (Logocentrisme) وإزاحة الدال عن مركزيته العلاماتية، وفتح النص على مكبوته، والعقل على لا معقوله[20].
فالمساءلة "الغراماتولوجية" التي مارسها "دريدا" هي فحص عميق لنحوية المنظومة الثقافية الغربية ولتكوينية العقل الذي يقف وراءها، ولطريقة تدبيرها للعالم، وصيغ إنتاجها للحقيقة. فهو لم يقف عند حدود مساءلة النصوص المكتوبة، والخطابات المنطوقة، وللكتابة كعلم، كما يشير للوهلة الأولى عنوان كتابه، وإنما طمح إلى معاينة العلاقات بين الإنسان والنص والعالم في ضوء جدلية (الطبيعة/الثقافة).
وهو الأمر نفسه الذي حدث مع "ميشال فوكو" (Michel Foucault) [1926-1984] حين باشر "المساءلة الأركيولوجية" لمعرفة كيفيات انبثاق الوضعيات المعرفية، وتشكل الأطر المنهجية، وتبلور الحقائق والرؤى والتصورات والأحكام، وتمركزات الأفكار والنظريات في حقبة معينة، ثم تلاشيها واختفائها في حقب أخرى. إنها حفريات في تاريخ الإنسان والأفكار والمعارف والنصوص والخطابات[21].
ولا يختلف الأمر كثيرًا، في خطوطه العريضة، حين نستبطن عمق المشروع الفلسفي للفيلسوف الألماني "هانس جورج غدامير" (H.G.Gadammer) [1900-2002] "بالمساءلة الهيرمونيطيقية". فالرجل كان يستهدف منطق المنهج العلمي الحديث الذي تعامل مع المعرفة والحقيقة تعاملا دوغمائيا، بالرغم من أن منطلقاته كانت ضد الفكر الدوغمائي، وأنتج وعيا زائفا بالتاريخ. كما سعى سعيه لإثبات تهافت كل أشكال الأنسنة التي ترهن الإنسان بالمنهج؛ إذ تحوّل المنهج إلى قوة ميتافيزيقية أو إمبريالية لا تُقهر، وتفصله عن دلالاته المحايثة، وعن نسبية لغته التي تصوغ مفاهيمه، وتحدّد عوالمه وحراكه ضمنها[22].
وهكذا، فبعد أن رهن العقل الغربي ذاته بالمنهج وللمنهج، واعتقد أنه المخلّص الوحيد، مع ديكارت وبيكون وأوغست كونت، كانط، هيغل،... هاهو اليوم يعيد ترتيب أوراقه، وينزل المنهج من عليائه إلى وضعية جديدة محايثة، تتسم بالنسبية والانفتاح المفرط. إنه يخرج من مرحلة المساءلة النسقية الفاحصة، إلى مرحلة المساءلة النقدية الجذرية (الراديكالية) التي لا يتورّع فيها عن مناقشة المقدّسات وتسفيه بداهاتها، وزعزعة ثوابتها ومرتكزاتها..
فهو يلج إلى كل المنظومات والأنساق والنماذج ليهشّم سلطتها النظامية ويفضح ادعاءاتها المعرفية والمنهجية، مما أدى إلى انفجار "طاقات الفكر النقدي التحليلي و[تعاظمها] بالرغم من أزمات الحضارة الأوروبية... فالمارد الخطير الذي أطلقته العالمية المعاصرة ليس هو الظاهرة الصليبية التي انتهى ظرفها التاريخي، وليس كذلك الإلحاد الساذج، وليس كذلك العلمانية البدائية، فهذه كلها ظواهر سطحية لما هو أعمق بكثير.
وهذا الأعمق بكثير هو الذي حمل أوروبا لأن تكون علمانية ووضعية، ونعني به تحرّر العقل من الثوابت والمنطق السكوني إلى التحليل والنقد وإعادة التعرّف على كل شيء. فكان مصرع اللاهوت المسيحي ومصرع النُظُم العقلية والأخلاقية التي ما ظُنَّ في يوم من الأيام أنها ستكون عرضة لمباضع التحليل[23]."
وهذا ما لم ينتبه له كثير من المفكرين العرب الذين يتعاملون مع هذه المنظومات الفكرية والأنساق الفلسفية الغربية دون مساءلة جدّية وجذرية لمرتكزاتها المعرفية، وقيمها الوجودية، واستراتجياتها المنهاجية. صحيح أن العقل الغربي قد تحرّر بشكل كبير من بعض تركاته السحرية واللاهوتية والإيديولوجية المزيّفة، وأطلق قدراته العلمية والابستمولوجية التي "تستهدف التفكيك والتحليل، و[لكنه] لازال بعد [عاجزا] عن الوصول إلى التركيب..
فمدرسة "فرانكفورت"، مثلا، قد فككت الوضعية المادية (العقل الأداتي) لتعطي مساحة للإنسان، ولكنها لم توضّح في النهاية أي إنسان هذا الذي تريد أن تعيد تركيبه وتمنحه حريته، والسبب أنها تحاول إيجاد الحلول ضمن البنية الوضعية نفسها، بل إن الأفضل كثيرا من جهود مدرسة فرانكفورت، ولكن عبر منهج أكثر إنسانية... هو موقف القرآن، لأنه مطلق من هذه التفكيكية، إنه يستصحبها في معرض التفكيك والتحليل والنقد، ولكنه يضيف إليها التركيب الغائي. وهذه من أهم اللحظات المعرفية في الفصل والوصل؛ لأنّ التفكيك والتحليل ينتهي في ممارسته إلى تفكيك الإنسان نفسه ليجعل مصيره سجلا احتماليا ونسبيا مفتوحا، فتكرس الليبرالية الفردية الغريزية، وتفقد حتى الروابط العائلية معناها. فالمنهج الابستيمولوجي بقدر ما هو مفيد على مستوى التفكيك هو الخطر بعينه إذا لم يتوجّه نحو التركيب، ولا يتم التركيب إلاّ عبر وعي كوني مطلق يصدر عن الإله الأزلي، تقدّست إرادته وتباركت مشيئته وتنزّه أمره[24]."
وإذا كان هذا حال الغربيين، فإن مجتمعاتنا لا محالة اليوم "تعيش لحظات التفكيك التاريخي الجدلي منذ تقاطعها مع الحضارة الغربية بداية بنهاية القرن الثامن عشر، ولم تؤدّ صيرورتها الاجتماعية والتاريخية حتى الآن إلى إعادة تركيبها وفق نسق محدّد، فهي ساحة مضطربة للحركات والبُنى التاريخية والمعاصرة، والتي لم تقطع نسيج العلاقات بينها بعد...
فليس ثمة نسق اجتماعي وحضاري ضابط لسلوك الواقع؛ لأن التفكيك لم ينته بعد إلى التركيب، ويحاول كل طرف فرض إرادته الذاتية على مجريات التركيب بنهج معين، أو بلا نهج، فما نحن فيه هو من خصائص هذه الفترة التاريخية الجدلية التفكيكية[25]" التي تتميّز في عمومها بالتيه الفكري، والعمى المفاهيمي، والطبع القلبي كما يقول "طه عبد الرحمن".
"إنه لا فكاك من التركات الثقيلة لهذه المرحلة التاريخية العصيبة إلاّ بالتخلّص من وهم المساءلات اللاتاريخية التي ورّطت العقل العربي لفترة طويلة في سجالات عقيمة أفقدته توازنه، وأعاقت تطوره. ومن جهة أخرى، التخفّف من إغراءات المساءلات المعرفية النقدية الراديكالية التي مارسها الغرب بقوة، وأراد من ورائها تحقيق ما اصطلح عليه "طه عبد الرحمن" بـ"التسوية الثقافية"؛ "التي هي تسليط نمط فكري واحد على جميع الثقافات المختلفة؛ فليس هذا الفكر المتسلط وليد تأليف بين عناصر مشتركة بين هذه الثقافات الخاصة، وإلاّ أضحى فكرا مشروعًا ومقبولًا، وإنما هو إفراز ثقافة واحدة بعينها هي ثقافة الأقوى؛ وواضح أنه ليس أضّر على [الفكر] من أن يهيمن [عليه] نمط فكري يُفرض، لا بالبرهان، وإنما بالسلطان، اقتصاديا كان أم سياسيا؛ إذ لا يلبث أن يجلب [له] الفقر، ثم الجمود، ولأهلـ[ـه] التبعية، ثم التلاشي[26]."
فسؤال المنهج عندنا، والسؤال المعرفي الثقافي عموما، يحتاج إلى أن يتخلّص من هجونة أصوله وطرحه، واستلابية وجهته، وضبابية مقصده، وتهوّره وتعسفيته في مواجهة (النص/الثقافة) وطمس هويته (ها)، وتخريب سيميائيته (ها)، ويولّي وِجهته الحقيقية المُرادة؛ فيبني منطقه النقدي والتحليلي والحجاجي التركيبي وفق طريقة واعية بطبيعة المفارقات والمآزق والأزمات التي يفرزها الواقع، وتستبطنها النصوص. ويحاول التكيّف معها والتقليل من حدّتها، ورصد البدائل الملائمة لها، لا مجرّد إلغائها أو القفز عليها والسكوت عنها. فلا وجود لعقل يخلو من المفارقات، ولا وجود لواقع يعلو على الأزمات. وهذا لا يتم إلاّ عبر اكتشاف ما يصطلح عليه "أبو القاسم حاج حمد" بـ"الناظم المنهجي"؛ "بمعنى أن قانون الأفكار لا يستوعب ما يبدو متناقضا ومتعارضا و[غريبا]، كمثال الجبر والاختيار، أو المادية والوضعية الانتقائية، ولكن ثمة فارقا كبيرا بين معالجة ما يبدو متناقضا ومتعارضا في إطار الضابط المنهجي نفسه لقانون الأفكار ودون توفيقية، وبين معالجة ما يبدو متناقضا ومتعارضا دون منهج ومن خلال التأمل العقلي فقط.
وهذا هو معنى المنهجية كناظم مقنّن لإنتاج الأفكار ذات النسق الواحد، فكل فكر تتعدّد مقولاته وتتضارب إنما هو فكر غير منهجي ولو التزم في إنتاجه الذهني بإطار مرجعي أرقى منه، فالقرآن الكريم، مثلا، يحمل ضمن وحدته الكتابية العضوية منهجية كاملة، غير أن الجهد البشري المبذول في التفسير انطلاقا من النصوص المجزّأة وتبعا للمقاصد الموقوفة على أحكام بعينها لا يمنح المفسّرين صفة المنهجية...
فالمنهجية التي نعنيها هي خروج العقل من حالة التوليد الذاتي للمفاهيم إلى اكتشاف النسق المرجعي الذي يحاكم هذه المفاهيم نفسها، ويؤطر لإنتاجها بحيث يحكم التطبيقات في مختلف الحقول الأخرى، فالمنهج هو خلاصة قوانين تحوّلت إلى نظريات تحولّت بدورها إلى إطار مرجعي وليس مجرّد صياغة موضوعية للتفكير[27]"، أو مجرّد آليات للتحليل والتفكيك والتأويل وإطلاق الأحكام.
وهذا هو الدافع الأساسي الذي وجّه "طه عبد الرحمن" لمباشرة "المقاربة الروحية الذِّكرية العمودية" لتجاوز كل أشكال المقاربات "العلمانية النسيانية الأفقية[28]" التي لا تستطيع، مهما فعلت، اكتشاف النسق المرجعي الذي يحاكم النظريات والمناهج والمفاهيم والتخريجات، ويقوّم اعوجاجها.
ولكي تأخذ المساءلة مفهوميتها، ويستعيد المنهج فعاليته ومقدرته القرائية والإقرائية (أو البيانية والتبيينية)، يجدر بالعقل العربي أن يبتكر صياغة سؤالية تنسجم مع إمكانياته الأونطولوجية وقدراته المعرفية، وأفقه الأكسيولوجي، أو بتعبير دقيق لـ"طه عبد الرحمن": صياغة سؤالية تداولية[29]؛ إذ نحن اليوم بحاجة إلى "السؤال المسؤول"، وهذا الأخير "ليس سؤالا فاحصا لموضوعه، متوسّلا بوضعه كسؤال كما نجد عند "سقراط"، ولا سؤالا ناقدا لموضوعه، مسلّما بوضعه كسؤال كما نجد عند "كانط"، وإنما سؤال يسأل عن وضعه كسؤال بقدر ما يسأل عن موضوعه، أو سؤال يفحص وضعه كما يفحص موضوعه أو ينتقد وضعه كما ينتقد موضوعه[30]."
فإذا استشعر العقل العربي هذه المسؤولية، يمكن عندئذ أن يُحيي روحه المفهومية وينتج معرفة مسؤولة ومنهجا مسؤولا "لا يركن إلى الاعتقاد في نفسه، فضلا عن عدم الركون إلى الاعتقاد في وسيلته التي هي العقل، وإنما يمارس النقد على نفسه كما يمارسه على منقوده وعلى وسيلته العقلية، فهو، إذن، ليس بنقد معقود يُخشى انعطافه بالضرر كما هو شأن السؤال بلا مسؤولية، وإنما هو نقد منقود يُؤَمَنُ جانبه، بل يُرجى نفعه... [ فالمفكر النقدي المسؤول] ليس هذا الذي يخوض في أي سؤال اتُفق، ولا ذاك الذي يخوض في كل سؤال خاض فيه غيره، وإنما هو الذي لا يسأل إلاّ السؤال الذي يلزمه وضعه ويلزمه الجواب عنه[31]."
ومن ثمّ، الارتقاء إلى لحظة تحرير الخطاب الفكري والفلسفي العربي من التابعية والسلبية والاتكالية والارتجالية وكل الوضعيات الباتولوجية التي أقعدته حينا من الدهر لم يكن فيه مسؤولا، ومنحه القدرة الخلاّقة على استشكال المفاهيم، وإنتاج النظريات وفحصها وتحيينها، وبلورة المناهج وتفعيلها ومحاورتها.
وإذا كان العقل يعتمد هذه الحوارية كإستراتيجية أساسية له، فإن المساءلة ستستمر وتنمو وتفجر إمكانيات الإبداع اللانهائية. وفي هذه الحالة سيتحول الوعي السؤالي إلى مكوّن أساسي من مكونات الفكر النّقدي، وليس مجرد صيغة عرضية توجد خارج الفكر وتنتهي بحضور الإجابة. كما سيصبح فاعلا استراتيجيا؛ أي لا يأخذ موقعا ثابتا بعينه، بقدر ما تكون له القدرة على التموضع والتموقع في أماكن الانسداد المعرفي، والانغلاق المفاهيمي، والحصار الإيديولوجي والختم العقائدي، ليفكّ الحصار عنها، ويفتح آفاقا جديدة للفكر، ويخطّ مسارات مغايرة للمعرفة.
3. المساءلة الطهائية كضرورة أنثروبولوجية وممارسة سيميائية
المتأمل في العلاقة بين الأنثروبولوجيا والسيميولوجيا يجدها علاقة جد وطيدة؛ إذ تعدّ الأنثروبولوجيا، في وجه من وجوهها، قراءة في الأنسجة الرمزية لحياة المجتمعات المدروسة، وتعدّ السيميولوجيا، وفق منطقها العميق، بحثا في نحوية الثقافات عبر العلامات والرموز. فالثقافة، من زاوية أنثروبولوجية، نسيج رمزي يصنعه الإنسان، كذلك كانت الثقافة عند "كليفورد غيرتز"، شبكة رمزية كنسيج العنكبوت يصنعها الإنسان ويعلق بها. وقبل ذلك طابق "كلود ليفي شتراوس" بين الثقافي والرمزي، بل إن الثقافة عنده ليست سوى مجموعة من الأنظمة الرمزية نجد بداخلها، في الموضع الأوّل، اللغة والقواعد الزوجية والعلاقات الاقتصادية والفن والعلوم والدين[32].
وتتضافر الأنثروبولوجيا والسيميولوجيا كأداتين معرفيتين تشكلان منهجا محكما لمقاربة ومساءلة وضعيات الإنسان الوجودية وصيغه الثقافية وأنماطه الحضارية، وهو يصطدم بالعلامات وينتج الرموز ويؤوّلها، خاصة وأن الإنسان المعاصر يعيش في "سياق حضاري كثر فيه اللغط عن تلف المعنى وضمور المرجع أو تفككه أحيانا، وفي عالم تميّعت حدوده، فتهاطلت فيه الدوال بضجيجها الصاخب الذي لا يُحيل أحيانا إلا إلى اللاشيء، إلى العدمية. في مثل هذا السياق، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المضي قُدما نحو ترميم أنظمة الدلالة، إلى إنقاذ الرمز من التلاشي. والرمز علامة اتفاقية بين الناس، إذا تمفصل بالفراغ انفرط العقد الاجتماعي الذي كان يشدّ تماسكهم[33]."
بل أكثر من هذا، السعي الدؤوب إلى تحرير الإنسان من "النسيان الأكبر الذي أصاب هذا العالم والذي أرّخ لحداثته نسيان مزدوج جعل الإنسان الأفقي لا يَقْدِرُ خالقه حق قدره؛ إذ نسي كيف كان "التدبير" و"العبادة" يأتلفان في حياة الناس ائتلافا حيا، حتى إذا دبّر، كان عابدًا؛ وإذ عبد، كان مدبِّرا؛ لقد انقلب "التدبير" و"العبادة" عنده إلى ضدّين متباينين[34]"، هذا بالرغم من أنهما يأتلفان في حياته ائتلافا كبيرا.
وكذلك السعي إلى استعادة "الذاكرة العمودية"، و"الفطرة الوحدانية" و"الأخلاق العمقية" و"المعرفة التداولية" و"الكفاية التأثيلية"، وهذا لن يتأتى إلا عبر "أنثروبولوجيا روحية" و"سيميولوجيا ملكوتية" كما بلورها "طه عبد الرحمن"، لا تقفان عند حدود البعد الأفقي الدنيوي والمُلكي، وإنما تستغوران الأبعاد العمودية والعميقة بغية تحصيل التكامل الإنساني الوجودي الذي لن يتحقّق إلاّ عبر التكامل الديني الذي "يُمكّن الفاعل الديني من ممارسة التشهيد على الوجه الأشمل، جاعلا من كل مرئي من مرئيات عالمه محلاّ لتنزّل حكم غيبي؛ ومردّ ذلك إلى أنه يقتبس من ذاكرة الإنسان الأولى معنى "الوحدانية"، ثم عليه معنى "الوحدة"..
فكما أنّ الإله واحد لا شريك له، فكذلك وحدة دينه لا نظير لها؛ وتتجلّى هذه الوحدة في تكاملين: أحدهما؛ "الاتساق"، ويتمثل في روح التوحيد التي تؤلف بين أحكامه، وفي مبدإ عدم التكليف بما لا يُطاق الذي يؤلّف بين أشكاله؛ والثاني، "الاتساع"، ويتمثل في تقديم الجمع بين الأشياء على التفريق، وفي عدم خُلوّ أي شيء عن حُكمه؛ أما غاية هذا التكامل المزدوج، فتتجلى في كون الدين يعرّف الإنسان بسرّ وجوده، مترقيا إلى كمال سلوكه، ويمدّه بأسباب سعادته، مؤديا إلى خلود روحه[35]."
ويكشف الخطاب الفلسفي الطهائي عن مقدرة إقناعية عالية، وحسّ سيميائي عميق وهو يمارس التأثيل العريق ليواجه سلطة الواقعي والسياسي والأكاديمي الصفيق؛ إذ يُبين التأثيلي بامتياز عن الرابطة الشعرية الوجودية الكونية بين الأنثروبولوجي والسيميائي، ويفجّر طاقة المساءلة والمكاشفة ليؤكد نصيب الخطاب الفلسفي من التمكن الاستشكالي، "فالأصل في التمكن الاستشكالي هو التأثيل المضموني؛ وإذا صار المفهوم متمكن الاستشكال امتلك أسباب الاتساع والامتداد، سواء وضع أصلا في لغته أو نُقل عن غيرها؛ ومن الجائز، بل من الراجح، بموجب الاختلاف الدلالي المقرّر بين الألسن، أن يتسّع ويمتد في لغته الأصلية بغير الوجوه التي يتسع ويمتدّ بها في اللغة المنقول منها، وهل هذا التوسّع إلاّ موجب لتحرّر المفهوم من اتباعيته الاستشكالية وتبعيته الفلسفية لهذه اللغة، وفي هذا التحرّر تمام نمائه الاستشكالي[36]."
وتظهر قدرة المساءلة المعرفية التوحيدية عند "طه عبد الرحمن" في كشفه عن الأثول العميقة بين مفاهيم: العالم، العمل، العلم، العلامة، وفتحه للإمكانيات الإشارية للعبارة الفلسفية، وهذا بغية "توجيه" الإنسان إلى فهم "المقاصد" الكبرى من حراكه في الوجود، والتخلّص من كل أشكال "النسيان" و"العدمية" و"العبثية السيزيفية"، و"الاختلاس البروميثيوسي".
يقول "طه عبد الرحمن" معبِّرا عن هذا الوعي التوحيدي: "ولو تأمّلنا وجود الإنسان في هذا العالم المرئي وتساءلنا عن سرّ هذا الوجود، لا يسعنا إلاّ أن نُقرَّ بأنه خُلق، كما خُلقت جميع كائنات هذا العالم، من أجل أن يكون آية؛ (أي علامة) دالة على خالقه سبحانه كما هي آيات تدلّ عليه، إلا أنّ الإنسان، وإن اشترك مع هذه الكائنات في الخلق وفي الدلالة على الخالق، فإنه اختلف عنها في الواجبات التي تُناط به بمقتضى هذه الدلالة على الخالق؛ فقد توجّب عليه أن يتبيّن الآيات في نفسه وفي الآفاق من حوله؛ لأنّ هذا التبيّن يفضي به إلى الإيمان بخالقه؛ وليس هذا فحسب، بل أيضا توجب عليه أن ينهض بوضعه كآية دالة على الخالق؛ وليس له من سبيل إلى النهوض بوضعه كآية وبمقتضياتها إلاّ بأن يدخل في العمل باختياره؛ من هنا كان الإيمان موجبا للعمل، فلا عمل إلا لمن آمن، والعمل بغير إيمان هباء[37]."
وهذا التصور الأنثروبو-سيميائي التوحيدي يخلّصنا من شراك التصورات الحلولية المادية الحتمية التي ترهن الإنسان كلية بالعلامة أو بالفكر أو بالكلمة؛ إذ في اعتقاد أصحاب هذه التصوّرات أننا "لا نملك أية قدرة على التفكير خارج العلامات. كما أننا لا نملك أي تصور عن الأشياء التي يمكن معرفتها كليّة؛ فالعلامة هي تقريبا هذا الشيء. أما الإنسان العلامة فهو ذلك الذي يكون الكلمة، وهذه الأخيرة لا تدل سوى على الدلالة التي منحها إياها؛ هكذا فالكلمة تتعلم من الإنسان وعكسيا، اللغة هي حامل الإنسان لأن الإنسان هو الفكر[38]."
ولكن التصور التوحيدي يجعلنا نتجاوز منطق العلامات إلى منطق الآيات ومن القراءة الشهودية للعلامات إلى القراءة الغيبية للآيات. وبالتالي يكون "من يسأل: "ما العمل؟" كمن يسأل: "كيف أكون آية؟"، أو "كيف أجعل من نفسي آية؟"؛ وقد حفظت لنا اللغة العربية في مبانيها مضمون هذه الحقيقة التي تجمع بين العمل والدلالة على الخالق؛ ذلك أن العمل الذي يشترط العلم هو، كما تقدّم، مقلوب عن العلم؛ ومعنى "العِلم" لغة، هو كونه "علامة" على المعلوم، فيكون العمل بموجب هذا القلب، علامة عليه؛ ولمَّا كان الإنسان قد خُلق من أجل أن يعمل، فقد لزم أن يكون المعلوم الذي ينزل العملُ منزلة العلامة عليه إنما هو الخالق سبحانه[39]."
وكلما استطاع الإنسان مساءلة ذاته والعلامات التي تحيط به، وحاول استغوار منطق الآيات في نفسه وفي الكون الذي يتواجد فيه، أدرك جلال الله واستمرأ جماله، وانتقل من رتبة الأقوال/الأعمال الخفيفة إلى القول/العمل الثقيل.
تركيب
بعد أن كشفنا عن طبيعة النسق المعرفي التوحيدي، وتعرفنا على مستوياته وخصائصه، ومدى تمايزه واختلافه وتجاوزه للنسق المعرفي الغربي، ونظرنا في مفهومية المساءلة المعرفية التوحيدية، التي يتجاوز المُسَائِلُ فيها ذاته الأفقية إلى ذاته العمودية، ويطلب دوما ذاكرته الروحية وخصوصيته الفطرية، ولا يبقى حبيس دائرة العلامات، بل يطمح إلى قراءة الآيات، صار لزاما أن لا مساءلة من دون مرتكزات ابستيمولوجية كبرى.
فلا مساءلة من دون أخلاق، لأن الأخلاق هي التي تدبر علاقة الفطرة البشرية بالكون الثقافي للإنسان وتُوجِّه مقاصدية حِراكه في العالم، ولا مساءلة من دون تأثيل؛ لأن التأثيل هو الذي يدبر علاقة الإنسان بأصوله وفروعه، فيحرّر المُقيّد، ويقيّد المنفلت، ويكشف المطمور، ويضبط المنثور، وينظم أساليب الاهتداء بالعلامات والإنصات للآيات. ولا مساءلة من دون وعي تداولي يُجذّر الإنسان في واقعه ومؤسساته ويمنحه قدرة الفهم والانفهام والإفهام.
الهوامش
[1]. طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط2، 2005، ص92.
[2]. إدغار موران، نحو سياسة حضارية، تر: أحمد العلمي، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، فرنسا: الملحقة الثقافية السعودية، ط1، 2010، ص25.
[3]. المرجع نفسه، ص111-112.
[4]. المرجع نفسه، ص145-146.
[5]. شفيق جرادي، مقاربات منهجية في فلسفة الدين، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط1، 2010، ص22.
[6]. طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، بيروت/ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط2، 2012، ص15.
[7]. توشيهيكو ايزوتسو، الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، تر: هلال محمد الجهاد، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ط1، 2007، ص37-38.
[8]. المرجع نفسه، ص38.
[9]. ينظر: أبو القاسم حاج حمد، القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية، بيروت: دار الساقي، ط1، 2011، ص50.
[10]. ينظر: المرجع نفسه، ص70.
[11]. طه عبد الرحمن، روح الدين، م، س، ص41.
[12]. للتوسع ينظر: نيكلاس لومان، مدخل إلى نظرية الأنساق، تر: يوسف فهمي حجازي، ألمانيا/بغداد: منشورات الجمل، ط1، (2010).
[13]. عبد الوهاب المسيري، دراسات في الشعر، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط1، 2007، ص17.
[14]. يرى المفكر الجزائري الراحل "إسماعيل راجي الفاروقي" (1921- 1986) أن التوحيد، كجوهر حضاري، يقوم ابستمولوجيا على جانبين أساسيين؛ جانب أسلوبي وجانب فحوي (مضموني)، ومن الخصائص الابستمولوجية للجانب الأسلوبي نجد:
1. الوحدة: وهي انتظام في إطار واحد تكون العلاقات داخله هرمية تفاضلية تشد بعضها بعضا. والانتظام في الإطار الواحد هو الصهر الإسلامي، وهذا الأخير ليس مجرّد جمع ميكانيكي وإنما هو هضم وتسوية لكل المكونات الإيجابية للحضارات والثقافات الأخرى وإعادة تخريجها تخريجا عضويا لا تشاكس فيه.
2. التعقّل: يقوم على ثلاثة بنود: رفض ما يخالف الحقيقة ورفض استمرار المتناقضين، وتقبل الدليل المخالف، وهو ضد التزمّت والتقوقع، والمتعقّل يتميّز بالتواضع الفكري ويدرك أن الحقيقة أكبر من يلمّ بها كلها.
3. السَّعَة: مبدأ يضمن الحركة والتنوع والاختلاف والتطور، وهو مبدأ يكشف عن عمق فطرة الإنسان وثرائها وتنوّع تجلياتها.
ومن الخصائص الابستيمولوجية للجانب الفحوي ما يلي:
1. الميتافيزيقية: وتعني أن التوحيد يجمع خيوط السببية ويرجعها إلى الله. فتوحيد الله يعني انفراده بتسبيب الأشياء والحوادث، وهذا يعني تجريده عن كل قوة أخرى.
2. المبدأ السوسيو-أكسيولوجي: ويعني أن التوحيد ينطوي على وازع أخلاقي وقيمي اجتماعي يحلّ كثيرا من المتناقضات ويحسم الخلافات بما يعود على الإنسان والحياة بالخير والنفع، وهذه الروح الإيجابية هي التي تصنع الحضارة.
3. المبدأ الجمالي: ويعني أن الفن التوحيدي يؤمن أن استحالة التعبير عن الله [عند اليونان المثال (Iedos) أو اللوغوس أيضا] هو أسمى الأهداف الجمالية التي يمكن له أن ينشدها، وذلك بحمل ما يرى على الإيحاء باللانهائية، فإبداع الفنان التوحيدي لفن الزخرفة، مثلا، هو رسم يمتد في جميع الاتجاهات إلى ما لا نهاية له، فإذا تتبعه المشاهد وأدرك أنه لا نهاية له، أدرك معنى من معاني استحالة التعبير، وبذلك يدرك معنى التنزيه، لهذا جاءت فنون المسلمين كلها تجريدية عكس الفن الإغريقي الذي كان بالدرجة الأولى تصويرا للآلهة.
ينظر: إسماعيل راجي الفاروقي، جوهر الحضارة الإسلامية، باتنة: دار الزيتونة/الجزائر، ط1 1989، ص6-16.
[15]. طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط2، 2006، ص106.
[16]. ميشال مايير، نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة (من الميتافيزيقا إلى علم السؤال)، تر: عز الدين الخطابي وإدريس كثير، منشورات عالم التربية (المغرب)، ط1، 2006، ص5-6.
[17]. المرجع نفسه، ص6.
[18]. عمر كوش، أقلمة المفاهيم: تحولات المفهوم في ارتحاله، بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 2002، ص26.
[19]. المرجع نفسه، ص24.
[20]. ينظر: جاك دريدا، في علم الكتابة، تر وتق: أنور مغيث ومُنى طلبة، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2005.
[21]. للتوسع أكثر ينظر: ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر: سالم يفوت، بيروت، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ط3، 2005.
[22]. للتوسع أكثر ينظر: هانز جورج غدامير، الحقيقة والمنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، مراجعة: جورج كتورة، بيروت: دار الكتاب الجديد، طرابلس: دار أويا، ط1، 2007.
[23]. أبو القاسم حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، بيروت: دار الهادي، ط1، 2004، ص152.
[24]. أبو القاسم حاج حمد، ابستيمولوجيا المعرفة الكونية: إسلامية المعرفة والمنهج، بيروت: دار الهادي، ط1، 2004، ص204-205.
[25]. أبو القاسم حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، ص15.
[26]. طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص16-17.
[27] أبو القاسم حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية: أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، بيروت: دار الهادي، ط1 2003، ص34-35.
[28] ينظر: طه عبد الرحمن، روح الدين، م، س، ص17.
[29]. المساءلة التداولية لدى "طه عبد الرحمن" هي التي تحفظ مجموعة من الخصائص: العقدية والخبرية والعملية واللغوية
ينظر: سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم، بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 2012، ص51-52.
[30]. طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، م، س، ص14.
[31]. المصدر نفسه، ص15،16.
[32]. ينظر: محسن بوعزيزي، السيميولوجيا الاجتماعية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2010، ص74-75.
[33]. المرجع نفسه، ص75.
[34]. طه عبد الرحمن، روح الدين، م، س، ص14-15.
[35]. المصدر نفسه، ص89.
[36]. طه عبد الرجمن، فقه الفلسفة: القول الفلسفي/كتاب المفهوم والتأثيل، (بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 1999، ج2، ص144.
[37]. طه عبد الرحمن، سؤال العمل، ص16.
[38]. إدريس كثير، نحو الفلسفة، دار الثقافة/المغرب، ط1، 2007، ص12.
[39]. طه عبد الرحمن، سؤال العمل، م، س، ص17.