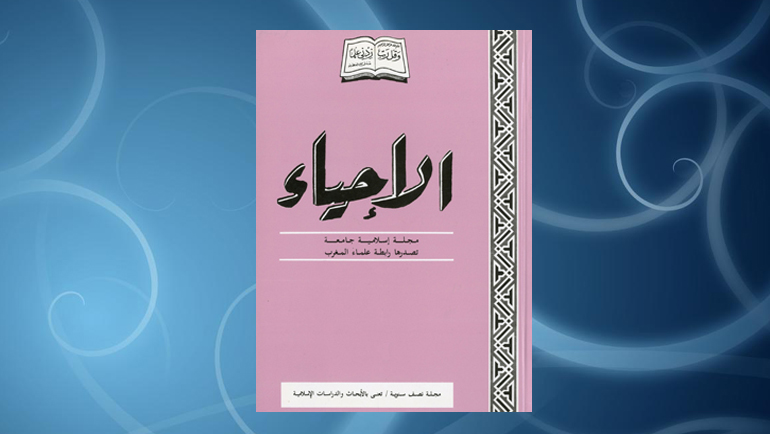
ذ. محمد الحجوي الثعالبي
(العدد 8)
من المعروف أن الإنسان مركب من جسم وروح؛ أي من مادة وروح، فالمادة متجسمة في هيكله المكون من اللحم والدم، والروح الذي لا يتجسم في شيء هو محرك لهذا الهيكل، المضفي عليه حياة وحركة ونشاطا.
فجسم الإنسان إنما هو وعاء يحمل الروح ويحفظه، وقد اندمج أحدهما في الآخر وارتبط وجود الأول بالثاني ارتباطا متينا كليا، حتى إنه لا يتصور وجود الروح بدون جسم، ولا يبقى للجسم معنى بعد أن يغادره الروح نهائيا، فينقلب ترابا.
فهذا الزواج بين المادة والروح يجعلنا نتساءل عن مدى انسجامهما في صعيد واحد، وعن سر ترابطهما في صورة الحيوان الناطق: الإنسان.
خلق الإنسان من لحم ودم، وركبت فيه شهوة الطعام والشراب لكي ينمو جسمه ويقدر على الحركة الملازمة لحياته، فكان مضطرا للبحث عن غذائه الذي لا مناص له منه ولا مفر، وأصبح بحكم ذلك مقيدا بالمادة خاضعا لضرورتها، ملتجئا إليها في حياته أحب أم كره.
فمشيئة الله أرادت أن يخلق الإنسان ضعيفا، مفتقرا إلى رزقه اليومي، مثله في ذلك مثل الحيوان الأعجم، لكنه تعالى وهبه قبسا من نوره ميزه به على الحيوان، ألا وهو العقل، وما العقل إلا ميزان جعل رهن إشارة الإنسان ليزن به الأمور ويميز به بين الحق والباطل، والصواب والخطأ، والخير والشر، فأصبح من المنطق أن يحسن الإنسان استعمال هذا الميزان حتى يتميز عن الحيوان الأعجم الذي لم يوهب عقلا، والذي لا يفرق بين الشيء وضده.
نعم، لقد وهب الله الإنسان شعاعا من نوره، ونفخ فيه من روحه، وركبه من المادة الطاغية، وطلب منه أن يجعل عقله حكما بين جسمه وروحه في صراعهما العنيف المتسلسل مدى الحياة...
فهذه الشهوات والملذات والحاجيات الملحة التي يدعو إليها الجسم دوما، تحاول أن تسيطر على المرء وتجعله ينصرف إليها وحدها ويخضع لسلطانها، ويزج بنفسه في تيارها الصاخب، دون أن يعير اهتماما للجانب الروحي، كأنه لم يخلق إلا من المادة وللمادة، بينما هو مركب من المادة والروح معا، وقبل كل شيء من الروح الخالدة الذي يستوجب أكثر عناية وأكثر اهتماما.
وبما أن الجانب المادي في الحياة براق يخطف الأبصار ويستهوي القلوب والأفكار، فإنه يكاد يحجب الجانب الروحي ويغطيه لولا نور العقل الذي قد يقاومه، ويصارعه، ويشق لصاحبه الطريق وسط الظلمات والأشواك والعراقيل فالإنسان بروحه قبل شيء. لذا يجب عليه – إن هو عمل بموجب العقل والمنطق، أن يهتم بروحه أكثر من اهتمامه بجسده. يجب عليه أن يبحث عن كل ما من شأنه أن يغذي هذا الروح، ويهذبه ويرتفع به عن الماديات وحقارتها، ويحلق به في جو المعنويات التي هي منه وإليه.
أما إذا كبته، وسجنه في محيط الملذات والشهوات والماديات، فإنه يكون قد أساء إليه وعذبه، وحرمه من النمو والحرية والمرح في جوه الطبيعي بينما أطلق العنان لنصفه الآخر حتى ترعرع وطغى على النصف الأول، فيصبح الإنسان بمثابة الحيوان الأعجم ولو كان ناطقا عاقلا، بل يصبح في بعض الأحيان أحط منه وأخس إذ يستعمل عقله وذكاءه في الشر والفجور، فينزل إلى الحضيض، إلى آخر درجة في سلم المخلوقات.
وتجدر الإشارة هنا إلى الملائكة الذين لم يركبوا من المادة، وإنما هم مخلوقات روحانية لا يشتغلون إلا بما يناسب كيانهم الروحي ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا﴾، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.
يتبين من كل ما تقدم أن الله جلت قدرته جعل المخلوقات الحية على ثلاثة أنواع؛ (الملائكة، الإنسان، الحيوان).
وقد شاءت إرادته أن يضع الإنسان وسط هذا الثالوث العجيب، بين الملائكة والحيوانات، فالملائكة وهبت عقلا ولم تركب فيها شهوة، والحيوان ركبت فيها الشهوة ولم توهب عقلا، أما الإنسان فقد جمع بين العقل والشهوة، وطلب منه أن يغلب عقله على شهوته، فإذا فشل فغلب شهوته على عقله، كان أحط من الحيوان، وإذا وفق فغلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة.
وهذا هو السر في كون الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام يوم نفخ فيه من روحه: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا﴾.
وما أمرهم الله بالسجود لآدم إلا لكونه خلق لأمر عظيم، ولكونه عرضت عليه الأمانة فحملها وتكفل بها، قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.
فقد خلقت أيها الإنسان لأمر عظيم، خلقت لتحارب نفسك الأمارة بالسوء، وترغمها على اتباع الطريق المستقيم، وتردها عن غيها كلما جمحت بك نحو الشهوات والملذات، خلقت لتلج سبيل الله وتعكف على ما من شأنه أن يقربك من الله، خلقت لتبحث عن ربك بالاطلاع على آياته وبالتأمل والتفكير في مخلوقاته التي تتجلى فيها عظمته ووحدانيته، وباقتناء الوسائل التي تبلغك تلك الغاية النبيلة.
خلقت لتعبد الله وتتعلق به، وتملأ بحبه قلبك، وبذكره وقتك، وبخوفه نفسك، وهذا معنى قوله تعالى في كتابه المبين: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾.
فهذه هي الغاية التي خلقنا من أجلها والتي لا نعيرها، وبالأسف، كل ما تستحقه من العناية والتفكير.
ولعمري إن جهاد النفس لهو الجهاد الأكبر، هو الجهاد الذي يتطلب منك اليقظة والحذر والكفاح المستمر، ففي كل لحظة أنت مضطر لمواجهة أعدائك الأبديين، الشيطان والنفس والشهوة، وفي كل حين أنت مطالب بإرغام النفس، وكبت الشهوة، والصراخ في وجه الشيطان اللعين الذي يوسوس في صدرك ويغريك ويغويك ويخدعك.
أليس هذا الجهاد يتطلب صبرا وجلدا وعزيمة فولاذية لا يطيق بها إلا ذوو الإيمان الراسخ الذين يلجأون إلى ربهم في كفاحهم، ويستمدون منه العون والنجدة، ويطرقون بابه في كل لحظة. ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ﴾.
لهذا ينبغي أن يكون الإنسان على اتصال دائم بمولاه في حياته الدنيا حتى يتغلب على نفسه باستخدامها في طاعة الله ومرضاته، وتلك هي حكمة مشروعية الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات.
فيا خسارة من قطع الصلة بينه وبين مولاه، فإنه قد فقد كل عون وكل نجدة، وصار لا يستند إلى ركن، مثله كمثل الريشة الملقاة في العاصفة، تتناقلها الرياح وتتلاعب بها التيارات.
ونلاحظ بغاية الحسرة والقلق أن بعض شبابنا أصبح يجهل الغاية الحقيقية من الحياة وفرط تفريطا مزريا في جوهر وجوده، وانغمس في تيار الماديات الذي جرفه، وصار لا يقيم وزنا للروحيات، ولا يعتبر إلا المادة، ويتفنن في الوسائل التي تبلغ إلى إشباع نهم الشهوات، وإرضاء الجانب المادي دون أن يعير أي اهتمام للجانب الروحي الذي هو به "إنسان".
على أني أبادر بالقول بأن الإسلام ليس دين التقشف ولا الزهد ولا الغلو، فهو يراعي في الإنسان الجانب المادي، كما يراعي فيه الجانب الروحي، ولا يطلب من أتباعه أن يكونوا ملائكة معصومين، كما لا يسمح لهم بأن ينزلوا إلى مستوى البهائم العجماء، إنما يريد أن يكون الفرد إنسانا بكل ما في هذه الكلمة من معنى، جديرا بأن ينتسب إلى الإنسانية الحقة لا أقل ولا أكثر.
فهذا الدين الحنيف أباح لنا أن نتمتع بجميع أنواع الطيبات وجميع أنواع الزينة والتسلية البريئة الطاهرة، وعاب على من يحرم منها نفسه، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.
لكن حرم علينا الخبائث والفواحش وكل ما من شأنه أن يفسد عقلنا وصحتنا، أو يوذي بسلامة مجتمعنا وكياننا، كما نهانا عن الانخداع بمظاهر الدنيا وزخارفها والانسياق في تيار الماديات، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾.
فهذه مظاهر الحضارة الغربية البراقة قد استولت على المشاعر، وبهرت الألباب، وتيهت العقول، وسحرت العيون، حتى أصبح الإنسان أسيرا لها، لا يعنيه شيء سواها، ولا يقيم وزنا لشيء غيرها، ولا يحلم إلا بالوصول إليها والتمتع بها ولو أدى به ذلك إلى التنكر للإنسانية، وللفضيلة، وللدين وللأخلاق.
فالإسلام دين يوافق بين الدنيا والآخرة، وبين المادة والروح، ويأمرنا أن نعطي لكل منهما حقه ونصيبه دون أن يضر أحدهما بالآخر، ودون أن يطغى هذا الجانب على ذلك. فبهذا وحده نكون قد طبقنا تعاليم الدين على الوجه الأكمل، واهتدينا بهديه السليم، وسرنا في طريقه المستقيم، وأدينا رسالتنا أحسن الأداء. فيا حبذا لو رجعنا إلى مبادئ الإسلام الحقة، وإلى كتاب الله المبين وسنة نبيه الأمين، ويا ليتنا لم نفرط في الدين ولم نزدر قوانينه ونستهزئ بشعائره التي تحثنا على أن نعمل للدنيا وللآخرة معا، لا أن نضرب بالآخرة عرض الحائط، وأن نصرف كل همنا في الدنيا الفانية. "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ولآخرتك كأنك تموت غدا".
فهذه هي النتيجة التي كنت أود أن أخرج بها من هذا البحث المتواضع، وحسبي أن أكون قد نبهت من الغفلة، وأيقظت من الغفوة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.







