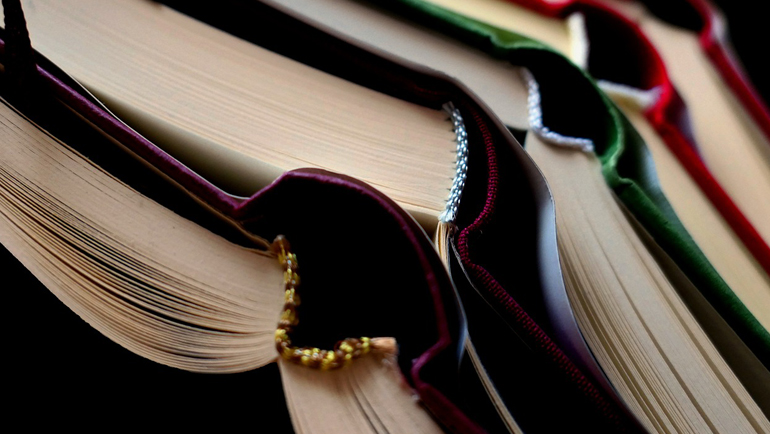ليسَ كلُّ حَشوٍ مَذموماً، فمنه مَحمودٌ وهو «الحَشوُ السَّديدُ في المَعْنى المُفيد»
ذَكَرَه المُظفَّرُ بنُ الفَضل العَلوي (ت. 656هـ) في "نَضْرة الإغْرِيض في نُصْرة القَرِيض"
ذَكَرَه في سياقِ حَديثِه عَمّا يَحتاجُ إليه الشِّعرُ من آلات، وله مصطلحاتٌ وصفات. وهي النحو والبلاغة والفصاحة والحقيقة والمجاز والصنعة والمصنوع وإقامة الوزن والقوافي
فأما الحشوُ السديدُ فقد مَثَّل له بقولِ أبي الشّيص الخزاعي:
إِنَّ الثَّمَانِينَ، وَبُلِّغْتهَا، /// قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِي إِلَى تُرْجُمَانِ
فقوله: وبُلِّغتها: حشوٌ سديدٌ وقد أفادت من الدعاء معنى جيداً.
وأنشد اليزيديّ:
فمَنْ ليَ بالعيْنِ التي كنتَ مرّةً ... إليّ بها، نفْسي فِداؤكَ، تنظُرُ
قولُه: نفسي فداؤكَ، كقولهِ: وبُلِّغْتَها، في الدُعاء. وقال أبو الوليد عبد الملك بن عبد الرحمن الحارثي:
فلَوْ بِكَ ما بي، لا يكُنْ بكَ، لاغتدَى ... وراحَ إليكَ البِرُّ بي والتّقَرُّبُ
قولُه: لا يكُنْ بكَ حشْوٌ حسن. وأنشد أبو عمرو بن العلاء الجاهلي:
وعَوْدٌ، قليلُ الذَّنْبِ، عاوَدْتُ ضرْبَهُ ... إذا هاج شوقي من معاهدِها ذِكْرُ
وقلتُ له ذَلفاءُ، ويحَك، سبّبَتْ ... لك الضربَ فاصْبرْ إنّ عادتَك الصّبْرُ
أخذ ابنُ المعتزّ هذا المعنى فقال:
وخَيْلٍ طواها القَوْدُ حتّى كأنّها ... أنابيبُ سُمْرٌ من قَنا الخَطِّ ذُبَّلُ
صَبَبْنا عليها، ظالمينَ، سِياطَنا ... فطارَتْ بها أيدٍ سِراعٌ وأرْجُلُ
قوله: ظالمين مثل قوله: قليل الذنب فهذا هو الحشْو السّديد، في اللفظ المُفيد. أما إذا كان الحشو كقولِ أبي العيال الهُذَلي:
ذكرتُ أخي فعاودَني ... صُداعُ الرأسِ والوَصَبُ
فالصداعُ لا يكون إلا في الرأس، وذكرُ الرأس حشْوٌ غيرُ سديد، ومثله قول ديك الجن:
فتنفّسَتْ في البيت إذ مُزِجَتْ ... بالماءِ واسْتلّتْ سَنا اللهَبِ
كتنفُّسِ الرَيْحانِ خالَطَهُ ... من ورْد جُورٍ ناضِرُ الشُّعَبِ
فذِكْرُهُ المزج يغني، وذِكْرُهُ الماءَ زيادةٌ لا يحتاج إليها، ولقد قصّر عن قول أبي نواس:
سَلّوا قِناع الطينِ عن رمَقٍ ... حيّ الحياة مُشارِفِ الحتْفِ
فتنفّسَتْ في البيت إذ مُزجَتْ ... كتنفُّسِ الرّيْحانِ في الأنْفِ
أمّا مَجيءُ "كانَ" حشواً في سياق التعجبِ فهو كثير، قياساً، وقد وردَ في غيرِها بغيرِ قياسٍ، فمما وردَت فيه كان الزائدةُ حشواً بين أداة التعجب وفِعْلِه قولُ الشاعر:
لله در أنو شروان من رجل /// ما -كانَ- أعْرَفَه بالدون والسفل
ونظيره قول الحماسي:
أبا خالد ما -كانَ- أوهى مصيبة أصابت معدا يوم أصْبَحْتَ ثاويا
وقول امرئ القيس بين حجر الكندي:
أرى أمَّ عمر ودَمْعها قد تحدرا /// بكاء على عمرو، وما -كان- أصبرا
أي: ما كانَ أصبرها،
وقول عروة ابن أذينة:
ما -كانَ- أحسنَ فيك العيشَ مؤتنفا /// غضا، وأطيب في آصالك الأصلا
أما ما سُمِعَت فيه زيادةُ "كانَ" حَشواً في غيرِ سياقِ التعجب، زيادَتُها بين الفعل ومرفوعه، قولُهُم: وَلَدَت فاطمةُ بنتُ الخرْشَبِّ الأنماريّةُ الكَمَلَةَ مِن بني عَبْسٍ لم يوجَدْ -كانَ- أفضل منهم.
وسُمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله الشاعر:
فَكيف إذا مررت بدار قوم /// وجيران لنا -كانوا- كرامِ
وشذَّت زيادَتُها بين الجار ومجروره، كقوله:
سَراةُ بني أبي بكر تسامى /// على -كان- المسومةِ العرابِ.
المصدر: نَضْرَة الإغريض في نُصرَة القَريض، المُظفَّر بن فضل العَلَوي (ت.656هـ) تح. نُهى عارف الحَسَن، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص:12