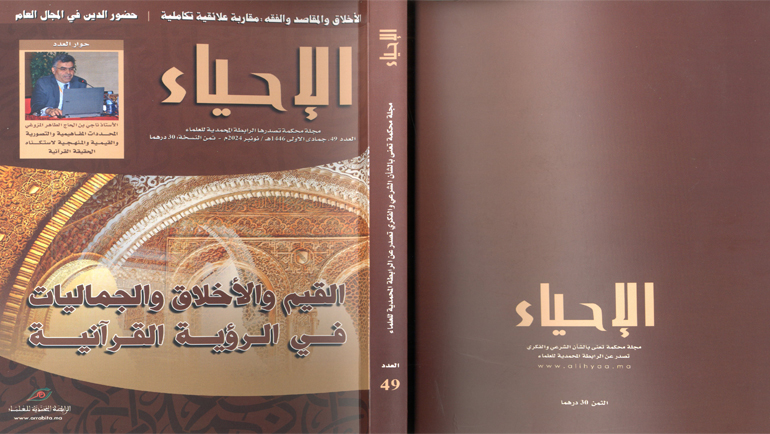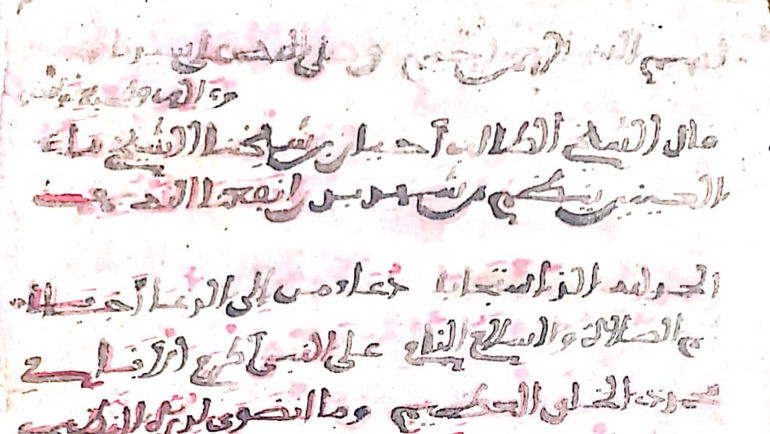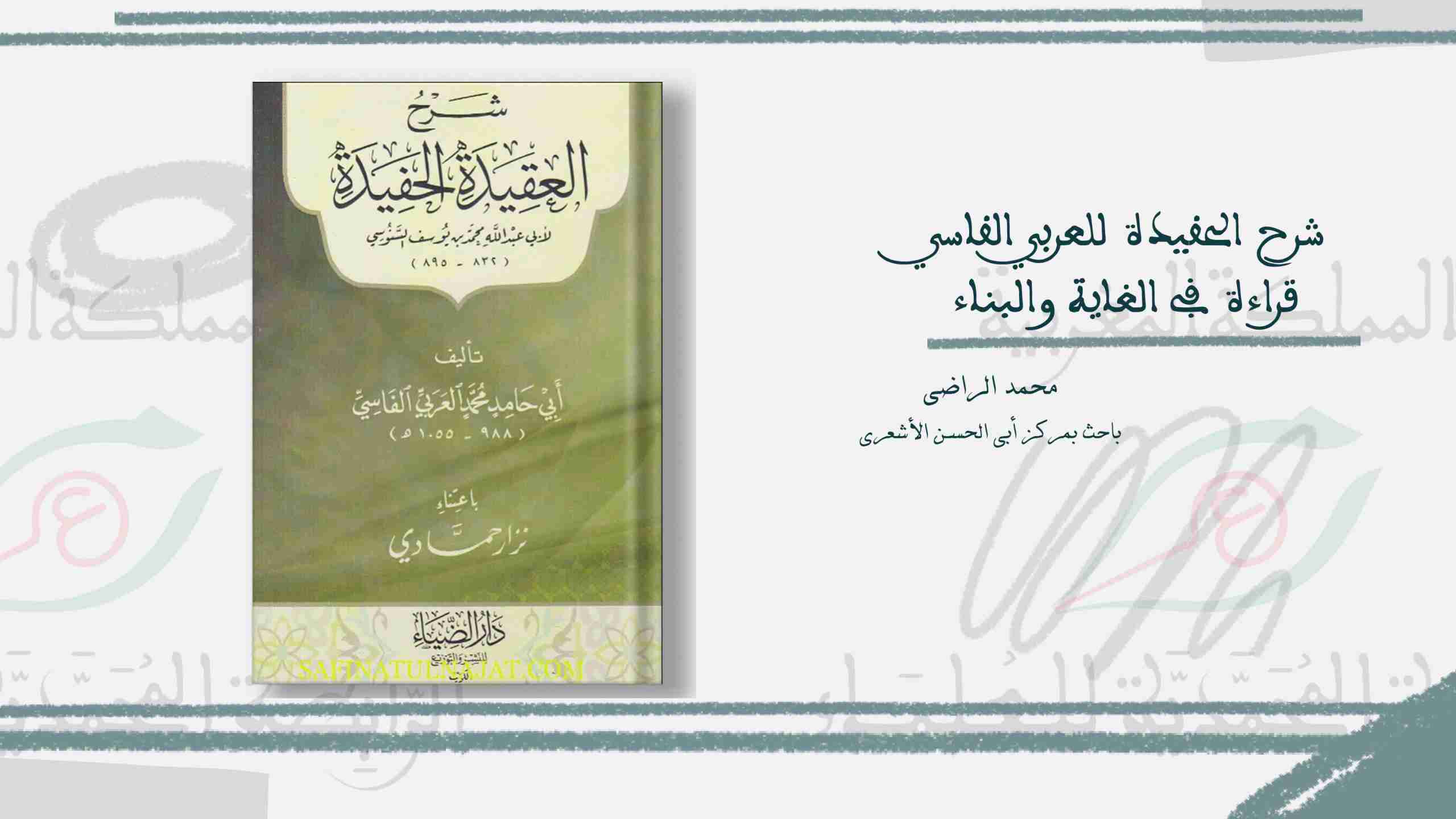أبرز سيد قطب رحمه الله في كتابه الفريد "التصوير الفني في القرآن" بصمته الأدبية، وتمكّنه اللغوي؛ حيث اشتغل على خصيصة من خصائص الأدب اللغوي؛ وعمل على تطبيقها على النص القرآني الكريم؛ وهي "التصوير الفني"، مجتهدا بذلك ما وسعه. وعن مناسبة تأليفه لهذا الكتاب، يقول: «وخطر لي أن أعرض للناس بعض النماذج مما أجده في القرآن من صور؛ ففعلت، ونشرت بحثًا في مجلة المقتطف عام 1939 تحت عنوان: "التصوير الفني في القرآن". تناولت فيه عدة صور فأثبتها؛ وكشفت عما فيها من جمال فني، وبينت القدرة القادرة التي تصور بالألفاظ المجردة، ما تعجز عن تصويره الريشة الملونة، والعدسة المشخصة. وقلت: إن هذا البحث يصلح أن يكون موضوعًا لرسالة جامعية»[1]. وعن الغرض من تصنيفه هذا المؤلَّف، يقول: «لقد بدأت البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف، لأجمع الصور الفنية في القرآن، وأستعرضها، وأبين طريقة التصوير فيها، والتناسق الفني في إخراجها -إذ كان همي كله موجهًا إلى الجانب الفني الخالص، ودون التعرض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو الفقهية، أو سواها من مباحث القرآن المطروقة»[2]. وفي معرض حديثه عن أساس بحثه ومرتكزه يحدثنا فيقول: «إن حقيقة جديدة تبرز لي، أن الصور في القرآن ليست جزءًا منه يختلف عن سائره. إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل. القاعدة الأساسية المتبعة في جميع الأغراض -فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال -فليس البحث إذن عن صور تجمع وترتب. ولكن عن قاعدة تكشف وتبرز. ذلك توفيق. لم أكن أتطلع إليه، حتى التقيت به! وعلى هذا الأساس قام البحث، وكل ما فيه إنما هو عرض لهذه القاعدة، وتشريح لظواهرها، وكشف عن هذه الخاصية التي لم يتعرض من قبل لها»[3]. وفي عرض فريد من الكتاب وسمه بـ"منبع السحر في القرآن الكريم"؛ حدثنا عن مدى تأثر العرب وإعجابهم بالنسق القرآني المعجز الباهر لعقولهم؛ المفحمة لبلغائهم، فيقول: «يجب إذن أن نبحث عن «منبع السحر في القرآن» قبل التشريع المحكم، وقبل النبوءة الغيبية، وقبل العلوم الكونية، وقبل أن يصبح القرآن وحدة مكتملة تشمل هذا كله. فقليل القرآن الذي كان في أيام الدعوة الأولى كان مجردًا من هذه الأشياء التي جاءت فيما بعد، وكان -مع ذلك- محتويًا على هذا النبع الأصيل الذي تذوقه العرب، فقالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر». ليتساءل : «فأين هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير والتقدير؟»[4]. ليخلص مستنتجا بقوله: «لا بد إذن أن السحر الذي عناه كان كامنًا في مظهر آخر غير التشريع والغيبيات والعلوم الكونية. لا بد أنه كامن في صميم النسق القرآني ذاته»[5]. يليها بمقاربة متميزة بين أثر القرآن الكريم في شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والوليد بن المغيرة أحد صناديد قريش وأحد بلغائها ومهرتها بلسان العرب، إذ يقول في ختامها: «ولكننا نجد في هذه السورة ـ كما نجد في سواها من السور المكية والمدنية على السواء ـ مُثُلا من ذلك الجمال الفني الذي ضربنا له الأمثال. وإننا لنستطيع أن ندع ـ مؤقتا ـ قداسة القرآن الدينية، وأغراض الدعوة الإسلامية؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والمكان؛ ونتخطى الأجيال والأزمان، لنجد بعد ذلك كله هذا الجمال الفني الخالص، عنصرا مستقلا بجوهره، خالد في القرآن بذاته، يتملّاه الفن في عزلة عن جميع الملابسات والأغراض. وإن هذا الجمال ليتملى وحده فيغني؛ ويُنظر في تساوقه مع الأغراض الدينية فيرتفع في التقدير»[6]. وفي معرض حديثه عن كتب التفسير، وتطرقها للجمال الفني في القرآن الكريم، يقول: «ثم أخذ التفسير ينمو ويتضخم ابتداء من أواخر القرن الثاني، ولكن بدلا من أن يبحث عن الجمال الفني في القرآن أخذ يغرق في مباحث فقهية وجدلية، ونحوية وصرفية، وخلقية وفلسفية، وتاريخية وأسطورية. وبذلك ضاعت الفرصة التي كانت مهيأة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفني في القرآن»[7]. ويقول معترضا مستدركا: «بقي الباحثون في البلاغة وفي إعجاز القرآن، وكان المنتظر أن يصل هؤلاء ـ وقد خُلِّي بينهم وبين البحث في صميم العمل الفني في القرآن ـ أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه المفسرون. ولكنهم شغلوا أنفسهم بمباحث عقيمة حول «اللفظ والمعنى» أيهما تكمن فيه البلاغة؛ ومنهم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية، فأفسد الجمال الكلي المنسق، أو انصرف عنه إلى التقسيم والتبويب؛ ووصلوا في هذا وذلك في بعض الأحيان، إلى درجة من الإسفاف لا تطاق»[8]. ورغم إشادة سيد قطب بالزمخشري والجرجاني رحمهما الله في ملامستهما لهذه الخصيصة القرآنية؛ «الجمال الفني في القرآن»، دون غوصهما فيه وطرقهما لُبابه، فقد انتقد جهود القدامى في إبراز الجمال الفني في القرآن الكريم قائلا: «وأيًّا ما كانت تلك الجهود التي بذلت في التفسير، وفي مباحث البلاغة والإعجاز، فإنها وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديمة، تلك العقلية الجزئية التي تتناول كل نص على حدة، فتحلله وتبرز الجمال الفني فيه ـ إلى الحد الذي تستطيع ـ دون أن تتجاوز هذا إلى إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله. هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن، فلم يحاول أحد أن يجاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة. اللهم إلا ما قيل في تناسق تراكيب القرآن وألفاظه، أو استيفاء نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة. وهذه ميزات ـ كما قال عبد القاهر بحق ـ لا تذكر في مجال الإعجاز، لأنها ميسرة لكل شاعر وكاتب شب عن الطوق»[9]، إلى أن يقول: «وبذلك بقي أهم مزايا القرآن الفنية مُغفلا خافيا، وأصبح من الضروري لدراسة هذا الكتاب المعجز من منهج للدراسة جديد، ومن بحث عن الأصول العامة للجمال الفني فيه، ومن بيان للسمات المطردة التي تميز هذا الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب؛ وتفسر الإعجاز الفني تفسيرا يستمد من تلك السمات المتفردة في القرآن الكريم. وإن لهذا الكتاب العظيم لخصائص مشتركة، وطريقة موحدة، في التعبير عن جميع الأغراض، سواء كان الغرض تبشيرا أم تحذيرا، قصة وقعت أو حادثا سيقع، منطقا للإقناع أو دعوة إلى الإيمان، وصفا للحياة الدنيا أو للحياة الأخرى، تمثلا لمحسوس أو ملموس، إبرازا لظاهر أو لمضمر، بيانا لخاطر في الضمير أو لمشهد منظور. هذه الطريقة الموحدة، هذه القاعدة الكبيرة، هي التي كتبنا من أجلها هذا الكتاب...هي .. التصوير الفني»[10]. وعن المقصود بالتصوير الفني في القرآن الكريم يحدثنا في مطلع مبحثه الموسوم بالتصوير الفني فيقول: «التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية؛ وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور؛ وعن النموذج الإنساني، والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد؛ وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية. فأما الحوادث والمشاهد، والقصص والمناظر، فيردها شاخصة حاضرة؛ فيها الحياة، وفيها الحركة؛ فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل. فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة؛ وحتى ينقلهم نقلًا إلى مسرح الحوادث الأول، الذي وقعت فيه أو ستقع؛ حيث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات؛ وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى، ومثل يضرب؛ ويتخيل أنه منظر يعرض، وحادث يقع. فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو؛ وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات، المنبعثة من الموقف، المتساوقة مع الحوادث؛ وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة، فتنم عن الأحاسيس المضمرة. إنها الحياة هنا، وليست حكاية الحياة»[11]. وعدّ هذا التصوير من بعض أسرار الإعجاز في التعبير القرآني بقوله: « فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية، وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروي، إنما هي ألفاظ جامدة، لا ألوان تصور، ولا شخوص تعبر، أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن». ولتأكيد مذهبه، وترسيخ طرحه وما عناه، يقول: «وهذا هو الذي عنيناه حينما قلنا: "إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن". فليس هو حلية أسلوب، ولا فلتة تقع حيثما اتفق. إنما هو مذهب مقرر، وخطة موحدة، وخصيصة شاملة، وطريقة معينة، يفتن في استخدامها بطرائق شتى، وفي أو ضاع مختلفة؛ ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة التصوير»[12]. وليضرب لنا جملة من الأمثال توضح منزعه، وتمثل تدوين ما رام له. ليحدد ـ في كتابه ـ مباحث علمية تتضمن آفاق "التصوير الفني في القرآن الكريم"، وألوانه وصوره؛ وهي: - التخييل الحسي والتجسيم - التناسق الفني - القصة في القرآن - أغراض القصة - آثار خضوع القصة للغرض الديني - الدين والفن في القصة - الخصائص الفنية للقصة - التصوير في القصة - رسم الشخصيات في القصة - نماذج إنسانية - المنطق الوجداني - طريقة القرآن وفي خاتمة كتابه يؤكد على حقيقة مفادها: «أن الدين لا يقف في طريق البحوث الفنية والعلمية التي تتناول مقدساته تناولا طليقا من كل قيد، وعلى أن البحوث الفنية والعلمية لا تصدم الدين ولا تخدشه حينما تخلص فيها النية، وتتجرد من الحذلقة والإدِّعاء، وأن حرية الفكر لا تعني حتما مجافاة الدين، كما يفهم بعض المقلدين في التحرر، حين يرون الجفوة بين الدين والفن والعلم في أوروبا لظروف تاريخية خاصة بالقوم هناك؛ فينقلونه نقلا إلى العالم الإسلامي، الذي لم تقع الجفوة بين الدين والعلم والفن فيه في يوم من أيام التاريخ»[13]. وليردف بالقول: «فليس هنالك من شطط حين أقول: إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن». إلى حين قوله عن كتابه والأثر الذي تركه في أوساط الدارسين: «وإنه ليسرني أن أعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طريقة التصوير في التعبير القرآني؛ أتاحت للكثيرين من دارسي القرآن، ومن أساتذة المدارس أن يجدوا سمة التصوير الفنية في مواضع كثيرة لم ترد في كتابي؛ وأن يستروحوا فيها جمالًا فنيًّا خالصًا يستخلصونه بأنفسهم، ويلتذونه بشعورهم، ويطبقونه على الشعر والنثر الفني في غير القرآن»[14]. انتهى.
الهوامش:
[1] سيد قطب، التصوير الفني في القرآن (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الشرعية السابعة عشرة، 1425هـ/2004م) (ص: 8-9). [2] المرجع نفسه (ص: 9). [3] المرجع نفسه (ص: 9-10). [4] المرجع نفسه (ص: 19). [5] المرجع نفسه (ص: 19). [6] المرجع نفسه (ص: 24). [7] المرجع نفسه (ص: 27). [8] المرجع نفسه (ص: 29). [9] المرجع نفسه (ص: 34). [10] المرجع نفسه (ص: 34-35). [11] المرجع نفسه (ص: 36). [12] المرجع نفسه (ص: 37). [13] المرجع نفسه (ص: 253) [14] المرجع نفسه (ص: 255)