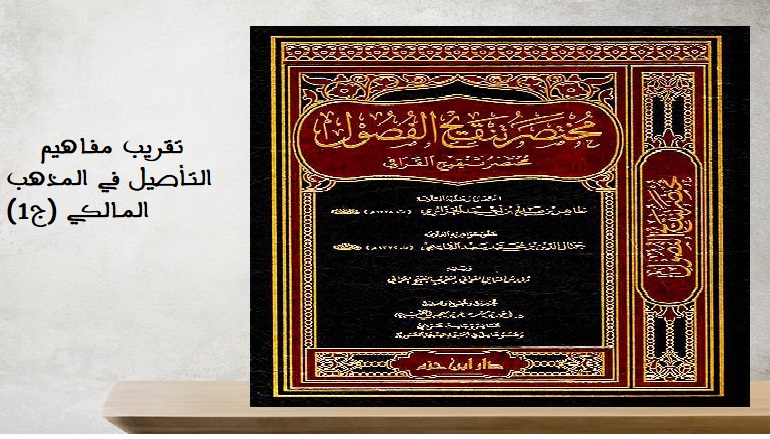مقدمة
يعتبر القرءان الكريم المصدر الأول من مصادر المعرفة في المجال التداولي الإسلامي، وهذا لا يعني أن القرءان يحتوي على كل المعارف والعلوم، وإنما لكون رؤى الكون والحياة، والتصورات المؤطرة لحركة الإنسان وتعامله مع مفردات الكون وقراءته لها كامنة فيه، والتي يمكن النفاذ إليها عبر سبر أغواره ومراعاة نظامه.
ومن حيث أن القرءان المجيد كلام الله عالم الغيب والشهادة الذي أحاط بكل شيء علما، يبقى هو المهيمن على كل المعارف والعلوم البشرية. ولابد في هذه الأخيرة من الانضباط بضوابطه والاستمداد من روحه. وكل معرفة أو علم نشأ بعيدا عن روح القرءان، إلا وتكون له نتائج سلبية على الإنسان والكون، أو يكون مدمرا لهما معا. وبالتالي يمكننا الحديث عن محددات منهاجية معرفية في القرءان، ستقتصر هذه المداخلة على أربعة منها هي:
- الغيب والشهادة.
- المطلق والنسبي.
- التعليم الإلهي.
- التصديق والهيمنة.
إن المعرفة هي سر الوجود، وذلك لأن علة وجود الإنسان عبادة الله، والإنسان لا يمكن أن يكون عابدا إن لم يكن عارفا، فالمعرفة بهذا شرط عبادتنا وسر وجودنا نحن بني الإنسان. ذلك أن الله، عز وجل، لا يعبد عن جهل لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: 28)، وقوله سبحانه: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: 10).
الله، عز وجل، هو الحقيقة المطلقة، وكل المعارف وجب أن تتصل بهذه الحقيقة وتسعى في الوصول إليها، ونجد هذا جليا في دراسات المؤرخ البريطاني "أرنولد توينبي"، المشهور بإضفائه البعد الديني على علم التاريخ وفلسفته، حيث اعتبر أن مهنته كمؤرخ هي في النهاية سعي لرؤية الله وهو يعمل في التاريخ، كما اعتبر أن حقائق التاريخ هي مفاتيح الطبيعة ومعنى الكون الغامض ومكاننا فيه، وأن الواقع الروحي خلف الظواهر هو الهدف النهائي لكل فضول[1]، وكذا وجب أن تكون فلسفة كل علم ومعرفة أي معرفة الحقيقة الكبرى والحقيقة الأولى الله، جل جلاله، ذلك أن الله يتجلى في كل شيء، وكل معرفة لا توصل إلى هذه الحقيقة فهي إما معرفة ناقصة أو ضالة.
من هنا تأتي أهمية المحددات المنهاجية للمعرفة في القرءان الكريم، باعتباره المصدر الأول من مصادر المعرفة، ثم باعتباره كلام الله المهيمن على معرفتنا ووجودنا. ومن شأن هذه المحددات أن تحول دون تيهان المعرفة البشرية في مجموعة من الإشكالات الفكرية من قبيل؛ تأليه الكون وتكونن الإله، تأليه الإنسان وأنسنة الله، أنسنة الكون وتكونن الإنسان[2]، هذه الفرضيات التي أسرت العقل والفكر الإنساني الحضاري برمته في محاولاته لتفسير ما حوله وعلاقته بمفردات الوجود والنواظم الرابطة بينها.
أولا: الغيب والشهادة
ترتبط نظرية المعرفة ارتباطا مباشرا بنظرية الوجود وهي تابعة لها، إذ تعتبر ثنائية الغيب والشهادة محددا رئيسا لإشكالات المعرفة (إمكان المعرفة، حدود المعرفة، طبيعة المعرفة). ذلك أنّ وجود الأشياء لا يتعلق بمعرفة الإنسان لها أو عدمه، فالوجود أكبر من أن يلم به الإنسان أو يدركه. وتقسيم القرءان للوجود إلى غيب وشهادة يشبه، إلى حد ما، التقسيم الفلسفي حيث ينقسم الوجود إلى ميتافيزيقي أي ما وراء الطبيعة، وإلى فيزيقي طبيعي.
إلا أن التقسيم القرءاني يختلف عن الفلسفي من حيث الربط الموجود بين العالمين، فالغيب والشهادة في القرءان ينتظمان انتظاما محكما، حتى صار عالم الشهادة بلا غيب بدون جدوى أو عبثا، كما أن عالم الشهادة دلالة وعلامة على عالم الغيب، وذلك لأن فكرة الغيب لها تأثير عملي مباشر على حياة الإنسان العملية والمعرفية، فكل توقيعاته في هذه الحياة الدنيا تتأثر بإيمانه بالغيب من عدمه؛ فالإيمان بالغيب "قيمة من القيم التي فرضها الله على الوجود الإنساني والمعرفة الإنسانية في كل مكان وزمان"[3]، مما يقودنا إلى القول بأن المعرفة الإنسانية قائمة على جدلية الغيب والشهادة.
إن قراءة الإنسان لا تكون إلا في هذه المجالات: (الشهادة، الغيب، الوحي)، والعلم أيضا لا يخرج عن هذه المجالات، فعالم الغيب مصدره الوحي وتصديقه عالم الشهادة (مشاهدة الظواهر الغيبية التي أخبر عنها الوحي من الموت والحياة والبعث من جديد...)، فلا يمكن للإنسان الوصول إلى معرفة وعلم بعالم الغيب إلا ما أخبر عنه الوحي.
أما بالنسبة لعالم الشهادة والوحي فهما مجالان متعادلان، وكلاهما يحيل على الآخر ويدل عليه، وكلاهما محتاج إلى الآخر في عملية القراءة، وكل فصل بينهما يؤدي إلى اختلال التوازن، لأن الله عز وجل خالق للكون وعالم به، وخالق للإنسان وعالم به، فأنزل القرءان دليلا للإنسان وهاديا له في هذا الكون الفسيح المليء بالأسرار والقوانين، مثل الدليل الذي تضعه المؤسسات للتعامل مع منتجاتها وصناعاتها، ولله المثل الأعلى.
إن القراءة تقدم علاقة تكاملية تآزرية بين عالم الشهادة وعالم الغيب، إذ تجعل الإنسان كلما "مكنته قراءته من تحقيق ذاته في عالم الشهادة، كلما كان أكثر قدرة وصلة بعالم الغيب، لأن قراءة الإنسان في كتاب الله، سواء التكويني (الكون)، أو التدويني (القرءان) تفتح له آفاق الغيب ليصبح شاهدا، بحيث يصبح عنده الغيب شهادة ... والإنسان بمقدار ما يكون قارئا لكتاب الوجود، بمقدار ما يكون مؤهلا لممارسة الخلافة على الأرض، فالقراءة هي الطريق إلى العلم، وهي الطريق إلى الاكتمال"[4].
1.الغيب
إن التصور الذي يقدمه القرءان عن الوجود يفضي إلى أن العالم لا ينحصر فيما هو مشاهد ومحسوس، بل إن هناك عالم غيبي خارج عن نطاق الحواس. إن الوحي وحده من يستطيع أن يقدم للإنسان تصورات يقينية عن المعارف المتصلة بعالم الغيب، لأن الإنسان عاجز عن إدراك الغيب بل هو عاجز حتى عن إدراك ما يمكن أن تدركه الحواس.
والخلل الذي يمكن أن يصيب المعرفة منهجيا هو الفصل بين الشهادة والغيب، أو إنكار هذا الأخير، فلابد من التكامل المعرفي بين عالم الشهادة وعالم الغيب لأنهما عالمان متداخلان ومرتبطان بعضهما ببعض، ولا يمكن الفصل بينهما بتاتا. فالمعرفة كما الدين تعتمد على الإيمان بالغيب، وإهدار هذا الجانب هو إهدار للمعرفة وللعقل الإنساني، بل إن المعرفة لا تكون معرفة حقيقية إلا إذا كانت معرفة مبنية على الإيمان بالغيب، لأنه إذا أنكرنا أو أهملنا فكرة الغيب سنكون أمام نتيجة حتمية وهي إنكار وجود الله وبالتالي ستضيع الحقيقة بضياع الحقيقة الكبرى ألا وهي وجود الله، عز وجل، الذي يرجع إليه كل الوجود بداية ومصيرا. والمعرفة بأسرار هذا الوجود الكامنة في الترتيب والوحدة في التركيب وفي التكامل الوظيفي للموجودات والعلائق بينها والنظام والانتظام كلها أمور تدل على وحدة الخالق المبدع.
وينقسم الغيب إلى عدة أقسام منها؛
أ. غيب وجودي (الله وملكوته)، يخبرنا الله، عز وجل، في كتابه أنه: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذا النور تدركه القلوب ولا تدركه الأبصار، الله أكبر من الوجود ولا صورة له وليس له شبيه حتى يمكن تخيله، أحاط بكل شيء علما ولا يحيط الإنسان به ولا بشيء من علمه: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ (الجن: 26-27).
كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول
كيف يحكي الربُّ أم كيف يُــرى فلعمري ليس ذا إلاّ فـضــول
فهو لا أينَ ولا كيف لــــــه وهو ربُّ الكيفِ والكيفُ يـحول
جَلّ ذاتًا وصفاتٍ وسمـــــــا وتـعالى قدره عما تقــــول[5]
ب. غيب إنساني، الإنسان ينتمي إلى عالم الشهادة لكن روحه تنتمي إلى عالم الغيب: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: 85)، كما أن كثيرا من متعلقات النفس البشرية، وكذا وظائفه العضوية والحسية الشعورية تبقى في جلها خفية مستعصية الإدراك. وقد أجمل الإمام الغزالي، رحمه الله، وصفها في هذه الأبيات:
قل لمن يفهمُ عني ما أقـــول قصّر القولَ فذا شرحٌ يطــولْ
ثمَّ سِرٌّ غامضٌ من دونــــــه قَصُرَتْ، والله، أعناق الفحـول
أَيْنَ منك الروحُ في جوهــــرها هل تراها أم ترى كيف تجـول
وكـذا الأنفاسُ هل تحصُــــرها لا ولا تدري متى عنك تـزول
أين منك العـقلُ والْـــــهَمُّ إذا غَلَبَ النومُ فقل لي يا جــهول
أنت، أًكْلُ الخبزِ لا تعــــــرفه كيف يجري منك أم كيف تبـول
ج. غيب مكاني، الإنسان لا يستطيع أن يرى إلا في حدود مسافة معينة، كما لا يستطيع أن يسمع إلا في حدود معينة، وهو داخل بيته لا يستطيع أن يعرف ماذا يفعل أبناؤه في الغرفة المجاورة، ولا يستطيع أن يعرف ما يحدث خارج منزله إلا ما أخبره به المخبرون. فكيف يستطيع إذن أن يعرف ما يحدث في العالم من أحداث فوق الأرض وتحتها وفي قاع البحر وفي السماء؟! لكن الله يعلم كل ذلك ! حتى الأوراق التي تسقط من الشجر يعلمها مصداقا لقوله عز وجل: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الأنعام: 60)؛ فهو، سبحانه، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وكيف سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون!
د. غيب زماني؛ وينقسم إلى ماض: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (هود: 49)، ومستقبلي: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (لقمان: 33)، كما أنها لا تدري متى تموت، وإلى أين المصير، وكيف هو المصير. وكل ما هو آت يبقى غيبا إلا ما أخبر عنه الله في كتابه العزيز أو رسوله الكريم.
2.الشهادة
إذا كان عالم الغيب هو ما غاب عن علم الإنسان، ولا سبيل له لإدراكه إلا ما أخبره به الله في كتابه أو على لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإن عالم الشهادة هو مجال حركة الإنسان وتوقيعه وهو الجزء المشاهد من هذا الكون، ولا يعني هذا أن الإنسان يحيط به علما تاما، بل تبقى معرفته به معرفة نسبية محدودة بمحدودية قدرات الإنسان الإدراكية ومداخله المعرفية. وهو ما سنتحدث عنه فيما يتلو.
ثانيا: المطلق والنسبي
المطلق والنسبي من المحددات الرئيسة للمعرفة، ففي المجال المعرفي لابد من بيان حدود المعرفة الإنسانية وإمكاناتها في مقابل المطلق التام والكامل المتعري عن كل قيد أو حصر أو استثناء أو شرط، والخالص من كل تعيُّن وتحديد، الموجود في ذاته وبذاته، واجب الوجود المتجاوز للزمان والمكان وإن تجلى فيهما. المتسم بالثبات والعالمية، الذي لا يرتبط بأرض معينة ولا بشعب معين ولا بظروف أو ملابسات معينة. والحقائق المطلقة هي الحقائق القبلية التي لا يستمدها العقل من الإحساس والتجربة، بل يستمدها من المبدأ الأول وهو أساسها النهائي. والحقيقة المطلقة هي النقطة التي تتلاقى عندها كل الأضداد، وفروع المعرفة جميعا من علم ودين، وهي النقطة التي يتداخل فيها المقدّس والزمني فهي وحدة وجود متكاملة[6].
إن المعرفة الإنسانية معرفة نسبية في مقابل معرفة الله المطلقة التي لا يحدها زمان ولا مكان، الله الذي أحاط بكل شيء علما: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (طه: 107)، ولا يحيط الإنسان بشيء من علمه إلا ما علمه إياه: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (البقرة: 255)، كما أن الله حقيقة مطلقة لكن معرفة الإنسان بكنه هذه الحقيقة تبقى نسبية، كما الوجود كله لا يستطيع الإنسان، مهما تطور ومهما بلغ من العلم، أن يحيط علما بمفردات الوجود وأسراره.
وهذه نتيجة منطقية لمحدودية القدرة على المعرفة عند الإنسان، فمثلاً الإنسان قد لا يرى من هذه الأشياء أمامه إلا ما يعكسه مدى من الأشعة لو طالت موجتها عنه أو قصرت لم ير شيئاً، وكذلك لا يسمع إلا مدى من الموجات الصوتية لو زادت أو قلت عنه لم يسمع شيئاً. والمعرفة الراشدة تؤمن يقيناً أن الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلاً، وأنه لا يعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: 85).
إن نسبية المعرفة لا تعني أبدا عدم إمكان المعرفة، بل الإنسان مدعو لسبر أغوار الكتابين المسطور والمنظور على حد سواء. والآيات القرءانية هي التي تحث الإنسان على النظر في الآفاق، وفي الأنفس، والسير في الأرض، والتفكر في الخلق، لاكتشاف سنن الله في الكون قصد الانتفاع بها روحيا وماديا. لكن يجب على الإنسان أن يستحضر أن العلم الذي يحصله نسبي، ليست له صفة الإطلاقية، ذلك أن كلمات الله لا تنفذ وحقائق الكون لا تنتهي، وآيات الله في الأنفس والآفاق لا حد لها ولا حصر.
ورغم كل القدرات التي زود الله بها الإنسان، إلا أنها تبقى نسبية؛ أي أن الإنسان لا يمكن أن يحيط علما بأسرار الوحي والكون وعالم الشهادة وعالم الغيب، ولا نقول هنا باستحالة الإدراك كما ذكرنا، لكن نقصد أنه إذا علم أو أدرك شيئا غابت عنه أشياء كثيرة الله وحده يعلمها، وليس "كما يزعم دعاة الحضارة الغربية الذين يقوم فكرهم على أساس طغيان معرفة الإنسان، وهو ما عرف بالفاوستيه، وتعني عبقرية الإنسان وقدرته على اكتشاف المجهول مهما بلغ هذا المجهول من خفاء، ولكون الإنسان قد أدهش بإنجازاته الضئيلة، فإنه غير قادر على تفهم معنى العناية الإلهية به، رغم أنه لا يزال في حضيض المعرفة فيما لو علم أن ما تم اكتشافه حتى اليوم، ليس شيئا بإزاء غوامض وأسرار عالم الشهادة، فكيف بعالم الغيب؟!"[7].
وحيث إن طبيعة الإنسان عاجزة وقاصرة عن إيجاد نفسها، فهي محتاجة إلى الله سبحانه في أصل خلقتها، ومن ثم فكينونته العارفة محتاجة إلى الله سبحانه في استعدادها وقدرتها على المعرفة والتعلم، ومحتاجة إلى مجال تمارس فيه عملية المعرفة.. ولهذا كانت معرفته نسبية بمعنى أنها معطاة له من الله بنسبة محدودة سواء بطريق الحس والعقل أو بطريق الوحي لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: 85)، وقوله تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (يوسف: 76).
فنسبية المعرفة البشرية تعني محدوديتها بالنسبة لعلم الله سبحانه المطلق، وقد جعل الله سبحانه هذه المعرفة مع كونها نسبية؛ يقينية تبعدها عن الشكية والنسبية السوفسطائية.
ثالثا: التعليم الإلهي
كان أول ما نزل من الوحي قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: 1-5) في هذه الآيات يأمر الله، عز وجل، نبيه ومن ثم كل إنسان بأن يقرأ، لكن هذا الأمر مشروط بمعية "باسم ربك" باسم ربك أيها الإنسان، ربك الكريم الذي خلقك، وكرمك، وعلمك ما لم تكن تعلم.
هذه المعية الربانية هنا تأتي محددا منهاجيا للقراءة البشرية؛ أي أن الإنسان القارئ يجب عليه أن يقرأ باسم الله ومع استحضار الله؛ لأنه هو الذي خلقه وكرمه بالعلم، فالإنسان لا يقرأ إلا بقدرة الله، عز وجل، ولو لم يشأ الله ما كان قارئا ولا علم شيئا، ولن يعلم إلا ما علمه الله الذي يعلم الجهر وما يخفى ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل: 78).
والإنسان، وهو يقرأ أينما قرأ، يجب أن لا ينسى أو تغيب عنه هذه الحقيقة، فإذا غابت عنه أو ظن أنه مستغن عن الله عز وجل، وأنه يمكنه أن يقرأ خارج القراءة الربانية، فسيكون مصير فعله وحركته حتما الطغيان والفساد.
وعلى ذلك، فإن "الإنسان في نظر القرءان غير مكتف بنفسه من الجهة المعرفية، كما أنه ليس خالقا لنفسه من الجهة الوجودية"[8]. فهذا المحدد المنهاجي يتأسس على مبدأين: الأول؛ أن الإنسان مدين لله في خلقه وتعلمه، والثاني؛ أن الإنسان خلق وهو لا يعلم شيئا، وأن الله سبحانه جعل فيه من الاستعدادات والكينونة الإنسانية القارئة وأدوات القراءة بحيث تحصل القراءة ويحصل العلم والمعرفة ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل: 78).
وصفوة القول أن التعليم الإلهي، يدخل في إطار العناية الإلهية، التي لا تفارق الإنسان منذ بداية الخلق إلى الرجعى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (البقرة: 27).
وهذا ينسجم مع الدلالة اللغوية للفظ "الرب"، جاء في المقاييس[9]، رب: الراء والباء يدل على أصول. فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرَبُّ: المَالِك والخَالِق والصَّاحِب. والرَبُّ: المُصْلِح للشيء. يقال رَبَّ فلان ضيعته، إذا قام على إصلاحها. وعند الراغب الأصفهاني[10]: الرَبُّ في الأصل للتربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، يقال رَبَّهُ وَرَبَّاهُ ورَبَّبَهُ... ولا يقال الرَبُّ مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات.
وقد لفت الطاهر بن عاشور إلى هذه اللطيفة، لطيفة الإصلاح والإتمام والقيام على الشيء ورعايته، في قوله: "... لتأكيد ما يشعر به ربك من العناية المستفادة من قوله: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ وأن هذه القراءة شأن من شؤون الرب اختص بها عبده إتماما لنعمة الربوبية عليه"[11].
ومن شأن استحضار هذه العناية الإلهية أثناء الكسب المعرفي البشري أن "تصوغ النفس الإنسانية بعلم الله، فتكون نتيجتها الإنسان الرباني الذي يعيش بعلم الله فيما يصدق وفيما يطبق، فيما يعتقد وفيما يعقل، فيلتقي الخلق والأمر، ويكون الوحي علما في صدره، ونورا في قلبه"[12].
وفي موضع آخر من سورة الأعلى تتجلى لنا هذه العناية الربانية في قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ الآيات 1-8.
من خلال موضوع السورة ككل، نجد الحديث عن عالمين اثنين هما عالم الشهادة (مظاهر الخلق + الدنيا...) وعالم الغيب (الخالق + الآخرة...)، وهذا الذي سيقرئه الله نبيه والناس من بعده في كتابه الخاتم، قد جاء متضمنا في الكتب السابقة صحف إبراهيم وموسى. وورد فعل الإقراء هنا مقرونا بصفته الله عز وجل الذي يعلم الجهر وما يخفى، وكأن الله، عز وجل، يوجه الإنسان هنا ويذكره بعلمه المحدود، ويقول له أنا خلقتك وخلقت هذه العوالم من حولك وأنزلت الكتب، وأنت لا يمكنك أن تحيط بها مطلقا، لكن سأقرئك من هذا وهذا بما يتناسب مع قدراتك والغاية التي من أجلها خلقت.
رابعا: التصديق والهيمنة
هذا المحدد القرءاني يعمل في إطار مجموعة من الأنساق المعرفية والأطر المرجعية المؤطرة للمعرفة البشرية:
أولها؛ أن الإنسان تكاملي في ذاته ومع بني جنسه، كما أن الرسالات السماوية كانت تكاملية عبر الأزمنة والأمكنة، كذلك المعرفة البشرية تكاملية هي بدورها عبر الأزمنة والأمكنة، وليست هناك معرفة بشرية مطلقة يمكن الوقوف عندها وعدم تجاوزها، بل الإنسان في اكتشاف واكتساب مستمر للعلوم والمعارف، لأن العلم والمعرفة يبنيان أولا على التعليم الإلهي للإنسان مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾، وقوله سبحانه: ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾، ثم على العلوم والمعارف السابقة. وقراءة هذا التراث البشري المعرفي هي قراءة استيعاب وتجاوز في إطار تصديق الوحي وهيمنته.
ثانيها؛ أن الإنسان بطبعه فيه نزوع للخير والشر، وهذا ينعكس على معارفه أيضا فإذا غلب جانب الخير طبع ذلك معرفته والعكس بالعكس، فلابد له من كابح وموجه يوجه معارفه واجتهاده العقلي نحو ما ينصلح به حال الإنسان والأرض، ولا يضر بالإنسان والكون؛ أي ما يحقق التوازن المنشود حيث يصير الإنسان ينظر إلى نفسه على أنه عنصر تكاملي مع باقي جنسه متوائم مع باقي العالم وليس معارضا له، مواءمة تحكمها ثنائية التسخير والاستخلاف لا التدمير والاستنزاف.
فعلى المعرفة إذن أن تكون خادمة للإنسان لا مدمرة له، أي أن تكون لها فلسفة إنسانية لا مادية صرفة تخدم فئة أو شعبا على حساب شعب آخر، حيث يكون هذا التوجه مناف لفلسفة الوجود الإنساني القائم على الوحدة والعيش المشترك في الكوكب الوحيد المهيأ للعيش. فالشعوب ليست بمعزل عن بعضها البعض كما أنها ليست بمعزل عن الكون، فما يضر بهذا الأخير يضر بها، وما يضر بأقصى شعب في أقصى مكان في الأرض إلا وتكون له انعكاسات سلبية أخرى على باقي الشعوب عاجلا أو آجلا. وهذا إطار مرجعي مهم وجب أن يهيمن على كل سعي معرفي بشري كيفما كان مجال هذا السعي.
ثالثها؛ أن العالم اليوم يشهد زخما وتدفقا معرفيا هائلا يختلط فيه الحق بالزائف والخرافة بالأسطورة نتيجة التطورات العلمية والتقنية ووسائل الإعلام، وتحول إنتاج المعلومات إلى صناعة، وتشير الإحصاءات إلى أن المعلومات العامة تتضاعف كل سنتين ونصف مما يؤدي إلى فقدان النقد والتحليل حيث أن تخمة المعلومات وطريقة العرض لا تتيح الفرصة لوضعها في ميزان التقييم أو معارضتها.
من هنا كانت المعرفة محتاجة لمرجع تحتكم إليه؛ يصدق على الأصيل الأثيل فيها، الموافق للحق والصواب، ويهيمن على الدخيل المنافي للحقيقة. وهذا المرجع هو الوحي، ذلك أن "كلام الله يهيمن على معرفتنا ووجودنا ونحن نعيش في صميم الكون والحياة"[13]، كما أن "العقل الإنساني يحيا بين آيات الله الكونية، وآيات الله القرآنية، حياة يحكمها نظام واحد، جعله الله أساسا لهداية الناس جميعا وفرادى في كل زمان ومكان"[14].
وهذه الحياة أساسها المواءمة التي جعلها الله في الإنسان، أي جعله يتواءم مع الكون كما يتواءم مع الوحي، ولولا هذه المواءمة "لما استطاع أن يتعقَّل الكون من حوله فيسخره انطلاقا من التفكر، ولما كان قادرا على التعامل مع الوحي وبنائيته ليستطيع، بذلك، أن ييسره انطلاقا من التدبّر"[15].
رابعها؛ قد يتساءل سائل: كيف للامتناهي (الكون) أن يحتكم للمتناهي (الوحي)؟ الجواب، أن مفردات القرءان في حركة مستمرة تتجاوب مع حركة الكون والوجود كله، فهي في عطاء مستمر، لو نفد الكون ما نفدت كلمات الله أبدا، مصداقا لقول العزيز الحكيم: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمان: 26).
إننا "نعجز عن فهم أي شيء، أو تفسير أية حقيقة من حقائق الوجود، ما لم نتصل بالمفردة القرءانية من خلال تفصيلها في آيتها، لأن هذه المفردة من خلال سياقها تقدم لنا احتمالات التذكر في وعينا الإنساني حتى ترشدنا إلى الحقيقة العميقة التي نريدها"[16]. وذلك أن نظم المفردات في القرءان المجيد موائم لنظم مفردات الكون، بل إن مفردات الكون تنتظم في القرءان كما تنتظم حركة الكون وسكناته، وما مفردات القرءان في الحقيقة إلا مفردات الكون والوجود نفسها (الله، الإنسان، السماء، الأرض، الجبال، البحر....)، لهذا جاز القول بأن نظام القرءان يساوي أو يوازي نظام الكون، ولمعرفة حقيقة أي منهما وجب النظر إليهما وفيهما معا مجتمعين لأن كليهما يقود إلى الآخر ويدل عليه.
خامسها؛ أن القرءان الكريم يرفض كل المسلمات المبنيَّة على الظنِّ والتخمين، أو التبعية والتقليد، ويدعو إلى إعمال العقل في التحري والتثبُّت، ويأمر بالتدبُّر والتأمُّل في نواميس الكون، والسير في الأرض لاكتشاف بداية الخلق والاعتبار بعواقب الأمم السابقة. كما يفتح القرءان باب الاكتشاف صعدا نحو الآفاق للإنسان والجن معا، مصداقا لقوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) (الرحمن: 33).
الهوامش
[1]. انظر مقاربته التاريخية للدين:
An Historian's Approach to Religion (Oxford University Press 1956). Gifford Lectures, University of Edinburgh, 1952-1953.
[2] . أنسنة الكون وتكونن الإنسان هو مدار مشروع السوبر إنسانوية، ويرتكز هذا المشروع على أن الإنسان والكون يشكلان كائنا واحدا، فيصير الكون إنسانا مالكا لكل الحقوق الإنسانية مثل حق الحياة والبقاء. كما يصير الإنسان كائنا بلا روح.
[3] . محمد العفيفي، القرآن القول الفصل بين كلام الله وكلام البشر، النسخة الإلكترونية: //kotob.has.it:http، ص168.
[4] . فرح موسى، الإنسان والحضارة في القرءان بين العالمية والعولمة، دار الهادي، ط1، (1424ﻫ/2003م)، ص95.
[5] . محمد إبراهيم الفيومي، الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل، القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت، صفحة 83-39، وهناك من ينسب هذه الأبيات للسيوطي.
[6] . المعجم الفلسفي.
[7] . الإنسان والحضارة في القرءان، م، س، ص96-97.
[8] . راجح عبد الحميد الكردي، نظرية المعرفة بين القرءان والفلسفة، مكتبة المؤيد، المملكة العربية السعودية/المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، (1416ﻫ/1996م)، ص 436.
[9] . أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، مادة "رب".
[10] . المفردات في غريب القرءان، مادة "رب".
[11] . التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984، ج30، ص439.
[12] . أحمد عبادي، مفهوم الترتيل في القرآن الكريم: النظرية والمنهج، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط1، 2007م، ص248.
[13] . محمد العفيفي، القرآن القول الفصل بين كلام الله وكلام البشر، ص177.
[14] . المرجع نفسه.
[15] . أحمد عبادي، الوحي والإنسان، نحو استئناف التعامل المنهاجي مع الوحي، مكتبة حراء، دار النيل، ط1، (1434ﻫ/2013م)، ص52.
[16] . سليمان عبد الله موسى أبو عزب، الإبداع اللفظي في القرآن الكريم (دراسة نقدية):
http://www.altaghrib.net/002/03/06.htm