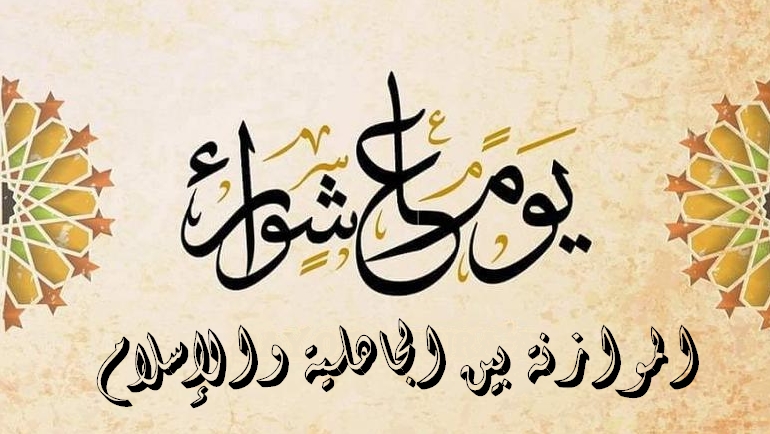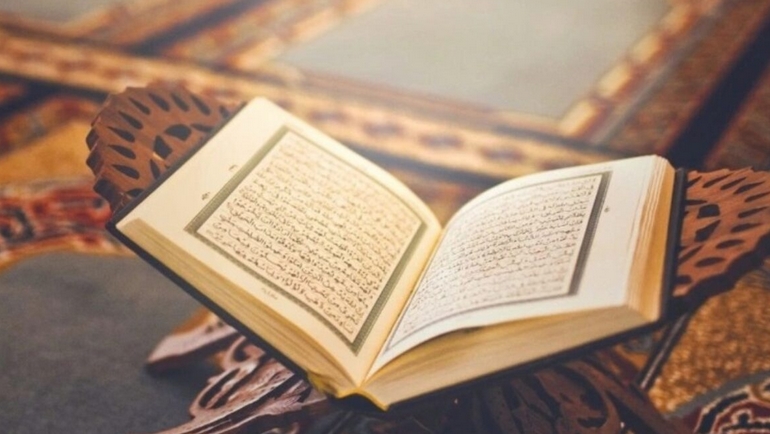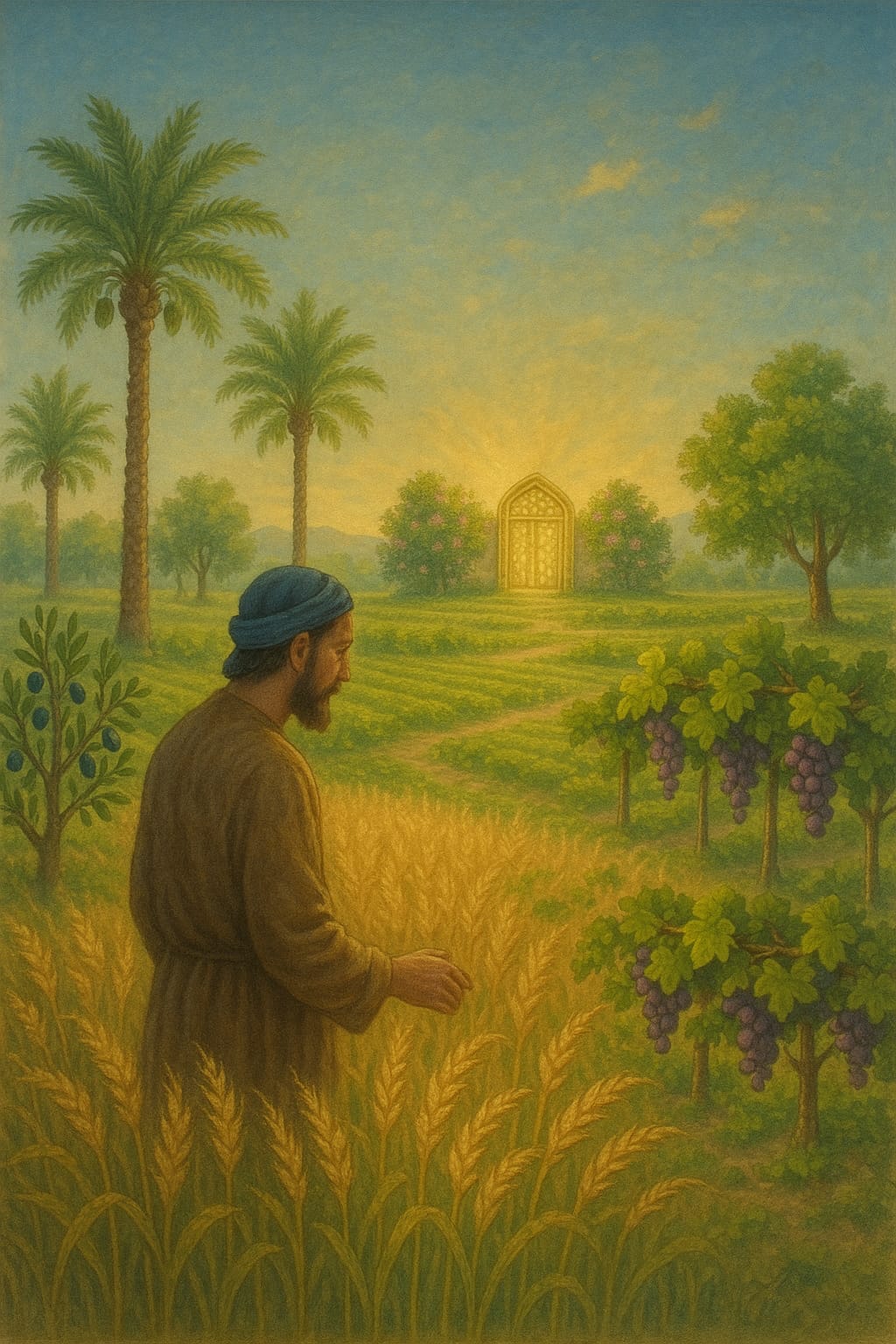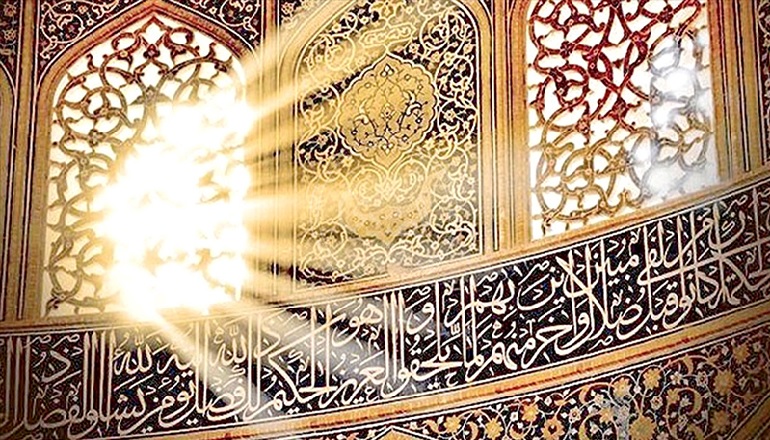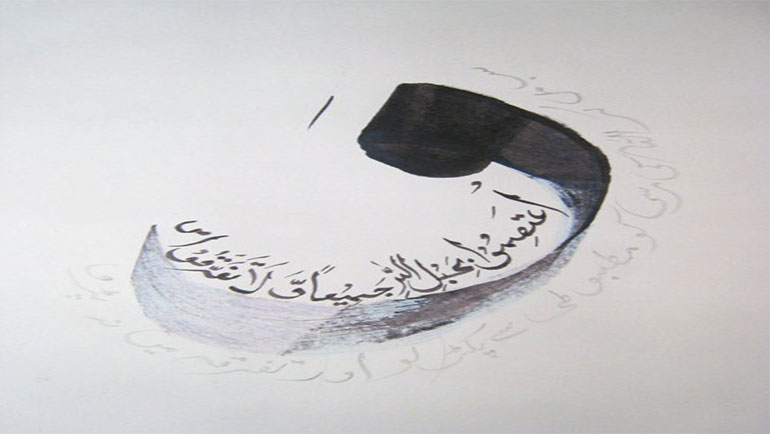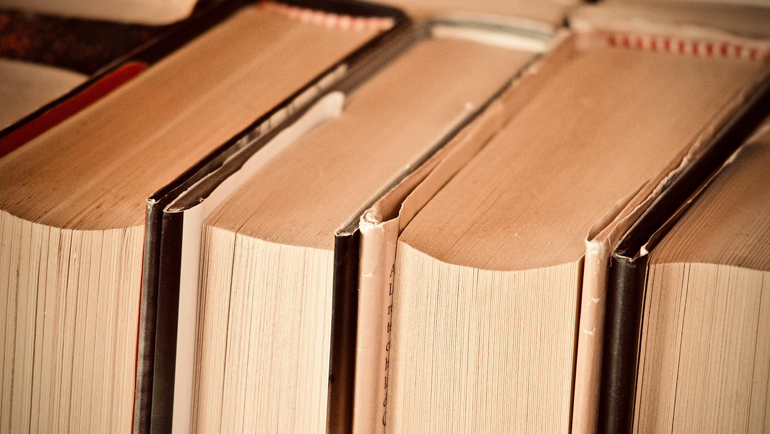
شغلت مسألة العقل أذهان المفكرين والفلاسفة قديما وحديثا، واختلفت آراؤهم في تحديد ماهيته ومدلوله ومصدره اختلافا بينا. وقد أدلى ابن القيم بدلوه في بحث هذا الموضوع، فجاءت كتبه ومؤلفاته حافلة بالآراء والإرشادات والتوجيهات المتعلقة بفضل وشرف وكيفية تربية هذا الجانب الحيوي من الذات الإنسانية. ويرمي هذا البحث إلى جمع هذه الآراء وترتيبها وتصنيفها وتحليلها، من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: شرف العقل وفضله.
المبحث الثاني: معاني العقل وحقيقته.
المبحث الثالث: محل العقل ومصدره.
المبحث الرابع: التفكير المحمود والتفكير المذموم.
المبحث الخامس: أشكال التفكير السليم.
المبحث السادس: آفات العقل أو موانع التفكير السليم.
المبحث الأول: شرف العقل وفضله
حظي العقل باهتمام كبير في كتابات ابن القيم، فقد بين رحمه الله شرفه وسمو منزلته، وذكر كثيرا من فضائله ومزاياه. فالعقل عنده "آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية وإيثار ما ينبغي إيثاره وإهمال ما ينبغي إهماله"[1] والعقل "آلة كل علم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه، والمرآة التي يعرف بها الحسن والقبيح"[2]، والعقل "مربي العلم وسائسه والمرشد إلى طاعة الرسل"[3] به (العقل) عرف الله، سبحانه وتعالى، وأسماؤه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ وبه آمن المؤمنون بكتبه ورسله ولقائه وملائكته؛ وبه عرفت آيات ربوبيته وأدلة وحدانيته ومعجزات رسله؛ وبه امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه. وهو الذي تلمح العواقب فراقبها وعمل بمقتضى مصالحها، وقاوم الهوى فرد جيشه مغلولا، وساعد الصبر حتى ظفر به بعد أن كان بسهامه مقتولا، وحث على الفضائل، ونهى عن الرذائل، وفتق المعاني، وأدرك الغوامض، وشد أزر العزم فاستوى على سوقه، وقوى أزر الحزم حتى حظي من الله بتوفيقه"[4]. "فالعقل ملك والبدن حراسه، وحركاته كلها رعية له"[5].
ويكفي العقل شرفا أن الله سبحانه وتعالى مدحه في كتابه، وأثنى على المنتفعين بعقولهم المتفكرين في آياته المتلوة والمسموعة فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 163)؛ وقال أيضا: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: 190). وفي المقابل ذم المشركين الذين أعرضوا عن استثمار هذه المنحة التي كرم الله تعالى بها الإنسان فقال جل وعلا: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ (الأنبياء: 32)، وأخبر عنهم أنهم صم بكم عمي لا يعقلون[6]، وأن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم شيئا[7]؛ وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة[8].
وللسلف أقوال كثيرة في هذا السياق أوردها ابن القيم نذكر منها: قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان حقيقة العاقل وفضله[9]: "ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين"؛ وقول الإمام علي، كرم الله وجهه، في علو منزلة العقلاء[10]: "لقد سبق إلى جنات عدن أقوام كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا، لكنهم عقلوا عن الله مواعظه، فوجلت منه قلوبهم، واطمأنت إليه نفوسهم، وخشعت له جوارحهم، ففاقوا الناس بطيب المنزلة وعلو الدرجة في الدنيا والآخرة"؛ وقول عائشة رضي الله عنها[11]: "قد أفلح من جعل الله له عقلا"؛ وقول معاذ بن جبل، رضي الله عنه، في بيان أجر العاقل[12]: "لو أن العاقل أصبح وأمسى وله ذنوب بعدد الرمل كان وشيكا بالنجاة والتخلص منها؛ ولو أن الجاهل أصبح وأمسى وله من الحسنات وأعمال البر عدد الرمل لكان وشيكا أن لا يسلم له منها مثقال ذرة"، قيل وكيف ذلك؟ "قال: إن العاقل إذا زل تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي رزقه، والجاهل بمنزلة الذي يبني ويهدم، فيأتيه من جهله ما يفسد صالح عمله".
المبحث الثاني: معاني العقل وحقيقته
للعقل معان ثلاثة عند ابن القيم:
أولها: العقل بمعنى الضبط والإمساك والمنع والحفظ، وهو ما يوافق المعنى اللغوي لهذه اللفظة"، تقول: عقلته عن كذا أي منعته وصددته؛ ومنه عقال البعير لأنه يحبسه عن الشرود، ومنه العقل لأنه يحبس صاحبه عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل؛ ومنه عقلت الكلام وعقلت معناه، إذا حبسته في صدرك وحصلته في قلبك بعد أن لم يكن حاصلا عندك، ومنه العقل للدية لأنها منع آخذها من العدوان على الجاني وعصبته"[13]، ومنه العقل بمعنى "ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه"[14]، وهو بهذا المعنى أحد مستويات الإدراك الخمسة[15] وهي: الشعور والفهم والمعرفة والعلم والعقل. "فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته، لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شرودها"[16].
المعنى الثاني: العقل بمعنى "القوة الغريزية التي ركبها الله في الناس"[17]، وهذه الغريزة[18] هي التي فارق بها الناس البهائم؛ والقدرات التي تحتوي عليها هي التي يتهيأ بها الإنسان لقبول العلوم النظرية؛ وبها يمارس التفكير وسائر العمليات الذهنية التي يقوم بها، لذلك وصف العقل بهذا المعنى بأنه "أب العلم ومربيه ومثمره"[19]، وهذا المعنى هو ما نجده عند كثير من الفقهاء والمربين المسلمين في تحديدهم لماهية العقل، ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل[20] والحارث المحاسبي[21] وعبد الرحمن بن الجوزي[22] وأبو حامد الغزالي[23] في أحد معاني العقل عنده. يقول الحارث المحاسبي: "فهو؛ (يقصد العقل) غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه، لم يطلع عليه العباد بعضهم من بعض، ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية ولا بحس ولا ذوق ولا طعم؛ وإنما عرفهم الله إياه بالعقل منهم، فبذلك العقل عرفوه، وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم بمعرفة ما ينفعهم ومعرفة ما يضرهم"[24]، وهذا يخالف ما ذهب إليه الفلاسفة من أمثال أرسطو[25] الذي اعتبر العقل جوهرا مجردا قائما بذاته[26]؛ ويخالف كذلك ما ذهب إليه بعض المتكلمين الذين يرون أن العقل "نوع من العلوم الضرورية"[27]، وقد انتقد ابن القيم هذه الآراء وبين استنادها إلى أصل خاطئ وهو إنكار القوى والأسباب والغرائز والطبائع، فهؤلاء يقول[28]: "ليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحركاتها، ولا في العين قوة امتازت بها عن الرجل يبصر بها، ولا في القلب قوة يعقل بها امتازت بها عن الظهر، بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة.
المعنى الثالث: العقل بمعنى القدرات العقلية المكتسبة، ويسميه ابن القيم "العقل المكتسب"[29]؛ أي المكتسب من العلم، فهو "ولد العلم وثمرته ونتيجته"[30]، والعلم الذي يقصده هو العلم المستفاد من مشكاة النبوة، لا المستمد من العقل المعيشي النفاقي"[31] الذي يؤدي بأصحابه إلى مجاراة الناس في أهوائهم، ومداهنتهم، ومحاولة إرضائهم على طبقاتهم، ومسالمتهم واستجلاب مودتهم ولو كان ذلك على حساب عقيدة الموالاة والمعاداة في الله، ظنا منهم أن ذلك هو تمام العقل[32]، فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله"[33].
وعند الغزالي أن هذا العقل يستفاد من التجارب، وهو ما عبر عنه بقوله[34]: "علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال"؛ فإن من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال عنه إنه عاقل في العادة، ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبي غمر جاهل".
وفي مناقشة العلاقة القائمة بين الجانب الغريزي في العقل والجانب المكتسب يرى ابن القيم أن هذه العلاقة علاقة تكامل وتعاضد[35]، فقد رد على الذين يفضلون أحد هذين الجانبين على الآخر، مبينا أن سبب هذه المفاضلة المتوهمة يرجع إلى كون صاحب العقل الغريزي الذي تنقصه التجربة والعلم يؤدي عادة من آفتي الإحجام وضعف المبادرة بسبب هذا النقص، "لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها"[36]؛ بينما يؤتى صاحب القدرات العقلية المكتسبة، برأيه، من الإقدام الزائد على الحاجة أحيانا"، لأن علمه بالفرص وطرقها يليقه على المبادرة إليها وعقله الغريزي لا يطيق رده عنها[37] فإذا جمع عقل المرء بين استعدادات الجانب الغريزي الفطري وفعالية القدرات المكتسبة" استقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب"[38]؛ وإذا اعترى النقص أحد هذين الجانبين في عقله انتقص بذلك؛ وإذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن منه[39].
نستنتج مما سبق أن العقل عند ابن القيم عبارة عن مجموعة من القدرات تؤدي وظائف لها علاقة بالجانب الذهني والفكري في حياة الإنسان؛ وهذا ما يشير إليه المعنى الأول، وهذه القدرات لها جانب غريزي فطري يولد معه الكائن البشري، وبواسطته يكون مستعدا لعقل ما حوله من العلوم والمعارف والصور والموجودات؛ وهو ما يشير إليه المعنى الثاني، فإذا حصل الاحتكاك بين هذا الكائن والمحيط الخارجي من حوله نمت هذه القدرات وازداد وهجها وفعاليتها وعطاؤها بفعل ما يتلقاه الإنسان من علوم ومعارف وما يحصله من خبرات وتجارب في حياته، وهذا النمو الزائد على الجانب الغريزي هو الذي يسميه "بالعقل المكتسب"، وهو ما تم توضيحه في المعنى الثالث.
وارتباط هذه المعاني الثلاثة السابقة بعضها ببعض يعطينا صورة شاملة عن حقيقة العقل وبعض وظائفه، في نظر ابن القيم، ويبين أن تعدد معانيه في كتاباته إنما يأتي، أحيانا، من باب إطلاق العام وإرادة بعض أجزائه أو جوانبه.
المبحث الثالث: محل العقل ومصدره
ذكر ابن القيم اختلاف الآراء في محل العقل في كتابه التبيان[40]، وقسمها إلى قولين حكيا عن الإمام أحمد في روايتين:
فأما القول الأول فذهب أصحابه إلى أن محل العقل هو الدماغ، واستدل هؤلاء بكون "الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله، ولولا أن العقل في الرأس لما زال؛ فإن السمع والبصر لا يزولان بضرب اليد أو الرجل ولا غيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما بهما"[41].
وأما القول الثاني فرأى أصحابه أن القلب هو محل العقل، ويجيبون أصحاب القول الأول بأنه "لا يمتنع زواله؛ (أي العقل) بفساد الدماغ وإن كان في القلب، لما بين القلب والرأس من الارتباط"[42]، ففساد القوة بفساد العضو قد يقع لمجرد وجود نوع من الارتباط بينهما، وقد لا يقع كما هو الشأن بالنسبة لنبات شعر اللحية ولو مع قطع الأنثيين[43].
وقد تتبعت هذه المسألة فيما وصلني من مؤلفات ابن القيم بغية الوقوف على رأيه فيها، فوجدته يتحدث تارة عن كون الدماغ هو محل القدرات العقلية ومعدن الحواس، وتارة أخرى ينسب العقل إلى القلب، وتارة ثالثة يجمع بين الرأيين ويؤكد اشتراك الدماغ والقلب معا في صدور العمليات العقلية عنهما، ففي بحثه لعلاقة العقل بالدماغ قال: "أما الدماغ فهو القائم بأمر الحس والإدراك وتكميل الحياة، إذ فيه آلات الإحساس التي بها يعرف النافع من الضار والملائم من المنافر، وبه صارت الحياة نافعة صالحة متجاوزة لزينة حياة النبات"[44]؛ وهذه الوظائف التي نسبها إلى الدماغ كلها وظائف عقلية محضة، وفي حديثه عن الأقسام الثلاثة التي يتكون منها الدماغ، وصف كل قسم بكونه محلا لقدرات عقلية معينة، فالله سبحانه وتعالى "جعل القسم المقدم محل الحفظ والتخيل، والبطن الأوسط محل التأمل والتفكر والبطن الأخير محل التذكر والاسترجاع لما كان قد نسيه"[45]، وقال عن الرأس وهو يقصد الدماغ: "وهو مجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمرة العقل تنتهي إليه"[46].
وحين تناول علاقة القلب بالعقل نسب الثاني إلى الأول وشبه هذه النسبة بنسبة القوة الباصرة إلى العين والقوة السامعة إلى الأذن[47]؛ ولهذا تسمى تلك القوة؛ (يقصد القوة العقلية) قلبا كما تسمى القوة الباصرة بصرا"[48] واستشهد في إثبات هذه النسبة – بقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج: 44) وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق: 37). وقال في معرض حديثه عن مكونات الإنسان: "ولا ريب أن هاهنا أمورا معلومة، وهي البدن وروحه القائم به، والقلب المشاهد فيه وفي الحيوان، والغريزة وهي القوة العاقلة التي محلها القلب"[49].
غير أن الرأي الذي انتهى إليه حسب فهمي هو: اشتراك القلب والدماغ معا في صدور العمليات العقلية عنهما، فبعد ذكره اختلاف الآراء في المسألة وتقسيمها إلى اتجاهين، بين أن كل اتجاه" أدرك شيئا وغاب عنه شيء"[50]، قال[51]: "والتحقيق أن منشأ ذلك ومبدأه؛ (يقصد العمليات العقلية) من القلب، ونهايته ومستقره في الرأس"، وقال في "مفتاح دار السعادة"[52]: "فالصواب أن مبدأه ومنشأه؛ (يقصد العقل) من القلب، وفروعه وثمرته في الرأس" وفي "بدائع الفوائد"[53] قال في معرض حديثه عن حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم: "شق صدر النبي، صلى الله عليه وسلم، والاعتناء بتطهير قلبه وحشوه إيمانا وحكمة دليل على أن محل العقل القلب وهو متصل بالدماغ".
ويلتقي ابن القيم رحمه الله في تفسيره لمصدر العمليات العقلية وعلاقتها بالقلب والدماغ مع ما توصلت إليه أحدث البحوث العلمية المعاصرة في مجال الأعصاب، فقد أكدت هذه الأبحاث استحالة تفسير نشاط سلوك الإنسان ونشاط دماغه وجهازه العصبي من غير وجود عقل أو نفس مدركة تحكم هذا النشاط[54]؛ وهو ما سماه ابن القيم بالقلب.
وتبدو آراء الماديين متهافتة أمام هذه الحقائق التي استنبطها ابن القيم من القرآن الكريم وأكدتها أحدث الكشوفات العلمية المعاصرة، فاختزالهم العقل في الدماغ المادي الذي يحمله كل إنسان في جمجمته، بدعوى أن العمليات العقلية ما هي إلا انعكاسات للتغيرات التي تقع في كيمياء الدماغ ونبضاته العصبية الكيموكهربائية ELECTROCHEMICAL ما هو إلا خرص تنقصه الأدلة العلمية الثابتة[55].
المبحث الرابع: التفكير المحمود والتفكير المذموم
قسم ابن القيم التفكير من حيث ثمرته إلى نوعين[56]: نوع يقود صاحبه إلى ما فيه مصلحته في معاشه ومعاده وهو التفكير المحمود، ونوع يدور به في فلك الأوهام وما لا ترجى منفعته في العاجل ولا الآجال وهو التفكير المذموم.
أولا: التفكير المحمود
يرتبط التفكير المحمود، في نظر ابن القيم، بأربعة مقاصد هي غاية أفكار العقلاء[57]:
- أحدها: غاية محبوبة مرادة الحصول.
- الثاني: طريق موصلة إلى تلك الغاية
- الثالث: مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول.
- الرابع: الطريق المفضي إليها الموقع عليها.
وتنقسم مجالات التفكير المحمود طبقا لهذه المقاصد إلى مجالين اثنين[58]:
المجال الأول: مجال الحياة الآخرة، ويتجه الفكر النافع فيه إلى أربعة محاور:
- أولها: التفكير في مصالح المعاد.
- الثاني: التفكير في طرق اجتلابها.
- الثالث: التفكير في دفع مفاسد المعاد.
- الرابع: التفكير في طرق اجتنابها.
المجال الثاني: مجال الحياة الدنيا، ويتعلق الفكر النافع فيه أيضا بمحاور أربعة:
- أولها: التفكير في مصالح الدنيا.
- الثاني: التفكير في طرق تحصيلها.
- الثالث: التفكير في مفاسد الدنيا.
- الرابع: التفكير في طرق الاحتراز منها.
وتندرج تحت هذه المحاور مواضيع كثيرة رغب ابن القيم في التفكير فيها في أماكن متفرقة من كتبه مبينا ثمارها التربوية، وفيما يلي أهمها:
- التفكر في آيات الله المنزلة تفكرا يتجاوز مجرد تلاوتها إلى فهم تعلقها والمراد منها[59].
- التفكر في آياته المشهودة، والاعتبار بها، والاستدلال بها على صفاته وأسمائه وحكمته وإحسانه وبره وجوده[60].
- التفكر في صنعه تعالى وآلائه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه[61].
ومن شأن التفكير في هذه الموضوعات الثلاثة أن يثمر في القلب معرفة الله تعالى ومحبته وطاعته، "فدوام الفكرة في ذلك يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة"[62].
- التفكير في عيوب النفس وأصنافها وأفعالها وعللها ومداخل الشيطان إليها وسبل تخليتها من الصفات الذميمة وتحليتها بالصفات الحميدة[63]، فهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، ومتى كسرت عاشت النفس مطمئنة وانبعثت وصار الحكم لها، فحيي القلب، ودارت كلمته في مملكته، وبث أمراءه وجنوده في مصالحه"[64].
- التفكير في واجب الوقت وجمع الهم عليه: فلكل وقت واجب أو واجبات تنبغي المسارعة إلى القيام بها، ومن شأن هذه المسارعة أن تنظم جهود الإنسان وأعماله وتورثه الإحساس بقيمة الزمن والحرص على استثماره، "فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها:؛ فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا"[65].
- التفكير في العلوم والمعارف والصناعات والمهن التي تساعد على عمارة الأرض وأداء رسالة الاستخلاف فيها، ومن هذه العلوم: "علم الطب، وعلم الحساب، وعلم الزراعة والغراس، وضروب الصنائع، واستنباط المياه، وعقد الأبنية، وصنعة السفن، واستخراج المعادن وتهيئتها لما يراد منها، وتركيب الأدوية، وصنع الأطعمة، ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء، والتصرف في وجوه التجارات، ومعرفة وجوه المكاسب، وغير ذلك مما فيه قيام المعاش"[66].
ثانيا التفكير المذموم
يشمل التفكير المذموم، في نظر ابن القيم، كل الأفكار الرديئة والخواطر السيئة التي تبعث على سوء التصرف أو تسبح بصاحبها في أوهام وخيالات لا ترجى من ورائها فائدة.
ومن أمثلة هذا التفكير في نظره ما يلي:
- التفكير في الغيبيات التي لا يقدر عقل الإنسان على الإحاطة بها ولا هو مكلف بالتفكير فيها، "كالفكر في كيفية ذات الرب سبحانه وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه"[67].
- التفكير في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع ولا تضر من مثل الشطرنج والموسيقى وأشكال التصاور[68].
- التفكير في العلوم التي لا تكسب النفس كمالا ولا شرفا، وعد ابن القيم من هذه العلوم: "علم المنطق (...) وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غايتها لم يكمل بذلك ولم يزك نفسه"[69].
- التفكير في الشهوات والملذات وكيفيات تحصيلها[70].
- التفكير المرتبط بالأوهام وما لم يقع، "كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة، ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم، ونحو ذلك من أفكار السفل"[71].
- الفكر المرتبط ب "تتبع أحوال الناس وما جرياتهم، مداخلهم ومخارجهم، وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة[72].
- "الفكر في دقائق الحيل التي يتوصل بها (الإنسان) إلى أغراضه وهواه، مباحة كانت أو محرمة"[73].
- "الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة[74].
- التفكير في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها ولا بالناس حاجة إليها، وهذه المقدرات موجودة، في نظر ابن القيم، في كل علم حتى في علم أصول الفقه[75].
المبحث الخامس: أشكال التفكير السليم
يعتبر التفكير السليم جوهر التربية الفكرية والعقلية عند ابن القيم، فقد دعا، وهو يناقش مظاهر الانحراف في الحياة الفكرية والتربوية في مجتمعه، إلى ممارسة أشكال التفكير التي لا تتعارض مع مسلمات الشرع الحق وقوانين العقل والفطرة السليمين؛ وحذر في المقابل من أشكال أسرت عقول كثير من الناس، وكبلت قدراتهم الذهنية والفكرية، وسجنتها في سجون الخرافة والأوهام والتقاليد.
وفي ما يلي جملة من أشكال التفكير التي دعا إلها وما يقابلها مما حذر منه:
أولا: التفكير المبني على النظر في الأشياء بدل النظر إلى الأشياء
فالنظر في الأشياء يثمر التفكير التأملي العميق الذي ينفذ ببصيرة الناظر إلى أعماق تلك الأشياء متجاوزا مظهرها الخارجي من أجل اكتشاف أسرارها ومآلاتها[76].
ومن فوائده العلمية والتربوية:
- العبور من صور الأشياء إلى حقائقها[77].
- معرفة المراد منها والحكمة البالغة من وجودها[78].
- التمييز بين مراتبها، ومعرفة نافعها من ضارها، وصحيحها من سقيمها، وقشرها من لبها[79].
- التمييز بين الوسيلة والغاية وبين وسيلة الشيء ووسيلة ضده[80].
- الارتقاء بالقلب في مدارج خشية الله، عز وجل، والإنابة إليه[81].
أما النظر إلى الأشياء فلا يعدو أن يكون نظرا حسيا سطحيا يجعل صاحبه حبيس أشكالها وصورها الظاهرية، بحيث "تستفرغ ذهنه وحسه، وتبدد فكره وقلبه (...) فنظره إليها بعين حسه لا يفيد منها ثمرة الاعتبار ولا زبدة الاختيار، لأنه لما فقد الاعتبار أولا فقد الاختيار ثانيا"[82].
ثانيا: التفكير المبني على النظر الكلي الشمولي بدل النظر الجزئي
يقصد بالتفكير الكلي أو الشمولي "ذلك الأسلوب من التفكير الذي يتناول الظاهرة من جميع جوانبها ويتحرى جميع أجزائها وما يتعلق بها"[83]، ويقصد بالتفكير الجزئي: التفكير الذي يركز على جزء من الظاهرة ثم يعمم أحكامه على بقية الأجزاء"[84].
وقد دعا ابن القيم إلى اعتماد الشكل الأول من التفكير لما يؤدي إليه من نتائج محمودة، وذم الشكل الثاني لأنه يؤدي إلى تشتيت وحدة موضوع التفكير ويقود صاحبه إلى أحكام خاطئة، ففي حديثه عن انقسام أهل العلم بشأن صفة العلم: هل هي فعلية أم انفعالية؟ رد إخفاق الطائفتين إلى اعتماد كل منهما التفكير الجزئي وذلك من خلال النظر إلى هذا الموضوع من زاوية معينة: فالطائفة الأولى ذهبت إلى أن العلم "صفة فعلية لأنه شرط أو جزء وسبب وجود المفعول، فإن الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته، ولا يتصور وجوده دون هذه الصفات"[85]، والطائفة الثانية قالت: "هو انفعالي، فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه؛ فإن العالم يدرك المعلوم على ما هو به، فإدراكه تابع له،، فكيف متقدما عليه"[86]، "فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحكمت كليا"[87]، والصواب الذي يمليه التفكير الشمولي الكلي" أن العلم قسمان: علم فعل وهو علم الفاعل المختار لما يريد أن يفعله، فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به، فهذا علم قبل الفعل، متقدم عليه، مؤثر فيه؛ وعلم انفعالي وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه، كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات، فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه"[88].
ثالثا: التفكير المبني على النظر العلمي بدل إتباع الظن والهوى
يرتكز التفكير العلمي، في نظر ابن القيم، على جملة من القواعد أجملها في قوله: "إذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل، فجرده من لباس العبارة، وجرد قلبك من النفرة والميل، ثم اعط النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن حسن ظنه نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه وممن يسيء به ظنه كنظر الحذر والملاحظة؛ فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه، وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق"[89].
ويمكن إجمال القواعد التي يتضمنها هذا النص في ثلاث هي:
القاعدة الأولى: النظر إلى كنه المعنى لا إلى مجرد العبارة: فكثيرا ما تحول التعابير والمصطلحات المستعملة في خطاب معين دون فهم مراد صاحبه منه. يقول ابن القيم في وصف هذه الظاهرة في عهده: "وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر، وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح"[90].
القاعدة الثانية: التجرد من الميل والتعصب والهوى: وهو ما سماه ابن القيم ب "تجريد القلب من النفرة والميل"[91]، فالتفكير إذا سبقه الميل والمبالغة في حسن الظن أو إساءته تحول من التفكير النقدي المنصف إلى التفكير الموجه، واهتم صاحبه بمصدر الفكرة أكثر من اهتمامه بدراستها والنظر في مغزاها، "فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه"[92].
القاعدة الثالثة: اعتماد التفكير التأملي الموضوعي بدل الاكتفاء بالانطباعات السريعة، وهذا ما يقصده ابن القيم بقوله: "ثم أعط النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف"[93]، والذي يطالع كتابه "مدارج السالكين" سيقف على تطبيقه لهذه القاعدة تطبيقا موفقا خلال دراسته لكتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي.
المبحث السادس: آفات العقل أو موانع التفكير السليم
لم يكتف ابن القيم ببيان الأساليب والطرق المساعدة على تنمية قدرات العقل وممارسة التفكير السليم فحسب، بل حذر أيضا من الموانع والآفات التي تعوق الاشتغال الطبيعي والسليم لهذا الجانب الحيوي في حياة الإنسان، وفيما يلي ذكر بعض هذه الآفات والموانع:
أولا: اتباع الهوى والشهوات
فالقلب، بما أنه أحد مصادر العقل في نظر ابن القيم، لا يتفرغ للتفكير في معالي الأمور وساميها إلا إذا خفت هجمات الهوى ونوازع الشهوة الصائلة عليه، وأخمدت نيرانها المحرقة، وسكنت هوائجها المتلفة، "أما إذا كانت الشهوات وافدة، واللذات مؤثرة (...) فالقلب إما أن يكون أسيرا ذليلا، أو مهزوما مخرجا عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه، أو قتيلا ميتا، وما لجرح بميت إيلام"[94].
وبالجملة، فاتباع الهوى "يطمس نور العقل، ويعمي بصيرة القلب، ويصد عن اتباع الحق، ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه، والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل"[95].
ثانيا: السكر وأسبابه
ربط ابن القيم السكر بإحدى علاماته الأساسية وهي فقدان التمييز؛ واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء: 43) وقول الإمام أحمد: "السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره"[96] وقول الإمام الشافعي في تعريف حالة السكر: "إذا اختلط؛ (يقصد السكران) كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم"[97].
ولا تقتصر أسباب السكر الذي يعوق التفكير السليم ويضر بالعقل، في نظر ابن القيم، على مجرد تناول المسكرات المادية كالخمر والعقاقير المسكرة، بل تتعداها لتشمل بعض العوارض والأمراض النفسية والمعنوية كذلك، فالسكر قد يكون سببه" ألم شديد يغيب به العقل"، وقد يكون سببه "قوة الفرح بإدراك المحبوب"[98]، فإن الحب إذا استحكم وقوي أسكر صاحبه"[99]؛ وقد يكون سببه "غضب شديد يحول بين الغضبان وبين التمييز، بل قد يكون سكر الغضب أقوى من سكر الطرب"[100].
ثالثا: التشبث بالعوائد والمألوفات
فالتشبث بالعوائد والمألوفات يمنع من التفكير الابتكاري، ويخلد بصاحبه إلى الكسل، ويعوق نضجه العقلي، وهذا ما وقع فيه من وصفهم ابن القيم بأنهم: "صبيان العقول، أطفال الأحلام؛ لم يصلوا إلى حد الفطام الأول عن العوائد والمألوفات، فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره وشر الشرين فيجتنبه"[101]، وسمى هؤلاء بأصحاب البصائر الضعيفة الخفاشية[102]، ووصف دينهم بأنه "دين العادة والمنشأ"[103].
رابعا: سماع الأصوات المطربة سيما إذا كانت من صور جميلة[104]
ويرى ابن القيم أن الغناء والطرب وسماع الأصوات الحسنة يؤثر على العقل والتفكير لأسباب منها:
- إن هذه الأصوات في نفسها "توجب لذة ينغمر معها العقل"[105].
- "إنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها وجهته، كائنا ما كان، فيحصل بتلك الحركة والشوق والطلب، مع التخيل للمحبوب وإحضاره في النفس وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكر، لذة عظيمة تقهر العقل"[106].
- إن هذه الأصوات "تثقل على القلوب الفكر في معاني القرآن وحقائق الإيمان؛ وبحسب انصرافه (يقصد المستمع) إلى السماع يكون انصرافه عن ذلك، فمستقل ومستكثر"[107].
خامسا: الجبن
أصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وتأثيره على العقل والفكر يكون من جهة القلب[108]، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء، انتفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه، وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره، فأصابه الزلزال والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه"[109]، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع"[110]، قال ابن القيم مستدلا بهذا الحديث على إثبات تأثير الجبن في العقل: "فسمى الجبن خالعا لأنه يخلع القلب عن مكانه، لانتفاخ السحر وهو الرئة (...) فإذا زال القلب من مكانه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمور على غير مواضعها"[111].
سادسا: إجهاد البدن والنفس
فالعمليات العقلية كعملية التفكير وغيرها "تجود في الليل وفي المواضع الخالية، وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة، وعند الهم الشديد، ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية"[112].
سابعا: الخواطر السيئة
فالخواطر واردات وهواجس وأفكار أولية ترد على القوة المفكرة للإنسان بشكل سريع ومتكرر، وتهجم عليه هجوم النفس[113]، وهي نوعان: خواطر حسنة، وخواطر سيئة، وخطواتها تكمن في كونها بداية كل علم وعمل وإرادة، ومن ثم فإن كل ما يترتب عنها يصطبغ بصبغتها؛ فإن كانت حسنة كان ما ترتب عنها حسنا وإن كانت سيئة أشغلت الفكر في ما لا فائدة من ورائه وقادته إلى مصارع الشهوة[114]، لذلك يقول ابن القيم محذرا منها: "دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها، فإن لم تف-عل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها[115].
ملخص البحث
يمكن إيجاز ما تناوله هذا البحث من أفكار وآراء ابن القيم في موضوع التربية العقلية والفكرية في الخلاصات الآتية:
- تحدث ابن القيم عن معاني "العقل" في اللغة وفي الاصطلاح، وخلص إلى أن العقل قوة غريزية فطرية ركبها الله تعالى في الإنسان، وبواسطتها يكون مستعدا لعقل ما حوله من الموجودات والصور والمعارف، وهذه القوة الغريزية تنمو وتزداد فعاليتها عن طريق ما يحصله الإنسان من خبرات في الحياة من خلال احتكاكه بالعالم الخارجي.
وقد انتقد في هذا السياق آراء بعض المتكلمين الذين ينكرون الجانب الغريزي في العقل، مبينا استنادهم إلى أصل خاطئ وهو إنكار القوى والغرائز والطبائع؛ كما انتقد آراء بعض الفلاسفة الذين يرون أن العقل جوهر مجرد قائم بذاته.
- ناقش ابن القيم الآراء المختلفة في موضوع مصدر العمليات العقلية، وبين أن العقل والدماغ يشتركان معا في صدور هذه العمليات عنهما، ويلتقي في هذا الرأي مع أحدث ما توصلت إليه البحوث العلمية المعاصرة في هذا المجال.
- حاول ابن القيم تصنيف القدرات العقلية والتمييز بين وظائفها، كما اهتم ببيان الفوائد المترتبة عن تشغيلها وطريقة تنميتها، وذكر علاقة بعضها ببعض، وقد استعان في هذا البحث بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب اللغة عن هذه القدرات، وله في ذلك إشراقات واستنباطات موفقة.
- قسم ابن القيم أنواع التفكير إلى نوع محمود وهو الذي يقود المتفكر إلى ما فيه مصلحته في معاشه ومعاده، ونوع مذموم وهو الذي يرمي بصاحبه في فلك الأوهام وما لا ترجى منفعته في العاجل والآجل، وقد رسم المسارات الأساسية لكل نوع من هذين النوعين، واهتم بذكر بعض النماذج من كل نوع؛ إلا أنه لم يوفق حينما أدرج التفكير في بعض الموضوعات كالشعر والمنطق والصناعات الدقيقة في خانة التفكير المذموم.
- اهتم ابن القيم بتوجيه العقل المسلم نحو التفكير العلمي الهادف المثمر الذي سيقود المسلمين نحو مدارج الرقي الحضاري والإنساني، وفي هذا الإطار ذكر بعض أشكال التفكير السليم التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، محذرا مما يضادها من أشكال أغرقت كثيرا من المسلمين في الفكر والوهم والخرافة وكبلت قواهم العقلية.
- تناول ابن القيم موانع التفكير السليم وعد منها: الهوى وإتباع الشهوات، والسكر وكل ما يغيب العقل، والتشبت بالعوائد والمألوفات، والجبن وسوء الظن وغيرهما من الأمراض النفسية؛ كما عد منها إجهاد البدن والنفس والاسترسال في بحر الأوهام والخواطر والهواجس السيئة.
(انظر العدد 17 من مجلة الإحياء)
الهوامش
- الفوائد، ص: 56.
- مفتاح دار السعادة، 1/214
- المرجع نفسه.
- روضة المحبين، ص: 7.
- مفتاح دار السعادة، 1/214.
- إشارة إلى قوله سبحانه: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 170).
- إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (الأحقاف: 25).
- مدارج السالكين، 3/512.
- روضة المحبين، ص: 8.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، الصفحة نفسها
- المرجع نفسه.
- مدارج السالكين، 3/95.
- مفتاح دار السعادة، 1/232.
- المرجع نفسه، 1/233.
- المرجع نفسه، 1/232.
- المرجع نفسه، 1/233
- يعرف ابن القيم الغريزة بالسجية والطبيعة والخليقة، انظر: مدارج السالكين، 2/255.
- مفتاح دار السعادة، 1/215.
- انظر: تقريب طريق الهجرتين، ص: 201.
- انظر: كتب "شرف العقل وماهيته عند الحارث المحاسي وأبي حامد الغزالي"، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت–دار الكتب العلمية ط، 1، 1406ﮪ - 1986م، ص: 58، وانظر كذلك العقل وفهم القرآن بتحقيق حسين القوتلي، دار الكندي، ط، 3، 1402 – 1982، ص: 201- 202.
- انظر: كتابه "ذم الهوى" تحقيق مصطفى عبد الواحد، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ط، 1، 1381ﮪ - 1692م، ص: 5.
- انظر: شرف العقل وماهيته عند الحارث المحاسي وأبي حامد الغزالي"، مرجع سابق، ص: 58- 59، وانظر كذلك: إحياء علوم الدين للغزالي، بيروت، دار المعرفة، (د.ت.ن) ص: 85.
- انظر: شرف العقل وماهيته، ص: 17.
- انظر: كتاب النفس لأرسطو، تحقيق أحمد فؤاد الأهواني، مكتبة عيسى البابي الحلبي، ط، 1949، ص: 108.
- تجد هذا التعريف أيضا عند الفارابي وابن سينا، انظر: محمود قاسم: في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط، 3 (د.ت.ن)، ص: 202- 218.
- نسب ابن القيم هذا الرأي للقاضيين: أبي بكر بن الطيب وأبي يعلى بن الفراء، انظر: تقريب طريق الهجرتين، ص: 201.
- انظر تقريب طريق الهجرتين، ص: 201.
- انظر: مفتاح دار السعادة، 1/215.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- شرف العقل وماهيته عند الحارث المحاسبي وأبي حامد الغزالي، م، س، ص: 60.
- مفتاح دار السعادة، 1/215- 216.
- المرجع نفسه، 1/215- 216.
- مفتاح دار السعادة، 1/215.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- انظر: التبيان في أقسام القرآن، ص: 511.
- المرجع نفسه.
- نفسه الصفحة نفسها.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، ص: 495.
- المرجع نفسه، ص: 511.
- مفتاح دار السعادة، 1/451.
- انظر: مدارج السالكين، 3/247.
- المرجع نفسه، 3/247.
- مدارج السالكين، 3/247.
- التبيان في أقسام القرآن، ص: 511.
- المرجع نفسه.
- مفتاح دار السعادة، 1/352.
- بدائع الفوائد: 3/204.
- انظر: مالك بدري: التفكر من المشاهدة إلى الشهود، الولايات المتحدة الأمريكية، هيرندن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة أبحاث علمية، رقم 3، ط، 2- 1413ﮪ 1992م، ص: 19.
- المرجع المرجع نفسه، ص: 19- 20.
- الفوائد، ص: 183.
- انظر: مفتاح دار السعادة، 1/334.
- الفوائد، ص: 183.
- انظر: الجواب الكافي، ص: 183.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، ص: 184.
- انظر: مفتاح دار السعادة، 1/356- 357.
- الجواب الكافي، ص: 183.
- المرجع نفسه، ص: 184.
- مفتاح دار السعادة، 1/489.
- انظر: الفوائد، ص: 183.
- المرجع نفسه.
- الفوائد، ص: 184.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، ص: 187.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، ص: 185.
- انظر: مفتاح السعادة، 1/359.
- مدارج السالكين، 3/290.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- انظر: مفتاح دار السعادة، 1/360.
- ماجد عرسان الكيلاني، مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح، ص: 58.
- المرجع نفسه، ص: 57.
- مفتاح دار السعادة، 1/166.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، 1/166.
- المرجع نفسه.
- مفتاح دار السعادة، 1/258.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- مفتاح دار السعادة، 1/258.
- مدارج السالكين، 3/265.
- المرجع نفسه، 1/449.
- مدارج السالكين، 3/319- 320.
- المرجع نفسه، 3/320.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، 3/321.
- الروح، ص: 512- 513.
- انظر: مفتاح دار السعادة، 1/520.
- المرجع نفسه.
- خصص ابن القيم مؤلفا مستقلا لموضوع الغناء والسماع وهو "كتابه" كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء"، طبع عدة مرات، ومن طبعاته: طبعة دار الجيل، 1992م- 1412ﮪ بتحقيق: ربيع بن أحمد خلف.
- مفتاح دار السعادة، 1/351.
- المرجع نفسه.
- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء، ص: 98.
- انظر: الروح، ص: 528.
- المرجع نفسه.
- أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب ما يجزيء من الغزو، حديث (2511) الإمام أحمد، 2/302- 320.
- الروح، ص: 528.
- مفتاح دار السعادة، 1/351.
- الفوائد، ص: 161.
- المرجع نفسه، ص: 160.
- المرجع نفسه، ص: 31.