في الحاجة إلى طب إنساني شامل

سؤال مفهوم الطب سؤال قديم جديد، قديم قدم وجود الانسان على الأرض باحثا عن أدوية لأمراضه وأسقامه وجديد ما دام الطب موجودا في حياة الناس...
لا يخفى على أحد أن الطب الأول كان طب الطبيعة بامتياز، وكانت العلاجات المتوفرة تعتمد على ما تنبت الأرض من أعشاب وثمار وبقول وخشاش، وعلى ما يستخرج من باطنها من معادن، بل كانت بعض أنواع الحيوان أيضا جزءا من المنظومة العلاجية في مجمل الثقافات والحضارات الإنسانية..
كان لليونان دور رائد في ازدهار المعرفة الطبية في العالم القديم، مستلهمين لا شك من حضارة مصر العريقة ومن عبقرية حضارة ما بين النهرين، لكن تنظيم هذه المعرفة وإكسابها طابع البحث والتنقيب والتصنيف المنهجي بدأ على يد الفاضل أبقراط، الذي ساهم بشكل كبير في عزل الطب عن سواه من معارف عصره، وجاء بعده الفاضل جالينوس الذي أكسب الممارسة الطبية مستوى من العمق النظري والقصد العملي جعلها تستمر في أشكال مختلفة لمدى قرون إلى اليوم...
لقد أدرك المسلمون الأوائل أن منظومة المعرفة الكونية المسددة بالعمل تنتظم ضمن جدلية مطلقة بين الغيب والإنسان والطبيعة.. وأن السمو الإنساني في بعديه الفلسفي والأخلاقي يمر بالضرورة عبر استحضار مفهوم الغيب واستلهام القيم النابعة من وحيه ضمن أفق الكون المنظور مجسدا في الطبيعة في مختلف تجلياتها وأنساقها المركبة..
لقد خرج الإنسان من رحم الطبيعة بالخلق، ووجب أن يعود إليها بالوعي، ذلك أن الابتعاد عن الطبيعة وعدم الغوص في أسرارها والاندماج الكوني معها واستلهام دروسها مآله إفقار المعرفة الإنسانية وانفصالها عن أصلها الكوني..
لا غرابة إذن أن نرى العلماء المسلمين، ضمن هذا الأفق الفكري المبين أعلاه، يتألقون في التأليف حول مختلف مجالات المعرفة الطبيعية بشكل مثير للعجب، فما تركوا حقلا من حقول معطيات الطبيعة إلا تفننوا في تحقيقه وضبط معطياته تصنيفا وتحليلا وتجريبا وتوظيفا..
إن نموذج الطب دال في هذا الاتجاه، فلقد شكل النهم العلمي الذي ميز علماء حضارة الإسلام حافزا لاستيعاب المعرفة الطبية القديمة عبر حركة الترجمة التي وفرت النصوص القديمة في مجال الطب، خصوصا الإغريقية منها، باللغة العربية، فازدهرت حركة التأليف الطبي وازدهرت معه المعرفة التصنيفية بالكائنات الحية وغير الحية التي شكلت أساس ما كان يعرف بالأقرباذين (الفارماكوبي)، أي مجموع المواد الطبيعية التي تتوفر على خصائص علاجية مع شروحات وجرعات ووصفات ومحاذير..
ولقد بدا المشهد الثقافي في العالم الإسلامي مؤذنا بظهور إنتاج علمي سيساهم في تغيير ملامح الممارسة الطبية في العالم، وكذلك كان.... فظهر الحاوي في الطب للرازي والقانون لابن سينا ومنهاج البيان فيما يستعمله الإنسان لابن جزلة، والاعتماد في الأدوية المفردة وزاد المسافر لابن الجزار، والتصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوي، والكليات في الطب لابن رشد والتيسير لابن زهر، وعمدة الطبيب لأبي خير الإشبيلي وصولا إلى جامع مفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار، وحديقة الأزهار للوزير الغساني، وتذكرة الشيخ داوود، وغاية البيان في تدبير بدن الإنسان لابن سلوم الحلبي، والهدية المقبولة في الطب لمحمد الصالحي الدرعي، وضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس للعلامة عبد السلام العلمي.. والطريف أنه على اختلاف هذه المؤلفات الرائدة من حيث العصر ومنهج التأليف والتخصصات، إلا أن الجامع بينها هو إتقان المادة الطبيعية التي تشكل أساس العلاج بعد تشخيص للأمراض بلغ ذروته حسب ما كانت تتيحه المعرفة العلمية وقتئذ...
كان من الطبيعي أن تنحو حركة الترجمة اتجاها معاكسا لما كانت عليه في السابق، فأضحى التسابق لترجمة كتب رواد الطب العربي الإسلامي ديدن مدارس الطب الناشئة في أوربا التي لم تعرف عمق جالينوس وقوة آرائه إلا عبر ابن سينا والرازي وابن رشد.. هذا الأخير الذي يعتبر من أروع شراح جالينوس على الإطلاق، وما أروع كلام المرحوم العلامة محمد عابد الجابري الذي قال إن ابن رشد هضم جالينوس بشكل منقطع النظير وتجاوزه من حيث المنهج والتحليل والتنظير، لأن فيلسوف قرطبة اتخذ لنفسه في هذا الكتاب الخطير، موقف المنظر لما يجب أن يكون عليه الطب حتى يرتفع من مجرد مجموعة معارف، تراكمت عبر الممارسة التي تقوم على الخبرة، إلى مرتبة العلم الذي تؤسسه «كليات»، أي أسس ومبادئ ومناهج، يجب أن تُعرف وتؤخذ كأساس للفكر الطبي. من هذه الزاوية، يمكن القول إن هذا الكتاب غير مسبوق ولم يظهر ما يماثله في موضوعه إلا في القرن التاسع عشر حين أصبحت فلسفة العلم موضوع اهتمام». وأن «الكليات، إذن، أقرب إلى أن يكون كتاباً في فلسفة العلم، أو الإبستيمولوجيا بالمعنى المعاصر للكلمة، منه إلى كتاب في الطب كممارسة، علماً أنه يلخص وبصورة كافية ومركّزة، الممارسة الطبية في عصره، لا كمجرد ناقل بل كطبيب مجتهد صاحب رأي...لقد علا نجم جالينوس وعلا نجم ابن رشد، لكن خفت نجم الطبيب باراسيلز (ت 1541) الذي أحرق كتبهما أمام الملأ بمنطق نكران الجميل، إن كان لنكران الجميل منطق، وبمنطق لا أريكم إلا ما أرى...
في حاضرة القيروان سطع نجم العلامة ابن الجزار (القرن الرابع الهجري) الذي بلغ بالممارسة الطبية في الغرب الإسلامي مستوى راقيا من حيث المعرفة والمنهج والتطبيق، ووصلت أعماله إلى أوربا خلال القرن الحادي عشر الميلادي بعد ترجمة أجزاء من زاد المسافر، والاعتماد في الأدوية المفردة، والمعدة وأمراضها ومداواتها، ومقالة في الجذام من طرف قسطنطين الإفريقي الذي نسبها كلها لنفسه..
ورغم هذا الانتحال وصل علم ابن الجزار إلى العالمية، وكان له دور حاسم مع أعمال ابن سينا والرازي وابن رشد والزهراوي وابن زهر في انبثاق مدارس طبية في دول أوربا أشهرها مدارس ساليرنو ومونبولييه وبولونيا وغيرها..
والمثير للانتباه أن جذوة البحث في أسرار الطبيعة من أجل مد المعرفة الطبية بما يحتاجه الإنسان لحفظ الصحة ما خفتت يوما، بل زادت حدتها مع تطور علم الكيمياء تدريجيا في أرجاء أوربا، استلهاما طبيعيا من المدرسة الكيميائية العربية الإسلامية التي كانت مزدهرة بالتوازي مع تطور الطب ومناهجه ومدارسه...
كان العلامة لويس باستور، رائد علم الجراثيم، يقول إنه قبل التعاطي لأي علم لابد من الاطلاع على تاريخه، لإيمانه بأن المعرفة الطبية المعاصرة تحمل في طياتها المعرفة السابقة بشكل عضوي، وأن التطور أيا كان لا يلغي ما سبقه، لأن منطق التراكم المعرفي يُبقى غالبا على الكليات التي تم نحثها على فترات طويلة من الزمن ويُخضِع الجزئيات لمختبر التحليل والتجريب من أجل التنقيح والمراجعة والاستيعاب والتجاوز...
فأهل العلم يعرفون ويدركون جيدا أم المعرفة كل لا يتجزأ، وأن المراجعة والصقل والتصويب والترشيد جزء من بنية المنظومة المعرفية في كليتها؛ بعض من هذا نجده عند العلامة الإبستيمولوجي كاستون باشلار الذي رسم طريقا واضحة لجدلية المعرفة النظرية والمعرفة التطبيقية بشكل عميق..
ضمن هذا الأفق النظري، نستطيع القول إن تطور الطب ليس تطورا خطيا في اتجاه واحد لا يلتفت للوراء ولا يراعي إنجازات الأوائل، فلقد عاد طب الطبيعة وعلم "الأقرباذين" إلى الازدهار من جديد بعدما عرف تراجعا خطيرا امتد لقرابة قرن، إذ أدى ازدهار الكيمياء الطبية خلال القرن التاسع عشر إلى تركيب الأدوية كيميائيا والتخلي التدريجي عن المواد العلاجية في شكلها الطبيعي، ومع الأرباح التي بدت تجنى من الصناعة الجديدة اختلط الطب بالاقتصاد وتعقدت المعادلة وأضحى من يدعو إلى الجمع بين الطبين، الطبيعي والكيماوي، معيقا لعجلة تقدم الطب الجديد...
لا ننسى أن الكثير من الأدوية المعاصرة للأمراض المستعصية ذات أصل نباتي، فنبات الوينكا هو أصل الفانكريسين والفانبلاستين إحدى ركائز العلاج ضد السرطان وكذلك التاكسول المستخلص لأول مرة من شجيرة الطقسوس، وعنصر الديجوكسين الفاعل ضد أمراض القلب مستخلص من القمعية (الديجيتال)، والحامض الساليسيلي (الأسبرين) المستخلص من نبات الساليكس من جنس الصفصافيات، ولا ننسى الكينين المستخلصة من الكانكينا كعلاج للملاريا قبل أن تظهر مؤخرا الأرتميزينين، المستخلصة من نبات الشيح الحولي، كعلاج شديد القوة ضد الملاريا واللائحة طويلة..
لما انعدم وجود المضادات الحيوية خلال الحرب العالمية الثانية، أعاد الطبيب العسكري الفرنسي جون فالني الزيوت الأساسية المستخلصة من النباتات العطرية إلى الواجهة، وذلك بعلاجه للإصابات الجرثومية التي تظهر كمضاعفات للجروح، واستطاع إنقاذ كثير من الجنود المغلوبين على أمرهم من بتر أعضائهم، وقبله المهندس الكيميائي روني-موريس غاتيفوسي الذي اكتشف بشكل فجائي خصائص زيت الخزامي ضد الحروق عندما غمس يده المحروقة في قارورة كانت مملوءة بالزيت المذكورة، وتحولت حكايته إلى إنجاز علمي كبير في مجال الحروق يجهله كثيرون مع الأسف، وصاحبنا غاتيفوسي هذا هو من نحث مفهوم "العلاج بالزيوت الأساسية: آروماتيرابي".. وللتذكير فإن هذه الزيوت الطيارة ذات الخصائص العلاجية المتعددة تستخلص بواسطة التقطير بآلة كان أول من اخترعها الشيخ الرئيس ابن سينا...
ألف العلامة لوسيان لوكليرك كتابه الرائع تاريخ الطب العربي في جزئين سنة 1876، وقد قُرأ بنهم شديد في الأوساط العلمية الأوربية، وفي فترة ما بين الحربين ظهرت كتابات موسوعية شديدة الفائدة حول العلاج بالنباتات الطبية أهمها كتب هنري لوكليرك صاحب الموسوعة الشهيرة، وتلاه الكتاب الجامع لبول فيكتور فورنيي حول النباتات الطبية والسامة لفرنسا سنة 1947، مباشرة بعض النقص الذي ظهر على الطب الاتفاقي المعتمد كليا على المواد الكيماوية، خلال الحرب العالمية الثانية، والطريف أن هؤلاء الرواد يحيلون كثيرا على الأطباء المسلمين، ولا أشك في استفادتهم من كتاب لوسيان لوكليرك المذكور..
إننا نشهد اليوم عودة قوية للعلاجات المعتمدة على الطبيعة، في كل بقاع الأرض، حتى التي يعتبر نظامها الصحي من أرقى الأنظمة في العالم، كسويسرا وبلجيكا وألمانيا والنمسا وفرنسا، والدول الأسيوية ذات النظام الصحي الراقي كاليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ التي ثمنت نظامها العلاجي الموروث بدمجه تدريجيا في النظام الصحي العام، وهو ما نجحت فيه الصين إلى حد كبير.. وهذه العودة هي في نهاية الأمر إغناء للمنظومة الصحية لامحالة، ولا ينبغي أن يتعلق الأمر البتة بصراع بين منظومتين، يسعى كثيرون إلى إشعال فتيله، بل الأمر يتعلق بتكامل وتواصل واستمرارية تعيدنا إلى ما ألمحت إليه سابقا من استمرارية علوم الأولين فينا وفق قواعد تطور المعرفة الإنسانية في أبعادها الفلسفية والعملية...
لا يعذر أي طبيب، مهما علا شأنه، في استيعاب تاريخ المعرفة الطبية في ميدان تخصصه، ولم لا يحصل الحد الأدنى من المعرفة الطبية الشاملة في بعدها الإنساني.. ما الذي يمنع طبيبا مختصا في مجال طب دقيق معين من أن يطلع، ضمن برنامجه التكويني المستمر، على ما يتعلق بتخصصه من مقاربات علاجية مختلفة عما ألف ممارسته وإتقانه –بطبيعة الحال- تمس العلاج بالنباتات الطبية والزيوت الأساسية والتغذية والتدليك والوخز بالإبر والاستحمام العلاجي وغيرها من العلاجات التي تحقق نتائج جيدة في مختلف الأمراض في مشارق الأرض ومغاربها...
لقد انتقل العلاج بالزيوت الأساسية والزيوت النباتية الذي طوره العلماء المسلمون بشكل كبير إلى رحاب الجامعات الأوربية، فصرنا نجد اليوم مستشفيات بأوروبا تدمج المواد الطبيعية بشكل رسمي في المنظومة العلاجية داخل المستشفيات الجامعية، والمثال الطريف الذي أسوقه هنا من مستشفى ليموج بفرنسا الذي حقق نجاحات جيدة في لحم الجروح باستعمال العسل (منها عسل الدغموس المغربي) وفق اجتهادات الدكتور الشهير ديسكوت، ناهيك عن مصالح طب كبار السن والأمراض النفسية والعصبية التي اكتشفت فضائل الزيوت الأساسية في محاربة الالتهابات المفصلية والتشنجات العضلية والاضطرابات النفسية والعصبية وغيرها من الأمراض التي لا يتحمل كبار السن فيها أدوية كيماوية ذات أعراض جانبية...
لا أخفي أن الأمر هنا يتعلق بمسألة معرفية بالأساس، فالخوض في عالم المواد الطبيعية واستعمالها في العلاج بموازاة الطب الاتفاقي المبني على المواد الكيماوية، أو التخلي عن الكيماويات إذا كان البديل الطبيعي ناجعا لا غبار عليه، مسألة تقتضي إلماما واسعا ومعرفة مستمرة بالتطور المذهل الذي يميز هذا العلم القديم الجديد، فهناك زيوت أساسية تحتوي على أكثر من 300 مادة كيميائية (لا كيماوية) تتفاعل فيما بينها لإعطاء مفعول علاجي معين. وإذا كانت بعض الزيوت قد أفصحت عن كثير من أسرارها لتوفرها على مواد فاعلة محدودة العدد كزيت الزعتر والقرنفل والأوكاليبتوس والكولتيريا (بكاف معقوفة) وشجرة الشاي (الميلالوكا)، فإن زيوتا أخرى مثل بعض أنواع الخزامى البرية ونباتات صحرواية لا زالت تعد بالكثير لتفرد مكوناتها الفاعلة وندرتها في عالم الطبيعة، وهذا موضوع آخر...
إن الإنجازات التي حققها المغاربة في مجال البحث في الطب الطبيعي ومعطياته وإمكانياته وأفقه لازالت تحتاج إلى من يزيل عنها الغبار ويبعثها من مرقدها ويخضعها للتحيين والتمحيص والتحقيق، ولا يمكن الاستفادة منها في المنظومة الصحية المغربية إلا عبر وضعها على خط مشروع صحي شامل يجمع بين مكتسبات الطب الاتفاقي كما هو متعارف عليه عالميا، والطب الطبيعي الذي عرف المغرب تألقا فيه ملفتا للنظر على مدى قرون منذ المدرسة التي تبلورت في الأندلس وأثرت الممارسة الطبية المغربية عبر تاريخها الطويل.. إن عمل التفكيك والتركيب هذا كفيل بإدراك أن مصيرنا الصحي المستقبلي رهين بحوار ونقاش واسع حول ما يمكن أن نقوم به عمليا لإدماج الطب الطبيعي ضمن منظومة الصحة الشاملة..
ولا طالما طالب الفاضل العلامة جمال بلخضر بذلك، وهو صاحب الموسوعة الرائعة حول التداوي بالأعشاب في الثقافة المغربية في أبعادها التاريخية والعملية، مع تحقيق علمي وضبط كيميائي للعناصر الفاعلة وتعريف بالمواد السامة الممكنة (1997)، ولما نجح الفاضل العالم من حاضرة فاس -حرسها الله- الدكتور عدنان الرمال من لفت الأنظار باختراعه لدواء مفاده تقوية مفعول مضاد حيوي بإضافة عنصر فاعل مستخلص من نبات عطري للقضاء على جراثيم مقاومة، بدأ ت بعض عناصر الوعي تظهر وطرح السؤال هل هذا العالم المجتهد فلتة من فلتات الزمان في بلدنا المبارك أم هو امتداد لعبقرية بلد ممتدة في عمق التاريخ....
لا شك ان إنجازا من هذا القبيل ليس غريبا على المغرب، بتاريخه العلمي وطبيعته المتنوعة العناصر وهمة أهله، لكن تكرار مثل هذا الإنجاز ودعم أمثاله لن يتم إلا بالإيمان أنه آن الأوان لإعادة طرح الأسئلة الشاملة حول مصير ومستقبل منظومتنا الصحية، وقتها لن تبقى المسألة مسألة تقليد ضد تجديد، أو أعشاب وزيوت ضد عقاقير كيماوية، أو أطباء ضد منتحلي صفة الطبيب، بل سيُستفرَغ الجهد في إدراك أن المسألة أكبر من ذلك، إذ هي مسألة تحيلنا من جديد إلى جدلية الغيب والإنسان والطبيعة...
هل سيأتي يوم نرى فيه كليات الطب في بلدنا تدرس أسس الطب الطبيعي وتشجع البحوث الجامعية حوله وصولا إلى تجارب سريرية، ونشم رائحة الزيوت الأساسية في مستشفياتنا الجامعية، في هواء غرف المرضى وفي قاعات الجراحة وفي أيدي الممرضين والممرضات وهم يخففون من آلام الناس، ونرى فيه الغذاء يتغير من جناح إلى آخر حسب تغير المرضى وأنواع المرض، ونرى فيه مشروبات النباتات الطبية معهودة في موائد المرضى، معتادة في نصائح الأطباء لمرضاهم، ومضادات حيوية ومضادات فيروسات من الزيوت الأساسية، لست أدري، لكنني أتمنى ذلك...






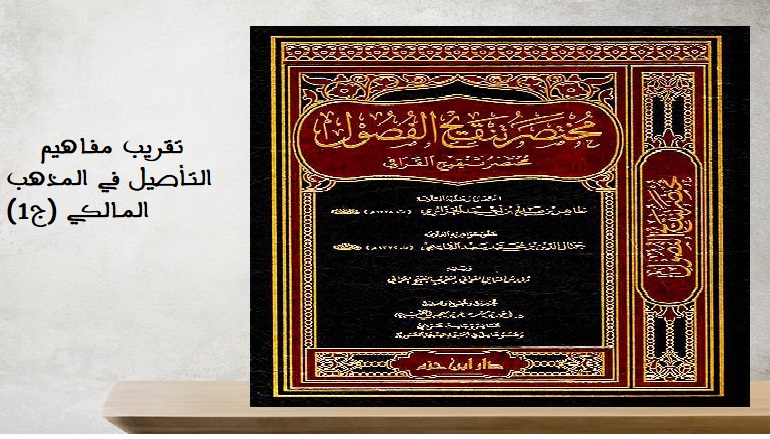
مقال رائع