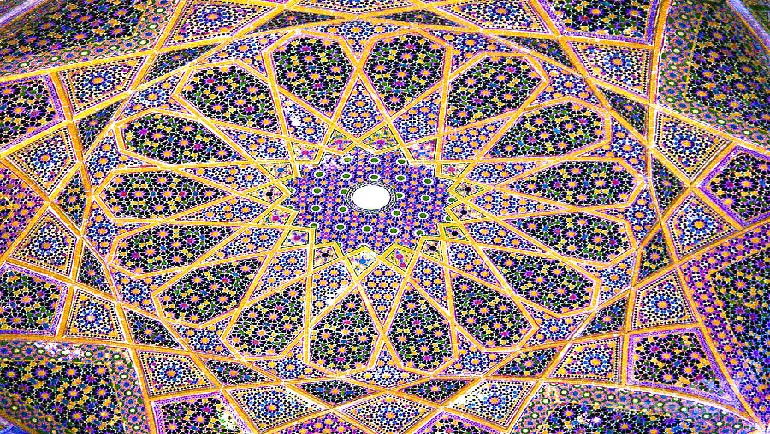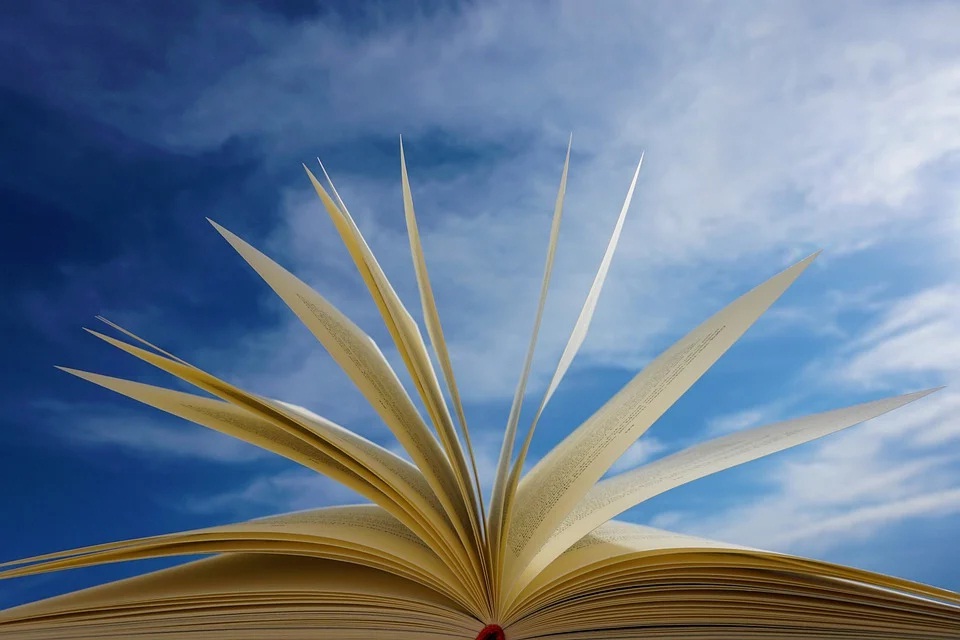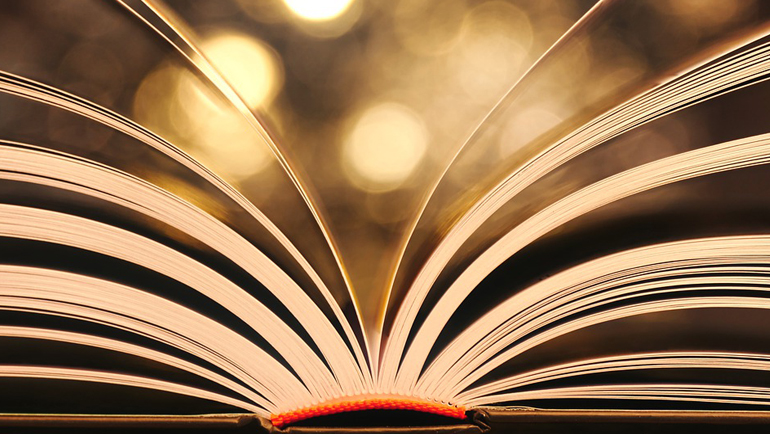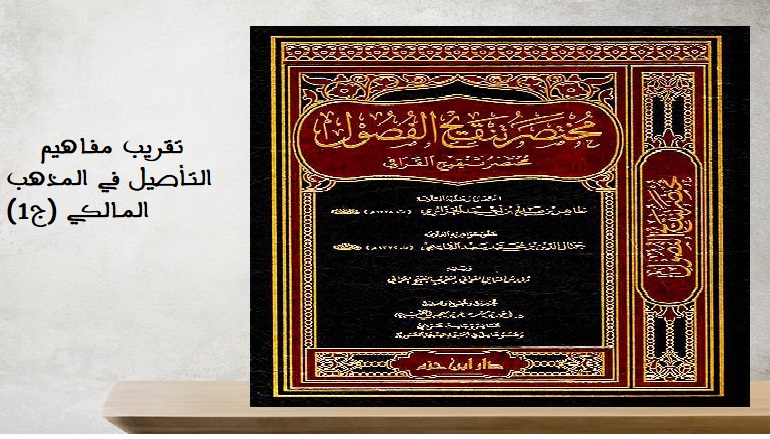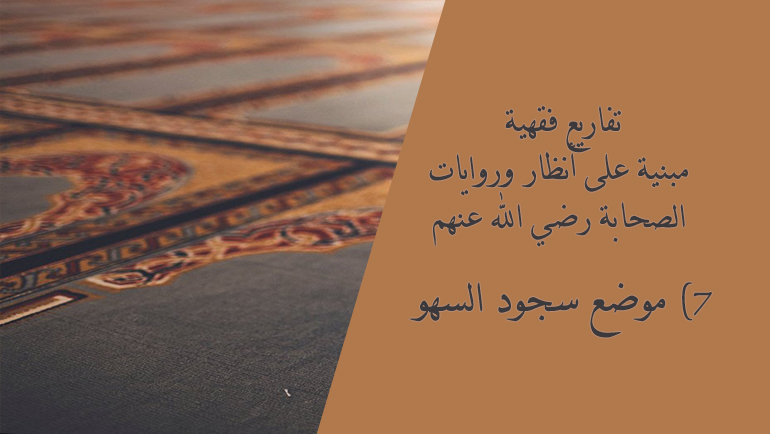تقريب مفاهيم التأصيل في المذهب المالكي(ج1)2
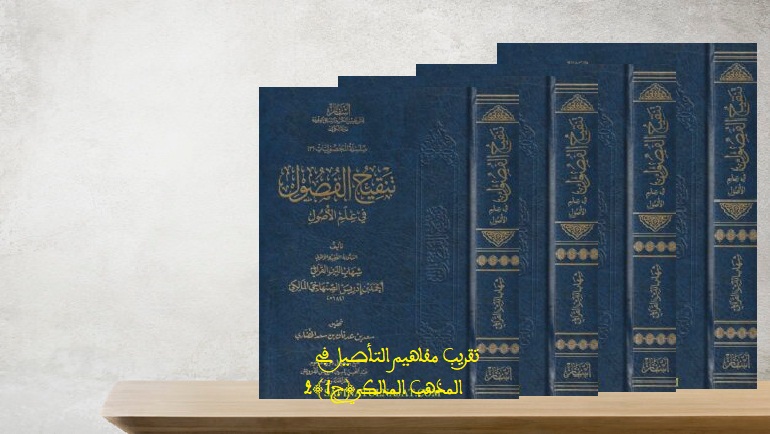
2- الدلالة والسياق.
إذ عرفنا أن الخطاب إنما يدل بقصد المتكلم وإرادته، وأن الفقيه في مسعاه التأويلي ينشد الوقوف على مرامي الخطاب الشرعي وتعقب مقاصده الدلالية، لابد من تقرير حقيقة أساسية مقتضاها أن تحصيل الدلالة الشرعية المقصودة لا يتأتى بمعزل عن السياق واستلزاماته، مادام المقصود الدلالي تتوارد عليه "احتمالات دلالية" أخرى تلابسه بمقتضى مسلمة الاحتمالية، ومن ثم يكون للسياق دور حاسم في توجيه الفقيه الوجهة السليمة في ممارسته التأويلية.
- مفهوم السياق:
إن تحصيل دلالة الخطاب تحصيلا سليما يتوقف على مجموعة من الملابسات والمعطيات التي تشكل الإطار العام للفعل الخطابي، هذا الإطار اصطلح على تسميته بالسياق.
ومن بين التعاريف المقترحة له أنه "النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم، وذلك بأوسع معاني هذه العبارة. إن السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل لا الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب، بل والقطعة كلها والكتاب كله، كما ينبغي أن يشمل -بوجه من الوجوه- كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات، والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لها هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن"[1]، ومن ثم "فالطاقات الإيحائية للمفردات تستقيم وتكتمل عبر العلاقات التي توجه توافقها وتآلفها في السياق (...) إذ المعنى يتكون فقط في السياق الكلامي. وفي تآلف الكلمات بالذات تختزن المعاني الجديدة وتتولد وتنخرط في علاقات متجددة تستجيب لمتطلبات التعبير"[2].
وعلى الجملة إن السياق يستلزم معطيات عديدة ومترابطة تشكل مكونات جوهرية له، وقد نجملها فيما يلي[3]:
أ - المعطيات التي تختص بلغة الخطاب، وتشمل مجموع العناصر المقالية أو اللفظية للنص كالوحدات الصوتية والصرفية والعلاقات التي تنتظمها وطريقة ترتيب هذه الوحدات داخل الجمل ومظاهر النبر والتنغيم.
ب - المعطيات التي تختص بمنشئ الخطاب أي المتكلم كالمعتقدات والمقاصد والتوجهات والقيم.
ج - المعطيات الخارجية التي يتم فيها الخطاب كالظروف الزمانية والمكانية والبيئية والحالية.
د - المعطيات الحوارية، أي جملة المعارف المشتركة بين المتخاطبين والتي على ضوئها يتم التفاعل فيما بينهم[4].
يظهر إذن من خلال هذه التحديدات أن السياق "ليس متعلقا بمستوى واحد من مستويات الخطاب -أي خطاب كان-وإنما يتعلق بمستوياته المختلفة البعيدة أو القريبة، الداخلية أو الخارجية، المباشرة أو غير المباشرة"[5].
وإذا علمنا أن الممارسة الخطابية ظاهرة معقدة، إذ هي نتاج تفاعل حي بين فعلين تواصليين هما فعل الإفهام الذي يقوم به المتكلم وفعل الفهم الذي يضطلع به المخاطب، فإن السياق بدوره يتسم بالتعقيد، حيث تنفذ آثاره إلى كافة أبعاد الخطاب: فلفعل الإفهام سياق مخصوص، ولفعل الفهم سياق مخصوص أيضا، وهذه السياقات تتفاعل فيما بينها على وجه التكامل والازدواج شاهدة على ثراء الخطاب، وبيان ذلك أن "إنشاء مدلول القول في عملية التكلم وتأويل هذا المدلول في عملية الاستماع، يتطلبان معا التوسل بسياقات مزدوجة، فسياق "الإنشاء" يحتوي نصيبا من سياق "التأويل"، وسياق "التأويل" يحتوي نصيبا من سياق "الإنشاء"، وعلى قدر هذا النصيب المشترك يكون التفاهم، حتى إذا عظم هذا النصيب واتسع اتساعا، ارتقى التفاهم إلى الفهم والتواصل إلى الوصال"[6].
والقول الجامع في هذا الموطن أن السياق هو جملة القرائن والاعتبارات المقامية المفيدة في ترجيح أحد الاحتمالات الواردة في الخطاب.
الهوامش:
-[1] دور الكلمة في اللغة، أولمان ستيفن، ص 61-62، ترجمة وتقديم كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، مصر، 1990انظر كذلك مشكل المعنى عند اللغويين العرب القدامى، بوشتى العطار، رسالة دكتوراه في اللسانيات ، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب، الرباط، 1995.
[2] - بحوث ألسنية عربية، ميشال زكريا، ص 82، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 1992.
[3] - المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ص 65 وما يليها، ط 1، 1987، ترجمة سعيد علوش، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع.
[4] - نظرية المعنى من خلال تأويل النص القرآني الكريم عند الأصوليين، عبد الرحمان العضراوي، ص 491 وما يليها، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط، 1994.
[5] - عوامل استخراح المعنى في نماذج من كتب الغريب، عبد الله طاهيري، ص 66، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب الرباط، 1996.
[6] - اللسان والميزان، طه عبد الرحمان، ص 266.