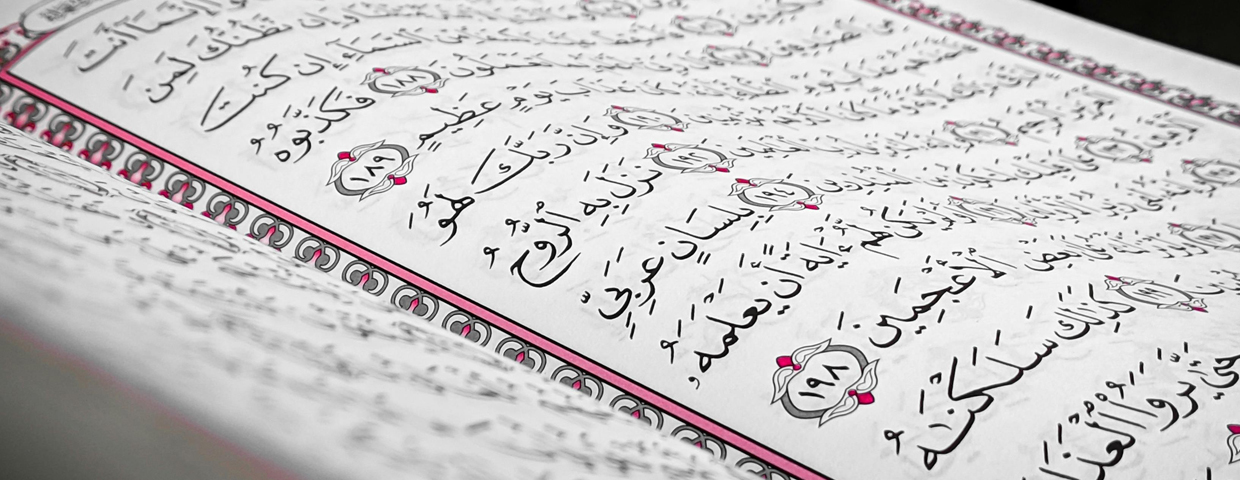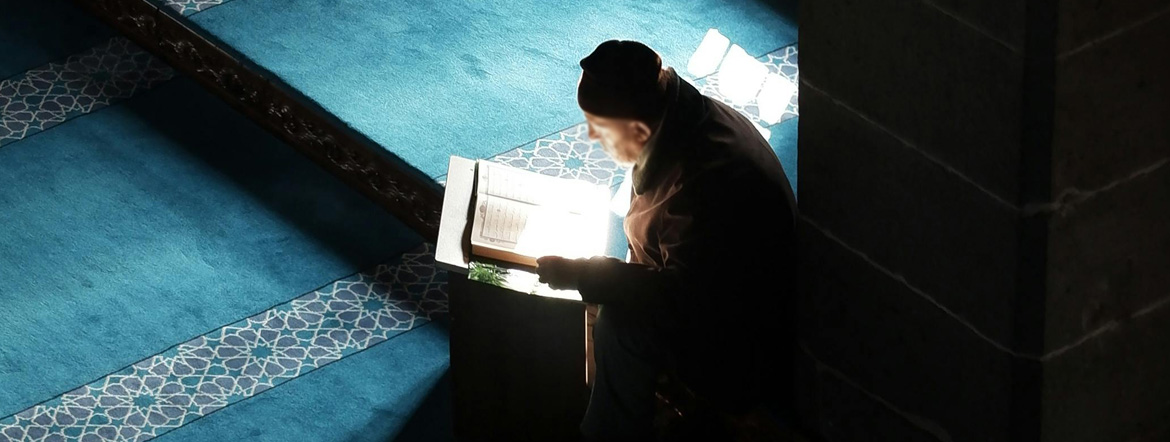على عكس الحال في القرون الأولى لظهور الإسلام، ينتشر المسلمون اليوم في كافة أركان المعمورة. في الماضي كان هناك تمييز واضح بين بلاد الإسلام، وبلاد غير المسلمين. وبتعبيراتنا اليوم كان هناك تمييز واضح بين البلدان التي تنتمي إلى الحضارة الإسلامية وبين البلدان التي تنتمي إلى حضارات أخرى. وكان المعيار الأساسي للتمييز بينهما هو الدين الإسلامي؛ البلدان التي تنتمي إلى الحضارة الإسلامية هي البلدان التي تدين بدين الإسلام والتي تطبق الشريعة الإسلامية، أما تلك التي لا تنتمي إلى الحضارة الإسلامية فلا تدين بالإسلام ولا تطبق شريعته.
اليوم اختلف الحال بشكل جذري، أصبحت هناك جاليات "مسلمة" بأعداد كبيرة في كل بلدان العالم تقريبا، بعضها، كما في الصين والهند، يصل إلى مئات الملايين ويزيد في العدد عن بلاد إسلامية كبيرة عديدة. نتيجة لذلك أصبح النظر إلى دين البلد أو الدولة باعتباره معيار التمييز بين بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين غير ملائم. فبدلا من أن تصبح البلاد نفسها أو الأرض نفسها هي التي توصف بالإسلام، أصبح الأكثر ملاءمة هو وصف المجتمعات نفسها بأنها مسلمة أو غير مسلمة.
طبقا لذلك، تصبح المجتمعات في البلدان "الإسلامية" المعاصرة هي مجتمعات مسلمة تمثل أغلبية مطلقة في هذه البلدان. وتوصف الدولة بأنها من الدول الإسلامية كنتيجة لازمة عن كون المسلمين لهم أغلبية مطلقة من حيث العدد فيها. كما تصبح المجتمعات "المسلمة" في البلدان غير "الإسلامية" مجتمعات تمثل أقليات مسلمة في هذه البلدان. وكنتيجة لازمة يصبح من غير الممكن وصف هذه البلاد بأنها من البلاد الإسلامية.
بعبارة أخرى، المجتمعات الإسلامية تعيش في عالم اليوم باشتراك مع مجتمعات أخرى غير إسلامية، أو غير مسلمة، سواء كأغلبية أو أقلية. وهذا يفرض على الفكر الإسلامي طرح تصورات "إسلامية" تجعل هذه المجتمعات مشاركة مشاركة فعالة في تقدم ونهضة البلدان والدول التي تحيا في ظلها. ولأن العمل على تقدم ونهضة المجتمع يطرح في الفكر الإسلامي في إطار مفهوم إعمار الكون، يصبح من الضروري أن يطور الفكر الإسلامي المعاصر مضمونا لهذا المفهوم يصلح للمجتمعات الإسلامية في كل مكان في المعمورة، في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية سواء بسواء.
في الفكر الإنساني (سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي) يطرح مفهوم تقدم ونهضة المجتمع من خلال مفهوم "الحضارة". الدول والمجتمعات المتقدمة هي المجتمعات التي حققت نهضة حضارية، في حين أن الدول المتأخرة هي تلك التي لا تقيم حضارة أو أن حضارتها القديمة قد اندثرت.
يتفق مفهوم الحضارة (الذي يعد مفهوما إنسانيا عاما) مع مفهوم إعمار الكون (الذي هو مفهوم إسلامي) في معنى مشترك هو تحول المجتمع إلى حالة النهضة والقدرة على تنظيم المجتمع وتحقيق أهدافه والقدرة على الدفاع عنه. بعد ذلك المعنى العام المشترك يمكن أن يختلف المفهومان إذا أخذنا في الاعتبار الجوانب الأخلاقية للمجتمع. مفهوم إعمار الكون يتضمن، حكما، الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية، أما مفهوم الحضارة فله دلالات أوسع فيما يخص الجوانب الأخلاقية. فالحضارات "المادية" التي تنكر العالم الآخر سوف ترتكز على معاني "مادية" للأخلاق، في حين أن الحضارات التي ترتكز على أديان أخرى غير الأديان السماوية سوف تمتلك منظومة أخلاقية "غير مادية" ولكنها أيضا غير إسلامية.
في ظل هذا الاختلاف بين مفهومي الحضارة وإعمار الكون، وفي ظل انتشار المجتمعات الإسلامية في كل بلاد العالم حاليا (وربما بشكل أكبر مستقبلا)، يصبح من الضروري تحقيق نوع من الاتساق بين المفهومين بحيث يصبح ممكنا للفرد المسلم في أي مجتمع مسلم في أي دولة في العالم أن يكون عنصرا فعالا ومساهما أصيلا في نهضة البلد الذي يعيش في ظله وينتمي إليه.
في هذا البحث نبين كيف يمكن تحقيق الاتساق بين هذين المفهومين بدون أن يطغى أحدهما على الآخر. فتصبح مشاركة الفرد المسلم (والمجتمعات المسلمة) في بناء الحضارة الإنسانية واجبا إنسانيا ودينيا، كما تصبح مشاركته في إعمار الكون تطبيقا لمبادئ الدين الإسلامي قياما بواجباته الدينية تجاه خالقه وخالق الكون.
في القسم الثاني من هذا البحث نستعرض مفهوم إعمار الكون في الفكر الإسلامي المعاصر ونبين أن مفهوم الحضارة بمعناه العام (الذي يقبل الارتكاز على مبادئ وقيم دينية) هو أحد تمثلات مفهوم إعمار الكون. في القسم الثالث نستعرض مفهوم الحضارة في الفكر الإنساني المعاصر ونبين ضرورته عند محاولاتنا فهم كيفية تحول المجتمع إلى حالة التقدم والنهضة. في القسم الرابع نستعرض الكيفية التي يمكن بها أن نضع الحضارة الإسلامية في سياق التطور الحضاري الإنساني في سياق المفاهيم المعاصرة للتعدد الحضاري والثقافي. في القسم الخامس نبين كيف يمكن تحقيق الاتساق بين المفهومين موضوع البحث وهما "الحضارة" و"إعمار الكون" ونبين الشروط اللازم تحققها في فهمنا لهذين المفهومين وكذلك في الممارسة الواقعية لهما، حتى نحقق الغاية المطلوبة. في القسم السادس والأخير نستعرض ملخص لتصوراتنا في هذا البحث.
أولا: الحضارة كتفسير لمفهوم إعمار الكون في الإسلام
يتحقق الاتساق بين مفهومي إعمار الكون والحضارة كلما أمكن بيان أنه ليس هناك تناقض بينهما؛ فالحضارة كمفهوم يمكن أن تمثل تفسيرا للمفهوم الإسلامي "إعمار الكون" يضاف إلى التفسيرات الأخرى الممكنة له. كذلك فإن إعمار الكون كمفهوم يمكن أن يكون تفسيرا لمفهوم الحضارة إذا حصرناه في إطار الفكر الإسلامي القائم على مجموعة من القيم والمبادئ العامة، يضاف إلى التفسيرات وصور الفهم الأخرى لمفهوم الحضارة. من هذا المنطق سوف يمكن القول بوجود مفهوم "إسلامي" للحضارة يعبر عن رؤية أو نظرة المجتمعات الإسلامية للحضارة كتصور نظري وتطبيقي.
ونقطة البدء، هنا، هي استعراض مفهوم إعمار الكون في الفكر الإسلامي وبيان كيف ينظر إلى مفهوم الحضارة من خلال الرؤية الإسلامية. ولسوف نعتمد في ذلك على عرض موجز لبعض الأبحاث المعاصرة التي تناولت هذين المفهومين بهدف تحقيق ذات الغاية، وهي التوافق بين المفهوم الإسلامي لإعمار الكون وبين التصورات المعاصرة للحضارة الإنسانية.
1. مفهوم إعمار الكون
يعرف زياد خليل الدغامين في مقالته "إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي"[1] إعمار الكون بأنه من المهام الأساسية للإنسان الخليفة في الأرض، ولضرورته القصوى للحياة الإنسانية كان الإعمار مظهرا من مظاهر تحقيق العبودية لله تعالى. ويضيف، اتسع مفهوم العبادة لا ليقتصر على أداء شعائر تعبدية معينة، بل تجاوز ذلك إلى كلّ فعل مادي أو معنوي من شأنه أن ينهض بالإنسانية، ويبعثها على تحقيق الرقيّ والنهضة في المجالات كلّها.
وهذا هو المعنى الأنسب الملائم لطبيعة الإنسان ولما أودع الله تعالى فيه من أسرار، من أهمّها حبّ البحث والتطلّع إلى المعرفة، والرغبة بمعرفة التفسير الصحيح لحكمة الخلق وسرّ الوجود، ووظيفة الإنسان فيه. وقد شهدت نصوص كثيرة من القرآن والسنّة بهذه المهمّة[2].
يبين الدغامين أنه لا يمكن أن تتمّ عملية الإعمار بنجاح إلا وفق نظرة كلية صحيحة للكون، فما هو الكون، وما غاية خلقه، وما علاقة الإنسان به؟ وكيف يمكن أن تتمّ عملية الإعمار؟ وما أهمّ مظاهرها؟ ويضيف أنه لربما تعدّ الإجابة على هذه الأسئلة ومحاولة الكتابة في إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي إسهاما في إعادة بناء الأمّة لنفسها، وترتيب أولوياتها، ووضعها أمام مسؤولياتها من ضرورة القيام بنفسها، واعتمادها على ذاتها في تحقيق ما تصبو إلى إنجازه من رقيّ ونهضة، استجابة لنداء الحقّ جلّ جلاله: ﴿قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ (الرعد: 11). فالرقيّ والنهضة لا يمكن استيرادهما من الخارج[3].
"فعمارة الأرض" بمعناها الشامل تشمل إقامة مجتمع إنساني سليم، وبناء حضارة إنسانية شاملة، ليكون الإنسان، بذلك، مظهراً لعدالة الله تعالى وحكمه في الأرض. إنّ مهمته تحقيق جامعة إنسانية فعّالة في سبيل النهوض بعمارة هذا الكوكب الأرضي، العمارة الكلية الشاملة لكل ما تتسع له كلمة "العمارة" من المعاني المادية والعلمية والاقتصادية. فهي غاية وجود الإنسان وهدفه الأعظم، ولا سبيل له إلى حياة كريمة إلا بالقيام بعملية الإعمار في مختلف الصعد، لتظهر كمالات الإنسان واستعداداته اللامحدودة في الحياة.
في هذا الإطار يبين الدغامين أن إعمار الكون إذا اقتصر على الجانب المادي ينتج نتائج وخيمة. فيبين أن القرآن الكريم قد حدثنا عن ذلك الإعمار المادّي وما آل إليه من مصير، يقول سبحانه: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ (الحج: 43). فالعروش والآبار والقصور كلّها منجزات ماديّة هلكت بفساد المنهج الذي سلكته تلك الأقوام في عمارة الأرض.
وهذا يعني، كما يقرر الدغامين، أنّ تلك العمارة المادية وحدها لا تكفي ولا تفي بمهامّ خلافة الإنسان في الأرض؛ فالعمارة لا تنفك عن المنهج الذي تستند إليه عملية الإعمار، والإنتاج المادّي وحده لا يمثل إعمارا حقيقيا للأرض بسبب عدم توافر ضمانات بقاء هذا الإعمار على حاله، فقد زالت أمم وأقوام لم تترك سوى بصمات وآثار تدلّ عليهم، كفراعنة مصر، وأباطرة الرومان، وأكاسرة الفرس، وغيرهم. والسبب الرئيس في زوال تلك الممالك والأمم والأقوام، هو مخالفتهم منهج الاعتدال والاستقامة وسنن الله في الأرض في عملية البناء، وتبديل العلاقة مع الكون، من حيث إنّها أصبحت علاقة عداء، لا وئام ولا ارتفاق[4].
أما من وجهة النظر الإسلامية، طبقا للدغامين، أوّل ما يتميّز به الإعمار الإسلامي أ نّه لا يقف عند حدود التعامل الماديّ الذي ينظر إلى الكون والإنسان نظرة ماديّة خالصة، ويقصر وجه الانتفاع به على المادّة أيضا، بل يتعامل معه بكل الأبعاد التي تحقّق الكمال الإنساني من جميع جوانبه المادية والروحية والعقلية. فهناك نوع من التناسق والانسجام بين طبيعة الإنسان وانعكاس هذه الطبيعة على عمارة الكون[5].
في ضوء ما سبق، يعرف الدغامين الإعمار بأنه كلّ عمل إنساني متصف بالصلاح والإصلاح ماديا كان أو معنويا، يهدف إلى تحقيق العبودية لله تعالى، والقيام بواجب الخلافة في الأرض. أي أنّ إعمار الكون يمثل عملية بناء محكمة للإنسان والحياة مهتدية بهدايات الوحي قرآنا وسنّة، وهادفة إلى معرفة الله ومرضاته، ومحقّقة لمهامّ الإنسان في هذا الوجود[6].
ولكي يمكن تحقيق هذا المفهوم للإعمار في أرض الواقع يحدد الدغامين مهام أساسية يلزم أن يقوم بها الإنسان حتى يحقق الإعمار، وكذلك شروطا يلزم تحققها حتى يتحقق الإعمار في الواقع الحياتي. يحدد الدغامين، أولا، المهام الأساسية للإنسان في: 1. القيام بواجب الخلافة. 2. عبادة الله تعالي. 3. عمارة الأرض. 4. أداء الأمانة. 5. الشهادة على الأمم[7]. وهذه المهام هي كما يظهر التزامات دينية في المقام الأول، فإذا لم يقم بهذه المهام لا يمكن أن يتحقق الإعمار.
ثم بعد ذلك يحدد شروط تحقيق إعمار الكون في: 1. العلم. 2. التفكر. 3. اكتشاف السنن الإلهية وتسخيرها[8]. وهذه كما يظهر شروط عملية يلزم القيام بها حتى يمكن أن يتحقق الإعمار في أرض الواقع. وأخيرا يبين الدغامين أن الالتزام بهذه المهام يؤدي إلى الإعمار الذي تتمثل مظاهره في: 1. العناية بالبيئة. 2. الحفاظ على موارد الكون. 3. الاقتصاد والتدبير[9].
ويظهر واضحا أن المفهوم الذي يطرحه الدغامين لإعمار الكون يحاول أن يحقق التوافق بين الجانب الديني متمثلا في التزامات الدين الإسلامي من حيث اعتبار إعمار الكون جزءا من عبادة الله، وبين الجانب الدنيوي (أو الحضاري) متمثلا في شروط نهضة الإنسان عموما سواء كان مسلما أو غير مسلم. ويظهر واضحا من هذا الاستعراض أن مفهوماً تفصيلياً للحضارة كان غائبا على الرغم من كونه مفهوما جوهريا بالنسبة لتقدم ونهضة الإنسان. لذلك نستعرض في الجزء التالي أحد الأبحاث التي تستعرض الربط المباشر بين الإسلام وبين الحضارة.
2. الإسلام الحضاري
يستعرض قطب مصطفي سانو[10]، "مشروع الإسلام الحضاري"، كما طرحته السلطات الماليزية ابتداء من عام 2002 ميلاديا، ليس باعتباره مشروعا فكريا فحسب، وإنما أيضا باعتباره مشروعا يهدف إلى التحقق في أرض الواقع. فيبين أولا الدوافع لهذا المشروع والتي تتمثل في هم استعادة تلك العافية الحضارية، والإمكان الحضاري والنهوض الحضاري، والمشاركة الحضارية[11]. ويضيف أن هذه الدراسة تروم تحرير القول في المسألة الحضارية، وسبل استعادة الأمة تلك العافية الحضارية التي افتقدتها، منطلقين في هذا الطرح من ذلك المشروع الحضاري الذي تبنته دولة ماليزيا لتحقيق هذا الأمل الذي طال انتظاره[12].
يقدم سانو مصطلح الإسلام الحضاري كما هو مطروح في المشروع الماليزي بأنه ليس تعبيرا عن تعاليم جديدة، وليس مذهبا حديثا، ولا دينا جديدا، بل إنه وجهة نظر جديدة تريد الحكومة من خلالها تكملة خططها وبرامجها من أجل تكوين مجتمع متحضر ومتميز قادر على معايشة مبادئ الإسلام بصورة شاملة[13].
وعرف هذا المشروع مصطلح الإسلام الحضاري بما يلي: "يراد بكلمة "الإسلام الحضاري" الإسلام الذي يركز على جانب التمدن وبناء الحضارة. ويقال باللغة الإنجليزية (Civilizational Islam) ويقابله باللغة العربية "الإسلام الحضاري" ونعني به النظام المتكامل (المنزل) من رب العالمين... وبالتعريف الكامل لهذا المبدأ نرى أنه عبارة عن وسيلة من وسائل تطوير الإنسان والمجتمع والدولة بصورة متميزة، وشمولية قائمة على أسس التمدن الإسلامي"[14].
في مقابل ذلك يعرض سانو لرؤية أخرى لذات المفهوم، وهي رؤية الكاتب تركي الحمد، صاحب كتاب "السياسة بين الحلال والحرام: أنتم أعلم بأمور دنياكم"؛ إذ حدد ذلك الكتاب المراد بمصطلح الإسلام الحضاري بقوله: "إن الإسلام الحضاري هو تلك المبادئ العامة والقيم الشاملة المجردة التي في حدودها تنبع "تعددية" معينة، وكلها إسلامية، مناقضة كل التناقض تلك الشمولية والأحادية، وسلطة الرأي الواحد التي تقول بها "الأحزاب" الإسلامية، كل على اختلاف مشربه واختلاف إدراكه، واختلاف هدفه؟"[15].
"بمعنى أن كل هذه النظم والتيارات والمذاهب والمجهودات الفكرية والجماعية إنما هي خاضعة، وفق تفسيرات مختلفة وإدراك مختلف، للمبادئ العامة والقيم الشاملة للإسلام وفق تعددية معينة كانت، أي هذه التعددية، مهماز الحركة وباعث التقدم والإنتاج في حضارة الإسلام عندما كانت سيدة العالم وروح عصر ذلك الزمان"[16].
ينقد سانو مفهوم تركي الحمد للإسلام الحضاري على أساس أنه يصنع مقابلة بين الإسلام الحضاري والإسلامي السياسي ويرى أن تلك المقابلة تجعل مفهوم الإسلام الحضاري مفهوما محدودا وغير شامل[17]. كذلك يرى أن المفهوم الذي انتهت إليه مصلحة الشؤون الإسلامية (الماليزية) بحاجة إلى إعادة نظر رفعا للالتباس الفكري والخلط المعرفي، ما دامت المبادئ والأسس التي يتضمنها مصطلح الإسلام الحضاري أوسع وأشمل من أن يكون تركيزا على جانب التمدن وبناء الحضارة[18].
وينتهي إلى أن الإسلام الحضاري ليس قيما ومبادئ في حقيقة الأمر، ولكنه فهم حضاري رشيد لتلك القيم والمبادئ[19]. كما يرى أن الغاية من استخدام مصطلح الإسلام الحضاري، أن ثمة اتفاقا على كون المصطلح شعارا ورمزا يحمل بين طياته مشروعا فكريا وعلميا آنيا يراد له أن يكون بديلا للمشاريع الفكرية والعلمية السائدة في العالم في العصر الراهن[20].
في نهاية البحث يقدم مصطفى سانو ملاحظاته على مشروع الإسلام الحضاري والتي تتلخص في النقاط التالية[21]:
- أن يعدل مصطلح الإسلام الحضاري ليغدو الفهم الحضاري للإسلام.
- تعميق الوعي وتكثيف التذكير بالدور الريادي والقيادي للأمة عبر هذا المصطلح من أجل وضع حد للشعور الانهزامي الاستسلامي الذي أمسى اليوم يخالج مخيلات الأجيال الصاعدة.
- ينبغي أن يكون واضحا بصورة جلية أن هذا المصطلح ما كان ليدل أو يروم، بأي حال من الأحول، تقسيم الإسلام أو تقسيم تعاليمه إلى ما هو حضاري وما ليس بحضاري.
- هذا التصور يقوم على الالتفات إلى ضرورة التأكيد على وجود القيم والمبادئ التي تمكن الأمم من بناء الحضارات عليها، كما يروم إلى ضرورة الالتفات إلى أن تلك القيم والمبادئ لا تحتاج إلى تبديل أو تطوير أو تغيير، ولكن فهمها والعمل بها هما اللذان يحتاجان إلى التطوير والتغيير والتبديل.
وأخيرا، يطرح سانو بعض المرتكزات المقترحة لمشروع الفهم الحضاري للإسلام[22]:
- قيم حضارية يجب تعزيز الوعي بها وهي: الإيمان، والتقوى، والعدالة، والأمانة، والسماحة، والرحمة، والاعتدال.
- مبادئ حضارية يجب تمثلها وتطبيقها في واقع الأمة، وهي: العلم الشامل، والعمل الصالح، والتخطيط الرشيد، والالتزام الرصين بالنظام، والانفتاح الحكيم على الآخر والاعتراف به.
في هذا المشروع تظهر بشكل واضح الحاجة إلى إنشاء علاقة صحيحة بين الجانب الديني لمفهوم النهضة والتقدم (وهو مفهوم الإعمار) وبين الجانب المجتمعي له (وهو مفهوم الحضارة). فالإسلام الحضاري، كمشروع، هو في واقع الأمر محاولة للتوفيق بين هذين الجانبين، بحيث يمكن للمجتمعات الإسلامية أن تحقق النهضة والتقدم في اتساق مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف. والخلل الواضح في هذا المشروع، كما عرضه سانو، يتمثل في افتقاده إلى الآليات المجتمعية التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف. فالمشروع يتضمن المبادئ والقيم (وهي مبادئ وقيم إسلامية)، ثم يقفز إلى النتائج والأهداف المرجوة من المجتمع كما لو أن هذه المبادئ والقيم سوف تعمل من تلقاء نفسها.
الصحيح هو أن هناك آليات مجتمعية يلزم التحرك من خلالها من أجل الربط بين المبادئ والقيم وبين النتائج والأهداف. هذه الآليات المجتمعية هي موضوع مفهوم الحضارة بالمعنى العام. فنشأة الحضارة وتطورها ثم أفولها لها قوانين وسنن تسري على كل المجتمعات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. وفهم هذه القوانين والسنن أمر جوهري لتحقيق الهدف المنشود أعلاه. لذلك كانت معالجة مفهوم الحضارة ضرورية من أجل تحقيق الاتساق بين المفهوم الإسلامي للإعمار والمفهوم المجتمعي للحضارة.
ثانيا: مفهوم الحضارة
كما تبين أعلاه يلزم امتلاك تصور واضح لمفهوم الحضارة والآليات المجتمعية التي يتضمنها هذا المفهوم إذا أردنا تحقيق النهضة المجتمعية المتسقة مع المبادئ والقيم الإسلامية. لذلك نقدم فيما يلي استعراضا موجزا لهذا المفهوم. هذه الآليات المجتمعية ترتبط في المقام الأول بأسلوب التفكير، والنظرة إلى العالم، وكيفية المعرفة، وإنشاء الأنظمة المجتمعية وكيف يكون الفرد في المجتمع فاعلا ومنتجا؛ فدول مثل اليابان وكوريا الصين قد تقدمت بسبب الاعتماد على هذه الآليات المجتمعية "الحضارية" قبل أي شيء آخر، والتي هي آليات تخص الإنسان بما هو إنسان.
ولأن الحضارة المسيطرة والمتطورة في عالم اليوم هي الحضارة الغربية، فإن الكثير من المفكرين يربطون بينها وبين مفهوم الحضارة بشكل مطلق. لذلك يلزم تحرير الارتباط بين الحضارة وتقدم الغرب، وبيان أن الحضارة ليس من الضروري أن تقوم على النمط الغربي أو طبقا للنموذج الغربي. وهذا يتطلب فهما للحضارة منفصلا ومستقلا عن الحضارة الغربية المعاصرة. ونقطة البدء هي التمييز بين مفهومي الحضارة والثقافة.
فنحن نستخدم اليوم مصطلحي الحضارة والثقافة بشكل طبيعي وتلقائي باعتبارهما من المصطلحات الفكرية الأساسية. وعادة ما يستدعي لأذهاننا مصطلح "الحضارة" الإنجازات الضخمة للإمبراطوريات التاريخية الكبرى، أو الإنجازات الحالية للحضارة الغربية المعاصرة. كما عادة ما يستدعي لأذهاننا مصطلح "الثقافة" ممارسات فكرية وفنية واجتماعية وأساليب حياة معينة لشعب معين أو حتى لقطاع معين من المجتمع. ولكن في واقع الأمر نشأ كلا المصطلحين في البداية للتعبير عن معنى واحد هو التطور الإنساني، ثم بعد ذلك استخدم كل منهما بطرق متعددة حتى أصبح تحديد معاني هذين المصطلحين أمرا عسيرا.
وحاليا يرتبط مصطلح الحضارة أكثر بعلم الاجتماع باعتبار الحضارات هي وحدة التحليل الكلية الأكبر للمجتمع ولا يقع فوقها سوى المجتمع الإنساني ككل. أما مصطلح الثقافة فيرتبط أكثر بعلم الإناسة (الأنثروبولوجيا) باعتباره يدرس في المقام الأول أساليب الحياة الإنسانية. وعلى الرغم من صعوبة تحديد معاني هذين المصطلحين، إلا أنه طالما أننا نعتمد بشكل أساسي على استخدامهما فيلزم أن نتفحص كيف يستخدما في الأدبيات المعاصرة، ثم بعد ذلك نقوم بتحديد كيفية استخدامنا لهما وللعلاقة بينهما.
1. تعريف الحضارة
يرد بروس مازليش مصطلح الحضارة تاريخيا إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا حيث يبين أن ميرابو الأب استعمل عام 1756 مصطلح "الحضارة" لتعريف المجتمع الذي يقوم فيه القانون المدني محل قانون القوة العسكرية. كما استخدمه في وصف مجموعة من الناس الذين يتسمون بالتهذيب وحسن السلوك وبالأخلاق الفاضلة في علاقاتهم الاجتماعية[23]. أما أرباد ساكولتزاي في "الحضارة ومصادرها"[24] فيبين أن هذا المصطلح له مستويان، أكبر (macro) وأصغر (micro). فيوضح أولا أن لب معنى الحضارة هو وضع حدود دنيا للعنف في العلاقة بين الإنسان والإنسان، في حين أنه من الناحية المنهجية التاريخية، صعود "الحضارة" يرتبط بفترات تفكك النظام (ساكولتزاي: 369). ثم يبين أنه مصطلح معقد، متعدد المستويات، ومحل جدل.
ويرى أن السؤال الأول يتعلق بطبيعة "الكيان" الذي يشير إليه هذا المصطلح، وأنه، والصفة المشتقة منه، يعمل على مستويين: الأول؛ يشير فيه مصطلح "الحضارة" إلى كيانات كبيرة جدا، تشمل عددا من الوحدات على المستوى الأكبر (macro-units)، مثل الدول والمجتمعات. على الجانب الأخر، يضيف ساكولتزاي، الحضارة، بمعنى السلوك المتحضر أو الشخص المتحضر، تشير على المستوى الأصغر (micro-level)، إلى السلوك الفردي للإنسان. لهذا، المشكلة الأولى التي يجب حلها، كما يرى، هي تفسير هذه الازدواجية بين المعنيين الأصغر والأكبر للمصطلح[25].
من جانب آخر يبين "رولاند روبرتسون" أنه من المهم أن نميز بين الحضارة ككيان اجتماعي/ثقافي مركب، من جانب، وبين الحضارة كعملية، من جانب آخر. ويضيف أن عملية التحضر تتكون من الطريقة التي من خلالها يتحول ما كان، تاريخيا، يمثل قيودا على السلوك الإنساني إلى شيء داخلي. هذه العملية تجعل السلوك الاجتماعي سلوكاً شخصياً أكثر منه سيطرة خارجية من المجتمع[26].
إضافة إلى ذلك، يميز جوهان أرناسون[27] بين معنيين أساسيين لفكرة الحضارة، أحدهما واحدي بالمفرد والآخر تعددي بالجمع، ويرى أن كلاهما كان مهما في تطور العلوم الاجتماعية، ولكن محاولات تنظيرهما على مستوى المفاهيم الأساسية حديثة نسبيا، ونتائجها لازالت محل جدل[28]. يضيف أرناسون أن مصطلح الحضارة ذاته غامض؛ على الرغم من أن استعماله الأساسي في فكر القرن الثامن عشر كان لتأكيد عملية كونية للتهذيب وامتلاك القوة، يبدو أن معنى تعدديا وربما نسبي، يعود إلى تعدد الثقافات في العالم، قد طرح بواسطة هؤلاء الذي كانوا روادا للنسخة الكونية. بمجرد أن أصبحت "الحضارة" كلمة مفتاح، تعرضت في نفس الوقت إلى تجاذبات وتعارضات تفسيرية لها علاقة بالتحيزات الأيديولوجية أكثر منها بالتنظير. وينتهي أرناسون إلى أنه بسبب التطور غير المتوازن للمعنيين، الحضارة بصيغة المفرد فكرة خلافية أكثر بكثير من "الحضارات" بصيغة الجمع[29].
2. العلاقة بين مفهومي الحضارة والثقافة
مفهوم الثقافة بمعناه الحديث ظهر، طبقا لبروس مازليش[30]، بعد فترة قصيرة كرد فعل على "الحضارة". ويرى أنه، بشكل خاص، جاء مفهوم الحضارة لكي يعني بالنسبة لعموم الناس أسلوب التفكير البارد، الحسابي، الميكانيكي والعالمي والمرتكز، على ما يفترض، على التنوير في فرنسا بعد الثورة. الثقافة، على الجانب الآخر، كما عبر عنها الفيلسوف الألماني هيردر، في سبعينيات القرن الثامن عشر، مغروسة في الدم، والأرض، والتاريخ الفريد لجماعة معينة: الشعب. على هذا الأساس، الحضارة تعد مادية، في حين أن الثقافة تعد في الأساس عقلية أو أخلاقية. وعلى الرغم من أنهما يستعملان في الاستعمال العادي كمترادفين، إلا أن المفهومان عادة ما يكونا محملين بمعاني مختلفة[31].
ورغم أن مفهوم الحضارة يشير إلى الجوانب المادية من تطور المجتمعات الإنسانية في حين أن مفهوم الثقافة يشير إلى الجانب الفكري والمعنوي لهذا التطور، إلا أن العلاقة بينهما ليست واضحة ولا محددة. ذلك أن طرح تصور معين للعلاقة بين مفهومي الحضارة والثقافة يرتبط بوضع تصور نظري متكامل للكيانات الكلية الكبرى التي نسميها الحضارة/الثقافة. ويمكن القول بأن هناك تصوران أساسيان، الأول يعتمد على فكر الحداثة الذي يستلهم مفهوم الحضارة بالمفرد، والثاني يعبر عن الحضارات بالجمع.
التصور الأول تعبر عنه تاريخيا الحضارة الغربية الحديثة، ويعبر عنه الآن مفهوم العولمة. وفق لهذا المفهوم هناك حضارة واحدة هي الحضارة الغربية المعاصرة والتي أصبحت الآن حضارة عولمية، ويقابله ثقافات جزئية. هذا المعنى يطرحه "وولف شافير" في مقالة بعنوان "حضارة عالمية وثقافات محلية"[32]. موضحاً أن الحضارة بالمفرد تعني سيطرة الإنسان على الطبيعة. أما الثقافة بالجمع فتبين البنية الاجتماعية لهذا المعنى. الحضارة هي أيضا المصطلح الذي يعبر عن الكل الاجتماعي-الطبيعي، والثقافة تعبر عن المكونات المحلية الجزئية للكل[33]. ويضيف، نحن نتجه نحو حضارة عالمية مع ثقافات محلية عديدة. الثقافات المحلية تعد بمثابة اللحم والعظم لهذا العالم والحضارة التقنية-العلمية الصاعدة تعد بمثابة الجهاز العصبي[34].
إذا حللنا هذا التصور فسنجد أنه يتضمن تناقضا داخليا؛ فكما ذكرنا أعلاه مفهوم الحضارة على وجه العموم مفهوم مرتبط بالآثار الملموسة لتطور الحياة الإنسانية أو الجماعة الإنسانية. لذا فتطور الآلات التي يستخدمها الإنسان تعد تطوراً حضارياً، وتطور المنشآت التي يعيش فيها الإنسان تعد تطوراً حضارياً، وكذلك وسائل إنتاج الفنون المختلفة ودور العبادة ووسائل الانتقال ومقار الحكم والمنشآت الصناعية..الخ.
ولأن الارتباط وثيق بين إنتاج الآثار الحضارية الإنسانية، وبين تطور فكر الإنسان كان مفهوم التطور الحضاري، أو مفهوم الحضارة، معبرا ضمنيا عن التطور الفكري للإنسان وأسلوبه في الحياة، أي ثقافته. لذلك أصبح مفهوم الحضارة مرتبطا بشكل أساسي بمفهوم الثقافة. فإذا كان مفهوم الحضارة معبرا عن النشاط المادي الملموس أو الآثار المادية الملموسة للنشاط الإنساني، فإن الثقافة تعبر عن أسلوب التفكير أو أسلوب الحياة الكامن خلف هذا النشاط وهذه الآثار الملموسة.
بمعنى آخر؛ أن الارتباط بين الآثار الملموسة لتجمعات معينة من البشر (الحضارة) وبين أسلوب الحياة والفكر البشري الكامن وراء تلك الآثار (الثقافة) هو بمثابة العلاقة بين الدال والمدلول في أي منظومة رمزية. فالدال هو العنصر المادي الملموس؛ كاللفظ في اللغة، أو الظاهرة في العلم. ويقابله المدلول الذي هو العنصر غير الملموس؛ كالمعنى في اللغة وحقيقة أو جوهر الكيان المكتشف في العلم. والعلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة انفصال وارتباط في نفس الوقت.
وعلى الرغم من أن الآثار المادية الإنسانية منها ما هو محدود القيمة والتأثير، ومنها ما هو كبير القيمة وعلى درجة كبيرة من التطور والتعقيد، إلا أننا قد درجنا في تاريخ الإنسانية على أن نسمي الأنشطة الإنسانية الكبرى، فقط، بالحضارات. ولا يقابل ذلك نفس التفرقة بالنسبة لمفهوم الثقافة. فنحن نطلق مصطلح ثقافة كون أسلوب إنساني في الحياة له سمات متميزة. وذلك بغض النظر عن أن يكون أسلوب الحياة هذا معبرا عن أسلوب حياة تجمعات ضخمة من البشر أو عن شعوب بكاملها، أو عن أن يكون له امتداد كبير في التاريخ.
وعلى هذا الأساس تمثل الأنشطة الإنسانية التي قامت في تجمعات إنسانية مثل الدولة الفرعونية، الإمبراطورية الفارسية، مجموعة المدن اليونانية القديمة، الإمبراطورية الرومانية، الخلافة الإسلامية، مجموعة الدول والمدن الأوروبية في العصر الحديث...الخ حضارات إنسانية. ولكن في مقابل ذلك لا تمثل الأنشطة الإنسانية القديمة في أستراليا أو ألاسكا أو جزر هاواي مثلا حضارة بالمعنى المتفق عليه، وإنما هي تمثل ثقافات تتميز وتختلف عن الثقافة الغربية السائدة في عالم اليوم.
وعلى ذلك إذا اتبعنا الاستخدام المتعارف عليه للفظي "الحضارة" و"الثقافة"، وبحكم طبيعة العلاقة بينهما باعتبارهما دال ومدلول مرتبطين ببعضهما، فإن كل حضارة من حضارات التاريخ الإنساني تعد "ثقافة" كبرى في التاريخ أيضا. ولكن بحسب نفس الاستخدام ليست كل ثقافة إنسانية بمثابة حضارة؛ لأن الحضارة آثار إنسانية كبرى، في حين أن الثقافة يمكن أن تكون كبرى ويمكن ألا تكون. من هذا الفرق في الاستخدام بين المفهومين نشأت مشكلة العلاقة بين الحضارة والثقافة في الفكر المعاصر.
فالمفهوم السائد في الفكر الغربي الآن هو أننا نعيش حضارة واحدة؛ بمعنى أن تقدم البشرية قد وصل إلى درجة أصبحت معها الأنشطة الإنسانية الملموسة واحدة في كل أرجاء الكوكب. وفي مقابل وحدة الحضارة هناك ثقافات متعددة، الثقافة الغربية، الثقافة الصينية، الثقافة الهندية، الثقافة العربية...الخ. والاعتراف بتعدد الثقافات، اعتبر في هذه الحالة، بمثابة مفهوم مضاد لمفهوم المركزية الأوروبية، التي هي مركزية ثقافية في الأساس.
إذا تأملنا هذا التصور في ضوء ما أثبتناه من أن العلاقة بين الحضارة والثقافة هي كمثل العلاقة بين الدال والمدلول. سنجد أنه من غير الممكن، منطقيا، أن ترتبط حضارة واحدة بثقافات متعددة. الحقيقة هي أن القول بحضارة عالمية واحدة وثقافات متعددة، يستخدم مفهوم "الثقافة" بمعنى ملتبس. فالثقافات المتعددة المقصودة هنا ليست ثقافات متساوية القيمة، كما يوحي هذا الاستخدام لأول وهلة.
والمعنى الحقيقي الذي يفيده هذا المفهوم، والذي يتفق مع المفهوم الصحيح للحضارة والثقافة، هو أنه كما وجدت في الماضي حضارات كبرى (تعبر عن ثقافات كبرى) وفي نفس الوقت ثقافات أخرى صغرى معاصرة لها، فإنه في عالم اليوم توجد حضارة واحدة كبرى (تعبر عن ثقافة واحدة كبرى)، وفي نفس الوقت ثقافات أخرى صغرى. وأن ما هو حادث ليس فقط سيطرة حضارة واحدة على العالم، وإنما أيضا سيطرة ثقافة واحدة على باقي الثقافات. وهو الأمر الذي نلحظه بالفعل من سيطرة الثقافة الغربية على العالم حاليا، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى فكرة المركزية الأوروبية.
ثالثا: تعدد الحضارات والثقافات كمفهوم إسلامي
النتيجة اللازمة عن التحليل السابق لمفهوم الحضارة وعلاقته بالثقافة؛ أن هناك تعدداً حضارياً حتى ولو كانت إحدى الحضارات مسيطرة في زمن ما، كما هو الحال بالنسبة لسيطرة الحضارة الغربية في القرون الثلاثة الأخيرة. ويقابل هذا التعدد الحضاري تعدد ثقافي أيضا، اعتمادا على الارتباط بين الدال والمدلول. ولكن هذا الاعتراف بالتعدد لا يمثل حلا نهائيا للإشكالية المتعلقة بمفهومنا للحضارة.
فتعدد الحضارات ليس معناه الانفصال بينها؛ ففي نهاية الأمر هناك مفهوم مشترك للحضارة. كما أن هذا المفهوم المشترك لا يؤدي إلى توحيد كل الحضارات، في حضارة واحدة. الصحيح هو أن هناك انفصال واتصال بين المفاهيم والرؤى المكونة لكل الحضارات. وبطبيعة الحال هناك تصور خاص للحضارة العربية الإسلامية لما هو مشترك بينها وبين باقي الحضارات ولما هو مختلف كذلك بينها وبين باقي الحضارات.
1. تعدد الحداثات والحضارة/الثقافة العربية الإسلامية
يظهر بشكل واضح في عصرنا الحالي أن هناك تحولات جذرية في الفكر الاجتماعي المعاصر تمضي في طريق التحول عن النظرة الحداثية التي ترتكز على المركزية الأوروبية إلى نظرة جديدة تعتمد تعدد الحضارات والثقافات. ولم يكن هذا التحول ناتجا فقط عن تحولات فكرية فلسفية أعمق تشمل كافة جوانب الفكر الإنساني المعاصر، وإنما أيضا عن مشكلات نظرية عميقة واجهت النظرية الاجتماعية المعاصرة وفرضت عليها التحول إلى تصورات جديدة تعددية.
في هذا الإطار تواجه الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة تحديات إثبات وجود؛ فهي مطالبة بطرح تصوراتها الذاتية عن مكانها في مثل هذه التغيرات الجذرية التي تسمح لها مثلما تسمح لباقي الحضارات/الثقافات الكبرى الأخرى بالتواجد في الفكر الإنساني المعاصر على قدم المساواة مع الحضارة/الثقافة الغربية المعاصرة. وهذا واجب إن لم نقم به بأنفسنا فسيقوم به آخرون ممن يهتمون بالحضارة/الثقافة العربية والإسلامية، وهذا يعد خطرا كبيرا على حضارتنا المعاصرة. فعلى الرغم من الفائدة الكبيرة التي تعود علينا من الجهد النظري الذي قام ويقوم به المستشرقون لمصلحة حضارتنا، إلا أن الفرق كبير بين معالجتنا لمكان حضارتنا/ثقافتنا في عالم اليوم في إطار الفكر الإنساني المعاصر، وبين تصوراتهم النظرية لنفس الموضوع.
وهنا يجب التمييز بين موضوعين: الأول؛ هو تصوراتنا عن العلاقة "التاريخية" بين الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية القديمة وبين الحضارات الإنسانية الأخرى، بما فيها الحضارة الغربية الحديثة. والثاني؛ هو تصوراتنا عن العلاقة "الجارية" حاليا في بدايات القرن الواحد والعشرين الميلادي بين الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة وبين الحضارة/الثقافة الإنسانية المعاصرة الواقعة تحت الهيمنة الغربية. ويستلزم التمييز بين هذين الموضوعين: أولا؛ الانتباه إلى المصطلحات المستخدمة في كليهما ودلالاتها على موضوع البحث، وثانيا؛ إنشاء العلاقة التاريخية بين هذين الطورين لهذه الحضارة، أي طورها القديم وطورها المعاصر.
2. التمييز بين الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية قديما وحديثا
الفرق الجوهري بين الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية قديما وبينها حديثا يتصل في واقع الأمر بتباين مستوى تطور المجتمعات محل البحث. في كلا الحالين لا يعبر الوصف "عربية إسلامية" عن معان عرقية أو دينية، وإنما يعبر عن معان حضارية/ثقافية. فالوصف عربية لا يعود إلى العرق العربي وإنما إلى اللغة العربية التي تمثل أحد العناصر الجوهرية التي تقوم عليها تلك الحضارة/الثقافة. أما الوصف إسلامية فلا يعود إلى الدين وإنما يعود إلى "النظرة إلى العالم" التي تقوم عليها تلك الحضارة/الثقافة.
صحيح أن هذه النظرة قد نشأت من العناصر الفكرية التي أرساها القرآن الكريم، إلا أن هذه النظرة لا تتماهى مع القرآن ذاته، فالتفرقة بين مصدر النظرة إلى العالم، أيا كان هذا المصدر، وبين مضمونها الفكري؛ تفرقة جوهرية يجب أن تستقر في الأذهان قبل استعمال هذه المصطلحات.
تتراوح التعبيرات الوصفية في الأدبيات ذات الصلة ما بين "عربية" فقط، أو "إسلامية" فقط. ونحن في هذا العمل نأخذ هذه التعبيرات الوصفية المختلفة للتعبير عن نفس المحتوى الحضاري/الثقافي الذي يقوم على اللغة العربية والنظرة إلى العالم المستمدة من القرآن الكريم. لذلك يمكننا استعمال التعبيرات الوصفية "العربية الإسلامية"، "العربية" أو "الإسلامية" على أنها تحمل نفس المعنى. خاصة وأن من يفضلون الوصف "عربية" يشيرون إلى وجود أعلام من غير المسلمين في هذه الحضارة، في حين يشير من يفضلون "إسلامية" إلى تصدر أعراق غير عربية للإنجازات والإبداعات التي تميزت بها.
في هذا الإطار تعبر الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية القديمة عن الحالة الحضارية لمجتمعات واسعة الانتشار في الجزء المسكون من العالم القديم. فقد امتدت مجتمعات الحضارة العربية الإسلامية من أواسط آسيا شرقا حتى بلاد الأندلس غرب أوروبا، ومن جنوب أوروبا وأواسط آسيا شمالا إلى جنوب شبه القارة الهندية وأواسط أفريقيا جنوبا. في هذه المنطقة الواسعة انتشرت الحضارة العربية الإسلامية بصورة شبه متجانسة، واعتمادا على "نظرة إلى العالم" واحدة وموحدة.
لذلك نجد أن المساهمات الفكرية والحضارية المختلفة كانت مشتركة ومتبادلة في هذه المناطق الشاسعة من العالم القديم. ولم يكن هناك فرقا نوعيا بين العلماء والمفكرين والمتكلمين في بلاد الأندلس مثلا، وبينهم في بلاد خوارزم أو شمال الهند، لذلك يمكننا الحديث، بحق، عن مركب حضاري واحد مكون من مجتمعات عديدة على مناطق شاسعة من الأرض باعتباره الحامل للحضارة/الثقافة العربية الإسلامية.
في مقابل ذلك حدثت تطورات جوهرية في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين في طبيعة المجتمعات التي مثلت في السابق الحامل لمركب حضاري واحد وموحد هو الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية. التطور الجوهري الأساسي بهذا الخصوص هو ظهور الدولة القومية كبديل لمفهوم الخلافة الإسلامية، ثم تلاه التطور الجوهري الآخر وهو ظهور العولمة.
أدى تحول مناطق الحضارة الإسلامية القديمة إلى نظام الدولة القومية إلى تغيرات اجتماعية أساسية ترتبط بطبيعة الدولة القومية. فقد ارتبط هذا النظام بظهور ما يسمى "بالقومية" (Nationalism). وهو مفهوم نشأ في إطار الفكر الحداثي يهدف إلى تكوين رابطة مجتمعية "للدولة" بديلة عن الروابط القبلية والدينية والعرقية. كما أن مفهوم الدولة القومية يرتكز على مفهوم الفصل بين الذات والموضوع، والذي ترجم في صورة الانفصال التام بين الدولة وباقي الدول على حساب الروابط الثقافية والحضارية. وكان من شأن هذه التطورات ظهور اختلافات ثانوية بين المجتمعات "الإسلامية" في الجوانب الحضارية والثقافية. فأصبحت هناك اختلافات لا يمكن تجاهلها بين مجتمعات مثل ماليزيا وأندونيسيا في آسيا، ونيجيريا وموريتانيا في أفريقيا، وبين هذه وتلك وبين المجتمعات العربية والإيرانية والتركية.
على الجانب الآخر، أدى الظهور التدريجي لظاهرة العولمة إلى تداخل ثقافي وحضاري غير مسبوق بين المجتمعات المختلفة. فأدى الانتشار الواسع لوسائل الإعلام والمنتجات الغربية المختلفة إلى وصول الحضارة والثقافة الغربية إلى كافة مناطق العالم "الإسلامي". في مقابل ذلك أدى انتشار ظاهرة الهجرة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية في الشمال إلى الظهور التدريجي لتجمعات "إسلامية" كبرى في المجتمعات الغربية المعاصرة.
ونتيجة لهذا وذاك بدأت الحدود الفاصلة بين الحضارتين/الثقافتين مطموسة وغير واضحة. إذ لا يمكننا الآن أن نحدد حدود واضحة للمجتمعات التي نصفها "بالإسلامية" أي التي تنتمي إلى الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية دون استبعاد جزء ليس يسيرا من التجمعات التي تنتمي إليها ولكنها تعيش في مجتمعات أخرى؛ (غربية في أوروبا وأمريكا، أو شرقية في روسيا والصين). وهذا الجزء غير اليسير يعيش اليوم منتميا بشكل كامل، بحكم نظام الدولة القومية، إلى المجتمعات التي يحيا فيها.
والمحصلة أنه نتيجة للانفصال الناتج عن نظام الدولة القومية، من ناحية، ونتيجة للاختلاط مع المجتمعات الأخرى، من ناحية أخرى، أصبح من الضروري وضع معيار واضح لتمييز مفهومنا للحضارة/الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة عن تلك القديمة. والمعيار التلقائي هنا هو الظهور الطبيعي لاختلافات ثانوية للنظرة إلى العالم في المجتمعات المختلفة التي نعتبرها جزءا من الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة. فهناك عناصر أساسية جوهرية لهذه النظرة إلى العالم لا تختلف من مجتمع إلى آخر، كما أن هناك عناصر جزئية أقل جوهرية سوف تختلف من مجتمع إلى آخر. وهذا يمثل تطبيقا آخر لمبدأ الفصل والوصل. فهذه المجتمعات بهذا المعنى تمتلك نظرات إلى العالم لها عناصر كلية واحدة (خطوة الوصل)، وعناصر جزئية مختلفة عن بعضها البعض(خطوة الفصل)[35].
في هذه الحالة سوف يمكن القول بوجود تعدد في الحضارة العربية الإسلامية ذاتها، فتوجد صور حضارية آسيوية/إسلامية (ماليزيا وأندونيسيا والصين، الخ)، هندية/إسلامية (باكستان وشمال الهند وبنجلاديش، الخ)، إيرانية/إسلامية (إيران وبعض مناطق وسط آسيا)، تركية/إسلامية (تركيا وبعض مناطق وسط أسيا أيضا)، ثم إفريقية/إسلامية (نيجيريا، موريتانيا، الصومال، الخ)، إضافة بطبيعة الحال إلى العربية/الإسلامية. ويضاف إلى ذلك بعض المجتمعات الإسلامية التي لم تصل بعد إلى مرحلة اعتبارها تجمعات حضارية والتي تقيم في الغرب باعتبارها ثقافة مستقلة معترف بها.
هذا التمييز الأساسي بين حالة الحضارة العربية الإسلامية القديمة التي اعتبرت موحدة، وبين الحالة الراهنة التي تعتبر مجزأة إلى تجمعات حضارية جزئية، سوف يفرض علينا كما سنرى في هذا العمل تصورات معينة للعلاقة بين هذه المجتمعات الحضارية وبين الحضارة الإنسانية المعاصرة. بحيث يظل الاعتراف بالتعددية الثقافية قائما ومعترفا به سواء على مستوى الحضارات/الثقافات الكلية، أي بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى، أو ضمن الحضارة/الثقافة الإسلامية المعاصرة نفسها.
3. الحضارة العربية/الإسلامية كجزء من التطور الإنساني
على الرغم من هذه التفرقة الأساسية بين الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية قديما والحضارات/الثقافات الجزئية العربية الإسلامية المعاصرة، إلا أنه في كلتا الحالتين لا يجوز دراسة هذه الحضارة بمعزل عن التطور الإنساني عموما، وعن العلاقات بينها تاريخيا وجغرافيا وبين الحضارات الإنسانية الأخرى، خصوصا. فالحضارة العربية الإسلامية القديمة قد نشأت وتطورت بشكل واضح من خلال التفاعل مع الحضارات الأخرى. كما أن الثقافات الجزئية العربية الإسلامية المعاصرة، خصوصا في العصر الحديث، تتطور حاليا نتيجة تفاعلها مع الحضارة الغربية المعاصرة المسيطرة حاليا.
وفي كلتا الحالتين أيضا لا تصلح النظريات القائمة على فكرة المركزية الأوروبية في تحقيق هذا الهدف. فهذه النظريات تنظر إلى الحضارة العربية الإسلامية القديمة على أنها لم تقم سوى بنقل المعارف القديمة بدون إبداع أو إضافة حقيقية للفكر الإنساني. وترى أن هذه الحضارة تتضمن عجزا داخليا يمنعها من التحول نحو الحداثة. وبنفس القدر فإن هذه النظريات لا تعترف بالتعددية الحضارية والثقافية وبذلك فهي تنكر أي وجود معاصر متميز للحضارة/الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة مثلما تنكر الوجود المتميز لما يمكن أن نسميه بباقي الحضارات المعاصرة (مثل الحضارة الصينية والهندية) حتى ولو لم نعتبرها متحققة بالكامل كما في حالة الحضارة الغربية الحديثة.
لذلك لم يكن هناك من مفر من وضع تصورات لكيفية وجود الحضارة العربية الإسلامية قديما وحديثا في إطار من تطور الفكر والحضارة الإنسانية. ويلزم لتحقيق ذلك أولا وجود تصورات نظرية عمومية للحضارات الإنسانية نستطيع أن نضع تطورات هذه الحضارة في إطارها، لكي تتحقق من خلالها إمكانية وضع الصورة القديمة لهذه الحضارة في إطارها الإنساني. ثم بعد ذلك يلزم أن يوضع تصور للحالة الراهنة للمجتمعات الإنسانية لا يلغي أو يستبعد التعددية، كما هو الحال بالنسبة لنظرية العولمة، بما يسمح بوضع التطورات المعاصرة لهذه الحضارة في إطارها. وبذلك تتحقق إمكانية وضع الصورة المعاصرة لهذه الحضارة في إطارها الإنساني أيضا.
الهدف الأول يتحقق من خلال الاعتماد على نظرية الحضارات التي ظهرت على يد العديد من المفكرين المعاصرين. في إطار هذه النظرية يطرح أرماندو سلفاتوري في عمله الهام "إعادة موضعة عالم الإسلام"[36] تصورا تفصيليا لوضع الحضارة العربية الإسلامية القديمة في إطار النظرية الحضارية المعاصرة واعتمادا على مساهمات عديدة لمفكرين آخرين في الموضوع.
في البداية يستعرض سلفاتوري موقف الفكر الغربي الحديث، القائم على فكرة المركزية الأوروبية، من الحضارة الإسلامية. يبين سلفاتوري أن العالَم الإسلامي، والذي كان تكوينه السياسي الأساسي، وهو الإمبراطورية العثمانية منظورا إليه من الغرب الأوروبي الحديث، ينظر إليه لمدة طويلة على أنه يعاني من غياب ديانة تضع حدود لذاتها، ودولة مركزية قوية قابلة للاستمرار مدعمة بهوية مؤسسية واضحة. نتيجة لهذا التصور، طبقا للمنظور الأوروبي، فإن قوة الدفع عبر الحضارية للإسلام تتبخر إذا قيست على المعايير الموضوعة بواسطة الحداثة السياسية ذات المركزية الغربية. ويضيف، نسخة أكثر تطورا من هذا التوصيف ترى أن السبب المشترك للخلل المزدوج المدعى هو ضعف إرادة القوة لدى حاملي الحضارة الإسلامية، والذي أصبح ظاهرا في القدرة المحدودة للنقد الذاتي والإصلاح الذاتي: مقدمة لخضوعها للهيمنة الغربية منذ نهايات القرن الثامن عشر[37].
هذا التصور يرفضه سلفاتوري ويرى أن هذا التوصيف لعوامل توقف الحضارة الإسلامية يجب أن يعاد النظر فيه. ويتابع هودجسون في القول بأن مسار الحضارة الإسلامية كان أكثر "عالمية" من ذلك الذي قام على بناء حضارة فردية مهيمنة، هي الحضارة الغربية الحديثة، ويعتبر، من الزاوية عبر الحضارية، بناءا بدرجة أكبر. معتبراً أن الطريق الصحيح هو تحليل كل أشكال "العالمية" والذاتية في الحضارات المختلفة بدلا من مجرد إجراء مقارنة جامدة بين كتل حضارية. ويرى سلفاتوري، طبقا لهذا التصور، أن المقاومة المتكررة داخل الحضارة الإسلامية لعلمنة الهويات المؤسسية يجب أن تقيم على أنها رد فعل لتوجه حضاري معين بدلا من التفسير الغربي بأنه خلل حضاري يعبر عن فتور في إرادة القوة[38].
بنفس الرؤية تقريبا، يلخص "جوهان أرناسون" موقف الفكر الغربي الحديث من الحضارة الإسلامية. فيقول بأن الاعتقاد بأن التقاليد الإسلامية استبعدت أي تمييز بين الدين والسياسة لم يختف بعد من الخطاب العام، ولكن النقاشات الأكاديمية قد قضت عليه تماما؛ ويضيف أنه من المسلم به الآن بشكل واسع أن التاريخ الإسلامي انطبع المسارات التي تحقق هذا التمايز، دون أن تتطابق مع تلك الخاصة بالحضارات الأخرى ولا يمكن ردها إلى درجة أقل من نفس الديناميكية. في مسار الفتح الإسلامي الأول، يضيف أرناسون، التقاليد والآليات الأكثر قدما للحكم الإمبراطوري تم دمجها في النظام الجديد، واكتسب الفضاء السياسي، بذلك، أشكالا ومعاني أجنبية بالنسبة للرؤية الدينية الأصلية للفاتحين. في نفس الوقت، تطور الإطار الديني بطرق مؤدية إلى نوع معين من الاستقلال للحياة الاجتماعية ولشروط السيطرة السياسية عليها[39].
بعد هذا التوصيف المبدئي لاختلاف الحضارة الإسلامية عن الحضارة الغربية الحديثة يضع سلفاتوري هذه الحضارة في قلب علم التحليل الحضاري، ويرى أن دراسة دينامياته من شأنها تثري النظرية الاجتماعية. ويبين أنه، في إطار استخدام أدوات علم الاجتماع التاريخي المقارن في التحليل الحضاري، إذا أخذنا في الاعتبار خصوصية الإسلام بطرق تتعالى بشكل جزئي على المقاربات المقارنة الصارمة، يمكن أن تظهر المفاهيم المفتاحية في النظرية الاجتماعية في ضوء جديد: لا تبدو فيه خاضعة فقط للتدقيق في نقد الحداثة الأكثر حضورا في ديناميات الحضارة الغربية، ولكنها تكتسب مزيدا من الإشكاليات، التعقيد، وتزداد غنى من خلال منظور إسلامي للعلاقات المتبادلة للثقافة والسلطة، والتي تشكل المعادلات التحليلية الأساسية للتحليل الحضاري. الاختلاف الإسلامي المزعوم يمكن أن يظهر بأنه متجذر في "معيارية" دينامياته الكونية، مستثمرا الثقافة في صور متوسعة ذات مشروعية وسطية للسلطة[40].
في إطار النظرية الحضارية التي ترتكز على فكرة إيزنشتادت عن العصر المحوري (Axial age) يستعرض سلفاتوري العلاقة بين الحضارة الإسلامية والحضارات السابقة عليه. فيبين أن الإسلام كحضارة تخص المركب الحضاري "الأفرو-أورو-أسيوي" يقدم حالة مفتاح لفكر الفضاء الكوني عبر الحضاري.
يسمى "مارشال هودجسون"، طبقا لسلفاتوري، هذا الفضاء الكوني "عالم الإسلام" (Islam dom) ويصفه بأنه حضارة فريدة من نوعها، والتي ورثت وركبت بشكل مبدع السمات الثقافية والخصوصيات السياسية لوحدة ثقافية-جغرافية ضخمة وقديمة: عالم "الحضارة الإيرانية-السامية "ما بعد المسمارية" بما يشمله من تقاليد ترتكز على النبوة في غالبيتها قائمة على البلدات الصغيرة والتي تميل نحو التجارة.
ويضيف، نابعة من ومحافظة على مركز جاذبيتها الرئيسي في هذه المنطقة، أعاد الإسلام تركيب وأعطى قوة دافعة غير مسبوقة لتراث عدد من المكونات الحضارية وعلى وجه الخصوص الميل نحو الأممية وإلى درجة كبيرة المساواتية للتقاليد الإيرانية-السامية. أعطاها إمكانيات جديدة عبر-حضارية بواسطة استثمار هذا الميل نحو التوسع في أعماق نصف الكرة الأرضية "الأفرو-أورأسيوي" (العالم القديم)[41].
انطلاقا من هذا الوضع المميز للحضارة الإسلامية يقدم سلفاتوري تحليلا تفصيليا للكيفية التي يجب أن يتموضع بها عالم الإسلام في فكر الحداثة. هذه التحليلات ترتكز على أعمال مفكرين آخرين مؤسسين للتحليل الحضاري من أمثال أيزنشتادت، جوهان ارناسون، مارشال هودجسون وريمي براغ، ولا تقدم سوى مبادئ وتصورات عامة تحتاج إلى المزيد من العمل حتى تصل إلى تصور متكامل عن تموضع عالم الإسلام في التطور الحضاري المعاصر.
يرى سلفاتوري أن هناك حاليا استرتيجيتان أساسيتان لتحقيق معايير أكثر عدلا للتعامل مع الحضارة الإسلامية. الأولى هي مقاربة أيزنشتادت التي تعيد تأطير الحداثة في إطار "تعدد الحداثات". والثانية هي مسار مواز يشدد على إمكانية التنظير حول البعد الدينامي للتقاليد قبل تحليل أنماط الحداثة. ويرى أن كلا الاستراتيجيتان يمكن أن توفرا أسسا نظرية لمنظور هودجسون للإسلام على أنه فضاء كوني عبر-حضاري متفرد يخلط بشكل أصيل المكونات الأساسية "للشرق" و"الغرب" أكثر منه كحضارة متميزة ومدمجة مثل أوروبا الغربية، الهند أو الصين. ويضيف أن التقاليد، مع دينامياتها، خلافاتها الداخلية والتفاعل المشترك، تراكباتها وأحيانا اندماجها، تمثل البعد الثقافي للحضارات. ويبين أنه في سياق دراسته لعالم الإسلام، طور هودجسون نقده للتصور التافه للتقاليد الذي كان شائعا خلال دوائر نظرية التحديث. ضد النظرات ذات البعد الواحد للتحديث أكد على الفعل الخلاق والتفاعل التراكمي كسمات أساسية للتقاليد[42].
وفي مقارنة تحليلية طويلة يرى سلفاتوري متابعا "ريمي براغ" أن الفرق بين الحضارتين الغربية والإسلامية يعود في النهاية إلى الانحراف في نوع من الأعراض التي تقوم بترجمة الثقافة إلى سلطة وشرعنتها. ويبين أن عالم الإسلام ينحرف عن القاعدة التي تجسدت في المعايير الحضارية التي حملتها أوروبا الغربية، ولكن أوروبا هي التي انحرفت عن المسار الأكثر خطية بكثير عن الإسلام، والذي يعكس تركيبا أكثر تناغما وأقل اضطرابا، وإن يكن أصلي، للموروث العبري مع التراث اليوناني، الذي تم امتصاصه بحماس بواسطة الفلاسفة المسلمين والدارسين الآخرين[43].
يُبرز سلفاتوري نقلا عن براغ، كيف أن الإسلام قد أحدث بعثا تركيبيا جديدا لكل تلك السمات الخاصة بمصادر العصر المحوري التي روجت لتوجه إنساني نحو "الخير المشترك"، وأشاعها عبر فضاء عالمي واسع يمتد ما بين أوروبا، شمال أفريقيا، الشرق الأدنى والأوسط ومناطق شاسعة أخرى. الكلمة كما تظهر في القرآن تصبح لحظة تحرير بفضل قدرتها على الكشف وسلطتها المعيارية، أكثر منها بواسطة وضع دينامية أخروية في حالة حركة. في هذا الإيمان الجديد، يقتضي التمثل الداخلي لأوامر القانون الإلهي "الشريعة"، القليل من التوسط الذي يتيسر في الغالب من خلال الميل نحو تمثل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه التحليلات المعتمدة على النظرية الحضارية، والتي تضع التطور الحضاري لعالم الإسلام في صورة أكثر اتساقا مع تطور الحضارة الإنسانية وفي صورة أكثر تعقيدا وغنى من الصورة "العلمانية" الغربية التقليدية تمثل خطوة مهمة نحو الهدف المطلوب. ذلك أنه يمكننا البناء على هذه التصورات التي تجعل الحضارة الإسلامية تاريخيا جزءا جوهريا من التطور الحضاري الإنساني.
4. الثقافة العربية الحديثة في إطار تعدد الحداثات
أدبيات التحليل الحضاري، كما تبين أعلاه، تؤسس للتعدد الحضاري/الثقافي بخصوص الصورة المعاصرة للحداثة الإنسانية. فإذا كانت عملية التأسيس هذه تتمثل في نظرية حضارية إنسانية عامة، فإن عملية تأسيس الحداثة في حضارة/ثقافة معينة في الواقع المعاصر يجب أن تقوم على أساس فكر نابع من المجتمع نفسه. بمعنى آخر، تمنحنا النظرية الحضارية فقط الإمكانية النظرية لتقديم تصوراتنا الخاصة.
ففي ظل النظرية الحضارية تصبح لدينا الأدوات النظرية اللازمة لمواجهة المفهوم الحداثي المعاصر المرتكز على المركزية الغربية، وهو مفهوم العولمة. كما تعطينا الأدوات النظرية لمواجهة التصورات الجزئية النابعة منه، مثل الفصل بين الخلفيات الحضارية/الثقافية وبين عملية الحداثة، كما يظهر ذلك عمليا في فرض المفهوم الغربي للعلمنة ولفرض النظرية الليبرالية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وفيما يخص المجتمعات العربية المعاصرة (التي تنتمي إلى الحضارة العربية/الإسلامية التاريخية) تصبح نتائج التحليل الحضاري المتعلقة بموضعة الحضارة الإسلامية في التاريخ الحضاري مضافا إليها مبدأ ومنهج الفصل والوصل، الذي سبق لنا تقديمه في أعمال أخرى، أدوات كافية لتحقيق حداثة عربية معاصرة كجزء من الفكر الإنساني المعاصر.
في هذا الإطار العام يجب أن ننظر إلى الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة في إطار عالم اليوم المتعدد الحداثات. فالثقافة العربية الإسلامية المعاصرة لها سمات ثقافية متميزة ومسار تاريخي معين للتطور لا يزال مؤثرا بقوة في تطور مجتمعاتها في عالم اليوم. هذه السمات المتميزة تاريخيا ليست، كما ظهر في استعراضنا أعلاه، متخلفة عن العصر، وإنما هي متميزة من زوايا معينة تجعلها أكثر راهنية من حيث علاقات السلطة بالثقافة.
من هذا المنطلق يجب أن نعالج قضية إعمار الكون من خلال التأسيس للنهضة العربية الإسلامية الحديثة. فالهدف هو تحقيق تحول المجتمعات العربية (والإسلامية) المعاصرة لتغدو مجتمعات حديثة. ولكن هذه الحداثة ليست متطابقة فكريا أو نظريا مع فكر الحداثة الغربية المعتمد على المركزية الأوروبية. ففي ظل الحداثة متعددة الثقافات يصبح ممكنا للفكر العربي المعاصر أن يطرح مساره الخاص نحو الحداثة معتمدا على استمرار مساره التاريخي ولكن في تواصل مع ما خَلُصَ إليه الفكر الإنساني المعاصر. ولسوف تكون نقطة الانطلاق هي تحديد طبيعة النظرة العربية المعاصرة إلى العالم، ثم البناء عليها من أجل التأسيس لحداثة عربية معاصرة غير منقطعة عن تاريخها الطويل ولا عن ما وصل إليه الفكر الإنساني المعاصر، ولكنها في ذات الوقت مستقلة عنهما تعكس إبداعها الخاص في عصرها الحديث.
ومن أجل تأسيس الحداثة العربية الإسلامية على نظرتها إلى العالم في اتساق مع الحضارة الإنسانية المعاصرة نحتاج أولا إلى الارتكاز على المنهج الملائم للمرحلة المعاصرة للحداثة، والذي يتسم بسمتين أساسيتين، هما: معارضة الفصل بين الذات والموضوع، ومعارضة المركزية الأوروبية. ونحتاج ثانيا إلى الارتكاز على مبادئ نظرة المجتمعات الإسلامية إلى العالم وتحويلها إلى آليات منهجية تحول هذه المبادئ إلى الواقع العملي.
رابعا: شروط التوفيق بين مفهومي "الإعمار" و"الحضارة"
في فلسفة الحضارة، بحسب دراسة "كارول كويجلي" الهامة "تطور الحضارات"، تمر الحضارات بسبعة مراحل تبدأ بمراحل التأسيس (الظهور ثم التكون) ثم مراحل النضوج (التوسع ثم الصراع ثم الإمبراطورية) ثم مراحل الانحدار (التحلل ثم الغزو). وهناك نوعين من الحضارات. أحدهما حينما يصل إلى دور النهاية يموت ويندثر ولا يستطيع أن يتجدد. أما الثاني تمر فيه الحضارة بالمراحل المتتالية ولكنها حينما تصل إلى المرحلة الأخيرة يمكنها أن تتجدد مرة أخرى فتعود إلى المرحلة الثالثة لتبدأ طورا جديدا من النمو والازدهار. ولكن، بحسب كويجلي، هذا التجدد مشروط بقدرة الحضارة على تقديم تصورات جديدة بشكل كلي تستطيع أن تتعامل بنجاح مع الواقع الجديد والتغلب على المشكلات السابقة التي أدت إلى دخولها في دور الانحلال[44].
طبقا لهذا التصور فإن تجدد الحضارة العربية الإسلامية في عصرنا الحالي مرتبط ارتباطا مباشرا بقدرتها على تقديم تصورات جديدة بشكل كلي للقضايا المعاصرة بشكل يمكنها من أن تتعامل بنجاح مع الواقع المعاصر والتغلب على المشكلات القديمة التي أدت إلى دخولها دور الانحلال. في هذا القسم نطرح تصورنا في ضوء تحليلاتنا أعلاه لشروط نجاح فكر النهضة في تحقيق التجدد الحضاري للمجتمعات الإسلامية.
وهذه الشروط هي شروط موضوعية ناتجة عن استخلاص الدروس من التجارب الإنسانية الناجحة في تحقيق نهضة مجتمعية شاملة، وناتجة أيضا عن تصوراتنا عن كيفية تحقيق الاتساق بين المفهوم الإسلامي للنهضة المجتمعية والمفهوم الإنساني لها. وهي شروط يجب أن تتوفر في أي فكر يمكن اعتباره جزءا من الفكر المؤسس للنهضة العربية الإسلامية المعاصرة التي يتحقق فيها الاتساق بين مفهومها "الإسلامي" للإعمار والمفهوم الإنساني للحضارة. وهي كذلك شروط فكرية تكفل تحقق الآليات الحضارية اللازمة للربط ما بين المبادئ والقيم العامة "الإسلامية"، وبين الأهداف والغايات اللازم تحققها في أرض الواقع، ويمكن انطلاقا منها وضع المبادئ العامة التي تميز فكر النهضة العربية الإسلامية المعاصر.
وتتلخص هذه الشروط في نوعين من المبادئ: النوع الأول؛ هو مبادئ عامة "خارجية" بالنسبة لهذا الفكر تتعلق بعلاقته بالذات، وبالفكر الإنساني على العموم، وبالمبدأ العام الشامل الذي يجب أن يخضع له هذا الفكر بكافة تجلياته. والنوع الثاني؛ هو مبادئ عامة ولكنها موضوعية تخص طبيعة الفكر ذاته وتتعلق بتصوراتنا العمومية عن طبيعة الإنسان وحدود قدرته على التعقل، وطبيعة العالم أو الوجود ككل، ثم طبيعة العلاقات بين الموجودات.
مبادئ النوع الأول، والتي هي مبادئ أساسية ثلاثة عامة وخارجية بالنسبة للفكر التأسيسي للنهضة: الأول؛ هو عدم التناقض مع النظرة العربية الإسلامية المعاصرة إلى العالم كما هي مستقرة في اللاوعي المجتمعي حاليا. لأن أي فكر يتناقض مع هذه النظرة لن يتمكن من التجذر في المجتمع وبالتالي يصبح غير قادر على تحقيق النهضة. والثاني؛ هو أن يكون هذا الفكر إنسانيا عاما يهم كل إنسان بما هو إنسان وليس فكرا خاصا بالمجتمعات العربية والإسلامية فقط.
وذلك لأن القضايا الخاصة بالمجتمعات العربية والإسلامية تعد في نهاية الأمر حالات خاصة من قضايا المجتمع الإنساني على العموم. لذا فإن أي فكر عربي (وإسلامي) معاصر يلزم أن يحمل بعدا إنسانيا مجردا، وأن يتفاعل موضوعيا سواء بالنقد أو بالتدعيم مع الأطروحات الموجودة في الأدبيات المعاصرة حتى يصبح جزءا من الفكر الإنساني المعاصر. والفكر العربي الذي يطرح خاليا من هذا البعد الإنساني لن يكون فكرا إنسانيا أصيلا، وبالتالي لن يكون قادرا على التأسيس للنهضة بشكل حقيقي.
أما المبدأ الثالث؛ فهو اعتماد مبدأ الفصل والوصل على العموم كمبدأ فكري عام. فليس هناك فصل تام بين القضايا والمجالات الفكرية المختلفة، وإنما هناك درجات من الفصل ودرجات من الوصل. ولأن المنهج الأساسي في الحضارة العربية الإسلامية هو منهج الفصل والوصل، فإن اعتماد هذا المنهج سوف يؤدي بشكل تلقائي للتوافق بين الفكر العربي المعاصر والتراث العربي الإسلامي القديم، من ناحية، والتوافق بينه وبين الفكر الإنساني المعاصر، من ناحية أخرى. وهذا ينتج تصورا في القضايا الجوهرية للنهضة مثل قضايا السياسة والحكم، وقضايا الحريات وحقوق الإنسان، متوافقة مع نظرتنا العربية الإسلامية إلى العالم، من ناحية، ومع التطورات الفكرية والحضارية الإنسانية المعاصرة، من ناحية أخرى.
مبادئ النوع الثاني، والتي هي مبادئ موضوعية ثلاثة ناتجة عن مبادئ النوع الأول: الأول؛ هو مبدأ حدود العقل، فالعقل لا يمتلك القدرة المطلقة سواء في إدراك العالم الموضوعي أو إدراك الجوانب الذاتية والأخلاقية للإنسان. وهذا المبدأ يحفظ المبادئ الأساسية الأخلاقية للنظرة العربية الإسلامية إلى العالم. الثاني؛ هو مبدأ اللاحتمية، فالعالم ليس حتمي ولا يتطور بشكل خطي بسيط ولا يمكن التنبؤ بمستقبله مسبقا. وهذا يجعل الاتساق بين العقل العربي والإسلامي والعلم الإنساني المعاصر ممكنا، وبالتالي يجعل مشاركتنا في النهضة العلمية الإنسانية ممكنة. أما المبدأ الثالث؛ فهو مبدأ الكلية/الجزئية، فالنظر إلى العالم ومعالجة القضايا المختلفة يجب أن يتم في إطار رؤية أو نظرة كلية وفي نفس الوقت من خلال معالجة الجزئيات التي ترتبط مع بعضها البعض في علاقات متبادلة تنتج في مجموعها الكل. وهذا المبدأ يؤدي إلى التخلي عن التفسير الحرفي للنصوص الإسلامية، من ناحية، والفهم الحرفي لفكر الحداثة، من ناحية أخرى لصالح الاعتماد على فهم كلي مقاصدي لنصوص التراث، وفهم إنساني متعدد الثقافات للحداثة الإنسانية المعاصرة.
هذه المبادئ في مجموعها تمثل الشروط التي يجب أن يلتزم بها أي فكر يمكن اعتباره جزءا من الفكر المؤسس للنهضة العربية الإسلامية المعاصرة. بعد ذلك يمكن للتصورات والاتجاهات المختلفة التي تقع في إطارها أن تقدم تصورات عديدة مختلفة لكافة القضايا الفكرية المعروفة نظريا وعمليا وتعد، بذلك، ضمن الفكر التأسيسي للنهضة العربية الإسلامية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المبادئ في مجموعها تكفل تخطي الانقسام السائد اليوم بين أنصار فكر الحداثة وأنصار الفكر الإسلامي، بغض النظر عن التجاء كليهما بدرجات متفاوتة إلى صور متباينة من التوفيقية. فاعتماد منهج الفصل والوصل والالتزام بعدم التناقض مع النظرة العربية الإسلامية يفتح المجال واسعا أمام الفكر الإنساني للتفاعل مع فكرنا المعاصر. وذلك لأن جوهر مشكلة الانقسام هي في التناقض بين بعض التصورات المقدمة من الجانبين مع بعضهما البعض.
ولأن جوانب عديدة من الفكر من الجانبين ليست ضرورية لتحقيق النهضة فإن جعل نقطة البدء هي عدم التناقض يؤدي تلقائيا إلى تجنب الخلافات المترتبة على هذه التصورات. فكل التصورات الإنسانية بما فيها التصورات الحداثية مقبولة في حدود عدم التناقض مع نظرة الذات. وبذلك نضمن الاستمرارية في الفكر وعدم ممانعة الذات في التحول نحو الحداثة. كما أنه على الجانب الآخر فإن أي فكر يوصف بأنه "إسلامي"؛ أي معتمد في المقام الأول على التراث والتقليد يجب أن يطرح باعتباره فكرا إنسانيا في المقام الأول، يهم الإنسان بما هو إنسان.
وبذلك نضمن عدم التناقض مع الفكر الإنساني، أو الانعزال عنه بدعوى الخصوصية، وما يترتب علي ذلك من خسارة الاستفادة من الخبرة الإنسانية عبر التاريخ. فهذين المبدأين في حقيقة الأمر يضمنان التوافق مع نظرتنا إلى العالم "الذات" ومع الفكر الإنساني "الآخر"، في ذات الوقت، وبالتالي يضمنان إزالة عوائق التحول نحو الحداثة.
إضافة إلى ذلك فإن الاعتماد على منهج الفصل والوصل يؤدي بسهولة إلى حل التناقضات التي يمكن أن توجد بين الجانبين بشكل إبداعي جديد يعبر عن الذات المعاصرة. وبالتالي سوف تنحسر مشكلة الانقسام في حدود الاتجاهات التي يمكن وصفها بالمتطرفة أو المتشددة من الجانبين؛ ذلك الذي وقف عند حدود فكر الحداثة المادي الحتمي الذي أصبح تقليديا، وذلك الذي يلتزم بالتقليد الحرفي للفكر الإسلامي القديم. وهو ما سيترك مساحة واسعة للتقدم والإبداع في الفكر العربي المعاصر.
ويجب الإشارة أيضا إلى أن مفهوم "النظرة العربية إلى العالم" مفهوم يحتمل تعدد وجهات النظر في جوانب ثانوية منه. ولكنه لا يحتمل هذا التعدد في الجوانب الأساسية مثل الاعتقاد في وجود الله أو في وجود حدود للعقل الإنساني أو في أولوية الأخلاق على التقدم المادي. لذلك سوف يمكن أن توجد صور مختلفة بشكل ثانوي لهذه النظرة في المجتمعات الإسلامية المختلفة (أو ذات الأغلبية المسلمة كما هي حالة المجتمعات العربية المعاصرة)، وهو ما سيؤثر على نتيجة تجربتها في التحول إلى الحداثة وبالتالي يظهر الاختلاف الجزئي في نتائج هذه التجارب الإسلامية المتعددة.
باختصار تطبيق هذه المبادئ سواء على المستوى الفردي في المجتمعات العربية والإسلامية، أو على مستوى المجتمع ككل، يضمن لنا تحقيق الواجب الديني في "إعمار الكون"، وفي نفس الوقت المشاركة الإيجابية في تطور الحضارة الإنسانية المعاصرة.
خاتمة
طرحنا في هذا العمل قضية نهضة المجتمعات العربية والإسلامية باعتبارها قضية دينية ترتبط بمفهوم "إعمار الأرض" من ناحية، وباعتبارها قضية إنسانية ترتبط بمفهوم التطور الحضاري من ناحية أخرى، وبينا أن تحقيق الهدف، المتمثل في النهضة، يرتبط بقدرتنا على تحقيق الاتساق بين هذين المفهومين، بحيث يمكن الارتكاز على الفكر الإنساني المعاصر ومفهومه للحضارة والآليات المرتبطة به لتحقيق المبادئ والقيم والغايات التي ترتكز عليها النظرة الإسلامية إلى العالم المستمدة من القرآن الكريم.
لتحقيق هذا الهدف لزم تقديم استعراض موجز لكل من هذين المفهومين وللأسلوب الأسلم لتحقيق الاتساق بينهما. في القسم الثاني استعرضنا من خلال بعض الأدبيات الإسلامية المعاصرة مفهوم إعمار الأرض وكيف يرتبط بمفهوم الحضارة فيما سمي بمشروع "الإسلام الحضاري". وبينا أن هذا المشروع يفتقر للارتباط الحقيقي لمفهوم الحضارة بالمعنى الإنساني وبالآليات الإنسانية الطبيعية لنشأة وظهور وتطور الحضارات. لذلك قمنا في القسم الثالث باستعراض موجز لمفهوم الحضارة انطلاقا من الأدبيات الإنسانية الحديثة والمعاصرة وارتباطه بمفهوم الثقافة، وبينا كيف يمكن أن يتحرر مفهوم الحضارة من ارتباطه بالحداثة الغربية. في القسم الرابع بينا كيف يمكن أن يوضع تصور لتعدد الحضارات والثقافات في إطار الفكر الإسلامي، وكيف يمكن وضع الحضارة الإسلامية في إطار التطور الحضاري الإنساني، واستعرضنا بعض الأدبيات الغربية التي تؤسس لهذا التصور. وهذا يمهد للقضية الأساسية التي نطرحها؛ وهي الاتساق بين المفهوم الإسلامي للنهضة، المتمثل في إعمار الكون، والمفهوم الإنساني له، كما يعكسه مفهوم الحضارة.
في القسم الخامس قدمنا، انطلاقا من الأدبيات التي تم استعراضها ومن أعمالنا السابقة، تصورنا للشروط التي يمكن أن تحقق الاتساق المطلوب بين مفهومي إعمار الكون، والحضارة، والمبادئ والأسس التي يجب أن يرتكز عليها أي فكر عربي وإسلامي يهدف إلى تحقيق النهضة انطلاقا من هذه المبادئ.
الهوامش
[1]. زياد خليل الدغمائي، "إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي"، تحرير: فتحي حسن ملكاوي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مجلة إسلامية المعرفة العدد 54 ، (1429ﻫ/2008م)، ص23-62.
[2]. المصدر نفسه، ص23.
[3]. المصدر نفسه، ص24.
[4]. زياد خليل الدغمائي، "إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي"، م، س، ص32.
[5]. المصدر نفسه، ص35.
[6]. المصدر نفسه، ص36.
[7]. المصدر نفسه، ص36-39.
[8]. المصدر نفسه، ص39-51.
[9]. المصدر نفسه، ص51-60.
[10]. سانو، قطب مصطفى، "مشروع الإسلام الحضاري: المفهوم والغايات والمرتكزات: رؤية نقدية"، مجلة إسلامية المعرفة، تحرير: فتحي حسن ملكاوي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد 55، (1430ﻫ/2009م)، ص11-46.
[11]. المصدر نفسه، ص11.
[12]. المصدر نفسه، ص12.
[13]. المصدر نفسه، ص15-16.
[14]. المصدر نفسه، ص16.
[15]. المصدر نفسه، ص17.
[16]. المصدر نفسه، ص18.
[17]. المصدر نفسه، ص19.
[18]. المصدر نفسه، ص20.
[19]. المصدر نفسه، ص21.
[20]. المصدر نفسه، ص22.
[21]. المصدر نفسه، ص23-25.
[22]. المصدر نفسه، ص33-43.
[23]. Mazlish, Bruce, Civilization in a Historical and Global Perspective, International Sociology , V. 16, 2001, p. 293.
[24]. Szakolczai, Arpad, Civilization and its Sources, International Sociology;V. 16, 2001, P. 369–386.
[25]. Ibid, p.369-370.
[26]. Robertson, Roland, "Civilization", Theory, Culture & Society, 2006, Vol. 23(2–3): 421.
[27]. Arnason, Johann, "Civilizational Patterns and Civilizing Processes", International Sociology, 2001, V. 16; p. 387-405
[28]. Ibid, p.387.
[29]. Ibid, p.388.
[30]. Mazlish, Bruce, Civilization in a Historical and Global Perspective, International Sociology, 2001, V. 16; p. 293–300.
[31]. Ibid, p.295.
[32]. Schäfer, Wolf, "Global Civilization and Local Cultures: A Crude Look at the Whole", International Sociology, 2001, ; V. 16; p. 301- 319.
[33]. Ibid, p.301.
[34]. Ibid, p.302.
[35]. انظر استعراضنا لمبدأ ومنهج الفصل والوصل باعتباره المبدأ الأساسي في الحضارة/الثقافة العربية الإسلامية في عملنا: سمير أبو زيد، سمير، "العلم والنظرة العربية إلى العالم: التجربة العربية والتأسيس العلمي للنهضة"، الفصل السابع، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009، ص217-247.
[36]. Salvatore, Armando, "Repositioning 'Islamdom': The Culture -Power Syndrome within a Transcivilizational Ecumene", European Journal of Social Theory, 2010, V. 13(1), p. 99–115.
[37]. Ibid, p.100.
[38]. Ibid, p.101.
[39]. Arnason, Johann, "Civilizational Patterns and Civilizing Processes", op.cit, P.399.
[40]. Salvatore, Armando, 2010, " Repositioning 'Islamdom': The Culture -Power Syndrome within a Transcivilizational Ecumene", op.cit, p.99-100.
[41]. Ibid, p.100.
[42]. Ibid, p.101-102.
[43]. Ibid, p.104.
[44]. Quigley, Carroll, "The Evolution of Civilizations - An Introduction to Historical Analysis", 2nd ed., 1979, Liberty Press, p.146.