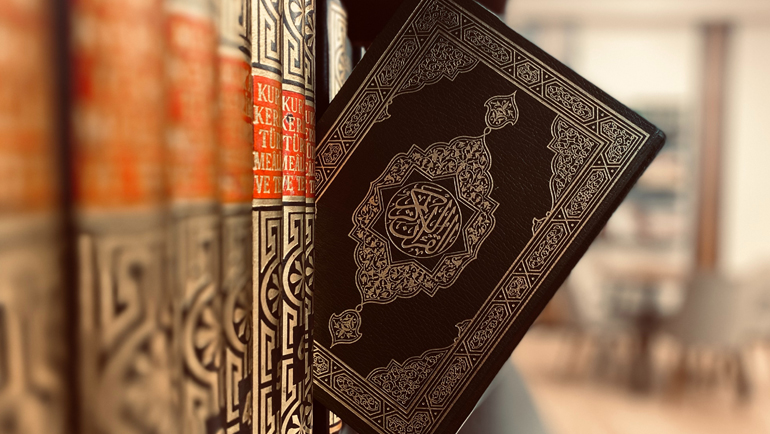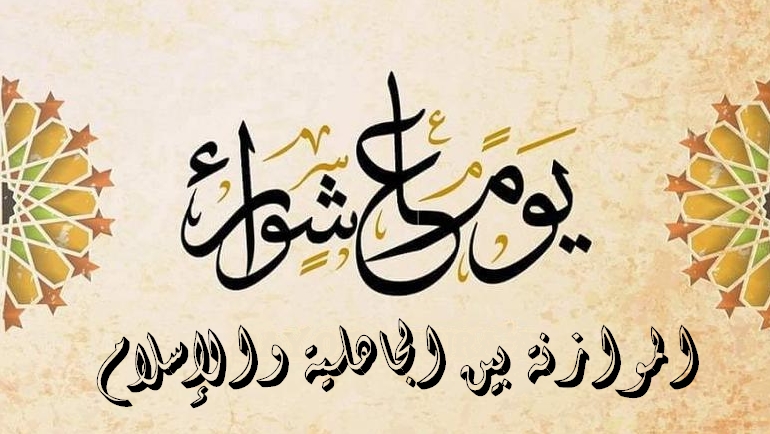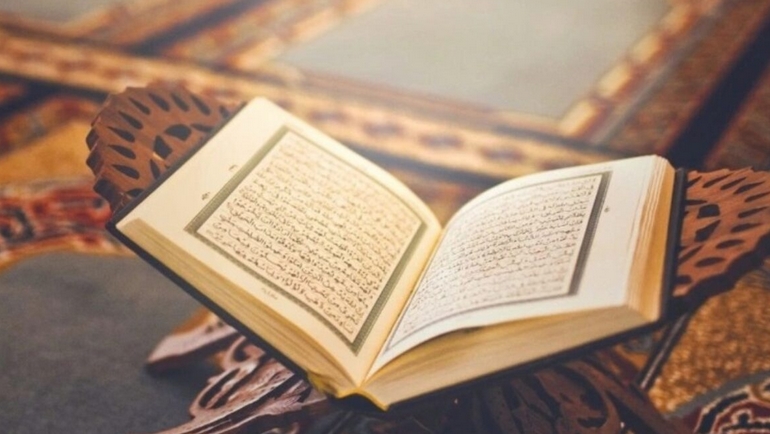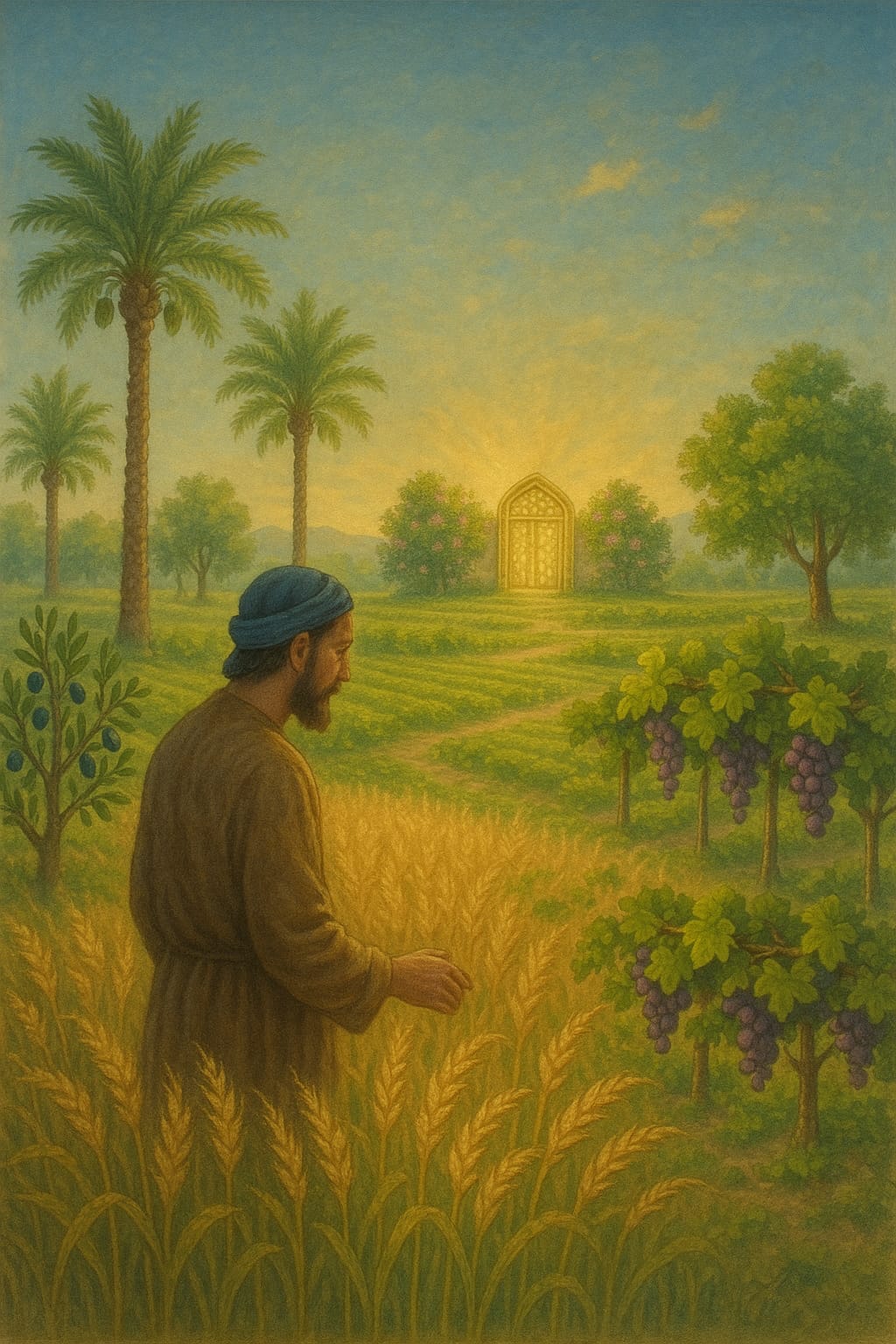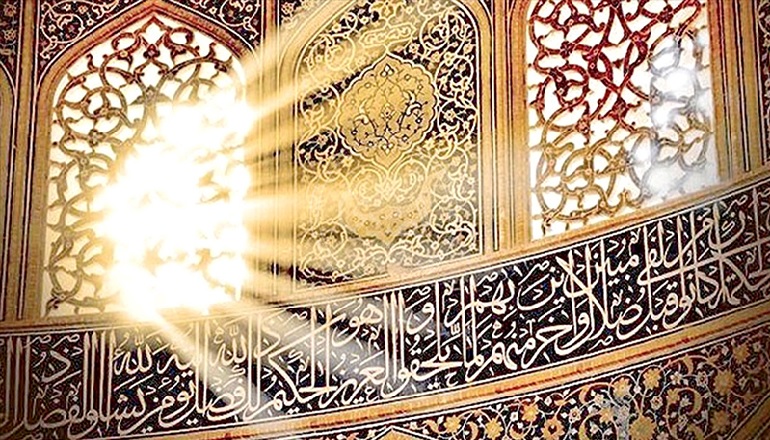من جهود علماء الغرب الإسلامي في توجيه متشابه الكتاب توجيه آيتين مقررتين لسعة علم الله

بسم الله الرحمن الرحيم
الأولى موضع يونس: وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ...
الثانية موضع سبأ: "عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ ...
إن مما يذكي جذوة المراقبة في القلوب، ويُعد النفوس لاستحضار عظمة علام الغيوب، تيقن العبد سعة علم الله، و أنه مطلع على ما دق أو عظُم من أمر خليقته، فلا تخفاه خافية، ولا يغيب عن علمه شيء، وأمر إحاطته بكل شيء وهيمنته على كل شيء أكبر خطرا من معرفة العبد بربه، وإن بلغ في المعرفة ما بلغ، وترقى في مدارج الكمال ما ترقى، فهو سبحانه العليم بكل ما وقع، وما يقع، وما قدر أنه سيقع، وما لم يقع إن وقع كيف كان يقع.. كل ذلك معلوم و مسطور قبل البدو، "وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ" [يس:12]، وإن من الآيات التي وردت مقررة لهذا المعنى آيتان سيقتا لنفس الغرض، تباينتا بالتقديم والتأخير، و اختلف وجههما الإعرابي مما جعلهما من متشابه الكتاب، الأولى في سورة يونس، "وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" [الآية:61]، والثانية في صدر سورة سبأ، "عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" [الآية:3].
فبظاهر النظر الآيتان معا تنفيان أن يند عن علم الله شيء، أو يغيب عن معرفته شيء، وذاك معنى العزوب، قال الطاهر ابن عاشور: "والعزوب: الخفاء. ومادته تحوم حول معاني البعد عن النظر، وفي مضارعه ضم العين وكسـرها "[1] قال في التاج: أَي: لا يَغِيب عن عِلْمِه شيءٌ[2] قال ابن سيده: "والعازِب والعَزيب: الغائب البعيد، وقد عزَب يعزُب عُزوباً ومنه تعزيب الراعي إبله؛ إنما هو بُعدُه بها عن البيوت."[3] وفيه لغتان: عزب يعزُب، وعزب يعزِب"[4]. إِذَا غَابَ، والجمهور على قراءة يعزب بضم الزاي، وانفرد الكسائي بكسـرها، قال أبو حاتم: "القراءة بالضم، والكسـر لغة"[5]، يريد أن القراءة المستفيضة بالضم، وقراءة الكسـر قليلة، ولا يضيرها قلتها، ما دامت الضوابط المرعية في القراءة حاصلة، قال الشاطبي:
750 ويعزبُ كسرُ الضمِّ مع سبأٍ رسا وأصغرَ فارفعه وأكبرَ فيصلا
قال الألوسي:"وفيه إشارة إلى طريق المراقبة، وحث على المحافظة، فإن المرء إذا علم يقينا اطلاع الله عليه فى كل آن، وحافظ على أوقاته سلم من الخلاف وعامل بالإنصاف[6]"
وفي أصغر وأكبر قراءتان؛ قراءة النصب وتوجيهها أنها معطوفة على ظاهر "مثقال" المجرور بمن المؤكدة، ومحلها الرفع على الفاعلية، وهي قراءة الجمهور كما سلف، ويمكن أن يكونا منصوبين على نفي الجنس بلا قبلهما وقد ارتضى هذا التوجيه الزمخشري. وقرأ حمزة برفعهما على الاستئناف، قال: "الوجه في القراءة بالنصب في قوله: (ولا أصغر من ذلك) الحمل على نفي الجنس، والرفع على الابتداء ليكون كلاما برأسه ".[7]
ومثقال الشيء ما يساويه في الثقل، والذَّرة صغار النمل جمعه ذَرٌّ، وخاطبهم القرآن بما يَعدونه أصغرَ شيء في الوجود، ثم استدرك بقوله: "ولا أصغر من ذلك ولا أكبر." بما يمكن أن تتوصل إليه البشرية مما يكشفه العلم الحديث، وإذا كان ذلك علمه بصغر الأشياء فكيف بكبيرها؟
وجاءت آية سبأ مقررة لنفس الغرض، إلا أن النفي فيها جاء ب "لا" النافية، بدل "ما"، و جاءت بتقديم السماوات على الأرض بصيغة الجمع بدل الإفراد، فقال تعالى: "عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" [الآية:3]، ولتقريب ضبط الآيتين لصغار الطلبة -ممن لم يتزودوا من قواعد العربية- وضع المحفظون نصوصا مسعفة لضبط كيفية أداء مقرإ نافع من طريق الأزرق الذي يقرأ به في المغرب، وذلك بالتنصيص على نصب أصغر وأكبر في موضع يونس، وضمهما في موضع سبأ، على أن مما يلفت انتباه المتمعن في الذكر هو البحث عن وجه تقديم الأرض في موضع يونس وتأخيرها في موضع سبأ، وممن أثاره هذا السبك الزمخشري (467هـ) فقال:"فإن قلت: لم قدّمت الأرض على السماء، بخلاف قوله في سورة سبأ عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ؟ قلت: حق السماء أن تقدم على الأرض، ولكنه لما ذكر شهادته على شئون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم، ووصل بذلك قوله لا يَعْزُبُ عَنْهُ لاءم ذلك أن قدَّم الأرض على السماء، على أنّ العطف بالواو حكمه حكم التثنية."[8]
وبمثل تعليله البيضاوي وجَّه ( 685هـ) تباينهما فقال: "وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها، والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها [9]".
وذاك الذي ارتضاه أبو حيان (745هـ) في معرض وقوفه على أسرار الكتاب فقال: "ولما ذكر شهادته تعالى على أعمال الخلق ناسب تقديم الأرض الذي هي محل المخاطبين على السماء، بخلاف ما في سورة سبأ، وإن كان الأكثر تقديمها على الأرض"[10].
و ذكر ابن الزبير الغرناطي توجيها لطيفا لذلك، أُورده مع توجيه الآيتين السابقتين، وقد ذَكَر معهما الآية الثانية من سورة سبأ، " قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ" [سبأ:22]، وإنما عدلت عن إيرادها لخلوها عن مصطلح العزوب، الذي اشتملت عليه الآيتين الأوليين، قال رحمه الله:
"الآية الثامنة من سورة يونس: قوله تعالى: " وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ " [الآية:61] وفي سورة سبأ: " عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ " [الآية:3] وقال فيما بعد: " قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ [الآية:22] للسائل أن يسأل عن تقديم الأرض على السماء في سورة يونس وعكس ذلك فى الموضعين من سورة سبأ؟
والجواب عن ذلك والله أعلم: أن آية يونس مقصود فيها من تأكيد الاستيفاء والاستغراق ما لم يقصد في الأخريين، وإن كان العموم مرادا في الجميع إلا أن آية يونس قضت بزيادة التأكيد ولذلك تكررت فيها مع ما قبلها ما النافية المتلقى بها القسم في قوله: " وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا " [الآية:61] فقوي بذلك قصد تأكيد الاستغراق وتضمين الكلام معنى القسم فقال تعالى: "" وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ " بزيادة مِن في الفاعل، وهي مقتضية معنى الاستغراق في مثل هذا، وبناؤها على ما المتلقى بها القسم بفهم ما قلناه من معنى القسم وتأكيد الاستغراق، بل أقول: إن "مِن " في مثل هذا نص فى ذلك.
قال سيبويه رحمه الله: "إذا قلت: ما أتانى رجل، فإنه يحتمل ثلاثة معان؛ أحدها: أن تريد أنه ما أتاك رجل واحد بل أتاك أكثر من واحد، والثاني: ما أتاك رجل في قوته ونفاذه، بل أتاك الضعفاء، والثالث: أن تريد ما أتاك رجل واحد ولا أكثر من ذلك، فإن قلت: ما أتاني من رجل كان نفيا لذلك كله " هذا معنى كلامه، والحاصل منه أن "مِن " في سياق النفي تعم وتستغرق.
ثم إنه قد تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ " فدخول "من " في المفعول في الموضعين من قوله: " وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ " فزيدت في المفعول وهو اسم نكرة وارد في سياق النفي، وذلك محصِّل للاستغراق، ثم حمل عليه قوله تعالى: " وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ... " الآية، فناسب هذا تقديم ذكر الأرض على السماء؛ لأن السماء مصعد الأمر، ومحل العلو، ومسكن الملائكة؛ وهي مشاهدة لهم، ومستقبل الداعين، منها ينزل الأمر، ورزق العباد، وفيها الخزنة من الملائكة، وإليها يصعد بأرواح المؤمنين، ويعرج الملائكة السياحون في الأرض؛ المسؤولون عن أفعال العباد، فكان العلم بما فيها أجلى وأظهر، وكان العلم بما في الأرض أخفى، وهذا بالنظر إلينا، وبحسب متعارف أحوالنا، وإلا فعلم بارينا سبحانه بما في الأرض وما في السماء على حد سواء، كما أن علمه بالسر والجهر مستو، "سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ " [الرعد:10] ولكنا إنما خوطبنا على أحوالنا، وبما نتعاهده ونتعارفه من المعانى والصفات، ولذلك ورد فى القرآن التعجب والدعاء والترجى وغير ذلك.. فخوطب العباد بما يتعارفون ويألفون فيما بينهم.
فهذا بيان ما تقدم.
فلما كانت الأرض بالنسبة إلى اسمها فيما ذكرنا كان أمرها أخفى، وكان أمر السماء أوضح وأقرب، من حيث ذكرنا خوطب الخلق على ذلك، فقدم ذكر ما هو عندنا كافة أخفى، فقيل عند قصد المبالغة في تأكيد الاستغراق والقسم على ذلك: " وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ " ونظير هذا الوارد هنا قوله تعالى: " رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ [إبراهيم:38] " وهذه الآية في الذي تعطيه من إفهام القسم والاستغراق والابتداء بما هو عندنا أخفى كآية يونس من غير فرق، وعلمُه سبحانه بما خفيَ عندنا أو ظهر سواء، تعالى ربنا عن شبه الخليقة.
فإن قيل: فإن قوله سبحانه: " وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ " [النمل:85] قد اجتمع فيه زيادة من الاستغراقية بعد ما النافية المشيرة إلى معنى القسم كما في الآيتين، وقد تقدم فيه ذكر السماء بخلاف ما في الآيتين؟ قلت: لما تقدم هذا قوله تعالى: "وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ " [الآية:75] وقد تقدم في سبأ إحراز التسوية من غير فرق، فقدم ذكر السماء، وإنما كانت تكون كالآيتين لو لم يتقدمها ما ذكر، وإذ قد تبين وجه تقديم الأرض في آية يونس فنقول: إن الآيتين من سورة سبأ لما لم يتقدم فيهما ما تقدم في آية يونس مما يحرز تأكيد العموم والاستغراق، ولم يكن فيهما داع من المعنى لتقديم الأرض على السماء ثم إن ورود السماوات بلفظ الجمع يحرز في الآيتين من سورة سبأ معنى العموم والاستغراق؛ إذ هو مراد في كل هذه الآيات الواردة في هذا الغرض، فأعطاه وأحرزه في آية يونس وآية إبراهيم ما نجد في هاتين الآيتين من محرز معنى القسم والاستغراق، وأعطاه وأحرزه في آيتي سبأ ما ورد فيهما من جمع السماوات، وجاء كل على ما يجب ويناسب[11].
[1] التحرير والتنوير، 22/141.
[2] للزبيدي، مادة: "ع/ز/ب".
[3] المخصص في اللغة العربية، باب "ع ز ب"
[4] مفاتيح الغيب، 17/274 .
[5] المحرر الوجيز، 3/128.
[6] روح البيان، 4/57.
[7]الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 2/355.
[8] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 2/355.
[9] : أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 3/117.
[10] البحر المحيط، 6/79.
[11] ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، 1/146-148