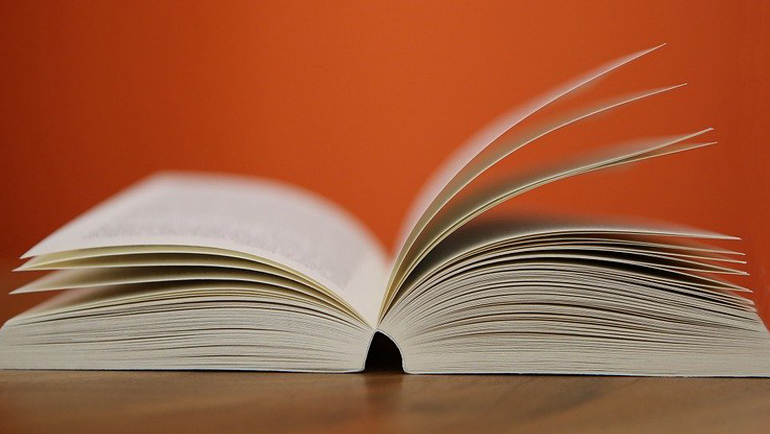
شكلت مباحث المقاصد الشرعية أحد محاور الجدل العربي الإسلامي المعاصر في سياق تفعيل الاجتهاد والتجديد من أجل تأسيس حداثة إسلامية وعربية ثانية، ولذلك فقد اتخذ الجدل مسارات متباينة في تفهم معاني المقاصد لدى جيل المؤسسين الكبار؛ ومجالاتها، وحدودها وإمكانية استثمارها وتوظيفها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك عقب تكاثر الدراسات الحديثة التي تبين الصلة بين صنوف المباحث الأصولية وارتباطها الوثيق بالظروف والملابسات الاجتماعية داخل أبنيتها التاريخية التي عملت على توجيه مساراتها وتحديد غاياتها.
وبهذا فإن البحوث الحديثة تتجه إلى منع الطابع الوصفي الظاهر لسائر أنواع الكتابات الأصولية بغرض تعمية الأثر الشخصي الخاص للمؤلف في عمله الفكري؛ فبموجب الأثر الشخصي للمؤلف، وعلى الرغم من الإقرار بالطابع الشكلي للكتابات الأصولية، فإنّ أيَّ عملٍ علمي لابدّ أن يتمتع بشخصيةٍ خاصة به على نحوٍ ما. وقد تبين بصورة جلية الأهمية الاستثنائية لتوافر معلومات واضحة وكافية عن خصوصية وتكوين المؤلف، ونوعية قرّاء كتاباته، ونوعية وخصائص المجتمع الذي يعيش فيه، الأمر الذي يمكننا من ملاحظة ودراسة العلاقة الوثيقة بين نظريته وبراهينه ونظام السرد الذي يستخدمه، وبين المعطيات التاريخية والاجتماعية التي يتحرك ويؤلف من خلالها.
في هذا السياق تبلورت رؤية تقليدية تتعامل مع النظرية الأصولية، التي تمثّل في الواقع النتاجَ الجماعي لأجيال متعاقبة من الأصوليين، باعتبارها نظرية موحّدة متجانسة، وذلك بسبب السمة الشكلية التي تطغى عليها. وبهذا ترسخ الاعتقاد بأنّ المؤلفات النظرية الأصولية أحدية الطابع، ويكفي الاطلاع على أحدها لمعرفة بقيتها، إلا أن هذه الرؤية تلغي معالم التميّز بين كتاب وآخر، وتهدر جملة الظروف الاجتماعية للمؤلفين وافتراضاتهم المعرفية الخاصة، الأمر الذي يحجب الغايات المستهدفة لسائر الخطابات الأصولية.
فالخطابات الأصولية تتخذ أشكالاً ومضامين متعددة، والنظريات الأصولية تختلف وتتميز عن بعضها بدرجات عديدة. وعلى الرغم من أن المؤلفات التي تنتمي إلى مدرسة أصولية واحدة، تتوافر على درجة من التشابه والتماثل؛ إلا أن ذلك لا يعني التجانس والتطابق التام وغياب الخصوصية الاجتماعية والسياسية والتاريخية. فالمدارس الأصولية تتوافر على خصوصية فقهية وطابعاً عقديا مميزاً لها، إلا أن الاختلافات في المنهج والمضمون لا تخفى على الدارسين، فلا يمكن التعامل مع أعمال الجويني والغزالي وابن الحاجب والآمدي وابن تيمية والسرخسي وأبو الحسين البصري وابن عبد السلام وابن قدامة والشاطبي وغيرهم باعتبارها نسقا يعيد نفسه دون اعتبار الفروقات الابداعية الفردية.
يمكن من خلال الشاطبي تبيّن الفروق والاختلافات بين كافة المساهمات الأصولية؛ فالعلاقة التي تجمع بين نظرية المقاصد والأزمة التي عاشها علم الأصول في عصر الشاطبي بيّنة لا لبس فيها، فقد تبلورت ظاهرة الاختلاف بحيث استهلكت مجهودات الفقهاء والأصوليين، وقد أشار إليها الشاطبي في مواضع عدة من "الموافقات"، كقوله: "لقد كنا قبل شروق هذا النور نتخبط خبط عشواء، وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير السواء، لضعفها عن حمل هذه الأعباء، ومشاركة عاجلات الأهواء على ميدان النفس التي هي من بين المنقلبين مدار الأسواء، فنضع السموم على الأدواء مواضع الدواء، طالبين للشفاء كالقابض على الماء، ولا زلنا نسبح بينها في بحر الوهم فنهيم ونسرح من جهلنا بالدليل، في ليل بهيم، ونستنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي أكباباً على الوجوه ونظن أننا نمشي على الصراط المستقيم[1]."
فالتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية حملت الشاطبي على إبراز قضية القطع أو اليقين، وهي مسألة محورية في مشروعه التجديدي؛ إذ يقول في المقدمة "إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعةٌ إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي[2]." وبهذا المعنى نجد أن العلاقات التي تجمع بين مضامين نظرية المقاصد من جهة، والوضعية العامة للفكر الأصولي الذي ينظم إنتاج المعرفة الاجتهادية في ذلك العصر بدأت تظهر.
وبهذا فقد بات واضحا بأن بحث المقاصد يرتبط بجملة الآليات المنتجة لخطاب المقاصد تاريخيا، فالظروف والملابسات التاريخية حكمت إبداعه من خلال النظر في تكامله وشموله من جهة، وخصوصية مبدعيه من جهة أخرى، وتتجلى العلاقة بين منتجي الخطاب الفقهي بشكل عام والمقاصدي بشكل خاص مع التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال الشاطبي فنظريته الابداعية الفريدة انبثقت من خلال ملاحظته وإدراكه لما آلت إليه أحوال الأندلس في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي من عجز الفقه عن مواكبة ومعالجة القضايا والمسائل النازلة[3]، حيث شرع ببيان سبل تكييف الشريعة مع الظروف الاجتماعية المستجدة، ولا يعني ذلك تلفيقا للشريعة لحساب الواقع من خلال اصطناع آليات نظرية تحقق مرونة تفضي إلى تكييف الشريعة مع الأنظمة والقوانين والممارسات الوضعية، وإنما إبداعا موصولا مع الشريعة الإسلامية نصا وروحا، والتي اختطفتها نزعتان متطرفتان تمثلت بفقهاء عصره ومتصوفيه وهما التهوين والتهويل.
فبحسب النظرية المعرفية للشاطبي يعتبر "البرهان" الأساس المعرفي لمصادر الشرع وهي بعيدة عن الاحتمال، فالقول بعدم اليقين يفسح المجال لإعادة النظر فيه، وصولا إلى الشك في أسسه الأمر الذي ينسحب على أصول الدين، ولذلك كانت مقدمات أصول الفقه يقينية سواء أكانت عقلية أم عادية أم منزلة، ففي المجال العقلي الأمور تندرج في ثلاث فئات وهي: الضروري والممكن والمستحيل، كما أن نظريته تقوم على إحصاءات استقرائية شاملة قرآنية وحديثية وليست ذات طبائع فردية..
وبهذا فقد أخذ الشاطبي ممن سبقه كالجويني والغزالي القول بأن هدف الشريعة الوجودي يكمن في حماية وتعزيز ثلاث فئات فقهية تتمثل بـ الضروريات والحاجيات والتحسينيات[4]، وذلك لبيان أن مصالح المسلمين مصانة على أكمل وجه، فالشريعة وضعت لمصلحة العباد، وتتضمن الكليات الضروريات الخمس، وتعني تحقيق مناحي الشريعة الضرورية من أجل حسن سير الشؤون الدينية والدنيوية؛ إذ يؤدي أي خلل في ذلك إلى أن تعم الفوضى في العالم[5].
لعل الخشية من القول ببدعية الأخذ بمفهوم المقاصد حملت الفقهاء والأصوليين على الاستطراد والتشديد على رسوخ المفهوم في الخطاب القرآني والحديثي واجتهادات وسلوكات وممارسات الصحابة والتابعين وتمثل المجتهدين وتحققهم به في مختلف الحقب والعصور الإسلامية، وقد استشعر معظمهم بعد القرن الرابع الهجري ضرورة بيان شرعية البحث المقاصدي ورسوخه في المصادر والممارسات الإسلامية المأصولة، وطالما كان النسيان يسري على الإنسان بفعل الزمان اشتدت الحاجة لاستدخاله وتوظيفه في الحقل الأصولي والكشف عن أسسه المعرفية في المصادر الإسلامية، فالإمام ابن القيم يؤكد على أن: "القرآن وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح... ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة[6]"، وقد بلغت العناية بتحديد جذور البحث المقاصدي مداها الأرحب مع الشاطبي بحيث بات القرآن الكريم في صلب الاستدلال المقاصدي، فالقرآن يعالج في أغلب الحالات، قضيةً أو مجموعة من القضايا المترابطة في أكثر من موضع واحد، ولذلك فالشاطبي يدعو إلى ضرورة مراجعة جميع الآيات ذات الموضوع الواحد عند استخراج حكم شرعي من أيّ نص قرآني. فقد تأتي آية أو أكثر تفسّر آية أخرى غير واضحة الدلالة، وقد يتوقف الفهم الصحيح لجزء من النص القرآني على فهم جزء آخر، وقد نجد في جزءٍ ما يمكن من خلاله أن نفسّر أو نؤكد أو نتمم معنى جزء آخر. فالشاطبي يقرر وحدة النص القرآني، وانسجامه وتماسكه على مستوى المعنى.[7]
لم يتردد الشاطبي، كما هو متوقع، في الإشارة إلى آثار هذه النظرة بشكل حاسم، حيث أشار بشكل واضح وصريح إلى أنّ الآيات المكية الموحاة في بداية الدعوة الإسلامية تشكّل القاعدة العامة في فهم القرآن، وأشار إلى أنّ هذه الآيات تقرر المبادئ والقواعد الشرعية الأكثر عموميةً وكليّةً؛ أي ضرورة حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
وذهب إلى أنّ الوحي القرآني الذي تأخر في النزول، على الرغم من أنه قد يكون متمماً لهذه المبادئ والقواعد الكلية، إلا أنه يقوم بشكل رئيس بشرح وتفصيل معاني هذه القواعد المتقدمة. وعليه، فإنّ السور المدنية ترتبط بعلاقة وثيقة بالسور المكية، وهي أقل كلية وشمولاً، وتضم في الغالب أحكاماً شرعية فرعية في مسائل تفصيلية.
يستدل الشاطبي في دعوته إلى ضرورة عودة الفقيه إلى القرآن أولاً في عملية الاستنباط الفقهي في المسائل التفصيلية، وإلى أنّ رتبة السنة متأخرة في الاعتبار عن القرآن، بأدلة عديدة وفي مقدمتها، أنّ القرآن مقطوع به، وأن السنة مظنونة، والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف القرآن فإنه مقطوعٌ به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدَّمٌ على المظنون، فلزم من ذلك تقديم القرآن على السنة. وبهذا نرى أن الشاطبي يجعل نسبة الثبوت والقطعية هي المعيار الذي يحدد المكانة المعرفية لكلا المصدرين.[8]
يشدد الشاطبي على تقرير مبدأ عام يقضي بأنّ القرآن يقرّر الأساس الأكثر أهمية في الشريعة، أي المبدأ الذي ينظّم مصالح العباد. لأنّ الهدف الكلي للشريعة يكمن في نهاية المطاف في الحفاظ على مصالح المسلمين الدنيوية والأخروية على السواء.[9] ولتحقيق هذا الهدف، فإنّ الشريعة تسعى إلى حفظ ثلاثة أقسام من المصالح، هي على التوالي المصالح الضرورية، والحاجية، والتحسينية.
ومن دون تحقيق مصالح القسم الأول التي تقتضي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، فإنه لا يمكن أن يكون الوجودان الدنيوي والديني منتظمين، بل قد يكون انتظامهما أمراً مستحيلاً. ومن جهة أخرى فإنّ القسمين الآخرين يجعلان تطبيق الشريعة أمراً ممكنا من خلال تخفيف المتطلّبات الشديدة (الرخص الشرعية)، ومن خلال التوسعة، والتيسير، ورفع الحرج، والرفق[10].
فالضروريات الخمس كما تأصّلت في القرآن، تفصّلت في السنة، فإنّ حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان، وهي الإسلام، والإيمان، والإحسان، فأصلها في القرآن، وبيانها في السنة، ومكمله ثلاثة أشياء: وهي الدعوة إليه، وجهاد مَنْ عانده أو رام فساده، وتلافي النقصان الطارئ في أصله. وأصل هذه المعاني في القرآن، وبيانها في السنة على الكمال.
وحفظ النفس حاصلة في ثلاثة معان: وهي إقامة أصله بتشريع الزواج، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم، من جهة المأكل والمشرب، والملبس والمسكن، ومكمله ثلاثة أشياء، وذلك كاجتناب الزنى، والنكاح الصحيح، وما يلحق به من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان، وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد، وشرعية الحد والقصاص. وشبيه بذلك فإنّ القرآن يقدم المبادئ الشرعية العامة التي تهدف إلى حفظ الأملاك.
وحفظ العقل بمنع تناول ما يفسده مثل الخمر، وهو مذكور في القرآن، ومكمله تشريع حد الخمر أو الزجر عن سائر المخدرات الموكول إلى اجتهاد الأمة، وذلك لأنّ القرآن ترك التنصيص على أحكام خاصة لهذه الأمور المكملة، فتركتْ السنة أيضا النصَّ على حكم خاص بها، وبالتالي تُرك الحكم فيها إلى الاجتهاد. وقد وجد الشاطبي في هذا الأمر فرصة مناسبة للإشارة إلى أنَّ السنّة تترك كل ما يتركه القرآن نفسه.
إن المبدأين الأكثر أهمية في نظرية الشاطبي، هما: مبدأ الحفاظ على المصلحة العامة، ومنهج الاستقراء المنطقي، فحفظ المصلحة العامة يمثل غاية مشروع الشاطبي النظري، والاستقراء وسيلة هذا المشروع. إذ لا تقوم حجية مبادئ المصلحة العامة على أيّ نص قاطع في القرآن ولا في السنة، ولكنها مستمدةٌ من استقراء نصوص الوحي. وفي الحقيقة، فإنّ عدداً من مصادر التشريع، مثل الإجماع، والقياس، والاستحسان، تمّ إثبات حجيتها من خلال الاستقراء[11].
وبحسب الباحث "وائل حلاق" في الوقت الذي كان فيه الشاطبي يتبنّى نظريةً في التشريع تُشدّد على دنيوية مصالح المجتمع مع المحافظة على صلة قوية مع الجانب التعبّدي الروحي فيه، فإنه كان يسعى ليواجه ما كان قد اعتبره قضية إشكالية في عصره. وقد كان يناصر عبر مؤلفاته تبسيط التشريع، ويجاهد، بلا كلل ولا ملل، ضد الصياغات والتجريدات المعقّدة للنظرية الأصولية الشائعة في عصره. وكان يعتقد بوجود صلة قوية بين سيادة هذه النظرية الأصولية التي تتسم بالتجريد والتنظير الكلامي وبين المشكلة الخطيرة التي اجتاحت مجتمعه الأندلسي.
وهو لا يفتأ يؤكّد باستمرار في كتابيه اللذين وصلا إلينا معارضتَه الصلبة والمحكمة للممارسات التشريعية لهذا المجتمع، حيث كان يرى أنّ هذا المجتمع يقوم بالتهرب والتلاعب بشريعة الله دون أي تحرّج وشعور بالذنب،.وكان يرى أنّ ممارسةَ الحيل الشرعية، والتلفيق العشوائي بين المذاهب الفقهية الأربعة، بالإضافة إلى الهجر الفعلي للشريعة أمورٌ ليست حصيلة الطابع التجريدي للنظرية التشريعية فقط، لكن أيضا حصيلة النظرة الكلامية لهذه النظرية وطابعها اللاتاريخي الذي يتجاهل المتطلبات الإنسانية والاجتماعية.
وبكلمة أخرى، فإنّ ضعف النظرية التشريعية السائدة في تطوير فهم لحماية الشريعة للقضايا التي تهمّ البشر والمجتمعات، والخطاب التجريدي الذي استخدمه الفقهاء في عرض فقههم قد نفّر المسلمين من الشريعة. هذا بالضبط هو الذي حمل الشاطبي على التشديد، مراراً وتكراراً، على أنّ الإسلام والشريعة الإسلامية لا يختلفان عن حامل الرسالة من حيث إنه كان "نبياً" أمياً؛ أي إنّ الواجبات الشرعية الأساسية الواجبة على جميع المسلمين، وكذلك حقوقهم الأساسية كما تمّ تقريرها في السور المكية كلها قابلةٌ للفهم بالنسبة لجميع الناس من جميع المستويات.
ومن خلال إسناده إلى تلك السور، التي تعطي الوجود الدنيوي نصيبَه المشروع من الحقوق والمزايا، دوراً رئيساً في نظريته، فإنّ الشاطبي كان يحثُّ إخوانه المسلمين إلى العودة إلى تطبيق الشريعة بشكل سليم، هذه الشريعة الحريصة على الناس ومصالحهم. فقد كانت "الدنيوية"؛ (بمعنى الانهماك في حفظ مصالح الناس والمجتمعات) التي تُشكّل أساس نظرية الشاطبي هي المسؤولة عن موقفه المتفرّد نحو دور القرآن في نظريته الأصولية، بل أكثر من ذلك حيث إنها تبيّن لنا لماذا أسند الشاطبي للقرآن نصيبَ الأسد في عملية الاستدلال الفقهي، وأحلّ السنّة النبوية في المرتبة الثانية في هذه العملية[12].
يُعدُّ الشاطبي باعثا لعلم المقاصد، ومؤسس عمارته الكبرى، ومرجع كل مشتغل بهذا الفن الجليل. كما يُعدُّ كتابه "الموافقات في أصول الشريعة" فتحاً جديداً في هذا الميدان. فإذا كان للإمام الشافعي الفضل في إرساء القواعد الأولى لعلم الأصول، فللإمام الشاطبي الفضل العظيم في إبراز نظرية المقاصد من خلال التفاته إلى ما يسمى بروح الشريعة، فعلى يدي الإمام الشاطبي اكتملت نظرية المقاصد، وعلى يديه وصلت إلى مرحلة النضوج، وكان ذلك في القرن الثامن الهجري، وهو القرْن الذي سماه عبد المجيد الصغير بـ "عصر المقاصد الشرعية وقرن الكتابات السياسية[13]."
عندما جاء الإمام الشاطبي عرف الفكر المقصدي نوعاً من التراكم تميز بغزارة المادة ولكن مع الافتقار إلى المنهج والخلو من النتائج العلمية والواضحة.
والذي قام به الشاطبي هو نقد علم الأصول من أجل إعادة تأسيسه، وطلب اليقين والقطع في مسائله وقضاياه، وعلى حد قول الصغير فإن الشاطبي قد ثَمَّن مشروع "البيان" عند الشافعي، وانتقل به إلى مشروع "البرهان[14]". وذلك من خلال تقديمه علم المقاصد بوصفه حلا لمشكلة البدع وأزمة الانحطاط ورسم وسيلة ناجحة للتكيف مع الظروف عن طريق هذا العلم الجديد الذي ينصب على الكليات دون الجزئيات والقطعيات بدل الظنيات، ويتجاوز النظرة الفرعية الجزئية إلى النظرة الكلية المقصدية العامة.
في هذا السياق يعتبر الإمام الجويني نموذجا لإدراك العلاقة بين الوعي بمفهوم المقاصد وبين وظيفتها في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فبعد أن أدرك استحالة عودة الخلافة كما كانت في عهدها الأول عمل على إعادة ترتيب شروط الإمام ونعوته، فيشير في هذا المجال إلى أن شرط الصلاح والتقوى يجب أن يكون مقدماً على شرط النسب القرشي؛ إذ يقول: "إذا وُجد قرشيّ ليس بذي دراية، وعاصره عالم تقي، يُقَدَّم العالم التقيّ. ومن لا كفاية فيه؛ فلا احتفال به، ولا اعتداد بمكانه أصلاً[15]."
وفق قراءته لم يجد الجويني مخرجاً سوى تأسيس قواعد وأسس جديدة ومقاصد شرعية قطعية، وفق المصلحة العامة للأمة على اعتبار أن المقاصد ذات ارتباط قوي بالمشكل الاجتماعي والسياسي. فبالمقارنة بين الماوردي والجويني تظهر لنا صورة انحطاط القيم في انتقال فقهاء السلطان من قيم الولاء للعدل المطلق، إلى الولاء للاستبداد المطلق، وهذه مقارنة بين هذين الأصوليين الشافعيين، فإن كان كتاب "الأحكام السلطانية" للماوردي عبارة عن تأسيس للمعنى الثاني، فإن كتاب "غياث الأمم في التياث الظلم" للجويني هو في باب تأسيس المعنى الأول[16].
فقد تميّز الجويني بحضور المفاهيم الأساسية لعلم المقاصد، وقدَّم وصفاً نقدياً لانحلال السلطتين العلمية والسياسية، ثم أعقبه بتقديم الأسس والكليات التي أناط بها أمل الإنقاذ، ثم محاولات الإصلاح وإعادة النظر في التاريخ والفقه. وكان مجمل ما قدمه الجويني في باب المقاصد، يمكن حصره في أمرين[17]؛ المقاصد الشرعية المستقرأة غير المنصوصة، والتي تشكل أصول المصالح في الشرع. والمقاصد الشرعية المستفادة من القرائن التي تحتف بالنصوص الشرعية.
لم تتوجه عناية المتقدمين وصولا إلى الشاطبي بتحديد دلالة مصطلح المقاصد باعتباره يستعصي على التحديد الجامع المانع بالمعنى المنطقي الأرسطي كشأن المفاهيم الكبرى المتعلقة بالوجود نظرا وعملا، ونظرا لارتباطه بمنهج النظر المعرفي والاجتماعي والتاريخي، ولذلك فالمصطلح يحيل إلى جملة من المعاني والحكم والأحكام بعضها يتسم بالثبات والاطراد والعموم وتطبيقاتها العملية تخضع للوقائع الاجتماعية المتغيّرة..
إلا أن المتأخرين اجتهدوا في ضبط دلالة المصطلح وبيان وظائفه، في هذا السياق كان الطاهر ابن عاشور متيقظا لهذه الإشكالية فحدها بمفهوم عام فـ"مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا ما في الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظاتها، ويدخل في هذا أيضاً معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة[18]." وتنقسم إلى معان حقيقية، تتحقق في نفسها، ومعاني عرفية عامة تدل على المجريات التي ألفتها نفوس الجماهير واستحسنتها. ولإثبات معاني المقاصد يشترط فيها تحقق أربع صفات: الثبوت، والظهور، والانضباط، والاطراد.
وبهذا وسَّع ابن عاشور دائرة البحث في المقاصد، وأعطاه وجهة جديدة تتجاوز حدود السعي لتأسيس مجرد أصول تشريعية عقلية كلية قطعية، حيث فتح أفقاً أرحب للتنظير الاجتماعي بمعناه الواسع، من حيث هو سعي للتشريع والتخطيط للمستقبل، انطلاقاً من استيعاب معطيات الحاضر وتحليلها وتمحيص عناصرها وفق بصائر الوحي، وتوجيهها طبقاً لقيمه وأحكامه، توخياً لتحقيق مقاصده، وفق أولويات متراتبة متكاملة[19].
ولذلك فإن ميزة ابن عاشور، كما يقول طه جابر العلواني: "هو العمل على تقديم منهج للكشف عن المقاصد، جعله يضيف مقصدين هامين جداً، وهما: مقصد المساواة، ومقصد الحرية، وتلك خطوة اجتهادية هامة لابدّ من متابعتها والبناء عليها[20]." واستثمر المقاصد من خلال القيام بتطبيقات في دوائر المعاملات والسلوكيات الحادثة، ولذلك يقول: "إذا أردنا أنْ ندوّن أصولاً قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارضة، وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين، ونعيرها بمعيار النظر والنقد، فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي عاشت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية[21]."
أما علال الفاسي فقد ربط في كتابه "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" إسهامات الشاطبي وغيره ممن تحدثوا في المقاصد بهموم الحاضر ومشكلاته، وذلك واضح في حديثه عن منهاج الحكم وحقوق الإنسان[22]. وهو يعبر عن وعي بمفهوم المقاصد تأسيسا وتوظيفا على الصعيد المعرفي والتاريخي الاجتماعي.
لقد عمل الفيلسوف الكبير طه عبد الرحمن على تتبع المعاني الممكنة من مفهوم المقاصد، وتوصل إلى بيان ثلاث معانٍ أساسية؛ كل واحد منها يتعلق بنمط معين من المحتوى، وهي كلها تمثل فصولا خاصة وضعها الشاطبي في كتابه "الموافقات"، ونجد جذورها التاريخية في حقول المعرفة الإسلامية الصوفية والكلامية والفلسفية، ولعل أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي، المعروف بالترمذي الحكيم، الذي عاش إلى أواخر القرن الثالث الهجري على الأرجح، أحد ممثلي الاتجاه الصوفي الذي استخدم لفظ المقاصد عنوانا لأحد مصنفاته، وهو: "الصلاة ومقاصدها"، يعلل فيه أفعال الصلاة وما ظهر له من أسرارها؛ إذ يقول: "فأفعال الصلاة مختلفة على اختلاف الأحوال من العبد: فبالوقوف يخرج من الإباق. وبالتوجه إلى القبلة يخرج من التولي والإعراض. وبالتكبير يخرج من الكبر. وبالثناء يخرج من الغفلة. وبالتلاوة يجدد تسليما للنفس وقبولا للعهد. وبالركوع يخرج من الجفاء، وبالسجود يخرج من الذنب. وبالانتصاب للتشهد يخرج من الخسران. وبالسلام يخرج من الخطر العظيم...[23]."
وفي المجال الفلسفي استخدم البحث المقاصدي الفيلسوف أبو الحسن العامري، المتوفي سنة 381ﻫ. في كتابه: "الإعلام بمناقب الإسلام"، وقد جاء فيه على ذكر الضروريات الخمس، التي أصبحت محور الكلام في مقاصد الشريعة.
وبهذا كشف طه عبد الرحمن عن جملة المعاني المستعملة للفظ المقاصد؛ فالمعنى الأول يستعمل الفعل قصد بمعنى ضد الفعل "لغا" "يلغو". ولما كان اللغو هو الخلو من الفائدة أو صدق الدلالة فإن المقصد يكون على عكس ذلك "هو معلول الفائدة أو معقول الدلالة، وهذا المضمون الدلالي يعود إلى الفصل الذي وضعه الشاطبي تحت عنوان "مقاصد وضع الشريعة للإفهام"، وقد ناقش فيه قضيتين أساسيتين حاول فيهما إثبات صفة العربية والأمية للشريعة الإسلامية.
والمعني الثاني؛ يستعمل الفعل "قصد" أيضا بمعنى ضد فعل "سها" "يسهو". ولما كان السهو هو فقدان التوجه أو الوقوع في النسيان، فان المقصد يكون على خلاف ذلك، وهو حصول التوجه والخروج من النسيان؛ هذا المعنى يدل على البعد الشعوري والإرادي الذي تعكسه الفصول التي وضعها الشاطبي تحت فصل "مقاصد وضع الشريعة للامتثال" و"مقاصد المكلف".
وفي المعني الثالث؛ يستعمل فعل "قصد" ضد الفعل "لها" "يلهو"، لما كان اللهو هو خلو من الغرض الصحيح و فقدان الباعث المشروع، فإن المقصد يكون على العكس من ذلك هو حصول الغرض الصحيح و قيام الباعث المشروع". هذه الدلالة كما بينها طه عبد الرحمان تعكس "المضمون القيمي" وهو الذي ناقشه الشاطبي في فصل "مقاصد وضع الشريعة ابتداءً[24]."
من خلال هذا التحليل يتبين لنا أن دلالة نظرية المقاصد يصعب حصرها في بعد واحد لاحتوائها على قابلية عجيبة للفهم المتعدد، لهذا وصل في الأخير إلى القول: وعلى الجملة فإن الفعل "قصد" قد يكون بمعنى "حصل فائدة" أو "حصل نية" أو بمعنى "حصل الغرض"، فيشمل "علم المقاصد" إذ ذاك على ثلاث نظريات أصولية متمايزة فيما بينها، أولها نظرية المقصودات، وهي تبحث في المضامين الدلالية للخطاب الشرعي والثانية نظرية القصود، وهي تبحث في مضامين الشعورية أو الإرادية، والثالثة نظرية المقاصد، وهي تبحث في المفاهيم القيمية للخطاب الشرعي.
لقد تبنى محمد عابد الجابري القول باعتبار المقاصد نقلة في النظام المعرفي بالمعنى الذي يعتبر فيه أنه علم يخرج أحكام الفقه من المعالجة البيانية إلى التنسيق البرهاني[25]. عبر مفهوم المعقولية لدى الشاطبي والتي يريد من خلالها عقلنة الأحكام الشرعية بناءً على مفهوم القطع. هذه العملية حسب الجابري توازي تشكل اليقين في العقليات؛ إذ يقول: "كيف يمكن بناء معقولية في الشرعيات على القطع وهو يوازي اليقين في العقليات ونحن نعلم أنها تعتمد النقل وليس من إنشاء العقل؟ يجيب الشاطبي إن ذلك ممكن جدا إذا نحن اعتمدنا على الطريقة البرهانية فبنينا أصول الفقه على كليات الشريعة وعلى مقاصد الشرع، وإن كليات الشريعة تقوم مقام الكليات العقلية في العلوم النظرية، أما مقاصد الشرع فهي السبب الغائي الناظم للمعقولية[26]."
يكشف الجابري عن العلاقة بين العقلنة والحكمية عقب بيان أنواع المقاصد التي حددها الشاطبي وهي أربعة: المصلحة والفهم والتكليف وإخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما كان عبدا لله اضطرارا. قال: "وما يهمنا منها هنا هو علاقتها ببناء المعقولية في ميدان الفقه، فهي لها علاقة بالأسباب عند أرسطو وهي أربعة كذلك، هل نطابق مثلا بين السبب المادي وبين قدرة المكلف، وبين السبب الصوري ومعهود العرب، وبين السبب الفاعل وإخراج المكلف من داعية هواه، وبين السبب الغائي ومصالح العباد؟ لنكتف بالقول أن نموذج المعقولية في الطريقة البرهانية خلال القرون الوسطى كان نموذج أرسطو، ولذلك فليس غريبا أن نجد ملامح هذا النموذج في كل محاولة لإفضاء المعقولية على البناءات الفكرية، سواء منها ما له طابع فكري كالعقليات عند ابن رشد أو ما يؤطر العقل كأصول الفقه عند الشاطبي[27]."
وبصرف النظر عن المقاصد الأيديولوجية لمقاربة الجابري التجزيئية بالانحياز إلى عقلانية متخيلة في التراث على حساب البيان والعرفان، والتي كشف عوارها طه عبد الرحمن من خلال بيان تكامل وشمولية التراث والتداخل المعرفي، إلا أن الجابري كان متيقظا للمسألة التاريخية والاجتماعية للمقاصد ووظائفها العملية.
في هذا السياق تبنى طه عبد الرحمن رؤية أخلاقية للمقاصد باعتبارها نظرية عامة تقدم الجانب القيمي، ويعترض على الجابري بقوله: "لأننا سوف نرى أن المضامين المقصدية تندرج في نظام معرفي أنزله الجابري مرتبة هي دون مرتبة البيان؛ إذ ينكشف على أنها مضامين عرفانية، فيكون الانتقال الذي حصل في علم الأصول ليس انتقالا إلى الأفضل؛ أي ارتفاعا في القيمة العلمية كما ادعى هذا النقد، بل انتقالا إلى الأخس[28]." ويرى بأن هذه النظرية شاملة إذا ما حاولنا أن نستقرئ فيها الأبعاد الأخلاقية في دلالتها النسقية؛ إذ يقول: "وحاصل الكلام في الأوصاف الأخلاقية للمقاصد الشرعية؛ أي أن المقصود الشرعي معنوي وفطري، وأن القصد إرادي وتجريدي، وأن المقصد حكمي ومصلحي، علما بأن المصلحة هي المحل المعنوي لتحقيق الصلاح، وعلى هذا يكون علم المقصد هو الصورة التي اتخذها علم الأخلاق للاندماج في علم الأصول[29]". وبهذا يشدد طه عبد الرحمن على القول: "وما الشاطبي عندنا إلا أب التداخل بين علم الأخلاق وعلم الأصول، فاتحا بذلك طريقا في بناء العلم الإسلامي على أسس التنسيق المتكامل الذي لا نعلم له نظيرا في السابق ولا في اللاحق[30]."
على الرغم من تكاثر مباحث المقاصد الشرعية خلال العقود الأخيرة بحيث باتت أحد محاور الجدل العربي الإسلامي المعاصر في سياق تفعيل الاجتهاد والتجديد من أجل تأسيس حداثة إسلامية وعربية ثانية، إلا أن معظم الدراسات اتخذت طابعا شكليا وصفيا تكراريا ومسارات متباينة في تفهم معاني المقاصد لدى جيل المؤسسين الكبار ومجالاتها وحدودها وإمكانية استثمارها وتوظيفها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال عدد من الدراسات التي أنجزت في سياق استكمال التكوين العلمي الأكاديمي، ومع أن هذه الرسائل استبطنت الأهمية النظرية والعملية التي أشار إليها رواد النهضة العربية الإسلامية أمثال محمد عبده إلا أن معظم الدراسات في هذا السياق كانت مخيبة للآمال حملت نتائج تكرس الجمود والشكلانية ومثلت جسدا لا روح فيه وكأنها تماهت خطابيا مع الطرح الاستشراقي بالقول بسكونية وجوهرانية أصول الفقه وعجزه عن التواصل والإبداع.
وفي المقابل ظهرت جملة من الدراسات الحديثة التي تبين الصلة بين صنوف المباحث الأصولية وكشف ارتباطاتها الوثيقة بالظروف والملابسات الاجتماعية داخل أبنيتها التاريخية التي عملت على توجيه مساراتها وتحديد غاياتها، وظهرت طبقة من الباحثين الكبار على اختلاف توجهاتها بددت الأساطير والأوهام الاستشراقية أمثال؛ وائل حلاق، وطه عبد الرحمن، وعبد المجيد الصغير، ومحمد عابد الجابري، والريسوني، والعلواني، والنجار، والميساوي.
وبهذا فإن البحوث الحديثة تتجه إلى منع الطابع الوصفي الظاهر لسائر أنواع الكتابات الأصولية بغرض تعمية الأثر الشخصي الخاص للمؤلف في عمله الفكري، فبموجب الأثر الشخصي للمؤلف، وعلى الرغم من الإقرار بالطابع الشكلي للكتابات الأصولية، فإنّ أيَّ عملٍ علمي لابد أن يتمتع بشخصيةٍ خاصة به على نحوٍ ما. وقد تبين بصورة جلية الأهمية الاستثنائية لتوافر معلومات واضحة وكافية عن خصوصية وتكوين المؤلف، ونوعية قرّاء كتاباته، ونوعية وخصائص المجتمع الذي يعيش فيه، الأمر الذي يمكننا من ملاحظة ودراسة العلاقة الوثيقة بين نظريته وبراهينه ونظام السرد الذي يستخدمه، وبين المعطيات التاريخية والاجتماعية التي يتحرك ويؤلف من خلالها.
في هذا السياق، تبلورت رؤية تقليدية تتعامل مع النظرية الأصولية، التي تمثّل في الواقع النتاجَ الجماعي لأجيال متعاقبة من الأصوليين، باعتبارها نظرية موحّدة متجانسة، وذلك بسبب السمة الشكلية التي تطغى عليها. وبهذا ترسخ الاعتقاد بأنّ المؤلفات النظرية الأصولية أحدية الطابع، ويكفي الاطلاع على أحدها لمعرفة بقيتها، إلا أن هذه الرؤية تلغي معالم التميّز بين كتاب وآخر، وتهدر جملة الظروف الاجتماعية للمؤلفين وافتراضاتهم المعرفية الخاصة، الأمر الذي يحجب الغايات المستهدفة لسائر الخطابات الأصولية.
إن الخطابات الأصولية تتخذ أشكالاً ومضامين متعددة، والنظريات الأصولية تختلف وتتميز عن بعضها بدرجات عديدة. وبالرغم من أن المؤلفات التي تنتمي إلى مدرسة أصولية واحدة، تتوافر على درجة من التشابه والتماثل؛ إلا أن ذلك لا يعني التجانس والتطابق التام وغياب الخصوصية الاجتماعية والسياسية والتاريخية.
فالمدارس الأصولية تتوافر على خصوصية فقهية وطابعاً عقديا مميزاً لها، إلا أن الاختلافات في المنهج والمضمون لا تخفى على الدارسين، وقد وجدنا ذلك في التعامل مع أعمال الجويني، والغزالي، وابن الحاجب، والآمدي، وابن تيمية، والسرخسي، وأبو الحسين البصري، وابن عبد السلام، وابن قدامة، والشاطبي، وغيرهم باعتبارها نسقا يعيد نفسه دون اعتبار الفروقات الإبداعية الفردية، ولعل المستقبل يحمل أملا في ظهور دراسات أكثر شمولا ودقة في الكشف عن إمكانات معرفية تأويلية في تفهم المقاصد في ظل الانبعاث الثوري العربي يؤسس لحداثة عربية إسلامية مجددة.
الهوامش
[1]. أبو إسحق الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط1، 1991م، 1/13.
[2]. المرجع نفسه، 1/19.
[3]. لمزيد من التفصيل أنظر:
Khalid Masud, Islamic Legal Philosophy (Islamabad, 1977).
[4]. الموافقات، م، س، 4/11.
[5]. وائل حلاق، تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام: مقدمة في أصول الفقه السني، ترجمة: أحمد موصللي؛ فهد بن عبد الرحمن الحمودي، بيروت: دار المدار الإسلامي، ط1، 2007.
[6]. ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، 2/22.
[7]. الموافقات، م، س، 3/276.
[8]. المرجع نفسه، 4/5.
[9]. الموافقات، م، س، 2/4-6.
[10]. وائل حلاق، صدارة القرآن في النظرية الأصولية عند الشاطبي، م، س، ص18.
[11]. الموافقات، م، س، 1/15-16.
[12]. وائل حلاق، صدارة القرآن في النظرية الأصولية عند الشاطبي، م، س، ص32.
[13]. عبد المجيد الصغير، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية، بيروت: دار المنتخب، 1994م، ص462.
[14]. المرجع نفسه، ص470.
[15]. إمام الحرمين عبد الملك الجويني النيسابوري، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق: عبد العظيم الديب، قطر: مكتبة إمام الحرمين، ط1، 1400ﻫ، ص82.
[16]. زين، إبراهيم، مراجعة لكتاب: "الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية"، لعبد المجيد الصغير، مجلة إسلامية المعرفة، العدد الأول، سنة 1995م، ص158.
[17]. الجيوسي، عبد الله، أنموذج مقترح لقراءة نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مجلة التجديد، السنة الرابعة، العدد الثامن، ص243.
[18]. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، 1978، ص52.
[19]. المرجع نفسه.
[20]. طه جابر العلواني، مقدمة نظرية المقاصد عند الإمام محمد بن عاشور للحسني، ص19.
[21]. المرجع نفسه.
[22] . المرجع نفسه، ص72.
[23]. الحكيم الترمذي، الصلاة ومقاصدها، ص12
[24]. طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، دار الكتب العلمية، ط1، 1991، ص98.
[25]. محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ص554.
[26]. محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، 1991، ص210.
[27]. المرجع نفسه، ص211.
[28]. طه عبد الرحمن، تجديد المنهج، م، س، ص97.
[29]. المرجع نفسه، ص 97.
[30]. المرجع نفسه.







