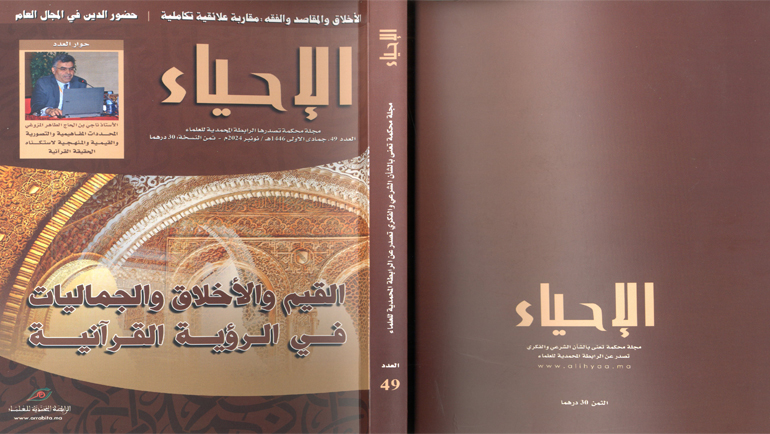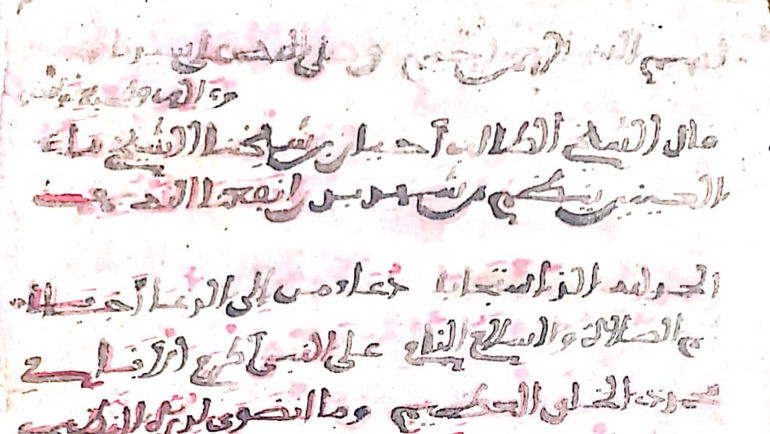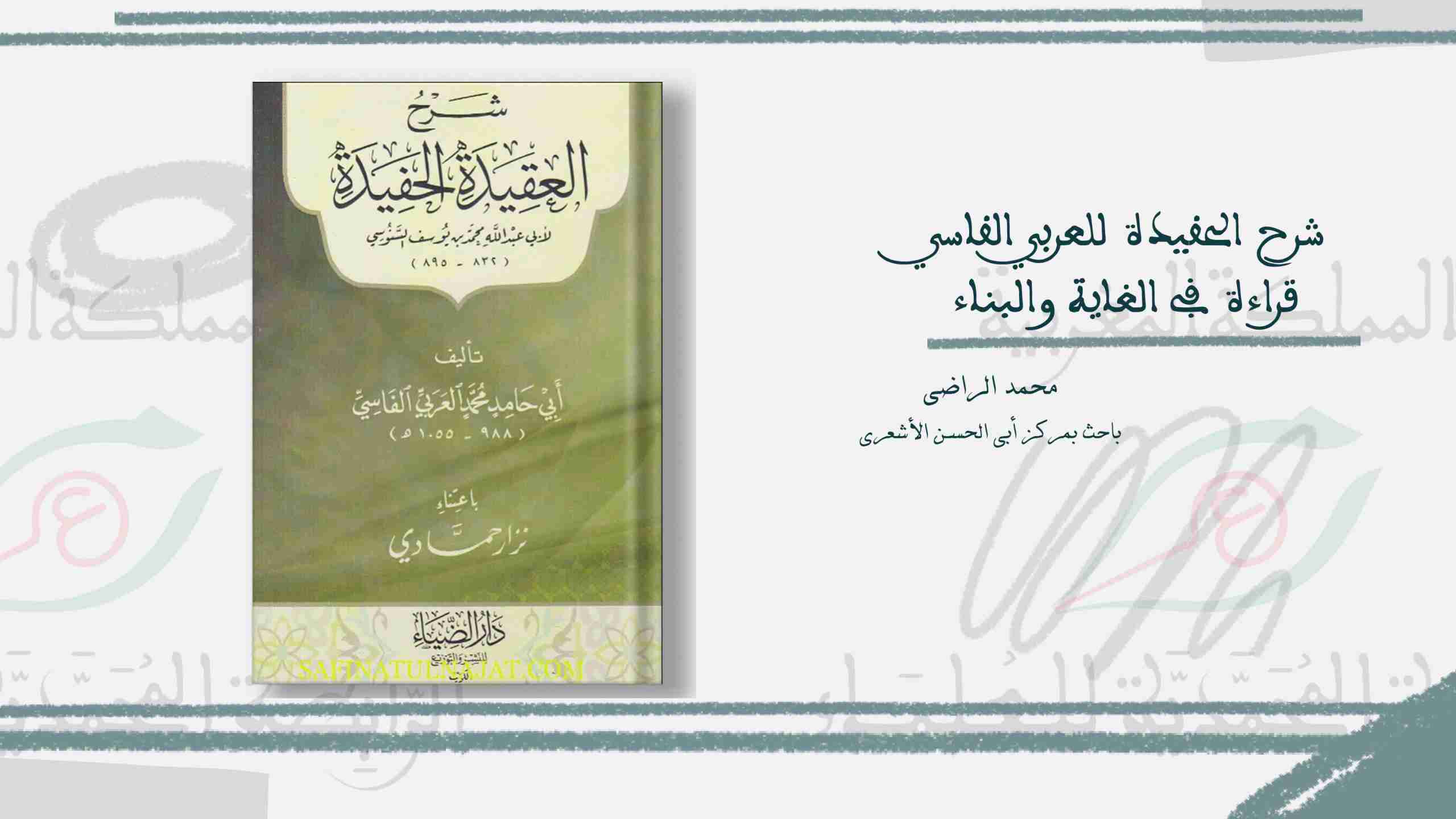قراءة في كتاب «المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» لأبي محمد القاسم السجلماسي

عن المؤلِّف:
السِّجِلْماسي: (كان حيا سنة 704هـ).
هو القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري، أبو محمد السجلماسي: أديب، ولد ونشأ بسجلماسة، ورحل إلى فاس فأخذ عن علمائها ودرّس في القرويين، وصنف « المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» [1]. ويذكر محقق المنزع الدكتور علال الغازي أننا ما زلنا نجهل الكثير عن تفاصيل حياة السجلماسي، بل لا نكاد نعرف على وجه التأكيد إلا أنه عاش في المغرب في أواخر القرن الهجري السابع ومفتتح الثامن. ونسبة المؤلف إلى سجلماسة قد تدل على أن هذه المدينة العريقة كانت مسقط رأسه، أو مكان نشأته ودراسته، أو كليهما معا، ولسجلماسة تاريخها المعروف بوصفها أحد مراكز العلم والتعليم في جنوبي المغرب الأقصى، ومنطلقا من منطلقات الحضارة الإسلامية المشعة نحو قلب القارة الإفريقية، ومن يدري لعل السجلماسي جلس أيضا للدراسة والتدريس في إحدى فترات حياته في مدينة مراكش نفسها، التي لا تبعد كثيرا عن سجلماسة، والتي عاش فيها حازم سنوات من شبابه، كما عاش فيها ابن البناء حياته كلها.[2]
العــنـــوان:
المنزع: جاء في لسان العرب يقال للإنسان إذا هَوِيَ شَيْئًا ونازَعَتْه نفسُه إِليه: هُوَ يَنْزِعُ إِليه نِزاعاً [3]، والمَنْزَعةُ مَا يرجِعُ إِليه الرَّجُلُ مِنْ أَمره ورأْيِه وتدبيرِه.[4]
ونستطيع أن نلمح من العنوان مظاهر الجدة التي سلكها السجلماسي في كتابه؛ فالمنزع يدل على معنى الاتجاه أو الطريق، ولفظة البديع الأولى تعني الجديد، أما لفظة البديع الثانية فتعني البلاغة؛ أي الاتجاه الجديد في تجنيس أساليب البلاغة. وكلمة أساليب التي ورد مصطلح البديع مضافا إليها، جعلها السجلماسي قوانين أساليب النظوم، يقول في ذلك: « وبعد، فقصدنا في هذا الكتاب الملقب بكتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع إحصاء قوانين أساليب النظوم التي تشتمل عليها الصناعة الموضوعة لعلم البيان وأساليب البديع، وتجنيسها في التصنيف، وترتيب أجزاء الصناعة في التأليف، على جهة الجنس والنوع، وتمهيد الأصل من ذلك للفرع، وتحرير تلك القوانين الكلية، وتجريدها من المواد الجزئية بقدر الطاقة، وجهد الاستطاعة[5]. وفي هذا المقام ذكرفضيلة الدكتور محمد الحافظ الروسي أن أشبه البلاغيين بحازم من هذه الوجهة هو السجلماسي صاحب المنزع، وذلك في رجعه صنعة البلاغة إلى أصولها وتحريره لقوانينها الكلية من موادها الجزئية. [6]
إن هذا العنوان المسجوع يوحي أن السجلماسي لا يختلف في نظرته إلى البديع عن الذين تكلفوا تكلفا في تقسيمه وتفريعه أضربا شتى، ولكن حين نتوغل في فصوله الداخلية فإننا نكتشف أننا إزاء تصور مخالف لما كان سائدا عن البديع، فصاحبه لا يهدف إلى إحصاء هذا الفن، فقد ابتعد عما كان مألوفا في البلاغة، وإذا تأملنا المحاور الرئيسية في الكتاب وما تفرع عنها من مباحث جزئية، تبين لنا أن البديع عند السجلماسي يشمل علوم البلاغة كلها من بيان ومعان ومحسنات لفظية ومعنوية [7]. وفي هذا المنحى يذكر محقق الكتاب علال الغازي أن عناوين كتب القرن الثامن في المغرب أبعدت الدارسين عن المضامين الحقيقية التي تمثل في بعدها ودلالاتها المضمونية والمنهجية والأسلوبية ما تهدف إليه عناوين التراث النقدي، إذ قضى العنوان البديعي على المضمون النقدي، فأبعد القارئ عن الوقوف على عالم خاص وجديد من الدرس النقدي الجديد الممتع والهادف، فالمنزع البديع والروض المريع ومنهاج البلغاء وغيرها، جنت على أهداف مؤلفيها وبالتالي على الثورة التي كان من الممكن أن تحدثها في الدراسة العربية الحديثة لو أن القارئ اطلع على هذه الكتب ليقف على تمردها على تلك العناوين المسجوعة والموجهة أو الموحية بأنها تدور في الفلك البلاغي عموما والبديعي خصوصا، في حين أنها تمثل منظورا آخر ومنهاجا فريدا وشمولية في الاصطلاح ما كانت لغيرها من كتب القدماء أو المعاصرين في الشرق كالطراز ومعاهد التنصيص وغيرهما.[8]
تطورمصطلح البديع:
إذا كانت لفظة البديع تعني في اللغة كل جديد محدث ومخترع، فإنها في البلاغة من المصطلحات الثلاث التي انقسم إليها علم البلاغة بعد السكاكي حيث أصبح علما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة[9]. ولقد ارتبط البديع بتطور جانبين متوازيين من الثقافة العربية: الشعر والنثر/ والنقد والبلاغة، فبينما عرف العرب القدماء منذ الجاهلية إلى ما قبل العصر العباسي بقليل تطورا مرحليا في أدبهم امتازوا فيه بالسليقة والاعتماد على الذوق والطبيعة بعيدا عن التكلف والتصنع، كان النقد والبلاغة أيضا يغرفان من ذلك اللون الذوقي في التقييم والحكم على الأثر الأدبي، وقدعرف الأدب العربي عصرين متباينين: عصر القدماء وعصر المحدثين، يبتدئ الثاني قبيل قيام الدولة العباسية من عهد بشار بن برد وإبراهيم بن هرمة، ومروان بن أبي حفصة، ومطيع بن إياس، وغيرهم من مخضرمي الدولتين ويشمل كل من جاء بعدهم ممن زاولوا صناعة الشعر العربي إلى اليوم[10]، مع ما يمكن رصده من تباين شعراء الأحقاب اللاحقة من اعتدال أو إغراق في محسنات الصناعة الشعرية، فلما كان القرن الثاني الهجري أخذ الشعر العربي يلبس رويدا ثوبا من الزخرف والتنسيق قصد توشيته بحلى وزخارف لا عهد له بها - على هذا النحو- ذلك هو الذي وقع عليه فيما بعد اسم البديع. [11]
ومن جهة فقد عرف القدماء الطباق، ومراعاة النظير، والإرصاد، والمشاكلة، والاستطراد، والتبديل، والتورية، واللف والنشر، وغيرها من المصطلحات التي نجدها مبثوثة في أشعارهم وأقوالهم وكذلك في آي الذكر الحكيم، ومع أنهم لم يقصدوا إليه فقد جاءهم عفوا وغزا شعرهم وأقوالهم في يسر وأناة « العرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل، فتترك لفظة للفظة، أو معنى لمعنى، كما يفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية الشعر، وإحكام عقد القوافي وتلاحم الكلام بعضه ببعض»[12]. وكانت العرب إنما تُفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحّته، وجزالة اللفظ واستقامته[13]. ولكن التغيير التدريجي ثم المفاجئ الذي عرفه المجتمع العربي مع صدر الإسلام والأمويين، ثم انتقاله القوي إلى العهد العباسي انعكس على الشعر كما انعكس على النقد والبلاغة، حيث انتقل من الشعر المطبوع إلى المصنوع فإلى لون فيه من التكلف والتصنع، ما أعطاه بحق تلك الظاهرة التي عرف بها أجيال طويلة بصور متفاوتة سواء في الفن أو في النقد والبلاغة التي تجاوزت أحيانا الطرح الشعري لدى الشعراء، بينما انفرد بعضهم بإبداعات تجاوزت النظر النقدي أحيانا، والانطلاقات الكبرى في التعامل مع الرؤى الفنية ثم النقدية اليونانية، وتجاوزها عند حازم والسجلماسي جعلت التنظير يتجاوز الشعر كثيرا. وهكذا يصبح للبديع مصطلحه الخاص بين المصطلحات فبينما كان يراد منه عند الجاحظ علم البلاغة بكل أقسامها، إذ بالبديع يحاول أن يتخذ لنفسه استقلالا نسبيا عن البلاغة، ولكنه ظل عالقا بعلمي المعاني والبيان عند ابن المعتز« وما ذكره من البديع والمحاسن خليط عند بعضه أخيرا من علم المعاني، كالالتفات والاعتراض، وتجاهل العارف، وبعض من علم البيان كالاستعارة، وحسن التشبيه، والتعريض والكناية، وبعضها من البديع الاصطلاحي»[14]، وأضاف الدكتور علال الغازي أنه لم يستطع أن يستقل حتى عند السكاكي نفسه الذي جعل منه تابعا لعلمي المعاني والبيان ولم يفرد له بابا خاصا كما سيفعل شراح المفتاح فيما بعد مثل الخطيب القزويني في تلخيصه، ومع ذلك استقل في أنواع تكاثرت واختلف النظر إلى تكاثرها وتنوعها من دارس إلى آخر، حتى وقع المصطلح في يد السجلماسي فأعطاه طابعا خاصا إذ أصبح يكتسي صبغة تراجعية عن الاستقلال الذي عرفه على يد المتأخرين بعد ابن المعتز، وكذا السكاكي الذي يقف في نقطة بداية التحول من مفهوم إلى آخر في دنيا تحديد علم البلاغة ومن ضمنها البديع، والسجلماسي وضع المصطلح في إطار التجنيس وعالجه من خلال محورين رئيسيين: التنظير الفلسفي: المنطقي، وبالطبع ما عرفه النقد والبلاغة العربية من تطور، والتطبيق العملي.[15]
عن المؤلَّف:
مادة الكتاب ومنهج السجلماسي فيه:
يعد كتاب المنزع البديع الأثر الوحيد الذي صنفه السجلماسي والذي وصل إلينا؛ وهو من المصادر البلاغية المندرجة في إطار ما يسمى بالمدرسة البلاغية الفلسفية في الغرب الإسلامي، وما إن يذكر هذا الكتاب إلا ويذكر معه كتاب «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لحازم القرطاجني (ت: 684هـ)، وكتاب «الروض المريع في صناعة البديع» لابن البناء المراكشي (ت: 721 هـ) نظرا لاتحاد خصائص هذه المصادر الثلاثة وامتيازها في الفلسفة والمنطق، واهتمام أصحابها بالتفريعات والتقسيمات للمصطلح النقدي والبلاغي، حتى يتسنى وضع قوانين للشعر والنثر عند العرب، واستخدام معايير المنطق لضبط هذه القوانين وتنظيمها. ومنهج السجلماسي في منزعه يمكن تحديده في خطوات؛ فقد افتتح السجلماسي كتابه بتمهيد تناول فيه قيمة البيان في حياة الإنسان، إذ به يستطيع فهم أسرار الإعجاز القرآني بيانا ومعنى وتذوقا وإدراكا لما تفتقت عنه ألسنة المبدعين، فهو يقول:« الحمدُ لله المُمْتَنِّ علينا بشَرفِ النُّطق، المُسْجِلِ لنا من حسن بيانه بإحراز خَصْلِ السَّبْقِ النّاهج بهذه الصَّنعة البلاغية والمَلَكَة البيانية إلى الوقوف على لطائف معاني تنزيله أنهجَ الطُّرق، الميسِّرِ بها على خواص عباده أنموذجا من معرفة وجه إعجاز نَظْمه كافَّةَ الخَلْقِ، الفاتِقِ ببديعِ بديع مباهجِ مناهجِ سحرِها الألسنة أبدعَ الفَتق»[16]، وبعد هذه المقدمة التمهيدية عمل السجلماسي على تحديد موضوع المنزع من خلال مباحثه العشرة مع رصد موجز لأهم عناصره المنهجية في مناقشة قضاياها، وتمثلت هذه الأجناس في: الإيجاز، والتخييل، والإشارة، والمبالغة، والرصف، والمظاهرة، والتوضيح، والاتساع، والانثناء، والتكرير. فالسجلماسي رجع البلاغة كلها إلى كليات عشر وسماها أجناسا عالية كما سمى المناطقة المقولات أجناسا عالية. فكأن بحث هؤلاء البلاغيين المناطقة عن كليات في البلاغة إنما كان متأثرا ببحث شيخهم أرسطو عن كليات منطقية.[17]
ثم انتقل المؤلف إلى تتبع كل جنس ورصد تفريعاته الاصطلاحية ومفاهيمه مع بيانها تنظيرا وتطبيقا، فكان الجنس الأول الذي بدأ به هو الإيجاز والذي قال عنه: وموضوع اسم الإيجاز مَقُول بمعنى الاختصار مرادف له.[18]
وفي تحديده للمصطلح وقف السجلماسي على الجانب اللغوي ثم استعماله الجمهوري[19] قبل الوقوف على مفهومه الاصطلاحي المحدد نظريا عنده أولا، ثم طرح آراء الآخرين عربا أو يونانا ثانيا مؤكدا أو رافضا مع التعليل للجهتين، قبل أن يفصل الصور التطبيقية على أساس التنظير. كما ينطلق السجلماسي من مصطلحين كبيرين في تحديده لكل جنس هما الموطئ والفاعل، قاصدا بالموطئ المعنى أو القاسم المشترك الذي يضم التفريعات اللاحقة المتولدة مباشرة، بينما يقصد بالفاعل القانون العلمي النظري العام، الذي يمثل القاسم المشترك بين المصطلحات التي تلتحم في وضعها الفلسفي المنطقي، بدلالتها النقدية والبلاغية وفق نظام لغوي بنيوي متجذر ومحدد. وقد كان يعتمد على شخصيته وثقافته الموسوعية في التخطيط لفلسفة نقدية وبلاغية مستعينا بآراء اللغويين والنحاة والأدباء والنقاد من جهة، وبالفلاسفة والمناطقة من مفكري المسلمين واليونان من جهة أخرى.[20]
لقد أبان السجلماسي منذ الوهلة الأولى في منزعه عن غايته من تأليف الكتاب، فقد هدف إلى تحقيق غايات متعددة؛ منها الوقوف على لطائف معاني القرآن ومعرفة وجوه إعجازه، فذكر أن الغاية من الصنعة البلاغية والملكة البيانية هي الوقوف على لطائف معاني تنزيله وتقديم أنموذج من معرفة وجه إعجاز نظمه كافة الخلق[21]، ومنها تنقية البلاغة العربية من التقسيم وتداخل الأقسام ولذلك فقد أحصى قوانين أساليب النظوم التي تشتمل عليها الصناعة الموضوعية لعلم البيان وأساليب البديع وتجنيسها في التصنيف وترتيب أجزاء الصناعة في التأليف على جهة الجنس والنوع[22]، وتحقيقا لهذا الهدف فقد عمد إلى الكتب البلاغية السابقة عليه واستخرج منها أساليب وصنفها بحسب الصناعة المنطقية؛ أي على أساس ترابط وتناسب وتراتب، ومن يرجع إلى الكتاب يدرك مجهودا جبارا في القراءة وفي التصنيف وفي الترتيب وفي تقديم قوانين للتأليف يسير على هديها الناثر والناظم للإقناع والإمتاع [23]. ويمكن القول إن السجلماسي تولى البحث في كليات بلاغية تكون كالمقولات بالنسبة للمنطق، ولكنه بحث في مرحلة الفعل أو الظهور.[24]
تعرض المنزع من خلال مباحثه العشرة لعدة قضايا نقدية تجاوزت الحدود البلاغية كما يجد الناظر إليها من خلال هذا النص المغربي الفريد، وقد جعل السجلماسي الإيجاز الجنس العالي الأول من أجناس علم البلاغة العشرة وعرفه بأنه قول مركب من أجزاء فيه مشتملة بمجموعها على مضمون تدل عليه من غير مزيد[25]، وبحسب الجانب المنطقي الأرسطي لا يوجد مبرر لتقديم دراسة الإيجاز على غيره من الأجناس، لأن الإيجاز جنس عال والجنس العالي لا يرتب تحت شيء، ولا يحمل على شيء آخر أصلا، لذلك لا يمكن أن يرتب جنس الإيجاز تحت جنس التخييل ولا يحمل عليه، ومثل هذا يقال في باقي الأجناس الأخرى، لا علاقة بين هذه الأجناس من حيث المبدأ، فكل منها له هويته وشخصيته المستقلة، وله مسافته الفاصلة، وهذه المسافة الفاصلة بين الأجناس متساوية، وعليه فإن المؤلف كان من الممكن له أن يبدأ بأي جنس أراد[26]، وقد ابتدأ السجلماسي بالإيجاز لأنه من أهم خصائص اللغة العربية، فقد كان العرب لا يميلون إلى الإطالة والإسهاب وكانوا يعدون الإيجاز هو البلاغة.[27]
أما الجنس الثاني فقد سماه السجلماسي التخييل، فيقول في هذا المنحى: هذا الجنس من علم البيان يشتمل على أربعة أنواع تشترك فيه، ويحمل عليها من طريق ما يحمل المتواطئ على ما تحته؛ وهي: نوع التشبيه، ونوع الاستعارة، ونوع المماثلة- وقوم يدعونه التمثيل- ونوع المجاز، وهذا الجنس هو موضوع الصناعة الشعرية. ويعد التخييل مسألة نقدية مهمة في الكتاب لكونه أداة فعالة في العمل الأدبي[28]، كما يأتي التخييل مرادفا للمحاكاة والتمثيل كما يقول السجلماسي: «والتخييل هو المحاكاة والتمثيل، وهو عمود الشعر إذ كان به جوهر القول الشعري وطبيعته ووجوده بالفعل»[29]. يشير مصطلح التخييل عند السجلماسي إلى الاستخدام الخاص للغة في الشعر، الذي يعتمد على التصوير أو الانحراف من خلال علاقات المقارنة أو الإبدال أو النسبة، كما يتمثل في التشبيه والاستعارة والتمثيل والمجاز، كما أنه يستخدم مرادفا للمحاكاة من ناحية أخرى، فضلا عن أنه جوهر الصناعة الشعرية، ذلك أنه يميز الشعر عما عداه من المستويات اللغوية الأخرى.
والتخييل بهذا المعنى له أصوله عند الفلاسفة المسلمين، بل إن مصطلح التخييل نفسه مصطلح خاص بالفلاسفة وحدهم، استخدموه في حديثهم عن الشعر بدلالات متعددة، تتصل بالتشكيل الجمالي في العمل الشعري من ناحية، وبالتأثير الذي يحدثه أيضا من ناحية أخرى[30]، وقد استند استخدامهم لهذا المصطلح إلى أساس سيكولوجي ومعرفي مرتبط أشد الارتباط ببنائهم الفلسفي الشامل، فالتخييل عند أولئك مرادف للمحاكاة ومقترن بها، وكلاهما يستخدم للدلالة على الجانب التصويري في الشعر، من تشبيه واستعارة ومجاز، أما استخدام مصطلح التخييل للدلالة عل الصياغة الشعرية، من زاوية تركيزها على الجانب التصويري، بحيث يصبح متضمنا الصور البلاغية، فواضح عند ابن رشد حيث يقول: وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة: اثنان بسيطان وثالث مركب منهما، أما الاثنان البسيطان فأحدهما تشبيه شيء بشيء وتمثيله به، وأما النوع الثاني فهو أخذ الشبيه بعينه بدل الشبيه، وهو الذي يسمى الإبدال في هذه الصناعة، وينبغي أن تعلم أن في هذا القسم تدخل الأنواع التي يسميها أهل زماننا استعارة وكناية؛ وأما القسم الثاني فهو أن يبدل التشبيه، مثل أن تقول: الشمس كأنها فلانة، والصنف الثالث من هذه الأقاويل الشعرية هو المركب من هذين[31]. وإقدام السجلماسي على تعريف الشعر هو خطوة مترتبة على تقديمه للتخييل بوصفه موضوعا للصناعة الشعرية، والتعريف الذي يقدمه للشعر يضرب بجذوره إلى الفارابي وابن سينا وابن رشد، وفي ذلك يقول السجلماسي: الشعر هو الكلام المخيل المؤلَّف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقفاة، فمعنى كونها موزونة: أن يكون لها عدد إيقاعي، ومعنى كونها متساوية هو: أن يكون كل قول منها مؤلَّفا من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر؛ ومعنى كونها مقفاة هو: أن تكون الحروف التي يُخْتَم بها كلّ قول منها واحدة[32]، وارتكاز السجلماسي على هذا التعريف يكشف عن صلته بالفلاسفة، خصوصا عندما يلح على أن التخييل هو السمة الجوهرية التي تكسب القول صفة الشعر، ويليه في الأهمية الوزن فالقافية، أو أن القافية لاحقة خاصة بالشعر عند العرب دون غيرهم[33]. لقد أكد الفلاسفة أولية عنصر التخييل على الوزن في الشعر، مع ضرورة اجتماعهما معا لتحقيق السمة الشعرية كاملة، فليس كل قول موزون يعد شعرا، وهذا نص الفارابي يؤكد هذا المعنى: فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكى الأمر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية، ثم سائر ما فيه، فليس بضروري في قوام جوهره، وإنما هي أشياء يصير بها الشعر أفضل، وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة، وعلم الأشياء التي بها المحاكاة وأصغرها الوزن[34]. ويلتقي السجلماسي في رؤيته للشعر وتعريفه له على هذا النحو مع حازم القرطاجني الذي حرص على أن يقدم الشعر بوصفه كلاما موزونا مقفى [35]، أو أنه كلام مخيل موزون، مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك [36]. لقد وضع الفلاسفة للسجلماسي أسسا نظرية ناقش بمقتضاها تصور علماء البيان وأهل صنعة البلاغة للشعر، وذهابهم إلى أن الوزن هو جوهره دون التخييل.
كما نجد السجلماسي يستخدم مصطلح التخييل في سياق آخر، فيكتسب دلالة جديدة يمكن أن تفهم من خلالها إلحاحه على كون الشعر مخيلا، وأن جوهره التخييل أو التمثيل، فيقول في هذا المقام: إن الذي استقر عليه الأمر في صناعة المنطق عند محققي الأوائل هو أن موضوع الصناعة الشعرية هو التخييل والاستفزاز والقول المخيل المستفَزّ من قبل أن القضية الشعرية إنما تؤخذ من حيث التخييل والاستفزاز فقط، دون نظر إلى صدقها وعدم صدقها[37]، وما نلحظه في هذا النص إشارة السجلماسي إلى أصحاب المنطق، وهم الذين يمدونه بالأسس النظرية والمصطلح الذي يقدم به مفهومه للشعر بصفة عامة.
وبناء على هذا كله يصبح قول السجلماسي: إن الشعر تخييل واستفزاز دال على التأثير الذي يحدثه الشعر؛ وهو تأثير ركيزته الانفعال، فالتخييل بهذا المعنى يدل على الاستجابة النفسية التي تحدث للمتلقي.[38]
صنف السجلماسي الإشارة الجنس الثالث من الأجناس العشرة العالية، والإشارة عنده من جانبها اللغوي من أشار يشير كأنه الإيماء إلى الشيء والإلماع نحوه[39]، وأما بلاغيا فقد دلت على العبارة عن المعنى بلوازمه وعوارضه المتقدمة، أو المتأخرة، أو المساوِقة، من غير أن يصرّح لذلك المعنى بلفظ أو قول يخص ذاته وحقيقته في موضوع اللسان[40]. إن أول من استحدث مفهوم الإشارة بعد أن استمد أفكاره من الفلسفة اليونانية هو الجاحظ، وقد نشأ هذا المفهوم عنده وجعله ضمن وسائل البيان الخمسة التي هي:« اللفظ، ثم الإشارة، ثم العَقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نِصبة»[41]، وما أكثر ما تنوب الإشارة عن اللفظ، وما تغني عن الخط، ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص[42]. وتوسع السجلماسي في شرح أنواع الإشارة مبينا أهميتها بوصفها ترتبط بالتجاوز والخروج عن المألوف، وقد ربطها السجلماسي بالمتلقي من حيث اللذة والاستفزاز اللذان ينتجان عن النص الإبداعي، يقول في ذلك: وفي ذلك ما فيه من الإلذاذ للنفس والإطراب لها بالغرابة والطَّراءة التي لهذا النوع من الدلالة، والسبب في ذلك كله هو ما جُبِلَت النفس عليه وعُنِيَتْ به وجُعلَ لها من إدراك النِّسَب، والوصل، والاشتراكات بين الأشياء، وما يلحقها عند ذلك ويعرض لها من انبساط روحاني وطرب.[43]
ويندرج تحت الجنس العالي الإشارة نوعان متوسطان هما: الاقتضاب والإبهام، والإقتضاب يندرج تحته نوعين متوسطين هما: التنويه والتعمية؛ ويندرج تحت التنويه التفخيم والإيماء، وتحت التعمية اللحن والرمز والتورية والحذف. وما يلاحظ في هذا الجنس العالي أن السجلماسي عمل على توظيف الشواهد القرآنية انطلاقا من السور المكية للاستعانة بها في تمثيل أساليب جنس الإشارة، ويمكن مرد ذلك إلى قول الجاحظ الذي تفطن إلى مزية الخطاب القرآني في مخاطبة القرآن للعرب وبني إسرائيل حيث قال: «ورأينا الله تبارك وتعالى، إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم، جعله مبسوطا، وزاد في الكلام».[44] وصنف السجلماسي المبالغة الجنس الرابع من الأجناس العشرة العالية في الترتيب، ويعد هذا الجنس أوسع أجناس البلاغة العشرة مساحة في المنزع، وأكثرها مصطلحات وأغزرها أجناسا متوسطة وأنواعا، والمبالغة في اللغة كما عرفها السجلماسي مثال أول لقولهم: «بالغ في الأمر يبالغ فيه إذا أفرط وأغرق واستفرغ الوُسع» هذا هو موضوعه في اللغة[45]، وفي هذا المقام قدم المؤلف التعريف الاصطلاحي للمبالغة للباقلاني حيث أشار إليه بكلمة قوم من دون ذكر اسمه صراحة، فقال: «وقال قوم: والمبالغة: تأكيد معاني القول» [46]، ويتفرع جنس المبالغة في المنزع إلى نوعين: الأول العدل وهو يختص بأبنية المبالغة في الألفاظ المفردة، والثاني المبالغة ويتمثل في الألفاظ المركبة فهذا النوع أنجب أنواعا متعددة وهي التي تدخل ضمنها فنون البديع المتمثلة في الإغراق، والتداخل، والاستظهار، والإطناب، والسلب والإيجاب، فتحت الإغراق يضع الغلو والتجاهل والتجريد والاستثناء، وفي تتبع السجلماسي لهذا المسلك انتقده أحد البلاغيين المعاصرين فقال في هذا الجانب: « ويظل يُحوِّل الأنواع إلى أجناس، والأجناس تحتها أنواع، في محاولة صارمة لضبط المعايير، وضم الأشتات وتجميد الأطراف، حتى استوت البلاغة على يديه إلى تمثال ضخم من الحديد، هم كل فرع فيه أن يكون له أصل، وكل أصل فيه أن يكون له دور، في «شجرة التركيب البنيوي» للبلاغة في نظر السجلماسي، مما تضاءل معه صنيع الرازي، والسكاكي والقزويني وشراح تلخيصه»[47]. وخلص إلى أن السجلماسي حاول أن يطعم حديثه المنطقي بأمثلة من الشعر، وبحديث عن الأصل اللغوي للمصطلح، ولم ينجح كل هذا في إخفاء صرامة منطقه وصلابة تقسيمه، وغياب اللمسة الجميلة من الكتاب كله.
جعل السجلماسي الرصف جنسا عاليا خامسا، وعرفه بقوله: وأصل الرصف عند الجمهور هو مثال أول لقولهم: رصف بين شيئين: ضم بينهما [48]، وذكر تعريف صاحب العين: الرَّصَفُ حِجارةٌ مَضمومَةٌ بعضها الى بعض في مَسيل [49]، وحدد السجلماسي دلالة هذا الجنس في الصناعة البلاغية من خلال الدلالة اللغوية التي تعني الضم، فعرفه بأنه القول المركب من أجزاء فيه لها وضعُ بعضها عند بعض، واقتضاءُ بعضها وترتيبٌ لبعض[50]. ويستنتج من هذا النص أن الألفاظ والمعاني المركبة لأجزاء القول في جنس الرصف تقوم بينها علاقات مترابطة تشتمل ثلاثة عناصر هي الوضع والاقتضاء والترتيب؛ ذلك أن هذه الألفاظ والمعاني توظف في مواضعها وفق انتظام وترتيب معين، ولذلك يقررالسجلماسي بأن حاصل هذا الجنس هو وضع في القول.[51]
وقد حاول السجلماسي أن يوفق بين مفهوم الوضع كما حدد في مقولات أرسطو، وبين الوضع في القول والبلاغة؛ فالوضع عند أرسطو لا قول له، في حين أن الوضع في البلاغة يستلزم القول ويوجبه، وفي هذا الشأن اهتدى المؤلف إلى حل هذا الإشكال فرأى أ
بأن حال القول في وجود هذا وثباته كحاله في دلالته على الأمر، فإنه بالوجه الذي يقال فيه مع تَقَضِّي أجزائه أولا فأولا: إنه دال على شيء ما من الأشياء، فبذلك الوجه بعينه يقال فيه: « إنه ثابت وموجود»، وبذلك الوجه بعينه يقال فيه: « إنه في مقولة الوضع»، وكذلك الوجه الذي يحصل به موجودا به يكون دالا، وبالوجه الذي يكون دالا يكون في مقولة الوضع، فإذن هذا الجنس من علم البيان (الرصف) هو وضع قائم في القول الواقع فيه بالنحو الذي له من الوجود[52]، وقد كان هدف السجلماسي من هذا الجنس أن يضم تحته كل الأنواع التي يرى أنها تسير وفق ترتيب وانتظام كما يقتضي بذلك المعنى اللغوي للرصف.
وقد صنف السجلماسي المظاهرة جنسا عاليا سادسا، ووضع هذا المصطلح ضمن منظور منطقي يقوم على الجمع في مقولة واحدة بين وسيطين هما المزايلة الذي يمثل التنافر والتخالف، والمواطأة وهو مجال التلاؤم والتناسب، فبين المصطلحين تناقض لا ينسجمان معا وهو ما ذكره المؤلف حيث قال: هل يمكن إرقاؤهما إلى جنس واحد يعمهما ويحمل عليهما حملا تعرف به ماهيتهما ويشتركان في جوهره المشترك؟[53] وقد التجأ السجلماسي في جنس المظاهرة إلى منطق أرسطو، فوقف عند أنواع التضاد الواردة في المتقابلات الواردة في كتاب أرسطو الذي قال فيها: وقد يجب في كل متضادين إما أن يكونا في جنس واحد بعينه؛ وإما أن يكونا في جنسين متضادين؛ وإما أن يكونا أنفسهما جنسين: فإن الأبيض والأسود في جنس واحد بعينه، وذلك أن جنسهما اللون، فأما العدل والجور ففي جنسين متضادين، فإن الجنس لذاك فضيلة، ولهذا رذيلة، وأما الخير والشر فليس في جنس، بل هما أنفسهما جنسان لأشياء[54]. ووفق التصور الفلسفي عرف السجلماسي المظاهرة بأنها قول مركب من جزئين كل جزء منهما يدل على معنى هو عند الآخر بحال ما[55]، فالقول إما أن يركب من الجنس المنافري فهو النوع المدعو المزايلة، وإما أن يركب من جنس الملائمي وهو النوع المدعو المواطأة.
ومن جهة حدد السجلماسي التقابل في المصطلحات المتفرعة عن المزايلة وهي المباينة والمطابقة والمكافأة والمقايضة، وساق لها عددا من الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية. كما نجد السجلماسي يعترض على اللغويين والبلاغييين أمثال قدامة بن جعفر، الذين يعتبرون المطابقة هي التماثل والتلاؤم، فهي في أصلها اللغوي من «طابَقَ ومُطابِقٌ: خَالَفَ ونَافَرَ ومُنَافِر»، لا شاكل ووافق ولاءم على ما يظنه قوم من العلماء [56]، فيؤكد بأن المطابقة في موضوع اللغة العربية هي المخالفة والمنافرة، وفي هذا المنحى قدم أقوال بعض علماء اللغة من قبيل الخليل بن أحمد وعبد الله بن المعتز الذين نقلوا اسم المطابقة على معنى المنافرة والمخالفة إلى هذا النوع من علم البيان، فالمطابقة عند السجلماسي تقوم على تصور فلسفي، يقول في هذا الجانب: «ويظهر أنه ينبغي أن يُفْهَم من اسم المطابقة في هذه الصناعة ما يُفْهم من اسم التقابل في صناعة المنطق».[57]
يعتبر التصدير عند السجلماسي أحد المكونات الشعرية الفرعية التي تنسجم مع المكونات الشعرية الرئيسية لديه والتي تتجلى في التشبيه والاستعارة والمماثلة والمجاز، وقد ربط السجلماسي التصدير بالنثر والقرآن، فقد اعترض على علماء البلاغة الذين يجعلون التصدير مخصوصا بالقول الشعري ولدحض تلك الفكرة ذكر أن «التصدير يقع في الأقاويل كلها شعرية كانت أو غير شعرية» [58]، وقدم السجلماسي الشواهد الدالة على نثرية المصطلح، فبدأها بأمثلة من النثر، وأردفها بآيات من القرآن الكريم، ثم ذكر أن سبب من يدعي أن التصدير لا يقع إلا في الأقاويل الشعرية فقال: « والظن بمن منع ذلك أن مثار شبهتهم وسبب غلطهم دوام الأنس بالقوافي، والاعتياد للأقاويل الشعرية مع وضوح هذا النوع من النظم فيها، وذلك لإدراك العَجُزِيَّة في القافية بالفعل وحِسًّا» [59].
وصنف السجلماسي التوضيح بوصفه جنسا عاليا سابعا وبين المقصود فيه في الصناعة البلاغية هو تَوْفِيَّةُ الدلالة على المعنى أقصى غاياتها والبلوغ بها أبعد نهايتها، وهو اسم لمحمول يشابه به شيء شيئا في جوهره المشترك لهما[60]، وقسم المؤلف التوضيح إلى نوعين: البيان والتفسير، وقد كان يعني بالبيان المعنى العام للكلمة المشتملة على معايير القول وموازين الكلام من وضوح وانكشاف لإظهار المعنى الغامض بعيدا عن العسر والتعقيد، ويشترط أن تتوفر خمسة شروط في ذلك وهو أن يكون بالأفصح من الألفاظ، والأجزل منها، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا، وأثبتها إبانة عند النفس[61]، ولذلك قرر أن تقع العبارة مستقلة الدلالة بذاتها من غير حاجة إلى غيرها[62]، وفي هذا المقام نجد تأثير الجاحظ جلي في شروط السجلماسي للكلام عندما جعل اللفظ أقوى أصناف الدلالات على المعاني، وقال إن البيان يحتاج إلى تمام الآلة وإحكام الصنعة، وإلى سهولة المخرج وجَهارة المنطق، وتكميل الحروف وإقامة الوزن، وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة، كحاجته إلى الجزالة والفخامة، وأن ذلك من أكثر ما تُستمال به القلوب، وتُثْنَى به الأعناق[63]، ورغم تأثر السجلماسي بالجاحظ فإننا نجده كثيرا يعتمد على ما ورد في كتاب النكت للرماني فقد نقل عنه جل الشواهد القرآنية، وكان له رأية الشخصي الذي ظهر عندما طبق مفهومه لكلمة البيان فهو لا يوافق الرماني على استعمالها مضافة للفظة حسن، فقال إن ما ذهب إليه وهم عرض له وغلط[64]، ومن ثم ليس هناك بيان حسن وآخر سيء، مستدلا بالشاهد القرآني الذي استدل به الرماني في مدح الله عز وجل للبيان، يقول تعالى: «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ القُرْآنَ خَلَقَ الإنْسَانَ عَلَّمَهُ البَيَانَ»[الآيات: 1-4] فقد رأى السجلماسي أن هذا الشاهد يعد دليلا عليه وليس له لعدم وجود أنواع للبيان توصف بالحسن أو القبح، وهذا بإقرار الرماني عندما قال: وليس بحسن أن يطلق اسم بيان على ما قبح من الكلام لأن الله قد مدح البيان واعتد به في أياديه الجسام. [65]
ويتضح من خلال تنظير السجلماسي للبيان فإننا نجد أنه يذكر الشاهد القرآني ثم يعقب عليه تعقيبا موجزا وهو ما نجده عند الرماني، فصاحب المنزع عمل على توظيف جميع الشواهد القرآنية التي ساقها صاحب النكت بكل تعليقاتها المقتضبة.[66]
وجعل السجلماسي الاتساع جنسا عاليا ثامنا، وعرفه بأنه صلاحية اللفظ الواحد بالعدد للاحتمالات المتعددة من غير ترجيح[67]، والاتساع عند ابن رشيق هو أن يقول الشاعر بيتاً يتسع فيه التأويل؛ فيأتي كل واحد بمعنى، وإنما يقع ذلك لاحتمال اللفظ، وقوته، واتساع المعنى[68]. فالاتساع يسمح للمبدع أن يتجاوز المعاني الأول إلى المعاني الثواني التي تـشكل بنيـة النص، ما يمنحه خصوصيته الفنية ويمنح المتلقي فرصة للمشاركة فـي إنتـاج الـنص الإبداعي فالاتساع هو الذي يضع القارئ في دائرة التأويل. [69]
وقسم السجلماسي الاتساع إلى نوعين الأول الاتساع الأكثري، والثاني الاتساع الأقلي، ولإيضاح المفهوم البلاغي لهذين القسمين أورد المؤلف مجموعة من الشواهد الشعرية والقرآنية.
وجعل السجلماسي الانثناء الجنس العالي التاسع وهو في الاصطلاح تردد المتكلم بين جهتي قول وجنبتي كلام[70]، فهو جنس متوسط تحته نوعان: أحدهما الانفتال، والثاني العدول، وضمن الالتفات النوع الأول من الانفتال، وجمع السجلماسي تحت نوع الانفتال أنواعا من فنون البديع شهد بعضها تداخلا، وقد عمد المؤلف إلى التمييز بينها، خاصة في نوع الالتفات الذي تجاذب مع مصطلح الاعتراض، إذ اعتبره بعض البلاغيين نوعا مشتركا معه، وفي هذا المنحى ذكر ابن رشيق: و الاعتراض عند قوم، وسماه آخرون الاستدراك، حكاه قدامة، وسبيله أن يكون الشاعر آخذاً في معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به، ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شيء مما يشد الأول، كقول كثير:
لَوْ أَنَّ البَاخِلِينَ، وَأَنْتِ مِنْهُم، /// رَأَوْكِ تَعَلَّمُوا مِنْكِ المِطَالَا
فقوله وأنت منهم اعتراض كلام في كلام[71]. وقدم السجلماسي للالتفات ثلاثة شواهد قرآنية وذلك لبيان موضع الالتفات فيها في قوله تعالى: « الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين الرَّحْمـنِ الرَّحِيم مَـالِكِ يَوْمِ الدِّين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين»[الفاتحة: الآيات: 2-3-4] واكتفى بالقول التفات لأنه انصراف من إخبار إلى مخاطبة [72]، وفي هذه الآية يقول الطاهر بن عاشور: وما هُنا الْتِفَاتٌ بَديعٌ فَإنَّ الحامِدَ لَمَّا حَمِدَ اللَّه تَعالَى وَوَصَفَهُ بِعَظيمِ الصِّفاتِ بَلَغَتْ به الفِكْرَةُ مُنْتَهاها فَتَخَيَّلَ نَفْسَهُ فِي حَضْرَةِ الرُّبُوبِيَّةِ فَخاطَبَ رَبَّهُ بِالإِقْبَالِ[73]. ثم قدم شاهدان آخران ترك أمرهما للمتلقي وهما قوله تعالى: « وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»[فاطر: 9]، وقوله تعالى: « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا»[فاطر: 27]. وبخصوص الآية الأولى يقول الزمخشري في بيان سبب الالتفات في الآية سوق السحاب إلى البلد الميت، وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها: لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: فــ«سُقْنَا»، و«أَحْيَيْنَا»، معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدلّ عليه[74]، هناك صورة أخرى للالتفات في الآية وهي العدول عن الفعل الماضي في «أرسل» إلى صيغة المضارع «فتثيره»، وأشار إلى ذلك ابن الأثير بقوله: إنما قيل: «فَتُثِيرُ»، مستقبلا وما قبله وما بعده ماض، لذلك المعنى الذي أشرنا إليه، وهو حكاية الحبل التي يقع فيها إثارة الريح السحاب، واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة.[75]
أما بخصوص الآية الثانية فقد تبينت صورة الالتفات من الغيبة إلى المتكلم، حيث أسند فعل الإنزال إلى ضمير الغيبة في قوله: «أنزل»، ثم عدل عن ذلك إلى ضمير المتكلم في قوله «فأخرجنا» لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الفَخامَة، إذْ هو مُسْنَد للمُعَظَّم المُتَكلِّم، ولأنّ نِعْمة الإخْراج أَتمّ من نعمة الإِنْزال لفائدة الإِخْراج، فأُسْنِد الأَتَمُّ إلى ذاته بضمير المتكلِّم، وما دُونَه بضَمير الغائب[76]. وفي مقام الالتفات خلص السجلماسي إلى أن «فائدة هذا الأسلوب من النظم والفن من البلاغة استقرار السامع والأخذ بوجهه، وحمل النفس بتنويع الأسلوب وطراءة الافتنان على الإصغاء للقول والارتباط بمفهومه».[77]
وقد صنف السجلماسي التكرير في الجنس العاشر وهو آخر الأجناس العشرة في المنزع، وعرفه في اللغة بأنه من كَرَّرَ تكريرا: رَدَّد وأعاد، والتكرار فيه بنية مبالغة وتكثير، وفي الاصطلاح هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع أو المعنى الواحد بالعدد أو بالنوع في القول مرتين فصاعدا [78]، كما أن التنصيص على أن تكون الإعادة بالعدد كشف على أن التكرار قد يكون في اللفظ والمعنى معا، وهو بتعبير اللسانيات النصية إعادة العنصر المعجمي نفسه [79]، إن التعريف الذي وضعه السجلماسي للتكرير كشف عن الأقسام التي انقسم إليها هذا الجنس وهما المشاكلة والمناسبة، وقد جعل المشاكلة تنتج التكرير اللفظي، والمناسبة تنتج التكرير المعنوي. ويدرج السجلماسي تحت جنس الاتحاد نوعين الأول البناء والثاني التجنيس، أما البناء فقد عرفه بأنه إعادة اللفظ الواحد بالعدد وعلى الإطلاق المتحد المعنى كذلك مرتين فصاعدا، خشية تناسي الأول لطول العهد به في القول [80] وهذا المفهوم كما أشار إلى ذلك أحد الباحثين فيه إشارة إلى منجز جديد لم يكتب لها الالتفات بشكل يعمقها ويوسعها، مع أن فيها إضافة جديدة ومفيدة إذ هي إشارة إلى وظيفة التكرار في الربط بين أجزاء الكلام[81]، وقد تطرق السجلماسي إلى دور التكرار في السياق الكلي للآيات لما في مصطلح البناء من دلالة الربط والتلاحم، في حين نجد أن القيرواني لم يلتفت إلى وظيفة التكرار في إطار السياق الكلي للنصوص، إذ رصد له وظائف دلالية ترتبط جميعا بالغرض الشعري [82]. ومثل للدور الوظيفي للبناء بقوله تعالى: « أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ»[المؤمنون: 35] وعلق عليه بقوله: فقوله «أَنَّكُم» الثاني بناء على الأول وإِذْكار به خَشْية تناسيه لطول العهد به في القول[83]، ولهذا يكتسب البناء القيمة الفنية التي أشار إليها المؤلف حيث يقول: ولا غَرْو والبناء بلاغة بديعة وسبيل من البيان عجيبة، تدل على قوة مِنَّة المتكلم في العبارة عن معانيه وتَحفُّظِه فيها بما يُخِلُّ في القول بمبانيه.[84]
كما عالج السجلماسي التكرير اللفظي تحت عنوان التجنيس الذي عرفه بقوله: هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد وعلى الإطلاق لمعنيين متباينين مرتين فصاعدا لمجرد الإعراب لا لعلة [85]، ويدخل تحت هذا الجنس أربعة أنواع الأول تجنيس المماثلة، والثاني تجنيس المضارعة، والثالث تجنيس التركيب، والرابع تجنيس الكناية. وفرع السجلماسي المضارعة إلى أربعة أنواع هي تجنيس الزيادة والنقص، وتجنيس القلب، وتجنيس السمع، وتجنيس الخط.
ومن جهة أخرى يرى السجلماسي أن الترصيع يعتمد على التوافق في بعض صيغ الألفاظ، ووضع ذلك التصور تحت نوع سماه المقاربة وقسمه إلى قسمين الأول التصريف والثاني المعادلة، وعرف الترصيع بأنه إعادة اللفظ الواحد بالنوع في موضعين من القول فصاعدا هو فيهما متفق النهاية بحرف واحد، وذلك أن تصير الأجزاء وألفاظها متناسبة الوضع متقاسمة النظم معتدلة الوزن مُتَوَخًّى في كل جزئين منهما أن يكون مقطعاهما واحد[86]، وساق لذلك شواهد من القرآن الكريم فذكر قوله تعالى: «وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ»[الطور: الآيات: 1-5] وإذا تأملنا هذه الآيات نلاحظ أن هناك تناسبا حدث بين ألفاظها وأجزائها من حيث الهيأة فكل آية تتركب من كلمتين، وكل كلمة في الجملة تتفق مع الكلمة الأخرى في البناء الصرفي(البيت، السقف، البحر)، (المعمور، المرفوع، المسجور).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
[1] الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، 5/ 181، دار العلم للملايين، الطبعة: 15، مايو 2002م. تكاد حياة السجلماسي أن تكون مجهولة فسنة وفاته غير معروفة، راجع المبحث الأول من كتاب المنزع البديع بدءا من الصفحة 37.
[2] المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، أبو محمد القاسم السجلماسي، تقديم وتحقيق: علال الغازي، ص: 14، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة الأولى: 1401هـ-1980م.
[3] لسان العرب، ابن منظور، 8/ 349، دار صادر-بيروت، الطبعة الثالثة: 1414هـ.
[4] لسان العرب، 8/ 352.
[5] المنزع البديع، ص: 180.
[6] ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني: مشروعه التنظيري: مقوماته وقوانينه، تأليف الدكتور محمد الحافظ الروسي، 1/ 164، منشورات دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى: 1428هـ-2008م.
[7] مجلة الدراسات العربية، القضايا النقدية والبلاغية في المنزع البديع للسجلماسي، د. صالح بن أحمد بن سليمان العليوي، ص: 1311.
[8] المنزع البديع، ص: 97-98.
[9] التلخيص في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، ص: 347، دار الفكر العربي.
[10] الصبغ البديعي في اللغة العربية، تأليف الدكتور: أحمد إبراهيم موسى، ص: 15، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1388هـ- 1969م.
[11] الصبغ البديعي، ص: 16.
[12] العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 1/ 129، دار الجيل، الطبعة: الخامسة، 1401 هـ - 1981م.
[13] الوساطة بين المتنبي وخصومه، أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، ص: 33، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
[14] مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، أمين الخولي، ص: 195.
[15] المنزع البديع، ص: 101-102.
[16] المنزع البديع، ص: 179.
[17] ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني، 1/419.
[18] المنزع البديع، ص: 181.
[19] الجمهوري: يرادف الموضوع الجمهوري للفطة من الألفاظ في معناها الأصلي الشائع عند الجمهور قبل تبلور دلالته في الصناعة النظرية، ويشكل الاختلاف. انظر: المنزع البديع، ص: 151، فهرس مصطلحات المنزع الفلسفية.
[20] المنزع البديع، 105-106.
[21] المنزع البديع، ص: 179.
[22] المنزع البديع، ص: 180.
[23] التلقي والتأويل(مقاربة نسقية)، محمد مفتاح، ص: 61، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى: 1994.
[24] ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني، 1/ 420.
[25] المنزع البديع، ص: 181-182.
[26] التلقي والتأويل، ص: 72.
[27] معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، ص: 202.
[28] المنزع البديع، ص: 218.
[29] المنزع البديع، ص: 407.
[30] فصول، مجلة النقد الأدبي، عنوان المقال: مفهوم الشعر عند السجلماسي، ألفت كمال الروبي، ص: 35، المجلد السادس، العدد الثاني، يناير/ فبراير/ مارس 1986.
[31] تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تأليف: أبو الوليد بن رشد، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد سليم سالم، ص: 58-59.
[32] المنزع البديع، ص: 218.
[33] مجلة فصول، ص: 36
[34] تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر، ومعه جوامع الشعر للفارابي، ابن رشد، تحقيق وتعليق: د. محمد سليم سالم، ص: 173.
[35] ن. منهاج البلغاء، ص: 71.
[36] نفسه، ص: 89.
[37] المنزع البديع، ص: 274.
[38] مجلة فصول، ص: 38.
[39] المنزع البديع، ص: 262.
[40] المنزع البديع، ص: 262.
[41] البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، 1/ 76، دار الجيل، بيروت.
[42] البيان والتبيين، 1/ 78.
[43] المنزع البديع، ص: 263.
[44] الحيوان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، 1/ 64، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، 1424 هـ .
[45] المنزع البديع، ص: 271.
[46] إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب، تحقيق: السيد أحمد صقر، ص:91، دار المعارف – مصر، الطبعة: السابعة، 2010م.
[47] البديع تأصيل وتجديد، د. منير سلطان، ص: 149، منشأة المعارف، الطبعة الأولى: 1986.
[48] المنزع البديع، ص: 337.
[49] كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، 7/ 111، دار ومكتبة الهلال.
[50] المنزع البديع، ص: 337-338.
[51] المنزع البديع، ص: 338.
[52] المنزع البديع، ص: 339-340.
[53] المنزع البديع، ص: 364.
[54] منطق أرسطو، تحقيق وتقديم: د. عبد الرحمن بدوي، 1/ 70، وكالة المطبوعات: الكويت، دار القلم: بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 1980م.
[55] المنزع البديع، ص: 368.
[56] المنزع البديع، ص: 370.
[57] المنزع البديع، ص: 376.
[58] المنزع البديع، ص: 409.
[59] المنزع البديع، ص: 409.
[60] المنزع البديع، ص: 414.
[61] المنزع البديع، ص: 415.
[62] المنزع البديع، ص: 414.
[63] البيان والتبيين، 1/14.
[64] المنزع البديع، ص: 415.
[65] النكت في إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة: ذخائر العرب (16)]، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني، تحقيق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام، ص: 106، دار المعارف بمصر، الطبعة: الثالثة، 1976م.
[66] انظر النكت للرماني ص: من 107-109، والمنزع البديع، ص: من 417-420.
[67] المنزع البديع، ص: 429.
[68] العمدة، 2/ 93.
[69] مجلة الدراسات العربية، القضايا البلاغية والنقدية في المنزع البديع للسجلماسي، ص: 1337.
[70] المنزع البديع، ص: 441.
[71] العمدة 2/ 45، وانظر ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه: د. إحسان عباس، ص: 507، دار الثقافة: بيروت- لبنان، 1391هـ-1971م.
[72] المنزع البديع، ص: 443.
[73] التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، 1/ 179، الدار التونسية للنشر - تونس، سنة النشر: 1984 هـ.
[74] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، 3/ 601، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1407هـ.
[75] المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن محمد، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، 2/ 146، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة.
[76] البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، 9/ 29، دار الفكر – بيروت، الطبعة: 1420 هـ.
[77] المنزع البديع، ص: 443.
[78] المنزع البديع، ص: 476.
[79] البدیع بین البلاغة العربیة و اللسانیات النصیة، جمیل عبد المجید، ص: 84.
[80] المنزع البديع، ص: 477-478.
[81] البدیع بین البلاغة العربیة و اللسانیات النصیة، جمیل عبد المجید، ص: 92.
[82] العمدة، 2/ 73-78.
[83] المنزع البديع، ص: 478.
[84] المنزع البديع، ص: 478.
[85] المنزع البديع، ص: 482.
[86] المنزع البديع، ص: 509.