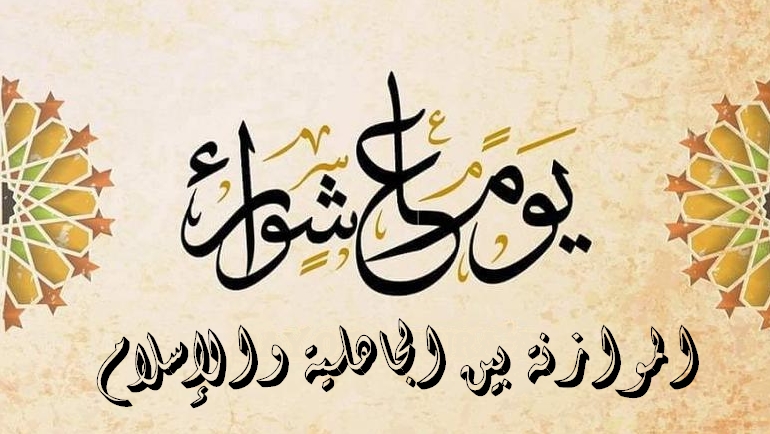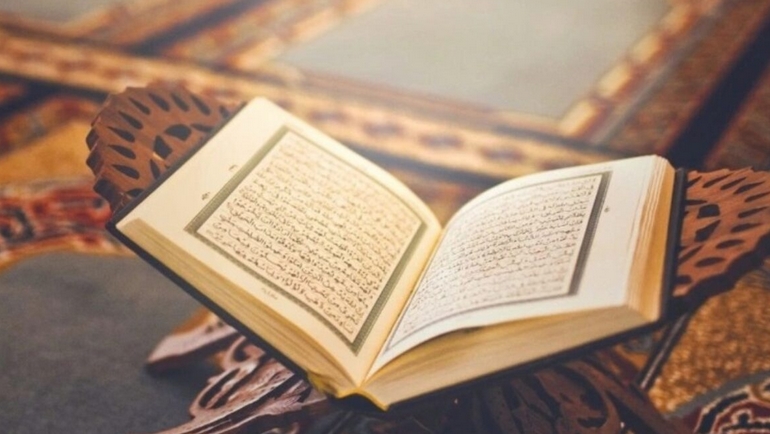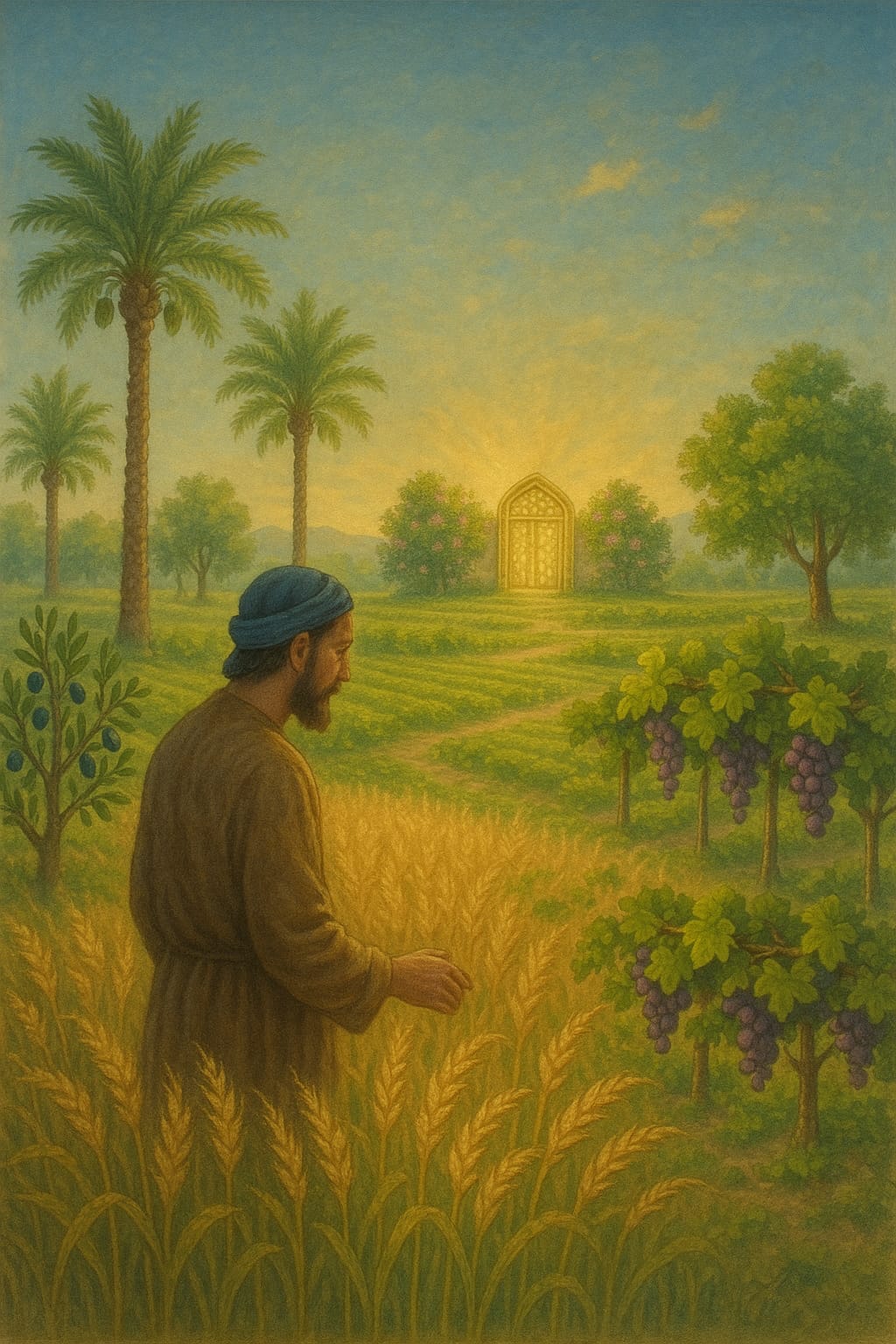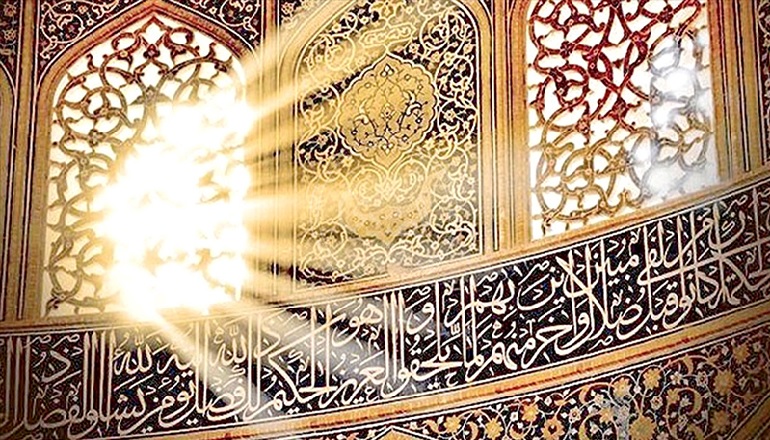تفاريع فقهية مبنية على أنظار وروايات الصحابة رضي الله عنهم 9) الاختلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة
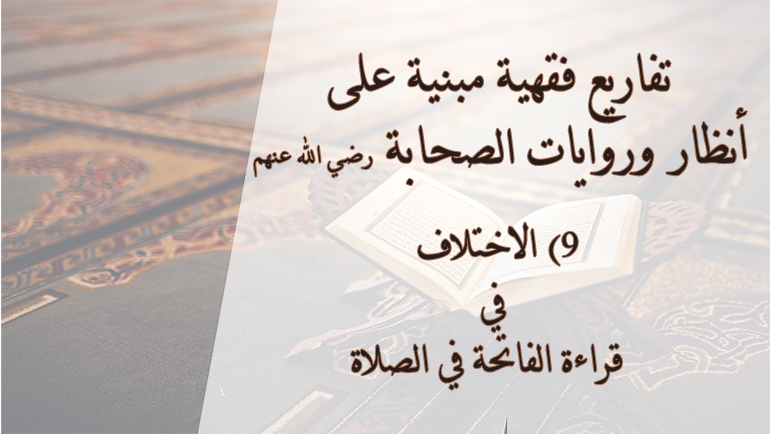
تقديم
فضَّل الله تعالى هذه الأمة -خاتمة الأمم- بخصائص ومزايا كثيرة، أجلُّها مَنُّه تعالى عليها بإرسال خاتم الرسل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وإنزال الوحي الخالد المحفوظ عليه، وهي الخصيصة التي هيَّأت لهذه الأمة أسباب الاستمرار على الحق من غير انحراف ولا ميل عن الحق، بخلاف ما وقعت فيه الأمم قبلها، ومِن ثمَّ كان التمسُّكُ بالكتاب الكريم ونهجِ الرسول صلى الله عليه وسلم السبيلَ الأوحدَ إلى تحقيق الأفضلية، ونيل الموعودات الإلهية. وقد شرع المولى جلَّ شأنه للعباد أحكامًا كثيرة ومتنوعَّةً تحقِّق لهم ملازمةً دائمة لهذا الدستور الإلهي الخالد، أبرزُها تشريعُ قراءتِه -أي: القرآن الكريم- عند كل صلاة، حيث أجمعت المذاهبُ كلها على فرضية قراءة القرآن في الصلاة.
وبعد إجماع المذاهب على فرضية القراءة، حصل الاختلاف بينهم في تفاريع فقهية تخص تعيين المقروء فيها، انبنَتْ جلُّها على اختلاف الأنظار واختلاف الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم، فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركنٌ واجبٌ لا تصح الصلاة بتركه. فيما ذهب الحنفية إلى أن الفرض الذي يكفي في الإجزاء في الصلاة هو قراءةُ ما تيسر من القرآن ولو لم يكن أمَّ الكتاب، وأقله عندهم ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدين.
ولابد -قَبْل بيان أسباب الخلاف وتوجيهاتِه- من بيان مذهب الحنفية بتحقيق، وذلك أنهم يرون حكم الفاتحة في الصلاة هو الوجوب وليس الفرضية، وهذا بناء على تفرقتِهم بين الفرض (الركن) الذي ثبت بدليل قطعي، والواجب الذي ثبت بدليل ظني. ومن ثمَّ فإن مذهبهم هو اعتبارُ صحَّةِ صلاةِ من ترك الفاتحة مع إقرارهم بأنه قد ترك واجبًا -في اصطلاحهم الخاص-؛ ويترتب على من تركها عندهم سهوًا سجودُ السهو، وإعادة الصلاة إن كان تركُها عمدًا([1])، وهذا هو محل الخلاف بينهم وبين الجمهور؛ لأن الجمهور يعتبرون الفاتحة فرضًا (ركنًا) تبطُل الصلاة بتركها سهوًا أو عمدًا.
سبب الخلاف
يرجع الخلاف بين الحنفية والجهور إلى أمرين ذكرهما ابن رشد في بدايته حيث قال: «والسبب في هذا الاختلاف: تعارُضُ الآثار في هذا الباب، ومعارَضَةُ ظاهر الكتاب للأثر»([2]).
وبيان هذين الوجهين من التعارض وَفق الآتي:
الأول؛ تعارضُ الآثار: وردَ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ، وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ. ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنِي. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»([3]). وظاهرُ هذا الحديث يدل على أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن من غير تعيين للفاتحة أو غيرها.
ويُعارِضُ الحديثَ السابقَ حديثان صحيحان أيضا؛
# الأول: رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»([4]).
# والثاني: رواه أبو هريرة رضي الله عنه -أيضا- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلَاثًا-، غَيْرُ تَمَامٍ»([5]). ومقتضى هذين الحديثين أن الفاتحة شرط في الصلاة.
الثاني؛ معارَضَة ظاهر الكتاب للأثر: ثم إن ظاهر الآية في قول الحق جل جلاله من سورة المزمل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}، يعضِّد حديثَ أبي هريرة الأول، ويعارضُ حديثَ عبادةَ بن الصامت وأبي هريرة الثاني، وهي أيضا (أي: الآية) تحتمِل أن يُحمَل ما أُبْهِم فيها مِنْ قراءةِ القرآن على المعيَّن بالأحاديث؛ وهي الفاتحة. وبذلك فإن دلالة الآية محتمِلةٌ؛ يمكن أن يستدل بها المذهبان على قوليهما.
وبناءً على القواعد الأصولية المقررة في درء التعارض الظاهر بين الأدلة الصحيحة، فإن الجمع إن أمكنَ أولى من الترجيح، وإلا فالترجيحُ ما لم يُعلَم النسخ، إذ الترجيح بالنسخ أولى من الترجيح بالاجتهاد. واعتمادُ هذا التقرير ممكنٌ بوجهَيْهِ (الجمع أو الترجيح) لِكِلا الرأيَيْن؛ يقول ابن رشد: «والمختلِفُون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مَذْهَبَ الجمعِ، وإما أن يكونوا ذهبوا مذهبَ الترجيح، وعلى كِلا القولين يُتصَوَّرُ هذا المعنى»([6]).
استدلال الحنفية
استدل الحنفية على مذهبهم بظاهر الآية كما سبق، ووجْهُ استدلالهم بها «أن الله تعالى أمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقا، وتقييدُه بفاتحة الكتاب زيادةٌ على مطلق النص، وهذا لا يجوز؛ لأنه نسخٌ»([7])، يقول السرخسي: «فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص، وهو يَعْدِلُ النسخَ عندنا، فلا يثبت بخبرِ الواحدِ»([8])، وهذا استنادا على تقريرهم الأصولي -المخالف للجمهور- في أنَّ الزيادة على مطلق النص نسخٌ، ولا يَنسَخُ الظنيُّ القطعيَّ عندهم.
ثم بعد اعتمادهم على ظاهر الآية، أجابوا عمَّا ورد في الأحاديث من تعيينٍ للفاتحة، بأنها أحاديث ظنية جاءت في مقابَلَة دليل قطعي (الآية)، وعلى مذهبهم، فإن «الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي، وخبر الواحد ليس بقطعي لكنه يوجب العمل به»([9])، فقالوا بوجوبِها لا فرضيتِها (الركنية)؛ لأن «خبر الواحد مُوجِبٌ للعمل دون العلم، فتعيُّنُ الفاتحة بخبرِ الواحدِ واجبٌ، حتى يُكرَهُ له ترك قراءتِها، وتثبت الركنية بالنص»([10]).
كما أنهم حملوا نفي الصلاة في حديث: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، على أنه نفيٌ لكمال الصلاة لا نفيٌ لصحتها، وحمَلوا النَّقْصَ في حديث: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلَاثًا-، غَيْرُ تَمَامٍ» على أنه نَقصٌ عن مرتبة الكمال أيضا، وهو نقصٌ لا يستلزم الفساد، وهو ما يطلقون عليه: نفي الفضيلة. فمعنى الحديثين إذن «مؤولٌّ؛ لاحتمال كونِه مذكورا لنفي الجنس، أو لنفي الفضيلة»([11])، والحديث إذا دخله الاحتمال تأكدت ظنِّيته، فلا يقوى -على مذهبهم- على معارضة القطعي من القرآن.
كما حملوا النقصان فيها أيضا على «النقصان في الوصف لا في الذات، ولهذا [قالوا] بوجوب الفاتحة»([12]) لا ركنيتها.
استدلال الجمهور
استدل الجمهور على وجوب الفاتحة (فرضٌ بمصطلح الحنفية) بحديثي أبي هريرة وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما السابقَيْن، وهما نصٌّ في تعيين الفاتحة في الصلاة مطلقا، وأما ما ورد في الآية وكذا في حديث أبي هريرة الأول مِن قراءة ما تيسَّر من القرآن في الصلاة، فإنه مبهَمٌ، وما في حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة الثاني معيَّنٌ، والمعيَّن قاضٍ على المبهم([13]).
كما استند الجمهور في ترجيحهم لفرضية قراءة الفاتحة إلى اعتبارِ قوَّة الأحاديث من جهة كثرتها، حيث يستدلون -بالإضافة إلى الحديثين السابقين- بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»([14]). ووجه الاستدلال بهذا الحديث -بالإضافة إلى قوته المستمَدَّة من كونِه حديثا قدسيا يحكي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى-، أن لفظَ (الصلاة) فيه عامَّة، فتنصرف لكل صلاةٍ شرعية، ولا يمكن حصول هذه القسمة بين العبد وربِّه في الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، فدلَّ ذلك على فرضيتها بعينها.
كما استدلوا بأحاديث أخرى تقوِّي اعتبارَ الكثرة والترجيحَ بها، وهي رواياتٌ وردت في قصة المسيء صلاته نَفْسِها، إلا أنها مِنْ غيرِ روايةِ أبي هريرة رضي الله عنه الأولى [المشهورة] التي فيها: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، بل هي من رواية رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، حيث رُوِيتْ عنه بأسانيدَ في بعضها تصريح بقراءة الفاتحة، وفي بعضها الآخر تنبيه على تعيين ما يُقرَأُ في الصلاة دون إطلاقه. أما الأولى (حيثُ صُرِّح بقراءة الفاتحة)، فهي من رواية رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، وفيها: «إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ»([15]). وأما الثانية (حيثُ نُبِّهَ فيها على تعيين ما يُقرَأُ وليس إطلاقه) فهي من رواية رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أيضا، وفيها: «وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ»([16]). فيستفاد من هذا أن الرواية المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه: «ثم اقرأ ما تيسَّر» مِن غيرِ ذِكْرِ أمِّ القرآن؛ فيها اختصارٌ من الرواة، وأنه لا بد من قراءة أم القرآن.
كما استدل الجمهور بدلالة النفي في حديث: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»؛ حيث اعتبروها دالَّةً على نفي الصحة لا نفي الكمال، فاعتبروا أنه حجة «في نفي الحقيقةِ لا كمالِها»([17])، وهو الأَوْلى؛ لما تقرر عند جمهور الأصوليين من أن الأصل نفي الحقيقة، ولا يُعدَل عنها إلى نفي الكمال إلا بدليل يوجِب ذلك.
كما استدلوا بمدلول النقص في حديث: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلَاثًا-، غَيْرُ تَمَامٍ»، حيث اعتبروا أنه دال على عدم جواز الصلاة مع وجود النقص الذي أقرَّ الشرعُ حصوله حتى يتم إعادتها، يقول ابن عبد البر: «وقد زعمَ من لم يُوجِب قِراءةَ فاتحةِ الكِتابِ في الصَّلاةِ، وقال: هي وغيرُها سواءٌ، أنَّ قولهُ: "خِداجٌ" يدُلُّ على جَوازِ الصَّلاةِ، لأنَّهُ النُّقصانُ، والصَّلاةُ النّاقِصةُ جائزةٌ. وهذا تحكُّمٌ فاسِدٌ، والنَّظرُ يُوجِبُ في النُّقصانِ ألّا تجُوز مَعهُ الصَّلاةُ، لأنَّها صلاةٌ لم تتِمَّ، ومن خرجَ من صلاتِهِ وهي لم تتِمَّ بَعدُ، فعليه إعادتُها تامَّةً، كما أُمِرَ، على حَسَبِ حُكمِها، ومنِ ادَّعى أنَّها تجُوزُ مع إقرارِهِ بنَقْصِها، فعليه الدَّليلُ، ولا سبِيلَ لهُ إلَيهِ من وجهٍ يُلزِمُ، واللَّه أعلمُ»([18]).
كما استدل الجمهور بالقياس، فقاسوا الفاتحة على بقية أركان الصلاة، بجامع كونها جميعًا أركانٌ فيها، فكما تعيَّنَت كل أركان الصلاة وحُدِّدَت، لزِم ذلكَ القراءةَ أيضا، فلا يكفي مجرَّدُ تعيينِ جنس القراءةِ، بل لابد من تعيين المقروء فيها، مِثلُها مثلُ الركوع والسجود، فإن الشارع لم يكتفِ فيهما بتحديد الجنس فقط، بل عيَّن هيئتهما على وجه التفصيل، يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: «ولأنه ركنٌ في الصلاة، فوجب أن يتعينَ بنوعٍ بعينه زائدٍ على تعيينِ الجنسِ، أصلُه الركوعُ والسجودُ»([19]).
واستدل الجمهور أيضا بإيراد الاحتمالات على أدلة المخالفين، ومعلومٌ أن الاحتمال إذا تطرق للدليل، لم يقوَ به الاستدلالُ والمعارضةُ، فأجابوا عن قوله جل وعلا: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}، أن «الآية محمولة على صلاة الليل نافلة»([20])، وأجابوا عن حديث المسيء صلاته حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» بأنه يمكن أن يُقال: «لعله لم يكن يُحسِن قراءة أُمِّ القرآن»([21])، وهو ظاهرٌ ووجِيهٌ في حال الأعرابي؛ لأنه لم يكن يحسن الصلاة رأسا، وهو الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادتها مرارًا.
ومن جهةٍ أخرى في تقوية رأي الجمهور، فإن القول بركنية الفاتحة فيه إعمال للأدلة كلِّها؛ لأن من قرأ الفاتحة فقد قرأ ما تيسر من القرآن، ولم يَدخُلْ فيمَن ترك الفاتحة التي نفَتِ الأحاديثُ صلاةَ من لم يقرأ بها، والتي تُحمَل على نفي الصحة؛ لأنه الأصل في دلالة النفي، ولأنه الأحوط في العبادات.
ختاما
وفي ختام هذا البيان المقتضب، يَحسُن التنبيه على بعض ما انْبَنى على هذا الخلاف وتأثيرِه في فروع المذهب المالكي، وذلك أن المالكية قد راعَوْا خلافَ الحنفية في هذه المسألة واعتبروا قوَّتَه في تفريعهم لأحكام قراءة الفاتحة في الصلاة، فخفَّفوا فيها دون بقية الأركان، ومن أشهر تلك الأحكام مسألتان:
الأولى([22]): إسقاطُهُم وجوبَ قراءتها عن المأموم مطلقا، واستحبوها له في السرية فقط، حيث جعلوها ممَّا يَحمَلُه الإمام عن المأموم؛ فغلَّبُوا جانب سنيتها من هذا الوجه، في حين أوجَبُوها على الفذ والإمام؛ فغلَّبُوا فرضيها من هذا الوجه.
الثانية([23]): عدمُ إلغاءِ ركعةِ مَن سها فيها عن قراءة الفاتحة (الإمام والفذ)، بل يُتِمُّ صلاتَه ويسجد للسهو قبل السلام للنقص، وهذا تغليبٌ منهم لجانب السنية فيها على الفرضية، ودليلهم على ذلك أيضا أَنَّه لمَّا لم يكن مقطوعًا بفرضية الفاتحة كبقية الأركان، لم يُسوِّغوا زيادة ركعةٍ كاملة في الصلاة بسبب السهو فيها. ثم إنهم أوجبوا عليه (أي: عمَّن تركها سهوا) بعد ذلك أن يعيد الصلاة احتياطًا، وهذا تغليبٌ منهم للقول بفرضيتها.
وهذان الفرعان هما على مشهور المذهب، وإلا ففي المذهب أقوال أخرى. لكن الغرض من هذا التنبيه، هو الإلماح إلى طريقة علماء المذهب المالكي في مراعاة الخلاف القويِّ المعتبر، واستحضارِه عند الاجتهاد في التفريع والتخريج، حيث يراعون قول المخالف تخريجا على قواعدهم، وإمعانا في تحري الصواب والأحوط. وهو منهج سديد في النظر، يتعامَل مع أقوال المخالف القويَّة على أنها تحتمل الصواب وإن كانت مرجوحة، فيسعى للجمع بينها وبين القول الراجح لديه حيث تَأتَّى له ذلك، وإن في الفروع والجزئيات من الأحكام.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
-------------------------------------------------------------------------
([1]) – انظر: حاشية ابن عابدين (1/458).
([2]) – بداية المجتهد لابن رشد (1/134).
([3]) – أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر). ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة).
([4]) – أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر). ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة).
([5]) – أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة).
([6]) – بداية المجتهد لابن رشد (1/135).
([7]) – البناية شرح الهداية للعيني (2/211).
([8]) – المبسوط للسرخسي (1/19).
([9]) – العناية شرح الهداية للبابرتي (1/294).
([10]) – المبسوط للسرخسي (1/19).
([11]) – العناية شرح الهداية للبابرتي (1/294).
([12]) – البناية شرح الهداية للعيني (2/212).
([13]) – بداية المجتهد لابن رشد (1/134-136).
([14]) – أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة).
([15]) – أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة، ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته). وأبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود). والبيهقي في «سننه الكبرى» (كتاب الصلاة، جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره، باب تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة). والحديث سنده صحيح، وإن كان اختُلف فيه عَلَى عليِّ بن يحيى بن خلاد الزُّرقي هل هو: عن عمه رفاعةَ. أم: عن أبيه عن رفاعة. قال ابن أبي حاتم: «والصحيح عن أبيه عن عمه رفاعة». انظر: العلل لابن أبي حاتم (2/69). شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (5/231).
([16]) – أخرجه ابن الجارود في «منتقاه» (صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم). والحاكم في «مستدركه» (كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، الأمر بالاطمئنان واعتدال الأركان في الصلاة). والنسائي في «سننه الصغرى» و«الكبرى» (كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود). والبيهقي في «سننه الكبرى» (كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب).
([17]) – تحفة المحتاج للهيتمي (2/34).
([18]) – التمهيد لابن عبد البر (13/17).
([19]) – الإشراف لعبد الوهاب البغدادي (1/233). انظر: الحاوي للماوردي (2/104). المغني لابن قدامة (2/147).
([20]) – الحاوي للماوردي (2/104). شرح التلقين للمازري (1/512).
([21]) – شرح التلقين للمازري (1/513). المغني لابن قدامة (2/147)
([22]) – انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (1/236).
([23]) – انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (1/238).