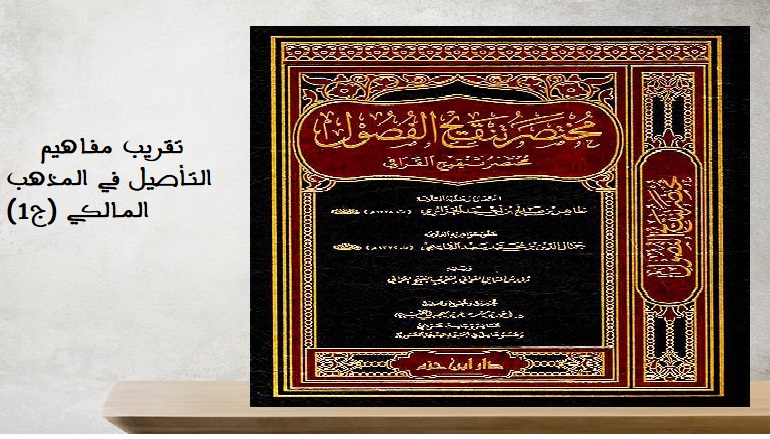قراءة القرآن المجيد ليست قراءة عادية، فهي لا تشبه قراءة أي نصّ منظوم أو منثور، كما لا يرقى لمشابهة القرآن أيّ نصّ آخر. فقراءة القرآن هي قراءة خاصة تقتضي من القارئ أن يكون قد هيَّأ نفسه وعقله وذهنه وقلبه ووجدانه تهيئة تامة لتلقيه وتلاوته تلاوة تلائم مقام القرآن وتناسبه، بحيث يكون القارئ مدركا تماما أنّه يقرأ كلمات الله ووحيه إلى الإنسان الرسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قام بدوره بتلقي هذا الوحي ونقله إلينا قرآنا عربيّاً غير ذي عوج ولا ريب فيه، وصرنا حين نقرؤه، نقرؤه دون وسائط، خطاباً إلهياً موجّهًا إلينا بشكل مباشر. فكأنك وأنت ترتّله تطوي الوحي الإلهيَّ في ثنايا قلبك وعقلك ووجدانك. فلكي نرقى إلى مستواه، ونعرج إلى عليائه فإن علينا أن نتدبر آياته، ونتلوها تلاوة، ونرتلها ترتيلاً، ونفكر فيها، ونتعقّلها، فإنه لولا تيسير الله له للذِّكر، لما أمكن للبشر المخلوق أن يمسّه، ويدرك شيئاً من آفاقه. إذ أنّ من شأن هذا القرآن أن لا يمسُّه إلا المطهّرون. من هنا أمرنا أن نعطي تلاوته "حق التلاوة". وحق التلاوة أمر عظيم لا يتيسر إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، والتواضع لجنابه، والإطراح على أعتابه.
وقد حذّر القرآن المجيد من كثير من أنواع القراءات التي تكون حجة على القارئ، لا حجة له. ومن أبرز أنواع القراءات التي شدَّد النكير على أصحابها "القراءة الحماريّة" وهي التي جاء التنبيه إليها والتحذير منها في الآية الخامسة من سورة الجمعة: "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِئايَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"، وليس هناك شيء أبلغ في نفي حقيقة القراءة وعدم الاستفادة بها من هذا المثل. فالحمار لا يقرأ ولا يكتب ولا يفكر ولا يتعظ ولا يتذكر. جوهر العلاقة بين الحمار والكتاب أن يوضع الكتاب على ظهره، ويسيّره صاحبه -بعد ذلك- يمنة أو يسرة كما يشاء، بل الحمار لا يدرك ما الذي يحمل، فضلاً عن أن يدرك أهميَّته، إنّما يدرك منه ثقله أو خفته على ظهره. ولذلك فإنَّ هذا النوع من حمل الأمانة - أمانة الكتاب، لم يؤد بهم إلى فقه في الدين، اللّهم إلا ذلك "الفقه البقريّ" إن صح تسمية ما بدا منهم في تعاملهم مع الأمر بذبح "بقرة" فقهاً.
بل قد حدث منا ما هو أخطر من ذلك حين شابهنا "كما أنزلنا عَلَى المُقْتَسِمِينَ، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ" (الحجر: 90–91) فـ"المقتسمون" وإن تعددت أقوال المفسَّرين فيهم[1]، فإنَّنا نرجح أن يكون المراد أولئك الذين جعلوا القرآن مقسّماً، فما وافق ما لديهم قالوا بصحته مع دعوى اقتباسهم منه، وما خالف ما عندهم من تراث قالوا فيه ما يشاؤون: (أساطير الأولين أو سحر أو كهانة أو شعر). فقسّموه وقالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ليخدعوا البسطاء "بموضوعيّتهم" أو علميّة مواقفهم المضطربة التي لا دليل عليها. وليسهل عليهم ذلك الاقتسام جعلوه أعضاء: من "التعضية" بمعنى التفريق والتجزأة، يقال: عضّيتُ الجزور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها. ومثل ما نهينا عن حمل القرآن بطريقة "حماريَّة" نهينا عن مشابهة سائر أولئك الذين عضّوه تعضية، وفرَّقوه، واتخذوا آياته شواهد لما يذهبون إليه بدلاً من أن ينطلقوا منه كلّه في كل ما يأخذون ويدعون، ويقرؤونه باعتباره قرآناً واحداً لا يقبل التعضية ولا التفريق ولا التجزأة.
إن المسلمين حين قرؤوا القرآن بطريقة التجزأة متشبهين بأولئك المقتسمين بوجه من الوجوه قد فقدوا الكثير من أنوار القرآن، وآثار آياته الموحَّدة التي أحكمت فصار كالكلمة الواحدة - كما قال أبو علي الفارسي (ت: 377ﻫ).
من هنا يصبح تناول "الوحدة البنائيَّة للقرآن المجيد" أمراً في غاية الأهمية؛ لأن إدراك هذه الوحدة سوف يساعد الباحث المسلم على حسن القراءة والترتيل، ودقَّة التلاوة، ثم استقامة الفهم إن شاء الله. فهي ركن منهاجيُّ، وليست مجرد فضيلة تضاف إلى فضائل الأسلوب القرآنيّ التي لا تحصى.
بيان المراد بالوحدة البنائيَّة
أما "الوحدة" فهي مقابل للكثرة والتعدّد أيّاً كان نوع الكثرة، وأيّاً كان إطار التعدُّد. فكون الشيء واحداً يعنى به: أنَّه ليس متعدداً، ولا قابلاً للكثرة أو التكرار. وفي "الوحدة" معنى الثناء، فإن قيل: "فلان واحد الدنيا"، أو "وحيد عصره". أريد به ذاك، فكأنَّه رغم انتمائه إلى البشر، وكونه واحداً منهم فإن له من الخصال والمزايا الحسنة ما يجعله كأنّه انفصل عن جنسه الذي لا يتمتع بتلك الخصال منه غيره، فصار واحداً. وقد قال الشاعر مادحاً:
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنّ المسك بعض دم الغزال
والقرآن المجيد منفصل عن سائر الكتب المنزلة وغير المنزلة، متفوق عليها، جميعاً، بخصائصه ومزاياه، ونظمه وبلاغته وفصاحته، وهو في الوقت ذاته واحد في داخله بهذه المزايا والخصائص، ينتظم حروفه وكلماته وآياته وسوره سلك واحد. والقرآن واحد في كونه متفرَّداً من تلك الحيثيَّة، ومن حيث الأهداف والمقاصد والغايات والآثار حتى ليبدو في ذلك -كلَّه- كما لو كان كلمة واحدة، أو جملة واحدة. لأن الواحد، في الحقيقة، ما لا جزء له البتة؛ فلا يقبل "التعضية" أيْ التقسيم إلى أعضاء، ولا يقبل التحويل والتغيير والتبديل فيما يتألف منه.
والواحد لفظ مشترك يستعمل على ستة أوجه:
فيستعمل لما كان واحداً في الجنس أو النوع مثل أن يقال: "الإنسان أفضل من الحيوان". أو فيما هو أهم بحيث يراد به جنس الإنسان وجنس الحيوان، فإذا قلت: زيد وعمرو واحد، أردت بذلك وحدتهما من حيث الانتماء إلى نوع واحد هو "الإنسان".
ويطلق على ما كان واحدا من حيث الخلقة، كأن تقول: "شخص واحد" أو من حيث الصناعة، كأن تقول: "حزمة واحدة".
ويطلق على ما كان واحداً لعدم نظيره، إما في الخلقة، كأن يقال: "الشمس واحدة". وإما في نسبة الفضائل إليه، كأن يقال: "فلان وحيد دهره، ونسيج وحده". ويقال لما كان واحداً لامتناع تجزؤه، أو امتناع تعضيته لصغره، أو لصلابته، أو لأنَّه غير قابل للتجزئة بطبيعة تكوينه.
ويقال لبداية العدد (واحد) وهو ما فوق الصفر ودون الاثنين.
وإذ وُصف الله، تبارك وتعالى، به أريد أنه لا يصح عليه التعدّد والتجزيء والتكثُّر؛ فهو واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي ألوهيَّته وربوبيَّته.
والقرآن واحد في جنسه ونوعه ونظمه وتحديه، وفرادته وإعجازه. لا يقبل التكثُّر ولا التعدّد ولا التعضية ولا التجزؤ. لا يشاركه في خصائصه وصفاته ومنهجه كتاب آخر؛ لا منزل ولا موضوع. وذلك هو مرادنا بـ"وحدته" من هذه الحيثيَّة.
أما "وحدته البنائيَّة" فقد أردنا بها أنه بكل سوره وآياته وأجزائه وأحزابه وكلماته يعتبر كأنه جملة واحدة.
وأما وصفنا لهذه "الوحدة" بـ"البنائيَّة" أو إضافة هذه "الوحدة" إلى "البنائيَّة" فقد أردنا به الإشارة إلى ما يدل عليه قوله تعالى: "كِتَابٌ أُحْكِمَتَ ـايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" (هود: 1) فالإحكام، هنا، من إحكام البناء بحيث يمتنع أي اختراق له لمتانته وقوته، ويدل عليه أو يدل له قوله تعالى: "فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءايَاتِهِ" (الحج: 50) بحيث يمتنع على الشيطان أن يبلغ شيئاً منها، فهي لتطمين البشرية أن هذا القرآن محفوظ ومغلق بإحكام أمام كل محاولات الاختراق. ومنها محاولات الشياطين الذين وَهَمَ الجاهليّون أنهم قادرون على اختراق أي مجال فزعموا أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعالى: "هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ..." (الشعراء: 220) ويعضد ذلك قوله تعالى: "مِنْهُ ءايَاتٌ محْكَمَاتٌ" (ال عمران: 7)؛ أي ما لا يمكن أن تعرض فيه شبهة أو يتطرق إليها عارض يتيح لأهل الفتنة والذين في قلوبهم مرض استثمار ذلك على وجه الحقيقة؛ لأن كل ما قيل أو يقال منهم ضد هذا القرآن إنَّما هو من قبيل الشغب واللَّغو، وعلى هذا يكون المراد بهذا المركب "الوحدة البنائية" للقرآن؛ أي أن القرآن المجيد واحد لا يقبل بناؤه وإحكام آياته التعدّد فيه أو التجزأة في آياته، أو التعضية بحيث يقبل بعضه، ويرفض بعضه الآخر، كما لا يقبل التناقض أو التعارض وغيرهما من عيوب الكلام. فهو بمثابة الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة أو الآية الواحدة، وإذا كانت قد تعددت آياته وسوره وأجزاؤه وأحزابه؛ فذلك التعدد ضرورة لا غنى عنها في التعليم والتعلّم، والتنزيل لتغيير الواقع وإبداله. فلم يكن في مقدور الإنسان أن يستوعب قرآناً يتصف بكل صفات القرآن جملة واحدة؛ بل عليه أن يأخذه أو يتبنَّاه باعتباره ذا وحدة بنائيَّة لا تختلف عن وحدة الكلمة في حروفها[2]، ووحدة الجملة في كلماتها وأركانها، ووحدة الإنسان في أعضائه، ولو نزل مفرقا. ولذلك فهو حين تعرض في أذهان بعضهم بعض آفات الخطاب ترتد عنه خاسئة حسيرة حتى لكأنَّ آياته تتراص فتصبح كالكلمة الواحدة في بنائه. فإذا مارس دوره في الهداية تفتّح واتسع ليستوعب كل ما لا تتحقق أهدافه بدون استيعابه، ثم يتجاوزها. وهكذا يستوعب فضاؤه كل الحادثات وسائر المستجدات وجميع الثقافات والحضارات وحاجات وتطلعات وأشواق بني الإنسان كافة. وليس هناك أي كتاب أو خطاب عربي أو وارد بغير العربية وعلى أي مستوى كان يتمتع بهذه الصفة عدا القرآن الكريم. إذ يستحيل على كتاب حتى لو بني بشكل موسوعة تبلغ عشرات، بل مئات المجلدات أن يستوعب "نبأ من قبلنا"[3]، وما نبأ من قبلنا إلا تاريخ البشرية -كلها- وكل تفاصيل ذلك التاريخ؛ بشراً وأشياءً وأحداثاً وعبراً ودروسا.
ضرورة الإيمان بالوحدة البنائيَّة
ولولا هذه "الوحدة البنائية" لما استوعب القرآن "خبر ما بعدنا" حيث استوعب مستقبل البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ببيان السنن والقوانين التي تقود هذا المستقبل وتصوغه وتبنيه، فهو لا يحقق ذلك عليها بطريق التكهّن والنبوءات والرؤى والمنامات كما زعمت أمم سابقة. ولا بطريق قياس المستقبل على الحاضر وقياسهما بعد ذلك على الماضي كما يتخيل الماضويّون، بل بالكشف عن السنن والقوانين الحاكمة على البشريّة وحركتها، والتاريخ وحركته، والغاية التي يتجه الخلق -كله- إليها وفقا لتلك السنن والقوانين الصارمة. فهي قراءة علمية دقيقة للمستقبل لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ولا يتطرق إليها الشك، فالله لا يهدي القوم الظالمين، ولا يهدي بهم. والظلم لا يختص بالطغاة بحيث يقضي المنطق أن يختص أولئك الطغاة بالعذاب، بل هو شامل عام في الحياة الدنيا، ونتائجه لا تستثني أحدا "وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِم مَّوْعِدًا" (الكهف: 58) ولا تختص بمن مارسوا الظلم الفعليَّ من الطغاة، بل تشمل أعوانهم ومؤيديهم، والمستسلمين لطغيانهم "وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً" (الأنفال: 25). ولا يختص الظلم بعدم العدل في الحكم، بل يتجاوز ذلك بحيث يكون دَرَكَات أعلاه الشرك "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" (لقمان: 13). ولذلك أمر الله الجميع بالتزوّد بالتقوى والتحصن بها، فذلك يمكن أن يوقف الظلم ويردعه. يضاف إلى ذلك أن القرآن يحمل القيم العليا الحاكمة والقواعد الدستورية والقانونية التي تقدم للبشرية مصدراً واحداً موحّداً يشتمل على "حكم ما بينكم" بحيث يقضي على جذور وأسباب قيام النزاعات والاختلافات ليصبح "العدل" قاعدة، والانحراف عنه شذوذاً. ولا ينتظر إلى أن تقع المظالم والانحرافات ليتقدم لمعاقبة أولئك الظالمين طمعاً في ردع سواهم -كما تفعل الأمم المعاصرة- فليست العبرة بذلك، بل بتزكية وتطهير الإنسان والأسرة والمجتمع والبيئة ونظم الحياة كلها، بحيث يتضافر الجميع على محاصرة الشر ومصادره والتخلص منها.
وذلك -كله- يجري بقول "فصل ليس بهزل" وما ينبغي أن يتطرق ذلك إليه. فهو ليس "حمّال أوجه" بحيث يستطيع كل المتنازعين أن يضموه إلى صفوفهم فيفسره المدعي ومحاموه على هواهم ليحققوا بذلك مصالحهم، ويفسره المدَّعى عليه ومحاموه كما يريدون، وتحمله النيابة على أن يستجيب لدعواها، ويفسره القضاة بما يرون، ثم تتسلسل جهات التفسير والتأويل من استئناف ونقض وإبرام وفي كل ذلك تبدّد الجهود والأموال والأعمار، ويضيع العدل أو جزء منه في تلك المتاهات، وتدمّر الطاقات لعدم وجود "القول الفصل" ولذلك كان هذا القرآن مثابة المتقين، ومرجع الأبرار، ومنبع الهداية ومصدر النور، لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب به الآراء ولا تنقضي عجائبه؛ وهو العدل كله والحق كله والهدى الكامل والنور الشامل والمنهج الواضح.
ضرورة الوحدة للتدبُّر
إنه قرآن أراد قائله ومنزَّله تبارك وتعالى له أن يُقرأ ويُتدبَّر، ويتفكر فيه، ويعقله العالمون، ويرتّله المرتلون، ويتلوه التالون، ويتبعه المهتدون؛ فأودع الله تبارك وتعالى فيه كل ما يجعله جاذباً لأصناف الخلق كافَّة، مستدعياً لهم لقراءته، قادراً على صنع الدوافع والدواعي والإرادات لترتيله وتلاوته.
و"وحدته" تمثّل الركن الأساس في هذا، كله، ولذلك فإنه مهما اتخذنا من الأساليب في الرجوع إليه فلن نستطيع أن نهتم بجانب من جوانبه، ونهمل الجوانب الأخرى. فإذا قلت: أنا قاض أو فقيه تهمني آيات الأحكام، وحدها، فاجمعوا لي كل ما بدئ بأمر أو نهي من الآيات لأتدبَّره وأستخرج القوانين والأحكام منه، فإنك لن تلبث إلا يسيراً لتدرك أن ذلك، وحده، لن يلبي حاجتك ولن تكشف لك آيات الأحكام عن دقائقها وقد فصلت الغصن عن الشجرة، فمعاني الآيات لن تسفر لك عن وجهها حتى تقرأها في سياقها وموقعها وبيئتها، تقلب طرفك وعقلك ولبك وفؤادك، وتصيخ السمع إلى نبضات الحياة في قلبك في ذلك، كله، ولن تبلغ الغاية، ولن تدرك المراد حتى تلاحظ سائر العلاقات بين الآية وبين القرآن كله يقودك توفيق الله تعالى ويصاحبك اسمه في الرحلة التي حين تتذوقها فلن تستطيع التوقف عن مداومتها؛ لأن القرآن بناء محكم واحد، ونظم متفرد واحد، تسري فيه، كله، روح واحدة تحوله إلى كائن حيّ يخاطبك كفاحا، ويشتبك معك في جدل شامل يجيب به عن تساؤلاتك، ويسقط عنك إصر شبهاتك، ويعيد تصميم تصوراتك وبناء قواعد ومنطلقات أفكارك، وتصحيح معتقداتك حتى يضعك على الصراط المستقيم لتستقيم على الطريقة، وتبلغ شاطئ الحقيقة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو ينبه إلى خطأ من تصوّر أن آيات الأحكام هي ما صدّر بأمر ونهي- قال: "ألا وإن في الأنفال أحكاما كثيرة"[4].
متى وكيف برزت بذور القول "بالوحدة البنائيّة"؟
ولذلك فإنه من الصعب أن نجد مفهوم "الوحدة البنائيَّة" في الإطار الذي نقدمه دائراً على ألسنة المتقدمين؛ فـ"جيل التلقي" من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، شغل بالتلقي والتطبيق، وهيمن ذلك على مجمل نشاط ذلك الجيل. كما أن إيمانهم بتحدَّي القرآن المجيد، وظهور استحالة الإتيان بمثله، أو بعشر سور مفتريات من مثل سوره، أو بسورة من مثله، كان من المسلَّمات البديهيَّة، فلم تبرز الحاجة في ذلك الجيل إلى النظر العقليّ والفلسفيّ الذي لم يكن قد ولد، بعد، في الساحة الفكريَّة الإسلاميَّة في قضية "التحدي" وحقيقته وعلام ينعكس، ولم يظهر البحث الفلسفيّ والبلاغيّ في الأوجه التي لم تعط للبشر فرصة الاستجابة لذلك التحدي، أو أوجدت فيهم العجز عن الاستجابة، فتلك أمور قد تأخر ظهورها والبحث فيها إلى القرن الثالث الهجري وما تلاه.
أما "جيل الرواية" الذي تسلّم الراية من "جيل التلقي" فقد استغرقه البحث عن الروايات وتتبُّعها وجمعها، فذلك هو التحدي الأكبر الذي واجه ذلك الجيل، وهو تحدّ لم يكن أقل خطورة من تحدي جمع الأمة -كلها- على مصحف واحد إمام. ذلك لأن القرآن المجيد كان مدوّناً محفوظاً في الصدور والسطور وسائر الوسائل المتاحة التي سخرها منزّل القرآن الذي تكفّل بحفظه من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. كما تكفل بإقرائه لرسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وإقراره في صدره فلا يُنسى ولا يضيع ولا يُخترق. كما تكفّل بجمعه وقرآنه. وليس كذلك المرويات والسنن والآثار التي لم يدون منها في العهد النبوي إلا القليل النادر، وكان تدويناً فرديّاً لم يخضع لمثل القواعد المنهجية التي خضع تدوين القرآن وجمعه لها، ذلك لأن المفروض فيها أن تدور حول القرآن دوران العلة والمعلول، والبيان والمبيَّن، فيحفظ ما اتَّصل بالقرآن منها، ويهيمن القرآن عليها، فلا تستقل عنه، ولا تنفصل عن مداره. ومع ذلك فقد استغرقت العمليَّات المشار إليها ذلك الجيل "جيل الرواية" بحيث انصرفت جهوده إلى جمع الروايات وتدوينها وتمحيصها وتصنيفها وجعلها ميّسرة لجيل الفقه وجيل النقد والميز والتحليل بعد ذلك.
أما "جيل الفقه" فقد انشغل بإنتاج الفقه، وتقعيد أصوله للاستجابة لمستجدات الحياة المتسارعة، وإعطاء الأحكام المناسبة للنوازل والوقائع لئلا تبقى واقعة من الوقائع دون حكم فقهي مكتسب ومستفاد من الأدلة الشرعية التفصيلية.
كما أن، هناك، من انشغل فيما عرف، آنذاك، بـ"الفقه الأكبر" الشامل لأصول الدين (علم الكلام) و(أصول الفقه) إضافة إلى (الفقه) ذاته، لأن الفكر الفلسفي والمستجدات بدأت تفرض نفسها وتستدعي البحث والدراسة والتحديد، وجلّ تلك البحوث كانت تستدعي النظر في الدليل الجزئيّ التفصيليّ، لا في القرآن، كلّه، باعتباره مصدراً منشئاً بكليّته ودليلاً كليّاً. ولم يكن خافياً أن أهم طرائق ووسائل النظر فيه هي تلك التي ترد الجزئيَّ إلى الكليّ، وتنظر في الكليّ نظراً مفاهيميّاً وتحليليّاً لتحقيق الاستفادة القصوى منه. ثم تربط ذلك ببيان السنة وتطبيقاتها، وبالكون وسننه انطلاقاً من منهاجية "الجمع بين القراءتين"[5]، لكنّ الوعي بهذا لم يأخذ حظه من التفعيل في تلك المرحلة، ثم تنبه العقل المسلم -بعد ذلك- إلى أنّ تفعيل هذه الرؤية أساس لا يستغنى عنه في فهم القرآن وحسن تفسيره، ودقة تأويله. ويتناول "الجمع بين القراءتين" الجمع بين القرآن والسنَّة الثابتة من ناحية، ثم بينهما وبين الكون من ناحية أخرى. وأن هذه الوحدة البنائية خطوة منهجية ضروريَّة وحلقة من سلسلة من المحدّدات والقواعد المنهاجيَّة التي لو أهملت أو أهمل بعضها فليس من الممكن أن نتلو القرآن حق تلاوته، أو نرتله ترتيله المنشود.
وعن "النظر الفقهي" المحدَّد شاع وانتشر النظر الجزئيُّ في آيات الكتاب الكريم. و"النظر الجزئيُّ" لا يمكن أن يؤدي إلى إدراك المناسبات والروابط وشبكات العلاقات بين الكلمات في إطار الآية، ولا بين الآيات في إطار السورة، ولا بين السور في إطار القرآن كلّه. كما لا يساعد ذلك النوع من النظر على الكشف عن العلاقات بين السور في المحيط القرآنيّ، كلّه، وبالتالي فقد غاب التفكير في "الوحدة البنائيَّة" أو لم تسلط عليها أضواء كافية يمكن أن تلفت الأنظار إليها بمثل القوة التي تلتفت بها إلى الدليل الجزئيّ المباشر. ويمكن أن يضاف إلى ما تقدم من دوافع "النظر الجزئيّ" عجلة المفتي ورغبته في الإفتاء فيما يعرض عليه من أسئلة دون تأخير تجعله يسرع إلى الدليل الجزئيّ، أي: الآية التي يراها كافية في تمكينه من الإجابة على السؤال. فإذا فعل فإنه قد لا يلتفت إلى ما لا علاقة مباشرة له بموضوع السؤال. لذلك فإنه حين جاء لبحث "الدلالات" فإنه لم يضع شيئاً يشير إلى ضرورة النظر في سائر آيات الكتاب الكريم، بل حصر ذلك في أحوال "النص المفرد" فبحثُ الخاص والعام، والمطلق والمقيد، واللفظ الموضوع لمعنى واحد أو متعدد، والأمر والنهي، وصيغ العموم وصيغ الخصوص، ومقتضى اللّفظ والمفهوم، والمشترك والمؤول، والنص والظاهر والمفسَّر، والدال بالعبارة والدال بالإشارة، والدال باقتضاء النص، وكذلك المفاهيم - مفاهيم الموافقة والمخالفة، والشرط والغاية[6]، وكل هذه مباحث تتعلق بالألفاظ المنفردة، أو دلالاتها وسائر العوارض الذاتية المتعلقة بها، وهي لا تنبه إلى ضرورة قراءة القرآن كله.
وحدة السورة
يقول ابن العربي: "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متّسقة المعاني، منتظمة المباني... علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلمّا لم نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف البَطَلة، ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه"[7].
ويقول الإمام الرازي: "... من تأمل في لطائف نظم السور وبديع ترتيبها علم أن القرآن كما أنّه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو، أيضاً، معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته..."[8]، ويقول الإمام أيضاً: "... أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط...".
ومع ذلك فإن العقول تتفاوت في مواقفها واستنتاجاتها، وبعض الناس أشد إحساسا بهذه الأمور الدقيقة من البعض الآخر، وأسرع في التفطُّن لها، والكشف عنها. كما أن الإنسان مخلوق تؤثر في حركته "الدواعي والصوارف" فحملات الطعن على القرآن والاعتراض عليه التي واجهه بعض أهل الشرك بها كانت من الدوافع للبحث الدقيق في دفاعات القرآن، عن نفسه، والكشف عن سائر مطاعن أهل الشرك فيه ودحضها وتفنيدها لإثبات سلامة النظم القرآني وتنزّهه عن الاختلاف والتناقض والخلل. ليثمر البحث في سلامة النظم، ودقة التناسب، ووحدة الموضوعات، واتجاهات الأفكار نحو "الوحدة البنائية" بحيث يقول ابن العربي في القرن الخامس: "... ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني علم عظيم..." كما ذكرنا آنفاً.
في الوقت نفسه نجد نماذج أخرى من العلماء تكونت لديهم الصوراف عن النظر في "وحدة القرآن" بل وحدة السورة الواحدة فنفوها عقلاً ووقوعاً... فالعز بن عبد السلام يتطرق لذلك ويتبنّى موقف النافين فيقول: "المناسبة علم حسن، لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلّف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك، يصان عن مثله حسن الحديث، فضلاً عن أحسنه. فإن القرآن قد نزل في نيّف وعشرين سنة في أحكام مختلفة، شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض"[9].
ويأتي الدكتور محمد عبد الله دراز بعد العز بقرون كالمعتذر عنه ليبين: أن هناك ما قد يسوغ ما ذهب إليه نحو العز من نفي "الوحدة البنائيَّة"، فيعرض رحمه الله الأسباب التي اجتمعت على القرآن بحيث كان يمكن أن تجعل نظم السورة القرآنية مفكّكاً أو غير مترابط بشكل يسمح بالقول "بوحدة السورة"، فضلاً عن القول "بالوحدة البنائيَّة" على مستوى القرآن، فذكر ثلاثة أسباب هي:
- أن القرآن بما امتاز به أسلوبه من اجتناب سبل الإطالة، والتزام جانب الإيجاز صار أسرع الكلام تنقلاً بين شؤون القول؛ فهو ينتقل من وصف إلى قصص إلى تشريع إلى جدل إلى ضروب شتى من فنون الكلام، وهذا أمر يجعل الحفاظ على تناسب المعاني وتلازمها أمراً عسيراً.
- أن القرآن لم يكن ينزل بهذه المعاني جملة واحدة، بل كان ينزل بها آحاداً متفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتجددة المتنوعة، وهذا الانفصال الزماني بينها، والاختلاف الذاتيُّ بين دواعيها كان بطبيعته مستتبعاً لانفصال الحديث عنها على ضروب من الاستقلال لا يدع منزعاً للترابط والوحدة.
- هو تلك الطريقة التي اتبعت في ضم نجوم القرآن بعضها إلى بعض، وفي تأليف وحدات السورة من تلك النجوم.
ومع ذكره رحمه الله لهذه الأسباب الثلاثة المنافية للوحدة، أو المانعة من القول بها فإنه قد عقّب عليه بقوله: "... لو عمدنا إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد -وما أكثرها- وتتبعناها مرحلة مرحلة، وتدبرناها كيف بدئت وكيف ختمت، كيف تقابلت أوضاعها وتعادلت، وكيف تلاقت أركانها وتعانقت... لو تدبرنا ذلك لوجدنا ائتلافاً وتناسباً بين المعاني والمباني، ولبدت لنا السورة وكأنها نزلت في نجم واحد"[10]. فأنت تراه مع ملاحظته لما يصلح اعتراضاً مستدلاً عليه من النافين إلا أن النتيجة التي بلغها كانت مغايرة. ثم بيّن لنا التناسب والترابط والائتلاف في أطول سور القرآن وأكثرها نجوماً، وأغناها تنوعاً في الموضوعات، وهي سورة البقرة.
ثم يعزز ما قرّره في ذلك الفصل القيم من كتابه بما نقله عن الأئمة أبي بكر النيسابوري، وفخر الدين الرازي، وأبي بكر بن العربي، وأبي إسحاق الشاطبي، وبرهان الدين البقاعي بقوله: "إن السورة وإن تعدّدت قضاياها في كلام واحد يتعلّق آخره بأوله وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. وإنما لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية"، يريد القضيّة المنطقية، وهي عبارة عن جملة واحدة.
ولنعد للتدليل على ما بدأناه من التوكيد على أن "الوحدة البنائية" ليست مزيّة تتحلى بها كل سورة لوحدها وبحسبها فقط، بل هي قضية قائمة بالقرآن كله؛ فالقرآن، كله، كالكلمة الواحدة، والجملة الواحدة. في كل سوره وأجزائه، يتسع حتى يصبح كوناً يعادل الكون، كله، بل يستوعبه ويضمّه تحت جناحيه، ويَدِق حتى تراه كأنّه كلمة واحدة لكنَّها عين جارية لا تتوقف ولا تغيض ولا تغور ولا تنضب في المعاني التي تشتمل عليها، والصور الرائعة المثيرة التي ترسمها في ذهن السامع، والآثار الهامة التي تتركها في نفسه.
لقد كان السلف الذين نزل فيهم القرآن الكريم عربَ الألسن، يعرفون حق المعرفة الطاقات اللُّغويّة للسانهم، ويعرفون حدودها معرفة سحرة فرعون لحدود سحرهم وطاقاتهم فيه، والمدى الذي يمكن أن يبلغوه، ولذلك كان السحرة أول المؤمنين؛ لأنَّهم أدركوا أن ما تحداهم موسى، عليه السلام، به يتجاوز كل مستويات السحر التي عرفوها، وبالتالي فليس هو بسحر وما ينبغي أن يكون سحراً. وكذلك الحال بالنسبة للقرآن الكريم وبلاغته وفصاحته وسلامة نظمه.
لقد كان أبناء الجيل الأول، جيل التلقي كثيراً ما يرجعون إلى شعر العرب ونثرهم في الجاهلية وفي صدر الإسلام فيستأنسون به في فهم بعض الكلمات والأساليب القرآنية، ولكنهم كانوا يدركون في الوقت نفسه الفروق الشاسعة بين لسان القرآن واللسان العربي، وهناك العديد من الشواهد البيانية التي أثرت عن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم حفلت بها كتب كثيرة، منها (الكتاب) لسيبويه (180ﻫ)، و(الخصائص) لابن جنّي (392ﻫ)، و(دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) للجرجاني (471ﻫ) ونحوها، وكلها تدلّ على مدى إدراكهم للبون الشاسع بين أرقى ما في اللسان العربي من مستويات البلاغة والفصاحة والنظم وبين لسان القرآن.
الوحدة البنائية ونظرية النظم عند الجرجاني
عبد القاهر الجرجاني يعدّ المتربع على القمة في الدراسات البلاغيَّة من غير منازع. ومنذ بدأنا دراساتنا النقليّة في مدارس المساجد واسما عبد القاهر الجرجاني والبلاغة يستدعي كل منهما الآخر، كما يستدعي المنطق اسم أرسطو، واسم أرسطو المنطق، وكما يستدعي اسم الإمام الشافعي أصول الفقه، واسم الأصول اسم الشافعي. ودراسات الجرجاني دراسات عالم متكلّم أشعري فيلسوف نحويّ، وبتلك العقليّة اكتشف أن "علم النحو" قد انحرف المشتغلون به حين قصروا دوره على أواخر الكَلِم، وجعلوا موضوعه ذلك - وحده. في حين أن عبد القاهر كان يرى أن مهمة "علم النحو" الأولى أن يؤدي بمن يمهر فيه إلى المعرفة الصحيحة بتركيب الجمل، وبناء أساليب الكلام، وترابط المعاني. وأن فائدته الأساس تبرز في تمكين الكاتب من الإتيان بالتعبير المحكم المتماسك من غير ضعف أو تفكّك، وأن العناية بأواخر الكلم وضبطها بالإعراب والبناء بأنواعهما هي وسيلة من الوسائل الهامة لتحقيق ذلك[11].
لكن الأصل هو أن يكون النحو وسيلة للكشف عن إعجاز النظم القرآني، ذلك أن عبد القاهر قد قام باستقراء لكل ما كان معروفاً في عصره من وجوه أو دلائل، كما سماها، تصلح أن تكون موضع "الإعجاز" في القرآن، فذكر كل وجه يحتمل أن يكون له دور في الإعجاز، وناقشه وعقّب عليه ليمارس عملية "سبر وتقسيم" في تلك الدلائل، "فبدأ يتساءل عن الكلمات المفردة في القرآن - هل يكمن فيها سر الإعجاز؟"[12] ثم حذف ذلك بعد أن قرّر أن الكلمات ملك مشاع للناس كافّة، لا يعجز أحد عن أن يأتي بمثلها، فمن المحال أن تكون هذه الكلمات المفردات موضع السرّ لهذا الإعجاز[13].
ثم انتقل إلى تركيب الحركات والسكنات في الجمل القرآنية، ونفى أن يكون لذلك أثر كبير في هذا الإعجاز[14]. وقد سخر الجرجاني سخرية مرّة ممن قال ذلك. وإذ قال فيمن جعل المفردات مجال الإعجاز: "فلو كان هناك شيء أبعد من المحال لكانت هذه الكلمات بمعانيها موضع السر لهذا الإعجاز...". وقد كانت سخريته أكبر وأمرّ فيمن رأى أن سرّ الإعجاز يكمن في الحركات والسكنات، فقد قال فيمن جعل سرّ الإعجاز في الحركات والسكنات في الجمل القرآنية: "إن مسيلمة وغيره قد تعاطوا ذلك في بعض ما عارضوا به القرآن فما انتهوا إلى شيء..."[15].
ثم تناول المقاطع والفواصل في الآيات، فبيّن أن الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر، وقد قدر العرب على روائع القصيد دون أن يستطيعوا الإتيان بسورة من مثل القرآن. فإذا لم تكن الفواصل والمقاطع سرّ الإعجاز فلن تكون أيضاً الاستعارة والمجاز؛ لأن الاستعارة لا تشمل جميع الآيات، والقرآن معجز جميعه. ثم بلغ غايته حين بلغ مرحلة القول بـ"النظم" وكاد يحصر سرّ الإعجاز فيه، قال: "وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها... وجدت المعوّل على أن هاهنا نظماً وترتيباً، وتأليفاً وتركيباً، وصياغة وتصوّراً، ونسجاً وتحبيراً..."[16].
والرجل لا يترك الأمر عائماً، بل يبيّن لنا مراده بـ"النظم" بشكل دقيق: "ثبت الآن أن لا شك ولا مزيّة في أن ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم. ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، ولم يعلم أنها معدنه ومعانه، وموضعه ومكانه، وأنه لا مستنبط له سواها، وأن لا وجه لطلبه فيما عداها - غارّ نفسه بالكاذب من الطمع، ومسلم لها إلى الخدع، وأنه إن أبى أن يكون فيها كان قد أبى أن يكون القرآن معجزاً بنظمه، ولزمه أن يثبت شيئاً آخر يكون معجزاً به، وأن يلحق بأصحاب "الصّرفة"، فيدفع الإعجاز من أصله..."[17].
لقد حمل الجرجاني، بشدة، على أولئك الذين اهتموا بالألفاظ ونسبوا الإعجاز إليها في مواضع كثيرة من كتابه. فـ"الألفاظ عنده خدم المعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها. وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"[18]. فالألفاظ لا تتفاضل، من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلمات مفردة؛ لأن التفاضل من حيّز المعاني، دون الألفاظ. وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر بقلبك، وتستعين بفكرك، وتعمل رويّتك، وتراجع عقلك، وتستجد في الجملة فهمك..."[19].
ويزيد في بيان مراده بـ"النظم" فيقول: "لما كانت المعاني إنما تتبيّن بالألفاظ وكان لا سبيل للمرتِّب لها، الجامع شملَها إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره إلا بترتيب الألفاظ في نطقه، تجوّزوا فكنّوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ، ثم بالألفاظ بحذف الترتيب، ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض، وكشف عن المراد، كقولهم: (لفظ متمكّن) يريدون: أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه [صار) كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئن إليه. و(لفظ قلق ناب) يريدون: أن معناه غير موافق لما يليه [فصار) كالحاصل في مكان لا يصلح له، فهو لا يستطيع الطمأنينة فيه، إلى سائر ما يجيء صفة في صفة اللفظ وساق هناك أمثلة ونماذج كثيرة، وتحليلاً وافياً لدقائق بلاغية رائعة"[20].
مسيرة النظم والوحدة البنائية
لقد كان المفهوم العام لدلالة "النظم القرآني" على الإعجاز في الأجيال الأولى التي منّ الله تعالى عليها بأن تكون في جيل التلقي، ثم جيل الرواية معنى قائماً في العقول والقلوب والنفوس، لم يتداول بحيث يتم إنضاجه، ووضعه في إطار المصطلحات والمفاهيم الفنيّة، شأنه شأن سائر الأمور المعرفيّة الكبرى، حتى جاء الجاحظ ليقع على مفهوم "النظم" ويكتب رسالة في "النظم القرآني" لم تصل إلينا، ولكن ضمّن بعض كتبه الأخرى المتداولة شذرات منها، وبعض الإشارات إليها، وتتابعت بعد ذلك الجهود لتبدو ناضجة سويّة على عهد عبد القاهر في كتابيه التأسيسيين: الدلائل والأسرار. وإذا كان عبد القاهر لم ينص على مفهوم "الوحدة البنائيَّة" فإن جهوده في بناء "نظرية النظم" قد شقت الطريق إليها، وأعطى كثيراً من الدلائل الدالة عليها، وقدم المعالم الموصلة إليها، ولحكمة الرجل وبُعد نظره أطلق على كتابه المفصِّل لنظرية النظم اسم (دلائل الإعجاز)، فهي في نظره "دلائل" على أوجه الإعجاز، كما أكّد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور[21].
فإذا تابعنا المسيرة نجد أن أبا علي الفارسي (377ﻫ) من بعد الجرجاني يعبر عن ذلك المعنى، الوحدة البنائيّة، بشكل صريح صراحة ابن العربي في قوله آنف الذكر. ففي (مغني اللبيب) لابن هشام (761ﻫ) في مباحث (لا) أورد قول الشاعر:
أبى جوده لا البخلَ واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قائله
شاهداً، وذكر أقوال العلماء في تفسير البيت، وأقوالهم في كلمة (لا) فيه، فنقل فيما نقل قول أبي علي الفارسي في كتابه (الحجّة في القراءات) نقلاً عن أبي الحسن الأخفش قوله: فسّرته العرب (أي: البيت): أبى جوده البخل، وجعلوا "لا" حشواً. نقله عن الأخفش. ثم قال الشارح: وكما اختلف في "لا" في هذا البيت: أنافية أم زائدة، كذلك اختلف فيها في مواضع من التنزيل، أحدها قوله تعالى: "لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ" (القيامة: 1) فقيل: هي نافية، واختلف في منفيِّها على قولين: أحدهما أنه شيء تقدم - وهو ما حكى عنهم كثيرا من إنكار البعث، فقيل لهم: ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم؛ قالوا: وإنما صح ذلك لأن القرآن -كله- كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى، نحو: "وَقَالُواْ يَأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ" (الحجر: 6) وجوابه: "مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ" (القلم: 2). وبعد أن فرغ من ذلك عاد لتوكيد ما نقله عن أبي علي الفارسي من أن القرآن كالسورة الواحدة[22].
والذي يهمنا من هذا النقل المطوّل نسبياً أن "وحدة القرآن البنائية" وأنه -كله- كالسورة الواحدة كانت أمرا معروفاً ومتداولاً في القرن الخامس الهجري، وأنها كانت بحيث يستفاد بها في التفسير والتأويل، وتوجيه بعض النصوص. وأن الحديث عنها لا ينحصر في دائرة بيان فضائل القرآن فحسب. بل هي مدخل منهاجي في التفسير والتأويل، وتوجيه النصوص التي تثار حولها إشكالات لغويَّة ونحويَّة. علماً بأن هذا المنهج القائم على النظر إلى القرآن في وحدته هو ما علَّمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل ما أثير من أسئلة واستشكالات في عهده، والتي عرفت بعد ذلك بـ"تفسير القرآن بالقرآن".
وعلوم القرآن، مثل غيرها من علومنا ومعارفنا الإسلامية، أصابها التّوقف بعد تلك المرحلة. فلم تأخذ مدياتها واستمراريتها التي كان من الممكن أن تمنحها الامتداد والتوسع، واستيعاب العصور اللاحقة كما استوعبت ما سبقها. و"الوحدة البنائية" للقرآن المجيد لو أتيح لها من يبلورها في تلك المرحلة، وما يمكن أن تنعكس عليه من أمور لفتحت من العلم الإسلامي أبواباً كثيرة، وعادت عليه وعلى علوم القرآن -خاصّة- بفوائد منهاجية جليلة، ولحسمت كثيراً من الغبش الذي دار حول التنزيل، وأصلحت كثيراً من الخلل. فما يستقيم مع القول بالوحدة البنائية التسليم بأيَّ نوع من أنواع (النسخ) المدّعاة لمناقضته للوحدة البنائية. ولا يقبل القول بوجود أو جواز وقوع تعارض عقليّ أو واقعي بين نصوص الوحي بحيث تستدعي استخدام أسلحة الترجيح. ولما كانت علوم التفسير واتجاهاته أخذت الأشكال التي ورثناها على ما فيها. ولما أصاب العقل المسلم الكسل عن التّدبّر والتّعقّل والتّفكّر والترتيل والتلاوة، حق التلاوة، ولَمَا سقط في دركات الهجر للقرآن ليشابه أولئك الذين حُمّلوا التوراة فلم يحملوها حقّ حملها، ولأدرك أنه قد حملّ القرآن، وأنه مسؤول عن حسن حمله، والتمسّك به. وقدّر الله وما شاء فعل، والعلم أرزاق للأجيال مقدّرة كالأقوات ينزّلها الله تعالى للبشر بقدر. وإذا لم يلتفت إلى فعل من أنزل القرآن عليه، ويتشبث به بحيث يسود سائر المناهج فما بالك في العصور التالية؟!
آثار (الوحدة البنائية)
للوحدة البنائية باعتبارها محدّدا منهاجيّاً من محدّدات (منهجيَّة القرآن) آثار على جانب كبير من الأهمية على سائر العلوم والمعارف النقلية، وحين يجرى توظيفها بشكل منهجي دقيق فإنها سوف تقدم للمنشغلين بهذه العلوم والمعارف وسيلة من أكثر الوسائل فاعليَّة في مراجعة ونقد التراث الإسلامي كله وفي مقدمتها ما يعرف (بعلوم المقاصد) وهي التوحيد، أو الكلام، والتفسير، وأصول الفقه، وعلوم الحديث، والفقه.
وفي هذه الفقرة من البحث سنحاول تقديم أمثلة ونماذج وجيزة تمثل إشارات لتلك المراجعات، القائمة على إدراك (الوحدة البنائيَّة) لعلها تكون معالم تعين الباحثين على مواصلة تلك المراجعات لتنقية التراث وتصحيح المسار.
التوحيد و(الوحدة البنائية)
علم التوحيد الذي صار يعرف بـ(علم الكلام) كانت مهمته الأولى أن يهتم ببيان حقائق الإيمان -كما جاء القرآن المجيد بها- وأركانه ودقائقه وكيف يجمع بين الإيمان والعمل، وتعليم المؤمن كيف يصون هذا الإيمان، ويجعله راسخا يقينياً على الدوام ويقيم على أساس منه متين تصوره بسائر مقومات الإيمان وخصائصه، ويؤسس على قواعد الإيمان (رؤيته الكلية) و(فرقانه): "يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" (الأنفال: 29)؛ فالإيمان هو القاعدة و المنطلق الذي يفرق به بين الخير والشر والحق والباطل في كل شأن.
كما يفترض بهذا العلم أن يحرس أركان العقيدة القرآنيَّة من أن يتسرب إليها ما ليس منها من تراث الأوائل أو ما إليه فتتحول إلى إطار مفتوح يدخله اليقينيّ، وما ليس بيقينيّ فتخفت أنوارها، ويضعف تأثيرها، وتفقد فاعليتَّها. ذلك لأنَّ للعقيدة الفاعلة المؤثّرة خصائص عديدة، في مقدمتها أن تكون أركانها قطعيَّة لا يتطرق الظن أو الاحتمال إلى شيء منها، وأن تكون محدودة جداً وواضحة جداً. وفي متناول الجميع مهما اختلفت مستوياتهم وقدراتهم على الاستيعاب. وفي الوقت نفسه لابد لها أن تكون عامة شاملة قادرة على الإجابة على جميع الأسئلة أو ما يطلق عليها (الأسئلة النهائيّة)[23] أو ما أطلق عليه الفلاسفة الأوائل (العقدة الكبرى)؛ ذلك لأن الإجابات الشافية عن هذه الأسئلة - هي التي تحرر وجدان الإنسان وعقله ونفسه من سائر أنواع الحيرة والضغوط التي تعيق حركته، وتقيِّد إرادته، وتشل فاعليَّته وتجعله تائها في غابات متشابكة من الأفكار والرؤى، والمعضلات والتفسيرات.
كما أنَّ من شأن العقيدة الفاعلة أن تقدم حلولاً، لا أن تفرز مشكلات. ولقد كان هذا شأن القرآن حين قدم للبشريَّة الإيمان ودعاها إلى التوحيد. لقد استعمل القرآن المجيد لتأييد دعواه تلك مجموعة من الأدلة التي يفهمها الناس على اختلاف مستوياتهم في الفهم والإدراك والثقافة والخبرة والتجربة وهي أدلة تستفز سائر قوى الوعي والإدراك في الإنسان وفي مقدمتها (دليل الخلق) ثم (دليل العناية) ثم (دليل الإبداع) و(دليل التمانع) وما إلى ذلك من أدلة تزخر آيات الكتاب الكريم بها. وكان القرآن يقدم دعاواه، ويقدم الأدلة على صدقها، ويتحدى المخاطبين أن يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى أي من هذه الأدلة بمعاول هدم، أو معارضة، أو ممانعة. فإذا فرغ من ذلك، وجرد معارضيه من أسلحتهم. ذكر شبهاتهم وحرَّرها بأقوى ما عرضت به من أساليب، ثم كر عليها لتفنيدها بأساليب لا تبقى لها أثراً يذكر؛ بل إن طريقة عرضها، ثم تفنيدها تصب على الدوام في صالح القرآن المجيد، لأن المعارض ينبهر بطريقة القرآن بالإحاطة بكل ما صدر عنه، أو حاك في نفسه، أو زوَّره في خاطره، ويأتي جواب القرآن بأساليبه المتنوعة ليجد المعارض نفسه في حالة اندهاش تام، بحيث لا يملك إلا الانقطاع أو الاستسلام أو الانسحاب بهدوء مذموماً مخذولاً. فإذا حاول بعد ذلك أن يداري هزيمته بشكل أو بآخر فإنه لن يجد إلا الشغب الصريح الذي يتحول إلى سلاح ضده لا عليه.
وقد استعرضنا التوحيد حقيقته وتجلياته المختلفة باختصار في كتابنا الوجيز (التوحيد) باعتباره أعلى القيم القرآنيَّة العليا الحاكمة وأساسها. وقد طبع عدة مرات. فلا نطيل في هذه التفاصيل فلما انتهى جيل التلقي، وبدأت نِحَل ومِلَل تظهر بأسماء لم يألفها القوم بعدُ ظنّوها نحلاً جديدة، تطرح شبهات محدثة، وما هي بمحدثة ولكن هذا ما ظنّوه. ولو تدبَّر الناس القرآن الكريم لوجدوه قد ناقش ذلك -كله- وفنَّده، وقال في سائر تلك النحل بما فيها (النحل المعاصرة) كلمته، وحسم أمرها.
ولكن القوم ظنوا أنها لحداثتها تحتاج إلى أساليب وفنون أخرى لمناقشتها وتفنيدها وحماية العقائد الإسلامية من أضرارها وأخطارها. فتطور (علم التوحيد القرآنيّ) إلى (علم الكلام) وصار يعنى بالمنطق اليوناني ووسائله لبناء التصورات والتصديقات، وطرائقه في إقامة البراهين ويعنى بالفلسفة اليونانية كذلك بمدارسها المختلفة ليواجه بها تلك الشبهات فآلَ (علم التوحيد) إلى (علم كلام) مهمته إيراد الشبهات المختلفة ومناقشتها بأساليب الفلسفة وطرائق المنطق باعتبار أن الخصم لا يؤمن بالقرآن فلا يمكن إقامة الحجة على الخصم بما لا يؤمن به، ولا يلتزم بمقولاته. ولم يلتفت جل علماء الكلام إلى أن الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات لم تحسم أية قضية من القضايا المثارة. وبقيت تلك المسائل في دائرة الثنائيَّات المتصارعة حتى يومنا هذا.
كما أن فريقاً منهم ظنوا أن الجدل في (قضايا الغيب وعالم الأمر) التي تشكل جوهر القضايا الكلامية قد لا يختلف كثيراً عن الجدل في القضايا الفقهية فلم يجدوا حرجاً في استعمال الأساليب ذاتها في تلك القضايا الخطيرة التي حسمها القرآن كلها وبلغ بها الغاية، وأوصل المهتدين بها إلى الثلج وبرد اليقين. ولعل هؤلاء ومن إليهم - هم الذين عناهم الإمام الشافعي يرحمه الله بقوله: (لا تتجادلوا في الكلام؛ فإنّكم إن تجادلتم في الكلام كفّر بعضكم بعضاً، فإن كنتم لا بد فاعلين فتجادلوا في الفقه فإن قصارى ما تبلغونه أن يخطئ بعضكم بعضاً).
لكن الكثيرين قد استمرؤوا ذلك الجدل، فإذا بكل تلك اليقينَّيات القرآنية تصبح مادة جديدة للجدل، دون استثناء، وتحولت موضوعات الفلسفة اليونانية والمقولات الإنسانيّة المندثرة إلى هذا العلم الجديد، وفي مقدمتها ما يتعلق بالذات الإلّهية، والصفات العليّة، وحقائق النبوات والجبر والقدر، ومصادر الفعل الإنسانيّ، بل وحقيقة الفعل الإنساني، وما إذا كان فاعله الحقيقي الله، والإنسان مجرد مظهر وشكل يقع الفعل منه ظاهراً، في حين أنه لا فعل له في الحقيقة والواقع أو أنّه هو المنشئ لفعله؟
كما اختلفوا في الأسباب والعلل أهي أسباب على سبيل الحقيقة أم هي مجرد أشكال ظاهرة لا تأثير لها والمؤثّر الحقيقي يختفي وراءها، وقعوا في الخلط بين المشيئة الإلّهية والمشيئة الإنسانيّة، وبين الإرادة الإلهّية والإرادة الإنسانية. وهكذا فكك علم الكلام الأمّة التي بناها القرآن المجيد ليجعل منها فرقاً وشيعاً وأحزاباً، واستعملت الأحاديث الموضوعة والضعيفة مثل حديث (افتراق الأمة) للتأصيل لتلك الأحوال الشاذة، فروت الفرق، كلها، حديث افتراق الأمة وتداولته حتى منحته شهرة لا يستحقها، لأن كل فرقة وجدت فيه ضالتها لتستدل به على أنها الفرقة الناجية والأمة كلها هالكة، والحديث ضعيف لا يمكن العثور له على سند صحيح، ولكن المنشغلين بهذه الأمور أقاموا على ذلك الحديث (الذي لا يصمد له متن ولا سند أمام معاول النقد العلمي الدقيق ووفق قواعد المحدثين أنفسهم) أقاموا علماً قائماً بذاته سموه (علم الملل والنحل) مازالت الكليَّات والجامعات المعنيَّة بالعلوم والمعارف النقليّة تقيم له الأقسام، وتمنح دارسيه الذين يتلقونه بالقبول كمن سبقهم شهادات الماجستير والدكتوراه والأستاذيّة وألقاب الحجة -حجة الإسلام، وآية الله... وكل قضايا (الكلام والملل والنحل) يقتطع المتناحرون فيها آيات من كتاب الله تعالى عن سياقاتها، ويبترونها من نظمها ووحدتها ونسقها ليجعلوا منها موضع شاهد فقط لما يذهبون إليه، ولا يعدم كل فريق وسيلة لحملها على ما يريد، وتفسيرها بما يجعلها شاهداً ملائماً لمذهبه، مؤيِّداً لوجهة نظره، وما أنزل القرآن العظيم ليتخذ شواهد لمقولات القائلين، ولذلك شاعت تلك المقولة الخطيرة ورددها المرددون وهي: (أن القرآن حمال أوجه) ونسبوا ذلك إلى الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وما كان لمثله أن يقول ذلك، وعنه روي حديث (القرآن باعتباره المخرج من الفتن) كما أخرجه الترمذي وغيره. كما أشيعت مقولة أخرى، هي: (أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية)[24] ليسوغوا لأنفسهم وضع مرجعيات أخرى إلى جانب القرآن المجيد. ففي مجال الكلام أعطوا للمنطق سلطة غير عادية حتى سماه الغزالي (معيار العلم) و(القسطاس المستقيم)، وصرح بأنَّ من لا يتقنه لا يعتد بعلومه. والكتابان مطبوعان متداولان.
كل ذلك وكثير غيره -مما يحتاج تتبعه وبيانه إلى دراسات مفردة مستقلة- قد حدث، لأن هذا النوع من المعرفة ما كان ينبغي أن يؤخذ من غير القرآن في وحدته، لا في تعضيته وتقطيعه.
فإذا أردنا التخلص من بعض هذا التراث المصاب، وتنقية ما يبقى منه، وتطهيره مما علق به، وتخليص العقل المسلم والوجدان المسلم من تلك الآثار الخطيرة فلا نجاة لنا إلا بعرضه كاملاً على القرآن في وحدته البنائيّة، ومراجعته ونقده والتصديق عليه في نور القرآن المجيد وهدايته. وإعادة بناء التوحيد والإيمان على القرآن، وتأسيس العقيدة على هديه. ويومئذ يفرح المؤمنون بالخروج من حالات التمزق والاحتراب إلى حالة الألفة التي كان القرآن قد أوصلهم إليها "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُم إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا..." (آل عمران: 103). لقد تفرقت الأمة من بعدما جاءتها البيّنات، وسقطت في أمراض الأمم السابقة. وما كان لذلك أن يحدث وبأيمانها نوران: ذكر وسنّة.
هذا الذي أجملناه هناك يمكن لأساتذة وطلبة (علوم العقيدة) وأقسامها أن يفصلوه في بحوث ودراسات تكشف عن تلك الإصابات الخطيرة التي تجعل الباحث يعجب كيف استطاعت هذه الأمة أن تعيش كل هذا الزمن الطويل رغم إصابتها بكل تلك الأمراض الخطيرة؟! إنه لا يغني عن الأمة شيئاً أن ينشغل أساتذة وطلاب هذه الأقسام بتحقيق المخطوطات، وتوكيد وبعث وإحياء تلك المقولات وهم يعلمون أنها لو كانت أو كان فيها خير لنهضت بالأمة من قبل، ولما كان حال الأمَّة هذا الذي هي عليه اليوم. إن هذه الأقسام مطالبة أكثر من غيرها بعمليات المراجعة لذلك التراث كله وعرضه على هداية القرآن الكريم الموحد للتصديق عليه بالقرآن والهيمنة عليه به، وإنقاذ الأمة وتطهير عقولها وقلوبها من إصاباته.
التفسير و(الوحدة البنائيَّة)
فإذا انتقلنا إلى (التفسير) وما يمكن للوحدة البنائيَّة أن تحدثه فيه، فسنجد أنّها سوف تدخل عليه تغييرات جوهريَّة. فالتفسير يعد أول المعارف الإسلامية حيث بدأ بعض الصحابة يمارسونه في عهد رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، لهم في ذلك حين كان يفسر لهم القرآن بالقرآن ذاته، أو يقوم بتنفيذ وتطبيق ما يوحى إليه ليبين لهم.
وقد كان ينبغي أن يتخذ ما قدمه رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، منهاجاً لا يحيد المفسرون عنه، بل يبنون عليه، وإذا كان لابد من إضافة شيء فليكن من القرآن ذاته، أو ينبغي أن يربط بالقرآن الكريم ربطاً محكماً. فسائر القضايا اللُّغوية كان ينبغي أن يكون الحَكَم فيها القرآن ذاته ولغته وأساليبه فلا يفسر القرآن بدواوين الجاهليّة، ولا بتراث بني إسرائيل، ولا بلغة البدو، بل تكون لغته هي المهيمنة على اللّغة العربيّة، وتكون اللّغة العربيّة تابعة للغته. يبني لسان القرآن قواعدها كلها انطلاقاً من لغته. ومن الطريف أن نذكر نموذجاً يوضح ما حدث. لقد وضعوا أحكام النحو والتصريف والاشتقاق وغيرها وفقاً للغة العرب، بل إن معاني الكلمات والعبارات قد حددت وفقاً لمراد العرب بها، فهذه الكلمة يحدد معناها العرف القرشي، وتلك يحدد معناها لسان بن تميم وتلك لهجة هذيل... إلخ. ولو أن لغة القرآن الكريم كانت مثل لغات هذه القبائل مبنى ومعنى، فأين هو الإعجاز؟ ولِم انبهروا به؟ وكيف أدركوا تفوقه وعجزوا عن الاستجابة لتحدّيه المتكرّر؟ إن الاتفاق في المباني، واستيعاب المعاني وتجاوزها، والسموَّ بها إلى تلك الآفاق التي جعلت من مفردات القرآن مفاهيم تتجاوز كل ما تعارفوا عليه في لغاتهم ذات المعاني المحدودة محدوديَّة آفاق فكر العربيّ -آنذاك- والبسيطة بساطة حياته وبيئته هي التي جعلتهم يجدون في آيات القرآن أموراً لم يألفوها، ومعاني لم تخطر لهم قبل نزول القرآن على بال، ولذلك قالوا في البداية: إنَّه شعر، ثم قالوا: إنَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه سحر ثم قالوا: إنَّه شيء يفوق طاقاتنا، ويستغرب أن يأتي على لسان واحد منَّا فهو إما كلام كهان أو سحرة، أو تنزلت به الشياطين... أو أنَّها من تعليم بشر من غيرنا... أو... أو.
والله تبارك وتعالى قال: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ" (إبراهيم: 5)، فلو كان القرآن نازلاً بلغات العرب -كما هي حقيقتها- مبنى ومعنى لما احتاجوا إلى بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم.
إن العرب قد رأت في الكتاب الكريم مثل ما رأته في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم؛ فهو منهم يعرفون نسبه وحياته وأسرته وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك، ولكن انفصاله عنهم فيما يستحيل عليهم أن ينالوه بكسبهم البشريّ، وهو النبوة والرسالة وتلقي الوحي عن الله تعالى سبَّب لهم الصدمة، ودفعهم إلى كل تلك التساؤلات والحيرة حتى أدرك من آمن منهم إمكان ذلك، فآمنوا بأنه بشر رسول. وهكذا صار القرآن بالنسب عربيّ اللُّغة ولكنّه وحي إلهيّ وكلماته تجمع بين سمات اللغة ومضامين الوحي، بل إنّ الوحي قد أعاد إنتاجها، إن صح التعبير، فالكلمة المستعملة فيه لم تعد كلمة قريش أو تميم أو هوازن أو هذيل، بل هي كلمة الله تعالى. ولذلك فإنَّنا نستطيع أن نجد أمثلة كثيرة جداً لمفردات استعملها القرآن، وطور معانيها، وفتح الكلمة على آفاق من المعاني ما كانت معروفة أو مستعملة لدى العرب. وهذا لا يعني إحداث قطيعة بين لسان القرآن واللسان العربيّ فالنصّ على عربيّة القرآن لا يحتمل التأويل، إن المراد أن يعرف تفوّق لسان القرآن على اللسان العربيّ المألوف كما لا يعني ذلك أن نهمل سائر المعاني اللُّغوية التي كانت متداولة أو معروفة وقت النزول، بل علينا أن ندرك كيف كانت تلك المعاني بسيطة ساذجة معبرة عن مستوى فكر العربيّ في تلك المرحلة فجاء القرآن ليشحنها بمعان لم تكن معهودة من قبل، ولا تندرج تلك المعاني تحت الفكر الإنسانيّ وقدراته.
فكل الكلمات الشرعيَّة مثل (الإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج، والكفر والشرك والنفاق، وما إليها) كانت لها معان بسيطة في الاستعمال العربي الجاهليّ فقام القرآن بتنقيتها وشحنها بالمعاني التي أراد لها أن تحملها وتشتمل عليها، فتطويع تلك الكلمات لكل تلك المعاني بعض أوجه إعجاز القرآن الكريم.
خاتمة
وبعد: فإنّ "الوحدة البنائيَّة" ما تزال في حاجة إلى جهود يقوم بها متخصصون في مختلف فروع المعارف الإسلاميَّة واللّغويّة لتستوي على سوقها، وتبرز فضائلها ومزاياها. وتأخذ موقعها الهام بين "المحدّدات المنهاجيّة" التي تتألف منها "منهجيّة القرآن المعرفيَّة" سائلين العليّ القدير أن يوفق ويعين على استكمال هذه البداية. ويرزقنا السداد، إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
الهوامش
- يرجى أن لا يفهم من هذا أننا ندعي إعجازاً في الألفاظ المفردة، بل نريد أن نؤكد أن تلاحم الكلمات في الآيات وتناسبها، وتلاحم الآيات مع نظيراتها، ثم السور مع أمثالها شبيه بتوافق الأحرف داخل الكلمة الواحدة، ولا فرق من حيث التناسب والتوافق والانسجام.
- جزء من حديث عليّ رضي الله عنه الذي قمنا بتخريجه في بداية الحلقة الثانية "الجمع بين القراءتين" في هذه السلسلة فارجع إليه.
- أشرنا إلى أن هذه الجملة قد شاع تناقلها عن الإمام علي رضي الله عنه وفي نقلها عنه نظر، وراجع هامش (رقم: 5، ص21) من حلقة "الجمع بين القراءتين" سلسلة "دراسات قرآنية".
- راجع هذا ونحوه في هامش (رقم:1، ص23) من حلقة "الجمع بين القراءتين" سلسلة "دراسات قرآنيَّة".
- راجع الحلقة الثانية من هذه السلسلة "الجمع بين القراءتين".
- كل هذه مصطلحات لمباحث أصوليّة، قد ترد في مباحث "علوم القرآن" في المطولات منها.
- عن: أسرار ترتيب القرآن، ص39-40. وراجع: إعجاز النظم القرآني، التناسب البياني، أحمد أبو زيد، ص6، منشورات كلية الآداب في الرباط، 1992. والإتقان، السيوطي، 2/108.
- للإمام الرازي كتاب "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز" تبنّى فيه "نظرية النظم" ومع ذلك فإنه سار فيه على نهجه في كتبه الأخرى التي ألف أن يستعين فيها بالمنطق والطرق الفلسفية والتفريع على أصول المسائل والاستطراد الكثير. فلم يلتفت بقدر كاف إلى ما يتعلق بجمال النصوروعة النظم، وإعجاز أساليب التعبير، وهو جوهر قضية النظم. وكذلك فعل في تفسيره حيث رأيناه يتجه الوجهة ذاتها.
- الإتقان، السيوطي، 2/108، ولابن عاشور تحفظ قريب من هذا راجعه في المقدمة الثانية، 1/27.
- راجع: النبأ العظيم، عبد الله دراز، فصل: القرآن في سورة منه-الكثرة والوحدة، ص142-163. وقد قدم رحمه الله في هذا الفصل منهجاً للكشف عن وحدة السورة قدم به لدراسته للوحدة البنائية في السورة التي اختارها نموذجا تطبيقيا كشف به عن الوحدة في سورة البقرة. وراجع مقارنا: التناسب البياني في القرآن، د. أحمد أبو زيد، ص49-51، لتجد قراءة د. أبو زيد لجهود، د. دراز وتلخيصه لمنهجه التطبيقي كما برز في سورة البقرة.
- راجع مقدمة: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني. وقد أكد على أن "النظم" ليس سوى تعليق الكلم ببعضها، ثم شرح ذلك بإسهاب ودلّل عليه. فنظرية النظم عنده قائمة على النحو، منبثقة عنه.
- خطوات التفسير البياني، مصدر سابق، ص206.
- انظر مناقشته لشبهات من جعلوا الفصاحة للألفاظ: دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص299 وما بعدها. وقارن بتحليله الدقيق لدور المفردات في ص33 وفي ص341.
- المرجع نفسه، ص21 وما بعدها.
- المرجع نفسه، ص39-44.
- المرجع نفسه، ص25. والمراد "بالصرفة" أنّ الله تعالى صرف العرب عن معارضة القرآن الكريم ولازم هذا القول: أنّ المعارضة ممكنة لولا هذا الصرف الإلهيُّ عنها.
- المرجع نفسه، ص333.
- المرجع نفسه، ص38.
- المرجع نفسه، ص43.
- نفسه، ص43.
- انظر التفسير ورجاله: محمد الطاهر بن عاشور، ص49. وكون الجاحظ من المعتزلة لا يقلل من أهميةَّ جهوده وريادتها في هذا المجال. حتى وإن استهدف بذلك الانتصار لمذهبه الكلاميّ. وكون عبد القاهر من الأشاعرة وأنّه أراد بذلك الانتصار لمذهبهم لا يقلّل من أهميَّة إبداعه في هذا المجال. وكل منهما قد شيد جانباً من جوانب النظرية أو أخذ بواحدة من عضَّادتي الباب.
- راجع: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، وحاشيته للشيخ الأمير، 1/185. وقد مرّ كيف علمهم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المنهج في القراءة، فتأمل! هذا وقد مرت إشارتنا إلى تحفظ العز بن عبد السلام، وابن عاشور.
- تطلق "الأسئلة النهائيّة" على مجموعة من التساؤلات الإنسانية التي تجيب العقيدة عليها، وهي من أنا من أين جئت، وإلى أين أنا ذاهب وماذا بعد؟! وهي أسئلة ناجمة عن قلق تدفع فطرة الإنسان إليه ليبحث ويأخذ طريقه إلى معرفة خالقه سبحانه، وهي ذاتها التي كان الفلاسفة الأوائل يطلقون عليها "العقدة الكبرى".
- عبارة شاعت في كتب الأصول، خاصّة في مباحث الاستدلال "لحجيَّة القياس" وردّدها بعض الكلاميّين كذلك. وعلماء الفرق.