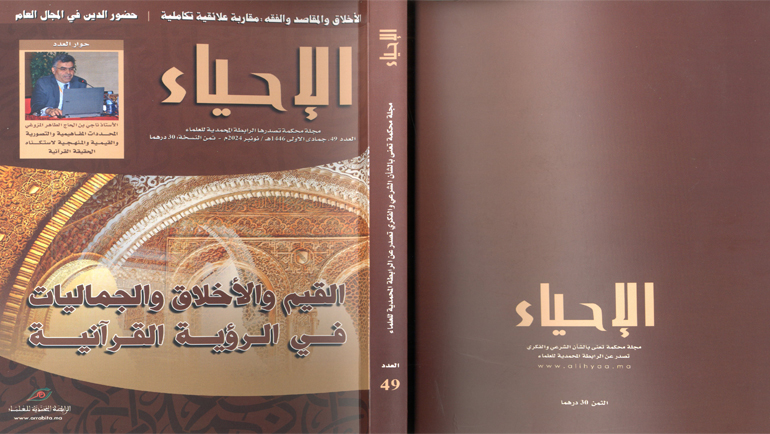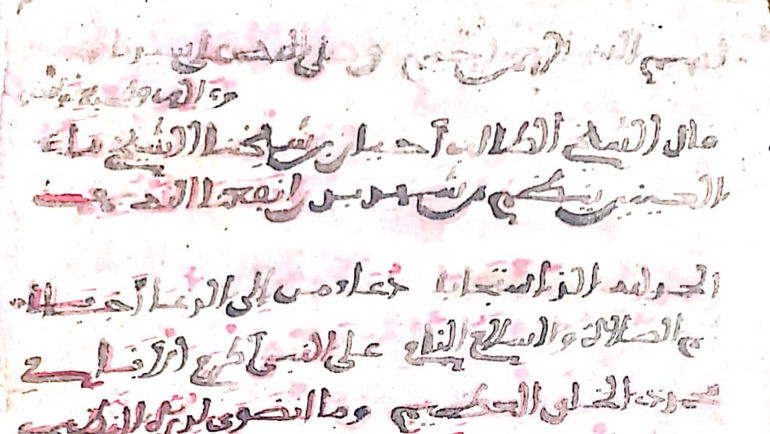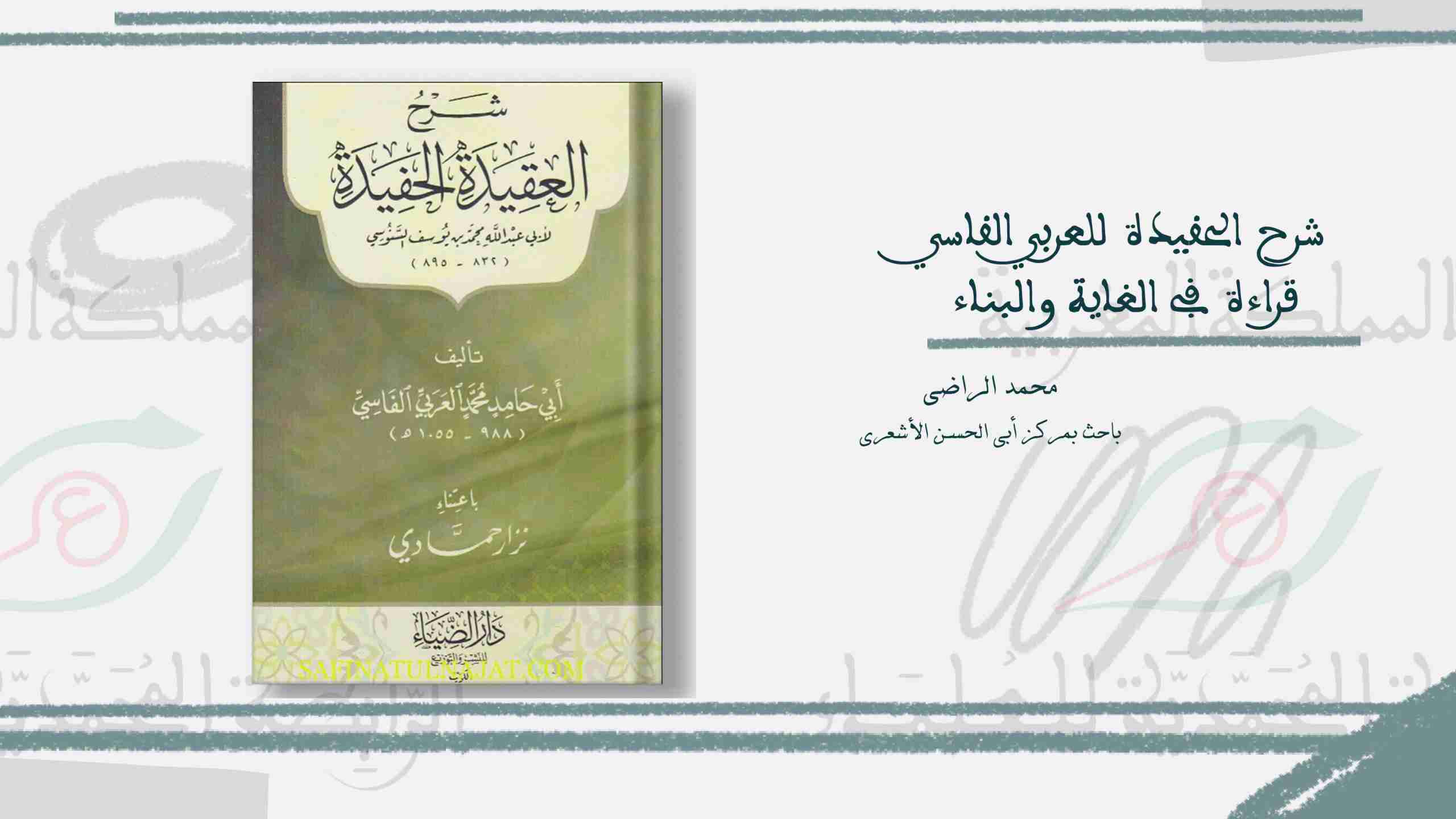تخلق قراءة الفكر الخلدوني، باهتماماته غير المتناهية، لدى القارئ حالة من الاندهاش المتواصل عبر فصول المقدمة، وغيرها من الكتابات، مثلما تخلق لديه قناعة راسخة بأربعة ثوابت تصاحبه عند قراءة كل العلوم التي تناولها ابن خلدون، بما فيها النقد الأدبي طبعا:
ـ أولها: أن عبد الرحمن كان يجسد مفهوم "المشاركة" بمعناها الانسيكلوبيدي المتعارف عليه في القرون الوسطى. فمن حيثما تناوله الباحث، يجده متخصصا دقيقا، عميق التحليل. إن من يدرس ابن خلدون يجد نفسه أمام مخزون معرفي لا آخر له، "لقد اهتم بكل شيء لكي يغير كل شيء" كما يقول.د. محمد عزيز الحبابي.
ـ ثانيها: أنه كان عملاقا في سعة علمه، لكن أيضا في جرأته ومنهجه المتطور في معالجة الأمور. لقد كان صاحب رؤية متميزة تبتغي التجديد في كل المجالات التي تناولها إلى حد التشابه في كثير من الأحيان مع النظريات الحديثة.
ـ ثالثها: لكن هذا النزوع: إلى تجاوز فكر العصر: لا يسمح بمحاكمة ابن خلدون خارج سياقه التاريخي كمفكر عاش في مرحلة القرون الوسطى، مما قد يفضي، وهو ما حصل فعلا، إلى الحكم عليه بالرجعية والتخلف في المنهج والفكر.
ـ رابعها: أنه واحد من أكثر المفكرين المسلمين إثارة لفضول الباحثين المعاصرين واستقطابا لدراستهم، مؤرخا، واجتماعيا، واقتصاديا، وفيلسوفا، ومربيا، وسياسيا، وقاضيا، وسفيرا، ورحالة...الخ، إلا أن هناك جوانب هامة من فكره غابت عن أصحاب هذه الدراسات، كالتصوف مثلا الذي ألف فيه كتابا على جانب كبير من الأهمية هو: شفاء السائل بتهذيب المسائل"، وأهلته تجربته فيه لأن يتولى مشيخة الخانقاه (الزاوي) البيبريسية بالقاهرة... وكالشعر الذي خلف فيه عددا كبيرا من النصوص الجيدة، وكتب عنه فصلا طويلا في المقدمة يدل على تمكن من أدواته، وتاريخه، وكالفقه والمنطق... إضافة إلى النقد الأدبي موضوع هذا البحث.
فالنقد الأدبي، كاهتمام فكري وكممارسة فعلية تدخل في صميم التجربة الأدبية، واحد من بين العلوم التي خفيت عن الدارسين، رغم أن ابن خلدون انشغل به، واجتهد في تجديد مناهجه وأحيانا تجاوز بعض الضوابط. والمسلمات الكلاسيكية فيه. وإن انتبه إليه بعضهم – وهم قليل جدا- فمن باب الإشارة العارضة فحسب.
من هؤلاء نذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني المؤرخ الذي ذكر في كتاب "رفع الإصر عن قضاة مصر" أنه اجتمع بابن خلدون مرارا وسمع من فوائده ومن تصانيفه خصوصا في التاريخ. وأنه: "كان لَسنا فصيحا حسن الترسل، وسط النظم، مع معرفة تامة بالأمور، خاصة متعلقات الملكة. وأنه كان جيد النقد للشعر، وإن لم يكن بارعا فيه"[1].
وأثنى عليه أيضا صديقه ابن الخطيب لسان الدين، وأشاد بإجادته في الأدب والشعر: ".. كثير الحفظ صحيح التصور. وأما نثره وسلطانياته السجيعة، فخلج بلاغة ورياض فنون، ومعادن إبداع يفرغ عنها يراعه الجريء..."[2]. وكذلك فعل أبو الوليد بن الأحمر[3]، والمقريزي[4].
وفي العصر الحديث، تنبه أستاذنا الدكتور عبد الله الطيب إلى هذا الأمر، وأشار إلى أن ابن خلدون ظُلم مثلما ظُلم القاضي عياض اليحصبي، وابن جرير الطبري، وأبو حامد الغزالي، وغيرهم، الذين اكتفى الباحثون بما اشتهروا به من علوم لدى الناس، وغضوا الطرف عن ما سوى ذلك. يقول متحدثا عن عراض الناقد: "هذا ولا يخفى أن كبار العلماء قد كانوا – بحكم تبحرهم في العلوم ومعرفتهم بالعربية وآدابها أيضا أدباء. وإنما غلب عليهم اسم العلم لقوتهم فيه. وربما كان الرجل من هؤلاء موسوعة ضخمة من ألمعكم والإتقان فاشتهر بما نظن أنه تخصص فيه دون سواه، مع دقة غوصه وبعد نظره في ذلك. مثلا محمد ابن جرير الطبري قد ضمن كتبه الاختيار النادر في الشعر، والحجج الجيدة في تحليل المعاني، والنظر الفاحص في مسائل النحو، مع الموازنة القليلة النظير بين مذاهب أهل الكوفة وأهل البصرة. وابن خلدون قد تناول موضوعات جيدة مما يدخل في صميم النقد وتاريخ الأدب. والغزالي قد تناول مسائل من أمهات علوم الاجتماع لاشك أن ابن خلدون قد انتفع بها في المقدمة"[5]. وقال عنه أيضا د. عمر فروخ أنه: "أديب وشاعر وناقد"[6].
وكما أشار أبو القاسم محمد كرو إلى الشهرة الأدبية الملحوظة لابن خلدون[7] فإن أستاذه في هذا المجال، ساطع الحصري أثبت أنه كان صاحب اطلاع واسع، وتعمق كبير في النقد الأدبي، وبالأخص منه ما ورد في كتاب الأغاني[8] الذي ذكره في المقدمة أكثر من ست مرات. وذهب إلى مثل هذا الرأي أيضا محمد بنتاويت والصادق عفيفي[9]، وعبد المنعم خفاجي[10] ومحمد رجب البيومي[11] وغيرهم.
غير أن د. إحسان عباس ذهب إلى أبعد من هذا حين جعل ابن خلدون: "أعظم ناقد في هذا العصر، رغم أنه لم يزاول النقد الأدبي ولم يمنحه من جهده الشيء الكثير"[12].
والواقع أن النقد الأدبي لم يكن بعيدا عن مجال اهتمام ابن خلدون خصوصا إذا علمنا أنه قبل اشتهاره بالعلم كان أديبا وشاعرا، يشهد بذلك ما ذكره ابن الخطيب من أنه شرح البردة، وشرح ألفية له، أي لابن الخطيب، في أصول الفقه هي "الحلل المرقومة في اللمع المنظومة "شرحا" لا مزيد عليه من البراعة والكمال"[13].
هذا بالإضافة إلى ما تجده بكثرة في الإحاطة من أشعار فيها الكثير من المهارة الدالة على تمرس بنظم الشعر. ولعل هذا ما دفع بغاستون بوتول إلى أن ينسب إليه ؛ (أي إلى ابن خلدون) ما أورده في آخر المقدمة من أشعار باللغة العامية إذ رأى أن هذه الأغاني "مفتعلة" على حد تعبيره[14].
هذه كلها مجموعة مؤشرات تكشف أساسا عن انتباه المفكرين إلى عمق اهتمام ابن خلدون بالأدب ممارسة ونقدا، وإن كانت لم تتجاوز مستوى الانتباه والملاحظة إلى الدراسة.
وجدير بالإشارة هنا أننا سنحاول أن نتحاشى نظريات ابن خلدون الألسنية واللغوية، وإن كانت ذات علاقة وطيدة بالنقد الأدبي، فقد تناولها بالتفصيل عدد من الباحثين[15]. كما أننا لم نلتفت إلى تعليقاته النقدية التي ترد على مدى صفحاتها المقدمة حول بعض النصوص الشعرية والنثرية، لأننا ركزنا على أهم المحاور الأساسية في الموضوع، وإلا فالموضوع، لسعته وتعدد جوانبه، في حاجة إلى عدة أبحاث متخصصة سنوردها في موضع لاحق.
1. مفهوم الأدب
إن أول ما يسجله الباحث هنا، هو أن ابن خلدون لم يقدم تعريفا صريحا للأدب بمعنى دقيق. بل أورد ما يشبه "مجموعة إيضاحات" حول هذا العلم. فهو يعتقد أن الأدب لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها، وإنما المقصود ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور (سيعرفهما فيما بعد كلا على حدة). ويلاحظ أن هذا التقسيم الثنائي يتكرر عشرات المرات في المقدمة. مؤكدا انفصال الفنين من حيث الأدوات والخصائص، واتصالهما من حيث انتماؤهما إلى علم الأدب.
بعد هذا يستعرض ابن خلدون مجموعة من الأدوات المفيدة لطالب البراعة في هذا العلم: "... وإنما المقصود به عند أهل اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم. فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الملكة من شعر عالي الطبقة، وسجع متساو في الإجادة، ومسائل في اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية، مع ذكر بعض أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم منها، وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة. والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه، لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه"[16]. ويحتاج الأديب كذلك إلى معرفة علوم أخرى لا مناص له عنها كالقرآن والحديث والاصطلاحات العلمية[17].
بعد هذا يحدد ابن خلدون أمهات المصادر الضرورية لتأسيس ثقافة أدبية في أربعة: "أدب الكاتب" لابن قتيبة، و "الكامل" للمبرد، و" البيان والتبيين" للجاحظ، و "النوادر" لأبي علي القالي. وأما سواها: "فتبع وفروع". على أنه ألح في غير ما موضع من المقدمة على أهمية كتابين آخرين أثنى عليهما كثيرا، هما: الغاني والعمدة اللذين يبدو أنه تأثر بهما إلى حد كبير حسبما تدل عليه كثرة استشهاده بأقوالهما وآرائهما. كما أن تعريفه للآداب لا يخلو من تأثر بالأصبهاني في إدراج الغناء ضمن فنون الأدب[18]. في حين أن كثيرا من العلماء أدرجوه ضمن: " علم الأصوات".
2. ماهية الشعر
الواقع أن ابن خلدون أوهم بعض الدارسين بوجود تناقض في تعريفين أوردهما للشعر. وذلك ما جعل د. إحسان عباس[19]، يتجاهل أحدهما ويثني على ملامح التجديد في الآخر.
1. التعريف الأول يقول فيه: "اعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين: فن الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون المقفى..."[20] وهو تعريف مألوف لدى أغلب النقاد العرب القدامى كابن رشيق[21]، الذي أثنى عليه ابن خلدون في عدة مواضع من المقدمة. إلا أن ابن خلدون سوف يسخر منه ويستخف بأصحابه في موضع آخر. ولعل ذلك راجع إلى أنه أورده في معرض الحديث عن العلوم والفنون والملكات، التي تستلزم تعريفات وصفية ظاهرية فحسب. فكان الغرض منه وصف الشعر بشكل عام كنمط تعبيري من حيث قواعده الكبرى وضوابطه ولذلك جاز أن نسمي المعرف هنا "نظما" (إذ ليس كل نظم شعرا). لكن حين ينتقل ابن خلدون إلى مستوى آخر، يتغاضى عن التعريف الأول، ويطرح تصورا نقديا دقيقا لخصائص وجزئيات العملية الإبداعية، مما يمكن إدراجه في صميم الممارسة النقدية. وكأنه يخاطب في التعريف الأول قارئا من مستوى أول (الباحث عن تعريفات عامة للعلوم، وفي التعريف الثاني الباحث عن وسائل وأدوات التمكن من الملكة الشعرية).
2. التعريف الثاني، وفيه يرفض ما أثبته أولا. يقول، بعد أن تحدث عن الشعر والملكة الشعرية كيفية تحصيلها؛ وقول العروضيين في حده إنه الكلام الموزون المقفى ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده، ولا رسم له، وصناعتهم إنما تنظر إلى الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة. فلا جرم أن حدهم ذلك لا يصلح له عندنا، فلابد من تعريف يعطينا حقيقة من هذه الحيثية فنقول؛ الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به"[22].
يفهم من النص إذن، الشعر ينبني على ستة مقومات:
أ. البلاغة.
ب. توظيف الاستعارات والأوصاف.
ج. الوزن.
د. الروي.
ﻫ. وحدة البيت.
و. الجريان على الأساليب المخصوصة به عند العرب. وإلا فهو نظم فقط. (على أن كلام ابن خلدون كان عاما في هذا الشرط الأخير، فلم يوضح بدقة أساليب العرب الواجب جريان الشعر عليها، وإن كان قد أشار في موضع آخر إلى أن خلوه منها هو ما أخرج المتنبي والمعري من دائرة الشعر. ولعله كان يقصد بذلك ما اصطلح عليه "بكثرة الماء" في الشعر. يفهم ذلك من خلال ما استشهد به أشعار الجاهليين التي تخلو من الطابع العقلي الفلسفي وتمتلئ بالقوة والجزالة مع الطبع).
3. الحد بين الشعر والنثر
إن تحديد مفهوم الشعر يقود بالضرورة إلى المقارنة بينه وبين النثر ورسم مجال كل منهما كنمطين تعبيريين لهما من التداخل والتمايز ما يجعل طرح هذه المقارنة جزءا أساسيا من فهم العملية الإبداعية الأدبية بشكل عام.
يحاول ابن خلدون في هذا السياق أن يضع لكل منهما حدا خاصا به، منتقدا بذلك الخلط السائد عند كتاب زمانه، الذين يستعملون السجع المفرط والقافية، ويقدمون النسيب بين يدي الأغراض، وما إلى ذلك من المبالغات التي تجعل النثر شعرا دون وزن، وهذا في رأيه غير صواب في باب البلاغة: "...واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به عند أهله ولا تصلح للفن الآخر... وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض. وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه، لم يفترقا إلا في الوزن. واستمر المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية، وقصروا الاستعمال في المنثور كله على هذا الفن الذي ارتضوه وخلطوا الأساليب فيه، وهجروا المرسل وتناسلوه، وخصوصا أهل المشرق"[23].
والواقع أن ابن خلدون التزم بهذا التصور فعلا في نثره عموما، وفي كتاباته ومراسلاته السلطانية، إذ اعتمد على الترسل وخلا من البديع والسجع الذي هيمن على أسلوب الكتابة في القرن 8ﻫ.
أما ما تجده في الثناء على ابن الخطيب بأنه: "آية من آيات الله في النظم والنثر والمعارف والأدب، لا يساجل مداه... ولا يهتدى فيها بمثل هداه... فهو إمام النظم والنثر في الملة المحمدية من غير مدافع"... مع ما عرف عن ابن الخطيب من الولع بالسجع والتكلف فيه، من إقرار بجمالية هذا الأسلوب، فإنه ثناء أدبي صاحبته شروط تختلف، وسياق يستدعي المجاملة والتودد أكثر مما يستدعي التقويم والممارسة النقدية[24].
ويدافع ابن خلدون عن هذا الموقف انطلاقا من القاعدة الجاحظية: "لكل مقام مقال"، فيخلص إلى أن للشعر أمورا تناسبه كالتزيين (ومنه القافية، واللوذعية، وخلط الجد بالهزل والوصف، وضرب الأمثال، والتشبيهات والاستعارات، وغيرها) مما لا يتناسب والمخاطبات السلطانية التي ينبغي أن تستجلب الرهبة في قلوب المخاطبين. وفي المقابل يرى أن مما يناسب النثر: الترسل ونبذ السجع إلا في النادر، وإعطاء المقام ما يستدعيه من إيجاز أو إطناب، وحذف أو إثبات، وتصريح أو إشارة وكناية واستعارة. وأما نقل مواصفات الشعر إلى النثر. فمذموم عنده.
ويتساءل ابن خلدون عن أسباب هذه الظاهرة، فيخلص إلى أنها ترجع إلى ما شاب لغة أهل العصر من عجمة وضعف في الملكة جعلاهم، وبالأخص منهم المشارقة، يجتهدون في التستر على عجزهم ذلك بالتزويق اللفظي، فولعوا بالبديع والتجنيس ولو على حساب الإعراب والنحو.
4. مفهوم البلاغة (الزجل والشعر غير العربي)
الحقيقة أن موقف ابن خلدون في هذه القضية يمثل ثورة على مفهوم البلاغة الكلاسيكي. فمن المعلوم أن المشددين من قدماء النقاد العرب وخصوصا الفقهاء منهم جعلوا الفصاحة مقتصرة على اللغة العربية لأنها القرآن ولغة أهل الجنة... وسموا من سواهم من الأمم الأخرى الأعاجم تشبيها لهم بالحيوان العجم لأنهم يتكلمون لغات لا تبين ولا تعرب.
لم يكتف ابن خلدون بإقرار وجود الإفصاح في اللغات الأخرى بل أقر بوجود الشعر فيها أيضا، باعتبار أن لكل لسان لغة بلاغة وفصاحة تخصانهما. يقول: "هذا الفن من فنون كلام العرب وهو المسمى بالشعر عندهم، يوجد في سائر اللغات، إلا أننا الآن إنما نتكلم في الشعر الذي للعرب، فإن أمكن أن تجد فيه أهل الألسن الأخرى مقصودهم من كلامهم، وإلا فلكل لسان أحكام في البلاغة تخصه، وهو في لسان العرب غريب النزعة عزيز المنحى[25].
وفي موضع آخر، يطلق ابن خلدون القاعدة الأدبية التي لا نعلم أن أحدا من النقاد العرب القدماء التفت إليها قبله. وهي المنطلق الأساس الذي لا يمكن بدونه خلق أي شكل من أشكال التواصل مع الثقافات الأخرى غير العربية. إنها بمعنى آخر دعوة إلى الانفتاح على الآخر من خلال النص الإبداعي: "اعلم أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقط، بل هو موجود في كل لغة، سواء كانت عربية أو عجمية. وقد كان في الفرس شعراء، وفي اليونان كذلك وذكر منهم أرسطو في كتاب المنطق أو ميروس الشاعر، وأثنى عليه. وكان في حمير أيضا شعراء متقدمون"[26].
ومن جهة أخرى، كان لسان مضر قد تحول في القرن 8ﻫ تدريجيا إلى مجموعة من اللهجات المتباينة فيما بينها حسب المناطق سميت آنذاك "بلغة أهل الأمصار" التي تمخض عنها شعر ملحون ينظمه أهل كل مصر بلغتهم، ولا يراعون فيه الإعراب والقواعد النحوية. فنبذه المتأدبون ورفضه النقاد، وأنفوا عن تسجيله في مصنفاتهم رغم أنهم قد يستحسنونه خفية، فباستثناء ما أورده الشعراء الزجالون من آراء في مقدمات دواوينهم (كابن قزمان مثلا) فإن هذا الشعر الملحون بقي على هامش النقد والأدب العربيين مدة ثلاثة قرون على الأقل إلى أن كتب عنه ابن خلدون ودافع عنه بقوة في فصلين كاملين من مقدمته هما: "أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد"، و"الموشحات والأزجال للأندلس".
في البداية يعرض ابن خلدون تطور اللغة العربية وفسادها في الأمصار، ثم يشرع في استعراض التغيرات التدريجية التي دخلت على القصيدة الخليلية، لقد لجأ الشعراء أول الأمر إلى اللحن فيها كي تناسب إيقاع الموسيقى في الغناء. (ويشير إلى أن معاصريه من علماء اللسان كانوا يستنكرونها). وقد أعلن ابن خلدون عن موقفه صريحا من هذه الأشعار. فوصفها بالبلاغة، ونعت أصحابها بالفحولة: "ولهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة، وفيهم الفحول والمتأخرون والكثير من المنتحلين للعلوم لهذا العهد، وخصوصا علم اللسان، يستنكرون هذه الفنون التي لهم إذا سمعها، أو يمج نظمهم إذا أنشدوا، يعتقد أن ذوقه إنما نبأ عنها لاستهجانها وفقدان الإعراب منها، وهذا إنما أتى من فقدان الملكة في لغتهم. فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سليما من الآفات في فطرته ونظره. وإلا فالإعراب لا مدخل له في البلاغة. إنما البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى المقصود ولمقتضى الحال"[27].
إن البلاغة، بهذا الاعتبار، قد تتحقق في غياب الإعراب (بالمعنى المتعارف عليه). لأن الإعراب عند هؤلاء الشعراء اللاحنين يتحقق بقرائن يتعارفون عليها ولا ينبغي أن تخضع للنحو العربي الموروث. ويمثل على بلاغة هذا الشعر بثلاثة عشر مقطوعة بعضها من المطولات، مشيرا إلى اختلاف الإطلاقات الاصطلاحية، فهو يسمى لدى المشارقة "بالبدوي" ولدى المغاربة "بالأصمعيات"، وإذا غنوه سموه بـ"الحوراني" نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام.
أما أهل الأندلس، فقد استحدثوا بدورهم فنا شعريا سموه: "الموشح"، وبرعوا فيه حتى أتوا "بالبديع العجيب": "... ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا يكثرون منها ومن أعارضيها المختلفة، ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا، ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد... وتجاروا في ذلك إلى الغاية، واستطرفه الناس جملة، الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه..."[28]. ثم يورد مجموعة من الموشحات (تدل على محفوظه الكبير في هذا الباب)، لأبي بكر ابن زهر، وعبادة القزاز، وابن أرفع رأسه، والأعمى الطليطلي، ويحيى بن بقي، وأبي بكر الأبيض، والحكيم أبي بكر بن باجة، ومحمد بن أبي الفضل بن شرف الدين حاتم بن سعيد بن موصل، وأبي إسحاق الرويني، وأبي الحسن بن سهل، وابن حيون، والمهر ابن الفرس، وابن جرمون، وأبي الحسن بن الفضل، وأبي بكر بن الصابوني، وابن خلف الجزائري، وابن هزر البجائي، وابن الخطيب...
غير أن المشارقة عندما نظموا على نمط الموشح، جاؤوا بالرديء المبتذل نظرا للتآكل الظاهر عليه. وهو أمر ينسجم في نظر ابن خلدون مع منطق الأشياء. إذ أن لكل مصر سعرا يعبر عن حال أهله. فإذا كانت القصيدة الخليلية في المغرب تتسم عموما بالتكلف "وقلة الماء"[29] لأنها واردة عليه من محيط مغاير، فإن الأمر نفسه حصل مع الموشحات التي برع أهل الأندلس فيها، فلما وردت على المشارقة وحاولوا النظم فيها جاءوا بالرديء المتكلف.
يتابع ابن خلدون عملية التأريخ لهذه الثورة المغربية على القصيدة العربية الكلاسيكية، فينتقل إلى المرحلة الأخيرة؛ أي الزجل، حيث لا يكتفي الشاعر باللحن أحيانا، بل يتجاوز الفصحى كليا، ويعتمد العامية كلغة شعرية.
لقد كانت آراء ابن خلدون هنا بالذات تتميز بالجرأة في تبرير هذه الثورة، إذ يوظف مجموعة من الاصطلاحات التي نجدها عادة في الكتابات النقدية القديمة مؤكدا أن لهذا الفن كذلك بلاغته، وفحوله، ومحاسنه، وعيوبه، ونوادره، ومدارسه النقدية: ولما شاع فن التوشيح في أهل الأمصار على منواله، ونظموا في طريقته الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعرابا. واستحدثوا فنا سموه بالزجل، والتزموا بالنظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد. فجاءوا فيه بالغرائب، واتسع للبلاغة فيه مجال بحسب لغتهم المستعجمة وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان وإن كانت قيلت قبله في الأندلس، لكن لم يظهر حلاها، ولا انسكبت معانيها، واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه..."[30] ثم يقوم بسرد مجموعة من النصوص الزجلية التي استحسنها عند أهل الأندلس.
على هذا النحو سار أهل المغرب كذلك في تجاوز القصيدة الخليلية. فقد استحدثوا نمطا شعريا على لغتهم يتكون من أعاريض مزدوجة سموه: "عروض البلد" ثم لما لقي استحسانا لدى أهل فاس، وولعوا به، عملوا على تطويره، فظهرت فيه عدة أصناف، مثل: المزدوج، والكاري، والملعبة، والغزل... ووصلوا به إلى مستوى الفحولة: "... فمن المزدوج ما قاله ابن شجاع من فحولهم، وهو من أهل تازا..."[31].
إن "الفحولة الشعرية" بهذا المعنى، ترتبط بالملكة التي يكتسبها الشاعر في لغة بعينها. ولذلك فهي لا تقتصر على العربية فحسب بل تتوفر في جميع اللغات.
للبرهنة على ذلك، يشرع ابن خلدون في اصطياد عدد من "النكت البلاغية" الجيدة، الموجودة في هذه الأزجال، مبديا الإعجاب الشديد ببلاغتها. من ذلك قوله مثلا: "...وكان لهذه العصور القريبة من فحولهم بزرهون من ضواحي مكناسة رجل يعرف بالكفيف أبدع في مذاهب هذا الفن. ومن أحسن ما علق له بمحفوظي، قوله في رحلة السلطان أبي الحسن وبني مرين إلى إفريقية يصف هزيمتهم ويعزيهم عنها... يقول في مفتتحها: وهو من أبدع مذاهب البلاغة في الإشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه، ويسمى: براعة الاستهلال:
سبحان مالك خواطر الأمرا ونواحيها في كل حين وزمان
إن طعناه عطفهم لنا قسرا وإن عصينا عاقب بكل هوان[32]
إذ يقوم بعملية نقدية تستند إلى مقومات النقد والبلاغة العربيين، ولذلك أشار إلى براعة الاستهلال، والبديع، وحسن التخلص،...الخ.
يخلص ابن خلدون من خلال كل ما ذكرناه، مرة أخرى إلى أن الذوق في لغة ما، إنما يحصل لمن خالطها. فلا المغربي يدرك بلاغة شعر الأندلسي، ولا العكس، ولا يدرك كل منهما بلاغة شعر المشرقي ولا العكس...لأن كلا منهم مدرك لخاصيات لغته الدقيقة وجمالياتها، متذوق لشعرها بحكم خبرته بها[33].
ولابد من الإشارة هنا إلى أن أسلوب ابن خلدون في عرض هذه النظرية يدل مرة أخرى على هيمنة المنهج التاريخي على فكره، إذ لا يحلل ولا يؤسس التصورات والاستنتاجات إلا بعد استعراض تطور الظاهرة من خلال الجرد التاريخي.
والواقع أن ابن خلدون لو لم ينسب إليه في النقد الأدبي إلا هذه الرؤية المتطورة، لكانت كافية لتصنيفه ضمن كبار النقاد في تاريخ الأدب العربي، لقد كان بذلك يلغي، كما يقول إحسان عباس، مهمة الناقد الكلاسيكي، ويفتح الباب أمام البيئات الشعبية لتخرج نقادا يقننون لتلك الفنون[34]. وكان يؤسس طفرة كبيرة في تاريخ الأدب. إلا أنها كانت متقدمة جدا عن سياقها التاريخي. ولذلك بقيت خارج نطاق البحث والدراسة، مجمدة بين أسطر الكتاب إلى حدود أواخر القرن 19م وبداية القرن20، حيث سيظهر علم الفلكلور (كلمة لاتينية: علم= Lore – وشعب =FOLK) المتخصص في دراسة التراث الشعبي.
5. اللفظ والمعنى
يذهب ابن خلدون في هذا المبحث مذهبا قريبا من مذهب الجاحظ حين جعل المعول على اللفظ في نصه الشهير: "والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي"، وأبي هلال العسكري الذي جعل مدار البلاغة على تحسين اللفظ في النثر والشعر...[35]. فهو يرى كذلك أن المعاني موجودة في الضمائر عند كل فرد، وأن الفرق بين الشعراء إنما يكون في الملكة اللغوية المتوفرة لدى كل واحد منهم، ولذلك شبه المعاني بماء البحر الذي لا يختلف في ذاته، وإنما تختلف الآنية التي يغرف بها. وبها يرتفع أو يتضع شأنه، حسب كونها من ذهب، أو فضة، أو صدف، أو زجاج أو خزف. إنه تشبيه بعيد إلى الأذهان أيضا تشبيها قديما معروفا مفاده أن المعاني روح والألفاظ جسد لها. يقول ابن خلدون: "اعلم أن صناعة الكلام نظما ونثرا إنما هي في الألفاظ لا في المعاني. وإنما المعاني تتبع لها وهي أصل، فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر إنما يحاولها في الألفاظ.. والذي في اللسان والنطق إنما هو في الألفاظ. وأما المعاني فهي في الضمائر، وأيضا فالمعاني موجودة عند كل واحد وطوع كل فكر منها ما يشاء ويرضى، فلا تحتاج إلى صناعة. وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كما قلناه، وهو بمثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني التي يغترف بها الماء من البحر، منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف، والماء واحد في نفسه، وتختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء، كذلك جودة اللغة وبلاغتها..."[36].
وفي إطار هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، وتفاعلهما كمكونين أساسيين داخل النص الأدبي بشكل عام، يذهب بعض الباحثين بقول ابن خلدون: "والذي في اللسان والنطق إنما هو الألفاظ، وأما المعاني فهي في الضمائر"، إلى حد قرنها بالنظريات الألسنية الحديثة، مثل: الألسنة اللبنانية الأمريكية. متجلية في كتابات هاريز، وبلو مفيلد.. التي تولي الشكل اللغوي كل اهتماماتها داخل نسيج العملية الإبداعية، وتقوم في المقابل بإقصاء دراسة الدلالة من مجال هذه الاهتمامات؛ ومثل الألسنية التوليدية والتحويلية التي تسعى إلى تأسيس قواعد توليدية شكلية تقرن الدلالة بالصوت اللغوي[37].
6. تأسيس التجربة الشعرية: (الملكة، وطريقة النظم)
ينطلق ابن خلدون هنا (مثلما هو الحال بالنسبة لكثير من نظرياته) من تجربته الذاتية، فقد أشار في ترجمته الذاتية إلى أن أستاذه ابن حجر نصحه بحفظ كتاب الأشعار الستة، والحماسة للأعلم، وشعر حبيب، وطائفة من شعر المتنبي، وكتاب الأغاني. غير أنه لاحظ ولع الناس بتعلم اللغة. وهو أمر غير كاف في نظره، لأن الشعر يحتاج إلى "نوع تلطف"، وهذا التلطف لا يتحقق بإتقان العروض والنحو واللغة، بل بالحفظ الذي يمكن الطالب من كيفية انسجام الأوزان والألفاظ مع المعاني لدى شعراء العرب القدامى وهي ملكة يفهم من كلام ابن خلدون أنها ذوقية لا ترتبط بتعلم.
لذلك ينصح طالب الملكة الشعرية بأن يحفظ نماذج من الشعر العربي "حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها"، وأن يتخير لذلك أجوده، لأن جودة الشعر من جودة المحفوظ. وأقل ما يكفي فيه، شعر شاعر من الفحول الإسلاميين كابن أبي ربيعة، وكثير، وذي الرمة وجرير، وأبي نواس، وحبيب والبحتري، والرضى، وأبي فراس، وأكثر شعر الأغاني. ومن قل حفظه جاء شعره رديئا. لأن كثرة المحفوظ تمنح شعرا ذا طلاوة ورونق، وقلته تنتج "نظما" ساقطا. وبعد هذا تأتي مرحلة نسيان المحفوظ، فتمحي رسومه الحرفية ولا يبقى منها إلا الأسلوب الذي ينتقش في الذهن في صورة قوالب (حسب اصطلاح ابن خلدون دائما)، فإذا أراد المرء أن ينظم قصيدة، استحضر القالب في ذهنه، ثم نسج على منواله بتشكيل قوالب جزئية أو مركبات صغيرة داخله وبالتالي يكون مؤلف الكلام أشبه بالبناء أو النساج الذي يلتزم قوالب معينة لا يخرج عنها إلا فسد بناؤه أو نسجه.
إن المطلوب بهذا المعنى هو تكوين مفهوم "الملكة الشعرية" التي تختلف ـ تماما ـ عن امتلاك الأدوات التعبيرية من نحو، وعروض وقواف: "والشعر من بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين... فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة حتى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب... ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها في إطلاقهم، فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه. ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفته العروض. فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية. وإنما ترجع إلى صورة ذهنية للتراكيب كلية...، اعلم أن لعمل الشعر وصناعته شروطا أولها، الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها... وربما يقال أن من شروطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة، إذ هي صادة عن استعمالها بعينها. فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها، انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسيج عليه".
إضافة إلى ذلك، أشار ابن خلدون إلى جملة ملاحظات منهجية من شأنها الرفع من قيمة الشعر:
- أن يحرص الشاعر على الخلوة، وعلى اختيار المكان المناسب بكل عناصره من منظور ومسموع، لأن شرط استجماع القريحة توفر الجمام والنشاط والسرور، ملخصا ما ذكره بعضهم من تخصيص حالات بعينها كوقت التبكر عند الهبوب من النوم، وفراغ المعدة ونشاط الفكر. وكالعشق والانتشاء وغيرها.
- إذا استعصى عليه الشعر رغم توفر هذه الشروط، فليتركه لوقت آخر ولا يكره نفسه عليه.
- وليضع الشاعر نصب عينيه قافية يبني عليها قصيدته لأن ذلك يسهل عليه البناء.
- وإذا ورد عليه بيت لم يناسب قصيدته فليحتفظ به لموضعه المناسب.
- وبعد الخلاص من الشعر، ينبغي الرجوع إليه بالتنقيح والتهذيب، وأحيانا بالترك، رغم أنه قد يبخل به الشاعر لإعجاب كل امرئ بإبداعه.
- لا يستعمل إلا الأفصح من التراكيب. وليهجر الضرورات اللسانية التي تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة.
- وعليه أن يجتنب المعقد من التراكيب، ويقصد إلى ما كان منها سهل المعنى للفهم.
- وعليه أن يتحاشى كثرة المعاني في البيت الواحد. لأن فيها تعقيدا على الفهم وحشوا. وبالتالي تتطلب من الذهن جهدا للغوص عنها. وهذا أمر مستكره لأنه يمنع الذوق من استيفاء مقصوده من البلاغة. ولذلك، فأحسن الشعر ما تسابق معانيه ألفاظه، إلى الذهن سهولة. وحشد المعاني في البيت الواحد، هو ما جعل شيوخ ابن خلدون يعيبون شعر ابن خفاجة مثلما عابوا شعر المتنبي والمعري، لعدم نسجهما على الأساليب العربية، مما جعل شعرهما عبارة عن كلام منظوم. والحاكم في ذلك هو "الذوق" الذي أكد ابن خلدون أنه وحده الفارق بين النظم والشعر. وهو الذي عبر عنه في موضع آخر بـ "الظفر بالمدلول"، الذي هو من أسباب اللذة، (ولنلاحظ هنا أن ابن خلدون يكشف عن السبب الحقيقي الذي جعله فيما قبل يخرج المعري والمتنبي من طبقة الشعراء، أي حشد المعاني في البيت الواحد وطغيان الفلسفة على الشعر بحيث تفقده "الماء").
- ثم يتجنب الحوشي والمقصر، وكذا السوقي المتبذل من الألفاظ لأنه ينزل الشعر عن طبقة البلاغة، ويقربه من عدم الإفادة، وهما طرفان متلازمان، لأن الثاني ينتج عنه الأول. ولذلك كان شعر الربانيات والنبويات قليل الإجادة إلا نادرا، لأن معانيهما متداولة بين الجمهور فتصير مبتذلة لذلك، (وهنا نلاحظ بعض التعارض مع ما سجله سابقا من أن المعاني متوفرة في الضمائر لكل الناس ولا فرق بينهم إلا في اللفظ).
- إذا تعذر الشعر بعد كل هذا فعلى المرء أن يراوده في القريحة، فإنها مثل الضرع تدر بالامتراء وتجف بالترك والإهمال.
- وفي الأخير يشير إلى أن هذا كله مستوفى بتفصيل في "العمدة" (الذي يبدو أنه كان متأثرا به إلى حد كبير). ثم يذكر مقطوعتين شعريتين لبعضهم في تلخيص هذه التوجهات[38].
بعد هذا ينبه ابن خلدون إلى مسألة مثيرة هي أن جودة الملكة إنما تحصل بكثرة وجودة المحفوظ. ولذلك فإن من كثر محفوظه في العلوم، جادت ملكته في العلوم وقصرت في الشعر. والعكس صحيح. ولذلك كان الفقهاء قاصرين في البلاغة نظرا لما يسبق إلى محفوظهم من القوانين العلمية والاصطلاحات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة. ويستشهد على ذلك بحكاية طريفة: "ذاكرت يوما صاحبنا أبا عباس بن شعيب كاتب السلطان أبي الحسن، وكان المقدم في البصر باللسان لعهده، فأنشده مطلع قصيدة ابن النحوي، ولم أنسبها له، وهو هذا:
لم أدر حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي
فقال لي على البديهة: هذا شعر فقيه، من قوله: ما الفرق، إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من كلام العرب، وكان كذلك".
ويحكي ابن خلدون أيضا أنه شكا لابن الخطيب، ولأبي القاسم قاضي غرناطة استصعابه الشعر كلما رامه، ثم علل ذلك بكلام نال إعجاب الاثنين، مفاده أن ما سبق إلى محفوظه من أشعار الفقه والأصول والقراءات والمنطق والتسهيل وغيرها، خدش ملكته الشعرية التي استعد لها بمحفوظه من القرآن والحديث وكلام العرب، فعاق القريحة عن بلوغها.
وفي هذا السياق يشير أيضا إلى أن كلام الإسلاميين (حسان، عمر، جرير، الفرزدق، الحطيئة، نصيب...) أعلى طبقة من كلام الجاهليين (النابغة، زهير، عنترة، ابن كلثوم، علقمة، طرفة...) لأن الإسلاميين سمعوا بالطبقة العالية المعجزة من القرآن والحديث، وامتزجت بها نفوسهم، فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم على ملكات أهل الجاهلية ممن لم يسمع هذا الكلام المعجز، ولذلك جاء كلامهم أحسن ديباجة ورونقا ومبنى وتثقيفا، وهذا من أغرب ما ذهب إليه ابن خلدون، إذ خالف فيه جل النقاد القدماء.
7. على مستوى الممارسة: (أسلوب كتابة ابن خلدون)
بشكل يختلف تماما عن أسلوب الكتابة السجعي السائد آنذاك الذي انتقده بشدة، التزم ابن خلدون في كتاباته بالنثر المرسل، فلم يوظف تقنيات البديع والسجع والتصنع اللفظي... مما أكسبه تميزا وخصوصية، وأهله لشغل منصب كتابة السر في البلاط[39]. وإن كنا نجد بعض السجعات أحيانا، إلا أنها نادرة، وتتميز ببساطتها وقصر فواصلها، وعذوبة موسيقاها...مثال ذلك ما ورد في ديباجة المقدمة، وفي بعض الفصول في مجال محدود جدا.
ويبدو أن الذي دفعه إلى هذا المنحى، هو إيمانه بالفكرة قبل كل شيء. إذ هي المقصود من النثر الذي ينشأ عادة للإقناع وتبليغ الخطاب، بصرف النظر عن شكله على عكس الشعر الذي يقصد منه في العادة المتعة أو: "الظفر باللذة" على حد تعبيره لذلك جاء نثره سهل المأخذ، لين الجانب في غير ابتذال ولا تعذر، وقد شهد له بذلك عدد من الأدباء والعلماء كابن الخطيب، والمقريزي، وابن حجر العسقلاني، وأبي الوليد بن الأحمر، وغيرهم.
لكن، يتساءل غاستون بوتول عن السبب الذي جعل العدد الكبير من معاصري ابن خلدون (باستثناء الذين ذكرناهم)، يتجاهلونه كمرحلة مهمة في تطور النثر العربي فيسجل أن خطأ ابن خلدون هو أنه لم يكن نموذجا لجمال الأسلوب وفق المعنى الذي يطلق على هذه الكلمة في الشرق. إذ كان يكتب بلغة مستقيمة خالية من التكلف والتحذلق والدقائق النحوية التافهة، وغيرها مما استحوذ على القرون القادمة[40].
هكذا بقي أثر ابن خلدون محدودا في معاصريه ومن بعدهم، إلى أن جاء العصر الحديث حيث ضاق الأدباء ذرعا بالأساليب الكلاسيكية خصوصا أواخر القرن19 وبداية القرن 20، وكان أسلوب ابن خلدون أقرب إلى تحقيق ميولهم نحو التحرر، وربما ذهب بعض الباحثين إلى أنه هو الذي أنقذهم إنقاذا ناجحا، وإلى حد اعتباره "الأستاذ الأكبر" لكتاب الصحف والمجلات، ولزعماء التجديد والإصلاح كالأفغاني ومحمد عبده وغيرهما فيما دعوا إليه على المستوى اللغوي[41]. وهو رأي رفضه د. عبد الله الطيب الذي اعتبر الأمر "وهما" عرض للنقاد. لأن ابن خلدون، في رأيه، لم يكن أصيلا في ترسله، ولا زعيما لهذا المذهب، وإنما اقتفى أثر العلماء في العمد إلى النثر الخالص في باب التأليف العلمي، كالغزالي، وابن تيمية، وابن القيم، والسيوطي، وغيرهم[42].
والواقع أن الترسل في الكتابة مألوف لدى العلماء بالفعل، إلا أن تجديد ابن خلدون يبدو على الخصوص في نقله من الكتابة العلمية إلى النثر الفني متجليا في الرسائل السلطانية والإخوانيات، إضافة إلى كتاب "التعريف" الذي يعتبر أول سيرة ذاتية بلغت مستوى النضج والجودة، لأنها كتبت على نسق أدبي "عال ومعاصر"[43].وعدها بعضهم مقدمة أدبية رائعة لتاريخه[44]، رغم مطاعن طه حسين وتلاميذته فيها باعتبارها مظهرا لتضخم الأنا عند ابن خلدون.
وفي ختام هذه القراءة السريعة، لابد من الإشارة إلى أن ابن خلدون كان أيضا شاعرا. وكانت قصائده تتميز، عموما، بالنفس الطويل ومعظمها في غرض المديح إلا أنها تفتقر إلى الجمالية الفنية العالية، وإن لم تخل من حسن الوصف. (ولعل هذا بالذات ما اعترف به بنفسه لبعض أصحابه كما سبق الذكر).وعلى مستوى المعجم، تغلب عليها بعض الاصطلاحات العلمية، وتخلو من الحوشي الغريب. وعلى العموم، لقد كان شعره شعر مفكر مؤرخ وفيلسوف، أكثر منه شعر أديب.
انظر العدد 13 من مجلة الإحياء

الهوامش
- ابن خلدون في حياته، د. جمال الدين الرمادي، ص95.
- الإحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطيب، 3/508.
- نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، أبو الوليد بن الأحمر.
- ابن خلدون في حياته، ص 95.
- القاضي عياض الناقد، د. عبد الله الطيب ص 200.
- تاريخ الأدب العربي 6/588.
- العرب وابن خلدون ص 23.
- دراسات حول مقدمة ابن خلدون ص 582.
- الأدب المغربي ص 73.
- قصة الأدب في الأندلس ص 326.
- الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير ص 198.
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص 616.
- لسان الدين بن الخطيب د. أحمد مختار العبادي ص 352.
- ابن خلدون ص 12.
- انظر مثلا: د. ميشال زكريا: الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون.
- المقدمة ابن خلدون 3/1277.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، 3/1283.
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص 624.
- المقدمة 3/1295.
- العمدة 1/119.
- المقدمة 3/1305.
- المرجع نفسه، 3/1296.
- لسان الدين بن الخطيب د. أحمد مختار العبادي ص 88.
- المقدمة 3/1299.
- المرجع نفسه، 3/1324.
- المرجع نفسه، 3/1326.
- المرجع نفسه، 3/1337.
- حسب الاصطلاح الجاحظي.
- المقدمة 3/1350.
- المرجع نفسه، 3/1353.
- من المثير هنا ما ذهب إليه غاستون من أن هذه الأشعار العامية اصطنعها ابن خلدون بنفسه (ولم يعلل هذا الرأي). انظر: ابن خلدون ترجمة عادل زعيتر ص 12.
- المقدمة 3/1364.
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص 629.
- المرجع نفسه، ص 98.
- المقدمة 3/1312.
- الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون د. ميشال زكريا ص 55.
- المقدمة 3/1306إلى 3/1313.
- التعريف بابن خلدون ص 70.
- ابن خلدون – غاستون بوتول ص 123.
- قصة الأدب في الأندلس، عبد المنعم خفاجة، ص 326 وانظر أيضا: الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير د. محمد رجب البيومي ص 198.
- المرشد 3/807.
- العرب وابن خلدون محمد كرو ص 66.
- ابن خلدون غاستون بوتول ص 12.