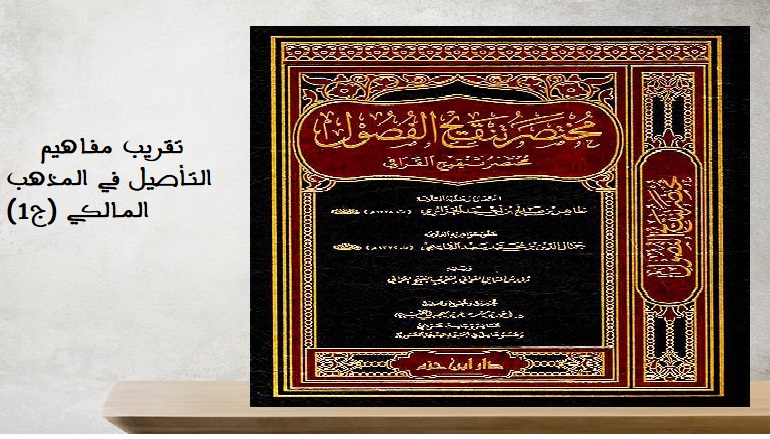لا ريب أن المنهج والمصطلح هما العلم. ولا غرو إن كان تحليل الخطاب سيد الفنون. من أجل هذا وذاك كان اختيار العتبة؛ المنهج التحليلي: رؤية مصطلحية أسلوبية. ولئن تعلق الأمر بالأدب والنقد، فإن الدراسة المقترحة تصلح بعد تهذيبها وتشذيبها لمعالجة النصوص جميعا. ولعل استخدام المنهج الشامل المتكامل بُعيد إعطاء صورة تقريبية عنه يعد ضربة لازم كما يقال.
ولسوف يبقى المنهج ناقصا إذا ما غضضنا الطرف عن المستويات المطروحة بدءًا بالتركيبي، والصوتي، والمعجمي، مرورا بالجمالي، والوظيفي، والرمزي؛ وليس انتهاء بالبلاغي، والأسلوبي، والمخيالي؛ فضلا عن الدلالة والصورة والفضاء وما إليها من إضافات تقترحها السيميائيات بعد البنيوية وما بعدها.
وقد آليت على نفسي في هذه المقاربة المتواضعة أن لا تقتصر على مجرد الذوق والعاطفة، إيمانا مني بأننا، مع العلم أن العلوم الإنسانية في واد والحياد أبدا في واد آخر؛ كما أن "الحق يحب الإنصاف قطعا" كما قال ابن الوزير اليمني، رحمة الله تعالى عليه، في "إيثار الحق على الخلق"[1]، في صدد الجمع ما وسعنا الجهد بين الفن والموضوع، وبين الشمول والتكامل، على مذهب ابن قتيبة الديْنَوَري في مشكل القرآن ومشكل تأويل الحديث.
وأنت خبير أن التعبير الجمالي آت لا محالة من الأسلوب باعتباره الشخصية الحق للأديب أو الناقد. من أجل هذا وذاك كان لزاما أن نؤكد على مسألة اعتدال النسب بين الفن والموضوع أو الشكل والمضمون، على الرغم من تذبذب بعضهم في هذا الشأن. أما إذا شئنا الحقيقة فإن اختيارنا يقع على ضرورة الانطلاق من الفن إلى الموضوع بما هو أولى وأوفق وأعلى.
لذا فقد تأسس دفعا للإشكالات التي يحتمها الاقتصار على المضامين من جهة، أو بعض المقولات المنهجية المجتزأة من جهة ثانية، اقتراح منهجية الوصف والاستقراء والتاريخ والإحصاء الذي يستتبع بالضرورة الاختيارات الأسلوبية، فنا وموضوعا، لتصح النتائج إذا ما كان من حظ النصوص المدروسة نقدة مهرة.
ذلك بأن المواد تتشابك بينها بما يربطها من وشائج شتى رفيعة، قد تستعصي إلا على رؤية وبصر صاحب النظر النافذ؛ وهو الأمر الذي بمقدوره أن يستدرك فيكمل النقص لدى بعض الدارسين المتذرعين بالأسلوبية من غير ضبط ولا ربط.
وللحقيقة فإن الخلل جاء من لدنْهم، وليس من الأسلوبية فكرا ومصطلحا وفلسفة ومنهاجا.
من أجل ذلك أصررت على إضافة الدرس المصطلحي لما يوفي عليه من إثراء للخطاب بما يسعف به من أدوات تحليلية ناضجة مكتملة مجربة. يتجلى إجرائيا وعمليا ما يمكن أن تسفر عنه بدءًا بالمفهوم وإعادة صياغته، وتناسل المصطلح، ومسألة الصفات أو الموصوفات أو هما معا، وقبلها المشتقات والورود، ثم بعد ذلك العلاقات والضمائم دون الفصل بينها لمزيد من التناسل المصطلحي داخل وخارج الإطار، ثم سوق القضايا الموضوعية، آخر المطاف، باعتبارها مستدركة لما قد يتجاوز في صُلب الدراسة الفنية والأدبية.
ولأجل مناقشة المناهج والتقنيات وغيرها لاختيار المنهج الشامل المتكامل. نقترح أن يتوجه هذا التصميم عبر المسيرة البحثية انطلاقا من تبيان وظيفة النقد الأدبي وغايته، وملامح المنهج المتكامل المنشود وإنسانيته، وكيف أن المنهج النفسي جزء من كل، وقراءة النصوص الشعرية، بله بعض المكث في إطار من الإحصاء غير المتفلت لما يؤدي إليه من نتائج ذوات بال في الدراسة الأسلوبية تلافيا لمطبات الإحصاء. وكذا منهج الرواية بين التأصيل والتأسيس. ناهيك عن الحوم حول البنيوية والبنيوية التكوينية وما بعد البنيوية، وإضافات السيميائية، لننهي الموضوع بمعالم منهج الدراسة المصطلحية ابتداء من الإحصاء، فالدراسة المعجمية، والدراسة النصية، والدراسة المفهومية، والعرض المصطلحي على منوال المشتقات، والمفهوم، والصفات بشقيها المبينة والحاكمة، والعلاقات، فالضمائم؛ ثم القضايا.
ونختم ببعض النتائج التي أسفرت عنها هذه المدارسة مع فتح لبعض الآفاق الممكنة في الإطار نفسه.
أولا: وظيفة النقد الأدبي وغايته
تتلخص وظيفة النقد الأدبي وغايته في تقويم العمل الأدبي من الناحية الفنية، وبيان قيمته الموضوعية والتعبيرية والشعورية، وتعيين مكانه في خط سير الأدب، وتحديد ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغته، وفي العالم الأدبي كله، وقياس مدى تأثره بالمحيط، وتأثيره فيه، وتصوير سمات صاحبه وخصائصه الشعورية والتعبيرية، وكشف العوامل النفسية والخارجية التي اشتركت في تكوينه. وسنختم هذه المقاربة بما بعد البنيوية، كما نعرج على البنيوية التكوينية، لنرفض ما حقه الرفض بعد الموازنة، ونقبل ما قام الدليل على صوابه.
ومن هذا البيان الموجز نستطيع أن ندرك موقفنا في النقد الأدبي سواء في القديم أم في الحديث، ونقيس خطواتنا إلى مداه، ونعرف كم بلغنا في تكوين هذا الفصل الهام من مكتبتنا الأدبية.
ولقد خطونا خطوات لها قيمتها قديما وحديثا، ما في ذلك من شك، ولكننا لم نزل بعيدين عن المأمول.
وأول نقص ملحوظ أنه ليست هناك أصول مفهومة، بدرجة كافية، للنقد الأدبي، وليست هناك مناهج كذلك، تتبعها هذه الأصول. ومعظم ما يكتب في النقد الأدبي عندنا اجتهاد، وذلك طبيعي ما دامت الأصول لم توضع، والمناهج لم تحدد بالدرجة الكافية.
نعم هناك دراسات نقدية تطبيقية للأدب والأدباء، وهي كثيرة متنوعة، ولكن هذا شيء آخر غير الدراسات التي تتولى الحديث عن أصول النقد ومناهجه، فتضع له القواعد، وتقيم له المناهج، وتشرع له الطريق[2].
لذلك يتطلب الوضع أمرين اثنين:
أولا؛ وضع أصول وقواعد للنقد، حتى لا يكون الذوق الخاص هو وحده الحكم.
ثانيا؛ وصف مناهج النقد في القديم والحديث.
وربما خطر على بال من يخطر على باله أن الترتيب العكسي لهذين القسمين أولى، إذ إن المناهج هي التي تقوم عليها الأصول والقواعد، ولكن الواقع والإرادة الشخصية تتجه ناحية النقد التطبيقي في الوقت الذي تضخم فيه التنظير الذي يمكن أن يستغنى عنه أو عن بعضه في كثير من الأحيان إلى حد كبير.
والأمر الآخر الذي يجعل هذه الرؤية مسوغة أن بمكنة الناقد المقتدر أن يضع الأصول ويطبقها في الآن ذاته، ويبين القواعد ويختبرها سواء بسواء، حتى إذا بلغ المتلقي إلى الجانب الوصفي النظري، أضحى العمل في شقه الأولي أنموذجا محسوسا للنظريات المجردة، وتطبيقا عمليا للمناهج المقررة.
ولما كان موضوع النقد الأدبي هو العمل الأدبي، فقد يتعين الحديث عن ماهية العمل الأدبي، وغايته، والقيم الشعورية والتعبيرية فيه، وفنونه المتنوعة، وأن تستبين أصول كل فن من فنونه، وطريقة نقده وتقويمه، لتحضر النماذج قدر الإمكان، فتستمد منها الأصول والقواعد.
أما المناهج المقترحة فهي: المنهج الفني، والمنهج التاريخي، والمنهج النفسي، والمنهج المتكامل. ولعل هذا يكون أشمل تقسيم لمناهج النقد لا يَضطرنا أن نستطرد إلى تفصيلات صغيرة لجميع النزعات والاتجاهات، التي تنطوي في خلال هذه المناهج الكبيرة.
هذا ولا نرى جدوى من حمل النقد العربي على مناهج أجنبية عنه، لها ظروف تاريخية وطبيعية غير ظروفه، بل نؤثر الخوض في هاتيك المناهج في محيط النقد العربي في القديم والحديث، حتى إذا اضطُررنا إلى الاقتباس من مناهج النقد الأوروبي، كان ذلك في الحدود التي تقبلها طبيعة النقد في الأدب العربي، وتنتفع بها وتنمو بها نموا طبيعيا، بعيدا عن التكلف والافتعال[3]؛ أو التقليد والابتذال.
أما إذا تعارضت المناهج فقد وجدتني مؤثرا مختارا مرجحا المنهج الفني على المنهجين التاريخي والنفسي، بيد أن المنهج المختار في الحقيقة والمقترح نظريا وتطبيقيا هو المنهج المتكامل الذي ينتفع بهذه المناهج جميعا ومثلها معها أو يزيد، ولا يجمل بالدارس الموضوعي أن يحصر نفسه داخل قالب جامد أو منهج واحد.
وللحقيقة فإن أولى أولويات المنهج الشامل المتكامل أن الألوان الفنية والأدبية هي التي تملي المنهج أو المناهج المعتمدة القمينة بإحسان وإتقان العمل بصدد المجال المعين إن كان مسرحا أو سينما أو رواية أو قصة أو قصيدة أو غيرها.
ذلك بأن المناهج إنما تصلح وتفيد حينما تتخذ منارات ومعالم، بيد أنها تفسد وتضر حين تجعل قيودا وحدودا، لذا وجب أن تكون مزاجا من النظام والحرية والدقة والابتداع. وهذا هو المنهج الذي ندعو إليه في النقد والأدب والحياة!
ولعل دعوتنا إلى هذا الشمول والتكامل، وذاك الاستقلال المنهجي يربأ بنا أن نحبس أنفسنا في قواعد مقتبسة وقوالب مقررة على اعتبار أن اضطرابا ما في المنهج المقترح قد يحصل؛ ذلك لأن فهم المنهج لا ينبغي أن يكون محدودا ومحددا بقالب تقليدي معين، مستعار من النقد الأوروبي وتاريخه.
ويترتب علينا أن نعرف طريقنا بما أن مناهج النقد وأصوله ليست قوالب جامدة، وأنه يحق لكل ناقد أن يبتكر طريقته، ثم بعد ذلك سيجيء مؤرخو المذاهب النقدية فيضعون الوصف الذي يرونه لهذه الطريقة أو تلك كما يرون، ولا ينبغي للناقد أن يكون حريصا على أن يقول هؤلاء المؤرخون: إنه اتبع هذا المذهب أو ذاك[4]. فلا يحتفل إلا بالموضوعية والإنصاف والإحكام.
ثانيا: ملامح المنهج المتكامل
إذا كنا قد آثرنا المنهج الفني وهو في حقيقته متكامل من منهجين أو ثلاثة: المنهج التأثري، والمنهج التقريري، والمنهج الذوقي، أو الجمالي ـ فإنما آثرناه لأنه أقرب المناهج إلى طبيعة العمل الأدبي، ولكننا لم نقصد أن يكون هو المنهج المفرد، بما أن الملاحظة النفسية عنصر هام فيه، والملاحظة التاريخية ضرورية في بعض مناحيه.
حتى إذا كانت المناهج بصفة عامة في النقد معالم، وليست حدودا، كما قدمنا، شأنها في ذلك شأن المدارس في الأدب ذاته، فكل قالب محدود هو قيد للإبداع، وقد يصنع القالب لنضبط به النماذج المصنوعة، لا لتصب فيه النماذج وتصاغ!
ولحسن الحظ أن النقد العربي الحديث سلك في أحيان كثيرة طريق المنهج المتكامل الذي يجمع هذه المناهج جميعا. ونرى أمثلة لهذا في كتب طه حسين عن المعري والمتنبي. وفي حديث الأربعاء ومن حديث الشعر والنثر وشوقي وحافظ.
كما نرى أمثلة له في كتب عباس محمود العقاد عن ابن الرومي وشاعر الغزل وجميل بثينة وشعراء مصر وبيئاتهم.
وقد سلك سيد إبراهيم هذا الطريق نفسه في الفصول الأولى من كتابه النقد الأدبي: أصوله ومناهجه، وكذلك في كتابيه التصوير الفني وكتب وشخصيات[5].
ثالثا: إنسانية المنهج المتكامل
إن المنهج المتكامل لا يعد النتاج الفني إفرازا للبيئة العامة، ولا يحتم عليه كذلك أن يحصر نفسه في مطالب جيل من الناس محدود، فالفرد في عصر من العصور قد يعبر عن أشواق إنسانية للجنس البشري كله، ولمشكلات هذا الجنس الخالدة التي لا تتعلق بوضع اجتماعي قائم أو مطلوب، إنما تتعلق بموقف الإنسانية كلها من هذا الكون ومشكلاته الخالدة كالغيب والقدر وأشواق الكمال اللدنية الكامنة في الفطرة البشرية.
وهذه وأمثالها لا تتعلق بزمان ولا بيئة، ولا عوامل تاريخية. والعصر الواحد ينبغ فيه كثيرون في البيئة الواحدة ولكل منهم طابع خاص واتجاه خاص وعالم خاص. ولم يكن ابن الرومي يعبر عن ذاته فحسب، إنما كان يعبر عن موقف إنساني غير مقيد بعصر من العصور حين قال:
أَلاَ مَنْ يُرِينِي غَايَتِي قَبْلَ مَذْهَبِي وَمِنْ أَيْنَ وَالْغَايَاتُ بَعْدَ الْمَذَاهِبِ؟
فهي مشكلة المجهول التي وقفت أمامها البشرية منذ خلقتها وستبقى واقفة أمامها أبدا، كذلك كان يقف الخيام يدق هذا الباب المغلق أمام البشرية، فلا يفتح له، فيوقع أوجع ألحانه وأخلدها في عالم الفن والحياة، وهو يرى الناس يأتون من حيث لا يدرون، ويذهبون إلى حيث لا يدرون، لا يستشارون في مجيء ولا يستشارون في خروج، ولا يعلمون ماذا يكون في اللحظة التالية، ولا كيف يكونون:
فِـي سَـبِـيـلِ الْأَسْــرَارِ وَالْأَلْــغَـــازِ
ذَاتَ يَـوْمٍ حَـلَّـقْـتُ تَـحْـلِـيـقَ بَـازِي
فِي سَمَاءِ الْمَعْنَى الْخَفِيِّ الْمَجَازِي
وَلِـحِــيـنِـي لَـمْ أَلْــقَ فِـي الْأَفْــلاَكِ
لِـي قَـرِيـنـاً فِـي الْـفَـهْمِ وَالْإِدْرَاكِ[6]
وكذلك وقف المعري وقفته الإنسانية أمام قبر الإنسان وكأنما تجمع في حسه كل ماضي الإنسانية ومستقبلها، وهي تتصادم وتتزاحم وتنطوي في حفرة، في نهاية المطاف:
صَاحِ هَذِهِ قُبُورُنَا تَمْلَأُ الرَّحْــبَ فَأَيْنَ الْقُبُورُ مِنْ عَهْدِ عَادِ؟
خَفِّفِ الْوَطْءَ مَا أَظُنُّ أَدِيمَ الْــأَرْضِ إِلاَّ مِنْ هَـذِهِ الْأَجْـسَـادِ
رُبَّ قَبْـرٍ قَدْ صَارَ قَبْراً مِرَاراًضَـاحِـكٍ مِنْ تَـزَاحُمِ الْأَضْـدَادِ
ومثل تلك الأشواق والآلام ليست خاصة بعصر ولا بيئية، وإنما هي أشواق البشر، وآلام البشر من ناحية موقف البشر من الكون والحياة، وقد تكون آثار للبيئة في الصورة التي تبدو فيها تلك الأشواق والآلام، ولكن هذا لا يخرجها عن كونها أشواقا وآلاما للجنس الإنساني كله.
رابعا: المنهج النفسي جزء من كل
لا يأخذ المنهج المتكامل النتاج الأدبي بوصفه إفرازا نفسيا محدد البواعث، معروف العلل، فالنفس أوسع كثيرا من علم النفس، ورواسبها واستجاباتها قد تكون أعمق من هذا الفرد، على فرض أننا وصلنا إلى استكناه جميع البواعث الشخصية في نفس الفنان.
فالمنهج المتكامل يتعامل مع العمل الأدبي ذاته، غير مغفل علاقته بنفس قائله، ولا تأثرات قائله بالبيئة، ولكنه يحتفظ للعمل الفني بقيمه الفنية المطلقة، غير مقيدة بدوافع البيئة وحاجاتها المحلية، ويحتفظ لصاحبه بشخصيته الفردية، غير ضائعة في غمار الجماعة والظروف. ويحتفظ للمؤثرات العامة بأثرها في التوجيه والتلوين، لا في خلق الموهبة ولا في طبيعة إحساسها بالحياة.
وهكذا ننتهي إلى القيمة الأساس لهذا المنهج في النقد، وهي أنه يتناول العمل الأدبي من جميع زواياه؛ ويتناول صاحبه كذلك، بجانب تناوله للبيئة والتاريخ، وأنه لا يغفل القيم الفنية الخالصة، ولا يغرقها في غمار البحوث التاريخية أو الدراسات النفسية، وأنه يجعلنا نعيش في جو الأدب الخاص، دون أن ننسى مع هذا أنه أحد مظاهر النشاط النفسي، وأحد مظاهر المجتمع التاريخية إلى حد كبير أو صغير. وهذا، فيما نحسب، هو الوصف الصحيح المتكامل للفنون والآداب[7].
خامسا: قراءة النصوص الشعرية
وهنا لابد من أن أشير إلى همٍّ طالما عانى منه النقاد والدارسون، وهو: من أي زاوية يتناولون النصوص مدارَ الدراسات والمقاربات المزمعة، وما الذي سيكتبون عنها وعن كاتبيها وهم أصحاب الدواوين الثرة التي تستعصي على الدرس، أو على الأقل إن هي استسلمت وأذعنت، فلا أقل من أن ينفق عليها وقت عزيز.
ولعل المطلوب هو أن يختار الناقد واحدا واحدا من دواوين المراد قراءة أشعارهم الأكثر تعبيرا عن شاعرية كل شاعر على حدته، شكلا ومضمونا، وأن يتناوله بالدرس والتحليل. أو أن يختار ما يختاره من كتب في الأجناس الأدبية أو الفنية الأخرى.
وأحسب الاختيار، على هذا، سيكون في محله تماما، بسبب ما ستنطوي عليه الدواوين من خصب وتنوع وإبداع؛ فضلا عن العامل المشترك بينها من وجهين:
الأول: عزف الشعراء جميعهم على جل الأغراض الشعرية عبر دواوينهم الأخر.
الثاني: اختصاص المجموعات الشعرية بلون واحد مما أحب تسميته بالشعر الروحي الذي ربما انبنى عليه هذا الاختيار؛ أو غيره من الاختيارات الأخر أو الأغراض إذا ما تعلق الأمر بالقديم ولا أقول التقليدي أو الكلاسيكي. أو بالنظر إلى أي مشترك فني أو موضوعي أو هما معا؛ وهذا هو الأوفق.
وكما هو معروف فإن التعامل مع شاعر ما، قد يأخذ أحد السياقات الثلاثة:
- دراسة مسألة محددة أو ظاهرة ما، في أعماله الشعرية كافة.
- دراسة جل المسائل والظواهر، في ديوان واحد من دواوينه، أو ربما قصيدة من قصائده.
- دراسة مفردة محددة أو ظاهرة، في ديوان واحد من دواوينه، وهي المهمة التي يضطلع بها، في الأغلب، المعنيون بالنقد التطبيقي، وإن كانت مهمتهم تنساح أحيانا باتجاه المحورين السابقين.
وقد يختار السياق الثاني من يختاره، ليضع كل ديوان بين يديه دارسا منقبا، في محاولة متأنية لاستقصاء معطياته وملامحه، وقيمه الفنية والموضوعية على السواء؛ وإن كان التركيز منصبا عن عمد، أو هذا ما ينبغي أن يكون، على الجانب الفني أكثر من صنوه الموضوعي، حتى تستوي شجرة النقد الحقيقية على سوقها.
وقد يتحرك الناقد، وهو يتعامل مع الدواوين، على جملة من المحاور وَفق تسلسلها في البحث فيما يتعلق بكل ديوان تتخللها عتبات تفصيلية تنظر في فهرس المواد.
وبهذا يكون ربما قد تناول القضايا الأكثر أهمية في كل ديوان، واضعا نصب عينيه بالضرورة مسألة الشكل والمضمون، أو الفن والموضوع، بكل تأكيد، دون إغفال لأي منهما، وإن كان المفضل لدينا الانطلاق من الجانب الفني، مما لم يمنع من الانطلاق من الموضوع أحيانا أخرى للضرورة الملحة، ليوفي السبر على معطيات فنية وموضوعية اقتضاء؛ وهي مسألة ضرورية لا خيار فيها للدارسين، إذا أرادوا، فعلا، أن يقدموا تقويما دقيقا لهذا العمل أو ذاك من أعمال الشعراء، أو لجملة أعمالهم.
وأغلب الظن أن الميل الخاطئ للأدباء باتجاه المضمونية في دراساتهم وأعمالهم النقدية، مما غطى مساحات واسعة من معطياتهم في العقود السابقة، تلك المعطيات التي لم تول القيم الفنية اهتماما كافيا، هذا الميل أو الجنوح قد مضى إلى غير رجعة، بعد إذ أدرك هؤلاء الأدباء أن التعامل الدراسي والنقدي مع الأدب، لا يتم إلا بتناول الجانبين معا.
لترى جملة من الدراسات ضمن سيل من الأعمال النقدية، تجيء مؤكدة التزام المنهج الأكثر إحكاما في التعامل مع الظاهرة الأدبية.
وللحقيقة فإن معالجة الموضوعات الهامة يحسن أن تتبلور في ثنائية متوازية، لكن في سياقين محددين:
يتناول أحدهما الموضوع، ويتعامل ثانيهما مع الفن بما يعتمده من لغة، وينطوي عليه من قيم جمالية، دون أن يسمح لشيء من التداخل يَمَسُّهُمَا، لتأتي أكثر التزاما بمطالب الدراسة المنهجية.
وهكذا فقد يعتمد الناقد، عبر جملة من المحاور المختارة، منهجا متوحدا يقوم على إضاءة المسألة أو الظاهرة موضوع المحور المعين، بالتحليل والمقارنة والاستنتاج، وتأكيدها بمعطيات الدارسين والنقاد الذين تعاملوا مع الشاعر حينا، أو تحركوا خارج دائرته حينا آخر، كما يحسن بالنقدة عدم الاكتفاء بالديوان الذي بين أيديهم فحسب، بل وجب أو حسن أن يَعْبروا بين الحين والحين إلى دواوين أخرى للشاعر، فضلا عن الاستشهاد ببعض تنظيرات الشاعر نفسه إذا تيسرت ووجدت العلاقة الوطيدة.
ومرة أخرى، فقد يختار الدارس الدواوين والأشعار التي تعجبه ليدرسها، وإلا فإن تسليط أضواء النقد على كثير من الأعمال غير المكتملة من التي يتسرع أصحابها في نشرها، لا يعجبهم التعامل معها بطريقة نقدية منصفة، تذكر المناقب والمثالب في الوقت نفسه؛ فهم يؤثرون الإطراء والمدح والمجاملة فقط. وهذا ما لا ينفع التراكم المنشود في المنهاج الشامل المتكامل، ولن ترفد المكتبة المنتظرة بالمجاملات والإخوانيات.
أما المنهاج الذي يفضل اعتماده في التحليل، فهو الانطلاق من النصوص لقراءتها من داخلها، بعيدا عن القراءات النمطية التي تُسقط المناهج الغربية على كل مكتوب، كما يستحب أن يكون في اللغة النقدية بعض النداوة بما هي إبداع على إبداع، فلا يتعب القارئ في تتبع مفرداتها وتراكيبها وخيوطها.
هنالك قد تمنح مثل هذه الدراسات المتلقين فرصة لممارسة اكتشاف القيم الفنية في قصائد الشعر، تنصف الشعراء، وتعرف كيف تتعامل مع كل منهم بما يوضح أبعاد تميزه، ويؤطره واحدا من الشعراء المقتدرين.
سادسا: مطبات الإحصاء
حين يحلل بعض الباحثين قصيدة أو ديوانا، ينبغي أن لا تكون الإحصاءات إلا منضبطة تمام الانضباط حتى لا يتسرب الخلل إلى نسبة الأفعال إلى الصفات، مثلا، لكي يثير ناتج القسمة الشك فلا يبعث على الارتياح؛ لأن القيمة قد تكون من الضعف، وضعفها دليل على تدني مستوى الشعرية في القصيدة المدروسة، لأن حاصل القسمة، يعطينا قيمة عددية تزيد وتنقص تبعا لزيادة عدد الأفعال ونقصها على عدد الصفات، وتستخدم هذه القيمة باعتبارها معيارا إحصائيا يدل على أدبية الأسلوب، كلما زادت كان طابع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدبي، وكلما نقصت كان أقرب إلى الأسلوب العلمي.
ولما أن يعود الناقد الحصيف المدقق إلى القصيدة، مُبْدِئاً ومُعيدا في إحصائها، لربما وجد عدد الأفعال غير مستثن من الإحصاء الأفعال الناقصة، والأفعال الجامدة كما يفعل عادة في الدراسات التي أجريت على الإنجليزية والألمانية، بيد أنه إذا كان أمر الأفعال هينا ويسيرا لأن هامش الخطأ فيها ضئيل، فإن قاصمة الظهر تجلى في الصفات، إذ قد يحصي الباحث الصفات من دون تدقيق ليكون البون شاسعا، فتقلب المعادلة رأسا على عقب، إن ارتفعت نسبة الأفعال إلى الصفات.
وقد يكون من أسباب الاختلاف عدم تحديد معنى الصفة، الناتج عن عدم العودة إلى كتب النحو، فالصفة كما حددها النحو العربي[8] بمعنى النعت وهو التابع الدال على صفة من صفات متبوعه أو من صفات متعلقه. أو هو الوصف الذي يكمل موصوفَهُ بدلالة على معنى فيه أو فيما يتعلق به[9].
إن مصطلح الصفة عند بعض الباحثين مصطلح غامض وملتبس، كما هو الشأن في الدراسات الأجنبية أي في الإنجليزية والألمانية حيث لا يستبين ماذا تعني على وجه الدقة. وهناك ـ إن تعجب فاعجب ـ من يضع الصفة مقابل الفعل.
1. الإحصاء في الدراسة الأسلوبية
أول من وضع أسس الإحصائيات الحديثة واستخدمها في أبحاثه هو العالم المشهور داروين في كتابه: أصل الأنواع، سنة 1856م، حيث استخدم الإحصاء لدراسة التنوع في الطبيعة، وأسباب هذا التنوع، فلاحظ أن بين أفراد الجنس الواحد اختلافات كثيرة على الرغم من أنها بسيطة، حتى الأبناء الذين ينحدرون من أصلاب واحدة لابد أن توجد بينهم اختلافات، وسمى هذه الاختلافات فروقا فردية، وأكد على أهميتها في التطور والارتقاء[10].
هنالك تلقَّف علماء التربية الفكرة، ونادوا بضرورة مراعاة الفروق الفردية في التعليم، لأن الفصل الدراسي ليس كتلة متجانسة كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل توجد بين المتعلمين فروق فردية يتعين على المدرس أن يضعها في الحسبان، عبر مختلِف مراحل الدرس، فهم يختلفون في القدرة على الفهم والتحصيل، كما يختلفون في المهارات الفكرية الأخرى، واستخدام علماء التربية التحليل الإحصائي لمعرفة العمر العقلي وحاصل الذكاء، فحاصل الذكاء يساوي العمر العقلي مقسوما على العمر الزمني، مضروبا في مائة[11].
كما انتقلت الفكرة أيضا إلى حقل النقد الأدبي، فاستخدمت الإحصائيات في دراسة الأسلوب الأدبي في أواخر القرن التاسع عشر سعيا وراء إقامة منهج علمي موضوعي لتحقيق النصوص، وتوثيق نسبتها إلى مؤلفيها الحقيقيين، فقد طبق النهج الإحصائي في تحقيق محاورات أفلاطون، وتوثيق رسائل بولس الرسول وتعاليمه التي تلحق بالأناجيل الأربعة[12].
ومما يسر استعمال المنهج الإحصائي، وساعد على رواجه وانتشاره ظهور الكمبيوتر وحاسبات الجيب، وأصبحت المقاربة الأسلوبية الإحصائية وسيلة الإثبات الوحيدة حين تنعدم الشواهد التاريخية الصريحة[13].
إن الإحصاء الذي استخدم في دراسة الأسلوب الأدبي في القرن التاسع عشر كان إحصاء بسيطا، ولكن الإحصاء تعاظم دوره في ما يعرف بالأسلوبية الإحصائية إلى درجة أن أبرز المفاهيم الأسلوبية المعاصرة تعرف تعريفا رياضيا تتلاحق فيه مصطلحات العلوم المادية، فنجد تعريفات للأسلوب تستند إلى الإحصاء مثل هذا التعريف[14]:
The style of a text is defined as a function of the aggregate of the rations between the frequencies of its phonological, grammatical and fiscal items, and the frequencies of the corresponding items in a contecstualy related norm more concisely; the style of a text is the aggregate of the contecstualy probabilities of its linguistic items.
وترجمته[15]: أسلوب النص هو وظيفة مجموع النسب بين تردد مواده الصوتية والنحوية والمعجمية، وتردد المواد المماثلة في أنموذج آخر قريب منه سياقيا، وبعبارة أوجز: أسلوب النص هو مجموع الاحتمالات السياقية لمواده اللغوية.
كما يعرف العدول أو الانزياح تعريفا رياضيا أيضا على هذا النحو[16]:
We way defiance deviance as purely statistical notion as the difference between the normal frequency of a feature and its frequency in the text or corpus.
وترجمته: العدول أو الانزياح هو الفرق بين التردد العادي لصفة أسلوبية ما، وترددها في النص أو في مجموعة من النصوص. إن العدول الذي يمثل صُلب العمل الإبداعي وجوهره يتحول في الأسلوبية الإحصائية إلى بيانات عددية، وإلى أرقام وكميات. وقد آثرنا استعمال مصطلح العدول على الانزياح في هذه المقاربة لأنه أدق في التعبير عن الظاهرة ووصفها[17]، ولأنه مصطلح تراثي أصيل، اختاره أغلب البلاغيين، ثم لأنه مصطلح تتوفر فيه النية الجمالية والمقصِدية الفنية، لأنه مشتق من فعل متعد، على عكس لفظ الانزياح المشتق من فعل لازم.
كما يتجلى الطابع الرياضي الكمي في استخدام معادلة بوزيمان الألماني مؤشرا إحصائيا لتمييز أسلوب النص الأدبي بواسطة تحديد النسبة بين مظهرين من مظاهر التعبير هما الأفعال والصفات[18].
إن المقاربة الإحصائية للأسلوب تضع على عاتق الدارس مهمات جسيمة قد لا يستطيع النهوض بها وإنجازها على الوجه الأكمل، فمن الناحية النظرية ينبغي أن يكون الدارس الذي يعتمد المنهج الأسلوبي الإحصائي على معرفة ودراية بالأسس والقواعد النظرية للمنهج، وأن يتمتع بحساسية فنية فائقة، وبعبارة عليه أن يمتلك كفاية أسلوبية عالية، وأن يكون لدية معرفة عميقة بأسرار اللغة ودقائقها، كما يجب أن تكون لديه مبادئ عامة في الإحصائيات، وأن يضع في الاعتبار قضايا أخرى شائكة مثل التعقيدات المرتبطة بالإبداع الأدبي، وطبيعة اللغة الأدبية عامة، والشعرية خاصة.
أما من حيث الممارسة العملية، فإن التعريف المشار إليه آنفا وهو أن: "أسلوب النص وظيفة مجموع النسب بين تردد مواده الصوتية والنحوية والمعجمية، وتردد المواد المماثلة في أنموذج آخر قريب منه سياقيا". يشير إلى جملة من الضوابط التي يجب العمل بمقتضاها في إطار الأسلوبية الإحصائية، من أهمها:
ـ أن دراسة الأسلوب لا تقتصر على مستوى واحد من مستويات النص، بل تمتد لتشمل كل مستوياته الصوتية والنحوية والمعجمية؛ أي أننا لا نستطيع أن نحدد ملامح الأسلوب إلا إذا درسنا كل شيء، بيد أنه يتعذر علميا إجراء الإحصاء في كل الاتجاهات، إذ توجد مستويات أخرى في النص من الصعب إخضاعها لتقنيات التحليل الإحصائي، وهي الجمع والوصف والتصنيف.
ـ أن إحصاء المواد اللغوية في النص المدروس وحده لا يكفي بل لابد من مقارنته بإحصاء مواد لغوية أخرى في نص أنموذجي قريب منه سياقيا، يكون بمثابة النص المعياري. فنتائج الإحصاء لا تكون ذات قيمة علمية إلا إذا نظر إليها في ضوء الفوارق، وقورنت باستعمالات مماثلة في نفس السياق.
ـ أن المقارنة لا تجري ولا تصح إلا بين النصوص التي تمتلك عددا من العوامل المشتركة أو العلاقات السياقية.
إن إحصاء السمات الأسلوبية المتكررة في النص دون مقارنتها بسمات مماثلة في نصوص أخرى تملك مشتركات مع النص المدروس، يكون فارغا وعديم الجدوى وبلا قيمة علمية. فهذه دراسة علمية جيدة حول شعر أبي تمام، اعتمد فيها الباحث الأسلوبية الإحصائية، أحصى كل شيء عددا، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: فقد أحصى مثلا جميع صور التشبيه في شعر أبي تمام وكل ضروب الاستعارة، ومختلف أنماط الفصل والوصل، وجميع أنواع التوازي، إلا أن بعض نتائج البحث لم تكن في مستوى الجهد المبذول نظرا إلى إغفال المقارنة؛ ومنها أن أبا تمام لم يخرج عن الإطار العام الذي رسمه الشعراء القدامى في تشبيهاتهم، وأن التشبيه الضمني قليل في شعره بالقياس إلى الصور التشبيهية الأخرى.
والسؤال هو: إذا كان أبو تمام لم يخرج، كما يزعم الباحث، عن الإطار العام، وظل محافظا على الأنموذج القديم في بناء الصورة التشبيهية، فما الداعي إلى دراسة التشبيه أصلا؟ ثم أين خصوصية أبي تمام وتفرده؟ ألم يجمع النقاد القدامى على أن له طريقة خاصة في الشعر؟
الواقع أن الخلل آت من غياب المقارنة بين أبي تمام في مجال الصورة التشبيهية، وبين شعراء آخرين تربطهم به علاقات سياقية معينة، فلو فعل الباحث لاكتشف جوانب التميز والخصوصية لدى أبي تمام، كما أن الخلل آت أيضا من عدم التفرقة بين نوعين من السمات أو الملامح الفنية؛ السمات الثابتة التي هي بمثابة قواعد عامة أو عادات أو أعراف تعبيرية، وبين السمات المتغيرة التي هي مواطن التفرد والخصوصية.
ولم يكن ضروريا دراسة جميع صور التشبيه عند أبي تمام، لأن بعضها يمكن أن يكون داخلا في إطار السمات العامة للشعر العربي في مجال بناء الصورة التشبيهية، وعندئذ يجب تجنبها، والتركيز على ما يظن أنه خاص[19].
إن ما يسوغ الاعتماد على الإحصاء في دراسة الشعر هو أننا عندما ندرس واقعة أسلوبية، أو ظاهرة أسلوبية، نفترض أنها ليست مقصورة على النص المدروس، فربما فشت في شعر شعراء معاصرين للشاعر، أو متقدمين عليه، أو لاحقين به، وحتى يمكن أن نعتبرها سمة مميزة، أو ملمحا فنيا خاصا، يتعين اللجوء إلى الإحصاء لقياس الظاهرة عنده، ثم مقارنتها بنفس الظاهرة عند شعراء آخرين تربطه بهم عوامل مشتركة، وبدون ذلك لا يكون للإحصاء معنى.
لننظر، مثلا، إلى التشبيه الضمني الذي قال الباحث إنه قليل في شعر أبي تمام (30 مرة)، مقارنة بالأنماط التشبيهية الأخرى، فهذا مزلق من مزالق الإحصاء، وخطأ منهجي. وما ذلك إلا لأن الأصوب أن نقارن التشبيه الضمني عند أبي تمام بالتشبيه الضمني عند البحتري، أو أبي العلاء المعري، أو أبي الطيب المتنبي، لنجد أن أبا تمام يكثر من استعمال التشبيه الضمني بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الشعر العربي. ومن ثم فهو يمثل ملمحا أساسيا من ملامح شعره الخاصة.
إن المعطيات الإحصائية في غياب المقارنة تؤدي إلى نتائج خاطئة، ولكن لابد من أن نستدرك لنقول: إن الوفاء بالتزامات المنهج الأسلوبي الإحصائي وتطبيقه بشكل جيد لا يغني ولا يفيد كثيرا إذا لم تعضده الكفاية الأسلوبية العالية والحساسية الفنية الفائقة[20]، فبنية النص جمالية، وينبغي أن ننظر إليه على هذا الأساس، وكل تحليل أسلوبي ما هو إلا محاولة للكشف عن بعض مواطن الجمال في هذا النص أو ذاك[21]، والباحث الذي لا يتمتع بكفاية أسلوبية متميزة في تذوق النصوص، واستجابة جمالية لها، لن يذهب بعيدا في دراسته، ولن يحقق شيئا ذا بال إذا كان يعول فقط على التحليل الإحصائي[22]، بل لابد أن يشحذ حاسته الفنية ويصقل خبرته الأسلوبية ليجيد الإصغاء إلى نبض الكلمات، ويلتقط أدق الذبذبات. إن ثمة حرارة داخلية تتوهج داخل مفردات اللغة من جهة، وضمن طريقة ترابطها وانسجامها من جهة أخرى[23].
وهكذا فإن من أهم مزالق الإحصاء في الدراسات الأسلوبية الحديثة:
ـ الإحصاء في غياب المقارنة.
ـ عدم التمييز بين السمات الأسلوبية الثابتة، والسمات المتغيرة، أو بعبارة أخرى: عدم التمييز بين السمات الأسلوبية العامة والسمات الفردية الخاصة.
ـ الركون إلى الإحصاء وإغفال عنصر مهم في الدراسة الأسلوبية وهو الحدس أو الحاسة الفنية.
ـ إغفال حقيقة مهمة جدا، هي أن الأسلوب ثمرة دراسة مختلِف جوانب النص دراسة شمولية.
ـ وهناك مزلق آخر هو عدم تحديد المصطلح تحديدا دقيقا قبل الانخراط في أي مقارنة إحصائية.
إن من الأهمية بمكان أن نعرف حدود المنهج الإحصائي في دراسة الأسلوب، كما يتبين من خلال هذه الملاحظ:
ـ إن المعطيات الإحصائية ليست أكثر من نقطة البداية أو المنطلق، وينبغي أن تفحص في ضوء التحليل الأسلوبي المعمق لمختلف مستويات النص قبل استخلاص أي نتيجة.
ـ إن المعطيات الإحصائية يمكن أن تفيد في تأكيد الملاحظ الذوقية التي نبديها حول الأسلوب.
ـ إن التحليل الإحصائي لا يستطيع أن يغوص بعيدا في أعماق النص أو الأسلوب، بل يمسه مسا خفيفا، لأنه يقف عند حدود ما هو واضح وبارز كالسمات الأسلوبية التي تحظى بنسبة عالية من التردد.
إن الإحصاء لا يقرأ إلا ما في السطور، أما ما بينها وما خلفها فلا سبيل إليه بالإحصاء وحده[24]. إذ لا بد من الدراسة الأسلوبية.
ـ يتعذر أن نطلب دليلا كميا على كل ملحظ نبديه حول أسلوب النص، ويكفي أن نعدد الأمثلة للسمة الأسلوبية موضوع الدراسة.
ـ توجد أنظمة أخرى في النص منها ما هو من الصعوبة إخضاعه للمقاربة الإحصائية بتقنياتها المختلفة من جمع ووصف وتصنيف وإحصاء[25].
من أجل هذا وذاك نحسب أن المقاربة الأنجع والأقرب إلى إعطاء نظرة جامعة لكل خطاب هي المقاربة الشمولية.
2. منهج الرواية بين التأصيل والتأسيس
إن ما ينبغي أن تعتمده الرواية من أبعاد فنية وجمالية وموضوعية لا يجدر إلا أن تمتاح من عدة مناهج تصب في المنهج الشمولي الذي سأحاول تبيين معالمه من وجهة نظري المتواضعة.
ويتعلق الأمر بمناهج ثلاثة وهي:
ـ رؤيا العالم للوسيان غولدمان بالنظر إلى إغراء العنوان وإيهامه، فضلا عن تقاطعه مع غيره من الرؤى.
ـ والبنيوية عموما على اعتبار قضية إرداف الخاص و العام في الصعيد ذاته[26].
ـ والإيماء إلى المنهج الجنسي الذي عمت به البلوى، مما لا ينبغي أن يعني أبدا أن كل ما تعم البلوى به قد يقبل عند الجميع.
ولم أقتصر على تلك المناهج إلا لأنها كافية في نظري لبسط المراد بالنظر إلى العموم والخصوص الكائن بينها بله التشابك بين رؤاها. لأقبل، جزءًا أو كلا، ما حقه القبول، وأرفض ما حقه الرفض حسب ما أتصور أنه المنهاج المقترح والمنشود في الفن و الأدب.
أما عن غولدمان فـ"سيقال: إن الأمر يتعلق بفكر لا إنجازي (كذا!)، لكن أي فكر لا يبدو كذلك يظل فكرا إلى آخر المطاف دون أن يصبح أيديولوجية؟
إن سوسيولوجية الأدب عند غولدمان ليست وصفا فحسب أو نقلا لألفاظ واضحة أو رمزية ضمن خطاب آخر، خطاب تجريدي، ولكنها البحث الصعب الذي يرمي إلى مواجهة ذلك التباين المتباعد دوما عن تجديد يصاغ وراء الأفكار المعبر عنها قصد إثبات هويته"[27].
حتى إذا حصل الاتفاق في الوضوح والرمزية بين المنهج العربي ورؤية العالم في هذا الصدد، فإن الاختلاف حول المذهبية يعد ضربة لازم. بمعنى أنه إذا كان هناك التقاء بين هذه الرؤية والنظرة الشاملة إلى الله جل جلاله، والحياة، والأحياء في تصور الأدب ذي المنهج الشمولي، فإن الاختلاف وجب حقا على مستوى العقيدة أو المذهبية إذا جاز أن نستعيض بها عما يسمونه اصطلاحا بالأيديولوجية. ذلك بأن التصورات المادية المحض غير التصور الروحي والمادي، ويختلفان اختلافات جوهرية معلومة أبرزها النظرة المادية الصرف إلى الأشياء؛ وإلا فإن التصور الشمولي يشمل المادة والروح معا.
على حين لا حرج علينا أن نقبل الوضوح باعتباره عاملا مشتركا بين المنهجين، بل قد يعد من الناحية الموضوعية روحا لمعطيات الفن عموما بالنظر إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (إبراهيم: 5)؛ مما لا يعني أن الرمز الشفاف المستسلم للقارئ بله الناقد بمفاتيح مضيئة سياقا وسباقا مما يدعو إليه الأدب والفن الجاد الشامل والمتكامل.
وأما عن البنيوية وما بعدها والقصور البادي فضلا عن عدم البراءة الشكلية، فإن ذلك كله يدعو إلى التثبت قبل الإفادة من هذه المناهج على وجه العموم، إلا ما استيقنا أنه لا يخالف ما ندعو إليه في الشكل والمضمون، أو الفن والموضوع.
ثم ألا يجدر بنا أن نستنبت المناهج في أرضنا؟ لماذا، إذاً، الجري وراء الآخرين حتى فيما لفظوه، واكتشفوا غيره كمثل ما بعد البنيوية، مع العلم أن "ما بعد" هذه عندهم تفيد نسخ ما قبلها، على حين يصر بعضنا على اجترار قديمهم رغم أنف الحداثة التي إليها يدْعون.
ومع ذلك لابد أن نقر أن للاستنبات والاستنباط أصحابه من أهل الذكر، لأن المجال فتح، وينبغي أن يبقى مفتوحا قابلا للاجتهاد المحفوف بالخطأ والصواب، لمن يحسن ولمن لا يحسن حتى إن بعض الإخوة كتب كتابا أراد أن ينتصر فيه لنظرية النظم معتمدا إياها في النقد الأدبي، وكان موفقا في الجانب النظري، إلا أنه، مع الأسف، أخفق إخفاقا ذريعا في مستوى التطبيق حيث طفق في دراسة النصوص بطريقة مسمارية، سمّها إن شئت، أو هيروغليفية معمورة بالدوائر والمستطيلات والبيانات وما إليها مما يفقد التواصل ويغيب النظرية المدعاة[28].
هذا بعض ما عنّ عن التأصيل ذي العلاقة بدراسة المناهج جميعا ونخلها حتى يتسنى الرفض أو القبول. وقد اكتفينا بالإشارة السريعة إلى العنوانات الثلاثة من بنيوية، وبنيوية تكوينية، ومنهج جنسي، كما سيأتي، لدلالتها على غيرها.
أما القصد من التأسيس كما هو معلوم عند أهل هذه الصناعة فإنه ليس كصنوه التأصيل، ذلك بأن التأصيل هو البحث عن القواعد مجتمعة أو متفرقة لإسناد أحد الموضوعات ذات الأهمية، في حين نجد أن التأسيس يحاول إعادة إنتاج المعرفة قصد إضافة معينة، أو تجميعا لشتات مجموع من المفردات المتفرقة بطريقة مبدعة لإعادة تركيب المعنى الجديد المراد.
بناء على هذا، فإن التأصيل يقتضي منا أن نبين عوار المناهج التفكيكية جميعا إذا ما طبقت في المجال الأدبي والفني، فكيف إذا استثمرت في محاولة إيجاد الاختلاف في القرآن الكريم وعلومه؟
ومن أعجب ما قرأت في هذا الصدد حوارا لأركون وأدونيس في مجلته "مواقف" حيث اتفقا على أن النص الثاني، بزعمهما، يشوش على النص الأول، كأن لهما غيرة على القرآن الكريم، ولكن حقيقة الأمر تفصح عنها سفسطتهما المسماة بالعلمية والموضوعية، حيث طفق يكيل المدح أحدهما للآخر، وتعجبا كيف اتفق كل على حدته على هذا الأساس من موقعه أو معركته كما أحبا أن يدّعيا.
اتفقت كلمتهما على أن قول الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآَنَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (الرحمن: 1-2)، كما في النص الأول، حتى إذا قال النص الثاني: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً"[29]، إذاً فالقرآن، بوساطة العلاقة المتعدية، سحر، وها هم أولاء يدعون أن القرآن سحر أو شعر أو كهانة أو غير ذلك كما يخرصون.
والملحوظ أنهما يقصدان المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي الذي يشير إليه الحديث الشريف، هذه واحدة. أما الثانية فإننا نقول لهم: حين تريدون إزاحة النص الثاني ليبرز التناقض على أشده في النص الأول، وتذهب أسباب النزول وما إلى ذلك من علوم آلية مساعدة، فإنكم تفعلون. وحين تريدون أن تعتسفوا على النص القرآني تستخدمون ما تدعون إلى عدم الاتكاء عليه!
وإلا فمن من العلماء والأدباء والمهتمين من يصدق خرافة قتل الكاتب أو "موت الإله" بما توحي به من أبعاد ذات خطر كبير على رؤية الفن الشامل عموما؟
كما كثر اللغط وتعددت المناهج التي لا تستحق مجرد الحديث عنها لولا الضرورة الملحة في كشف فساد بضاعة القوم ومن تبعهم.
فهناك منهج يدعى المنهج الجنسي/Erotique، واسمه دال عليه، وقد تم اعتماده في الشعر فضلا عن الرواية، ونحن لا نستحيي في نبذ مثل هذه الإبداعات الزائفة المزيفة التي تحب أن تشيع الفاحشة في الناس[30]. وإن كنت أقارع أصحاب هذه الدعايات، فإني أعجب لمن اتبعهم ظنا منه أنه يناصر الإبداع.
فقد سبق أن كتبت شيئا عن نجيب الكيلاني، رحمه الله تعالى، ولما أن أبنت عن بعض الصور الخادشة للحياء التي صورها بقلمه الجميل، إلى الحد الذي يدغدغ شعورك، انبرى لي أحدهم مدافعا عن الصور الغريبة التي لا تليق بالأدب. هنالك ظهر لي أن أسر إليه ومن معه أن الفيصل هو عدم قدرة تصوير بعض الروايات سينمائيا، أو مسرحتها؛ وإلا فإن الدعوة إلى الأدب الجاد ستكون لاغية.
وبالصدد ذاته أحب أن أقول: على الأدباء أن يولوا وجوههم شطر السينما والمسرح ناقلين فنون وموضوعات الروايات والقصص، كما يطالبون المسؤولين بربط التعليم بالشغل.
ثم إني سائلهم: هل بالإمكان قبول نقل رواية فيها لقطات جنسية خادشة للحياء من الدراما إلى المسرح؟ وهل يسوغ للممثلين أن يقوموا بما يقوم به غيرهم خاصة إذا كانوا ملتزمين أخلاقيا؟
وعودا على بدء؛ إن المنهج الشامل والمتكامل يقتضي منا جملة من الأعمال في النظر والتطبيق حتى يتأصل على أساس متين، وذلك بعد تركيم العديد من الروايات ذوات القيمة الفنية العليا في الأشكال والمضامين من حيث وجب على الكتبة في هذا المجال أن يستفيدوا من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ومن طرائق الروائيين الغربيين خاصة في الجوانب الشكلية البريئة التي تنتصر للفضيلة وتخاصم الرذيلة والإباحية.
وعلى الناقد البصير الذي لا يجامل ولا يحابي أن يبين كيف أنه من العار أن نتحدث عن الكيلاني، رحمه الله تعالى، بما هو فارس ضمن فرسان الرواية والقصة حقا، مثله في ذلك كمثل نجيب محفوظ، رحمه الله تعالى، في الرواية العربية بما حققاه من ركام مكنهما من المكانة التي يستحقانها عن جدارة وتحقيق؛ مما لا يمنع أن أعمالهما في حاجة إلى المزيد من النقد والتمحيص.
على حين لم يكتب الآخرون إلا روايتين أو رواية أو حتى ثلاث لا يمكن معها أن تدخلهم في عداد الروائيين بما أنهم أدلوا دلاءهم في كثير من التخصصات أحسنوا في جلها. الشيء نفسه فيما يتعلق من كتب كتابة صوفية لا ترقى إلى مستوى الرواية المنشودة، بما اشتبهت كتابته الصوفية شعرا ونثرا ورواية لا تكاد تميز بينها الذائقة الأدبية النقدية.
وهنا أحب أن أهمس في أذن المهتمين بأن قصة يوسف عليه السلام والقَصص القرآني جملة، ومحطات من السنة والسيرة، وبعض من روايات الغرب تحت مظلة الكلمة الحكمة، وكيف أنها ضالة المبدع أنى وجدها فهو أولى الناس بها وأحق، قمينة برفد التصور الشامل المتكامل الذي نصبو إليه في تأسيس وتأصيل الرواية الأدبية إبداعا ونقدا وتنظيرا؛ وإلا فلا شمولية أو تكامل، ومن ثم فلا إبداع!
3. ما بعد البنيوية
إن الذي يطالع ما يكتبه بعض الباحثين والفلاسفة النقاد في الغرب عبر السنين الأخيرة، في ما يسمى بمرحلة ما بعد البنيوية يجد هذا التدافع المتلاحق من الأفعال وردود الأفعال بصدد البنيوية فلسفة ومنهجا نقديا، قد لا يكون بعضها مما يقره العلم الجاد أو الرغبة في احترام الحقيقة.
ونحن نعلم كيف أن البنيوية كانت بشكل من الأشكال محاولة لتجاوز أخطاء وتناقضات الماركسية والوجودية اللتين اعتبرت كل منهما في مراحل التألق والانتشار عقيدة نهائية، لكن البنيوية باعتبارها هي أيضا صدورا وضعيا يتضمن الخطأ والصواب، لم تنج من المصير نفسه، فإن اندفاعها في التخلي عن النزعة الإنسانية ونزوعها إلى التعالي الذي يلغي التاريخ ويعتقل الإنسان في أقبية النسق والبنية والوحدة والنظام، قاد إلى التمرد عليها، حتى لا يمكن اعتبار تظاهرات الطلبة الفرنسيين في أحداث مايو المشهورة عام 1968م نوعا من الثورة ضدا على البنيوية، بل إن البنيويين أنفسهم انفرط عقدهم ولم يبق مخلصا للأفكار البنيوية الأولى سوى كلود ليفي شتراوس، الأب الروحي للحركة كلها، وهو يهودي حفيد لأحد الحاخامات، وهو الأمر الذي يذكرنا بالآباء الروحيين للعديد من الحركات الجديدة ذات الطابع الانقلابي كماركس وفرويد ودوركايم وغيرهم.
وبعد عام 1968م تغيرت كتابات البنيويين الفرنسيين ولم يقتصر الأمر على آلتوسير وفوكو من رواد الحركة، اللذين سعيا إلى نفي صلتهما ببنيوية ليفي شتراوس، وإنما تعدتهما إلى رولان بارت الذي أعلن عام 1970م أنه هجر الطريقة التي يتبعها عام 1966م! عندما كتب مدخله الشهير إلى "التحليل البنيوي للنص". بل إن مطالع العقد السابع من القرن الماضي شهدت أفول البنيوية في فرنسا نفسها بالقدر التي شهدت حركة جديدة مضادة لن تكف عن التصاعد يتزعمها المفكر الفرنسي جاك دريدا الذي انطلق ابتداء من مبدأ تدمير البنيوية على نحو ما فهمها البنيويون في مبتدأ أمرهم[31].[32].
إن هذه الأفعال وردودها إزاء حركة هي ليست في نهاية الأمر علما مطلقا نهائي الملامح، انعكست على العقل الشرقي والعربي بوجه خاص تقبلا أو رفضا، ونحن نكتفي، ها هنا، بواحدة من المعارك النقدية التي تمثل أنموذجا لما تشهده الساحة العربية، وإلا فإننا يجب أن نخصص لها عشرات الصفحات.
يقف الأستاذ سامي محمد في مقال له بعنوان على حافة النقد: أمعيار أم بنية؟[33] عند محاضرة للدكتور مالك المطلبي بعنوان الخطاب الشعري والخطاب النثري فيحاول أن يضع يديه على المعطيات الأساس للمحاضرة والمآخذ التي يتهم بها صاحبها.
لقد رسم لنا المحاضر، يقول الرجل، حدودا بنيوية فاصلة بين النثر والشعر، لم تلتزم بالتقسيم التقليدي لما هو شعر أو نثر، والعمود الفقري لمتن المحاضرة هو النص لا غيره. فإن كنا نريد الحكم على جودة نص ما ينبغي لنا أن ندرس النص نفسه بمعزل عن كاتب النص أو تاريخه أو تفاصيل حياته، بمعنى أن المحاضر اتخذ من تفكيك النص DECONSTRUCTION منهجا ثابتا، إنه يحيلنا إلى النص من الداخل لا من الخارج، من خلال التركيب الصوتي للمفردة وعلاقاتها مع المفردات الأخرى، واللغة بهذا المعنى نظام من العلاقات الداخلية القائمة على اشتراطات صوتية بين المنشئ والمتلقي، إنها رموز وإشارات يخاطب الكاتب بها قارئه، بنية المفردة هي القوام الأساس في إجراء تفكيك النص وإعادة تركيبه، الناقد البنيوي في هذه الحالة ينبهنا إلى العلاقات التي تربط مقاطع الكلمة وعلاقاتها مع السياق الدلالي للجملة، هناك قوانين ثابتة تشبه الجدول الرياضي، والتعبير للمحاضر، الذي ينبغي أن نستظهره عن ظهر قلب لكي نستطيع فك رموز النص أي فهمه واستيعابه. الخطاب بهذا المعنى رسالة يبثها الكاتب شاعرا أو ناثرا، أي إنه المرسل الذي يعطي للنص دلالاته ورموزه وهي المعول عليها في التلقي، أما نية كاتب الرسالة خارج مفرداتها فلا تشكل قيمة إبداعية نعول عليها في فهم النص نفسه.
من هنا لابد للناقد البنيوي أن يتخلى عما أسماه المحاضر بالنقد المعياري الذي تراكمت أحكامه عبر عصور عديدة ربما بدأت من فن الشعر وانتهت بالمناهج النقدية أو التيارات الفلسفية في قرننا هذا.
تتخذ البنيوية، إذاً، من المنهج اللغوي أساسا في تقويم النص، وبهذا فإنه تنكر على المناهج الأخرى صدقها في التقويم لأنها تَضْطَرُّ الناقد إلى أن يقيم وزنا لاعتبارات قد تقع خارج حدود النص المكتوب؛ ولهذا فإن البنيوية لا تعترف نقديا بكل محاولة اختبار للنص لا أساس لها في تطويعه إلى الإحالة الصوتية، والصوت هنا رمز ودلالة، ومتى استطاع الناقد أن يحل هذا الرمز، وهو شفرة يرسلها المنشئ، عن طريق التحليل الصوتي، فإنه يوفق في فهم الرمز أي وحدة النص، وهذا لا يتأتى أيضا إلا عبر رصد العلاقة الصوتية القائمة بين مفردة وأخرى، فالمفردة بهذا المعنى كائن حي له مقوماته ووظيفته، ولابد لهذا الكائن (المفردة) من علاقة بكائن آخر/مفردة أخرى. ومن خلال هذه العلاقة نقيم النص دون أن تكون لدينا مقاصد جمالية.
يرى المحاضر أن المقدمة الجمالية، وهي التي تعتمدها المعيارية في مناهج النقد الأخرى، مرفوضة في تقويم النص بنيويا، لأنها تؤدي لا محالة إلى إحالتنا إلى خارج النص وتبعدنا من بعد ذلك عن اعترافنا بالمفردة على أنها شفرة ينبغي حلها صوتيا، وبهذا يلغي المحاضر كل هذه المناهج التي تتبنى المعايير/الأحكام في الفهم النقدي.
إن مقاصدنا بشكل عام، وربما ثقافتنا ومخزوننا المعرفي، لا تشفع لنا في سعينا إلى الحكم على النص لأنها تتضمن مقدمات جمالية وأحكاما نقدية، وربما اتجاهات فكرية لا يستسيغها النص نفسه. فالتناص نفسه هو الأداة الشرعية لفهم الأثر الفني. إن لهذه المقاصد عواطف وأفكارا لا يحتملها السياق الصوتي والدلالي للمفردة أو الجملة؛ بمعنى أن هذه العواطف والأفكار لا تنسجم مع تجريد اللغة، فمثلما أننا لا نتعاطف مع الأرقام لأنها مجردة من العواطف والأحاسيس، ينبغي لنا بالمثل ألا نتعاطف مع اللغة إلا بمقدار ما تحمله من رموز وشفرات.
هذه هي الخطوط العريضة لتعليق الناقد المذكور على المحاضرة التي ألقاها ناقد آخر يلتزم البنيوية نقديا، لكن المعلق لا يكتفي بهذا، بل يمضي لكي يسطر بلون مغاير على ما يعتبره أخطاء وثغرات في المنهج البنيوي كما عرضته المحاضرة.
فهو بعد أن يشير إلى أن المحاضرة أثارت نقاشا ساخنا مثلما أثارت ردود فعل عنيفة، يقول بأن البنيوية منهج لغوي لا نقدي، إنها تنظر إلى النص وكأنه روبو خال من العواطف والانفعالات. وهل في الأرقام العددية عواطف؟
البنيوية إذاً منهج يسعى إلى تحطيم كل المؤسسات النقدية التي تتعامل مع الفكر وقد اختطت لها منهجا في التفكير.
ومن شعارات البنيوية ألا اجتهاد خارج النص، والنص هنا، كما يفهمه دعاة البنيوية، لا يحمل وظيفة أخلاقية أو قاعدة للسلوك الإبداعي، إنما هو نظام صوتي وليس نظاما فكريا، فعلى النص أن يكون منزها من الاعتبارات الجمالية التي اتفقت عليها الفلسفات والمذاهب أو اختلفت، لأنها ليست برقعا يغطي النص ينبغي لنا رفعه لنرى ما يخبئ تحته.
والبنيوي هنا ميكانيكي، فكما يفكك الميكانيكي أجزاء السيارة ويركبها من جديد، فإن البنيوي يفعل ذلك مع أجزاء النص من المفردات.
والميكانيكي لا يتعاطف مع الآلة المجردة إلا بقدر وظيفتها في سياق العمل الآلي، وهكذا حال البنيوي الذي لا يتعاطف مع الأسلوب إلا بقدر كونه نظاما خاصا من الرموز والإشارات.
إنه يجرد النص من سياقه التاريخي والاجتماعي، وبهذا فهو ينكر على النص دوره ووظيفته الاجتماعية ولنقل السياسية، فالبنيوي يسعى دائما إلى دق أسافين بين المنشئ والمتلقي، إنه يوجه إهانة إلى إرادة الكاتب الذي يعبر عن موقف أو اتجاه فكري أو فلسفي معين، فهو بهذا المعنى يرفض الدور المذهبي في الأدب والفكر بشكل عام، ويضع الإبداع خارج حدود التاريخ.
إن الأدب شكل من أشكال الفكر واللغة التي هي رأسمال البنيوي وعاء الأدب، والأدب وهو النصوص كما يفهمها البنيويون نشاط فكري يجري في الذهن والحواس، وإذا ما طبقنا المنهج البنيوي على نص معين فسنجده يحيل النص إلى علاقات لا إنسانية، بل إلى أصوات بدائية ليفي شتراوس. ولهذا لا يعترف البنيويون بجودة نص أو رداءته، لأنهم يتعاملون مع أصوات، ولهذا فإنهم لا يقيمون وزنا للمستوى التقني الفني/Technique؛ لأنه في رأيهم لعبة لخداع القارئ، ولهذا فإن الناقد البنيوي حينما يحلل نصا أو يكتب عنه فإن حكمه يأتي تجريديا، لأن همّه أن يفرق النص عن سياقه الجمالي والأسلوبي الفني التقني؛ ومعنى ذلك أن تصبح كل النصوص لغة لا أدبا.
وإذا كان المحاضر يرفض المعيارية في الحكم النقدي، فإنه بذلك يلغي تاريخا طويلا من اهتمامات الفكر الإنساني الذي جهد منذ عصر اليونان حتى الوقت الحاضر في صياغة وإعادة صياغة قوانين الإبداع ومبادئه عبر مفكرين وفلاسفة وأدباء، ولهذا فإن البنيوية برفضها المعيارية تدعو إلى مبدأ الإلغاء الإبداعي؛ أي إن إبداعا معينا (كالبنيوية نفسها) باستطاعته أن يلغي كل الإبداعات ما قبله، وهذا منطق لا تقره طبيعة الأشياء أو تاريخ الإنسان، إن مبدأ التراكم المعرفي يظل واحدا من قوانين الطبيعة والإنسان، إنه قانون مطلق، وما المعيارية التي هي حصيلة المبادئ والأحكام الجمالية، إلا جزء من هذا التراكم المعرفي الذي جهد العقل الأدبي منذ قرون عديدة في إرساء تفصيلاته وإشاعة احتكاماته[34].
طبعا إن المحاضر البنيوي لن يقر هذا الذي ذهب إليه المعلق في نقداته، ومنذ البدء يتهم "المقال بأنه كان ضحية اللَّبس المتأتي من بُعد الزميل المعلق عن هذا الحقل"[35]. وهو يشير في البداية كذلك إلى نقطة يعدها جوهرية في هذا المقام، وهي أن أغلب أحكام النقد الأدبي عندنا تستمد مقوماتها من العقل المجرد ومنطقه التصوري، معتمدة الذوق والحدس والتبصر، نائية عما نريد أن يتأسس في حياتنا من إحالة الأدب إلى العلم، أي مقاربة (الإبداع) من الظواهر، وكان هذا غاية المحاضرة الآنفة الذكر، وهذا على وجه التحديد ما تحاول (الألسنية) بوصفها الفلسفي في اللغة بثه في روح الأدب ونقله، بعد أن أنهكته المعايير القبلية والنظرات الإحالية والتفسيرية، فما لم تخترق أحكام النقد نظام اللغة وتحط بمناهجه فسوف تظل أحكاما مضللة، ذلك لأن العلاقة بين اللغة والأدب ليس علاقة حامل بمحمول، وإلا أصبح كل منطوق أو مكتوب أدبا، إن لغة النص الأدبي تشبه إلى حد ما (الكلمة) في اللغة، فالكلمة هي دال ومدلول، معنى وصوت، مفهوم ومادة في آن، فكيف ندخل في تصورنا تفريغ المدلول من الدال، أو تجريد الدال من مدلوله إلا إذا قلنا بتمزيق وجه ورقة الشجرة من غير تمزيق ظهرها؟
هذه هي الحال في الخطاب الأدبي، لا يمكن تحليله إلى عنصرين: اللغة والأفكار، في حين يمكن ذلك في كل ما هو خارج الأدب، إن الأدب هو نوعه، ونوعه لغوي! وإن اللغة في خارج الأدب مضامين وأفكار ومعلومات، أما في الأدب فهي رموز، وعلى هذا الوجه سنلحظ القيم الخلافية بين الشاعر والمصلح، بين الأدب والتمذهب، بين لوثر وماركيز، بين المعلم الأول والمتنبي.
وبعد استعراض موجز لأوجه النشاط البنيوي في الحقل النقدي وارتباطه بالألسنية، ينهي المحاضر رده بالقول بأن الناقد حاول أن يفرق على نحو تقليدي، بين الشعور والجماد، الروبو والحديد والأرقام من جهة، والانفعال الإنساني من جهة أخرى: فهل تتنازل الحداثة حتى تلجأ إلى استعارة اعتراضات تقليدية أصبحت في ذمة الماضي؟
لقد كانت العاطفة المعيار الأول في التفريق بين الشعر والنظم، بين الأدب والنثر، لكننا نسأل: ما العاطفة؟ وما العاطفة في الأدب؟ وما معيار التفريق بين عاطفة وأخرى؟ وما مدى المطلق في العاطفة والنسبي؟ أي هل العاطفة خارج الجغرافية (عاطفة الباريسيين هي نفس عاطفة الهنود الحمر؟) وخارج التاريخ (هل عاطفة عصر النهضة هي نفس عاطفة عصر الروبو؟) وعلى هذا، هل الأرقام والحديد بلا عاطفة؟ إن الاحتكام إلى العاطفة بمعناها اليومي لا الاصطلاحي، يمثل عودة أو حنينا إلى الرومانسية التي أعطاها الواقع ظهره.
إن على النقد الأدبي أن يقصي من منهجه صيحات الاستحسان والدهشة وهز الرؤوس وأصوات التعجب! وعليه بدلا من ذلك أن يثبت لنا تركيب دهشتنا تركيبا رياضيا.
لم تكن محاضرة المطلبي وكلمة سامي محمد ورد المطلبي على الكلمة هي خاتمة المطاف، فإن الأخذ والرد، وهو عمل إيجابي بحد ذاته، لأنه يدل على عدم استسلام مطلق لأي نظرية جديدة، لولا أنه جاء متأخرا نسبيا بعد أن تحول بعض رواد النظرية عنها إلى صيغ ونظريات أخرى، هذا الأخ والرد استمر قبل المحاضرة وبعدها حيث تطالعنا على مدى أشهر متقاربة فحسب جملة من العناوين التي تعالج المسألة من أكثر من زاوية، فتلتزم المنهج البنيوي نظرية وتطبيقا حينا، وترفضه حينا آخر، وتدعو إلى الإفادة والموزونة منه حينا ثالثا، وتحكي عن بعض رواده أو مؤلفاتهم رابعا[36].
مهما يكن من أمر فإن النقد البنيوي، بتفكيكه للنص، يمارس تشريحا دقيقا أقرب إلى مطالب المنهج العلمي، ويتوغل عميقا في البنية اللفظية والدلالية السيميائية، ويجدول، بتعامله مع المفردات، معطيات ووحدات التوافق والتضاد من أجل استخلاص نتائج أكثر دقة من خلال معاينة هذه التقابلات اللفظية والعلاقات البنائية، ثم إن النقد يبدأ بفصل العمل عن كافة ارتباطاته الخارجية، ويسعى للتعامل معه بأكبر قدر ممكن من التجرد والموضوعية بصفته "نصا" تتضمن بنيته من الداخل المغزى النهائي لما يريد الأديب أن يقوله.
فالمفردة ـ اللغة تتجاوز في نطاق الإبداع الأدبي مهمتها الوظيفية، لكي تلتحم بالرمز أو الدلالة التي تريد أن تقولها أو تعبر عنها، ومن ثم فإن طبيعة الارتباطات بين الكلمات في مواقعها من العبارات والجمل، قد يقود بشكل أقرب إلى الصواب، وأبعد عن الإقحام من الخارج، وبمواضعات عرفية قد تفرض ولا تفسر، يقود إلى المغزى الأخير للنص.
وبما أن المعنى الذي تحمله المفردة في النص الأدبي يخرج عن كونه معجميا صرفا أو تاريخيا صرفا، وإنما هو التحام بين الدال والمدلول، فإنه يؤدي إلى تشكل وحدات تسعى تعارضيا أو تقابليا إلى إقامة بنائها، ويجيء النقد البنيوي لكي يستجوب ويستخلص الحوار القائم بين هذه الوحدات. إن هذا الحوار هو الصوت الحقيقي للنص ومعناه الأقرب إلى الصواب.
هذا حق ولكن مرة أخرى: لماذا الموقف أحادي الجانب؟ لماذا لا نضيف هذا الاكتشاف الهام، مع قدر من التحفظ في اعتباره اكتشافا[37]، إلى تراكمات الخبرات النقدية عبر القرون فنزيدها قدرة على فهم الإبداع وتحليله؟
لماذا محاولة سد الأذن عن كل الأصوات الأخرى والاكتفاء بمعطيات الاكتشاف الأكثر حداثة واعتباره العلم الأخير، بل الوحيد، حتى إذا ما كرت الأيام وأفرز العقل البشري، أو الخبرة، قناة جديدة للاتصال والفهم إزاء العمل الإبداعي، حكم على الاكتشاف السابق بالإعدام أو النفي على أقل تقدير[38].
إن الأمر الذي لا شك فيه هو أن النقد البنيوي قد يصل، بالتأكيد، إلى نتائج تضيء العمل وتضع يده على إيقاعه وهدفه، لولا أن البنيوية، في مقابل هذا، تلح في محاولة جر العمل الإبداعي إلى مختبرات الصوت وعلم اللغة والتعامل الكيميائي بحثا عن العنصر والمركب في هذا العمل[39].
وهو الأمر الذي يضيق الخناق على الممارسة النقدية ويرغمها على المرور باللغة والمختبر! على حين يفقد الناقد أحيانا ما يمكن اعتباره الحس الجمالي الذي يتميز، أو يجب أن يتميز، بقدر غير قليل من الحرية والعفوية والمرونة والاستشراف.
والبنيوية، بسعيها إلى فك الارتباط بين الأديب وعمله، لم تأت بأمر جديد تماما، لقد سبقتها محاولات متواصلة لتحقيق هذا الانفصال في مجالي الآداب والفنون التشكيلية، كذلك الذي قال به، مثلا، سوريو وبايير في مجال الرسم؛ وكل الذي فعلته هو إلحاحها على هذا الفصل في ما يمكن اعتباره "قتلا للإنسان"؛ إذا اعتمدنا عبارة رجاء غارودي، رحمه الله تعالى، وسحبناها من الفلسفة إلى النقد، فما دام العمل الإبداعي هو نفحة الفنان أو الأديب نفسه، هو تعبيره الخاص الذي يتخلق في أتون تجربته الخاصة أو رؤيته الذاتية للظواهر والأشياء، فإن فصله عن صاحبه قد يقود إلى نتائج ما خطرت على بال الأديب أو الفنان. بل إن الأمر يتضمن خطأ ما على مستوى الأنشطة الجمالية، إذ لا يمكن بحال فصل البنية التركيبية للعمل الإبداعي، عن التصاميم الواعية للأديب ومعطياته اللاواعية.
وقد مارس معظم النقاد تجربة الإبداع، وهم يعرفون جيدا كيف يتخلق العمل بعيدا، في ما يبدو للوهلة الأولى، عن صاحبه، مستقلا، يقيم بنيانه بمنطقه الخاص الذي طالما دهش لمعماره الأديب نفسه، هذا حق، وحق كذلك أن التخلق لا يمكنه إلا أن يتدفق بين ضفتين لا يند عنهما: خبرات الأديب، وتوجهه التعبيري، أي أسلوبه الإبداعي ولغته المنتقاة إلى حد كبير من الوعي المسبق على مستوى النوع الأدبي والتركيب اللغوي.
وهكذا فإننا، ها هنا، يجب أن ننظر إلى المسألة من جانبيها، وأن نتجاوز خطيئة الرؤية الأحادية، فإذا كان النقد الغربي قد غاب يوما في طيات حياة الأديب وخبراته بعيدا عن النص نفسه، وانفصل يوما آخر عن الإنسان المبدع لكي يغيب في المفردات اللغوية والإشارات الدلالية للنص نفسه، فإن الحق يقتضي تجاوز هذا الميل ذات اليمين وذات الشمال، والتحقق بالموقع الوسطي الموضوعي الشامل الذي يتعامل مع الإنسان ومعطياته، أي مع الأديب ونصه على قدر سواء.
فما دام النص تعبيرا عن صاحبه فإن التكوين النفسي والاجتماعي للأديب، وانتماءه العقدي، وحصيلته المعرفية، ومأثوراته البيئية ومحمولاته الوراثية ستجد نفسها بالضرورة منسربة هنا وهناك في نسيج إبداعه، موغلة في شبكة مفرداته وجمله وتعابيره. ومن ثم فإن إضاءة العمل النقدي لخلفيات الأديب النفسية والاجتماعية والمعرفية والعقدية والبيئية والوراثية، تعد ضرورية لفهم العمل الإبداعي وإدراك أبعاده ومضامينه، تماما كما أن فصل النص عن هذا كله، من جهة أخرى، والتوغل في متابعة ما تريد مفرداته ووحداته في تقابلاتها وتضاداتها أن تقوله يعد ضروريا كذلك.
فما الذي يمنع من اعتماد المنهجين معا لتحقيق نتائج أفضل للممارسة النقدية؟ وما الذي يرغم النقد على الأخذ بأحدهما والضرب بالآخر عُرْضَ الحائط ما دام قد تبين لكل ذي نظر أنه، في العلوم الإنسانية على الأقل، ليس ثمة حقيقة نهائية، ولا علم مقفل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما دام رواد المناهج والنظريات الجديدة وتلامذتهم ما يلبثون بعد زمن قصير فحسب أن يعيدوا النظر في معطياتهم لكي يغيروها أو ينقلبوا عليها؟!
وها هي البنيوية في موطنها الأول فرنسا تعلمنا هذه الحقيقة، كما علمتنا إياها من قبل في الفرويدية والوجودية وغيرهما؛ إنها الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهان الخصوم والمعجبين على السواء[40].
4. إضافات السيميائية
لتكتمل الأطاريح على الصورة التي ارتأينا أن نيمم وجوهنا شطرها، بحثا عن الخطاب الفني المستوفى ينبغي أن نعترف أن "لا وجود لسيميائيات للعلامة دون سيميائيات للخطاب. إن نظرية للعلامة كوحدة (كذا!) معزولة ستكون عاجزة على شرح الاستعمال الجمالي للعلامات، ولهذا فإن سيميائيات للفن يجب أن تكون بالضرورة سيميائيات للخطاب والنص[41] والسياق في هذه الحالة، وفي جميع الحالات أيضا، هو إشارة إلى مفهوم العلاقة ذاته.
ثم إن مفهوم الدلالة ذاته لا يمكن أن يتأسس باعتباره المنظومة التي تمنح للسلوك الإنساني معنى إلا استنادا إلى وجود رابط، أي وجود علاقة تجعل من الغياب فعلا للحضور. فالنفي ليس إلغاء لشيء آخر، بل هو تأكيد لحضور شيء ما ليس باديا من خلال الطرف المتحقق، فالانطلاق من الخير لإثبات الشر ليس نفيا للخير بقدر ما هو تأكيد لوجود شبكة علائقية يستند إليها الخطاب من أجل توزيع سياقاته، أي إنتاج مضامينه المتعددة.
وعلى هذا الأساس، يجب النظر إلى التدليل باعتباره شبكة كبيرة من العلاقات، وتشكل هذه الشبكة، في ذات الوقت، سلسلة من الإكراهات المفروضة على المعنى، فهي ما يحدد شكل وجوده، وطرق انتشاره، وربما نمط استهلاكه أيضا، وكل محاولة لتحديد حجم المعنى وسمكه يجب أن تمر بالضرورة عبر إعادة بناء هذه الشبكة العلائقية، وكل قراءة هي في واقع الأمر محاولة لإعادة بناء النص من خلال إعادة بناء قصديته، وفق سياقات ليست مرئية من خلال التجلي المباشر للنص.
من هنا فإن المعنى، باعتباره شبكة علائقية، يعد الأساس الذي ينبني عليه "نسق العلامات"، ولن تكون العلامة، تبعا لذلك، سوى معنى منتشر يُفترض في الإجراء التحليلي أن يقوم بإعادة بناء منطقه الداخلي، لنتصور حالة نص يتطور في اتجاهات متعددة ويقدم، مع ذلك، إمكان وصف وتحديد تخومه.
إن السيميائيات ليست علما للعلامات، إنها الدراسة الممكنة لمفاصل المعنى. فالسميائية لا يمكن أن تكون تدبيرا لشأن خاص بعلامة مفردة، ولا علما لعلامات معزولة. بل هي طريقة في رصد المعنى وتحديد مظانه، إنها أيضا طريقة في الكشف عن حالات تمنعه وممانعته. ولهذا فالسيميائية ليست تعيينا لشيء سابق في الوجود، ولا رصدا لمعنى واحد ووحيد، إنها على العكس من ذلك إنتاج، والإنتاج معناه الخروج من الدائرة الضيقة للوصف "الموضوعي"، إلى ما يحيل على التأويل باعتباره سلسلة من الإحالات المتتالية المنشئة لسياقاتها الخاصة.
إن السيمياء مطاردة للمعنى لا ترحم، فبقدر ما يتمنع المعنى، تتشعب مسارات السميائية وتتعقد شبكتها وتكبر لذتها وحجم التأويل، فيزداد كثافة وتماسكا ويؤدي إلى عدول دلالي يستعصي على الحصر؛ إذا جاز أن نفيد من أمبيرتو إيكو.
أما إذا كانت القواعد معروفة منذ البداية، ففي هذه الحالة يكون المعنى واجهة مفتوحة بلا خبايا ولا أسرار. وهذا ما يشكل صلب القضايا الخاصة بالدلالة وسبل الكشف عنها. فمن جهة، لا يمكن الحديث عن الدلالة إلا من خلال علاقة هي ذاتها بؤرة لسيرورة لا معطى مكتف بذاته، ولا يمكن للدلالة، من جهة ثانية أن تقف عند حدود التعيين المباشر للمراجع المادية. فالتوسط بين الإنسان وعالمه حالة مسلم بها، ولا يمكن للإنسان أن يعي ذاته ومحيطه خارج الأشكال الرمزية التي تصوغ مجمل حالات إدراكه. إلا أن وقوف العلامة عند حدود ما يعين ويصف أمر مناف لطبيعة المعنى ولطبيعة الحياة ذاتها. فالرغبة في خلق "محميات دلالية" نُهْرَعُ إليها كلما حاصرتنا الحياة بإكراهاتها النفعية أمر طبيعي، بل ضروري ضرورة الفن ذاته. لذلك كانت العلامة أيضا مهدا لدلالات من طبيعة خاصة نطلق عليها الدلالات الإيحائية أو المعاني الثانية.
وليس غريبا أن تتطور، انطلاقا من مقترحات بورس، مثلا، مجموعة من التصورات التي جعلت من السيميائيات في المقام الأول نظرية في التأويل (انظر كتابات أمبيرتو إيكو الأخيرة). بل إن هناك من نظر إلى هذه السيميائيات باعتبارها اللبنة الأولى التي استندت إليها التفكيكية في بناء تصورها للدلالة. فأن تكون السيمياء حركة لا متناهية من الإحالات، فهذا معناه أن العلامة بمجرد ما تتلخص من قصدية محفل التلفظ، فإنها تنشر خيوطها في كل الاتجاهات، وحينها تكون كل السياقات محتملة، وتكون كل الدلالات ممكنة.
ولقد أبدى دريدا إعجابا كبيرا بفكرة الإحالات التي لا تنتهي عند حد كما تصور ذلك بورس. فبورس في تصور دريدا "ذهب بعيدا في الاتجاه الذي يطلق عليه تفكيكية المدلول المتعالي. فهذا المدلول سيقوم، في لحظة ما، بوضع حد نهائي للإحالة من علامة إلى أخرى. إن الأمر يتعلق هنا بشيء مثل التمركز الذاتي، وما وراء الحضور المجسد في الرغبة القوية والنسقية التي لا يمكن كبح جماحها. والحال أن بورس كان يعتبر لامحدودية الإحالة معيارا يدلنا على وجود نسق من العلامات. فما يطلق العنان للدلالة هو نفسه ما يجعل توقفها أمرا مستحيلا. فالشيء ذاته علامة"[42].
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه النبرة المتحمسة لفعل تدليلي لا يتوقف عند حد بعينه مصدرها تصور آخر، ولا علاقة لها بالسيميائيات؛ فهي مبدأ بشرت به التفكيكية ودعت إلى تطبيقه في تحليل الوقائع الإنسانية. وعلى هذا الأساس، فإن ما تدعو إليه السيميائيات شيء مخالف لهذا التصور. فعلى عكس التفكيكية، التي لا ترى أي جدوى من التوقف عند مدلول بعينه، فإن السيميائيات تعتقد أن كل عمل تأويلي يأتي بمعلومة جديدة تغني المعرفة التي تختزنها العلامة في تحققها البدئي.
وبعبارة أخرى، إنها تحيل على اختيار يقود إلى خلق سلسلة من المسارات الداخلية التي تقيم روابط فعلية أو ضمنية بين ما هو متحقق وبين ما يحال عليه من خلال السيرورات التأويلية المتنوعة. فالسيمياء بطبيعتها اللامتناهية تقود المؤول إلى ترجمة علامة في علامة أخرى ضمن سيرورة تلغي من حسابها مقولة المرجع بوصفه حدا ماديا، لكي تستحضر نص الثقافة الذي يعد العنصر الوحيد الذي يمكننا من إرساء نقطة نهائية ضمن تدفق دلالي لا ينتهي نظريا عند حد بعينه.
ولقد كانت مقولة المؤول، كما تصورها بورس وحدد حقولها واشتغالها، مقولة هامة في تحديد حيوية التأويل وحركية السيورة التدليلية. ففي كل إحالة نكون، في واقع الأمر، نؤسس لبدايات سيرورة تأويلية جديدة، فالعلامة مستودع لعدد هائل من الوحدات الثقافية القابلة للتحقق ضمن سياقات متنوعة، لا إحالات سرطانية تنفي الروابط بين المنطلق ونهاية الرحلة[43].
معالم منهج الدراسة المصطلحية
قبيل الإشارة إلى القيمة العلمية للمصطلح رأسا، فإن دواعي الاشتغال عليه إشكالان رئيسان:
أولهما الفوضى المصطلحية في كل مجالات الفنون والآداب والثقافات.
وثانيهما رفد الدراسة المصطلحية الدراسة الأسلوبية بما هي أهله.
وبهذه الاعتبارات يُرى لأهل النظر كيف "يتصف المعنى الاصطلاحي بشيء من الخصوصية، ويجب من ثم أن يكون واضحا دقيقا، ودالا على معنى واحد غير متعدد"[44]. فـ"لابد أن يكون المصطلح بدلالة واضحة وواحدة في داخل التخصص الواحد"[45].
ثم "إن الاضطراب في استخدام المصطلحات، في أي فن أو صناعة، ليس بالأمر الهين الذي يمكن أن يقال عنه إنه لا يضر، فإن لم يكن من ضرر سوى إهدار الجهد في معرفة العديد من المصطلحات المترادفة على قسم واحد من أنواع الفن لكفى، فكيف والانشغال به يحول دون التعمق في أسرار الخطاب"[46]؟
من أجل ذلك، ندعو إلى مخاصمة الفوضى المصطلحية في كل فن على حدته، ولن يتأتى ذلك إلا بتراكم المنجز بوساطة العمل المؤسسي، والتوافق التداولي الموجد، المكسب للشرعية.
وحتى يمكن الإسهام ولو بجهد المقل نشير إلى أن للمنهج في الدراسة المصطلحية مفهومَيْن:
مفهوم عام ومفهوم خاص.
فالمنهج بالمفهوم العام، هو طريقة البحث المهيمنة المؤطرة للمجهود البحثي المصطلحي كله، القائمة على رؤية معينة في التحليل والتعليل والهدف. وهذا الذي يوصف بالوصفي أو التاريخي أو ما أشبه، تميزا له عن غيره.
والمنهج بالمفهوم الخاص، هو طريقة البحث المفصلة المطبقة على كل مصطلح من المصطلحات المدروسة، في إطار منهج من مناهج الدراسة المصطلحية بالمفهوم العام. وهذا الذي يـمكن تلخيص معالمه الكبرى بإيجاز شديد، منذ الشروع فيه حتى الفراغ منه، في خمسة أركان/مطالب:
الإحصاء
ويقصد به الاستقراء التام لكل النصوص التي ورد بها المصطلح المدروس، وما يتصل به، لفظا ومفهوما وقضية، في المتن المدروس، وذلك يعني:
ـ إحصاء لفظ المصطلح إحصاء تاما، حيثما ورد، وكيفما ورد، وبأي معنى ورد، في المتن المدروس، ما دام قدر من الاصطلاحية في مجاله العلمي الخاص، ملحوظا فيه؛ فالمصطلح مفردا أو مجموعا، معرفا أو منكرا، اسما أو فعلا، مضموما إلى غيره أو مضموما إليه غيره، كل ذلك ضروري المراعاة عند الإحصاء.
ـ إحصاء الألفاظ الاصطلاحية المشتقة من جذره اللغوي والمفهومي إحصاء تاما كذلك، على التفصيل نفسه.
ـ إحصاء التراكيب التي ورد بها مفهوم المصطلح أو بعضه دون لفظه إحصاء تاما كذلك.
ـ إحصاء القضايا العلمية المندرجة تحت مفهومه، وإن لم يرد بها لفظه.
حتى إذا استخلصت النصوص، وصنفت حسب حاجة الدراسة، التصنيف الأولي، أمكن الانتقال إلى الركن/المطلب التالي.
الدراسة المعجمية
ويقصد بها دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللغوية فالاصطلاحية، دراسة تبتدئ من أقدمها مسجلة أهم ما فيه، وتنتهي بأحدثها مسجلة أهم ما أضاف، دراسة تضع نصب عينيها علام مدار المادة اللغوية للمصطلح، ومن أي المعاني اللغوية أخذ المصطلح، وبأي شروح شرح المصطلح. وذلك لتمهيد الطريق إلى فقه المصطلح وتذوقه، وليسهل تصحيح الأخطاء التي قد يكون جلبها الإحصاء.
الدراسة النصية
ويقصد بها دراسة المصطلح وما يتصل به، في جميع النصوص التي أحصيت من قبل، بهدف تعريفه، واستخلاص كل ما يسهم في تجلية مفهومه؛ من صفات وعلاقات، وضمائم، وغير ذلك.
وهذا الركن هو عمود منهج الدراسة المصطلحية: يمهد له ما قبله، ويستمد منه ما بعده؛ إذا أحسن فيه بوركت النتائج وزكت الثمار، وإذا أسيء فيه، لم تفض الدراسة إلى شيء يذكر. ومدار الإحسان فيه على الفهم السليم العميق للمصطلح في كل نص، والاستنباط الصحيح الدقيق لكل ما يمكن استنباطه مما يتعلق بالمصطلح في كل نص.
فالنصوص، ها هنا، هي المادة الخام التي يجب أن تعالج داخل مختبر التحليلات، بكل الأدوات والإمكانات، لتقطر منها المعلومات المصطلحية تقطيرا، وتستخرج استخراجا؛ فمعطيات الإحصاء، ومعطيات المعاجم، ومعطيات تحليل الخطاب المقالية والمقامية معا، ومعطيات المعارف داخل التخصص وخارجه، ومعطيات المنهج الخاص والعام، النظري والعملي كل أولئك ضروري المراعاة عند التفهم، وكل ذلك مما به يتمكن من المفهوم وما يجليه.
الدراسة المفهومية
ويقصد بها دراسة النتائج التي فُهمت واستخلصت من نصوص المصطلح وما يتصل به، وتصنيفها تصنيفا مفهوميا يجلي "خلاصة التصور المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس في المتن المدروس؛ من تعريف له يحدده؛ بتضمنه كل العناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم، وصفات له تخصه كالتصنيف في الجهاز، والموقع في النسق، والضيق أو الاتساع في المحتوى، والقوة أو الضعف في الاصطلاحية، والنعوت أو العيوب التي ينعت بها أو يعاب. وعلاقات له تربطه بغيره كالمرادفات والأضداد وما إليها، والأصول والفروع وما إليها، وضمائم إليه تكثر نسله وتحدد توجهات نموه الداخلي، كضمائم الإضافات والأوصاف، ومشتقات حوله من مادته تحمي ظهره، وتبين امتدادات نموه الخارجي. وقضايا ترتبط به أو يرتبط بها، مما لا يمكن التمكن منه إلا بعد التمكن منها؛ كالأسباب والنتائج، والمصادر والمظاهر، والشروط والموانع، والمجالات والمراتب، والأنواع والوظائف، والتأثر والتأثير، وغير ذلك مما قد يستلزمه تفهم مفهوم، ولا يستلزمه تفهم آخر. وهذه الشجرة المفهومية الوارفة الظلال، الزكية الغلال، في أغلب الأحوال، هي التي يجب أن تجلى بعرضها في الركن/المطلب الخامس على أحسن حال"[47].
العرض المصطلحي
ويقصد به الكيفية التي ينبغي أن تعرض وتحرر عليها خلاصة الدراسة المصطلحية للمصطلح ونتائجها. وهو الركن الوحيد الذي يرى بعينه لا بأثره. وجماع القول فيه حسب ما انتهت إليه التجربة أن يكون متضمنا للعناصر الكبرى التالية على الترتيب:
المشتقات
وتتضمن كل لفظ اصطلاحي ينتمي لغويا ومفهوميا إلى الجذر الذي ينتمي إليه المصطلح المدروس؛ كالمجتهد مع الاجتهاد، والبليغ مع البلاغة، ولا يدخل فيها المنتمي لغويا فقط؛ كالإنفاق مع النفاق، ولا المنتمي مفهوميا فقط كالقصيدة مع الشعر. إذ محل هذه العلاقات والمصطلح بمشتقاته من حوله، ينمو ويمتد مفهوميا من خارجه، وأشكال المشتقات وصورها مشهورة في باب الصرف.
فإذا فرغ من المشتقات بدئ بالمفهوم.
المفهوم
ويتضمن المعنى اللغوي، ولاسيما الذي يترجح أن منه أخذ المعنى الاصطلاحي والمعنى الاصطلاحي العام في الاختصاص، ولاسيما الأقرب إلى مفهوم المصطلح المدروس، ومفهوم المصطلح المدروس معبرا عنه بأدق لفظ، وأوضحه وأجمعه ما أمكن، وشرطه المطابقة للمصطلح، وضابطه أنه لو وضعت عبارة المفهوم مكان المصطلح المعرف في الكلام لانسجم الكلام؛ وإنما ينضبط ذلك إذا راعى الدارس في تعريف المفهوم كل العناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم، المستفادة من جميع نصوص المصطلح وما يتعلق به في المتن المدروس؛ فلا تبقى خاصية دون إظهار، ولا ميّزة دون اعتبار.
وللتأكد من صحة المفهوم وزيادة بيانه، يحلل بالتفصيل المناسب إلى كل عناصره. ومع كل مقال مثال، وإنما يتضح ذاك بهذا.
فإذا تم تحديد المفهوم، وهو اللب والنواة والسداة، بدأ الحديث عن الصفات، وهي اللحمة والكسوة.
الصفات
وتتضمن:
- الصفات المصنفة: وهي الخصائص التي تحدد طبيعة وجود المصطلح في الجهاز المصطلحي موضوع الدراسة، كالوظيفة التي يؤديها، والموقع الذي يحتله، وغير ذلك.
- الصفات المبينة: وهي الخصائص التي تحدد درجة الاتساع أو الضيق في محتوى المصطلح، ومدى القوة أو الضعف في اصطلاحية المصطلح وغير ذلك.
- الصفات الحاكمة: وهي الصفات التي تفيد حكما على المصطلح، كالنعوت أو العيوب التي ينعت بها أو يعاب، وغير ذلك.
فإذا تمت الصفات الخاصة بالذات، بدأ الحديث عن العلاقات بغير الذات، مما يأتلف مع المصطلح ضربا من الائتلاف، أو يختلف معه ضربا من الاختلاف.
العلاقات
وتتضمن كل علاقة للمصطلح المدروس، بغيره من المصطلحات، ولاسيما العلاقات الثلاث:
- علاقات الائتلاف؛ كالترادف والتعاطف وغيرها.
- علاقات الاختلاف؛ كالتضاد والتخالف وغيرها.
- علاقات التداخل والتكامل؛ كالعموم والخصوص، والأصل والفرع، وغيرها.
فإذا ضبطت العلاقات الواصلة للمصطلح بسواه، والفاصلة له عن سواه، أمكن الانتقال إلى ما ضم إلى المصطلح، أو ضم إليه المصطلح؛ مما يكثِّر نسله المصطلحي، ويحدد توجهات نموه الداخلي كما سلفت الإشارة.
الضمائم
وتتضمن كل مركب مصطلحي (ضميمة) مكوَّن من لفظ المصطلح المدروس، مضموما إلى غيره، أو مضموما إليه غيره، لتفيد الضميمة المركب في النهاية مفهوما جديدا خاصا مقيدا، ضمن المفهوم العام المطلق، للمصطلح المدروس. فكأن المصطلح بضمائمه ينمو ويتشعب مفهوميا من داخله.
وأبرز أشكال الضمائم:
ـ ضمائم الإضافة؛ سواء أأضيف المصطلح إلى غيره، أم أضيف غيره إليه.
ـ ضمائم الوصف؛ وقد يكون فيها المصطلح واصفا أو موصوفا.
القضايا
وتتضمن: كل المسائل المستفادة من نصوص المصطلح المدروس، وما يتصل به، المرتبطة بالمصطلح، أو المرتبط بها المصطلح؛ مما لا يمكن التمكن من مفهومه حق التمكن، إلا بعد التمكن منها حق التمكن. وهي متعذرة الحصر لكثرة صورها وتنوعها من مصطلح إلى مصطلح. وأهميتها لا تكاد تقدر في التصور العام للأبعاد الموضوعية للمفهوم، ولا سيما في بعض العلوم.
ومن أصنافها، كما تقدم، الأسباب والنتائج، والمصادر والمظاهر، والشروط والموانع، والمجالات والمراتب، والأنواع والوظائف، والتأثر والتأثير.
وبالحديث عنها ينتهي الحديث عن الفرض في العرض، آخر ركن من الأركان التي بني عليها منهج الدراسة المصطلحية[48].
وتجدر الإشارة هنا إلى شدة الارتباط بين المصطلح والمفهوم والبحث الموضوعي، وهو الأمر الذي يفصح عن هذا المجهود المدرسي والمنهجي الشامل المتميز.
الخاتمة
لقد تحصل لدي بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا يحسن بأي دراسة، مهما كانت عتبتها مضمونية، أن لا تعرج على المستوى الفني والتركيبي/النحوي بألوانه المختلفة القديمة والحديثة سيان؛ ناهيك بالصوتي والدلالي والمعجمي؛ ثم الجمالي والوظيفي والرمزي. الشيء نفسه فيما يتعلق بالمستوى البلاغي والأسلوبي؛ فضلا عن الهم والاهتمام بالدلالة والمخيال والصورة والتأويل.
كما لابد من اعتدال النسب بين الفن والموضوع، أو الشكل والمضمون، أو الفنية والرسالية؛ حتى إذا جاز أن نغلب كفة على أخرى فلتكن كفة الفن الذي من دونه ليس هنالك إبداع.
أما المناهج والتقنيات فلا يتصور أن يخلو منها فن من الفنون. وإن كانت دعوتنا إلى المنهج الشامل المتكامل كما نتصوره في الألوان الإبداعية، فإن المنهج الفني يفي بالغرض إذا ما أردنا أن نعتبر البساطة في الاصطلاح، وإلا فإن المنهج المنشود يبسط ظلاله على المنهج النفسي والتاريخي والوصفي والموضوعي، فضلا عن الاستقراء والإحصاء.
ثم إنه لابد، قبل أي إحصاء، من أن يحدد الباحث مصطلحاته تحديدا دقيقا رفعا لكل التباس، وإذا لم يحترم المدلول الأصلي للمصطلح، عليه أن يشير إلى ذلك، وإلا سنجد أنفسنا أمام مصطلحات غير مفهومة.
ثم إن اللجوء إلى الإحصاء في مجال دراسة الأسلوب، وهو مجال يعتد فيه بالجودة الفنية والتأثيرات الجمالية والتلوينات العاطفية، أمر أثبت قدرته على النفاذ إلى أعماق النص، بالنظر إلى أهمية الاستعانة بالمعطيات الإحصائية، على وجه الخصوص حين يكون الدارس ممتلكا لأدواته الإجرائية في مقدرة وتخصص للتعامل مع النصوص.
نعم نفيد من معطياتنا الثقافية على وجه العموم، وفي الوقت نفسه لا يسوغ لنا أن نزهد في ما صلح في الثقافات الأخرى، خاصة ما ثبت أنه يصب في نهر الإنسانية الرحيب، حيث العوامل المشتركة، وضمان عدم الذوبان والتقليد الأعمى. فلا يجدر بنا أن ننزه المدنية الغربية كما فعل طه حسين لما قال في مستقبل الثقافة في مصر: "علينا أن نتبع "الحضارة" الغربية بحلوها ومرها، وخيرها وشرها، إن كان فيها شر". كلا!
لابد من التقويم والتمحيص لقبول ما حقه القبول، ورفض ما حقه الرفض، حتى لا نحرم من الإفادة من المشترك الإنساني، وهو كثير، وإن كان، اضطرارا، حقا علينا أن نشكل استثناء ثقافيا، فعلنا ولا حرج؛ كما يفعل كثير منهم دون أدنى عقدة من نقص.
لذلك سقنا في الصفحات السابقة مجموعا من العناصر الخاصة بالهُوية النظرية والتطبيقية، من خلال الإحالة على الأصول الفلسفية والتاريخية والمنهجية والمصطلحية، ومن خلال تحديد السيميائية، بعد الأسلوبية والبنيوية بأصنافها كافة، وطريقتها في الرصد، لتتجلى الإمكانات والإضافات التي تمدنا بها هاتيك المناهج خاتمتها السيمياء؛ من أجل تحديد أفق تصور تأويلي خاص.
وليتضح، آخر المطاف، أن السيميائية نظرية خاصة بالمعنى وليست مجرد رصد لعلامات معزولة. ولهذا فإنها وجب أن تقودنا، في كل عمل تحليلي، إلى إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة، لا مجرد الوقوف عند تحديد مكونات الواقعة المدروسة؛ ورصد تنويعاتها الممكنة.
ولقد أعطينا أمثلة واقعية على كيفية الإفادة من المناهج والتقنيات التي يحتويها المنهج الشامل المتكامل، أو المنهج الفني، فكانت المواد المشكّلة؛ النحو العربي، والبلاغة، والأدوات التحليلية العربية الخالصة، دون إقصاء للبنيوية، والسيميائية في احتراس أكيد حتى لا تأتي النتائج ضدا على المقدمات رغم أنف المنطق.
الهوامش
[1]. محمد بن إبراهيم الوزير (تـ840ﻫ) له مؤلفان أطبقت شهرتهما الآفاق: العواصم والقواصم. إيثار الحق على الخلق.
[2]. النقد الأدبي: أصوله ومناهجه. سيد قطب. د.ط أو ت. دار الشروق. ص5.
[3]. سيد قطب، النقد الأدبي: أصوله ومناهجه، د. ط، ود. ت، دار الشروق، ص5-6.
[4]. المرجع نفسه، ص6.
[5]. المرجع نفسه، ص223-224.
[6]. المرجع نفسه، ص224-225.
[7]. المرجع نفسه، ص225-226.
[8]. النحو الوافي، عباس حسن، مصر: طبعة دار المعارف، 3/437.
[9]. محمد بوحمدي وعبد الرحيم الرحموني، دراسات أسلوبية في التراث، فاس: مطبعة آنفو-برانت، المغرب، 2005م. ص124-126.
[10]. Statistics. p.11.
[11]. Statistics. p.12.
[12]. Stephen Ullman, meaning and style, Basil Blackwell, Oxford, 1973, p.67.
[13]. دراسات أسلوبية في التراث، م، س، ص117-118.
[14]. Meaning and style, p.65.
[15]. شفيع السيد، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، ص176.
[16] .N.E. Enkvist, Linguistics and style, p.72.
وانظر أيضا:
Geoffry N. Leech and Micheal H. Short, style in fiction,
A linguistic introduction to English fictional prose, third impression 1984, p.48.
[17]. عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، بيروت: المكتبة العصرية، ط1، (1422ﻫ/2001م)، ص142. الهامش 21.
[18]. سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، القاهرة: عالم الكتب، (1412ﻫ/1992م).
[19]. دراسات أسلوبية في التراث، م، س، ص121-123.
[20]. Style in fiction. p.46-47.
[21] H. G. widdowson, stylistics and the teaching literature, fourth impression, 1983, p.6.
[22]. David crystal and Derek Dary, inverstigating English style, p.12.
[23]. دراسات أسلوبية في التراث. د.محمد بوحمدي ود.عبد الرحيم الرحموني، م، س، ص123-124.
[24]. Style in fiction, p.47.
Linguistics and style, p.72.
[25]. دراسات أسلوبية في التراث، م، س، ص127-128.
[26]. إشارة إلى البنيوية والبنيوية التكوينية.
[27]. تنظر: دراسات في النقد الحديث. إعداد و ترجمة: حسن المنيعي، مكناس: مطبعة سندي/المغرب. ط1، 1995م.
[28]. للعلامة عبد الله الطيب، رحمه الله تعالى، رأي مخالف للشيخ عبد القاهر الجرجاني حول نظرية النظم، وكيف بنيت على النحو والتركيب، حيث يدعو إلى الجانب الروحي في مسألة الإعجاز.
[29]. رواه أبو داود وغيره، وجاء أيضا بلفظ آخر: "بعض البيان سحر".
[30]. الشيء نفسه يتعلق بالعنف، والانتصار له خاصة في الشاشة الأمريكية.
[31]. عصر البنيوية، التمهيد، ص6-7.
[32]. عماد الدين خليل، تأشيرات على البنيوية، مجلة المشكاة، عدد مزدوج 15-16، (محرم-جمادى الثانية 1413ﻫ/يوليوز-دجنبر 1992م)، ص131-132.
[33]. جريدة الجمهورية البغدادية. 5 حزيران 1986م.
[34]. تأشيرات على البنيوية. د.عماد الدين خليل، م، س، ص132-137.
[35]. جريدة الجمهورية. 24 حزيران 1986م.
[36]. ينظر على سبيل المثال المقالات التالية وفق تسلسلها الزمني:
النقد الأدبي الجديد بين النزعة العلمية والنزعة الإيديولوجية. سمير حجازي. جريدة الجمهورية. 1 حزيران 1986م. البنيوية والنقد الأدبي. لكاتب لم يذكر اسمه. جريدة الثورة البغدادية. 15 حزيران 1986م. حفيف اللغة واستبدادية المتعة. الناقد الأمريكي هارولد برودكي. ترجمة: سامي محمد. جريدة الجمهورية. 26 حزيران 1986م. الأفقي والعمودي في اللغة. عبد الجبار داود البصري. الجمهورية. 30 حزيران 1986م. في حضرة النص الإبداعي. عبد الهادي خضير. جريدة القادسية. تموز. 1986م. لغويات. د. مالك المطلبي. الجمهورية. 29 تموز 1986م. البحث عن منهج في النقد الأدبي. د. عبد الستار جواد. الثورة. 31 تموز 1986م. كيف تصير اللغة علما. سعيد الغانمي. الثورة. 11 آب 1986م. كيمياء القصة القصيرة: العنصر أو المركب. د. مالك المطلبي. الجمهورية. 12 آب 1986م. صراع الأنوار الأدبية. د. مالك المطلبي. الجمهورية. 19 آب 1986م.
[37]. لنتذكر على سبيل المثال نظرية (النظم) لعبد القاهر الجرجاني (ت 471 ﻫ) ومعطياته النقدية ذات التوجه البنيوي في كتابيه: (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز).
[38]. تأشيرات على البنيوية، م، س، ص137-140.
[39]. انظر مقال الدكتور مالك المطلبي: كيمياء القصة القصيرة: العنصر والمركب، جريدة الجمهورية، 12 آب 1986م.
[40]. تأشيرات على البنيوية، م، س، ص140-143.
[41]. Le signe. Umberto Eco. Ed Labor. 1984. p.25.
[42]. De la grammatologie. J.Derrida. Les éditions de Minuit. 1967. p.71.
[43]. سعيد بنكراد، السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزمن، سلسلة شرفات، 11، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2003م، ص34-37.
[44]. إدريس نقوري، المصطلح النقدي في نقد الشعر، البيضاء: دار النشر المغربية، ط1، 1982م، ص8.
[45]. محمد فهمي حجازي، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، مصر: مكتبة غريب، 1993م، ص12.
[46]. أحمد أبو زيد، بديع القرآن ومصطلحاته: تنقيح وتجديد في الترتيب، الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، ندوة علمية، الرباط: مطبعة المعارف، 1996م، ص377. بتصرف.
[47]. الشاهد البوشيخي، مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية، مطبعة آنفو-برانت، 12 شارع القادسية، الليدو-فاس، ط1، (محرم 1423ﻫ/أبريل 2002م)، ص29 – 37. بتصرف. وانظر أيضا نظرات في المصطلح والمنهج. للكاتب نفسه والسلسلة نفسها. ص22–31.
[48]. مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية، م، س، ص29-37، بتصرف.