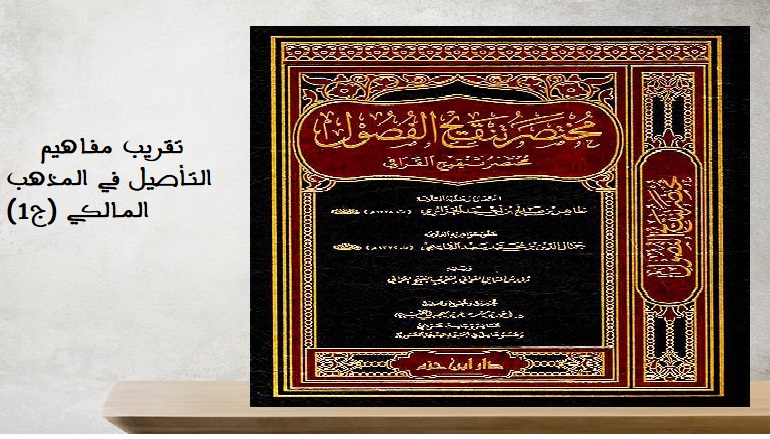من الموضوعات التي أثارها أهلُ الأصول والمقاصد منذ القديم: فكرة "المصالح والمفاسد المحضة من حيث الوجود والعدم" وما يخدمها بالتّبع من قضايا أصولية وفروع فقهية عديدة، وسيّاق ذلك عندهم أنهم حين يتحدثون عن أفعال المكلفين وما يَعْرِضُ لها من صلاح وفساد يتّفقون ابتداء على أنها محلّ لامتزاج المصالح بالمفاسد، وأن الواجب على أهل العلم حيّال ذلك نهجُ أسلوب التقريب والتغليب لدرْك أي القبيلين هو الغالب لَِيُعْتبر، وأيهما المغمور لِيُهْدر.
ولكنهم يختلفون، بعد ذلك، في فَرْضِ وجودِ أو انعدامِ المصالح والمفاسد المحضة، فكان السؤال المثار عندهم: هل ثمة أفعالٌ للمكلفين هي مصالح كلها، أو مفاسد كلها؟ فلا يخالط الأولى نزرٌ مِن فساد، ولا الثانية ذَرّةٌ من صلاح. وفي هذا الشأن تسترسل خطاباتهم تتفرّع، وتختلف آراؤهم وتتنوّع. ومَن ينظر في عمق هذا الاختلاف ويتأمل مداه يجده بالغا حدّ التعارض بل التناقض؛ وبيان ذلك أنهم انقسموا في مواقفهم تجاه هذا النوع من المصالح والمفاسد بين منكٍر لوجوده ومثبتٍ له، والمثبتون أنواع؛ فمنهم المقرُّ بكثرة الوجود، والقائلُ به على وجه الندرة، والساكتُ عن وصفه بوفرة أو قلة، لذلك تسعى هذه الدراسة لإجراء عرض مركز للاتجاهات الفقهية الكبرى من هذه المسائل:
عرض مذاهب العلماء في الموضوع
1. مذهب ابن قدامة المقدسي (توفي 620ﻫ)
يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني: "الشرع لا يَرِدُ بتحريم المصالح التي لا مضرّة فيها، بل بمشروعيتها[1]"، فَيُفهم من هذا الكلام، ومثله، إقرار الرجل بوجود المصالح المحضة، ولكنه لم يفصّل القول في نسبة هذا الوجود أكثير أم قليل؟
2.مذهب العز بن عبد السلام (توفي 660ﻫ)
عند تتبع كلام العز بن عبد السلام في شأن طرائق الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة نجده يصرّح بوجود ما هو مُتَمَحِّضٌ منها، فهو يُعَبِّرُ عنها بالمصالح والمفاسد "الخليّة"، وفي ذلك يقول: "والضابط أنه مهما ظهرت المصلحة "الخليّة" عن المفاسد يسعى في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخليّة عن المصالح يسعى في درئها، وإن التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها[2]."
غير أن العز بن عبد السلام حينما يتحدث، بالأصالة، عن طبيعة هذا الوجود نجده يؤكد على أن "المصالح الخالصة عزيزة الوجود[3]"؛ وهذا يعني تسليمه بوجود شيء من المصالح والمفاسد المحضة، إلا أنه وجودٌ نادر جدا؛ لأن أكثر أفعال العباد في الغالب تمتزج فيها المصالح والمفاسد في آن واحد، فكان الخالص منها في حكم النادر وجوده، والقاعدة أن النادر لا حكم له.
ومما يَسْتَدِلُّ به العز بن عبد السلام على ذلك أمران:
الأول: كَوْنُ المآكل، والمشارب، والمناكح، والمراكب، والمساكن... لا يتحصّل شيء منه إلا بكدٍّ ونَصَبٍ، مقترن بها، أو سابق عنها، أو لاحق بها.
والثاني: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات[4]."
3.مذهب شهاب الدين القرافي (توفي 684ﻫ)
وأما شهاب الدين القرافي فيجزم تمام الجزم بانعدام المصالح الخالصة والمفاسد المتمحّضة في الدنيا، ويستدل على ذلك بدليل من أقطع الأدلة الشرعية، ألا وهو دليل الاستقراء، حيث يقول: "استقراء الشريعة يقضي أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلّت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلّت على البعد...[5]."
ومعنى هذا المذهب أنك مهما بحثت في أفعال المكلفين، الواقعة أو المفترضة، فإنك لن تحصّل مصلحة خالصة ولا مفسدة محضة أبدًا.
4.مذهب ابن تيمية (توفي 728ﻫ):
وأما ابن تيمية فيقرّ بوجود المصالح المحضة، ولكن من غير أن يقيّد هذا الوجود بقلّة ولا كثرة، يُفهم ذلك من قوله: "والشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض، فإذا لم يكن فيه فساد، أو كان فساده مغمورا بالمصلحة، لم يحظره أبدا[6]."
5.مذهب أبي إسحاق الشاطبي (توفي 790ﻫ)
وإذا تصفّحنا كتاب الموفقات لأبي إسحاق الشاطبي وجدناه يدرس هذا الموضوع بتفصيل غير مسبوق، فيما نعلم، فهو ينظر إليه بنظرين اثنين، فيقرّر أن "المصالح المبثوثة في هذه الدار يُنظر إليها من جهتين: من جهة مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها.
فأما المنظور الأول: فإن المصالح الدنيوية، من حيث هي موجودة هنا، لا يتلخص كونها مصالح محضة... لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاقّ، قلّت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها؛ كالأكل، والشرب، واللبس، والسكنى، والركوب، والنكاح، وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكدّ وتعب.
كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود؛ إذ ما من مفسدة تفرض في الحياة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير... ويدلك على ذلك أن هذه الحياة وضعت على الامتزاج بين الطرفين، والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك، وبرهان التجربة التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص...
وأما النظر الثاني فيها: من حيث تعلق الخطاب بها شرعا، فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجلها وقع النهي[7]."
فتكون خلاصة مذهب الشاطبي النفي التام لوجود المصالح والمفاسد الدنيوية المحضة، ليكون قوله وقول القرافي في المسألة سيّان. مع تميّز الشاطبي بالنظر الثاني للموضوع واستقلاله به.
6.مذهب الطاهر ابن عاشور (توفي 1394ﻫ)
أما الطاهر بن عاشور فيقرّ بوجود المصالح والمفاسد المحضة، وفي ذلك يقول: "ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها... وهذا ظاهر في الخير الخالص والشر الخالص[8]." ثم ينبّه بعد ذلك إلى أن "النفع الخالص والضرّ الخالص وإن كانا موجودين إلا أنهما بالنسبة للنفع والضر المشوبين يعتبران عزيزين[9]."
وبذلك يوافق ابنُ عاشور مذهبَ العز بن عبد السلام القاضي بندرة وجود المصالح والمفاسد المحضة، وهو الأصل في هذا الباب عند ابن عاشور، غير أنه أصل تعرض له، عنده، اعتبارات عدّة، نعتبرها من قبيل تأملات ابن عاشر الأصولية النقدية، ومنها:
ـ الاعتبار الأول: كون ماهية الضّرر والنفع غير منضبطة في الغالب، فهي شيء نسبي يختلف حدّه وحقيقته ومستواه من شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال، فما يعدّه البعض نفعًا قد لا يعدّه آخرون كذلك، وما يعدّ ألمًا مستفحلاً عند قومٍ قد لا يخرج عن نطاق الألم المعتاد عند قوم آخرين.
ـ الاعتبار الثاني: كون الحكم بوجود الصلاح المحض والفساد الخالص يختلف من فعل الفرد إلى فعل الجماعة، وهو ما أشار إليه ابن عاشور بعد أن أورد كلام العز والشاطبي في المسألة، حيث وإياك أن تتوهم من كلامهما اليأس من وجود النفع الخالص والضرّ الخالص، فإن التعاون الواقع بين شخصين هو مصلحة لهما وليس فيه أدنى ضرّ، وإن إحراق مال أحد إضرار خالص.
على أننا لا نلزم فرض الأمرين في خصوص تعامل شخصين أو أكثر، بل إذا صورناه في فعل الشخص الواحد نستطيع أن نكثر من أمثلته، على أن بعض المضرّة قد يكون لضعفه مغفولا عنه ممن يلحقه، فذلك منزّل منزلة العدم، مثل بعض المضرّة اللاحقة القادر على الحمل الذي يناول متاعا لراكب دابة سقط منها متاعه، فإن فعله ذلك مصلحة محضة للراكب، وإن ما يعرض للمناول من العمل لا أثر له في جلب ضرّ إليه، وكأن العز تصور ذلك عزيزا؛ لأنه نظر إليه من جهة المعاملة بين شخصين[10]."
من آثار الاختلاف في الموضوع
عند مراجعة الأقوال الواردة في الموضوع، والتحقيق في الأسباب المنشئة لاختلاف أصحابها، والتطلّع إلى آثارها الفقهية، واستبصار نتائجها العملية... يمكن تحصيل النتيجتين الآتيتين:
النتيجة الأولى: عدم الحاجة إلى هذه المقدمة النظرية أصلاً
فقد دأب كثير من أهل الأصول والمقاصد بسط هذه المقدمة النظرية في مصنّفاتهم، والخوض في تفاصيلها[11]، والرّد على المخالفين فيها... دون جدّة في التناول[12]، ولا تغيير في النتائج، وكأنهم يفعلون ذلك من باب الوفاء لنهج أسلافهم الأصوليين في تناول المباحث الأصولية.
والحق أنها مسألة نظرية ليس وراءها فائدة عَمَلِيّة، ويصدق عليها ذلك الأصل الجامع الذي قرّره الشاطبي حين قال: "كل مسألة لا ينبني عليها عملٌ فالخوض فيها خوضٌ فيما لم يدلّ على استحسانه دليل شرعي[13]."
والشاهد على صحة ما نقول أن غاية ما يتحصّل من مطالعة كلام أهل الأصول والمقاصد في هذا الموضوع أمران:
ـ الأول: أن الجميع متفق على أن أفعال المكلفين قابلة لأن تكسى لباس المصالح والمفاسد في آن واحد، فتصير بذلك وعاءً يمتزج فيه القبيلان، ويتداخل فيه الوجهان. لتكون القاعدة المعوّل عليها في هذا الباب "أن اختلاط المصالح والمفاسد أمر واقع ما له من دافع." وعندئذ ما ينبغي أن تكون هذه نهاية البحث، بل الواجب عندئذ تعيين الجهة الراجحة من الجهة المرجوحة، ولا يكون ذلك إلا وفق قواعد الترجيح المبثوثة أصولها في رحاب هذه الشريعة الغراء، وليس بحسب حكم الاعتياد الكسبي كما يُفهم من ظاهر كلام الشاطبي.
ـ الثاني: أنه اختلاف يغلب عليه قدر كبير من طابع الصورية والتجريد، فلا يتحصّل من ورائه أساس فقهي يُعمل به، ولا بُعد مصلحي يُركن عند النوائب إليه، بل نعدّه وجها من وجوه تأثر الفكر الأصولي بخلفية التحسين والتقبيح العقلي، ونجزم بأن هذه القضية الجزئية النظرية، على شاكلة مثيلاتها، غالبا ما يقع فيها الدّور والتسلسل، بحيث تكون نهاية البحث فيها العَوْدُُ إلى أوّلها، وبيان ذلك من ثلاثة أوجه، هي:
أ. لَوْ قَدَّرْنَا الجواب بالإيجاب، ولو على وجه الندرة، كما هو مذهب العز بن عبد السلام والطاهر بن عاشور، وأَقْرَرْنَا بوجود هذا النوع المتمحّض من المصالح والمفاسد، وسُقنا له الشواهد، وضربنا له الأمثلة، وأخرصنا المخالف، وأرضينا المؤالف... ففيم ينفع ذلك علم العالمين، وعمل العاملين؟ لأننا لم نتجاوز حدّ وصف ما هو كائن واقع (هذا صلاح محض وهذا فساد محض).
ب. وهو نتيجة لسابقه، وحاصله أن الحكم على الأفعال بالصّلاح المحض أو الفساد الخالص لا ينتج عنه، ولا يتصوّر أن ينتج؛ أي اختلاف فقهي على مستوى الأحكام الشرعية؛ لأن هذا النوع من الأوصاف "صلاحٌ محضٌ/فسادٌ محضٌ" يحمل في ثناياه أحكاما شرعية متفقا عليها، قد يكون الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الحرمة، كلّ بحسب ظروف المكلّف وأحواله، وطبيعة التكليف ومآلاته... ولنبرهن على ذلك انطلاقا من المثالين الذين ذكرهما ابن عاشور:
المثال الأول: "التعاون الواقع بين شخصين هو مصلحة لهما وليس فيه أدنى ضرّ [14]."
المثال الثاني: "وإن إحراق مال أحد إضرار خالص[15]."
فكون الأول صلاح محض والثاني فساد محض أمران ليس لهما معنى إلا مشروعية الإقدام على الأول، ووجوب الإحجام عن الثاني، فهما، إذن، قضيتان لا تقبلان الخلاف بين كُلِّ مَنْ له مُسْكَةٌ مِن عقل، فكيف بعلماء الفقه وأرباب الاجتهاد! فكان الحاصل أن لا مدخل للاجتهاد في هذا الباب.
المثال الثالث: أننا لو قدّرنا الجواب بالسّلب، ونفينا وجود المصالح والمفاسد المحضة، وجزمنا بأن كل أفعال المكلفين لابد أن تمتزج فيها المصالح بالمفاسد... فأيّة فائدة نكون قد حصّلنا، ولأي مقصد قد مهّدنا إلا أن نعود إلى القسمة الأولى التي هي محل اتفاق ووفاق، وهي القاضية بأن امتزاج الصلاح بالفساد في أفعال المكلفين أمر واقع ما له من دافع.
وعليه: يكون الأولى بالبحث والأجدر بالتتبع في هذا الباب هو تعيين المسالك الموصلة إلى معرفة ما هو صلاح وما هو فساد، وأثر العقل السليم المسلم في هذه المعرفة، وحدوده...وغيرها من المباحث الأصولية المتفرقة في بطون مصنفات الأصول والمقاصد.
النتيجة الثانية: تأويل معاني بعض هذه المذاهب بما يفسد معناها ويبشّع جمالها
والمقصود عندي بالذات مذهب الشاطبي، وبيت القصيد فيه مصطلح "مواقع الوجود"؛ فإن مراد الشاطبي منه، كما يتبين من سياق كلامه السالف ذكره، طبيعةُ المصالح والمفاسد من حيث هي مبثوثة في هذا الوجود، وكيفية تلقي عقول الناس لها، وانسياق طبائعهم معها.
وهنا مكمن الغرابة الظاهرة، غير المقصودة، للقانون الذي جاء به الشاطبي في هذا الباب، وهو قانون الترجيح بين المصالح والمفاسد، حيث يفرض عند اختلاط المصالح بالمفاسد في الفعل الواحد أن يُنْظَرَ إلى الجهة الغالبة منهما بحكم الاعتياد أولاً لدرْك الراجح منهما، وما تخرّج من ذلك النظر هو الذي يُعْرَفُ به قولُ الشارع في المسألة من حيث كونها مصلحة أو مفسدة شرعا.
ومعلوم أن أنظار الناس تختلف في تقدير ما هو صلاح وما هو فساد، فيكون اختلافها في معرفة الراجح منهما، عند التمازج، أبين وأظهر!
وكيف تعدّ التصورات العرفية ميزانا للتصرفات الشرعية، مع أن الشرائع ما جاءت إلا لتطويع النفوس، وقهر الشهوات، وإصلاح فاسد العادات!؟
وهل يُعْقَلُ أن تَفُوتَ الشاطبي ذاته مثل هذه المعاني، وهو رائد علم المقاصد، وعَلَمُ علمائها، وصاحب المؤلفات الشهيرة فيها، وبخاصة كتابيه "الموافقات" و"الاعتصام"، فإنهما موضوعان بالأصالة لدفع مثل هذه الأوهام والبدع، ومن تطلّل على ما فيهما من المعاني يجدهما طافحين بالتنبيه على ما نقول![16].
فما مراد أبي إسحاق الشاطبي من ذلك؟ وما هي الأبعاد المقاصدية التي كان يروم تحقيقها منه؟
توضيح المقال ورفع الإشكال
لعل من قبيل التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي أنه بنى نظريته لهذا الموضوع على ثنائية التناول؛ إذ المصالح المبثوثة في هذه الدار يُنظر إليها، عنده، بنظرَين اثنين، من جهة مواقعها في الوجود أولاً، ثم من جهة تعلق خطاب الشرع بها ثانيًا.
1.بيان النظر الأول
وممّا يستفاد من هذا النظر عند الشاطبي أن المصالح والمفاسد بأوصافها التي هي عليها في ظاهر هذه الحياة الدنيا لا يتحصّل في نظر العقلاء أن تكون محضةً أبدًا، بل لابد في كل مصلحة جاريّة أو متوقعة، توقعا راجحًا أو مظنونًا، أن تُسبق أو تُقرن أو تُتبع بنوع من الآلام والأتعاب والمشقات، كما أن كل مفسدة لابد أن تُسبق أو تقرن أو تتبع بنوع من الملذّات والأفراح والمسرّات. ولما كان الأمر كذلك وجب تعيين الجهة الغالبة من الجهة المغلوبة بحسب مواقعها في هذا الوجود، لِنَمِيزَ بعد ذلك المرغوب فيه من المهروب عنه. فيكون المراد بعبارة (مواقع الوجود) "ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير الخروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع[17]" حسب تعبير الشاطبي نفسه؛ وقصده من ذلك: النظرُ في أحوال المصالح والمفاسد من حيث وجودها الأصلي في هذه الدار، وما هي عليه ذاتيا، دون استصحاب نظر الشرع فيها.
2.بيان الصلة بين النظر الثاني والأول
وأما النظر الثاني في أمر المصالح والمفاسد عند الشاطبي فهو من جهة تعلق خطاب الشرع بها، وهذا النظر، عنده، مبناهُ وقوامهُ على النظر الأول؛ إذْ لَمَّا كانت أفعال المكلفين في هذه الدار ممتزجة الصّلاح بالفساد، وأنه لا يُتصوّر عقلا انفكاك إحدى الجهتين عن الأخرى، فإن الشارع قد رتّب أحكامه وفق ما يغلب من الجهتين بحكم الاعتياد، وذلك باعتبار الجهة الغالبة وإهدار الجهة المغلوبة، كأن الجهة المغلوبة في نظر الشرع حكمها العَدَمُ.
ومحاولة الشاطبي هذه تهدف بالأساس إلى إعادة النظر في حقيقة المصالح والمفاسد وما تُعرف به، وتعميق الرؤيا في المفاهيم القريبة من ذلك، وإثارة القضايا الخادمة لهذه المواضيع بقدر واسع من التحقيق والتنقيح، كما هو دأب الشاطبي دومًا، وهو بهذا النظام المقاصدي البديع إنما يسعى إلى تأسيس المصلحة على إطلاقها الثاني المتعلق بخطاب الشرع لا إطلاقها الأول، كما قد يُفهم من ظاهر كلامه؛ لأن المصالح إذا وُكلت إلى عقول الناس لم تنضبط بحال أبدًا، ولو فُرِضَ انضباطها بمجرّد العقل لكان الإنسان في غُنية عن الشرع، وذلك عين المحال.
وإذا اتضح هذا المعنى وتقرّر، فليُعلم أنه يُمثّل تصوّر الشاطبي العام للعلاقة الجدلية التي تربط مصالح الدنيا بمفاسدها، ويُقرّب تمثّله لطبيعة التجاذب والتأثير الحاصلة بين ما هو صلاح في حكم الاعتياد وما هو مصلحة في موازين الشرع.
غير أن من الناس من نظر إلى ظاهر كلام الشاطبي، وأشباهه، في الموضوع فاستشكله، وآخرون لم يحسنوا فهمَه، وفريق ثالث تعمّد تأويلَه... فتشارك جميعُهم في إفساد حقيقته وتبشيع جماله. ولقد كان من تجليات خطورة هذه القراءات القاصرة المتعجّلة، ما يلي:
ـ استسهال حدّ المصالح
حيث يوجد من يرى أن المصلحة والمفسدة لا يليق تعريفهما اصطلاحًا، بل ويتعذّر؛ لأنهما من الوضوح والبداهة بحيث يُدْركهما كل إنسان بالضرورة، لذلك تجد معناهما قائما بالنفس على درجة كبيرة من الظهور يصعب معها الكشف والبيان، وهذا الاتجاه هو الذي عبّر عنه الفخر الرازي[18] (توفي 606ﻫ) في المحصول بقوله: "والصواب عندي: أنه لا يجوز تحديدهما؛ لأنهما من أظهر ما يجده الحيّ من نفسه، ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما، وبينهما وبين غيرهما، وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو أظهر منه[19]."
ونجد من المعاصرين، المهتمّين بموضوع المصلحة، من يسلك مسلك الرازي في الموضوع، فلا يرى ضرورة ولا حاجة للتعريف بالمصلحة اصطلاحًا، بل ويحسب بذل الجهد في ذلك إهدارًا للوقت، إن لم يكن سببا في ضياع حقيقة مفهوم المصالح الشرعية! وليس لقائل هذا الكلام من حجّة إلا أن يُصِرّ على أن المصلحة هي المصلحة من حيث كونها مصلحة!؟ كأنها، عنده، أمرٌ يعرف ولا يوصف!
ففي محاولة من مصطفى زيد لرصد أول فهمٍ وتعريفٍ للمصلحة أورد خبر زيد بن ثابت[20]، في صحيح البخاري، في مسألة جمع القرآن، ثم أتبعه بقوله: "إن هذا الفهم للمصلحة والتعريف بها هما أول فهم للمصلحة وتعريف بها بعد عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وليس من شك في أن أبا بكر وعمر خاصة، والصحابة عامة، لم يكن من همّهم أن يعرّفوا المصلحة؛ إذ كان كل همّهم منصرفًا إلى تحقيقها... فالمصلحة عندهم إذًا من الوضوح بحيث لا يحتاجون إلى التعريف بها... على أن اللغويين يرون في المصلحة نفس الوضوح فلا يتكلّفون في تفسيرها وتوضيحها[21]."
ثم يخلص مصطفى زيد إلى النتيجة التالية: "فقد تكون محاولة التعريف وسيلة إلى الغموض إذا كان المعرف شديد الوضوح[22]."
قلت: إذا كانت المصلحة معنى قائما في نفوس هؤلاء الصّحب الفضلاء، يفهمونه سليقة، ويعملونه سجية، دونما تكلّف منهم ولا تعسف، فهم أهلٌ لذلك وأجدر النّاس به، وكفى بأقوالهم المأثورة وأقضيّتهم المشهورة[23] على هذا الأمر دليلا مقنعا، فقد "كان الصحابة، وهم أفقه الناس لهذه الشريعة، أكثر الناس استعمالا للمصلحة واستنادا إليها[24]."
ولكن هذا الزمان غير ذاك الزمان؛ إذ الجميع اليوم يجري وراء المصالح، ويجادل باسمها، ويتلبس بلبوسها، بمن فيهم من العلمانيين والمستشرقين والمستغربين والملحدين والمرتدين... وسائر أعداء الدين!؟ فكان الواجب حدّها بما يصونها ويضبطها.
والأخطر الأهول من ذلك كلّه أن يقول هؤلاء: قد عرضنا هذه القضية وتلك المسألة على عقولنا فوجدناه يستحسنها، فعرفنا أنها لشرع الله مناسبة، ولمحاسن معانيه ملائمة، فهي إذًا من جملة المصالح المأذون فيها شرعا... يقولون ذلك جدالا منهم وعنادا!!
ونتيجة لما سبق نؤكد على ضرورة تعريف المصلحة تعريفا اصطلاحيّاً جامعا لخواصها، مانعا لاختلاط غيرها بها، فقد يكون السكوت عن ذلك، في هذا العصر خاصة، سببا في تطاول الألسنة على حرمات الشرع بالتقوّل والافتراء، بل ذلك ما حصل مع وجود هذا الكمّ من التعريفات التي أعطيت للمصلحة[25]، فكيف مع تصوّر غيابها!؟
ـ التعويل على أحكام الاعتياد وفَرْطِ التجارب في دَرْْك المصالح
ومن مزالق هذه القراءات القاصرة أن قوما ادّعوا دَرْك مقاصد الشارع في الوقائع والنوازل بحكم الاعتياد وفرْط التجارب، بل ويحتجون لنصرة رأيهم هذا بظواهر من كلام أئمة المقاصد كأبي زيد الدبوسي[26]، وسيف الدين الآمدي[27]، وأبي إسحاق الشاطبي[28]، وغيرهم، وتحايلا منهم يتعمّدون إيراد تلك الأقوال منزوعة السياق، محذوفة المثال، عاريّة البيان.
وليست التجارب كمصدر لمعرفة مقاصد الشارع بالشيء الغريب عن الفقه الإسلامي وأهله، فكثيرا ما كان، ولا يزال، أهل العلم يعوّلون في معرفة صلاح أو فساد ما يَعْرض لهم، أو يُعْرَض عليهم، من أحوال الوقائع غرائب النازل على التجربة، أو حتى عند الترجيح بين ما يتحيّرون فيه بين الإقدام عليه لما فيه من صلاح أو الإحجام عنه لما يكتنفه من فساده، وسواء كانت تلك التجارب المعوّل عليها تجاربهم الشخصية أو تجارب غيرهم من أهل العلم والفضل، فالتجربة "هي التي اعتمدها الشاطبي حينما جعل من مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة النظر إلى النتائج؛ أو ما يسميه هو بالمسببات[29]."
والذي ننبّه إليه ونؤكد عليه في هذا الموضع، هو ضرورة تحديد مفهوم (التجارب) بغية أن لا تختلط بالأوهام المخيلة والدعوات الباطلة، فالتجارب المعتدّ بها عند أهل العلم تشمل نتائج جميع صنوف العلوم المعاصرة الموثوق بها، مع ضرورة الاستعانة بأهلها الأكفاء المخلصين، يقول الدكتور أحمد الريسوني: "... كذلك الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، كل ما تكشفه وتثبته بوسائل علمية وإحصائية فيجب أن نعتمده لمعرفة مقاصد الشريعة... فمقاصد الشريعة تحتاج إلى توسيع مسالكها بالوسائل المنهجية للكشف عنها، دون أن نفتح المجال لكل من أراد أن يقول في مقاصد الشريعة ويقصدها بما يشاء[30]."
ومما يدخل في مسمّى التجارب على سبيل التمثيل لا الحصر:
- التعويل على وسائل الإثبات المعاصرة الموثوق بها علميا في إلحاق الأنساب، وإثبات الجرائم، وتخليّة سبيل الأبرياء...
- ومثال ذلك أيضا اعتماد تجربة أهل الطب المعاصر في تحديد أقصى وأدنى مدة الحمل، على الأقل للخروج من اختلاف الفقهاء القديم القاضي بأن أقصى مدة الحمل سنتين عند الحنفية، وأربع سنوات عند الشافعية والحنابلة، وخمس عند المالكية، بل روي عندهم: سبع سنوات! اعتمادا على أقوال مروية عن بعض النساء[31].
- ومن ذلك ما قاله جماعة من الفقهاء أن الولد يمكن أن ينسب إلى أبوين رجلين، وبعضهم قال: ينسب إلى ثلاثة إذا ادعوا نسبه، أو ألحقه بهم القافة (الخبراء الذين يحكمون بالشبه) خلافا لمذهب الشافعي... وهذا كله مرفوض بمنطق العلم الحديث ومسلّماته التي دلّت عليها الملاحظة، والتجربة، وآلات الاختبار، والتصوير، وغيرها[32].
ـ الاحتكام إلى خالص العقل في العمل المصلحي
إن للعقل، عندنا معاشر المسلمين، في التشريع الإسلامي مكانة عالية ومنزلة سامية، ومما يشهد لأصالة هذا المبدأ (الاستقراء التام)، فمن يستقري نصوص الشريعة، قرآنا وسنة، يجدها كثيرة التنبيه على أمرين هما:
الأول: التأكيد على ضرورة تسخير العقل وإعماله فيما يجلب معاني الصلاح.
والثاني: التشديد على مسؤولية تعطيله وإهماله.
وقد بحث الباحثون في كتاب الله تعالى، ونظر الناظرون في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن أيّة إدانة موجهة إلى العقل تسوّغ التوجّس منه، أو التردّد في إعماله، أو التبخيس من شأنه ومَقَامِه... فلم يجدوا فيهما غير مقام المدح والتمجيد والتّبجيل، والرّفعة والتّزكية والتّجميل.
وإذا كان من طبائع العقل الإنساني استرسالُهُ في مواضيع المعرفة، وسرحُهُ في متاهات النظر، فواجب المسلم ألا يتعدى بعقله حدودَه في درك المصالح والمفاسد، وذلك الذي استشعره جمهور الأصوليين والفقهاء، فحفظوا للعقل منزلته ومكانته، وما تجاوزوا به حدّه ومَسْرحه. غير أن أقواما من المتفيهقة اغتروا بقدرات العقل الإنساني في معرفة ما هو صالح وما هو فاسد، فنصبوه إماماً وحظّه في القسمة أن يكون مأموما، وجعلوه متبوعًا وحقه أن يكون تابعا، فلا يزن إلا بموازين الشرع، ولا ينظر إلا من خلف أستاره.
وليس فيما ذكرناه تعارض ولا تناقض؛ لأن دعوة الإسلام إلى إعمال العقول هي على مستويين اثنين هما:
المستوى الأول: دعوة للاهتداء
وهي دعوة عامة لكل العقول من أجل الاهتداء إلى حقيقة الوجود والمصير، ومعرفة عظيم قدرة خالق الإنسان مدبّر الأكوان، كما في قوله تعالى: ﴿قل سيروا في الاَرض فانظروا كيف بدأ الخلق﴾ (العنكبوت: 20).
المستوى الثاني: دعوة للاجتهاد
وهذه دعوة خاصة إلى أهل الاجتهاد دون غيرهم، فلا تشمل كل عقل، وإنما العقل السليم المسلم المجتهد، وهو العقل الخالي من كل أعراض المرض النفسي والعقلي، المترفّع عن الأخذ بالأوهام والأباطيل، المتسيّد على الهوى، المسلّم لدين ربه، الوقّاف عند حدود شِرْعته، اليقظ الناظر المجتهد، وإلا فإن "الرأي لا قيمة لأحكامه إذا لم يكن رأيا مسلما؛ أي إنسانيا بالمعنى الصحيح للكلمة؛ أي مجردا عن الأهواء والشهوات التي تنشأ عن الفساد في الأرض، والتي تتنافى مع المقصد الشرعي العام في الصلاح والإصلاح[33]."
وتقييد العقول بالسليمة إنما هو لإخراج مدركات العقول المعلولة والشاذة التي تغيّر نمطها عن أصله الأول، فتكدّر صفوها ونقاؤها، وانطفت أنوارها، وضاعت جودتها. وتقييد العقول بالمُسلمة لإخراج العقول التي تدين بغير دين الحنيفية السمحة، فإن من يزن المصالح والمفاسد بغير ميزان شريعة الإسلام فقد حكم بغير ما أراد الرحمان؛ لأن الدين عند الله الإسلام: ﴿ومن يبتغ غير الاِسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الاَخرة من الخاسرين﴾ (ءال عمران: 84) وتقييد هذه العقول بالمجتهدة لإخراج العقول الجاهلة والجامدة والمقلّدة والبليدة، لأنها دوما عن إدراك المصالح بعيدة.
من نتائج البحث وخلاصاته
لقد كان من نتائج هذا البحث المتواضع ما يلي:
ـ المصلحة في الفقه الإسلامي إما أن تكون خالصة من كل فساد أو مخلوطة بشيء منه، وليس هذا محلا للبحث مجديا وما ينبغي أن يتّخذ كذلك.
ـ عند تمازج المصالح بالمفاسد يتعيّن شرعا معرفة الجهة الغالبة من الجهة المغلوبة، وإدراك وجوه التقريب والتغليب يكون وفق قواعد وضوابط خاصة يلزم أهل الاجتهاد مراعاتها، والفزع إليهم دون سواهم في شأنها.
ـ إن لمفهوم "المصلحة" من السّعة والسّلاسة ما يجعله يصدق أحيانا على ما يوافق مقاصد الشريعة، وأحيانا أخرى على ما يطابق جذبات الأهواء ورسوم الاستحلاء، فوجب التثبت في إطلاق لفظ "المصلحة" ومراعاة سياقات وروده، فإنه حمّال لمعاني متقابلة متناقضة.
ـ ليست التجارب كمصدر لمعرفة مقاصد الشارع بالشيء الغريب عن الفقه الإسلامي وأهله، وإنما الواجب تعيين حدود ما هو من التجارب الموثوق بها من سواه.
ـ لا يجوز لقائل في الإسلام أن يقول في شيء حلّ ولا حرم ولا صلح ولا فسد إلا بدليل شرعي معتبر، ولو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحدّ الذي حدّه النقل فائدة، وذلك عين المحال.
الهوامش
[1]. ابن قدامة، المغني، 6/436.
[2]. قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1/43.
[3]. المرجع نفسه، 1/14.
[4]. انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، م، س، 1/14. والحديث رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، حديث رقم: 2823. والترمذي، كتاب صفة الجنة، حديث رقم: 2422. وأحمد في مسند المكثرين، حديث رقم: 7216.
[5]. شرح تنقيح الفصول، ص78.
[6]. تعليل الأحكام، ص377. ولعله في فتاوى ابن تيمية: 3/338-349.
[7]. الشاطبي، الموافقات، 2/339-341.
[8]. مقاصد الشريعة الإسلامية، ص69.
[9]. المرجع نفسه، ص64.
[10]. المرجع نفسه، ص64 وما بعدها.
[11]. على اختلاف في مستويات ذلك عندهم، فهم بين موجز ومقتصد ومسهب.
[12]. يستثنى من هذا الأصل نَظَرُ الإمام الشاطبي للموضوع، فقد جاء على قدر كبير من المخالفة لِمَا اعتاد الأصوليون بسطه في هذا الباب.
[13]. الموافقات، م، س، 1/42.
[14]. مقاصد الشريعة الإسلامية، م، س، ص: 64 وما بعدها.
[15]. المرجع نفسه.
[16]. من ذلك مثلا قول الشاطبي (توفي 790ﻫ): "ليس المراد بالمصلحة ما هي ملائمة لطبعه، يقصد العاقل، أو منافرة، بل ما يعتد بها الشارع، ويرتب عليها مقتضياتها." الموافقات:1/216.
[17]. الموافقات، م، س، 2/341.
[18]. هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الكبرستاني الرازي فخر الدين، المعروف بابن الخطيب، من نسل أبي بكر الصديق، ولد بالري سنة 544ﻫ وإليها نسبته، وأصله من طبرستان، فقيه وأصولي شافعي، متكلم، نظار، مفسر، أديب، ومشارك في أنواع من العلوم... وتوفي سنة 606ﻫ. (انظر وفيات الأعيان 3/381. وطبقات الشافعية الكبرى 5/33).
[19]. الفخر الرازي، المحصول، 5/158.
[20]. هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري الخزرجي، استصغره النبي، صلى الله عليه وسلم، يوم بدر فردّه، وشهد الخندق، أحد كتاب الوحي، ولد بالمدينة ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي، صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بالفرائض والقضاء والفتيا والقراءة. (انظر الاستيعاب 2/537، وأسد الغابة 2/221، والإصابة 1/561).
[21]. نجم الدين الطوفي، المصلحة في التشريع الإسلامي، ص19.
[22]. المرجع نفسه، ص21-22.
[23]. انظر: ولي الله الدهلوي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ص15 وما بعدها.
[24]. يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ص20. وقد ذكر هناك العديد من الأمثلة والشواهد.
[25]. هذه جملة من تعريفات أهل العلم للمصلحة في الاصطلاح الفني:
ـ تعريف أبي حامد الغزالي (توفي 505ﻫ)، حيث عرّفها بقوله: "نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة... وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملّة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق." المستصفى:1/216-217. وهو تعريف جامع لحقيقة المصالح الشرعية، مانع من دخول غيرها فيها.
ـ تعريف الخوارزمي[25] (توفي387ﻫ) والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق." إرشاد الفحول، ص403.
ـ تعريف نجم الدين الطوفي (توفي 716ﻫ) حيث عرّف المصلحة بأنها "السبب المؤدي إلى مقصود الشارع." نقلا عن تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي، ص278.
ـ تعريف الشاطبي: "وأعني بالمصالح: ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان، وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعما على الإطلاق." الموافقات 2/239.
[26]. كما في تعريف أبي زيد الدبوسي (توفي 430ﻫ) للمناسب بقوله: "المناسب عبارة عمّا لو عرض على العقول تلقته بالقبول." انظر: الىمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 4/237.
[27]. كما في قول سيف الدين الآمدي (توفي631ﻫ) مثلا: "الأصل تنزيل التصرفات الشرعية على وزّان التصرفات العرفية." الإحكام في أصول الأحكام، 3/233.
[28]. كما في قوله مثلا: "فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجلها وقع النهي." الموافقات: 2/339-341.
[29]. عبد الجبار الرفاعي، مقاصد الشريعة، ص201.
[30]. المرجع نفسه، ص201-202.
[31]. انظر: يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص124.
[32]. المرجع نفسه، ص125.
[33]. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص47