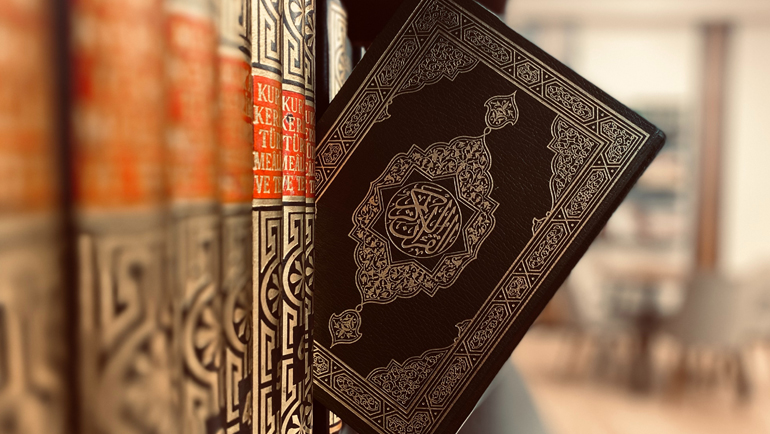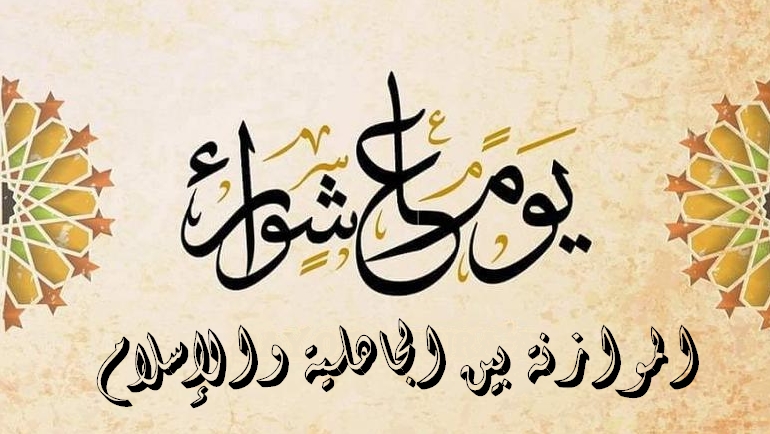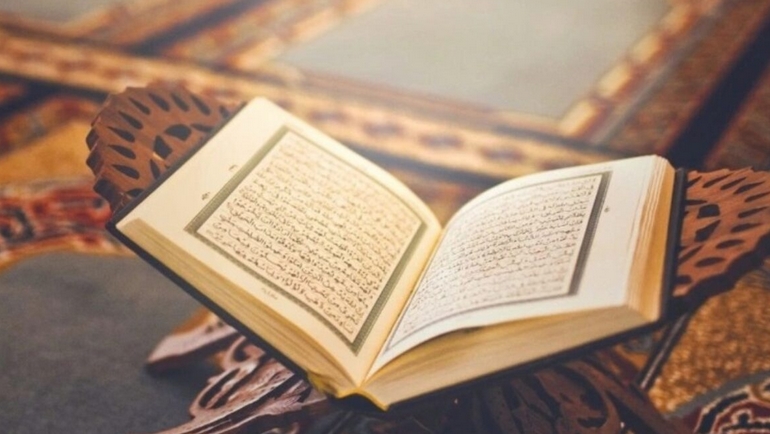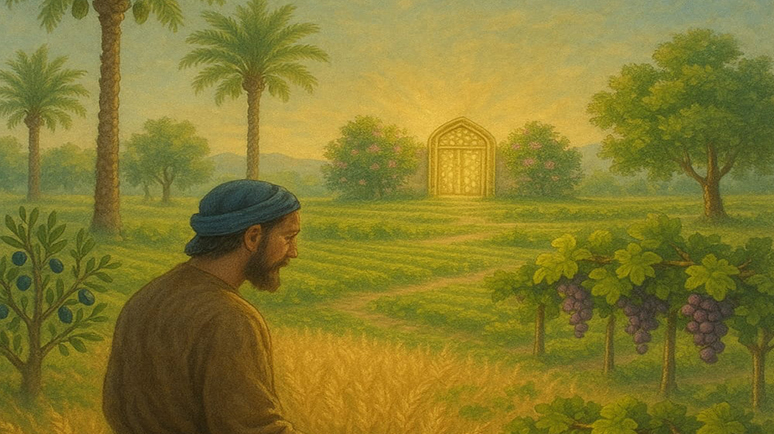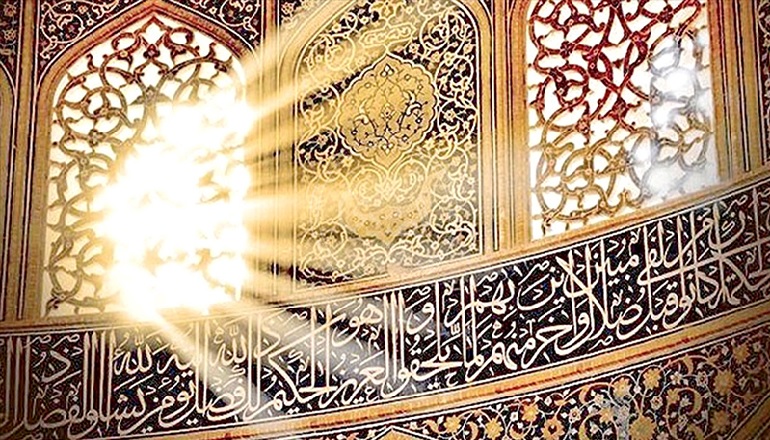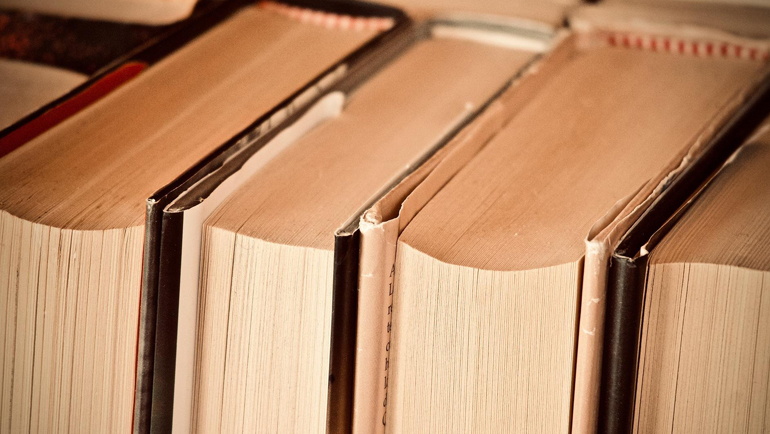
يتناول هذا المقال عرضا وجيزا لنقاش حي معاصر، بدأ منذ عقد أو عقدين تقريبا، يدور حول مصير أهم ركيزة من ركائز العلوم الإنسانية والاجتماعية الأوروبية، أعني علم الفيلولوجيا philology. فقد بدأ ثلة من العلماء الاهتمام مجددا بالفيلولوجيا بعد أن لاقى هذا العلم وابل من النقد والرفض من قبل دراسات ما بعد الكولونيالية postcolonial studies والبنيوية strucuturalism([1]).
ومعلوم أن نقد الاستشراق للفيلولوجيا وصعود التيارات البنيوية وما بعدها في دراسة النصوص قد أحدثت ما يمكن أن يسمى "ردة عن الفيلولوجيا"، بحيث صار ينظر إلى هذا الفن بأنه أداة استعمارية وماضوية وسلطوية، بل وممل أحيانا.
وينادي الفيلولوجيون الجدد بـ"العودة إلى الفيلولوحيا"The Return to Philology، وهو شعار اتخذه بعض النقاد عنوانا لأعمال لهم، كـ"بول دي مان"،Paul de Man و"إدوارد سعيد" Edward Said([2])، ويريدون بذلك جعل النظر في التنوع والتعدد والاختلاف أساسا لعمل الفيلولوجي، وإدراج دور القارئ والمتلقي، بل والجماعة المفسرة في تشكيل النص وفهمه، فلا تكون الفيلولوجيا مهتمة بالبحث عن النص الأصلي ومعناه فحسب. يريد الفيلولوجيون الجدد أن يتجاوزوا التاريخانية التوثيقية الصلبة التي اتسمت بها بعض الدراسات الفيلولوجية من جهة، كما يريدون تجاوز إنكار المنهج التاريخي التي اتسمت به دراسات البنيوية وما بعدها، ومن هنا كانت فيلولوجيتهم تتحرك بين نزعتَي التأريخ والتأويل.
ومعلوم أن الفيلولوجيا، بمعناها التقني الدقيق، فن يشتغل على النصوص المكتوبة قصد تأسيس نص علمي ونشره. وهدف الفيلولوجيا بهذا المعنى هو السعي، حسب الوسع، للوصول إلى النص الأصلي. ويعد الفيلولوجى الألمانى "كارل لاخمان" Karl Lachmann 1793-1851م صاحبَ مَنهجٍ فى تأسيس النصوص المعروف بال- ستما stemma أو منهج التشجير، وقد صار شائعا ومعلوما بين الباحثين المحققين([3]). وبمعناها العام، فتعني الفيلولوجيا علم اللغة التاريخي والمقارن، وموضوعها تحقيق النصوص القديمة ودراستها حسب سياقيها التاريخي والثقافي. ويسمى هذا العلم أيضا بـ"علم الآداب القديمة وفقه اللغة"، فلا علم من العلوم الإنسانية اليوم إلا ويتصل بالفيلولوجيا بسبب وإليها يعود.
ولا يخفى أن أهم مصطلحات النزعة التأريخية التي صبغت فيلولوجيا القرن التاسع عشر، كما تبلورت في دراسات الكتاب المقدس والآداب اليونانية والرومانية القديمة، هي: النص الأصلي أو الأم ur-text، التركيب construction أو إعادة بناء النص reconstruction، وتبييئ النص في السياق أو الكشف عن السياق المقدّر في النص contextualisation، الشاهد التاريخي الماديmaterial evidence/document، النص المتلقى textus receptus، النموذج الأصلي vorlage.
ويقصد علماء دراسات الكتاب المقدس Biblical studies من النص الأصلي نص التوراة والإنجيل كما وضعه مؤلفه قبل أن يعتريه تغيير بعدي، أي ما قبل ترجمته السبعينية اليونانية septuaginta والماسورا العبرية masora، بينما يكون النموذج الأصلي محاولة تحديد أقدم إصدار للكتاب العبري الذي يمكنهم استخلاصه من النصوص التي بين أيدينا.
ومع الفلاسفة الرومانطيقيين الألمان في القرن التاسع عشر، وخصوصا مع شليغل Schlegel، ودلتاي Dilthey وشلايرمخر Schleiermacher، بدأ التعامل مع الفيلولوجيا بوصفها تأويلا عاما للنصوص، أعاد النظر الفلسفي واللاهوتي مجددا إلى دراسة النصوص القديمة. وكان الهدف من هذه النزعة التأويلية فهم مقاصد الكاتب والنص معا، فتكون إعادة تركيب النص متأسسة على ربط التفسيري والنحوي والبلاغي بقواعد التاريخ والفلسفة.
وبعد سنة 1920م، عانت الفيلولوجيا، لاسيما في فرنسا، من منافسة اللسانيات الجديدة بكل تفريعاتها، وبالذات من البنيوية الرافضة للمنهج التاريخي الفيلولوجي. وقد صار مجال فعْلها محدوداً، بدلاً من أنْ يتوسّع، بحيث اقتصر على تأسيس نص مّا، وكانت ثمرتُها تكمُن في إنجاز "نشرة نقدية" لهذا النص في غالبِ الأحيان، وليس خاف دور الطباعة في ترسيخ هذا المنتج الجديد.
بينما استمر في ألمانيا خلال القرن العشرين تقليدٌ في التأويل الأدبي والثقافي يخصّ النصوص التراثية يستمد روحه ومنهجه من الفيلولوجيين الفلاسفة السالف ذكرهم. وقد قام هذا التأويلُ على اسْتِجْماع البحث الأدبي والأسلوبي والمقارن في الاشتغال على النصوص. ويمكن ذِكْرُ إرنست كيرتيوس Ernst Curtius وليو سبيتزر Leo Spitzer وإريك أورباخ Eric Auerbach باعتبارهم ممثلين لهذه النزعة.
ومن منطلق الاستفادة من الدراسات ما بعد الكولونيالية وحضور التاريخ الكوني global history في الجامعات الأوروبية حديثا، شرع الفيلولوجيون الجدد إلى التجديد في الفلولوجيا نفسها من خلال إعادة النظر في مناهج الاشتغال على النصوص نظرا وعملا، وذلك من خلال المساهمة في نقد الخطابات الثقافية الإقصائية وتشجيع البحث الفيلولوجي الإنساني المقارن. ويمكن حصر أهداف هذه الدعوة في أمور ثلاث:
- تقويم الممارسات النصية textual practices خارج أوروبا وداخلها.
- التجديد في مناهج قراءة النصوص القديمة ودراستها.
- فتح آفاق رحبة للبحث من خلال نقد الطروحات الثقافوية والإقصائية؛ (كالتمركز الأوروبي والاستعماري عموما على ذاته) وإدراج الأصول الأدبية والثقافية من خارج المجال الأوروبي في إطار كوني عام.
أولا: موجبات العناية بعلم الفيلولوجيا: عرض موجز لمشروع "فيلولوجيا المستقبل"
في عصر لا سابق له في انتقال المعارف والخبرات، وهجرة البشر والعقول، وتَعَقُّد أشكال الاتصال الإنساني والاختصاص العلمي، أصبح البحث في التراث الإنساني العالمي المتمثل في نصوص الآداب القديمة، جمعا وتوثيقا، تحقيقا ودراسة، حاجة ماسّة.
ويأتي مشروع "فِيلولوجيا المُسْتَقْبَل"، الذي يتخذ من جامعة برلين الحرة بألمانيا مركزا له، داعما ومنشطا للبحث العلمي في التقاليد والممارسات النصية المهمشة، حديثها وقديمها، من آسيا وإفريقيا والعالم العربي وأوروبا، ويسعى المشروع أساسا إلى التعرف على تلك الممارسات النصية التي تعود إلى عهد ما قبل الاستعمار، والتي آلَتْ إلى التهميش أو الإقصاء أو النسيان، وإدراجها في ثقافة إنسانية عالمية تُثَمِّن التنوع الثقافي والاختلاف الفكري.
يستلهم المشروع روحه من مفكرين وباحثين مرموقين، تجمعهم رغبة في الخروج عن الأنساق الثقافية الضّيِّقة في الدراسات الإنسانية والانخراط في مقاربات للقراءة والبحث أكثر رحابة وانفتاحا على التراث الثقافي العالَمي. على رأسهم المفكر الراحل إدوارد سعيد، لاسيما في مقاله الموسوم العودة إلى الفيلولوجيا The Return to Philology الذي دعا فيه إلى إعادة الاعتبار للتراث الأدبي العالَمي وفتح آفاق جديدة للقراءة تتسم بنزاهة إنسانية أرقى وانفتاح أصدق للذات على الآخر. وينطلق المشروع أيضا من واقع الدراسات الإنسانية في الجامعات الغربية والتي تقتطف اليوم ثمار العولمة المتمثلة في سهولة التبادل المعرفي انفتاحا على التراث الثقافي العالمي ورفع الستار عن نتاج نصي قد هُمِّش بفعل هيمنة ثقافة المستَعْمِر([4]). وقد عبَّر عن هذا الواقع بنحو من التفصيل أستاذ الدراسات الهندية في جامعة كولومبيا شلدون بولك Sheldon Pollock في مقاله: "فِيلولوجيا المُسْتَقْبَل: مَصِير عِلْم لَيِّن في عالَم صعب" Future Philology: The Fate of a Soft Science in a Hard World.
عنوان المشروع مقتبس من رسالة سِجَاليّة كتبها أحد أعمدة فقه الأدب اليوناني واللاتيني الألمان من القرن التاسع عشر، هو أُلْريش فون فلاموفتس - مولندورف Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff أسماها مستقبل الفيلولوجيا! Zukunftsphilologie! 1872 والتي ردّ بها على كتاب الفيلسوف وفقيه اللغة الشهير فريدريش نيتشه "ميلاد التراجيديا من روح الموسيقى"Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872. دار السجال حول طبيعة المنهج الذي تدرس به النصوص اليونانية واللاتينية القديمة والهدف المرجوّ تحقيقه من درسها. فبينما كان يرى فلاموفتس أن الكشف عن الماضي لا يتحصل إلا بدراسة متأنية للسياق التاريخي وأن الابتعاد عن الشأن اليومي شرط ضروري لتحقيق ذلك، كان نيتشه يذهب إلى أنّ الإغراق في التوثيق والتأريخ للنصوص القديمة لدرجة الاختصاص قد أعيا قراءة تلك النصوص، بل أدى إلى إماتتها. في نهاية الأمر، يصبّ السجال الذي دار بينهما في قضية محورية تهم كل باحث في التراث الأدبي القديم: كيف ندرس نصوص الماضي ولماذا؟ ما حاجة الشأن الآني واليومي بدراسة الماضي؟ وما السبيل إلى ردم الفجوة بين البحث التاريخي التوثيقي والبحث الأدبي والفكري الإنساني؟ يقتبس المشروع عنوانه من هذا السجال وذلك لإعادة الاعتبار للأهمية العالَمية التي تحتلها الفيلولوجيا اليوم ولما سيؤول إليها حالها في المستقبل. الهدف إذا هو المساهمة في تنشيط البحث في الممارسات النصية في العالم ومراجعة مناهج تَناوُل النصوص تحقيقا ودراسة من أجل تحقيق علم للنصوص القديمة يسعى إلى المحافظة على التراث الإنساني عامة، ويُقدم عنايةً بالكوني والمحلي في آن واحد.
إضافة إلى هذا، يسعى مشروع فِيلولوجيا المُسْتَقْبَل إلى أن يشجع الأبحاث التي تهدف إلى إعادة النظر في تراث الكتابة التاريخية والمهارات التوثيقية والأدبية في العصور الوسيطة والحديثة. كما يهتم المشروع بإلقاء الضوء على السجال الفكري والجدل الأدبي، ليس فقط من أجل فهم هذه السجالات بحد ذاتها وتقييمها حسب نوعها الأدبي ومكوناتها الداخلية، بل كذلك لكشف اللثام عن السياق الاجتماعي والفكري الأعم والشروط التاريخية التي أدت إلى هذه السجالات.
على سبيل المثال، أحدثت الحركات التجديدية السَّلَفية ad fontes في العالم العربي، الداعية إلى الرجوع إلى الأصول الأدبية والدينية؛ كالتي حصلت في القرنين الرابع عشر والتاسع عشر الميلاديين مثلا، في زمن اتّسم بتسارع وتيرة الهجرات وتواتر الأزمات السياسية والاقتصادية، اهتماما متجددا بالأصول الأدبية وتنشيطا في مجال التأليف والتوثيق والإبداع العلمي.
إن عددا ضخما من النصوص والموسوعات التي صارت العمدة في مجالات فكرية شتى قد صُنِّفتْ في زمن كثير المحن ما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر للميلاد. أَضِفْ إلى ذلك أن التجديد الذي حصل على أيدي علماء وفقهاء ولغويين من بلاد الشام في القرن التاسع عشر، في عصر شَهِدَ قَلَقا ثقافيا أحدثه الاستعمار والتبشير، قَلَقَا نظر إليه من عاينه كصدع في بنى المعرفة ومؤسساتها من جهة، وكفرصة للانتهاض والتجديد من جهة أخرى. وبالقدر نفسه في الصين، أدّى سقوط عهد منغ في 1644م إلى تجديد الاهتمام بدرس التراث الصيني القديم، إذْ أراد العلماء الصينيون حينها إحياءَ المنهج الكلاسيكي القديم في دراسة النصوص، فبدأوا يقرأون النصوص القديمة بمناهج جديدة، مطبقين طرائق في البحث مُبْتَكَرة كدراسة الخطوط، والمنقوشات والصوتيات وعلم المعاجم([5]).
يحسن بنا، هنا، أن نتأمل فعل الهجرات والأزمات والمصائب الطبيعية في تشتت المعرفة وانتقالها عبر المجالات الجغرافية والثقافية. ما الأثر الذي تحدثه هجرة العلماء وكتبهم، المطبوعة منها والمخطوطة، في الإبداع الفكري؟ وما أثر هذه الهجرات البشرية والعلمية في النهضة العلمية التي شهدها القرن العاشر في بغداد، وعصر النهضة الأوروبي، أو عصر المنغ بالصين؟ ما الأنساق والاتجاهات العلمية التي يتم استبدالها أو تعزيزها أو ترجمتها، سواء كانت نصا أو فهما أو مسلكا، من خلال هذه الهجرات؟ لا شك أنَّ أثر هجرات الشعوب والأفكار، الناجمة عن المصائب والأزمات، لهو مبحث جدير بالانتباه. فنجد، مثلا، عند ما تَدْلَهِم الأزمات وتتسارع وتيرة الهجرات يبدأ العلماء بمساءلة مشروعية مسلكهم المعرفي ونجاعته، قد تتجلى هذه المساءلة كدعوة إلى التجديد أحيانا وقد تأخذ شكل سجال فكري في أحيان أخرى، يصاحبها توليد مفردات ومفاهيم جديدة من أجل إعادة تنظيم المعرفة المتراكمة حسب نسق معرفي جديد.
إن أحد أشدّ مُعْضِلات الفيلولوجيا اليوم هو أنها تخدم أحيانا مصالح رؤى إقصائية مُغْترّة ومستعلية لا محل لها في الجامعة الإنسانية العالمية. يبدو هذا بين الحين والآخر عند بعض المؤرخين الذي يتوسلون بمناهج سقيمة للتأكيد على الخلافات الثقافية والقطرية. ولهذا كان من بين المواضيع المهمة في مشروعنا هو بحث ما صار يسمى بعصر "انحطاط" الشعوب غير الأوروبية وتأخرها كالصين والهند والعرب المتساوق مع "تفوّق" الغرب، والتي أنتجت مجموعة من الدراسات التاريخية والأدبية، تفتقد إلى أسس فيلولوجية متينة، تتسم بالاحتقار لثقافات شعوب العالم وتراثها المكتوب. من هنا، فإن المنهج الفيولوجي، إذا ما فهمناه كمنهج يُثَمِّن القراءات المتعددة للنصوص والتَّدَبُّر المُتَأنِّي لها والكشف عما هو إنساني وعام فيها، هو خير سبيل إلى تحرير ثقافات شعوب العالم من سِجن ثقافة الأفق الواحد وهيمنتها.
يرى القائمون على مشروع "مستقبل الفيلولوجيا" أنّ الاهتمام بالنصوص القديمة ودراستها والانفتاح على التراث الفيلولوجي العالَمي هي من أهم السُبُل إلى بعث الحياة في الإنسانيات اليوم. فكمال الذات لا يأتي إلا بعد نقد الذات لنفسها، فهي لا تكتمل حقا إلا بتلك المعرفة التي تأتي من دراسة شعوب العالَم وتراثها وأفكارها. ولهذا كان مصير العلوم الإنسانية ونجاحها مرهونا بشروط ثلاثة: الوعي بالذات، والكونية المفاهيمية، والتعددية المنهجية. فإذا كانت الفيلولوجيا تريد أن تحيا في عالمنا المتعولم المتسارع والمتغير دوما فسيكون عليها أن تعيد الاعتبار إلى ما قدّمه العلماء والكُتاب، من كل زمان ومكان، من مناهج ومسالك معرفية، ذلك لأننا لا ندرك أهمية قراءة النصوص حقا والسبيلَ إلى الرفع من شأنها بين العلوم إلا إذا تَعَدَّدَت مناهجنا وتَنَوَّعت قراءاتنا معتبرين التقليد أو التراث لا عبئا على الفهم بل الفضاءَ الذي يكمن فيه المعنى ويتحرك، ولا يكون هذا التَعَدُّد إلا بالانفتاح على مناهج مغايرة ومتنوعة لقراءة النصوص في العالَم.
ثانيا: مجالات المشروع
لعلّ أهم مكون من مكونات المشروع هو البحث في تاريخ حقل الفيلولوجيا نفسه.فلا يكون التجديد المنهجي المنشود في دراسة التراث دون وعي بتاريخ المفاهيم الفكرية والممارسات النصية التي تأسست عليها النصوص القديمة. ولذلك يقترح القائمون على المشروع التركيزَ على محاور البحث التالية:
1. أصول الفيلولوجيا وتحوّلات الممارسات النصية
ما هو أصل الفيلولوجيا؟ بأي شكل فكري تتجلى الفيلولوجيا وما مَنَاطُها؟ وكيف تتحوّل عبر الحقول والمجالات المعرفية؟ وما هي الشروط السياسية والثقافية التي تؤدي إلى تلك التحّولات؟ يقع الاهتمام هنا في تتبع التطوّر التاريخي للفيلولوجيا في سياقات ثقافية وبيئية مختلفة. ولعلّ من الأمثلة الواضحة التي تبين مسار شكل من أشكال الفيلولوجيا وتطوراتها هو الأثر الهلنستي في التراث الفيلولوجي العربي واللاتيني، والذي ازدهر في مراكز علمية مهمة، فارسية وعربية وإفريقية؛ كالبصرة، وبغداد، وبخارى ومرو وتمبكتو، على سبيل المثال. وأيضا، نذكر ذلك الشكل من فقه الأدب الفارسي في بلاد الهند الذي تطوّر بفعل تَعالُق الفلولوجيا الهلنستية - العربية مع الفلولوجيا السنسكريتية.
2. منزلة الفيلولوجيا بين العلوم (كعلاقتها بالعلوم الطبيعية والدينية والقانون مثلا).
ما علاقة الفيلولوجيا بغيرها من أشكال المعرفة؟ وكيف يتم توظيف المعرفة الفيلولوجية في مجالات علمية أخرى؟ يهتم مشروع فِيلولوجيا المُسْتَقْبَل برصد المسارات الفكرية التي سلكتها الفيلولوجيا كي تصبح علما مستقلا بذاتها، مغايرة في مجمل تصوراتها ومناهجها عن العلوم الدينية والطبيعية والفقهية وإن تقاطعت معها في عدد من الأهداف والممارسات البحثية. إن التفاعل ما بين العلوم الفيلولوجية وغيرها من العلوم، في آسيا وإفريقيا وأوروبا، يمثل مجالا حيويا للبحث، يكشف عن الأسباب الثقافية والمؤسساتية التي جعلت النص وعاء للمعرفة وسبيلا إليها في آن واحد.
3. علاقة الفيلولوجيا بالجامعة
كيف تظهر مؤسساتيا وتَعْمَل؟ أين يُمارس علم الفيلولوجيا خارج أوروبا، ومن يمارسها؟ وتحت أي مسمى؟ يهتم مشروع فِيلولوجيا المُسْتَقْبَل بالإطار المكاني والمؤسساتي؛ كالمدارس والجامعات والمكتبات الذي نشأت فيه الفيلولوجيا، قديما وحديثا. فمثلا، تعتبر كتابات فلهم فون هومبلدت Wilhelm von Humboldt 1762-1835، وفريدش شلايرماخر Friedrich Schleiermacher 1768- 1834عن الجامعة الألمانية الحديثة مصدرا ثريا لدراسة صلة علم الفيلولوجيا بالجامعة واستقلاقها علما وفق تصورات علماء القرن الثامن عشر والتاسع عشر الألمان، وهي تكشف كذلك عن الخلفية السياسية والفكرية التي صاحبت تلك التطورات. وفي المجال العربي مثلا، ما زالت مسارات مؤسسات علمية عريقة كالأزهر والزيتونة والقرويين بحاجة إلى تأريخ ودراسة متأنية، تجمع ما بين معطيات الدرس التاريخي والأرشيفي والبحث في سير العلماء الذين عملوا في هذه المؤسسات. كيف عملت هذا المؤسسات في الأزمنة ما قبل الحديثة وما صلتها بمؤسسات الدولة الأخرى؟ وما الذي حصل بها في الأزمنة الحديثة؟ ما هي الأبعاد التاريخية والفكرية لظهور الجامعات العصرية منذ مطلع القرن العشرين، كجامعة القاهرة مثلا؟ ثم ما علاقة عمارة البناء وهندسة الفضاء والمكتبات وقاعات الدرس والمناظرة بطبيعة الفيلولوجيا وعلاقة الأستاذ بالطالب واستقلالية الباحث؟
4. علاقة الفيلولوجيا بالدراسات الدينية
ما صلة العلوم الدينية بالفيلولوجيا؟ كيف أدّى تطور الفكر الديني إلى تغيرات في الممارسة الفيلولوجية؟ إن أثر الإصلاح المسيحي والحركة البروتستانتية في ازدهار الفيلولوجيا الأوروبية وأخذها الشكل الذي أخذته، وبالذات كما تجلى في التقليد الفيلولوجي الألماني، كما مثله فلهام ديلتاي 1833-1911 Wilhelm Dilthey، وإمنويل هرش 1888-1972 Emanuel Hirsch، لهو مثال واضح على صِلَة الفكر الديني بالممارسة النصية. من الأسئلة التي يطرحها مستقبل الفيلولوجيا إذاً: كيف ظهرت أشكال معينة من الفيلولوجيا والدرس النصي كنتيجة لمستجدات الفكر الديني؟ إن هذا الأثر ما زال بحاجة إلى تتبع مصادره وأشكال تظاهراته في البيئات الفكرية المختلفة والسياقات الدينية المتنوعة، كبيئة علماء الهند المسلمين مثلا الذين اشتهر من بينهم شاه ولي الله الدهلوي 1703-1762 Shah Walliullah، وسيد أحمد خان 1817-1898 Sayyid Ahmad Khan، وشبلي نعمانيShibli 1857-1914 Numani، ومولانا أبو الكلام آزادMaulana Abul al- 1888-1958 Kalam Azad، وحميد الدين فراهي Hamiddudin Farahi 1863-1930، أمين أحسن إصلاحي 1904-1997 Amin Ahsan Islahi، والتي ظهرت على أيديهم مناهج جديدة في دراسة النصوص الدينية وتفسيرها، وذلك بفعل الفكر السَّلَفي التنويري وشيوع مراكز التعليم الاستشراقية التي شاعت في شبة القارة الهندية وكردّة فعل على الحركات الاستعمارية والتبشيرية.
5. الفيلولوجيا والإمبريالية والقومية
يكمن الاهتمام هنا بصلة الفيلولوجيا باعتبارها شكلا من أشكال المعرفة بأنظمة الحكم والسلطان. يدخل في هذا اعتبار الفيلولوجيا علما استعماريا ليس لها من غرض إلا الحط من ثقافات الشعوب، كما يدخل دور الفيلولوجيا في تأطير الأصول الأدبية القومية national canons والمحافظة عليها بل وفيما بات يسمى "صناعة التراث" the invention of tradition. يدخل في ذلك أيضا رفض بعض أشكال الفيلولوجيا باعتبارها شكلا من أشكال الهيمنة الاستعمارية ودعم أشكال أخرى من الفيلولوجيا باعتبارها سبيلا إلى تحرير الشعوب من سيطرة سلطان المستعمر.
6. الفيلولوجيا، والترجمة، وصيرورة المعرفة
ما أثر هجرة العلماء وانتقال كتبهم ونصوصهم في الإبداع المعرفي؟ وما هي سبل هجرة العلماء والكتب والأفكار قديما وحديثا؟ ما فِعْل ترجمة النصوص من مجال لساني ما إلى مجال آخر في تأطير مدونة نصية ما وتغيير الممارسة النصية لتناسب ذلك التأطير الجديد؟ ما أثر السجال الفكري وكتب الرد والدحض والمناظرة في انتقال المعرفة، وإن كانت هذه المعرفة من الخَصْم المرفوض؟ وكيف يتم إقصاء بعض الأنساق المعرفية والممارسات النصية وتهميشها بسبب هذه التغيرات؟وما السبيل إلى كتابة تاريخ لصيرورة الفيلولوجيا يراعي نجاحاتها ومواطن تفوقها أحيانا، كما يراعي إخفاقاتها؟
ثالثا: آليات تنفيذ مشروع "فيلولوجيا المستقبل" وأدواته:
يشرف على المشروع عدد من الباحثين والباحثات من جامعة برلين الحرة بألمانيا من تخصصات مختلفة، وينفذ المشروع حسب الطرق التالية:
ـ دعوة خمسة باحثين شباب واعدين لمدة سنة أكاديمية واحدة للمساهمة في نشاطات المشروع من خلال أبحاثهم في مجالات تخصصاتهم. يتم الإعلان عن هذه المنح سنويا، عادة في فصل الخريف، ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، شرط أن يكون قد حصل عليها خلال مدة لا تتجاوز ست سنين حين التقديم، وأن يكون بحثه منسجما مع مقاصد المشروع وملتزما بقواعد البحث التاريخي والفيلولوجي. يتوقع من المتقدمين المقبولين المشاركة بنشاطات المشروع بشكل دوري والتحاور مع الباحثين الآخرين من أجل تحقيق التواصل الثقافي المنشود..
ـ دعوة باحثين من أنحاء العالم للمساهمة في سلسلة المحاضرات والورشات العلمية التي ينظمها المشروع..
تنظيم عدد من المنتديات الدولية، عقد أولاها في القاهرة 2010، بعنوان "الممارسات النصية خارج أوروبا 1500-1900''Textual Practices Beyond Europe 1500-1900، وعقد ثانيها في مدينة دلهي في الهند سنة 2012 وكان عنوانها "الصلات الفيلولوجية عبر آسيا"Philologies Across the Asias: The Transmission, Translation and Transformation of Knowledge in the Early Modern World. كما نظم المشروع خلال الأعوام الماضية عددا من المؤتمرات العلمية حول أدب الشروح، وتاريخ الدراسات السامية، وتلقي فلسفة فتغنشتاين عربيا وآداب البحر الأبيض المتوسط. كما شارك في عدد من الندوات الدولية من بينها مؤتمر الدراسات آسيا الجنوبية الذي انعقد في البرتغال سنة 2012، ومؤتمر "التأويل" الذي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط سنة 2013.
ـ يصدر قريبا أول عدد من أعداد مجلة المشروع وتسمىPhilological Encounters؛ أي مقابلات أو موازنات أو حوارات فيلولوجية.
رابعا: الفيلولوجيا الجديدة والدراسات العربية والإسلامية
تطرح هذه "العودة إلى الفيلولوجيا" التي تشهدها بعد الجامعات الأوروبية والأمريكية عددا من الأسئلة بشأن محل الدراسات العربية منها، وبالأخص، الحاجة إلى التأريخ لمفاهيم العلوم الإنسانية واللغوية والتراثية كما تم تلقيها وتطبيقها في دراسة التراث العربي والإسلامي منذ التفاعل بعلم الفيلولوجيا (بما فيه علم الاستشراق) إبّان حقبة الاستعمار. ولعل أبرز تلك المفاهيم والخطابات التي تحتاج إلى مثل هذا التأريخ هي: "الاستشراق" و"التراث" و"الإحيائية اللغوية" و"التجديد" و"الترجمة"، لما لها من حضور بارز في مخيال الخطابات السياسية والثقافية العربية اليوم وتصورها لماضيها ومستقبلها.
وقد بدأ ثلة من الباحثين تناول ما يمكن أن يسمى خطاب "الفيلولوجيا العربية الحديثة" بالدرس والنقاش، اذكر منها، على سبيل المثال، كتابي رضوان السيد "المستشرقون الألمان" و"الصراع على التراث"، وكتاب شربل داغر "العربية والتمدن"، والدراسات التي حررها عبد الكبير الشرقاوي حول ترجمة الملاحم الأدبية الفارسية واليونانية إلى العربية؛ كـ"شعرية الترجمة: الملحمة اليونانية في الأدب العربي"، و"الترجمة والنسق الأدبي: تعريب الشاهنامه في الأدب العربي"، وغيرها كثير، والمجال خصب وواعد ولا نزال في أول الطريق.
الهوامش
([1]) من بين هذه المشاريع العلمية التي تدعو إلى التجديد في هذه العلم مشروع "فيلولوجيا المستقبل" zukunftsphilologie، في جامعة برلين الحرة في برلين، والذي يشرف عليه صاحب هذه السطور، وسيجد القارئ تفصيلا للمشروع وأهدافه على موقع المشروع وفي باقي المقال: www.zukunftsphilologie.de
([2]) “The Return to Philology”, in Humanism and Democratic Criticism, Edward Said, 2003 .
تُرجِم المقال إلى العربية بعنوان: "العودة إلى الفيلولوجيا" في كتاب "الأنسنية والنقدية الديمقراطية"، ترجمة: فوّاز طرابلسي، دار الآداب، 2005م، ص 79-107.
([3]) انظر: مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، رمضان عبد التواب، القاهرة، 1986م، وانظر أيضا: نقد النص، بول ماس، (Textkritik, Paul Maas, Leipzig 1950)، ترجمه عن الألمانية ونشره ضمن كتابه: النقد التاريخي، عبد الرحمن بدوي، ط.4، 1984م. ومن أهم الدراسات النقدية التي تناولت منهج "لاخمان" دراسة المفكر الإيطالي "سبستيان تمبرانو": La genesi del metodo del Lachmann 1963، وقد ترجم إلى العديد من اللغات كالانجليزية:The genesis of the Lachman method, Sebastiano Timpanaro, University Chicago Press, 2005.، وجدير به أن ينقل إلى العربية.
([4]) E.g. Said, Orientalism, 1979, “The Return to Philology” in Humanism and Democratic Criticism, 2003; Rodinson, Europe and the mystique of Islam, 1987; Al-Azmeh, Times of History: Universal Topics in Islamic Historiography, 2007; Kane, Intellectuels non europhones, 2003; Al-Sayyid, al-Mustashriqun al-alman, 2007; Pollock, The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India, 2006, Future Philology: The Fate of a Soft Science in a Hard World”, Critical Inquiry, summer 2009; Harpham, Geoffry, “Roots, Races and the Return to Philology”, Representations, May 2009, p. 34-62.
([5]) “The Unravelling of Neo-Confucianism: From Philosophy to Philology in Late Imperial China”, Elman, Benjamin, in Tsing Hua Journal of Chinese Studies, December 1983, 73, cited in Pollock 2009, p.944.