العلوم الإسلامية والتأصيل المعرفي: قراءة في إشكالية النهضة العلمية ونسقها الفكري

يُشير مصطلح العلوم الإسلامية إلى تلك العلوم التي طُورت في الحضارة الإسلامية، والتي غطت، بحسب التقسيم الخلدوني[1]، نوعين من النشاط الفكري، هما: المعرفة العقلية الفلسفية التي "يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وبراهينها ووجوه تعلمها"[2]، والمعرفة النقلية "المستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي"[3]. وقد بلغت تلك العلوم، بصنفيها، قمة ازدهارها في العصر العباسي؛ فهو يمثل، وفقاً لأطروحة يُعبر عنها عنوان كتاب مونتمغري واط (The formative Period of Islamic Thought)[4] الفترة التي اكتمل فيها تَشكُل الفكر الإسلامي، حيث اتضحت معالمه ونضجت مناهجه. ولعل لهذا السبب وُصف بأنه عصر الثورة العلمية في الإسلام في شتى مجالات المعرفة وضروبها، غير أن هذا الوصف يقابله اختلاف حول تقييم نوعية تلك النقلة العلمية، وتفسير نشأتها، ومآلاها.
فمن جهة أولى، يبدو أن القول بأن العلوم الإسلامية بلغت نضجها المنهجي والعلمي في عصور ازدهارها على يد الأئمة الأعلام[5]، قول رغم صحته لا يعني بالضرورة أن "أكثر أفهامنا المنظمة عن الإسلام شيوعاً في العصر الحالي يرجع إلى ما صاغه مفكرو الإسلام في تلك الحقبة على وجه التحديد"[6]؛ ذلك أن كل المقاربات التي تمت يومها هي مقاربات جزئية، في العقائد الإسلامية (علم الكلام) أو الأحكام الفقهية العملية (علم الفقه) وأسسها النظرية (علم الأصول) أوفي الفلسفة والتصوف، وهي كلها مجالات تخصصية، مما يعني أنها لا تعبر عن الحالة الشاملة للإسلام. بالإضافة إلى ذلك فإن الثقافة الدينية والعلمية الإسلامية اليوم لا تعود كلها إلى الصورة المذهبية التي صاحبت تلك الحقبة التاريخية على أهميتها.
ومن ناحية ثانية، تُظهر عدد من الوقائع التاريخية ضعف حجج السرد التقليدي، للحركة الاستشراقية، الذي يُفسر نشأة العلوم الإسلامية بظاهرة الترجمة التي تمت في عصر العباسيين، بل وتكذب افتراض أن ثمة تفاعل حضاري وقع بين المسلمين والبيزنطيين أفضى إلى تلك الترجمة؛ حيث أظهرت الدراسات المتخصصة[7] أن العمران وما صاحبه من نمط حضاري جديد في مدن الإسلام وحواضره كان وراء عملية الترجمة تلك منذ أيام الأمويين، لدوافع وأغراض عملية في الأساس.
ومن ناحية ثالثة، يبدو أن ما شاع من ادعاءات حول أثر حجة الإسلام أبو حامد في إعاقة النهضة العلمية وتوقف مسيرتها في الازدهار والتطور ما هو إلا "أوهام حول الغزالي"[8]، فلا النهضة العلمية توقفت بعده كما قيل، ولا الحركة العقلية الفلسفية تأثرت بكتابه "تهافت الفلاسفة"، كما سيتضح.
بناءً على ما سبق، تتخذ الدراسة الحالية من الموقف الذي انتهى إليه عدد من الباحثين من تراث الإمام أبي حامد الغزالي، خاصة من كتابيه "تهافت الفلاسفة" و"إحياء علوم الدين"، وما كتب حولها من مراجعات وإضافات، مع تنويه خاص بالمراجعات التي تربط بين ازدهار العلوم بالعمران وفقاً لنظرية ابن خلدون، نقطة انطلاق لوصل عملية تقييم النهضة العلمية الإسلامية المبكرة وما تلاها من انقطاع بجهود ومساعي تيار في الفكر الإسلامي المعاصر اتخذ من التأصيل المعرفي؛ بمسمياته المختلفة: إسلامـ(يـة) المعرفة[9]، والتكامل المعرفي[10]، والتحيز المنهجي[11]، غايةً لجهودٍ مؤسسيةٍ منظمة، تقاطعت مع مشاريع فردية لمفكرين احتلت كتاباتهم مكانتها لدى المشتغلين بالفكر والمعرفة الإسلامية من المعاصرين، تحاول جاهدة استئناف نهضة علمية في سياق معاصر.
وقد بدأت الدراسة بمراجعة وتقييم ما كتب حول أثر الإمام الغزالي السالب في مسار النهضة العلمية الإسلامية. ولما كان هذا الادعاء قد شاع نتيجة السرد التقليدي لنشأة العلوم في الإسلام وافتراض أن ثمة تفاعل حضاري بين المسلمين والبيزنطيين قد وقع إبان تشكل الحضارة وعلوم العمران في الإسلام، وأن ذلك التفاعل أفضى إلى عمليات ترجمة منظمة عجلت من ازدهار العلوم الإسلامية، فإن الباحث اعتمد على الدراسات التي عملت على تفنيد هذا السرد للبحث عن مكانة كتابات الغزالي وتقييم إضافته في مجالي الفكر النقدي والتثاقف مع الآخر والتأليف لأغراض التعليم النظامي الذي يُعنى بتهذيب العلوم وترتيب مباحثها وتطورها.
ثم على ضوء محاولة التمييز بين كتابات الغزالي في مؤلفاته النقدية، والتي كان إصلاح مناهج التفكير محور اهتمامها، وكتاباته البنائية في مجال التعليم والتدريس، سوف تعالج الدراسة شروط النهضة العلمية بالتوقف عند المبادئ التي نوه إليها ابن خلدون في مباحث عنون لها في مقدمته بعناوين ذات دلالة مثل: "العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة"[12]، و"التعليم من جملة الصنائع"[13]، و"حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم"[14]. والغاية من بحث تلك الشروط هي فهم تلك القواعد والقوانين العامة في سياقها المجتمعي والحضاري الذي عناه صاحب المقدمة، واستخلاص مقومات النهضة العلمية بوصفها مدخلاً للنهضة الحضارية الشاملة، وفهم ما نوه إليه المصلحون من علاقة تأخر العلوم بتأخر المسلمين فهماً مفصلاً[15].
وبعد الفراغ من دراسة تلك المبادئ العامة واستجلاء العلاقة التفاعلية بين الحضارة والعلوم نعود مرة أخرى لسيرة الإمام الغزالي العلمية لنعيد قراءتها على ضوء تلك المبادئ ذاتها، التي نوه إليها ابن خلدون. على أن إعادة القراءة هنا ستنشغل بتتبع أثر معرفة الغزالي بعلوم اليونان ومنطقهم، عبر نقولات الفلاسفة المسلمين، على منهجيته في التعامل مع التراث العلمي الوافد، لا بغرض تبين السبب الذي دفعه لنقد الفلاسفة وقبول منطقهم، بل بغرض استكشاف منهجه في الأساس في مجالي تقعيد أدوات النظر العقلي في العلوم الشرعية من جهة وتنقية الثقافة الدينية من جهة ثانية.
ولأن الدافع الأول لهذه القراءة في الموقف من تراث الإمام الغزالي هو محاولة إعادة صياغة إشكالية النهضة العلمية الإسلامية، فإن الدراسة اعتنت أخيراً باستخلاص بعض الموجهات لفهم المسألة المعرفية/الفكرية في سياق العصر الراهن، بهدف تنبيه المشتغلين بالتأصيل المعرفي إلى حدود المقاربات الفكرية الناقدة لعلوم الآخر/الغير وفلسفاته، وتمييزها عن المعالجات البنائية التي تثري الاجتهاد العلمي الأصيل وتنمي المعارف التطبيقية، التي عليها قوام العمران. إذ يبدو أن بدون هذا التمييز ستظل جهود التأصيل المعرفي الإسلامي تراوح مكانها.
لماذا تراث الإمام الغزالي؟
إن البدء بمراجعة الموقف من تراث الإمام الغزالي واتخاذه إحالة مرجعية لتصحيح ما شاع من تفسير للانقطاع الحضاري في مجال العلوم الإسلامية من جهة، ولتفسير أزمة المؤسسات المعاصرة التي اتخذت من القضية المعرفية أولوية الأولويات، باختزالها لعلة النهوض في العالم الإسلامي في أزمة الفكر من جهة أخرى، يثير سؤال لماذا أبو حامد الغزالي تحديداً؟
في الواقع، فإن النتائج التي انتهت إليها العديد من الدراسات في مجال تاريخ العلوم العربية الإسلامية وفي مجال تقييم تراث الغزالي، بالإضافة إلى تزايد الحاجة إلى المراجعات في مجال مشاريع الإصلاح والنهضة التي يعبر عنها الفكر الإسلامي المعاصر، كل ذلك يعزز أهمية إعادة قراءة إشكالية النهضة العلمية الإسلامية من منظور علاقة العلوم بالحضارة ودور الأخيرة في صناعة التعليم الذي تقعد مؤسساته العلوم تقعيداً منهجياً وفنياً يمكنها من المساهمة في فضاء كوني أوسع.
فقد قدم صليبا، على سبيل المثال، سرداً بديلاً لما هو شائع من تفسيرات للتقدم العلمي الذي شهدته الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي. حيث صاغ مجموعة اعتراضات، مشفوعة بحجج وأدلة، على السرد التقليدي الذي لا يزال يمثل نظرية في تفسير اهتمام المسلمين تاريخياً بالفكر العلمي بظاهرة الاحتكاك مع الحضارات القديمة، واستملاك علومها عبر عملية الترجمة.[16] فهذا السرد، كما يصفه صليبا، "يتجاهل حقيقة أن علوم تلك الحضارة، والتي أصبحت عن طريق الترجمة بين يدي العلماء المسلمين، كانت ناقصة ومليئة بالتناقضات. وهو تناقض لا يؤسس لتقدم، فلابد إذاً من البحث عن علة أخرى لما حدث فعلياً من نهضة علمية شاملة"[17].
كما ينبه إلى ضعف التصور السائد في الربط بين تفسير تراجع الثورة العلمية الإسلامية لاحقا، وبعد ازدهار سريع، وبروز فئة من العلماء يصفهم السرد الاستشراقي التقليدي بالمتشددين الدينيين، إذ يحتل من وجهة النظر هذه العمل الشهير لأبي حامد الغزالي الموسوم بتهافت الفلاسفة ذروة سنام هذا التشدد.[18] فهذا السرد الاستشراقي لا تدعمه وقائع التاريخ، فـ"ـبالنظر إلى الوثائق المحفوظة، يمكننا أن نؤرخ جلياً لنشاط مزدهر جداً في جميع تلك المجالات تقريباً، وبالضبط خلال القرون اللاحقة للغزالي"[19].
يعزز هذه النتيجة ما انتهى إليه عبد الرحمن بدوي من قبل، في مقاله "أوهام حول الغزالي[20] ولكن من زاوية نظر أخرى. حيث ذهب بدوي إلى أن "كتاب تهافت الفلاسفة لا يرد له ذكر عند المشتغلين بالفلسفة في المشرق في القرون الأربعة التالية لوفاة الغزالي (505ه–1111م) حتى خوجة زادة (توفى 893ه–1488م) صاحب كتاب تهافت الفلاسفة الذي رد فيه على الغزالي" ثم يؤكد أن "إغفالهم لكتاب الغزالي يدل على أنهم لم يحفلوا به، ولم يكن له التأثير المزعوم في صرف الناس عن الفلسفة والفلاسفة، وربما كان تأثيره على المتكلمين أكبر. لكن ]يقول بدوي[هذا موضوع آخر يحتاج إلى بحث قائم برأسه"[21].
وإن لم يقطع بدوي بشيء من أثر كتاب التهافت على المتكلمين، فإن سليمان دنيا يذهب إلى أن هذا الكتاب، بمقدار ما فيه من النزعة الإيجابية، "ينضاف إلى ما ألفه الغزالي في علم الكلام.. ]فقد كان الغزالي في حال شكه[ يبحث عن الحقيقة التي يدين بها، ويلقى الله عليها[22]. فغاية عمل الغزالي في التهافت تتمثل في "إظهار العقل بمظهر العاجز عن اقتناص الحقائق الإلهية، ولهذا، يحاول الغزالي فيه أن ينتزع ثقة الناس من العقل كمصدر تتعرف منه المسائل الإلهية"[23].
اتساقاً مع ما انتهى إليه سليمان دنيا، فإن عمل الغزالي في التهافت قد يصدق عليه وصف المرزوقي الذي يرى فيه محاولة أخلاقية "تقابل بين مفهوم العلم النافع دنيوياً وأخروياً ومفهوم العمل الذي ينفع". وهي محاولة تسلم بـ"ضرورة الفصل بين العلم وإطلاق نتائجه وفرضياته إطلاقاً ميتافيزيقياً"، نقضاً "للفلسفة الحلولية المستندة إلى الإدراك الجحودي"، التي تحكي تاريخ "تعثر طويل وتلعثم شديد ]للفكر الديني الاستخلافي[ في علاقته بالأفلاطونية التوراتية المحدثة الهلنستية". فهذا الفصل "لم يصل إلى الصياغة الدقيقة إلا عند الغزالي، قبل وقوعه في فخ التصوف المتفلسف، عندما استند إلى معايير معرفية للتمييز بين العلم وإطلاقه الميتافيزيقي، وذلك في مقدمات التهافت"[24].
وفي المقابل، بحسب المرزوقي، فإن العلم الذي يمكن أن يصبح مدخلاً إلى الإدراك الشهودي، "إذا فُهِم حقَّ الفهم فتخلص من هذا الإطلاق الذي يحوله إلى ميتافيزيقا" قد "صيغ صياغة أولى تقابل معرفياً بين العقل وطور ما بعد العقل. و]لكنه[ لم يصل هذا الأمر إلى الصياغة الدقيقة إلا عند ابن خلدون عندما استند إلى علة عقلية في التمييز بين المعرفة السببية والمعرفة التوحيدية، أو بين الإدراك الأول والإدراك الثاني المتمثل في إدراك حدود الإدراك بصفته أساس التوحيد"[25]. وهذا التمييز بين صنيع الغزالي وابن خلدون تمييز مهم من منظور معرفة الفرق بين عملية الإصلاح الفكري الثقافي مقابل النهضة العلمية في التاريخ الإسلامي، وهي المسألة التي نرى أهمية استصحابها عند تقييم موقع جهود التأصيل المعرفي في النهضة العلمية الإسلامية المأمولة في هذا العصر.
ذهب المرزوقي، إضافة لتمييزه بين جهود الغزالي وابن خلدون، إلى وصف كتاب الإحياء بأنه عمل إصلاحي يهدف إلى تنقية الثقافة في أبعادها الدينية والفقهية والروحية، والتي انعكست، لا على العامة فقط، بل في سلوك العلماء ومؤسسات التكوين العلمي وفي العلوم الموجهة للاجتماع الديني والسياسي.والحال كذلك، فإنه ليس من المستغرب أن يُعد الغزالي ممثلاً لحركة إحياء قوية في الإسلام "كافحت حركة ]أخرى[ مضادة قامت باسم الإسلام أيضاً وكانت تتجه بأصحابها نحو الهاوية، تلك هي حركة الجمود والقسر التي وعدت المجتمع بمصير مظلم. وانه لأمر جدير بالتنويه، هنا، أن نلاحظ أن حركة الجمود هذه لم تتجسد فقط على مستوى الوجود الفاعل أو القابل في التاريخ وإنما تبلرت أيضاً في حقل العلم والمعرفة أو بتعبير أدق وأوسع في آن واحد في حقل الثقافة"[26].
يُضاف إلى ما تقدم أن الغزالي، كما يستفاد من سيرته ومؤلفاته، لم ينكر أهمية العلوم التي عليها قوام الحضارة والعمران؛ كالرياضيات والفلك والمنطق وعلوم الطبيعة والسياسة والأخلاق، "بل اعترف بمساهمات من اشتغل بها من الفلاسفة الذين أنكر عليهم أخطاءهم في فلسفة ما وراء الطبيعة، مثل: الفارابي وابن سينا"[27]. ولعل في اعتراف الغزالي، كسائر علماء الإسلام، بتلك العلوم إشارة إلى ضرورة الفصل بين العلوم البحتة التي تزدهر وتكثر باطراد مع الحضارة، بحسب ابن خلدون، والميتافيزيقا التي تحتمل مباحثها أقوالا تتعارض مع ما جاء به الدين الحق، كما أوضح الغزالي نفسه في التهافت.
ولما كان الشيء بالشيء يذكر، فإن الاشتغال بالعلوم الكونية، والتي لا تخص أمة بعينها، بقصد المشاركة في الإسهام فيها، يظل الحلقة الأضعف في مؤسسات التعليم والبحث العلمي بالعالم الإسلامي اليوم؛ حيث اكتفت معظم دوله باستيراد العلوم التقنية، بدلاً عن الرهان على توطين بيئات وبرامج بحث علمي على غرار ما تم في عصور النهضة الإسلامية الذهبية. ويبدو أن هذه الظاهرة سببها عدم التمييز بين مسار تطوير العلوم الطبيعية والإسهام فيها ومسار تقييم فلسفتها ونقد نظرياتها ومناقشة تحيزاتها.
بين إصلاح مناهج التفكير وشروط النهضة العلمية
يبدو، بالفعل، أن التاريخ يتصف "ببعض الثوابت التي تحدد بناه مهما كان من تغير ظرفياته ومضامنيه"[28]، فـ"البحث في ثوابت الأثر الذي برز في خصائص الفعل التأسيسي الأول من الحضارة العربية الإسلامية"[29] يُعد مقدمة لفهم شروط النهضة العربية الإسلامية مجدداً. ذلك أن بحث تلك الثوابت يساعدنا على تجاوز "وضعيتنا الحالية: وضعية ما يوصف بكونه دالاً على التعثر والإخفاق في الانخراط ضمن هذه الحضارة التي بلغت إلى أرذل العمر فصار فيها أقصى الماضي غاية لأقصى المستقبل روحياً (البوذية والزانية Zenism مثالاً أعلى للروحانية المتأزمة) ومادياً (الاشتراكية والرأسمالية الشرقيتان مثالاً أعلى للوجود الاجتماعي الاقتصادي المتأزم)"[30].
فهذا التعثر الذي يصفه المرزوقي يذكرنا بالحال التي كان عليها العرب في معركة الشرق–الغرب المحتضر عند بزوغ فجر الإسلام، "فلا فارس وتوابعُها (والروحانية الدينية الطبيعية) و]لا الحضارة[ البزنطية وتوابعُها (والروحانية الدينية المنزلة) استطاعتا ابتلاعَ الوجود العربي الجامح، على الرغم من السيطرة المادية والروحية المؤقتة في أطراف الجزيرة، بل وأحياناً في قلبها. فقد تأجل إدماجهما في الوجود العربي إلى أن تم للعرب تحقيق الشروط التي تجعل هذا الإدماج يتم من موقف السيادة الروحية والقوة المادية"[31]. على أن فعل الاستيعاب الذي تم في الماضي "ينبغي أن يفهم في أعماقه النظرية والإرادية العملية حتى نتمكن من إدراك التوافق العجيب بين هذه الأحداث التي تبدو عرضيةً وتاريخياً، و]بصفة خاصة[ أحداث التاريخ العقلي والروحي للإنسانية في اللقاء الصدامي بين الشرق والغرب ومهمة "الوسط–الوسيط" الشاهد عليه والمخلص منه"[32].
في الاقتباس السابق، يبدو جلياً أن المرزوقي لا يتفق مع ما انتهى إليه رضوان السيد من الزعم بأن "الثقافة الغربية هي ثقافة العالم وثقافتنا نحن أيضاً لأننا جزء منه"[33]، إذ يبدو أن في ذلك تبسيط يتجاهل أن "وجود الغرب فينا ووجودنا فيه اليوم وجودان غير سويين، فضلاً عما تتسم به صورة كل منهما عن الآخر من العتامة والتشويه. فالأول حضور لا تبرز منه إلا العجرفة المادية القاهرة، والحالات الشعورية السطحية، مما جعل أثرَه فينا يرتدُّ إلى القسر أو إلى المحاكاة، لأنه لم يبلغ بعد درجة التلقيح الناجح"[34].
وعلى نحو قريب مما ذهب إليه المرزوقي، يرى زروق أن "كل نهضة وكل تغيير اجتماعي، وحضاري، ينبغي أن يقوم على نهضة علمية؛ وكل نهضة علمية يجب أن تقوم على أسس وأصول معرفية ثابتة، على أساسها يمكن إنتاج المعارف والعلوم في شتى المجالات والميادين".[35] وهذا الرأي، فيما يبدو، هو عين ما بشر به مالك بن نبي، حيث كان يرى أن المسألة الفكرية وإن كانت ذات صلة بأوضاع العالم الإسلامي في جانب من جوانبها، إلا أن نهضة المسلمين من منظور مشكلات الثقافة لا تقتصر على الجانب الفكري فحسب، فهناك أشياء أخرى أعم من ذلك كثيراً "تخص الحياة في مجتمع معين من ناحية، كما تخص السلوك الاجتماعي الذي يطبع تصرفات الفرد من ناحية أخرى"[36]؛ فعلى الرغم من ظاهر هذا التحفظ، إلا أن مالك بن نبي رأى أن ظروف العالم الإسلامي والبلاد العربية توفر مسوغاً لدراسة "الأفكار"، "فهي إما أن تؤثر بوصفها عوامل نهوض بالحياة الاجتماعية، وإما أن تؤثر على عكس ذلك بوصفها عوامل ممرضة، تجعل النمو الاجتماعي صعباً أو مستحيلاً"[37].
وفقاً لهذه الرؤية، فإن الذي يفصل المسلمين عن ركب الحضارة والتقدم لا يعود إلى نطاق الأشياء (كالنقص في مجال المدافع والطائرات والمصارف)، بل إلى مستوى الأفكار، ولكن من جهة أن نقص الأشياء ينتهي من الوجهة النفسية إلى التشاؤم، ومن الوجهة الاجتماعية إلى التكديس، وكلاهما يفقدا المسلم فاعليته الاجتماعية[38]، وهي فاعلية لا مرد إليها إلا بالفكر فـ"الفكرة قيمة"[39] في ذاتها؛ ذلك متى ما توفرت الشروط الضرورية التي تمكن الأفكار من أن تثمر فتؤثر إيجاباً في حركة المجتمع. إذاً، فإن مالك بن نبي خلص إلى تحديد مكانة الأفكار في صناعة الفاعلية الحضارية بتنبيهه إلى أهميتها بالمقارنة بعالم الأشياء، فامتلاك المجتمع للمعارف وتطويره للأفكار التي تناسبه أولى من استيراد التقنيات التي تيسر له حياته. وهي خلاصة، فيما يبدو، تعبر عن رؤية ابن خلدون في هذا الصدد. فقد لاحظ لورنس، في مقدمته للترجمة الإنجليزية للمقدمة، أن ذكر ابن خلدون للعلوم تأخر في مقدمته الشهيرة إلى الفصل الأخير منها، وكان تعليقه على ذلك: "ليس لأنها؛ ]أي العلوم[ غير مهمة أو ثانوية عند النخبة المسلمة ]التي يمثلها ابن خلدون[ ولكن لأن العلوم لم تكن تمثل جزءاً مكوناً للحياة البدوية"، ويستنتج من ذلك "أن مكانة العلوم، كما الفصل بينها والصنائع/المهن، ألهمتا ابن خلدون رؤية وطريقة لتنظيم علمه"[40] الجديد، علم العمران.
يبدو أن لملاحظة لورنس هذه دلالاتها بالفعل، فحركة ترجمة علوم اليونان في الإسلام، سواء أرُخ لها بصنيع عبد الملك بن مروان في الديوان، وجهود خالد بن يزيد بن معاوية في صناعة الكيمياء، أو بجهود العباسيين والمأمون في بيت الحكمة، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالحاجة العملية لـ"علوم الأوائل" التي عمل المسلمين على إتقانها وتطويرها، وحسن توظيفها في مجتمع له نموذجه الثقافي والقيمي؛ فلولا ذلك السياق الحضاري التمدني الجديد لما أصبح المجتمع الإسلامي، في المدن والحواضر، واعياً بتحدياته العلمية العملية المستجدة.
إذاً، فإن الحاجة العملية، وفقاً لابن خلدون، تقدم تفسيراً (من بين تفسيرات أخرى) لظاهرة ازدهار العلوم، فملكة الإحاطة بالعلوم والتفنن فيها مسألة تتصل بصناعة التعليم التي تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة[41]، كما أن الاشتغال بالعلوم أمر زائد عن المعاش. و"متى فضلت أعمال أهل العمران على معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع"[42]. والمعنى، أن الإسهام الذي تُحدثه أمة من الأمم في المجالات العلمية والتطبيقية المختلفة مرهون باستقرارها، وقدرتها على التخطيط والتنظيم بأفق وخيال واسع، "لا يقتدر عليه المنشغلون بالمحافظة على ضروريات الحياة، العاجزون عما فوقها"[43].
إذا كان الأمر كذلك، فإن فهم نشأة العلوم الإسلامية بشكل جدي، على ضوء تفسير الوقائع التاريخية التي كانت تمر بها دولة الخلافة الإسلامية، لابد وأن يتحفظ على قبول فكرة أن انتقال علوم اليونان إلى عالم الإسلام تم في الخفاء[44]، فالعلوم لا تزدهر في أجواء كهذه، ولا يمكن أن يكون لها أساس إذا دُرست في الخفية ولم تناقش مسالكها علانية، فـ"مصداقية أي علم ليست ممكنة ما لم ينتشر هذا العلم ويخضع للنقاش"[45] المعمق بين أفراد المجتمع العلمي والمجتمع الأوسع. هذا بجانب أن إتقان العلوم لا يتم في غياب صناعة التعليم، فهو شرط ضروري لاتساع دائرة من يتوافر على ملكة الإحاطة بمبادئ تلك العلوم وقواعد استثمارها.
إن التاريخ الحقيقي للعلوم، وفقاً للتحفظات المذكورة أعلاه، يطرح مسائل هامة ترتبط مباشرة بالعوامل المجتمعية التي كانت إما معيقة لحركة انتقال العلوم وتطبيقاتها أو مشجعة لها[46]. وفي هذا الصدد يقترح صليبا إعادة قراءة نصوص فهرست ابن النديم (الذي يعود تأليفه إلى العام 377ه، 987-988م)، وأعمال ابن قتيبة (المتوفى 879م)، والجشيهاري (المتوفى 942م)، حيث يُستفاد منها أن الجزم بنقل العنصر الفارسي في العصر العباسي للعلوم اليونانية إلى العربية "يرتكز بالأصل على قصة أسطورية، تعود جذورها إلى منجم فارسي"[47]، كان همه ترسيخ الاعتقاد في تلك القصة الأسطورية "ليؤمن بواسطته عملاً له ولسلالته من بعده"[48]. كما تُفيد تلك المصادر الأولية ذاتها أن افتراض الاحتكاك المتبادل بين المسلمين والبيزنطيين افتراض لا ينهض له دليل، فقد ظلت بيزنطة، كما أورد ابن النديم، "تمارس اضطهاد الفلاسفة وتكتنز علوم اليونان في معابد مقفلة وما شابه حتى منتصف القرن العاشر... ]فـ[ لم يكن هناك مثقفون بيزنطيون قادرون على التحكم بالمصادر الكلاسيكية اليونانية، ونقلها إلى الحضارة الإسلامية"[49].
إذاً، فثمة ظروف إدارية واجتماعية واقتصادية وسياسية أدت إلى حركة علمية في العهد الأموي لأغراض عملية، مع خالد بن يزيد بن معاوية الذي "بدأت معه الترجمة"، إبان حكم عبد الملك بن مروان، حيث ارتبطت الترجمة في أول أمرها بالديوان فهما (الترجمة والديوان) "عملان لا يتجزأن"[50]. وقد كان خالد مهتماً بصناعة الكيمياء، وهي علم له فائدة كبرى بالنسبة للخليفة الذي "كان مهتماً بسك نقود ذهبية جديدة"[51]. فـ"من غير الكيمائي كان مؤهلاً لتمييز الذهب الخالص عن المعادن الأخرى؟ ومن غير الكيميائي كان ضليعاً في كشف الممزوج والمتشابه؟... إن أهل الصنعة كانوا هم الذين يمتلكون الخبرة الكافية لسك الدنانير الجديدة"[52].
إضافة إلى الحاجة العملية الملحة في دولة الخلافة، فإن الربط بين الترجمة وتعريب الديوان يفسر بعداً آخراً يمكن اختزاله في مبدأ المنافسة، وما تبعه من هندسة اجتماعية في مجالات ذات صلة بالمهن. إذ يبدو أن روح المنافسة، التي زكتها عملية تعريب الديوان، تكشف الأسباب الحقيقية لازدهار العلوم في الإسلام. فقد أدى تعريب الديوان إلى "إقصاء المجموعات الناطقة آنذاك بالفارسية واليونانية عن الأعمال الإدارية، وقد كان أغلبهم من الزرادشتيين أو المسيحيين"[53]، الذين كانوا يمثلون علية مجتمع البيروقراطيين، ممن كانوا من قبل التعريب يشعرون بالاستقرار في مراكزهم الإدارية، بسبب "احتكارهم بكل طمأنينة مراكز السلطة في الحكم لسنوات عديدة، لأنهم فقط كانوا يحتكرون لغة ما أو علماً ما؟"[54] في دولة كانت دائماً سوقاً مزدهرة[55]. غير أن القلق بدأ حين اتهم أفراد هذا المجتمع بعضهم بعضاً بالخيانة، في ظروف تهميش طرأت فجأة مع تعريب الديوان[56].
هكذا ولدت تلك الظروف روحاً تنافسية غير مسبوقة، همها الأول "اكتساب الاختصاصات الأكثر تطوراً في العلوم التي كانت الدولة بأمس الحاجة إليها لتصريف أعمالها"[57]، فاستخدم الفرس "معرفتهم في اللغة اليونانية والعلوم الابتدائية التي كانوا يستخدمونها في الديوان، ليحاولوا أن يعلموا أنفسهم أو أولادهم العلوم الأكثر تطوراً التي أشارت إليها ]كتب[ العلوم الأساسية من أجل المزيد من الدقة والتعقيد"[58]، كما اضطروا لتعلم اللغة العربية التي أصبحت لغة المنافسة في مجال الخدمة البيروقراطية وفي العلوم الرفيعة المستوى في آنٍ واحد[59]. بمثل هذه الترتيبات تمكنت "عائلات بأكملها من العودة لتشغل أعلى المراكز في البلاط العباسي... وتمكنت من شغل المراكز التي كانت أكثر حساسية من وظائف الديوان القديمة؛ لقد تمكنوا أن يصبحوا هم المستشارين المقربين إلى الخليفة نفسه"[60]. وقد أدى كل ذلك إلى بروز "طبقة جديدة من الناس، عملت على استحداث نوع جديد من الاحتكار وفي أعلى مستويات الدولة"[61].
لقد نتج عن هذا الجو من المنافسة، المشار إليه أعلاه، "أرقى طبقة من العمال الذين خدموا البيروقراطية العباسية، إذ تميزوا بكفاءتهم العالية، وساهموا في دفع حركة الترجمة والمعرفة المعمقة بعلوم الأوائل وتعديلها "وفقاً للحاجات الموجودة آنذاك... (فـ)"حركة الترجمة لم تكن حركة تقوم بتقليد ثقافي أرقى، قائم هناك، يتنافس مع الثقافة الأم. بل كان على الثقافة الأم استخراج النصوص الملائمة فعلاً والتي أهملت تماماً في الثقافة الأخرى، في أقبيةٍ لسنواتٍ عديدة حتى تم إخراجها بسبب الحاجة إليها في بغداد حيث لاقت تقديراً أفضل"[62]. فـ"بعض النشاطات الإبداعية كانت قد سبقت تراجم النصوص الأولى، كما أن هذه النشاطات تطلبت المزيد من التراجم من أجل التركيز على تفكير أكثر إبداعاً"[63].
التعليم والتطور الداخلي للعلوم
على ضوء العرض السابق، وبنوع من الاختزال، يمكننا تلخيص العوامل التي دفعت المسلمين للاهتمام بالعلوم والمساهمة فيها في النقاط التالية:
- وعي المجتمع بحاجاته العملية التي بها قوام العمران؛ (نموذج احتياجات الخلافة؛ في الدواوين، والحسبة، وخرط الطرق والمدن، وحصر الأراضي والتركات...إلخ)؛ وذلك على اعتبار أن العباسيين أصبحوا من حيث لا يدرون ورثة للإصلاحات الإدارية التي أجراها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، والتي اقتضت إحراز المزيد من التقدم. وبالفعل تقدمت تلك العلوم بفضل الذين كانوا يعملون عند الخلفاء المتعاقبين في القرن الأول من الحكم العباسي، فقد كانوا أكفاء مؤهلين لتحقيق أي مشروع يحلم الخليفة بإنجازه، ولهذا وصف عصرهم بالعصر الذهبي في الحضارة الإسلامية[64].
- نوع من الهندسة الاجتماعية (لأصحاب المهن والصنائع) موصول بحراك مجتمعي تنافسي؛ فقد زعزعت الإصلاحات الإدارية تلك فئات في المجتمع كانت تعمل في الديوان وأجبرتها على تامين رزقها بأساليب أخرى، حيث "لجأت هذه الفئات إلى المعارف المتخصصة التي كانت تحصل عليها من خلال ترجمة العلوم الأكثر تقدماً. وهذا مكنها من الدخول في إطار المنافسة الجديدة[65].
- العلاقة الجدلية بين العلوم والمهن؛ فالتعليم نفسه صناعة، والمهنة تقتضي تعلم أسرارها والاطلاع على المزيد من الكتب العلمية الأكثر تقدماً.
- مناخ مهني نشط تحرسه القيم الإسلامية والمهنية؛ حيث مثلت قيم الدين الإسلامي معياراً لتحديد الموقف من التراث اليوناني الوافد يومها، كما مثلت قيم المهن معياراً للجودة وأساساً للحسبة والراغبة على أصحاب المهن والحرف.
ولعلنا لإضاءة تلك النقاط أكثر نفترض مع ابن خلدون أن التفنن في العلوم وإتقانها والإسهام في ترقيها يرتبط بالتعليم[66]، وأن البيئة التعليمية الفريدة والمناخ العلمي الذي توفر للعلماء في التاريخ الإسلامي المبكر أفضيا إلى نوع من الممارسات التعليمية اليومية كان لها كبير الأثر في تقنين عملية الاجتهاد العلمي وإشاعة روح الإتقان والإبداع والابتكار، حيث امتدت أثار تلك الروح "العلمية" خارج نطاق مؤسسات التعليم فلامست الحياة الإسلامية العامة على نحو ارتقى بها في سلم الحضارة الإنسانية.
لقد ارتبط التعليم بالكتاب، بعد أن عرف الناس التدوين، فصنفت العلوم وهذبت لغاية اختصار الوقت وعرض نتائج العلماء وتوثيقها وحفظها لمن يخلفهم ويأتي بعدهم، فالخلف إما أن يستحسنها أو ينبذها، بحسب عبارة ابن عاشور، إلى أحسن منها ـوأوضح. فـ"العلوم ما دونت إلا لترقية الأفكار، وصقل مراقي العقول. وبمقدار ما يفيده العلم من ذلك ينبغي أن يُزاد في اعتباره، فما القصد من كل علم إلا إيجادُ الملكة التي استخدم لإصلاحها. ونعني بالملكة أن يصير العملُ بتعليمات العلم كسجية للمتعلم، لا يحتاج معها إلى مشايعة القواعد إياه"[67].
في هذا الصدد، توثق دراسات المؤرخين ما كان يقوم به طالب العلم الشرعي من تدوين لملاحظاته على دروس أستاذه وكتبه ومؤلفاته فيما عرف بـ"التعليقة"، التي كانت شائعة في مجال دراسة الفقه. وهي ممارسة الغرض منها إظهار تمكن الطالب من العلم المعين، تمهيداً لاختباره وإجازته فيه[68]. وقد ينشر تلك التعليقات في مصنف "يكون بمثابة أول إصدار له"[69]. كما أن الطالب الذي يطمح أن يصبح مدرساً كان عليه أن يقدم شرحاً لكتاب من الكتب المعتمدة في مجال تخصصه العلمي، وأن يُحاضر فيه أو يشترك في مناظرة علمية يَجمعُ فيها لنفسه مجموعة واسعة من المسائل والردود عليها والأدلة المضادة، فقد كان الطابع الغالب على التدريس هو "المسألة" أو "المشكلة"، والتي تعني أن يكون لدى الطالب جواب حاضر لكل مسألة منها[70]، وأن يُصنف المسائل بنفسه ليتدرب على المناظرة ويستعد لاقتحامها، فالمناظرة كانت تمثل في عصر النهضة العلمية الإسلامية "لب التدريس العلمي وقمته"[71]. حيث كان من أسلوب ذلك العصر أن يطرح الطالب "قضية أو قضايا إشكالية مع القدرة على حلها"، كما يقوم بإعداد "التعليقة، وهي تقرير أو تعليق علمي"، وأن يمارس "المناظرة: تأييداً أو معارضة" ويحسن طريقة "الخلاف"[72].
بمثل تلك الممارسات والتقاليد كان يُعدُ العلماء ويتم تكوينهم علمياً، ابتداءً باكتساب مهارات الجدل، والقدرة على التحليل والتأليف، للوصول إلى أفضل الآراء الفقهية، ثم الدفاع عن تلك الآراء، التي يلزم أن يتم إقرارها في نهاية المطاف بإجماع العلماء، كغاية يطمح لها كل فقيه مجتهد.
بطبيعة الحال، لسنا هنا بصدد التوثيق لتلك التقاليد الإسلامية في التعليم، إذ يشغل فكرنا التعليق على منهج الغزالي وطريقته في تأليف "المنخول من علم الأصول" و"المستصفى من علم الأصول" مقارنة بما أنجزه في "مقاصد الفلاسفة" و"تهافت الفلاسفة"، وتوضيح دلالة ذلك من الناحيتين العلمية والفكرية.
نقصد بالناحية العلمية الطريقة التي سار عليها الغزالي في تحصيل العلم وتدريسه، حيث ذهب إلى أن العلوم ثلاثة أقسام، عقلي محض: لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه كالحساب والهندسة والنجوم، ونقلي محض: كالأحاديث والتفاسير وهذه يستوي في الاستقلال بها الصغير والكبير لأن قوة الحفظ كافية في النقل فليس فيه مجال للعقل، وما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وهو أشرف العلوم[73]، وعلم أصول الفقه من هذا القبيل؛ "فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محص التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد"[74]. وهو هنا، كما هو بين، لا يكتفي بتصنيف العلوم إلى عقلي ونقلي ومزدوج فحسب، بل يتعدى ذلك ليفاضل بينها على أساس الصدق والثمرة، فالعلوم منها ما هو "ظنون كاذبة لا ثقة بها" كعلم التنجيم، ومنها "علوماً صادقة لا منفعة منها"وعلوماً "ليس فيها مجال للعقل"؛ وهي مفاضلة غائية في الأساس تبحث عن العلم النافع كما تنشد اليقين العلمي، حيث يتكامل العلم والإيمان، فلا ينفصل الفقه عن الآخرة.
بناءً عليه، فإن اطلاع الإمام الغزالي على علوم عديدة في الفقهيات والعقليات والروحانيات، ومزجه للعلوم الأصيلة التي نشأت في الإسلام بدافع داخلي، بعلوم وافدة لها منطقها وإشكالاتها، جعله مدركاً للتناقض بين تلك العلوم بل ومدركاً لجوانب التلاقي الممكنة، على أن هذا التوتر والقلق الفكري شكل عند الغزالي حالة من الشك المنظم الذي ينشد "اليقين"، لذلك مارس النقد وعول على العقل، ولكن "بعد أن يستضيء الوعي بنور الإيمان الذي يمنحه الله لمن يخلص في طلبه"[75]. وبدافع من هذا التوتر، فيما يبدو، ظل معنياً بتحديد غايات العلم الذي يبحث فيه، والدقيق في مصطلحه ومفاهيمه، والتأصيل لمناهجها وتحديد أدوات النظر التي تناسب كل مبحث من مباحثه.
إذاً، فإن حسن التكوين العلمي الذي توفر له بجانب الطموح الشخصي والنبوغ الذهني الذي اتصف به مكن الغزالي من تطوير مصطلحات وأدوات منهجية وظفها باقتدار عند الاشتباك (نقداً وتصحيحاً) مع ما استقرت عليه علوم زمانه. فقد استعار، على سبيل المثال، مصطلح الذوق من القضاة الأصوليين، والذي يعني، عندهم، قابلية يستدعي المرء بموجبها معرفة مقاصد الشريعة، فيطبقونها على ما يعرض لهم من مشكلات قضائية/فقهية، فبنى عليه مسالك في النظر والاستدلال[76]. كما استخدم مصطلح التواتر المعنوي للاستدراك على الاستقراء المنطقي الناقص والزعم بأن تظافر الأخبار مع القرائن يؤدي إلى اليقين[77]، وبذلك انتهى إلى مزج المنطق اليوناني بعلوم المسلمين، بحجة أن علوم اليونان في المنطق "أكثرها على منهج الصواب، والخطأ نادر فيها، وأن فلاسفة اليونان يخالفون أهل الحق بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني والمقاصد"[78].
إن الغاية من مسعاه في هذا المزج عبر عنها في كتابه مقاصد الفلاسفة بقوله: "غرضنا تهذيب طرق الاستدلالات وذلك مما يشترك فيه النظار"[79]. ولذلك تجده كثير الاستشهاد بأمثلة فقهية ليقرر أن المنطق تتسع جدواه لتشمل العلوم النظرية العقلية منها والفقهية، فـ"النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات في ترتيبه وشروطه، بل في مآخذ المقدمات فقط"، أي أن النظر في الفقهيات لا يختلف عن النظر في العقليات من حيث الصورة، ولكن الخلاف من حيث المادة فقط[80].
يبدو أن الذي دفع الغزالي للتفكير في أدلة النظر الإسلامية من منظور علاقتها بالمنطق المأخوذ عن اليونان؛ أن علماء ألأصول في زمانه كانوا "يخرجون حدودهم على طريقة المنطق الأرسططاليسي، ويحاولون تحديد مصطلحاتهم على هذا الأساس، ويضعون لها تعريفات واضحة"، ومدلولات ثابتة محددة من الناحيتين اللغوية والأصولية الفقهية، بل حتى المتكلمين ضبطوا حججهم وخرجوها على أساس هذا التوجه الجديد، فـ"نشأت عن هذا حركة فكرية كانت شديدة الأثر في الفكر الإسلامي" اللاحق[81].
أياً كان الدفع، فإن الغزالي، وهو يمزج على طريقته بين المنطق وعلم أصول الفقه، التزم في تأليف المستصفى بطريقة التأليف البنائي الإيجابي، الذي يناسب التدريس والتكوين العلمي، فجمع فيه "بين الترتيب والتحقيق؛ الترتيب للحفظ، والتحقيق لفهم المعاني، فلا مندوحة لأحدهما عن الثاني. فصنفته، يقول الغزالي، وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب، يُطلع الناظرَ في أولِ وهلةٍ على جميع مقاصد هذا العلم، وَيُفِيدُهُ الاحتواءَ على جميع مسارح النظر فيه. فكل علم لا يستوفي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه"[82].
وهذه العبارة الموجزة في منهج تأليف المستصفى تلخص مبدأين مهمين: الأول؛ أن التأليف لأغراض التعليم مبناه على المعرفة بتاريخ العلم وقضاياه وموضوعاته، والثاني؛ أن ابتكار طريقة في التأليف ومعالجة الموضوعات يعتمد على التوسع في الاطلاع على العلوم البينية الأخرى ومناهجها. وهما، في تقديرنا، يمثلان أهم شروط تأليف ما يصطلح عليه في عصرنا هذا بالكتاب المنهجي.
أما فيما يخص الناحية الفكرية، فقد اشتهر الغزالي بقدرته على المحاكمة العقلية والمحاورة المنطقية لما تمتع به من "تمكن وسيطرة شاملة وأصالة وابتكار وفطنة واختبار وهضم وتمثيل"[83]، بالإضافة إلى الالتزام بالصرامة في التحليل والنقد لأقوال الفلاسفة وآرائهم، حيث طفق يشكك في المألوف القار "قصد تجاوزه ورده، أو إقراره وتوكيده"[84]. يقول عن نفسه في مقدمة التهافت: "فعلمت يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة"[85]. وهو بذلك يؤكد أن الإحاطة بمدارك أهل العلم ومذاهبهم فيه تتطلب صبراً وأناة وتحليلاً دقيقاً لعناصر الرأي، والتزاماً بالصدق التام في النقل عنهم، والنزاهة والحياد التام، وعدم التهور وسوى ذلك من مستلزمات الموقف العلمي[86].
لقد لاحظ سلمان دنيا، محقق كتاب تهافت الفلاسفة، أن الغزالي ألف في علم الكلام، وألف في نقد الفلسفة، وفي نقد مذهب الباطنية، وكان يقوم بالتدريس في مدرستي "نيسابور" و"بغداد"، فعقب على ذلك بقوله: "ومما يثير الدهشة أن شاكاً في الحقيقة يصدر تآليف إيجابية حول الحقيقة، ويدرس تدريساً إيجابياً. وأعني بالتأليف والتدريس الإيجابيين التقرير والشرح دون النقد والتزييف. نعم ليس من الغريب أن يصدر عن الشاك تأليف وتدريس سلبيان، وأعني بالتأليف والتدريس السلبيين النقد والتزييف، لأن الشاك باحث لم تسلم لديه أدلة الدعاوى، إذ قامت لديه حولها شبه، فهو إذا سطر لنا تلك الشبه في كتب أو ألقاها في دروس، كان مستجيباً لداعي له، وكان منطقياً مع نفسه، لذلك لم يكن غريباً من الغزالي أن ينتقد الفلسفة ومذهب التعليم"[87].
وكأن محقق التهافت يلفت أنظارنا إلى مسألتين منفصلتين عادة ما يقع الخلط بينهما لدى المعاصرين، وهما: التدريس وطريقة التأليف الخاصة به، والنقد الفلسفي وطريقة التأليف المناسبة له. فالتدريس عملية بنائية منهجية تقتضي التدرج في عرض الأفكار وترتيبها وتنظيمها وتصميمها وإخراجها حال التأليف بذات خصائص ومقومات هذه المنهجية البنائية، أما نقد الأفكار ودحضها فهي عملية سلبية تنفذ مباشرة لإضعاف المسوغ الذي تقوم عليه حجة الفكر المخالف والانتصار للرأي الذي يراه الناقد، وهذه الطريقة لا تناسب التدريس لكن قد تفضي إلى طريقة في النظر ومنهجية في التفكير لها أصول وقواعد. وقتها قد تشكل تلك الطريقة في النظر اتجاهاً مدرسياً يمكن تدريب أجيال من الدارسين عليه. أما النقد ذاته فهو عملية تتبع أخطاء الفكر لتقويمه.
يفهم من ذلك أن الإحاطة بالمعرفة، أياً كانت طبيعة تحصيلها وتعلمها، مسألة مرتبطة بمدى توافر نوع من الملكات الذهنية والعقلية لدى المشتغلين بها بجانب المعرفة العلمية المعمقة في المجال الذي يشتغلون عليه. وفي المقابل يتضح أن التجريد ونقد الأفكار والمناهج يأتي في مرحلة لاحقة للمعرفة المعمقة بالحقل العلمي، حيث لا يقدر عليه إلا من أجاد ملكة التنظير وأتقنها مثلما أتقن العلم، كما أن النقد والتمحيص لا يحسنه إلا من تدرب على مناهجه. فالمعرفة بموضوعات الحقل المعرفي المعين وقضاياه، أو بنظريات من ساهموا في تطويرها لا تكفي إذا لم يكن بمقدور من همه طرح مقاربات بديلة الاشتباك معها؛ بالتنقيح والتطوير أو بالنقض والتفنيد، وفتح آفاق جديدة.
وعند التدقيق، يبدو أن تنمية المعرفة مسألة زائدة عن المعالجة التخصصية المحدودة، ويشترط لتحقيقها، فيما يبدو، أمران:
الأول؛ توفر مساهمات رائدة، يقود أصحابها تلك المسالك الجديدة، بإرساء مقاربات بديلة في الحقل المعرفي المعين؛
والثاني؛ أن يتم تعليم تلك المساهمات الرائدة والمقاربات البديلة لعدد أكبر، بحيث تتسع دائرة المشتغلين عليها، وتتضح معالم الاتجاه الفكري الذي يبشرون به، ويراهنون على جدواه. ويتوقع أن يفضي اتساع تلك الدائرة إلى تباين وتنوع واختلاف في المفاهيم والنظريات في إطار الحقل المعرفي المعني، فـ"العلم واحد في نفسه"[88] وإن تباينت فلسفاته ونظرياته.
المنحى النقدي عند الغزالي وصلته بمساعي صياغة نسق فكري إسلامي لدى المعاصرين
حاولنا فيما انتهينا منه أعلاه، أن نؤكد أن المعرفة في الإسلام وإن كانت تتصل بالدين والثقافة والتاريخ، إلا أنها لا تقوم دون بنى تحتية وشروط موضوعية، في الاجتماع والاقتصاد كما في السياسة والتعليم، فإصلاح تلك البنى من شأنه أن يوفر مناخاً للبحث والتفكير العلمي تزدهر بسببه العلوم والمعارف. لكن لا يفهم من هذا كله أن تطور نظريات العلم مسألة تتعلق فقط بتلك العوامل الخارجية، بل من الأرجح أن ثمة عوامل أخرى أهم تتصل بالتفكير العلمي ذاته وبمسيرته ومصطلحاته ومناهجه التي يُعبر بها العلماء عن قضاياه ومناهجه ونظرياته، وغير ذلك من أمور قد يفيد التوقف عندها لفهم العلاقة بين التطور الداخلي للعلوم واكتشاف نظامها المعرفي ونسقها الفكري في ظل عمليات الاستمداد الثقافي والانفتاح على ميراث الحضارات الأخرى في مجالات العلم والمعرفة والفكر.
وقبل الإشارة إلى دلالات تراث الغزالي في هذا الخصوص، نبدأ بالتنويه إلى الاقتباس الذي صدرنا به هذه الدراسة، والمتعلق بتمييز ابن خلدون للعلوم الإسلامية لنوعين من العلوم، هما: العلوم العقلية والعلوم الشرعية. فهو وإن لاحظ تباين موضوعاتها ومناهجها، فضلاً عن مصادرها لم يقطع بعدم تلاقي هذين الصنفين من المعرفة. ولعل ميزة هذا التصنيف الخلدوني، في مقابل الوجهة التقليدية، التي سايرت الطريقة اليونانية،في تصنيف العلوم عند الفارابي وإخوان الصفا وابن سينا[89]، هي قدرته على إدراك الخاصية الإسلامية في نشأة العلوم الأصيلة الخاصة بالأمة وفي اقتباس العلوم من الأمم الأخرى، أقصد "خاصية الالتزام بخدمة العقيدة الدينية في العلوم"[90] بصنفيها على حدٍ سواء، حيث "لم ينشئ المسلمون علماً، ولم يقتبسوا علماً إلا لغرض خدمة حقيقة دينية عقدية أو شرعية بصفة مباشرة أو غير مباشرة"[91]. وهو تصور في الفكر الإسلامي يجعل "معارف الوحي هي المقياس والمحك الذي تُرد إليه العلوم الإنسانية ليرفدها بالرؤية الإسلامية الكلية"[92].
وتجنباً لنقاشات وجدل قد لا ينتهي، فإننا نكتفي بالتنويه إلى أن القصد من مرجعية معارف الوحي في هذا السياق هي التأكيد على ضبط التفكير في القضايا المعرفية الكلية، الغائية والنهائية،حيث يكون الاهتمام بالغايات الأخلاقية لعملية المعرفة والمعاني المستفادة منها في إطار الرؤية الإسلامية للحياة والإنسان والكون. فتلك الرؤية تظل قائمة وواردة عند العلماء وعند المتلقين بغض النظر عن أثرها على درجة الموضوعية والنزاهة العلمية عندهم حال اشتغالهم بقضايا المعرفة والعلم. وهي رؤية تشكلها الثقافة والتنشئة، وقد يكون لها حضورها لدى العلماء والباحثين، إلا أن بنية التفكير العلمي تتضمن القدرة الذاتية على اكتشاف الخطأ فيه، وطرح فرضيات جديدة كلما اقتضى الموقف العلمي ذلك، قد تثبت صحتها وقد يتم تخطئتها كذلك، فمبدأ المراجعة الفردية والجماعية والتصحيح الذاتي للعلم يظل قائماً ليمثل أهم حماية للمبدأ العلمي.
لا شك، إن مرجعية الوحي في عمليات التفكير إسلامياً قد تفهم في سياقات مختلفة، على نحو صحيح أو خاطئ، ولكنها في نهاية المطاف تمثل نقطة الانطلاق الأبرز عند البحث عن نسق تفكير إسلامي ،كونها تؤكد على مبدأ وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة، وتقوي الاعتراض على مبدأ تعدد المرجعيات العلمية التي تحاصر كل نوع من أنواع النشاط الفكري في دائرة مخصوصة، بالشكل الذي يكون فيه للعلم الديني والشرعي دائرته، وللعلم الطبيعي دائرته، وهكذا في حالة العلم الاجتماعي، والعلم الإنساني؛ كما توحي برفض منهج المقاربات والمقارنات التجزيئية التي لا تميز بين الكل والجزء، وتغرق في تفاصيل الأجزاء دون أن تعي موقع هذه الأجزاء من الصورة الكلية[93].
وبالعودة إلى الغزالي، فإن الاستدراكات والانتقادات التي اشتملت عليها مؤلفاته، التي لم يكتبها لأغراض التدريس، كالتهافت والمنقذ والإحياء، يبدو أنها جاءت معبرة عن الأصول الكلية التي استمد منها نسق تفكيره في القضايا الكلامية والدينية والفلسفية. فقد رأى أن المتكلمين، لكونهم دافعوا عن الدين بوجه أعدائه الذين أساؤوا تفسيره، حددوا مبادئ الدين ومباحثه لتكون في متناول الاستعمال والفهم تحت وطأة التقليد أو إجماع الأمة أو مجرد القبول من القرآن والأخبار. وقد ترتب على ذلك أنهم "في المحصلة لم يستطيعوا بلوغ صخرة المعرفة الحاسمة، التي هي هدف المعرفة جميعا"[94].
لا يفهم من ذلك أن للغزالي موقف سالب من علم الكلام، كما هو شائع، فهو وإن كان شديد الانتقاد لهذا العلم إلا أن "وراء هذا الانتقاد أطروحة أساسية وهي أن الوظيفة الأساسية لعلم الكلام هي حماية العقيدة، التي تقوم على دعائم من القرآن الكريم والسنة، ضد البدع. فالكلام ليس نهاية في ذاته، بل من الخطأ أن نعتقد أن الاشتغال بهذا الفن هو عين التجربة الدينية"[95]، فلابد من هذا العلم، ولكن كوسيلة لا غاية. وعندما يصرح الغزالي، في معرض حديثه عن علماء الكلام، بقوله "لما لم يكن ذلك مقصود علمهم"، فمراده هنا أن هؤلاء العلماء لم يطلبوا حقائق الأمور في ذاتها، ولكنهم فعلوا ذلك للذب عن العقيدة. وقد كان عملهم "مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات".
وهذا يعني أن علم الكلام، كما يفهم من السياق، لم يمنح الغزالي اليقين العلمي الذي يطلبه[96]. ومع ذلك فإنه قدم آراءه بوصفه متكلماً، همه الأول تبيين تعاليم المذهب الأشعري والدعوة إليه، وذلك بتصنيفه كتابي الاقتصاد في الاعتقاد، وقواعد العقائد، حيث ضمنهما أقولاً إيجابية حول علم الكلام تضع هذا العلم ضمن إطار نظري أوسع لعلم العقائد[97].
وفي نقده للمتصوفة، رفض الغزالي ادعاءهم بأن المرء في الحالة الصوفية يبلغ الحلول أو الاتحاد بالوجود الإلهي، فإدراك الله حقاً هو دوماً إدراك حضور العلي بوصفه وجوداً آمراً، والعلم به تعالى ليس أبداً معرفة بذاته، بل بمشيئته جل شأنه[98]. أما في مجال الفلسفة، فقد ذهب إلى أن أكبر أخطائهم جاءت في فلسفة ما وراء الطبيعة، ومن بينها إنكارهم بعث الجسد يوم القيامة، وتحديد معرفة الله بالعموميات دون التفصيلات، ودعواهم أن العالم أزلي وغير مخلوق. وهو في رده عليهم، بعبارة الفاروقي، "أقام نظام أفكاره الفلسفية على أن الله هو البدء والأساس، خلافا للفلاسفة الذين بدأوا بالحواس أو بالعقل"[99]. فهو قد ربط العقل بالإيمان، ومنه استقى فرضياته المطلقة، ثم أعطاه الحرية أن يمارس النقد كيف يشاء. ومن دون هذا الربط يكون العقل عرضة للخطأ ولا يمكن الاعتماد عليه.
على أساس من هذه التصورات عبر عن نقده لمبدأ السببية عند الفلاسفة الذين حسبوا أن الإدراك البسيط هو الحقيقة، فاعترفوا بضرورة ما هو غير ضروري. إذ يرى الغزالي أن "ما يصدر بعد"؛ أي النتيجة، لا يعني أبداً "ما يصدر عن"، أي السبب. فثمة حاجة إلى نوع مختلف من البرهان ليثبت أن السبب المزعوم كان السبب الحقيقي الوحيد لتلك النتيجة[100]. وهو بذلك يؤكد أن العادة وحدها هي ما يقع في الأساس من تفكيرنا، وليس الدليل العقلي. ثم يصر الغزالي أن ما يربط النتيجة بسببها هو فعل الله الذي علينا أن نؤمن أنه يتكرر في أنساق، لأن الله لا يريد أن يخدعنا أو يُضلنا. وإذا كانت الأسباب فاعلة ويمكن تحديدها من خلال العلم، فذلك لأن فعل الله يجري على نسق، لا كما زعم الفلاسفة أن ثمة قوة ضرورية في السبب تدفع إلى نتيجته[101].
إن مثل هذه القضايا التي تتبعها الغزالي، أثناء بحثه عن الحقيقة في حقول معرفية مختلفة ومتباينة، "لا نجد فيها ما هو جديد ويستقل به تماماً، بالمعنى الدقيق للجدة، وإن كانت فيه إسهامات لامعة في مجالات تفصيلية عديدة، مما يجعل خطاب الغزالي خطاباً ذا جدة وأصالة حقيقة بالإعجاب، من مثل تدوينه التصوف كعلم بعد أن كان قائماً في صدور الرجال، ومثل معالجته لقضية السببية، وتقصي الحالات الوجدانية، والتحليق في المجال الذوقي، ورصد دور الخيال في المعرفة"[102]. بل في الواقع بلغت سلطة خطاب الغزالي وتأثيره في الثقافة العربية الإسلامية مبلغاً عظيماً نتيجة مراعاته لما اسماه أنور الزعبي بـسياسة العلم، التي تهدف إلى إقناع المخاطب للعمل بمقتضى الخطاب، "وهي مسألة تهتم أساساً بتدبر كيفية استيعاب وتشغيل الخطاب في الأوساط المختلفة"[103]، وفي المحصلة فإن خطاب الغزالي تمتع بجملة خصائص بارزة، أهمها: أنه "ينطلق من مراجعة نقدية جادة لأعمال سابقية، فضلاً عن مراجعة الفكر السائد في عصره، وأنه يدلل على سلامة التوجهات البديلة أو المطورة التي يسير هو فيها، وذلك بتسويغها وبيان سلامتها المنطقية، كي يحمل متلقي الخطاب على تمثله تمثلاً جيداً، ثم الاعتقاد به والانصياع لمقتضاه. هذا بالإضافة إلى أن صاحب الخطاب يصدر عن منهجية متماسكة، لها عناصرها ومقوماتها[104].
على ضوء ما سبق، يبدو أن بالإمكان تأويل تراث الغزالي في مجال المساعي الإسلامية المعاصرة في فلسفة العلوم، التي تدعو إلى ضبط كل مجالات المعرفة في نسق تفكير إسلامي، واستنباط الدروس المستفادة من حقائقها المتناثرة في المجالات المختلفة، ونسجها في أنساق ونظم تُشكل ما يمكن تسميته "الفلسفة العلمية الإسلامية". فـ"نظرية الاتساق، كما يقول زروق، ترفض القول بأن هناك معتقدات لا تحتاج إلى تبرير، إذ ينبغي أن نجد لكل قضية تبريراً. ويتم هذا التبرير ببيان أنها تتسق مع مجموعة قضايا تمثل نظاماً أو بنية، أو أنها تلزم من قضايا هذا النظام.
فغاية التبرير عند استخدام الدليل في منهج الاتساق ليست نقل مرتبة الإبستيمولوجية من معتقد إلى معتقد، ولكن نقل مرتبة الإبستيمولوجية التي يمتاز بها كل المعتقد إلى المعتقد المعين"[105]، وهي قضية فلسفية في الأساس تعنى بالجمع بين طرق معرفية قد يبدو أنها متعارضة أو متصارعة عندما تدرس منفصلة، تماماً كما فعل الغزالي عند جمعه ومعالجته "للطرق الفقهية التي وسمت بأنها ظنية، وطرق الفلاسفة والمتكلمين الموسومة بالبرهانية، وطريقة المتصوفة الموسومة بالذوقية"[106]. فإن فلسفة العلوم تكشف عن النسق الكلي لتلك العلوم التي تباينت طرقها وتعددت موضوعاتها.
في إطار هذا البحث عن نسق فكري وفلسفة علمية إسلامية للعلوم يأتي اهتمام المفكرين المعاصرين بمبحث المفاهيم الإسلامية واستدراكهم على المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في دائرة فقهية أضيق من المعنى الإسلامي الواسع الذي يمكن أن تعبر عنه. "ذلك لأن علماء المسلمين وقد كانوا منشغلين بالحقائق الدينية أو الشرعية كانوا يحرصون على هذه الألفاظ والمفاهيم فيما يسمونه المعنى الشرعي. فالمعنى الشرعي ليس خروجاً عن المعاني الإسلامية الواسعة، ولكنه تحديد وتحجيم لمتعلق اللفظ وترتيب من حيث الأهمية لمتعلقات هذه الألفاظ.
وعندما ننطلق من القرآن والسنة في معرفة معاني ألفاظنا ومفاهيمنا سنجد أن تلك المعاني الإسلامية التي أسميت شرعية هي نفسها المعاني المطلوبة في المجالات التي لم تحظ ببحثٍ كثير في المجالات العلمية الكونية والاجتماعية والإنسانية، وذلك سبب مهم في توحيد العلوم وإسلاميتها. وبهذا يكون المعنى الإسلامي للفظ هو المعنى العام للفظ الذي تستعمله الأصول الإسلامية. وفي المجالات المعينة يتعين معنى اللفظ أي يكون معنى اللفظ أعياناً مدركة. وهذا يوضح أن استخلاص المعاني العامة للألفاظ يفتح الباب على مصراعيه أمام توحيد العلوم الإسلامية، وبالتالي أمام إسلامية العلوم التي أغفلت في ماضي السنين"[107].
إن الحديث عن نظرية معرفة يتكامل فيها العلم والإيمان، وعن منظور معرفي يعول فيه على معارف الوحي، يقتضي نقد وتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة من جهة، وبتجديد العلوم الإسلامية التقليدية، علوم الشريعة وأصول الدين. فالتمييز بين هذه العلوم وإن ظل يؤطر حدود التخصص في مجالاتها المختلفة، إلا أنه لا يمنع من إضافة الوحي مصدراً للمعرفة في المجال الاجتماعي، وهي المسألة التي تباينت حولها رؤى المعاصرين[108]. حيث فهم المرزوقي أن ربط الوحي بالعلوم الاجتماعية "مقايسة للعلم على الفقه في الاستناد إلى الوحي[109]، في الوقت الذي دافع فيه آخرون عن فكرة التداخل بين علوم الشريعة والعلوم الاجتماعية، وهي فكرة قريبة الشبه بتلك التي أشرنا إليها آنفاً في الصنف الثالث من العلوم وفقاً لتقسيم الغزالي، الذي سبقت الإشارة إليه آنفاً.فالعلوم الاجتماعية ليست علوماً وصفية خالصة، بل تتضمن مقولات قيمية، "كما أن الفقه لا يخلو من بعض المقولات الوصفية التي ترد عند تعليل الأحكام أو بيان حكمتها"[110].
هذه النتيجة ذاتها انتهى إليها التجاني عبد القادر حامد: فنبه إلى أن موضوعات علم السياسة التي يشتغل عليها المعاصرون هي ذاتها موضوعات علم السياسة الإسلامية، غير أن علم السياسة في التراث الإسلامي لم ينشأ علماً مستقلا عن الفقه، في أبواب الإمامة والجهاد. فقد كان الفقهاء الذين يتصدون لها هم علماء الأحكام من أصحاب النظرة القانونية التشريعية، تقريراً للأحكام السلطانية والعلاقات النظامية التي تشهد لها النصوص ويسير عليها المجتمع من الناحية العلمية. ويحكم حامد على هذه المنهجية الأصولية بالقصور في مجالات علم السياسة والعلوم الاجتماعية لعدة أسباب، منها: أنها، أولاً، تقصي المفاهيم والمعاني والأوصاف التي لا تشتمل على أحكام، وهي مفاهيم وأوصاف ذات مضامين أخلاقية مهمة ينبني عليها الفعل السياسي/الاجتماعي. كما أنها، ثانياً، تؤسس النظام السياسي على الإجماع، ولكنها تحول الإجماع إلى مسألة قانونية شكلية، وتغفل عملية التراضي التي تسبقه. كما أنها، ثالثاً، تركز على الإنسان الفرد، وعلى الخصائص الذاتية له، وتغفل المحيط الاجتماعي الذي يتحرك فيه ويتفاعل معه[111].
إن هذا الذي يقرره المشتغلون بالعلوم الاجتماعية من أهمية المزاوجة بين علوم الشريعة والعلوم الاجتماعية الحديثة، وتفكيك بناها ونماذجها على ضوء مرجعية معارف الوحي ومفاهيمه، يؤكد على جانب منه علماء الطبيعة، حيث يقول محجوب عبيد طه: "إن البحث العلمي، على مستوى التفاعلات الأساسية، كان دائماً مقترناً بفرضيات فلسفية أو مواقف عقدية، لا تقتضيها بالضرورة التجارب المعملية. وهذا الاقتران مهم لأنه يعطي امتداداً فكرياً وحضارياً للمجهود البحثي في العلم الطبيعي، ويمكنه من الإسهام، ليس فقط في مجال التطبيقات التقنية، وإنما أيضاً في مجال الفكر الإنساني الذي يطمح في التعمق في فهم الحياة وتنظيمها. ولذلك فإننا نجد أن صياغة كثير من القوانين العلمية الأساسية تجنح لشمولية واسعة، وتقرر مبادئ فوق أبعاد التجربة، فتحدد بذلك مواقف فلسفية معينة، وتترك انطباعاً واضحاً بأن هذه المبادئ الفلسفية بعينها هي ثمرة العلم التجريبي وما عداها باطل"[112].
وهكذا يمكن أن تفهم هذه الإفادات جميعها على أنها محاولات لتأكيد أن العلوم الإسلامية أوسع دلالة من علوم الشريعة وأصول الدين، فللإسلام تصوره الذي يمتد ليغطي أو يتقاطع مع العلوم المختلفة. وهو تصور لن يتولد عنه إضرار بالتفكير العلمي، أياً كان منطلق الحكم على ما يترتب على تلك المحاولات من نتائج، لأن أثر رؤى الإسلام وتصوراته على التجارب والاستنتاجات العلمية التي يُعبر عنها عالم من العلماء أو باحث في مجالات المعرفة الحديث المختلفة سيجري تقييمها من قبل المجتمع العلمي والتدقيق فيها، فإذا كانت خاطئة ستكشف ويجري نقدها ومحاولة تصحيحها.
ملاحظات ختامية
إن محاولة المساهمة في دفع النقاش حول مكانة "المعرفي" في سؤال النهضة العلمية والحضارية من خانة الأيديولوجيا المنغلقة إلى الدراسة العلمية المعرفية الهادفة قادتنا، في هذه الدراسة، إلى البحث في علاقة أفكار الغزالي في "التهافت" و"الإحياء" بظاهرة ازدهار العلوم في الحضارة الإسلامية. وهو بحث قصد منه استثمار فهم تاريخ العلم في الإسلام في مراجعة مسارات التأصيل المعرفي والتحيز المنهجي، وتقييم جدواها في تطوير العلوم وازدهارها بمؤسسات البحث والمعرفة والتعليم بالعالم الإسلامي.وفي هذه المراجعة، التي قصد منها صاحب هذه الدراسة فهم موقعه من مشروع التأصيل المعرفي، أكدنا على أهمية إصلاح طرق التفكير ومناهج بناء العلوم، لما لها، في تقديرنا، من أهمية في تجاوز الأزمة الحضارية الراهنة وبلوغ الفاعلية الإسلامية. وهي لهذا السبب يجب حمايتها من الوقوع في الأيديولوجية الخالصة، إذا قصد بالأيديولوجية تلك المعالجة التي تنشغل بمطالب سياسية ودوافع عملية تتطلب فعلاً غائياً لا شأن له بالنظر العلمي[113]، بل تتقلب في "فضاء المثل المفارقة للواقع"، في حين أن "منطق الواقع هو الذي ينبغي أن يسود ويغلب، لأن الواقع نفسه هو الذي يفرض الطرق الناجعة والمناهج المجدية لحل المشكلات والقضايا التي تهدد مصيره ونهاياته"[114].
نقول ذلك لأن تجربة التأصيل المعرفي اليوم تطرح، بالفعل، مشكلات معرفية أساسية، فالتأصيل وإن كان، في تصوره المرتجى، يتصل بالمعرفة لأنه يُعنى باللغة وبالدين وبالعلوم وبالثقافة، فإنه، في المقابل، لا يجري في أغلب تجاربه المعاصرة وفق مطالب العلم، وإنما تكتنفه العاطفة والهوى والرغبة والأماني وإغفال الواقع والحقائق المشخصة، وكأن "الهوى الأيديولوجي يتلبس جملة أشكال النظر فيه"[115]. ولا يمكن، في تقديرنا، استجلاء هذه المسألة من غير تحرير الهدف من التأصيل المعرفي وغايته، ومناقشة حدود التداخل والتباين بين "إعادة بناء علوم الأمة"؟[116]، ومسألة التمسك بالهوية؟[117].
وقد كان من ثمار المراجعة الحالية إبراز أهمية البحث في شروط النهضة العلمية التاريخية، وتصحيح ما شاع عن الإمام الغزالي والتعليق على جانب من إسهاماته المنهجية التي تفرد بها. لكونها إسهامات جاءت بعد توترات تسببت فيها المنظورات المتقابلة، بين المشتغلين بالعلوم العقلية، كما عرفها اليونانيون، وعلماء الإسلام المشتغلين بالمباحث التقليدية. حيث أوضحت الدراسة أن استيعاب تراث الأمم الأخرى والموقف منه لهما؛ (أي الاستيعاب وتشكيل الموقف) صلة بالفاعلية الحضارية والنهضة العلمية وحاضنتهما الثقافية. فنبهنا إلى أن الإشكال، هاهنا، سببه أن جهود الباحثين تحتفي، عادة، بالعلامة ابن خلدون وتنطلق من طريقته في تقييم عملية استيعاب التراث اليوناني إبان نهضة المسلمين العلمية تاريخياً، فيما تعزو الموقف السالب من تراث الأمم الأخرى والمتنكر له بصنيع الإمام أبي حامد الغزالي؛ ولهذا أولينا اهتماماً خاصاً لدحض مقولة أن ما قام به صاحب التهافت يمثل "تفاعلاً قاتلاً[118]، أو أنه يعكس صراعاً مريراً بين المتكلمين وطوائف من أهل العلم، ووأداً للتفكير الفلسفي جسد "بداية انهيار الجانب العلمي التطبيقي والمعرفي النظري ]فـ[شمل الفلسفة والعلوم التطبيقية ]معاً[، واعتبارها علوماً دخيلة ومهددة للدين، فتم خنق هذه العلوم بدعوى حماية الدين"[119]. فمثل هذا الحكم بجانب أنه يُظهر تعجلاً في تقييم ما انتهى إليه الغزالي في التهافت، يغيب إمكانية إعادة قراءة إضافة ابن خلدون في سياق مكمل لمشروع الإمام الغزالي.
كما قادنا البحث إلى الاطمئنان إلى أن التفسير الخاطئ لظاهرة ازدهار العلوم في الحضارة الإسلامية ساهم، في الغالب، في تشكيل موقف إسلامي مرتبك من التراث العلمي والحضاري للأمم الأخرى، وما لم يتم الوعي الصحيح بالتاريخ العلمي في الإسلام، فإن عدداً من الإشكالات ستظل تربك الساحة الإسلامية في المجالين الفكري والعلمي، ولعل أهم تلك الإشكالات الثلاث التالية:
أولاً؛ تغييب دراسة الشروط الموضوعية للنهضة العلمية لصالح مراجعات فكرية وفلسفية نظرية، والاعتقاد في أولية الإصلاح الفكري على غيره عند الحديث عن كيفية تجاوز الأزمة الإسلامية الحضارية كما فهمت في سياق العصور الحديثة.
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن خطة (أو بالأحرى خطط) إسلامية المعرفة، التي قصد بها أن تعبر عن رؤية عدد من مثقفي الأمة وأساتذة الجامعات وموقفهم من عملية الإحياء والبعث والإصلاح والنهوض الحضاري في العالم الإسلامي، انتهت، إلا نادراً، إلى وثيقة يرتبط استدعائها في الذاكرة بجماعة عرفت نفسها باهتمامها بالإصلاح الفكري، ونظرت لموقعها على أنه يمثل "ثغرة مهمة من ثغور العمل الإسلامي"، تتطلب "العمل المؤسسي لإصلاح الفكر الإسلامي معرفياً ومنهجياً، إدراكاً ]من أصحاب هذا الرأي[ لما للمعرفة في ذاتها من أثر في توجيه الحياة الإنسانية، مما يجعلها جديرة بجهود علمية وفكرية منظمة ودؤوبة"[120]. وهذا العمل المؤسسي غايته "تطوير منظور معرفي جديد والسعي لتكوين علماء ومفكرين مسلمين ذوي أصالة إسلامية راسخة وفهم عميق ومواكب لحقائق العصر وأوضاعه"[121]، فهؤلاء العلماء والمفكرين يُعول عليهم، من وجهة النظر هذه، في تعويض إخفاقات جهود الإسلام السياسي التي عجزت عن "بلورة رؤية كلية كونية للإسلام، تبرز علاقته بكل لحظة من حياة البشر، وبكل أطياف النشاط الإنساني المعاصر"[122].
وإذا كانت تلك هي الغاية فإن هذا التركيز على تطوير نموذج معرفي بديل، من خلال مراجعات نقدية في الفكرين الإسلامي الموروث والغربي الوافد،ظل يغفل الشروط الموضوعية للتكوين العلمي، التي تقتضي توفر البيئة العلمية من حريات ودافعية وإمكانات مادية وسند مجتمعي وغيرها من شروط شبيهة بما توفر للنهضة العلمية في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. فقد ركزت مؤسسات التأصيل المعاصرة على نقد الفكر الغربي أكثر من تركيزها على مسألة تقديم مساهمة نوعية تذكر في العلوم التي عليها قوام العمران.
ويبدو، كذلك، أن تجربة العقود القريبة الماضية تعزز الاعتقاد في أن نقد نتائج العلوم الحديثة، واجتهادات العلماء التي حوتها كتب التراث عندما تتم بمعزل عن عمليات التنمية والنهضة بالمجتمع والاستجابة لحاجاته العملية، فإنها لا تفتح آفاق للتفكير العلمي المتجدد، بل قد تعوقه.
ثانياً؛ شيوع تصور لدى بعض المشتغلين بموضوعات العلوم الاجتماعية والإنسانية من المسلمين المعاصرين يختزل المقاربة التأصيلية في حدود المعالجة الفقهية التي تُعنى بضبط الأحكام وتقعيد أصولها ودراسة مقاصدها، وكأن التأصيل المعرفي يدور في فلك الفقهيات الشرعية والمقاربات الدينية. ولا يخفى أن مثل هذه المقاربات يمكن أن تنتهي بأنصارها إلى عائق نفسي يحول دون تواصلهم الخلاق مع الفكر الإنساني عموما، والغربي على وجه الخصوص.
لا شك أن مثل تلك الظاهرة، المشار إليها أعلاه، قد تعود أسبابها إلى التكوين العلمي الأحادي في مجال العلوم الشرعية عندما يغفل المباحث ذات الصلة بها في العلوم الاجتماعية، أو إلى الموقف من العلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة في بعض الجامعات ومعاهد العلم الشرعي. بيد أن هذا كله يتطلب رسم سياسات تعليمية وحركة علمية دؤوبة تدفع بأصحاب التكوين الأحادي إلى مزيد من الاستفادة وفق منهجية مدروسة من المعارف والعلوم ذات الصلة بالقضايا العلمية التي يشتغلون عليها.
صحيح أن التجربة التاريخية لازدهار العلوم الإسلامية تفيد أن شيئاً من التفاعل الخلاق بين الأصيل والوافد من العلوم قد حدث بشكل تلقائي سلسل، إلا أن الواقع الراهن يتطلب الوعي المؤسسي بإمكانية اصطناع أوضاع تعيد تلك الممارسات التراثية في سياقات معاصرة. فلولا المواقف المتباينة من تراث اليونان، بين مؤيدين لها ملتمسين فيها معرفة فنية تقربهم من السلطان بالخدمة في مؤسسة الخلافة، وفريق آخر عمل على بلوغ غاية الوصول للسلطان بإجادته للغة العربية التي نقلت لها علوم الأوائل، فكتبت بلغة جعلت من ارتباطها بعلوم الدين أمراً يقتضي مراجعة النص المترجم وتصحيح ـأخطائه العلمية والنظرية الفلسفية جنباً إلى جنب. لولا ذلك لما أثمر ذلك الجدل حول الموقف من علوم اليونان يومها نقداً وشكوكاً علمية ودينية وفلسفية في الأساس، فـ"ولدت حقولا جديدة من المعرفة، مثل: علوم الهيئة، والفرائض، والميقات"[123] اتساقاً مع ميول أصحاب التفكير الديني. "وقد استطاعت هذه الحقول أن تثبت تفوقها العلمي بجانب مكانتها الدينية"[124].
ثالثاً؛ في غياب تشكل الحقول المعرفية الجديدة أو البديلة، التي كانت تأملها حركة التأصيل، والمشار إليها أعلاه، سيظل النقاش النظري يضخم أهمية البحت حول الموقف من التراث العلمي الغربي، في العلوم الاجتماعية والإنسانيات خاصة، وفي ظل هكذا وضع فإن المؤسسات العلمية والبحثية ستظل تعنى بنقد نتائج العلوم، وإبراز عقائد من صاغوا نظرياتها وقوانينها. وهي مناقشات، كما أوردنا في هذه الدراسة، على قدر من الأهمية الحضارية لولا أنها أغفلت بعدين مهمين في تقديرنا، وهما:
- كشف مسلمات العلماء وإن كان يفيد في معرفة التحيزات وتفسيرها، إلا أنها لا توفر حافزاً قوياً للإسهام في العلوم. ما يوفر هذا الحافز هو عمليات المراجعة والنقد والاشتباك مع نتائج العلوم، ورصد أخطائها إن وجدت. فالرصد عادة يحفز الباحثين أو الجماعة العلمية لبذل مزيد من الجهد والصبر للوصول إلى نتائج جديدة، تكون أصدق من تلك التي تم نقدها. ويبدو أن شيئاً من ذلك بالفعل قد وقع في تاريخ العلوم في الإسلام، عندما كشف العلماء عن أخطاء علوم اليونان وطوروها لأغراضهم الحضارية الخاصة. وفي حال التأكد من صحة نتائج العلوم التي انتهت إليها أمم أخرى فليس ثمة داعٍ علمي أو ديني يقتضي رفضها أو التنكر إلى نسبتها لأصحابها، بل الأولى السعادة بها وتوطينها في النسق الفكري الإسلامي.
- إن استنفاد الطاقات في مراجعات لا تتصل بهموم التنمية المباشرة، في مجالات الاجتماع والسياسة والاقتصاد، يولد الإحساس بأن مشروع التأصيل المعرفي يعيد ما انتقد من قبل على الحركة الفلسفية في الإسلام من تقصير، حيث مال ممثلوها يومئذ "إلى التفكير المجرد على طريقة اليونان وظلوا يدورون في حلقة القضايا الميتافيزيقية والطبيعية التي طُرحت على اليونان أو طرحها اليونان على أنفسهم. فابتعدوا، إلا لماماً، عن الحياة العامة الحقيقية"[125]. ومثل هذا التفكير قد يعكس مقاربات تنتسب إلى الفلسفة أو إلى الحجاج الديني على طريقة الغزالي في "التهافت" لكنه، في المقابل، لا ينشغل بالمساهمة في العلوم التي عليها قوام الحضارة والعمران.
وبعد، فإن النتائج التي انتهت إليها الدراسة تعزز من أهمية إعادة التفكير مجدداً في أس الإشكال الأول الذي تعاطى معه مشروع التأصيل الإسلامي للمعرفة، إشكال النهضة والتقدم والفاعلية الحضارية في الأزمنة الراهنة؛ حيث اتضح أن العلوم (نشأة وازدهاراً، أو تراجعاً وانكماشاً) ترتبط بمحيطها الفكري العام، وبمقومات اجتماعية وسياسية وتعليمية تسند عملية الإنتاج العلمي. وبمثل تلك المقومات والشروط يمكن إعادة التعبير عن التصور العام لقضية التأصيل المعرفي من خلال استحضار سؤال دورها في النهضة العلمية التي ظلت تشغل أنظار المسلمين منذ عصر النهضة العربي بحثاً عن أسس التقدم والفاعلية الحضارية. وما لم تضبط (بوصلة) التأصيل المعرفي وتتضح النهايات التي ينشدها فإن جهوده ستظل تراوح مكانها.
الهوامش
[1]. عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تقديم وتحقيق: إيهاب محمد إبراهيم، القاهرة: مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع؛ 2009، ص459.
[2]. المرجع نفسه.
[3]. المرجع نفسه.
[4].W. Montgomery watt: The formative Period of Islamic thought, (OneWorld Publication; London, 2008; Reprinted 2009).
[5]. فقد حفلت هذه الفترة بالإسهامات التأسيسية في مجالات الأصول الكلامية والفقهية واللغة والحديث والتفسير. انظر: محمد أبو زهرة، الإعلام بأعلام الإسلام: مقالات العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في مجلة العربي، كتاب العربي، الكويت، 2015.
[6]. فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع؛ 1988، ص56.
[7]. جورج صليبا مثالا مهماً في هذا الصدد كما سترد الإشارة له بالتفصيل لاحقاً.
[8]. عنوان مقال لعبد الرحمن بدوي، انظر عبد الرحمن بدوي: أوهام حول الغزالي، مؤتمر الغزالي دراسات في فكره وعصره وتأثيره، الرباط: كلية الآداب بجامعة محمد الخامس 1988. متاح على الرابط التالي:
http://www.ghazali.org/site-ar/gz-default-ar.htm
[9]. إسلامية المعرفة عنوان وشعار لأنشطة المعهد العالمي للفكر الإسلامي وبرامجه منذ تأسيسه في العام 1981م؛ للوقوف على الفكرة الأولى التي انطلقت منها هذه المؤسسة، يُمكن مراجعة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي: إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل والإنجازات، (فيرجينيا؛ الولايات المتحدة الأمريكية، 1987م). أما إسلام المعرفة فهو الشعار الذي اتخذت منه جامعة الجزيرة بالسودان رؤية لمؤسسة أنشأتها، بذات المسمى (معهد إسلام المعرفة)، بغرض تقديم "الأبحاث المتقدمة في مجال العلوم الاجتماعية وفلسفة العلوم"؛ للاطلاع على الرؤية التأسيسية لهذه المؤسسة يمكن مراجعة ورقة محمد الحسن بريمة إبراهيم: نحو برنامج للبحث العلمي في إسلام العلوم، معهد إسلام المعرفة بجامعة الجزيرة، 1994.
[10]. انظر في ذلك: أبوبكر محمد أحمد محمد إبراهيم، التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ فيرجينيا، 2007.
[11]. عبد الوهاب المسيري (تحرير)، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995. انظر تصدير الكتاب ومقدمة المحرر.
[12]. عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، م، س، ص458.
[13]. المرجع نفسه، ص454.
[14]. المرجع نفسه، ص614.
[15]. عبارة ابن عاشور في ذلك: "وأيقنت أن لأسباب تأخر المسلمين عموماً رابطة وثيقة بأسباب تأخر العلوم". محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب–التعليم العربي الإسلامي: دراسة تاريخية وآراء إصلاحية، قرأه ووثقه وقدم له: محمد الطاهر الميساوي، الخرطوم: دار الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق، وهيئة الأعمال الفكرية، ط1، 2010، ص313.
[16]. جورج صليبا، العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوربية، ترجمة: محمود حداد، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، كلمة، 2011م، ص16.
[17]. المرجع نفسه.
[18]. المرجع نفسه.
[19]. كما حدث في علم الحيل (أي في الميكانيكا)، مع أعمال الجزري (المتوفي حوالي 1205م)، أو في علم المنطق والرياضيات وعلم الفلك مع أعال أثير الدين الأبهري، (المتوفي 1240م) ومؤيد الدين العدضي (المتوفي 1266م) ونصر الدين الطوسي (المتوفي 1274) وقطب الدين الشيرازي (المتوفي 1311م) وابن الشاطر (المتوفي 1375) والقوشجي (المتوفي 1474م) وشمس الدين الخفري (المتوفي 1550م)، أو في علم البصريات، أو علم الصيدلة، وفي الطب، مع أعمال ابن النفيس (المتوفي 1288م)، فقد شهد كل مجال من هذه المجالات إنتاجاً حقيقياً مبتكراً وثورياً ظهر بعد وفاة الغزالي ومهاجمته الفلاسفة، وكان ينتج هذا الفكر أحياناً حتى داخل أحضان المؤسسات الدينية. انظر المرجع السابق، ص43-44.
[20]. عبد الرحمن بدوي: أوهام حول الغزالي، م، س.
[21]. المرجع نفسه، ص2 في النسخة الإلكترونية. ويضف في ص3 (في ذات النسخة) "ثم أنه لمن الغاية في السذاجة أن يقال إن كتاباً من الكتب أو هجوما لمؤلف –مهما كبر قدره-قد قضى على علم راسخ كالفلسفة".
[22]. أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة، تحقيق: سليمان دنيا، القاهرة: دار المعارف المصرية، ط4، ص64.
[23]. المرجع نفسه، ص24.
[24]. أبو يعرب المرزوقي، شروط نهضة العرب والمسلمين، م، س، ص129-130.
[25]. المرجع نفسه، ص130.
[26]. فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام، م، س، ص33.
[27]. إسماعيل الفاروقي ولمياء الفاروقي، أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، مكتبة العبيكان: الرياض، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1418هـ، ص432.
[28]. أبو يعرب المرزوقي، شروط نهضة العرب والمسلمين، دمشق: دار الفكر المعاصر؛ لبنان، ودار الفكر، 2001، ص249.
[29]. المرجع نفسه.
[30]. المرجع نفسه.
[31]. المرجع نفسه.
[32]. المرجع نفسه.
[33]. رضوان السيد: عبد الوهاب المسيري ولعنة الغرب (8 يوليو 2008)، متوفر الكترونيا على الرابط التالي:
http://www.voltairenet.org/article157654.html.
[34]. أبو يعرب المرزوقي: شروط نهضة العرب والمسلمين، م، س، ص252. (بتصرف)
[35]. عبد الله حسن زروق، نظرية المعرفة عند إمام الحرمين الجويني، ضمن كتاب ندوة الذكرى الألفية لإمام الحرمين الجويني، قطر: كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة/الدوحة، 6-8 أبريل 1999، ص165.
[36]. مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دمشق: دار الفكر، ط17، 2015، ص13.
[37]. المرجع نفسه، ص14.
[38]. المرجع نفسه، ص15.
[39]. المرجع نفسه، ص14.
[40]. دون ذلك في تصديره لترجمة مقدمة ابن خلدون في نسخة 2005. انظر:
Ibn Khaldun: the Muqaddimah: an Introduction to history, Translated and introduced by Franz Rosenthal, abridged and edited by N. J Dawood, with an introduction by Bruce B. Lawrence, (Princeton University; New Jersey 08540, USA), 2015, p. xii.
[41]. المقدمة، م، س، ص458.
[42]. المقدمة، م، س، ص484.
[43]. بتصرف من عبارة ابن خلدون "البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم، العاجزون عما فوقه، وأن الحضر ]هم[ المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم". ابن خلدون: المقدمة، م، س، ص131.
[44]. جورج مقدسي، الكليات: نشأة معاهد العلم في الإسلامي والغرب المسيحي، نقله إلى العربية: محمود سيد محمد، القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، ط1، 2015، ص436.
[45]. جورج صليبا، العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية، م، س، ص81.
[46]. المرجع نفسه، ص83.
[47]. المرجع نفسه، ص94.
[48]. المرجع نفسه.
[49]. المرجع نفسه.
[50]. المرجع نفسه، ص97.
[51]. المرجع نفسه، ص96.
[52]. المرجع نفسه.
[53]. المرجع نفسه، ص106.
[54]. المرجع نفسه.
[55]. المرجع نفسه.
[56]. المرجع نفسه، ص107.
[57]. المرجع نفسه، ص107-108.
[58]. المرجع نفسه، ص109.
[59]. المرجع نفسه، ص110.
[60]. كعائلة بختيشوع التي أنجبت عدة أطباء مرموقين للبلاط العباسي، والتي توارث أفرادها وظائفهم أباً عن جَدٍّ على مر قرن تقريباً. كما أن عائلة نوبخت بلغت هي الأخرى أعلى المناصب بين منجمي البلاط، وعلى مر أجيال عدة يعقب فيها الابن الأب"، م، س، ص110.
[61]. جورج صليبا، م، س، ص112.
[62]. المرجع نفسه، ص117.
[63]. المرجع نفسه، ص118.
[64]. المرجع نفسه، ص115.
[65]. المرجع نفسه.
[66]. عبارته في ذلك: "الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله". عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، م، س، ص454.
[67]. محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص314.
[68]. جورج مقدسي: الكليات: نشأة معاهد العلم في الإسلامي والغرب المسيحي، م، س، ص198.
[69]. توضح سيرة الغزالي أن أستاذه الجويني عندما قرأ تعليقاته صاح قائلاً: "دفنتني وأنا حي! هلا صبرت حتى أموت". حيث يفهم من ذلك أن إمام الحرمين أدرك أن تلميذه بدأ، وهو في هذه المرحلة من طلب العلم، في "تجاوز" أستاذه في بعض مسائل العلم، "فقد علق بإخلاص على درس أستاذه، مع معارضته أيضاً في عدة مواضع، وإعطاء أجوبته الخاصة عن المسائل"، كما نوه إلى ذلك المحققين. المرجع نفسه.
[70]. جورج مقدسي، م، س، ص386.
[71]. المرجع نفسه، ص387.
[72]. راجع مبحث المجتمع العلمي في المرجع نفسه.
[73]. أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول، دراسة وتحقيق: أحمد زكي حماد، (دار الميمان للنشر والتوزيع؛ الرياض، والشركة العالمية للنشر والترجمة والتدريب؛ القاهرة)، ط1؛ 2009، ج1، ص4.
[74]. المرجع نفسه.
[75]. إسماعيل راجي الفاروقي ولوس لمياء الفاروقي: أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومكتبة العبيكان؛ الرياض، 1998، ص431-436.
[76]. إسماعيل راجي الفاروقي ولوس لمياء الفاروقي: أطلس الحضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص432.
[77]. إبراهيم محمد زين: الاستقراء عند الشاطبي ومنهج النظر في مدوناتنا الأصولية، مجلة إسلامية المعرفة، السنة 8، العدد 30، خريف 2002م ص32.
[78]. علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي، (دار النهضة العربية؛ بيروت، 2016)، ص149.
[79]. المرجع نفسه.
[80]. المرجع نفسه.
[81]. المرجع السابق، ص159.
[82]. أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق، ص5.
[83]. عرفان عبد الحميد فتاح: الإمام الغزالي: دراسة في المنهج، (مجلة المجمع العلمي العراقي، ع3-4؛ أكتوبر 1981)، ص585.
[84]. المرجع السابق، ص589.
[85]. المرجع نفسه.
[86]. المرجع نفسه (بتصرف).
[87]. أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة، تحقيق سلمان دنيا، ص63.
[88]. عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص454.
[89]. أبوبكر محمد أحمد محمد إبراهيم: التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية، م، س، ص214.
[90]. عبد المجيد النجار: تصنيف العلوم في الفكر الإسلامي بين التقليد والتأصيل، ضمن: الطيب زين العابدين (تحرير): المنهجية الإسلامية في العلوم السلوكية والتربوية، (المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ فيرجينيا، 1990)، ج1، ص256.
[91]. المرجع نفسه.
[92]. إبراهيم محمد زين: تدريس الفقه وأصوله من وجهة نظر معارف الوحي، مجلة تفكر، (معهد إسلام المعرفة بجامعة الجزيرة بالسودان، ود مدني، مج1، ع1، 1999)، ص127.
[93]. المرجع السابق، ص135.
[94]. المرجع السابق، ص432.
[95]. ميشيل مرمره: إعادة النظر في علاقة الغزالي بالأشعرية، ضمن رشدي راشد (إشراف): دراسات في تاريخ علم الكلام والفلسفة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014، ص287.
[96]. المرجع السابق، ص291.
[97]. المرجع السابق، ص288-289. (بتصرف)
[98]. إسماعيل راجي الفاروقي ولوس لمياء الفاروقي: أطلس الحضارة الإسلامية، م، س، ص432.
[99]. المرجع السابق، ص435.
[100]. المرجع نفسه.
[101]. المرجع السابق، ص436.
[102]. أنور الزعبي: مسألة المعرفة ومنهج البحث عند الغزالي، (المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ودار الفكر بدمشق)، ص35.
[103]. المرجع نفسه.
[104]. المرجع السابق، ص37.
[105]. عبد اﷲ حسن زروق: نظرية المعرفة عند إمام الحرمين الجويني، ص166.
[106]. أنور الزعبي، م، س، ص49. (بتصرف)
[107]. إبراهيم أحمد عمر: العلم والإيمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام، ص62. (بتصرف)
[108]. انظر في مناقشة هذه المسألة بتوسع، أبو بكر محمد أحمد محمد إبراهيم: التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية، م، س، ص94-96.
[109]. أبو يعرب المرزوقي: إسلامية المعرفة: رؤية مغايرة، مجلة إسلامية المعرفة، (المعهد العالمي للفكر الإسلامي، كولالمبور، خريف 1998)، س4، ع14، ص148.
[110]. محمد أنس الزرقا: تحقيق إسلامية علم الاقتصاد: المفهوم والمنهج، ضمن:
IIIT: Toward Islamization of Disciplines, (international Islamic Publishing House; Riyadh & international Institute for Islamic Thought; Herndon), 1995, p.317.
[111]. التجاني عبد القادر حامد، التفسير التأويلي وعلم السياسة: دراسة في المفهوم القرآني والمتغير السياسي، مجلة إسلامية المعرفة، (المعهد العالمي للفكر الإسلامي، كولالمبور، خريف 1997)، س3، ع10، ص52. (بتصرف)
[112]. مجحوب عبيد طه: عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية، ضمن: عبد الوهاب المسيري (تحرير): إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، م، س، ص551.
[113]. هذا الاقتباس مأخوذ بتصرف عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003م: نحو إقامة مجتمع المعرفة، عمان، ص114.
[114]. فهمي جدعان: في الخلاص النهائي: مقال في وعود النظم الفكرية المعاصرة، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، 2012، ص235.
[115]. التعبير مقتبس من المرجع السابق.
[116]. هذا طرف من عنوان كتاب لطه جابر العلواني بالاشتراك مع منى أبو الفضل: نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية: مراجعات منهاجية وتاريخية، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 2009.
[117]. على سبيل المثال، يرى رضوان السيد، راي لا يوافق الباحث عليه، أن التأصيل "مهمة تطهيرية للثقافة العربية والإسلامية من أوضار الغرب وشروره". رضوان السيد: ثقافة العالم الإسلامي والبحث عن هوية، (مجلة العربي، يونيو 1998). والمقال متوفر على هذا الرابط:
http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=6651
[118]. جاسم سلطان: نحو وعي استراتيجي بالتاريخ، بيروت-القاهرة-الدار البيضاء: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2015، ص127.
[119]. المرجع نفسه.
[120]. يراجع محمد الطاهر الميساوي (تقرير): مستشارو المعهد العالمي للفكر الإسلامي في لقائهم الرابع بكوالالمبور بماليزيا في ديسمبر 1996، مجلة إسلامية المعرفة، السنة الثانية، العدد الثامن، ص202.
[121]. المرجع نفسه.
[122]. إسماعيل راجي الفاروقي: التوحيد: مضامينه على الفكر والحياة، ترجمة: السيد عمر، القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، ط2، 2014، ص36.
[123]. جورج صليبا: العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوربية، م، س، ص207.
[124]. المرجع نفسه.
[125]. فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام، م، س، ص44.


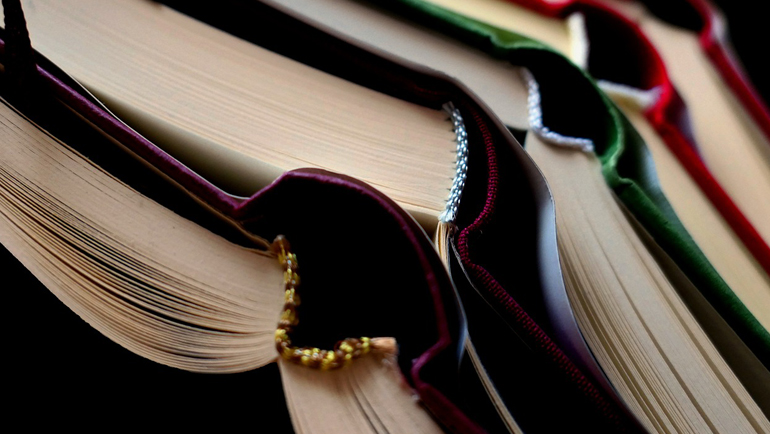





ما المقصود بمصطلح “العلوم الإسلامية” وكيف تم تقسيمها وفقاً للتقسيم الخلدوني؟