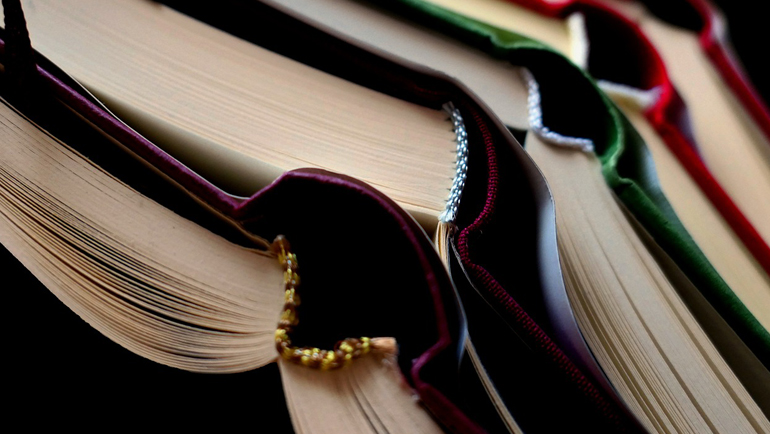تمثل الحسبة الوعاء الجامع الذي انتظمت فيه جميع المضامين الشرعية الداعية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أصبحت الحسبة الحاضنة المؤسسية لجميع تلك المضامين، لتتأهل مؤسسة الحسبة بذلك لتكون القناة الحصرية والمسلك الشرعي الوحيد الذي يضمن تفعيل تلك المضامين الشرعية داخل الزمن في إطار من النظام والانتظام المحكوم بالقواعد المنهجية والأسس الشرعية، فلم تعد ممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصح إلا من خلال ما يُمليه فقه الحسبة من قواعد وأحكام وضوابط، وهذا الشكل الشرعي الذي استقرت عليه تلك المضامين [مؤسسة الحسبة] حصنتها من التوظيفات الطائفية والتأويلات الفاسدة، وأمدتها في الوقت نفسه بالأساليب والأدوات التي جعلتها تعيش في قلب مشكلات الزمن وتحدياته، وأهلتها لتكون قادرة على إدارة حياة الناس والمجتمع والاستجابة لمتطلباتهم وتحقيق مصالحهم بكفاءة عالية نموذجية.
إن انتظام المضامين الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار شكلي [مؤسسة الحسبة] هو تأكيد على حرص الفقهاء الدائم والمستمر لتطوير الأشكال والأساليب الضامنة لتفعيل مضامين الشريعة بشكل سليم وصحيح داخل الزمن، وهذا الارتباط بين المضامين والأشكال الشرعية هو ارتباطٌ عام يشمل جميع مؤسسات الإسلام، حيث تستند مؤسسة الوقف ـ على سبيل المثال ـ على المضامين الشرعية الداعية إلى البر والخير، وكذلك مؤسسة القضاء والمظالم التي تستند على المضامين الشرعية الداعية إلى تحقيق العدالة والأمن وحماية الحقوق والمصالح، والفقهاء هم الذين راكموا الاجتهادات والطرق المتشعبة لضمان استمرارها داخل كل الظروف والصعوبات المحتملة داخل الزمن.
وقد بلغت درجة التداخل بين المضامين الشرعية وأشكالها حدا يصعب معه الفصل بينهما، وأصبح تجريد المضمون الشرعي من شكله الشرعي موجبا لموت بنيوي لمضمون الشريعة وأحكامها بشكل تلقائي، وتجريدا لفاعليته في الزمن، فالممارسات التاريخية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تورَّطَ فيها البعض فقاموا بها مجردة من أشكالها الشرعية [الحسبة] كانت في أغلبها سببا للفوضى ومدخلا للفتنة.
وهذا ما يؤكد ذلك الترابط الصلب بين المضامين وأشكالها في الشريعة، باعتبارها ثنائية مركزية، وأنها المدخل الجوهري لبناء تصور صحيح ومتكامل عن الشريعة والفقه بعيدا عن الآراء الاختزالية والتبسيطية.
وتأتي هذه الورقة لأستعرض من خلالها مظاهر الصفة المؤسسية للحسبة مع بيان خواصها الشكلية المميزة لها، وسأبرز بشكل خاص الدواعي والأسباب التفسيرية لتصنيف الحسبة باعتبارها مؤسسة، وتحقيقُ هذا المقصد وَقْفٌ على جملة من المقدمات تتعلق بالنظر باختصار في صفة «المؤسسة» كيف نشأت في الإسلام؟ وما هي معايير الاتصاف بها؟ وماهي الأدوار التي تضطلع بها الصفة المؤسسية؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات أستعير من ذ علي عزت بيجوفيتش تحليله للممارسة العملية والتطبيقية للإسلام، وذلك أنه يفترض استحالة تطبيق الإسلام في الممارسة العملية من مستوى بدائي([1])، وقد أسس هذا الافتراض على حاجة الإسلام الدائمة والمستمرة إلى تطوير الأشكال العملية للمضامين الشرعية [المؤسسات]، فالصلاة باعتبارها مضمونا شرعيا ـ على سبيل المثال ـ لا يمكن أداؤها أداء صحيحا إلا بضبط الوقت والاتجاه عن طريق علمي الفلك والتوقيت باعتبارهما أشكالا([2])، هذا الضبط يقتضي تطوير الأشكال الخادمة للمضمون، وهكذا في سائر العبادات والشعائر من صوم وزكاة، فـ«تطور جميع الميادين العلمية في القرن الأول الإسلامي قد بدأت بمحاولات تحقيق الفرائض الإسلامية بأكبر دقة ممكنة»([3]).
وفي السياق نفسه يقدم بيجوفيتش مثالا أكثر دقة لتطوير الأشكال المؤسسية في الإسلام خدمةً للمضامين الشرعية، ومَثَّل له بـ«مؤسسة الوقف»، والتي لا يوجد لها مثيل في البلاد غير الإسلامية، وعلى الرغم من أنه «لم يُذكَر الوقف في القرآن»، إلا أن المضامين الشرعية الداعية إلى الخير والبذل والعطاء، كانت دافعا قويا إلى تطوير الشكل الخادم لها عن طريق مؤسسة عظمى من مؤسسات الإسلام وهي: «الوقف»، فمحاولة تطوير الأشكال الخادمة للمضامين الشرعية الداعية للعطاء والخير أفرزت في نهاية المطاف هذا النظام المؤسسي الراسخ، والذي أدار قطاعات واسعة من العمل الخيري، والصحي، والديني، والتراحمي، في طول البلاد الإسلامية وعرضها على مدى قرون امتدت إلى عهد الاستعمار الغربي المعاصر، فظهوره ـ أي الوقف ـ في المجتمعات الإسلامية لم يكن على حد تعبيره «بمحض الصدفة، وإنما كان ظهوره نتيجة لسيادة روح التضامن، ولتأثير وظيفة الزكاة التعليمي في المجتمعات المسلمة»([4]).
إن المنطق الذي تنطوي عليه هذه الأفكار يقود بشكل تلقائي إلى فكرة مركزية في الإسلام، وهي أن الأشكال تقع على درجة واحدة من الأهمية مع المضامين الشرعية في الثقافة الإسلامية، وقد تندمج الأشكال مع المضامين إلى درجة يصعب فيها فصل المضمون عن الشكل، ومن ثم فإن فصل المضمون عن الشكل يقلص من فعالية المضامين، ويساهم في تجريدها وعزلها عن سياقاتها الشرعية، فالمناداة بالمضامين الشرعية الداعية للعطاء والخير في مثال الوقف ـ المتقدم ـ بعيدا عن المؤسسة [الشكل]، يجعل من مضامين العطاء والخير شعارات يصعب العمل بها في إطار الممارسات العملية للإسلام داخل الزمن.
يتأكد مما سبق أن الإسلام لم يمتد وجوده عبر تاريخه ولم تتطور تمثلاته وأنظمة ممارساته إلا عبر ما طوره العلماء والسلاطين وعموم الأمة من مؤسساته التي اتسمت بالنظام، وأشير هنا إلى بنية مستقرة من المؤسسات، فالدين ضربٌ من الانتماء إلى نظام رمزي ومعرفي ونموذج اجتماعي يصوغ المتنوعَ في إطار من الوحدة والاشتراك و«بعبارة اجتماعية: الانضمام والولاء إلى مؤسسة قارة تضمن عبر الزمان والمكان تواصلا وحضورا مُعبِّرا له».
انطلاقا من هذه الفكرة فإن المضامين الشرعية الداعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي ربطت خيرية هذه الأمة بممارسة هذه الفريضة، أفرزت لنا مؤسسة الحسبة كنظام [شكل] ضابط لممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [مضمون]([5])، وقد قدم الهدي النبوي للنبي ﷺ وبعدَهُ الممارسات النموذجية من طرف الخلفاء وعموم الصحابة ﭫ والتابعين للحسبة نماذج تأسيسية اتُّخِذت مستندا وأساسا فقهيا لتطوير أشكالها.
وبناء على ما سبق، فإن استمرار مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أشكاله الفقهية والنظامية [المؤسسة] الذي استقرت عليها وانتظمت فيها ممارساتُها أمر متعذر، ولا مجازفة في القول باستحالة ذلك، فقد أصبحت الحسبة هي الرافد الحصري لجميع المضامين الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [باليد]([6])، وهذا ما يفسر أن جميع التجاوزات التي تمالأ العلماء على استنكارها، وتمت ممارستها باسم الحسبة في التاريخ قد تمت خارج نظام هذه المؤسسة متفلتة من قواعدها وأشكالها، مكتفية في ممارستها بالمضامين الشرعية العامة الداعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممزوجة بجملة من الشعارات العامة والتي تتخذ من المقدمات المثالية والعاطفية المتحمسة مدخلا لها.
ولإبراز أهمية نظام الحسبة في احتواء المضامين الشرعية الداعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومد متعاطيها بآليات وأساليب ممارستها واقعيا دون الإخلال بأحكامها الفقهية وقواعدها التنظيمية، أقدم مثالا يجلي هذا بوضوح، وهو أن نصوص الشريعة العامة رتبت النهي عن المنكر في ثلاث مراتب حيث قال النبي ﷺ: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)([7]).
بناء على هذا الحديث اجتهد فقهاء المذاهب المعتمدة في تطوير صيغة دقيقة لمراتب الحسبة، تحدد تفاصيل الانتقال بين مراتب الاحتساب بشكل مفصل ومسؤول، وذلك حتى لا ينزلق فهم العامة لهذا المضمون الشرعي إلى الاختزال والتبسيط المخل، والتأويل المنحرف، بما قد يستتبعه ذلك من فتن التوظيف الطائفي أو السياسي لهذا المضمون الشرعي؛ وقد استطاعت الصيغة الجديدة لهذه المراتب والدرجات عند الفقهاء انتزاعَ سلطة استخدام اليد في الحسبة من الأفراد ووضعها في يد السلطة العامة، وحددت موجبات واستثناءات استعمال الأفراد لليد في الحسبة.
ونتوقف هنا عند جوهر هذه المقالة وهو تقرير الصفة المؤسسية للحسبة وتتبع خصائصها وهي أربعة:
الخاصية الأولى: وتتعلق بوتيرة ودرجة تغير المقولات والاجتهادات المتعلقة بالحسبة كخطة وكموضوع معا، وقد تم التغيير والتطور من هذه الناحية في أزمنة ممتدة واتجاهات فقهية متعددة وذلك من خلال نقاش شاركت فيه أجيال من العلماء، مسايرة بشكل موازٍ التطور المجتمعي في مختلف البيئات داخل الأمة.
فقد كان تداول فقه الحسبة يتم بشكل واسع في كل عصر، منتقلا من جيل إلى جيل حتى استوت مقولاته على سوقها، مع مراعاة تغير الأعراف والتطور المجتمعي.
ويمثل كتاب العقباني «تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» هذه الخاصية بشكل دقيق، حيث يمكننا من رصد تطور عدد من الاجتهادات الفقهية والتنظيمية للحسبة بشكل واضح.
الخاصية الثانية: الطابع المميز لمؤسسة الحسبة هو العمل الجماعي وتراكم التجارب بين الأجيال، حسبما تقتضيه هويتها الاجتماعية. وبالتالي فلا مجال فيها لإضفاء طابع القداسة على الأفراد، ولا محل فيها لثقافة الشخص المنقذ [المهدوية، السوبرمان].
وتتجلى هذه الخاصية داخل مؤسسة الحسبة في موقف العلماء من الإمام الغزالي في بعض مسائلها، وخاصة تلك التي دعا فيها إلى ممارسة الحسبة من الأفراد بنوع من الحماس دون توقف على إذن السلطان، فقد انتقده العلماء بصرامة، ولم يمنعهم من ذلك إمامته وعلو كعبه ولا آراءه الاجتهادية الفريدة المتعلقة بالحسبة وغيرها.
الخاصية الثالثة: توفر الصفة المؤسسية فضاءً تُحاكَم إليه الأخطاء الفردية التي يتوقع حصولها من أفراد المحتسبين، فمجمل ما قد يقعون فيه من زلل في ممارساتهم للحسبة تحتويه المؤسسة، فتأخذ تلك الأخطاء الفردية نطاقا هامشيا داخل النظام المؤسسي للحسبة، وعادة ما وصفت هذه الأخطاء والتجاوزات بالشذوذ والتفرد.
ولكن لم ترق هذه الأخطاء أو التجاوزات إلى أن تعتبر نماذج وسوابق يعتد بها ويعتمد عليها في بناء أحكام خطة الحسبة وقواعدها.
وقد صانت هذه الخاصية الحسبة من الانتقادات والمقولات التفكيكية التي تبنى على وقائع فردية شاذة.
الخاصية الرابعة: حماية الوعي الديني للأفراد داخل النظام المؤسسي، بحيث تصنف الأقوال والاجتهادات التي لا يؤيدها نظام المؤسسة كأقوال شاذة لا يعتد بها ولا تدخل في الوعي الديني المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بما يتوفر لنظام الحسبة من آليات ووسائل حماية العامة من جهة، وإشراكهم في الحسبة من جهة أخرى، فالوعي الجمعي الإسلامي يستبطن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كحكم شرعي ثابت، ولكن ممارسة العامة له مقيدة بالتكامل مع العلماء ومع السلطة الحاكمة.
وتنعكس هذه الخاصية في أن تلك الاجتهادات المخالفة لقواعد الحسبة يتم التنبيه عليها وتجاوزها دون اعتبارها تحديا كبيرا للنظام المؤسسي، وقد كانت العامة دائما مستبعدة من مثل هذه النقاشات ومتبعة لعلمائها.
وبهذا فقد استطاع الفقهاء أن يجمعوا بين الحفاظ على الحكم الشرعي للحسبة كشرط لتماسك النظام الأخلاقي والديني وبين ضمان التساكن الاجتماعي وعدم الإخلال بالأمن الداخلي، وهذا نفسره بما يمكن الاصطلاح عليه: بالخواص الشكلية للحسبة، أي تلك البُنَى والخصائص التي امتلكتها كمؤسسة لما يزيد عن اثني عشر قرنا، ولا يمكن من دون هذه البنى والخصائص تصور الحسبة كمؤسسة في الإسلام.
ويمكن تلخيص الخواص الشكلية للحسبة في خمسة عناصر متداخلة: هي: 1) المذهبية الفقهية، 2) وجوب انتفاء المصلحة الشخصية، 3) العنصر الرقابي، 4) الاحتراز من الفوضى والفتنة، 5) المبدأ الأخلاقي كقيد للحسبة.
وهذا الذي تحصل لدينا باستقراء التراث الفقهي للحسبة لأزيد من عشرة قرون من الاجتهادات والمؤلفات.
ولا أدعي هنا انحصار الخواص الشكلية للحسبة في هذه الروافد الخمس، إلا أنه لا يمكن إقصاء أي خاصية منها، وأيُّ محاولة للنظر في الخطة مع استبعاد إحداها سيؤثر بلا شك في أسلوب النظر للموضوع، وينعكس تبعا لذلك على السرديات والنتائج المتعلقة بممارساتها.
فاستبعاد الشكل المذهبي الفقهي للحسبة ـ على سبيل المثال ـ هي محاولة للنظر للموضوع دون استحضار أهم بنياته؛ إذ المذاهب الفقهية هي الوعاء الذي انتظمت فيه الحسبة فقهيا وتاريخيا، ولهذا فإن استبعادها في النظر للموضوع سيفضي إلى تصور بعيد عن الحقيقة، ولهذا السبب لا يُعترف بأية ممارسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم تكن مؤطرة بالمذهب الفقهي الذي أنتجها، وإلا فتح الباب أمام الفوضى وانفراط الأمن الاجتماعي.
وسنقوم هنا بتلخيص هذه الخصائص:
شكلت المذهبية الفقهية الوعاء الجامع الذي انتظمت فيه المضامين الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد استطاعت المذهبية الفقهية تطوير الأشكال الشرعية التي أمدت تلك المضامين بنظامها وشكلها الشرعي الذي استقرت عليها فيما بعد، وقد بلغ هذا التداخل بين الحسبة والنظام المذهبي حدا يتعذر معه النظر للحسبة كخطة خارج سياقها المذهبي، وحتى معايير الحكم على سير الحسبة ومدى موافقتها للقواعد الشرعية كانت تتم من خلال النظر في مدى الالتزام بالقواعد الفقهية المذهبية للحسبة داخل كل مذهب معين.
والسؤالان المطروحان هنا هما: هل يمكن تصور ممارسة سليمة للحسبة خارج النظام الفقهي المذهبي؟ والسؤال الثاني هل لتقويم العلماء لبعض ممارسات الحسبة في التاريخ صلة بهذا الارتباط المذهبي؟
للإجابة عن السؤال الأول يلاحظ أن ممارسة الحسبة في التاريخ قد ارتبطت بالمذاهب الفقهية، ولم تنجح أية دعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارجها، وأكبر مثال على ذلك هو التجربة الاعتزالية في الموضوع؛ إذ على الرغم من مركزية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى المعتزلة واعتبارها أحد الأصول الخمسة التي يقوم عليها مذهبهم([8])، فإنهم فشلوا في تطوير منهج خاص بهم للحسبة، بحيث يكون واضح المعالم؛ إذ ظل نقاشهم لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظريا ومجردا، وعلى حد تعبير المستشرق كوك «فالفكر المعتزلي يميل إلى العام والمجرد، وهو ما دفع المعتزلة ثمنه في النهاية»([9])، يشير كوك بهذه العبارة إلى الموت البنيوي الذي آل إليه المذهب الاعتزالي جراء ميله إلى «العام والمجرد».
وقد انعكس هذا الوضع على نظر المعتزلة لمؤسسة الحسبة، حيث ظل نقاشهم عنها محدودا في إطاره النظري، ولم تنجح كتاباتهم في صياغة نظرية متناسقة للحسبة([10]).
كما يؤكد فشل التجارب المعاصرة حول محاولة تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق إحداث هيئات ومؤسسات لها بمعزل عن المذهبية الفقهية، عن ذلك الارتباط الوثيق بين الحسبة وفضائها الفقهي المذهبي، ويرى مايكل كوك بنظر ثاقب أن أحد أهم أسباب فشل تجارب هيئات ومؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعاصرة يعود بالأساس إلى عدم اعتمادها على التراث الفقهي المذهبي، ومحاولة إنتاجها لمؤسسة تجمع بين خليط من الآراء غير متجانس مآله الوحيد الهرج والفوضى([11]).
أما الإجابة عن السؤال الثاني حول موجبات تقويم العلماء لممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد استندت هذه التقويمات في عمومها إلى القواعد والضوابط التي حددتها المذهبية الفقهية في ممارسة الحسبة، ولمزيد بيان بخصوص هذه النقطة أقدم مثالا من خلال نموذجين للحسبة عرفهما المغرب في وقت متقارب، يتعلق الأول بممارسات الحسبة التي اضطلع بها مؤسس الحكم المرابطي عبد الله بن ياسين، في مقابل الممارسات التي قام بها المهدي ابن تومرت أثناء تأسيسه للحكم الموحدي، المشترك بينهما هو استناد دعوتهما منذ البداية على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد شغل الاهتمام بتحقيق مقتضيات هذه الفريضة نطاقا مركزيا في أعمالهما بشكل واضح قد لا يحتاج إلى استدلال، إلا أن تفاصيل هذه الممارسة قد اختلفت بينهما اختلافا جوهريا، وتعود أسباب هذا الاختلاف بالأساس إلى منطلقاتهم الفقهية المذهبية، فبينما كان عبد الله بن ياسين أكثر انضباطا للقواعد المذهبية المرعية في ممارسة الحسبة([12])، فإن المهدي ابن تومرت كان متفلتا بشكل أكبر من هذه القواعد، جامعا بين المرجعية المهدوية واللامذهبية([13]).
وقد كان لهذا التباين في الانضباط للقواعد المذهبية أثر في تقويم العلماء لهذه الممارسات، فقد وجهت سهام النقد بشكل لاذع لممارسات المهدي ابن تومرت والتي كانت في مجملها موضعا للفوضى والفتنة، في حين لم تكن ممارسات عبد الله بن ياسين في مرمى النقد؛ لانضباط أغلب تلك الممارسات بقواعد المذهبية الفقهية.
بهذا يتأكد صحة الافتراض الذي يربط بشكل وثيق بين الحسبة ونظامها الفقهي والمذهبي، فمحاولة إنتاج ممارسة للحسبة خارج النظام الفقهي المذهبي أمر متعذر من خلال ما سبق بيانه من خلال نموذج المعتزلة، كما أن قواعد هذا النظام الفقهي هي التي شكلت وحددت المعايير النموذجية للحكم على ممارسات الحسبة عبر التاريخ، ليتقرر بذلك أن المذهبية الفقهية للحسبة هي أولى الخواص الشكلية التي لا يمكن تعريف الحسبة أو النظر إليها خارج نطاقها.
ب) وجوب انتفاء المصلحة الشخصية
ما يميز الحسبة كممارسة يضطلع بها الفرد أن من شروطها انتفاء ركن المصلحة الشخصية فيها، وذلك أن النهي عن المنكر من أجل تحقيق مصلحة شخصية ممارسة يتعذر تصنيفها كحسبة شرعية.
ويشمل هذا الشرط الحسبتين، الحسبة الشرعية العامة والحسبة القضائية، ومن هنا فإن انتفاء المصلحة الشخصية في الحسبة هو ثاني الخواص الشكلية المميزة لها.
وفي مقابل هذا الانتفاء فإن السعي إلى تحقيق المصلحة العامة عن طريق الحسبة يظل هو الأصل الذي تقوم عليه، ولهذا فإن كتب الحسبة تنزع دائما إلى التأكيد على أن الحسبة ممارسة تتغيى تحقيق المصلحة العامة، وذلك أنها تقرن عادة بين الحسبة وطلب الأجر والثواب من ذلك الفعل من جهة، وتدعو إلى اعتبار المصلحة العامة من جهة ثانية، وقد كان استغلال الحسبة لتحقيق بعض المصالح الشخصية سببا لسقوط عدالة المحتسبين وموجبا للمتابعة، وقد يفضي أحيانا إلى عزل المحتسب عن خطته.
وكسائر الخطط القضائية، فقد انزلق عدد من المحتسبين إلى استغلال النفوذ والتربح من الاحتساب في بعض الأحيان، وهو ما دفع العلماء إلى التأليف في الحسبة على الحسبة وعلى القضاء بوجه عام، ونجد عند ابن عبدون عنوانا خاصا في الحسبة على المحتسب، ولابن خلدون رسالة في الحسبة على القضاة وهي المعروفة بـ: «مزيل الملام عن حكام الأنام»، كما توجد إشارات تاريخية وفقهية متنوعة عن محاصرة هذه الأحوال التي لا يمكن الفكاك عنها في كل الخطط الشرعية.
يمثل العنصر الرقابي أحد الخواص الشكلية المميزة للحسبة، فمن خلاله تتميز الحسبة عن القضاء، وقد ذكر الماوردي أن الحسبة تزيد عن القضاء من وجهين، أولهما: أن المحتسب يجوز له التعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر، ولا يتوقف في ذلك على دعوى خصم مُسْتَعد كما هو شأن القاضي، والوجه الثاني أن للمحتسب سلطة رقابية واسعة في مواجهة المنكر([14])، هذان الوجهان يشكلان الخاصية الثالثة من الخواص الشكلية للحسبة، وهو المراد بـ«العنصر الرقابي».
وينبني على هذا الاعتبار أن سقوط هذا العنصر يفضي إلى إسقاط الحسبة بشكل كلي؛ إذ لا يتصور حتى من الناحية النظرية قيام الحسبة دون سلطة فعلية مسؤولة وزجرية، وقد بقيت صلاحية الزجر والردع مصاحبة لتاريخ خطة الحسبة القضائية؛ لأن تجريدها منها يؤول بالحسبة إلى ما يمكن اعتباره موتا بنيويا لها، وللتأكيد على ذلك يمكن القول أن أقصى درجات التفكيك التي بلغتها الحسبة في بعض الفترات التاريخية لم تكن لتستغني عن العنصر الرقابي، فقد كان هذا العنصر هو ما بقي ثابتا فيها على الرغم من التفكيك الذي لحق بالحسبة في بعض الفترات التاريخية.
تشتغل الحسبة في بيئة من النظام والانتظام؛ إذ يرفض منطقها الداخلي جميع صور الفوضى والفتنة المتوقعة، ومما يمكن ملاحظته بخصوص هذا الشأن أن جميع حركات الفتنة والفوضى التي اتخذت من الحسبة منطلقا لها، لم تسلم من النقد والمراجعة، ويمثل هذا الاتجاه نشاط العامة والحنابلة بالحسبة في المشرق خلال القرن الرابع، وخاصة من طرف أتباع البربهاري (ت329هـ)([15])، وكذلك ممارسات المهدي ابن تومرت وأتباعه بالمغرب، فقد كانت هذه الحركات في مرمى النقد والمراجعة بسبب ما أفضت إليه من صور الفوضى والفتنة، وكان لهذا الرفض من جهة العلماء لمثل هذه الممارسات تأكيدا على مركزية الاحتراز من الفوضى والفتنة في الحسبة، واعتبارها أحد الخواص الشكلية المميزة لها.
ومن خلال النظر فيما تقرر عند العلماء من شروط المحتسب ومما يحتسب فيه يتضح جليا مراعاة هذه الخاصية الشكلية، وكمثال على ذلك فقد احتوى نقاش الفقهاء حول شروط المحتسب ما يؤكد على منع صور الفوضى والفتنة في ممارسة المحتسب للاحتساب، فهم يتوجسون من وقوع الجاهل المفتقر لشروط المحتسب في منكر أعظم وأشد من المنكر الذي توجه إليه بالنهي، وذلك لما قد يفضي إليه الإنكار مع افتقاد شرط العلم من صور للفتنة والفوضى، ومن هنا يتضح سبب تشديدهم على شرط العلم في الحسبة، بل تؤكد قواعد الفقه المذهبي على سقوط الحسبة إذا أفضى القيام بها إلى مفسدة أعظم، وهذا تأكيد آخر على هذه الخاصية الشكلية للحسبة، كما أن الاحتساب في المنكرات المتفق عليها دون المختلف فيها يتضمن مزيد تأكيد على هذه الخاصية.
هـ) المبدأ الأخلاقي كقيد للحسبة
تستند الحسبة على المبدأ الأخلاقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى حد تعبير ذ وائل حلاق «وظيفة المحتسب مستمدة من الفكرة الأخلاقية التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»([16])، ولا يتصور قيام الحسبة بعيدا عن مبدئها الأخلاقي، فجميع مجالات اشتغال الحسبة إنما هو تحقيق وتفعيل لهذا المبدأ الأخلاقي، وهوما يمكن تسميته بـ«البنية الأخلاقية الأساسية والثابتة للخطة»، حيث تستند على مبادئ أخلاقية صلبة وراسخة في السياق العام للشريعة، وأن الممارسات الأخلاقية للشريعة لم تعكس افتراضات ونظريات فلسفية مثالية، بل جسدت أسلوبا نموذجيا في الممارسة العملية، وأن الحسبة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الشريعة تعكس هذا الأسلوب بشكل قوي داخل الزمن.
وتستمد الحسبة عوامل استمرارها وموجبات عملها داخل الزمن من المبدأ الأخلاقي الذي تستند إليه [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]، فمن خلال تحديد الفقهاء للمعروف الذي يتجه الأمر إليه بأنه كل ما هو أخلاقي، وأن المنكر الذي تتجه الحسبة إلى النهي عنه كل ما هو لاأخلاقي، فإن الحسبة انتصبت داخل الزمن، قياما بالحماية الأخلاقية وفق ثنائية المعروف (الأخلاقي) = المنكر (اللاأخلاقي)، وارتبطت اختصاصاتها بما تستند إليه من مبدأ أخلاقي، ومن هنا فإن النظر للحسبة كخطة شرعية لا يكتمل دون جانبها الأخلاقي.
وأؤكد في نهاية الحديث عن هذه الخواص الشكلية التي توصلت إلىها هي نتيجة لعملية طويلة من التتبع والاستقراء في محاولة لتجسيد الشكل الذي كانت عليه الخطة لأكثر من اثني عشر قرنا من زمن الشريعة، وكما أكدت في البداية فإن هذه الخصائص لا تنحصر في الخصائص الخمس المعروضة، بل إن مجال البحث والتعمق في النظر للموضوع سيقدم لا محالة بعض الخصائص الأخرى المميزة للحسبة، إلا أن هذا التعمق في البحث لن يصل إلى إبطال أحد هذه الخواص الشكلية أو إقصاء إحداها، لأن النظر للموضوع بعيدا عن إحداها أمر متعذر، والله أعلم.
وختاما فإن الفرضية الأساس التي حاولتُ التأكيد والاستدلال عليها في هذه الورقة البحثية، تتلخص في أن المناداة بالمضامين الشرعية دون استحضار لأشكالها التاريخية هو تفريغ لتلك المضامين من فاعليتها داخل الزمن من جهة، وتفكيك لبنيتها الداخلية من جهة ثانية، وأن تقييم ممارسات الفريضة يجب أن ينبني دائما على معيار الوفاء للنظام الشكلي، تحصينا لها من التوظيفات الطائفية والسياسية التي نعاينها اليوم كواقع ملموس عند الكثير من المكونات «الدينية»، والتي زجت بهذا المضمون الشرعي في حسابات سياسية ضيقة، تحول من خلالها المضمون الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى موضوع سياسي يخضع لمقتضياته ويقبع تحت الأدوار الوظيفية التي يمليها الواقع السياسي المضطرب.
لائحة المصادر والمراجع
ـ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، ت عبد الكريم عثمان، ط مكتبة وهبة، بدون تاريخ.
ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي لمايكل كوك، ترجمة رضوان السيد وعبد الرحمن السالمي وعمار الجلاصي، ط الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، سنة: 2013م.
ـ الشريعة النظرية، والممارسة، والتحولات لوائل خلاق، ترجمة كيان أحمد حازم يحيى، ط دار المدار الإسلامي، ط1، سنة: 2018م.
ـ الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش، تقديم عبد الوهاب المسيري، ترجمة محمد يوسف عدس، ط دار الشروق، ط8، سنة: 2016م.
ـ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لعلي بن أبي زرع الفاسي (ت726هـ)، ط دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط، ط1، سنة: 1972م.
ـ أخبار المهدي ابن تومرت وبداية دولة الموحدين لأبي بكر بن على المعروف بالبيذق (ت555هـ)، ط دار المنصور، ط1، سنة: 1971م.
ـ الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بـ: الماوردي (ت450هـ)، ط السعادة، بدون تاريخ.
([1]) قال: «إنه من المستحيل تطبيق الإسلام في الممارسة العملية انطلاقا من مستوى بدائي». الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش (ص: 294).
([2]) قال: «فالصلاة لا يمكن أداؤها أداء صحيحا إلا بضبط الوقت والاتجاه في المكان، فالمسلمون مع انتشارهم على سطح الكرة الأرضية عليهم أن يتوجهوا جميعا في الصلاة نحو الكعبة مكيفين أوضاعهم في المكان على اختلاف مواقعهم. وتحديد مواقيت الصلاة تحكمه حقائق علم الفلك، ولا بد من تحديد هذه المواقيت للصلوات الخمس تحديدا دقيقا خلال أيام السنة كلها. ويقتضي هذا تحديد موقع الأرض في مدارها الفلكي حول الشمس، وتحتاج الزكاة إلى إحصاء ودليل وحساب. . ويتصل الحج بالسفر وضرورة الإلمام بكثير من الحقائق التي يتطلبها المسافر إلى مسافات بعيدة. فإذا وضعنا الأمر في أبسط صوره، وإذا صرفنا النظر عن أي شيء آخر في الإسلام لوجدنا أن المجتمع المسلم، بدون أن يمارس أي شيء سوى هذه الأعمدة الخمسة للإسلام، يجب عليه أن يبلغ حدا أدنى من الحضارة، ومعنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يكون مسلما ويبقى متخلفا». الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش (ص: 294).
([3]) الإسلام بين الشرق والغرب (ص: 294).
([4]) الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش (ص: 283-284). «ونتيجة لإصرار التعاليم الإسلامية على العطاء، جرت ثورة هادئة في المجتمعات المسلمة تبلورت في مؤسسة «الأوقاف». والوقف، من حيث انتشاره وأهميته، لا يوجد له مثيل في البلاد غير الإسلامية، فلا تكاد توجد دولة إسلامية واحدة ليس فيها ممتلكات كبيرة مخصصة للأوقاف وخدمة الخير العام. ولم يذكر الوقف في القرآن، ولكنه لم يظهر في المجتمعات الإسلامية بمحض الصدفة، إنما كان ظهوره نتيجة لسيادة روح التضامن، ولتأثير وظيفة الزكاة التعليمي في المجتمعات المسلمة».
([5]) وتفسر هذه النقطة أسباب تأخر ظهور مؤسسة الحسبة إلى حدود منتصف القرن الثاني، بخلاف المضامين الشرعية التي كانت تمثلاتها وممارستها قائمة منذ العهد الأول الإسلام.
([6]) وبتعبير آخر يمكن القول أن الحسبة أصبحت هي القناة الرسمية والحصرية التي لا يمكن تقديم المضامين الشرعية الداعية إلى تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دونها، فأضفت المؤسسية على تلك المضامين الشرعية العامة والمتشعبة، صبغة من النظام والانتظام جمعت شتاتها، فأضحت بذلك ممارسة الواجب الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [باليد] خارج نطاق مؤسسة الحسبة أمرا متعذرا.
([7]) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم: 78.
([8]) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص: 741).
([9]) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي (ص: 301). ويضيف أنه «قد بدأ يتضح مع بداية القرن الرابع الهجري أن الاعتزال لا يصلح لتوجيه المسلم في سلوكه، فصار يشكل بالأحرى عنصرا في تركيبية فكرية، وهو تقليد التفكير النظري المجرد الذي أمكن تأليفه مع انتماءات أخرى».
([10]) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي (ص: 301)
([11]) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، الفصل الثامن: حنابلة نجد (263-297).
([12]) وهذا ملحظ جلي ينبني على استقراء تام لنشاطه ونشاط أتباعه في الحسبة خلال المرحلة الأولى من دعوتهم، فلم يكن قيامهم بالتطوع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البداية قد تم في ظل سلطة مركزية تكتسب شرعيتها من إجماع الأمة عليها بالمغرب حتى يمكن وصف خروجهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالافتيات عليها، بل كان المغرب خلال تلك الفترة تتقاسمه دويلات ضعيفة ومتفرقة الأطراف، بالإضافة إلى ظهور الطوائف الشاذة كالبورغواطيين وغيرهم، وكانت كلها عوامل داعية إلى قيامهم بالحسبة.
وقد تقيدت توصيات عبد الله بن ياسين لأتباعه بمراعاة مراتب الحسبة المقررة عند الفقهاء، فأمرهم بتعريف الناس بالمنكرات ثم وعظهم ودعوتهم إلى الإقلاع عنها، ثم زجرهم إن امتنعوا عن الاستجابة، لتتجه الحسبة عليهم بعد ذلك إلى درجة أعلى تتعلق بالحسبة باليد، وفي نص طويل في الأنيس المطرب يستعرض ابن أبي زرع نماذج من مراعاة حسبة عبد الله بن ياسين وأتباعه للقواعد والضوابط الفقهية المذهبية. الأنيس المطرب بروض القرطاس (ص: 125-126).
([13]) تكشف رحلة عودة ابن تومرت من المشرق على مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فكره، وتؤكد تفاصيل ممارسته للفريضة أثناء رحلته على عدم التزامه بالقواعد والمبادئ الفقهية المذهبية المؤطرة لها، وهو ما سجله بالتفصيل أبو بكر بن علي الصنهاجي المعروف بالبيذق وبشئ من التفصيل في كتابه: «أخبار المهدي بن تومرت».
([14]) «فأحدهما: أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه، فإن تعرض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته، وصار متجوزا في قاعدة نظره، والثاني: إن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأن الحسبة موضوعة للرهبة، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزا فيها ولا خرقا، والقضاء موضوع للمناصفة، فهو بالأناة والوقار أحق، وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوز وخرق؛ لأن موضوع كل واحد من المنصبين مختلف، فالتجوز فيه خروج عن حده». الأحكام السلطانية (ص: 210).
([15]) تفاصيل نشاط هذه الحركة مبسوط في الفصل السادس بعنوان: حنابلة بغداد، من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي لمايكل كوك (ص: 193).