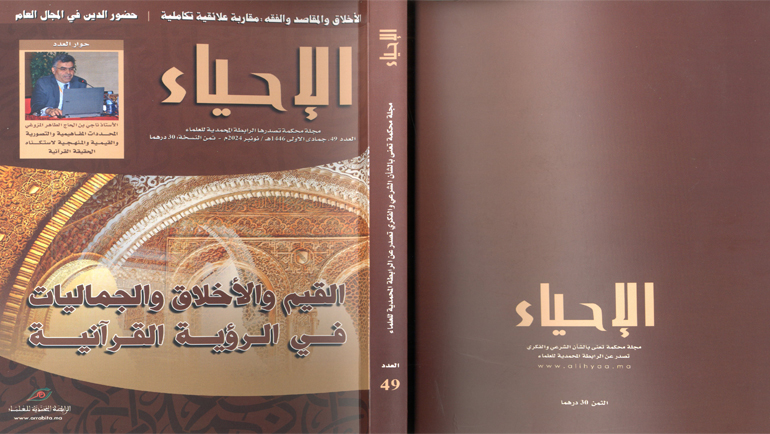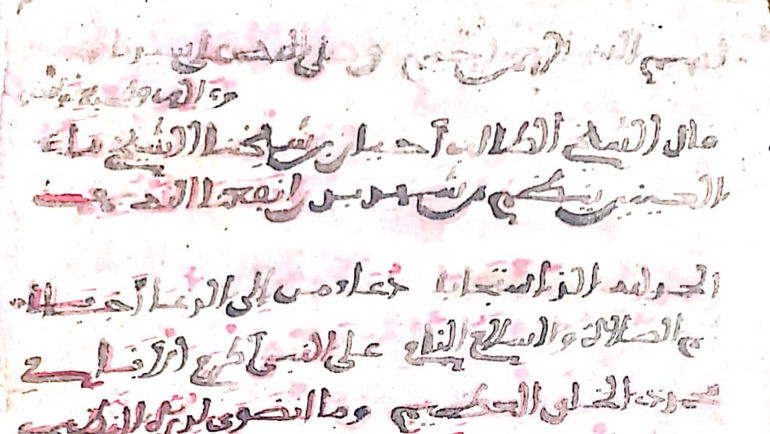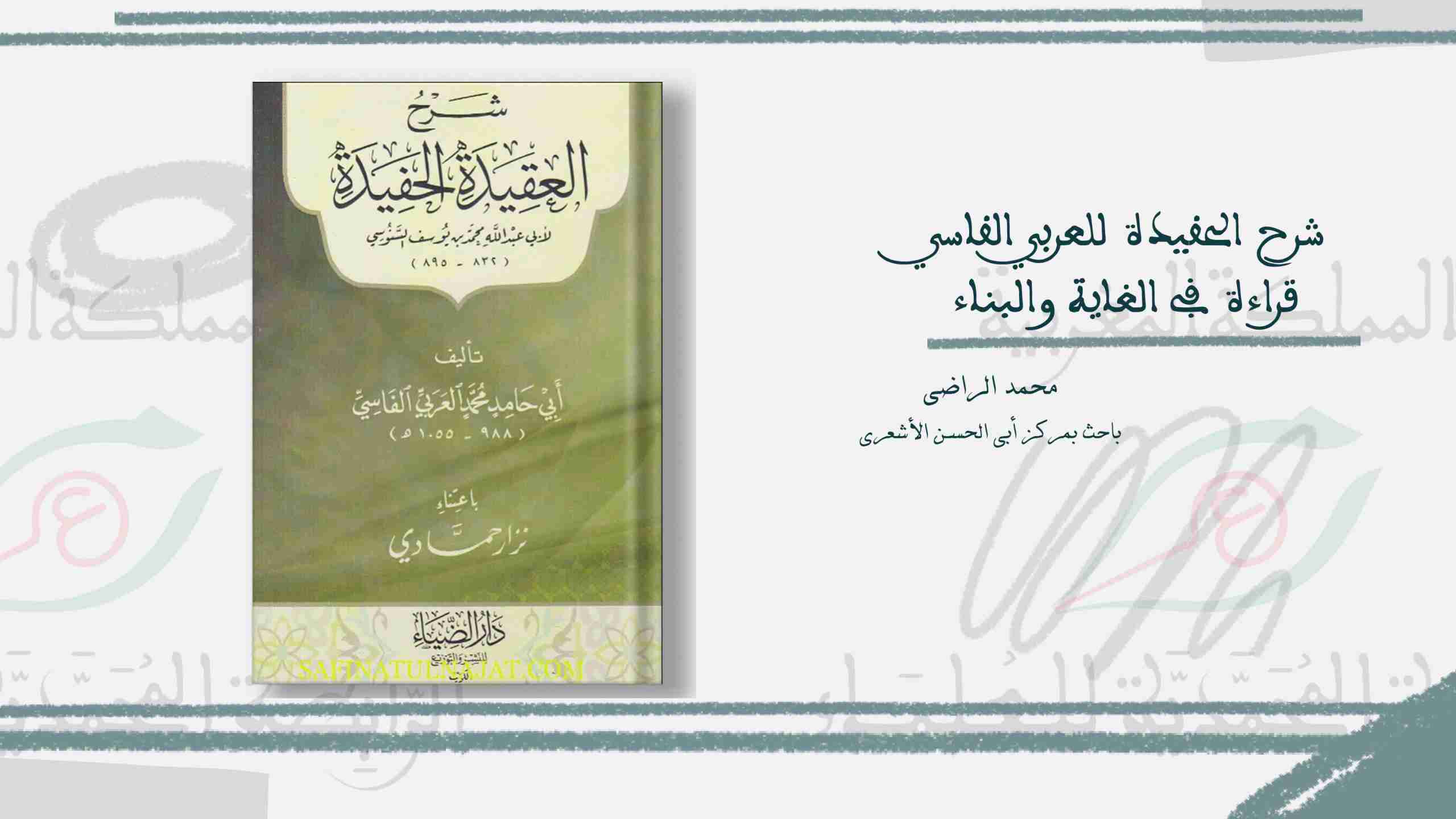مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبيةقراءة في كتاب
الحلقة الرابعة عشرة: الاستفتاح بالثناء في القرآن الكريم
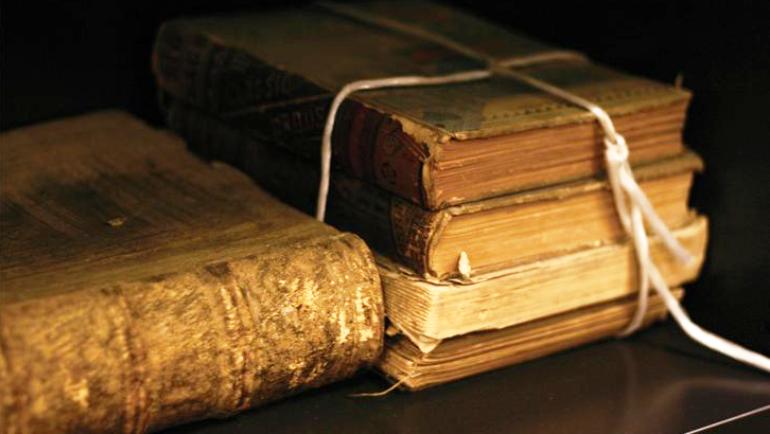
تمهيد:
أول أقسام فواتح سور القرآن الكريم هو الاستفتاح بالثناء، قال الزركشي في «البرهان»: «الْأَوَّلُ: اسْتِفْتَاحُهُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالثَّنَاءُ قِسْمَانِ: إِثْبَاتٌ لِصِفَاتِ الْمَدْحِ؛ وَنَفْيٌ وَتَنْزِيهٌ مِنْ صفات النقص. والإثبات نَحْوُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) فِي خَمْسِ سُوَرٍ، وَ(تَبَارَكَ) فِي سُورَتَيْنِ: الْفرْقَان: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفرقان)، والملك (تبارك الذي بيده الملك)، والتنزيه نحو: (سبحان الذي أسرى بعبده)، (سبح اسم ربك الأعلى)، (سبح لله ما في السماوات)، (يسبح لله)، كِلَاهُمَا فِي سَبْعِ سُوَرٍ، فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سورة استفتحت بالثناء على الله: نصفها لِثُبُوتِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَنِصْفُهَا لِسَلْبِ النَّقَائِصِ»(1)، قال الناظم [البسيط]:
أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ سُبْحَانَهُ بِثُبُو /// تِ المَدْحِ وَالسَّلْبِ لَمَّا اسْتَفْتَحَ السُّوَرَا(2)
وسنفصل الحديث في هذه الحلقة في سر افتتاح هذه السور بهذه الفواتح، ووجه مناسبتها لأغراض السورة، ودورها في براعة الاستهلال. الثناء بإثبات صفات المدح: وقد ورد الثناء بإثبات صفات المدح في فواتح سور القرآن الكريم بصيغتين اثنتين هما: الحمد لله وتبارك. أولا: الحمد لله: ابتدأت خمس سور في القرآن العظيم ب(الحمد للَّهِ) وهي سورة الفاتحة (الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين)، والأنعام (الحمد للَّهِ الذي خَلَقَ السماوات والأرض)، وسورة الكهف (الحمد لِلَّهِ الذي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب)، وسورة سبأ (الحمد للَّهِ الذي لَهُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض)، وسورة فاطر (الحمد للَّهِ فَاطِرِ السماوات والأرض) (3). وهن كلها مكية وقد وضعت في ترتيب القرآن في أوله ووسطه، والربع الأخير، فكانت أرباع القرآن مفتتحة بالحمد لله كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف(4). و(الحمد) هو الثناء على الجميل أي الوصف الجميل الاختياري فعلا كان كالكرم وإغاثة الملهوف أم غيره كالشجاعة. وقد جعلوا الثناء جنسا للحمد فهو أعم منه ولا يكون ضده. فالثناء الذكر بخير مطلقا وشذ من قال يستعمل الثناء في الذكر مطلقا ولو بشر، ونسبا إلى ابن القطاع وغره في ذلك ما رود في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار»، وإنما هو مجاز دعت إليه المشاكلة اللفظية والتعريض بأن من كان متكلما في مسلم فليتكلم بثناء أو ليدع، فسمى ذكرهم بالشر ثناء(5). وهو نقيض الذم وأعمُّ من الشكر، لأن الشكر يكون مقابل النعمة(6). وجملة الحمد لله خبر لكنها استعملت لإنشاء الحمد وفائدة الجملة الاسمية ديمومة الحمد واستمراره وثباته(7)، و(الْحَمْدُ) مبتدأ و(لِلَّهِ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر(8). سورة «الفاتحة»: استفتحها الله تعالى بقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). قال الطبري: حَمِد نفسه وأثنى عليها بما هو له أهلٌ، ثم علَّم ذلك عباده، وفرض عليهم تلاوته، اختبارًا منه لهم وابتلاءً، فقال لهم قولوا: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، وقولوا: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). فقوله (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) مما علمهم جلّ ذكره أن يقولوه ويَدينُوا له بمعناه، وذلك موصول بقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، وكأنه قال: قولوا هذا وهذا. قال: وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه(9). ووجه مناسبة افتتاح «الفاتحة» بالحمد ما ذكره ابن عاشور رحمه الله مفصلا في «التحرير والتنوير» من أن الشأن في الخطاب بأمر مهم لم يسبق للمخاطب به خطاب من نوعه أن يستأنس له قبل إلقاء المقصود وأن يهيأ لتلقيه، وأن يشوق إلى سماع ذلك وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل به ليستعد للتلقي بالتخلي عن كل ما شأنه أن يكون عائقا عن الانتفاع بالهدى من عناد ومكابرة أو امتلاء العقل بالأوهام الضالة، فإن النفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنذر، ولا تشرق فيها الحكمة وصحة النظر ما بقي يخالجها العناد والبهتان، وتخامر رشدها نزغات الشيطان، فلما أراد الله أن تكون هذه السورة أولى سور الكتاب المجيد بتوقيف النبيء صلى الله عليه وسلم كما تقدم آنفا نبه الله تعالى قراء كتابه وفاتحي مصحفه إلى أصول هذه التزكية النفسية بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التي تضمنتها سورة «الفاتحة» من قوله: (إياك نعبد) إلى آخر السورة، فإنها تضمنت أصولا عظيمة: أولها التخلية عن التعطيل والشرك بما تضمنه إياك نعبد. الثاني التخلي عن خواطر الاستغناء عنه بالتبري من الحول والقوة تجاه عظمته بما تضمنه وإياك نستعين. الثالث الرغبة في التحلي بالرشد والاهتداء بما تضمنه اهدنا الصراط المستقيم. الرابع الرغبة في التحلي بالأسوة الحسنة بما تضمنه صراط الذين أنعمت عليهم. الخامس التهمم بالسلامة من الضلال الصريح بما تضمنه غير المغضوب عليهم. السادس التهمم بسلامة تفكيرهم من الاختلاط بشبهات الباطل المموه بصورة الحق وهو المسمى بالضلال لأن الضلال خطأ الطريق المقصود بما تضمنه ولا الضالين. وأنت إذا افتقدت أصول نجاح المرشد في إرشاده والمسترشد في تلقيه على كثرتها وتفاريعها وجدتها عاكفة حول هذه الأركان الستة فكن في استقصائها لبيبا. وعسى أن أزيدك من تفصيلها قريبا. وإن الذي لقن أهل القرآن ما فيه جماع طرائق الرشد بوجه لا يحيط به غير علام الغيوب لم يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل وهي أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر المنعم بها فأراهم كيف يتوجون مناجاتهم بحمد واهب العقل ومانح التوفيق، ولذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب المجيد(10). فقد أثبت بقوله (الحَمْدُ لِلَّهِ) أنه المستحق لجميع المحامد، وأشار بعد ذلك إلى أنه يستحق الحمد من حيث كونه ربا مالكا منعما، ومن حيث كونه رحمانا رحيما، ومن حيث كونه مالكا ليوم الدين، ومَنْ هذه صفاته حقيق بأن يعبد، ولا تتهيأ عبادته إلا بمعونته والاستعانة به، وطلب الهداية على الطريق المستقيم مع أحسن رفيق، والاستعاذة من الذين خالفوا وضلوا هذا الطريق. إن هذه السورة مسماة بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن، وأن يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه، فقوله: رب العالمين تنبيه على أن كل موجود سواه فإنه دليل على إلهيته(11). اعلم أن هذه الكلمة مذكورة في أول سور خمسة. أولها: «الفاتحة»، فقال: (الحمد لله رب العالمين)، وثانيها: في أول هذه السورة، فقال: (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض) [الأنعام: 1] والأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى، فقوله: (الحمد لله رب العالمين) يدخل فيه كل موجود سوى الله تعالى. أما قوله (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض) لا يدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلمات والنور، ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات، فكان التحميد المذكور في أول هذه السورة كأنه قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور في سورة «الفاتحة» وتفصيل لتلك الجملة. وثالثها: سورة «الكهف»، فقال: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) [الكهف: 1] وذلك أيضا تحميد مخصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والهداية والقرآن، وبالجملة النعم الحاصلة بواسطة بعثة الرسل، ورابعها: سورة «سبأ» وهي قوله: (الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) [سبأ: 1] وهو أيضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: (الحمد لله رب العالمين) وخامسها: سورة «فاطر»، فقال: (الحمد لله فاطر السماوات والأرض) [فاطر: 1] وظاهر أيضا أنه قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: (الحمد لله رب العالمين) فظهر أن الكلام الكلي التام هو التحميد المذكور في أول «الفاتحة» وهو قوله: (الحمد لله رب العالمين) وذلك لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته. وواجب الوجود لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى وما سواه ممكن وكل ممكن فلا يمكن دخوله في الوجود إلا بإيجاد الله تعالى وتكوينه والوجود نعمة فالإيجاد إنعام وتربية، فلهذا السبب قال: (الحمد لله رب العالمين) وأنه تعالى المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه. فذلك الكلام هو الكلام الكلي الوافي بالمقصود. أما التحميدات المذكورة في أوائل هذه السور فكأن كل واحد منها قسم من أقسام ذلك التحميد ونوع من أنواعه(12)، وفي ما يلي تفصيل لهذه الأقسام: سورة «الأنعام»: استفتحها الله تعالى بقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)، وذكر ابن عطية أنه «لما ورد التصريح بأنه المستحق لجميع المحامد أتبعه بذكر بعض أوصافه الموجبة للحمد، وهي الخلق «للسماوات والأرض»(13). وبين الرازي في «مفاتيح الغيب» أن المذكور هاهنا قسم من أقسام قوله: (رب العالمين) لأن لفظ العالم يتناول كل ما سوى الله، والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوى الله، فالمذكور في أول سورة الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور في أول سورة الفاتحة، وأيضا فالمذكور في أول سورة الأنعام أنه خلق السموات والأرض، والمذكور في أول سورة الفاتحة كونه ربا للعالمين، وقد بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى المحدث أولى، أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه إلى المبقي حال بقائه، فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام يجري مجرى قسم من أقسام ما هو مذكور في أول سورة الفاتحة(14). ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر «المائدة» أنه تعالى لما ذكر ما قالته النصارى في عيسى وأمه من كونهما إلهين من دون الله، وجرت تلك المحاورة وذكر ثواب ما للصادقين، وأعقب ذلك بأن له ملك السموات والأرض وما فيهن وأنه قادر على كل شيء، ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد فلا يمكن أن يثبت معه شريك في الإلهية فيحمد، ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد والمقتضية، كون ملك السموات والأرض وما فيهن له بوصف خلق السماوات والأرض لأن الموجد للشيء المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه(15). سورة «الكهف»: استفتحها الله تعالى بقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا)، وهذا أيضاً تحميدٌ مخصوصٌ بنوع خاصٍ من النعمة وهي نعمة العلم والمعرفَةِ والهِدايَةِ والقرآن، وبالجملة النعمُ الحاصلةٌ بسَبَب بعْثَةِ الرُّسُلِ عليهم الصلاة والسلام(16). وذكر ابن عاشور أن موقع الافتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكلام في الغرض المهم. ولما كان إنزال القرآن على النبيء صلى الله عليه وآله وسلم أجزل نعماء الله تعالى على عباده المؤمنين لأنه سبب نجاتهم في حياتهم الأبدية، وسبب فوزهم في الحياة العاجلة بطيب الحياة وانتظام الأحوال والسيادة على الناس، ونعمة على النبيء صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعله واسطة ذلك ومبلغه ومبينه لأجل ذلك استحق الله تعالى أكمل الحمد إخبارا وإنشاء(17). سورة «سبأ»: استفتحها الله تعالى بقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)، وهو أيضاً قِسْمٌ من الأقسام الدَّاخِلَةِ تحتَ قوله تبارك وتعالى: (الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين) (18). وقد افتتحت السورة ب(الحمد لله) للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار باختصاصه به. فجملة (الحمد لله) هنا يجوز كونها إخبارا بأن جنس الحمد مستحق لله تعالى فتكون اللام في قوله: لله لام الملك. ويجوز أن تكون إنشاء ثناء على الله على وجه تعليم الناس أن يخصوه بالحمد فتكون اللام للتبيين لأن معنى الكلام: أحمد الله(19). والألف واللام في الْحَمْدُ لاستغراق الجنس، أي الْحَمْدُ على تنوعه هو لِلَّهِ تعالى من جميع جهات الفكرة، ثم جاء بالصفات التي تستوجب المحامد وهي ملكه جميع ما في السماوات والأرض، وعلمه المحيط بكل شيء وخبرته بالأشياء إذ وجودها إنما هو به جلت قدرته ورحمته بأنواع خلقه وغفرانه لمن سبق في علمه أن يغفر له من مؤمن، وقوله تعالى: (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) يحتمل أن تكون الألف واللام للجنس أيضا وتكون الآية خبرا، أي أن الحمد في الآخرة هو له وحده لإنعامه وإفضاله وتغمده وظهور قدرته وغير ذلك من صفاته، ويحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد والإشارة إلى قوله تعالى: (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [يونس: 10] أو إلى قوله: (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) [الزمر: 74] (20). وذكر الرازي أن الحمد هاهنا إشارة إلى النعمة التي في الآخرة، فلم ذكر الله السموات والأرض؟ فنقول نعم الآخرة غير مرئية فذكر الله النعم المرئية وهي ما في السموات وما في الأرض، ثم قال: وله الحمد في الآخرة ليقاس نعم الآخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها وفناء العاجلة ولهذا قال: (وهو الحكيم الخبير) إشارة إلى أن خلق هذه الأشياء بالحكمة والخير، والحكمة صفة ثابتة لله لا يمكن زوالها فيمكن منه إيجاد أمثال هذه مرة أخرى في الآخرة(21). ففي قوله تعالى في فاتحة هذه السورة: (الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة) [سبأ: 1] إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني بالحشر، واستدللنا عليه بقوله: (يعلم ما يلج في الأرض من الأجسام وما يخرج منها وما ينزل من السماء من الأرواح وما يعرج فيها) [سبأ: 2] وقوله عن الكافرين: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي) [سبأ: 3] (22). وعلق الطيبي على قول الزمخشري: (ما في السماواتِ والأرضِ كلُّه نِعمةٌ من الله تعالى)، فقال: «وذلك لأنه مَسارحُ أنظارِ المُتفكِّرين، ومهابطُ أنوارِ ربِّ العالمين، ومنها مَقاماتُ عروجِ العارِفين، فحُقَّ لذلك أن يُحمَدَ ويُثنى عليه. وحينَ ذكَرَ الله سبحانَه وتعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ) وصَفَ ذاتَه بأنه مالك هذه النِّعمةِ الجسيمة وأنها مِنه، عَلمْنا أنه المحمودُ على نِعَم الدنيا، ولمّا قرَنَ به (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) وهو مَطلق لم يُعْلَمْ أنّ الحمْدَ لأيِّ شيءٍ هو لِما فيه من نعوتِ الكَمال أو لِما أنّ منه النعمةَ والإفضالَ، فقَيَّد بالنعمةِ لدلالةِ القرينةِ الأولى عليها، وآل المعنى إلى أنه المحمودُ على النعمةِ الدنيوية والمحمودُ على النعمةِ الأخروية(23). وبين البيضاوي أن قوله تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) خلقاً ونعمة، فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته وعلى تمام نعمته. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ لأن ما في الآخرة أيضاً كذلك، وليس هذا من عطف المقيد على المطلق فإن الوصف بما يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمد بها، وتقديم الصلة للاختصاص فإن النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة. وَهُوَ الْحَكِيمُ الذي أحكم أمور الدارين. الخَبِيرُ ببواطن الأشياء(24). وذكر الطيبي في «فتوح الغيب» أنه أرادَ بالمُقيَّدِ الحَمدَ الثاني لأنه مُقَيَّدٌ بقَوله: (فِي الْآخِرَةِ)، والأولُ مُطلقٌ حيثُ لم يُذكَرْ معه «في الدنيا»، لكنَّ المصنِّفَ قَيَّدهُ بحَسبِ المُقابلة والعَطْفِ على نحوِ قول الشاعر:عَجِبْتُ لهم إذ يَقْتلونَ نفوسَهم /// ومقتلُهم عند الوغى كان أعذَرا
أي: يقْتلونَ نفوسُهم في السِّلْمِ بقرينةِ الوغى، بل قَيَّده بأنّه في الدنيا لأنَّ قولَه: (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) يدلُّ على ذلك لقولِه: «ثُمَّ وصفَ ذاتَه بالإنعامِ بجميعِ النِّعَمِ الدُّنيوية»، وهذا عَيْنُ ما ذكَره القاضي، ولعله عَرَّضَ بغيرِ المُصنِّفِ. ويُمكنُ أن يُقال: إن كُلاًّ من الحَمْدَيْن مُقَيَّدٌ ومُطلقٌ بحَسبِ التقابُلِ، فالأولُ مُقيَّدٌ ومُطلقٌ بحَسبِ التقابُلِ، فالأولُ مُقيَّدٌ بما يُنبُئ عن التعليلِ وتَرتُّبِ الحُكمِ على الوصفِ. والثاني مُطْلقٌ منه، والثاني مُقَيَّدٌ بكَوْنهِ (فِي الْآخِرَةِ)، والأولُ مُطلَقٌ منه. وأما إطلاقُ الأولِ فلقِلَّةِ مبالاةٍ بالدنيا وتحقيرِ شأنِها، وإطلاقُ الثاني للإيذانِ بفَخامةِ شأنِه وأنّه مما لا يدخُلُ تحْتَ الوصفِ من الإفضالِ والإكرامِ وغيرِ ذلك(25)، وهذا من أحسن البيان وأبلغه. سورة «فاطر»: استفتحها الله تعالى بقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)، وهاهنا الحمد إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة، ويدل عليه قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أي يجعلهم رسلا يتلقون عباد الله(26). فإن قيل: ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب؟ وأيضا لم قال في سورة «الأنعام» (خلق السماوات والأرض) بصيغة فعل الماضي؟ وقال في سورة «فاطر» (الحمد لله فاطر السماوات والأرض) بصيغة اسم الفاعل؛ فنقول في الجواب عن الأول: الخلق عبارة عن التقدير وهو في حق الحق سبحانه عبارة عن علمه النافذ في جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما كونه فاطرا فهو عبارة عن الإيجاد والإبداع، فكونه تعالى خالقا إشارة إلى صفة العلم، وكونه فاطرا إشارة إلى صفة القدرة، وكونه تعالى ربا ومربيا مشتمل على الأمرين، فكان ذلك أكمل. والجواب عن الثاني: أن الخلق عبارة عن التقدير وهو في حق الله تعالى عبارة عن علمه بالمعلومات، والعلم بالشيء يصح تقدمه على وجود المعلوم. ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشيء قبل دخوله في الوجود. أما إيجاد الشيء، فإنه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن القدرة إنما تؤثر في وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: خلق السماوات والمراد أنه كان عالما بها قبل وجودها، وقال: (فاطر السماوات والأرض) والمراد أنه تعالى إنما يكون فاطرا لها وموجدا لها عند وجودها(27). أما التحميدات المذكورة في أوائل هذه السور فكأن كل واحد منها قسم من أقسام ذلك التحميد ونوع من أنواعه(28). ثانيا: تبارك: افتتح الله تعالى سورتين من سور القرآن الكريم بقوله (تبارك) وهما: سورة «الفرقان» و«الملك». «تبارك»: تفاعل، من «البركة»، والبركة: الكثرة من خير ومعناه: زاد عطاؤه وكثر. وقيل: معناه: دام وثبت إنعامه. وهو من: برك الشيء، إذا ثبت(29). ثم إن «تبارك» فعل ماض جامد لا يتصرف فلا يأتي منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل وليس له مصدر ولا يستعمل في غير الله تعالى(30)، وورد في تفسير ابن عطية: «وتَبارَكَ فعل مختص بالله تعالى لم يستعمل في غيره، ولذلك لم يصرف منه مستقبل ولا اسم فاعل، وهو صفة فعل أي كثرت بركاته ومن جملتها إنزال كتابه الذي هو الْفُرْقانَ بين الحق والباطل»(31). والافتتاح بقوله تعالى (تبارك) افتتاح بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب لأن غالب فواتحهم أن تكون بالأسماء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصل، مثل قول طرفة: لخولة أطلال ببرقة ثهمد أو بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرئ القيس: قفا نبك البيت أو بحروف التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل «إن» و«قد» والهمزة و«هل». ومن قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء وقول النابغة: كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستكنا وظاهرا وبهذه الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع لأن الندرة من العزة، والعزة من محاسن الألفاظ وضدها الابتذال(32). سورة «الفرقان»: استفتحها الله تعالى بقوله: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً)، وتكرر قوله (تَبَارَكَ) في آيتين اثنتين من نفس السورة وهما قوله تعالى: (تَبَارَكَ الذي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذلك) [الفرقان: 10]، وقوله: (تَبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي السمآء بُرُوجاً) [الفرقان: 61]. وظاهر قوله (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) أنه إخبار عن عظمة الله وتوفر كمالاته فيكون المقصود به التعليم والإيقاظ، ويجوز مع ذلك أن يكون كناية عن إنشاء ثناء على الله تعالى أنشأ الله به ثناء على نفسه كقوله (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ) [الإسراء: 1] على طريقة الكلام العربي في إنشاء التعجب من صفات المتكلم في مقام الفخر والعظمة، أو إظهار غرائب صدرت(33). واشتملت هذه السورة على الابتداء بتحميد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه، ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها. وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن، وجلال منزله، وما فيه من الهدى، وتعريض بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك، والتنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم: الأولى: إثبات أن القرآن منزل من عند الله، والتنويه بالرسول المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ودلائل صدقه، ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنيا، وأنه على طريقة غيره من الرسل، ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب. الدعامة الثانية: إثبات البعث والجزاء، والإنذار بالجزاء في الآخرة، والتبشير بالثواب فيها للصالحين، وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ، وتكون لهم الندامة على تكذيبهم الرسول وعلى إشراكهم واتباع أئمة كفرهم. الدعامة الثالثة: الاستدلال على وحدانية الله، وتفرده بالخلق، وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك، وإبطال إلهية الأصنام، وإبطال ما زعموه من بنوة الملائكة لله تعالى. وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة (تبارك الذي) الخ(34). وذكر الطيبي أن قوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) واردٌ على نهج براعة الاستهلال، وهو مشتملٌ على هذا المعنى: فإن إنزال القرآن وتخصيصه بما يدل على كونه فارقاً بين الحق والباطل، وكون منزله معظماً في ذاته مباركاً في صفاته موجبٌ لأن لا يختص إنذار رسوله بقوم دون قوم، بل يكون للعالمين من الثقلين نذيراً، فإذن المعنى الذي سيقت هذه السورة الكريمة له: الحديث في الرسول وإنذاره، وبقية المعاني دائرةٌ عليه(35). وتضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف ببهتهم وسوء مرتكبهم ما لم يتضمن كثير من نظائرها كقولهم (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) [الفرقان: 7] الآيات، وقولهم (لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) [الفرقان: 21] وقولهم (لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) [الفرقان: 32] وقولهم (وما الرحمن) [الفرقان: 60] إلى ما عضد هذه وتخللها، ولهذا ختمت بقاطع الوعيد، وأشد التهديد، وهو قوله سبحانه (فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً) [الفرقان: 77] (36). ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف انفصال واحد منهم على إذنه وحذر من يخالف أمره وذكر أن له ملك السموات والأرض وأنه تعالى عالم بما هم عليه ومجازيهم على ذلك، فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن يفتتح هذه السورة بأنه تعالى منزه في صفاته عن النقائص كثير الخير، ومن خيره أنه نزل الفرقان على رسوله منذرا لهم فكان في ذلك إطماع في خيره وتحذير من عقابه(37). سورة «الملك»: استفتحها الله تعالى بقوله: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ فقد افتتحت السورة بما يدل على منتهى كمال الله تعالى افتتاحا يؤذن بأن ما حوته يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. ففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال كما تقدم في طالع سورة «الفرقان»(38). وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: «ورود ما افتتحت به هذه السورة من التنزيه وصفات التعالي إنما يكون عقيب تفصيل وإيراد عجائب من صنعه سبحانه كورود قوله تعالى: (فتبارك الله أحسن الخالقين) عقيب تفصيل التقلب الإنساني من لدن خلقه من سلالة من طين إلى إنشائه خلقاً آخر، وكذا كل ما ورد من هذا ما لم يرد أثناء آي قد جردت للتنزيه والإعلام بصفات التعالي والجلال»(39). الثناء بالنفي والتنزيه من صفات النقص: التسبيح: وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله» التي نحت منها السبحلة. ووقع التصرف في صيغها بالإضمار نحو: سبحانك وسبحانه، وبالموصول(40). وقد جاء الافتتاح بالتسبيح في سبع سور من القرآن الكريم، وتسمى هذه السور «المسبحات». وجاء في بعض الفواتح سَبَّحَ على لفظ الماضي، وفي بعضها على لفظ المضارع، وكل واحد منهما معناه: أنّ من شأن من أسند إليه التسبيح أن يسبحه، وذلك هجيراه وديدنه، وقد عدى هذا الفعل باللام تارة وبنفسه أخرى في قوله تعالى وَتُسَبِّحُوهُ وأصله: التعدي بنفسه، لأنّ معنى سبحته: بعدته عن السوء، منقول من سبح إذا ذهب وبعد، فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل اللام في: نصحته، ونصحت له. وإما أن يراد بسبح لله: أحدث التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصا(41). وورود صيغة التسبيح في هذه الفواتح على لفظ الماضي، وفي بعضها على لفظ المضارع، فيه إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة غير مختص بوقت دون وقت، بل هي كانت مسبحة أبدا في الماضي، وتكون مسبحة أبدا في المستقبل، وذلك لأن كونها مسبحة صفة لازمة لماهياتها، فيستحيل انفكاك تلك الماهيات عن ذلك التسبيح، وإنما قلنا: إن هذه المسبحية صفة لازمة لماهياتها، لأن كل ما عدا الواجب ممكن، وكل ممكن فهو مفتقر إلى الواجب، وكون الواجب واجبا يقتضي تنزيهه عن كل سوء في الذات والصفات والأفعال والأحكام والأسماء على ما بيناه، فظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة في الماضي، وتكون حاصلة في المستقبل، والله أعلم(42). اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين: الأول: بالقول كقوله باللسان سبحان الله. والثاني: بدلالة أحواله على توحيد الله تعالى وتقديسه وعزته، فأما الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم، ومن لا يكون حيا مثل الجمادات فهي إنما تسبح لله تعالى بالطريق الثاني، لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والإدراك والنطق وكل ذلك في الجماد محال، فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني(43). ثم إنه تعالى قال في البعض من السور: (سبح لله) [الحديد: 1، الحشر: 1] ، وفي البعض: (يسبح) [الجمعة: 1، التغابن: 1] ، وفي البعض: (سبح) [الأعلى: 1] بصيغة الأمر، ليعلم أن تسبيح حضرة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان، والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان، والأمر يدل عليه في الحال(44). وأشار الرازي في «مفاتيح الغيب» إلى أن التسبيح أينما جاء فإنما جاء مقدما على التحميد، ألا ترى أنه يقال: سبحان الله والحمد لله إذا عرفت هذا فنقول: إنه جل جلاله ذكر التسبيح عند ما أخبر أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: 1] وذكر التحميد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وفيه فوائد: الفائدة الأولى: أن التسبيح أول الأمر لأنه عبارة عن تنزيه الله عما لا ينبغي وهو إشارة إلى كونه كاملا في ذاته والتحميد عبارة عن كونه مكملا لغيره، ولا شك أن أول الأمر هو كونه كاملا في ذاته ونهاية الأمر كونه مكملا لغيره فلا جرم وقع الابتداء في الذكر بقولنا: (سبحان الله) ثم ذكر بعده الحمد لله تنبيها على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نهاية. إذا عرفت هذا فنقول: ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد وهذا تنبيه على أن الإسراء به أول درجات كماله وإنزال الكتاب غاية درجات كماله، والأمر في الحقيقة كذلك لأن الإسراء به إلى المعراج يقتضي حصول الكمال له، وإنزال الكتاب عليه يقتضي كونه مكملا للأرواح البشرية وناقلا لها من حضيض البهيمية إلى أعلى درجات الملكية، ولا شك أن هذا الثاني أكمل. وهذا تنبيه على أن أعلى مقامات العباد مقاما أن يصير العبد عالما في ذاته معلما لغيره(45). سورة «الإسراء»: استفتحها الله تعالى بقوله: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ)؛ فقد مجد تعالى نفسه بقوله سُبْحانَ وينزه ذاته العلية عما لا يليق بجلاله، ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا إله غيره(46)، وفي ذلك براعة الاستهلال (سُبْحَانَ الذي أسرى) لأنه لما كان أمراً خارقاً للعادة بدأ بلفظ يشير إلى كمال القدرة وتنزه الله عن صفات النقص(47). و«سبحان» علم جنس للتنزيه والتقديس وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره أسبح الله سبحانه أو سبحت الله سبحان أي فهو مفعول مطلق، ومعناه: ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص ولذا لا يستعمل إلا فيه تعالى(48). ووجه مناسبة فاتحة هذه السورة للسورة التي قبلها ما ذكره البقاعي من أنه «لما كان مقصود النحل التنزه عن الاستعجال وغيره من صفات النقص، والاتصاف بالكمال المنتج لأنه قادر على الأمور الهائلة ومنها جعل الساعة كلمح البصر أو أقرب، وختمها بعد تفضيل إبراهيم عليه السلام والأمر باتباعه بالإشارة إلى نصر أوليائه -مع ضعفهم في ذلك الزمان وقلتهم- على أعدائه على كثرتهم وقوتهم، وكان ذلك من خوارق العادات ونواقص المطردات، وأمرهم بالتأني والإحسان، افتتح هذه بتحقيق ما أشار الختم إليه بما خرقه من العادة في الإسراء، وتنزيه نفسه الشريفة من توهم استبعاد ذلك، تنبيهاً على أنه قادر على أن يفعل الأمور العظيمة الكثيرة الشاقة في أسرع وقت، دفعاً لما قد يتوهم أو يتعنت به من يسمع نهيه عن الاستعجال وأمره بالصبر، وبياناً لأنه مع المتقي المحسن، وتنويهاً بأمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإعلاماً بأنه رأس المحسنين وأعلاهم رتبة وأعظمهم منزلة، بما آتاه من الخصائص التي منها المقام المحمود، وتمثيلاً لما أخبر به من أمر الساعة فقال تعالى: (سبحان) وهو علم للتنزيه، دال على أبلغ ما يكون من معناه، منصوب بفعل متروك إظهاره، فسد مسده (الذي أسرى) فنزه نفسه الشريفة عن كل شائبة نقص يمكن أن يضفها إليه أعداؤه بهذا اللفظ الأبلغ عقب الأمر بالتأني آخر النحل. كما نزه نفسه الشريفة بذلك اللفظ عقب النهي عن الاستعجال في أولها، وهو راد لما علم من ردهم عليه وتكذيبهم له إذا حدثهم عن الإسراء، وفيه مع ذلك إيماء إلى التعجيب من هذه القصة للتنبيه على أنها من الأمور البالغة في العظمة إلى حد لا يمكن استيفاء وصفه»(49). وذكر ابن عاشور أن «الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. فإن جملة التسبيح في الكلام الذي لم يقع فيه ما يوهم تشبيها أو تنقيصا لا يلقيان بجلال الله تعالى مثل (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) [الصافات:180] يتعين أن تكون مستعملة في أكثر من التنويه، وذلك هو التعجيب من الخبر المتحدث به كقول:ُ (قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) [النور:16]، وقول الأعشى:قد قلت لما جاءني فخره /// سبحان من علقمة الفاخر
ولما كان هذا الكلام من جانب الله تعالى والتسبيح صادرا منه كان المعنى تعجيب السامعين، لأن التعجيب مستحيلة حقيقته على الله، لا لأن ذلك لا يلتفت إليه في محامل الكلام البليغ لإمكان الرجوع إلى التمثيل، مثل مجيء الرجاء في كلامه تعالى نحو: (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [البقرة:189]، بل لأنه لا يستقيم تعجب المتكلم من فعل نفسه، فيكون معنى التعجيب فيه من قبيل قولهم: أتعجب من قول فلان كيت و كيت. ووجه هذا الاستعمال أن الأصل أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما لا يليق بالله تعالى. ولما كان ظهور ما يدل على عظيم القدرة مزيلا للشك في قدرة الله وللإشراك به كان من شأنه أن ينطق المتأمل بتسبيح الله تعالى، أي تنزيهه عن العجز»(50). سورة «الحديد»: استفتحها الله تعالى بقوله: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)؛ افتتاح هذه السورة بذكر تسبيح الله وتنزيهه مؤذن بأن أهم ما اشتملت عليه إثبات وصف الله بالصفات الجليلة المقتضية أنه منزه عما ضل في شأنه أهل الضلال من وصفه بما لا يليق بجلاله(51). ووجه مناسبة افتتاح هذه السورة بالتسبيح لخاتمة سورة «الواقعة» أنه تعالى لما بين الحق وامتنع الكفار، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو حق، فإن امتنعوا فلا تتركهم ولا تعرض عنهم وسبح ربك في نفسك، وما عليك من قومك سواء صدقوك أو كذبوك، ويحتمل أن يكون المراد فسبح واذكر ربك باسمه الأعظم، وهذا متصل بما بعده لأنه قال في السورة التي تلي هذه: (سبح لله ما في السماوات) [الحديد: 1] فكأنه قال: سبح الله ما في السموات، فعليك أن توافقهم ولا تلتفت إلى الشرذمة القليلة الضالة، فإن كل شيء معك يسبح الله عز وجل(52). سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ذكر ها هنا وفي «الحشر» و«الصف» بلفظ الماضي، وفي «الجمعة» و«التغابن» بلفظ المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاته، لأنه دلالة جِبِلِّية لا تختلف باختلاف الحالات، ومجيء المصدر مطلقاً في «بني إسرائيل» أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال، وإنما عدي باللام وهو متعد بنفسه مثل نصحت له في نصحته إشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه(53). و«سبّح»: فعل ماض مبني على الفتح، و«لله»: متعلقان بسبّح وقيل اللام زائدة في المفعول، وقد تقدم القول في هذا الفعل وأنه قد يتعدى بنفسه تارة وباللام أخرى(54). سورة «الحشر»: استفتحها الله تعالى بقوله: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّماواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)، وختمها بقوله: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)؛ وبذلك تكون هذه السورة افتتحت بالتسبيح واختتمت به أيضا. افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح ما في السماوات والأرض لله تعالى تذكير للمؤمنين بتسبيحهم لله تسبيح شكر على ما أنالهم من فتح بلاد بني النضير فكأنه قال سبحوا لله كما سبح له ما في السماوات والأرض. وتعريض بأولئك الذين نزلت السورة فيهم بأنهم أصابهم ما أصابهم لتكبرهم عن تسبيح الله حق تسبيحه بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم إذ أعرضوا عن النظر في دلائل رسالته أو كابروا في معرفتها. والقول في لفظ هذه الآية كالقول في نظيرها في أول سورة «الحديد»، إلا أن التي في أول سورة «الحديد» فيها: ما في السماوات والأرض وهاهنا قال: ما في السماوات وما في الأرض لأن فاتحة سورة «الحديد» تضمنت الاستدلال على عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأرض فكان دليل ذلك هو مجموع ما احتوت عليه السماوات والأرض من أصناف الموجودات فجمع ذلك كله في اسم واحد هو ما الموصولة التي صلتها قوله: (في السماوات والأرض). وأما فاتحة سورة «الحشر» فقد سيقت للتذكير بمنة الله تعالى على المسلمين في حادثة أرضية وهي خذلان بني النضير فناسب فيها أن يخص أهل الأرض باسم موصول خاص بهم، وهي ما الموصولة الثانية التي صلتها في الأرض، وعلى هذا المنوال جاءت فواتح سور الصف والجمعة والتغابن كما سيأتي في مواضعها. وأوثر الإخبار عن سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بفعل المضي لأن المخبر عنه تسبيح شكر عن نعمة مضت قبل نزول السورة وهي نعمة إخراج أهل النضير(55). وذكر الرازي في «مفاتيح الغيب» أنه قوله تعالى في موضع: (سبح لله ما في السماوات وما في الأرض) [الحشر: 1] وفي موضع آخر: (سبح لله ما في السماوات والأرض) [الحديد: 1] فيه حكمة لكننا لا نعلمها كما هي، لكن نقول: ما يخطر بالبال، وهو أن مجموع السموات والأرض شيء واحد، وهو عالم مؤلف من الأجسام الفلكية والعنصرية، ثم الأرض من هذا المجموع شيء والباقي منه شيء آخر، فقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بالنسبة إلى هذا الجزء من المجموع وبالنسبة إلى ذلك الجزء منه كذلك، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال، قال تعالى في بعض السور كذا وفي البعض هذا ليعلم أن هذا العالم الجسماني من وجه شيء واحد، ومن وجه شيئان بل أشياء كثيرة، والخلق في المجموع غير ما في هذا الجزء، وغير ما في ذلك أيضا ولا يلزم من وجود الشيء في المجموع أن يوجد في كل جزء من أجزائه إلا بدليل منفصل، فقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض على سبيل المبالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح ما في السموات وعلى تسبيح ما في الأرض، كذلك بخلاف قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض(56). سورة «الصف»: استفتحها الله تعالى بقوله: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّماواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهوَ العَزِيزُ الحَكِيم). ووجه مناسبة فاتحة هذه السورة لخاتمة التي قبلها أنه لما ختمت «الممتحنة» بالأمر بتنزيهه سبحانه عن تولي من يخالف أمره بالتولي عنهم والبراءة منهم اتباعاً لأهل الصافات المتجردين عن كل ما سوى الله لا سيما عمن كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، افتتحت «الصف» بما هو كالعلة لذلك فقال: (سبح لله) أي أوقع التنزيه الأعظم للملك الأعظم الذي له (ما في السموات) من جميع الأشياء التي لا يغفل من أفلاكها ونجومها وغير ذلك من جواهرها وأعراضها في طلوعها وأفولها وسيرها في ذهابها ورجوعها وإنشاء السحاب وإنزال المياه وغير ذلك. ولما كان الخطاب مع غير الخلص أكده فقال: (وما في الأرض) أي بامتثال جميع ما يراد منه مما هو كالمأمور بالنسبة إلى أفعال العقلاء من نزول المياه وإخراج النبات من النجم والشجر وإنضاج الحبوب والثمار وغير ذلك من الأمور الصغار والكبار(57). أما مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من السورة فهو بيان أن الكافرين محقوقون بأن تقاتلوهم لأنهم شذوا عن جميع المخلوقات فلم يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات الكمال إذ جعلوا له شركاء في الإلهية. وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بأنهم لم يؤدوا حق تسبيح الله، لأن الله مستحق لأن يوفى بعهده في الحياة الدنيا وأن الله ناصر الذين آمنوا على عدوهم(58). سورة «الجمعة»: استفتحها الله تعالى بقوله: (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم)، و«يسبّح»: فعل مضارع مرفوع و«لله»: متعلقان به أو اللام زائدة في المفعول، وصيغةُ المضارع (يُسَبِّحُ) لإِفادة التجدد والاستمرار، فهو تسبيحٌ دائم على الدوام(59). وجه تعلق هذه السورة بما قبلها هو أنه تعالى قال في أول تلك السورة: (سبح لله) [الصف: 1] بلفظ الماضي وذلك لا يدل على التسبيح في المستقبل، فقال في أول هذه السورة بلفظ المستقبل ليدل على التسبيح في زماني الحاضر والمستقبل، وأما تعلق الأول بالآخر، فلأنه تعالى ذكر في آخر تلك السورة أنه كان يؤيد أهل الإيمان حتى صاروا عالين على الكفار، وذلك على وفق الحكمة لا للحاجة إليه إذ هو غني على الإطلاق، ومنزه عما يخطر ببال الجهلة في الآفاق، وفي أول هذه السورة ما يدل على كونه مقدسا ومنزها عما لا يليق بحضرته العالية بالاتفاق، ثم إذا كان خلق السموات والأرض بأجمعهم في تسبيح حضرة الله تعالى فله الملك، كما قال تعالى: (يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك) [التغابن: 1] ولا ملك أعظم من هذا، وهو أنه خالقهم ومالكهم وكلهم في قبضة قدرته وتحت تصرفه، يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل في سائر الأزمان(60). ذلك أن افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض لله تعالى براعة استهلال لأن الغرض الأول من السورة التحريض على شهود الجمعة والنهي عن الأشغال التي تشغل عن شهودها وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصا على الابتياع من عير وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة. وللتنبيه على أن أهل السماوات والأرض يجددون تسبيح الله ولا يفترون عنه أوثر المضارع في قوله: (يسبح). وقد جاء فيها فعل التسبيح مضارعا أيضا وجيء به في سواها ماضيا لمناسبة فيها وهي: أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة والتنديد على نفر قطعوا عن صلاتهم وخرجوا لتجارة أو لهو فمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة(61). ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على أعدائهم، أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه، وذكر ما أنعم به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعثته إليهم، وتلاوته عليهم كتابه، وتزكيتهم، فصارت أمته غالبة سائر الأمم، قاهرة لها، منتشرة الدعوة، كما انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم(62). سورة «التغابن»: استفتحها الله تعالى بقوله: (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ ذلك أنه لما كان جل ما اشتملت عليه هذه السورة إبطال إشراك المشركين وزجرهم عن دين الإشراك بأسره وعن تفاريعه التي أعظمها إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وتلك أصول ضلالهم ابتدئت السورة بالإعلان بضلالهم وكفرانهم المنعم عليهم، فإن ما في السماوات والأرض يسبح لله تعالى عن النقائص: إما بلسان المقال مثل الملائكة والمؤمنين أو بلسان الحال مثل عبادة المطيعين من المخلوقات المدركة كالملائكة والمؤمنين، وإما بلسان الحال مثل دلالة حال الاحتياج إلى الإيجاد والإمداد كحاجة الحيوان إلى الرزق وحاجة الشجرة إلى المطر وما يشهد به حال جميع تلك الكائنات من أنها مربوبة لله تعالى ومسخرة لما أراده منها، وكل تلك المخلوقات لم تنقض دلالة حالها بنفائض كفر مقالها فلم يخرج عن هذا التسبيح إلا أهل الضلال من الإنس والشياطين فإنهم حجبوا بشهادة حالهم لما غشوها به من صرح الكفر. فالمعنى: يسبح لله ما في السماوات والأرض وأنتم بخلاف ذلك. وهذا يفيد ابتداء تقرير تنزيه الله تعالى وقوة سلطانه ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويكون لهم تعليما وامتنانا ويفيد ثانيا بطريق الكناية تعريضا بالمشركين الذين لم ينزهوه ولا وقروه فنسبوا إليه شركاء(63). وجيء بفعل التسبيح مضارعا للدلالة على تجدد ذلك التسبيح ودوامه وقد سبق نظيره في فاتحة سورة الجمعة. وجيء به في فواتح سور: الحديد، والحشر، والصف بصيغة الماضي للدلالة على أن التسبيح قد استقر في قديم الأزمان. فحصل من هذا التفنن في فواتح هذه السور كلا المعنيين زيادة على ما بيناه من المناسبة الخاصة بسورة «الجمعة»، وما في هاته السورة من المناسبة بين تجدد التسبيح والأمر بالعفو عن ذوي القربى والأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة والسمع والطاعة لكي لا يكتفي المؤمنون بحصول إيمانهم ليجتهدوا في تعزيزه بالأعمال الصالحة(64). سورة «الأعلى»: استفتحها الله تعالى بقوله: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى). سبّح فعل أمر أي نزّه وقد تقدم وفاعله مستتر تقديره أنت واسم ربك مفعوله(65). وتسبيح اسمه عز وعلا: تنزيهه عما لا يصح فيه من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه(66). وقيل: سبح اسم ربك الأعلى، أي صل باسم ربك، لا كما يصلي المشركون بالمكاء والتصدية(67). سبح: نزه عن النقائص، اسم ربك: الظاهر أن التنزيه يقع على الاسم، أي نزهه عن أن يسمى به صنم أو وثن فيقال له رب أو إله، وإذا كان قد أمر بتنزيهه اللفظ أن يطلق على غيره فهو أبلغ، وتنزيه الذات أحرى. وقيل: الاسم هنا بمعنى المسمى. وقيل: معناه نزه اسم الله عن أن تذكره إلا وأنت خاشع. وقال ابن عباس: المعنى صل باسم ربك الأعلى، كما تقول: ابدأ باسم ربك، وحذف حرف الجر(68). فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الخويصة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من العقائد والأعمال كالسجود والحمد. ويشمل ذلك استحضار الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار المعنى يتكرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم الله تعالى(69). ووجه مناسبة افتتاح هذه السورة بالتسبيح أنه لما قال سبحانه وتعالى مخبراً عن عمه الكفار في ظلام حيرتهم (إنهم يكيدون كيداً) [الطارق: 15] وكان وقوع ذلك من العبيد المحاط بأعمالهم ودقائق أنفاسهم وأحوالهم من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق جل جلاله وتعالى علاؤه وشأنه، أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتنزيه ربه الأعلى عن شنيع اعتدائهم وافك افترائهم، فقال (سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: 1] أي نزهه عن قبيح مقالهم(70). الافتتاح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبح اسم ربه بالقول، يؤذن بأنه سيلقي إليه عقبه بشارة وخيرا له وذلك قوله: (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى) [الأعلى:6] فيه براعة استهلال(71). استنتاجات: - الثَّنَاءُ قِسْمَانِ: إِثْبَاتٌ لِصِفَاتِ الْمَدْح؛ وَنَفْيٌ وَتَنْزِيهٌ مِنْ صفات النقص. - ورد الإثبات لِصِفَاتِ الْمَدْح بصيغتين هما: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) فِي خَمْسِ سُوَرٍ، وَ(تَبَارَكَ) فِي سُورَتَيْن. - ورد الثناء على الله تعالى بالنفي والتنزيه عن صفات النقص في فواتح سبع سور من القرآن الكريم. - الاستفتاح بالحمد في أول سورة معينة إشارة إلى نعمة معينة يرد تفصيلها في تلك السورة. - جاء فعل التسبيح في بعض الفواتح ماضيا وفي بعضها مضارعا وفي بعضها أمرا للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات، وحصل بذلك أيضا التفنن في فواتح السور. - قال تعالى في موضع: (سبح لله ما في السماوات وما في الأرض) وفي موضع آخر (سبح لله ما في السماوات والأرض) لحكمة في ذلك اجتهد المفسرون في بيانها. - هذه الفواتح مناسبة لما قبلها ومناسبة لما بعدها؛ أي مناسبة أغراض تلك السورة مما يحقق براعة الاستهلال. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش: 1- البرهان في علوم القرآن 1/120. 2- انظر: البرهان في علوم القرآن 1/131، الإتقان في علوم القرآن 3/363، طبقات الشافعية الكبرى 8/167. 3- صفوة التفاسير 1/354. 4- التحرير والتنوير 22/135. 5- نفسه 1/154. 6- صفوة التفاسير 1/18. 7- إعراب القرآن الكريم وبيانه 1/16. 8- نفسه 1/14. 9- انظر: تفسير الطبري 1/140. 10- التحرير والتنوير 1/152. 11- مفاتيح الغيب 1/162. 12- نفسه 12/474. 13- انظر: المحرر الوجيز 2/265. 14- مفاتيح الغيب 1/162. 15- البحر المحيط 4/428. 16- اللباب 8/7. 17- التحرير والتنوير 15/246. 18- اللباب 8/7. 19- التحرير والتنوير 22/135. 20- المحرر الوجيز 4/404. 21- مفاتيح الغيب 25/195. 22- نفسه 26/221. 23- فتوح الغيب 12/496. 24- تفسير البيضاوي 4/241. 25- فتوح الغيب 12/497. 26- مفاتيح الغيب 26/221. 27- نفسه 12/474. 28- نفسه 12/474. 29- الموسوعة القرآنية 4/312. 30- إعراب القرآن الكريم وبيانه 6/664. 31- المحرر الوجيز 4/199. 32- التحرير والتنوير 19/7. 33- نفسه 19/6. 34- نفسه 19/6. 35- فتوح الغيب 11/261. 36- البرهان في تناسب سور القرآن ص: 261. 37- البحر المحيط 8/79. 38- التحرير والتنوير 29/8. 39- البرهان في تناسب سور القرآن ص: 342. 40- التحرير والتنوير 14/9. 41- الكشاف 4/472. 42- مفاتيح الغيب 29/441- 442. 43- نفسه 20/347. 44- نفسه 29/526. 45- نفسه 21/421. 46- محاسن التأويل 6/427. 47- صفوة التفاسير 2/143. 48- إعراب القرآن الكريم وبيانه 5/388. 49- نظم الدرر 11/288. 50- التحرير والتنوير 14/8- 9. 51- نفسه 27/356. 52- مفاتيح الغيب 29/440. 53- تفسير البيضاوي 5/185. 54- إعراب القرآن الكريم وبيانه 9/452. 55- التحرير والتنوير 28/65. 56- مفاتيح الغيب 30/552. 57- نظم الدرر 20/2. 58- التحرير والتنوير 28/174. 59- صفوة التفاسير 3/356. 60- مفاتيح الغيب 30/537. 61- التحرير والتنوير 28/185. 62- البحر المحيط 10/171. 63- التحرير والتنوير 28/232- 233. 64- نفسه 28/233. 65- إعراب القرآن الكريم وبيانه 10/449. 66- الكشاف 4/737. 67- مفاتيح الغيب 31/125. 68- البحر المحيط 10/455. 69- التحرير والتنوير 30/242. 70- نظم الدرر 21/391. 71- انظر: التحرير والتنوير 30/241. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر والمراجع: - إعراب القرآن الكريم وبيانه، لمحيي الدين الدرويش، الطبعة الحادية عشرة: 1432هـ/ 2011م، منشورات اليمامة ودار ابن كثير. - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)، لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة الأولى: 1418هـ، منشورات: دار إحياء التراث العربي، بيروت. - البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، منشورات: دار الفكر، بيروت، سنة: 1420هـ. - البرهان فى تناسب سور القرآن، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، تحقيق: محمد شعباني، منشورات: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، عام النشر: 1410هـ/ 1990م. - البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، سنة 1430هـ/ 2009م. - التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، منشورات الدار التونسية للنشر، تونس، سنة النشر: 1984هـ. - جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) لأبي جعفر الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى: 1420هـ /2000م، منشورات: مؤسسة الرسالة. - صفوة التفاسير، لمحمد علي الصابوني، الطبعة الأولى: 1417هـ/ 1997م، منشورات: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. - فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، للطيبي، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا، الطبعة الأولى: 1434هـ/ 2013م، منشورات: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، الطبعة الثالثة: 1407هـ، منشورات: دار الكتاب العربي، بيروت. - اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الطبعة الأولى: 1419هـ/1998م، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت. - محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى: 1418هـ، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت. - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى: 1422هـ، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت. - مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، الطبعة الثالثة: 1420هـ، منشورات: دار إحياء التراث العربي، بيروت. - الموسوعة القرآنية، لإبراهيم بن إسماعيل الأبياري، منشورات: مؤسسة سجل العرب، سنة: 1405هـ. - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرزاق غالب المهدي، الطبعة الثالثة: 1427هـ/ 2006م، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت.