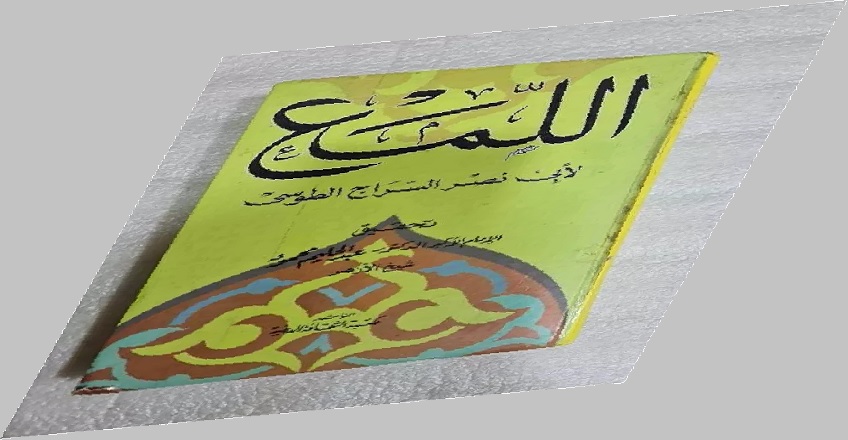التشوف إلى مقامات التصوف (8) درر من تفسير ابن جزي الغرناطي (مقام الخوف)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد فهذه درة ثامنة من نفائس درر الإمام العلامة أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي (ت:714) اقتنصت من تفسيره المسمى بـ«التسهيل لعلوم التنزيل» انتزعها الإمام من قوله تعالى: ﴿وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين﴾، [الأعراف:55]؛ محتفيا رحمه الله بالقيد دون المقيد، وبالصفة دون الموصوف؛ لذا آثرنا سلفا التقدمة للمقامين الواقعين صفة بموصوفهما ـ أعني الدعاء ـ؛ سيرا على مساق الآية الكريمة، على ما حرره المفسرون، وأعربه المعربون.
وها قد آن الأوان للنظر في مقامي الخوف والرجاء، مبتدئين بما وصى باستصحابه العمر كله أبو القاسم وغيره؛ ليكون زماما للنفس الجامحة، ودارئا للنزغات، ودامغا للشهوات، ومعينا على التزام الطاعات، وليس يتم ذلك إلا باستحضار آية الجلال والقهر والسلطان: خلقا وملكا، حسابا وعقابا؛ حتى إذا دنت الخاتمة، وأزف الرحيل، تؤمل في آيات الجمال رحمة ولطفا، رأفة وعطفا؛ وإليه الإشارة بحديث: ﴿لايموتن أحدكم.. ﴾ الآتي قريبا، وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه..﴾ ([1])
وقد زخر الكتاب المسطور بآيات بينات في شأن الجلال والجمال، من ذلك ما فيه عميق الإشارة للكون المنظور خلقا وإحكاما وتسخيرا: كمثل السماوات والأرض، والشمس والقمر، والنجوم والكواكب ، والجبال والأحجار، والأنهار والبحار، والرياح والسحاب، والمياه والرعد والبرق، ومراحل الجنين في الإنسان، والطير والحيوان ومنتجاته، والنبات ومحاصيله وثماره، وغير ذلك مما يبين جمال المصنوع وجلال إحكامه، وجبروت الصانع وعظمة إتقانه: ﴿صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون﴾[النمل:88].
وهذه شمسنا عبارة عن نجم أضخم من الأرض بأكثر من مائة مرة، وذاك سديم الجبار: ملايين النجوم تولد كل يوم، وقد اختفت في أحشائها شمسنا كأنها حبة خردل، وتلك مجرة درب التبانة التي تضم ما يداني أربعمائة مليار نجم وكوكب، ليست الأرض فيها سوى أدق من حلقة في فلاة، وثمة ما ينيف عن خمسمائة مليار مجرة تم اكتشافها إلى اليوم، وفي أوساطها تختفي مجرتنا الهائلة بشموسها وكواكبها كحبة رمل في فلاة..، وما بلغوا معشار ما خلق الله العظيم في كونه، ولا يستطيعون سبيلا؛ إذ لا قياس في غياب مقيس، ولا نسبة للجزء عند الجهالة بالكل: ﴿ ويخلق ما لا تعلمون﴾، وكل ذلك أعني ما نعلم وما لا نعلم من صنع الله قد وسعه كرسيه سبحانه، قال تعالى: ﴿وسع كرسيه السموت والارض﴾، وقد صح في الخبر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.. قلت: فأي آية أنزل الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: ﴿يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة﴾([2])، فمن لا يخاف تعظيما وإجلالا ورهبة من هذا الخالق العظيم فما قدر الله حق قدره؛ ولذلك قال سبحانه: ﴿وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموت مطويات بيمينه﴾ [الزمر: 67] أي: ما عظموه حق تعظيمه، وهذه الآية مذكورة في سور ثلاث: في سورة الأنعام، وفي سورة الحج، وفي هذه السورة([3]) الكريمة يعني سورة الزمر.
فهذا الذي تأمله العارفون، وهو الذي نظر إليه بالبصيرة أهل الله الواصلون، فحملهم على خوف الصانع وخشيته، وأجاءهم إلى رغبة الرحمن ورهبته، فارتقوا بطول النظر تأملا وتدبرا في الكونين: المسطور والمنظور إلى مقامي الخوف والرجاء وهما «جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود: فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزمة الرجاء. ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا سياط التخويف وسطوات التعنيف»([4])
وهما معا من أوائل مقامات السالكين، وأحوال الطالبين، ومطية الواصلين، وبه نفهم قول العارفين في الخوف والرجاء، قال الواسطي: «الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد»، وقال أيضا: «إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها فضلة لرجاء ولا لخوف»؛ لأن غاية أهل الشأن الفناء بالشهود في المشهود تحببا واشتياقا لا خوفا أو رجاء، فحالهم بكليته، وأمرهم برمته فناء في المحبوب تذللا وخضوعا، محبة له ونزوعا، وما الخوف إلا بداية الترقي، وما الرجاء إلا رياضة للتدني؛ حتى إذا أنست الحال بالله، وملك المحبوب الحشاشة، وفنيت في الجمال عن الجلال لم يبق التفات إلى ما كان سلما للزلفى، وسببا للقربى، فلم يكن خوف ولا رجاء؛ بل صارت الحال أسمى، والمقام أسنى..([5])؛ إذ هما زمامان فحسب، يمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناتها؛ كيما تترقى إلى غايتها، وتلك سبيل السائرين، وما هي بمهيع الواصلين؛ ولذلك قال سبحانه في شأن أهل الجنة: ﴿ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ فزال الخوف بزوال المخوف؛ إذ كان وسيلة لا غاية، وسبيلا لا مقصدا، وعلاقته بالأفعال لا بالذات والصفات، والمحبة بخلافه: غاية دائبة، متينة الصلة بالذات والصفات، فلا جرم أنها أعلى مأم العارفين، وأرفع غاية الواصلين([6])
وموجب الخوف ـ كما قال أبو القاسم ـ معرفة وعلم وغايته مجاهدة وعمل
فأما العلم فأسماه المعرفة بالله وقدره، والوقوف بالتأمل عند عظيم سلطانه وقهره، وإلى ذلك الإلماعة بقوله: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبخالقه؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ﴿أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه﴾([7]) قال وهب بن منبه: «ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل» وأرذله ما كان التفاتا إلى المعاصي والذنوب، وتشوفا إلى الأدران والعيوب؛ خوفا من عقابه، ورهبة من عذابه؛ على أنه سبيل الأوبة، ومهيع التوبة، وهو اللائق بالعامة كما ذكر أبو القاسم في درته، قال صاحب المنازل: «الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان، وهو خوف العامة، وهو يتولد من تصديق الوعيد، وذكر الجناية، ومراقبة العاقبة»([8]).
وأما العمل فكف الجوارح عن المعاصي والسيئات، وتقييدها بجميل الطاعات، وقمع النفس عن الشهوات، وتقييدها بالورع عن المتشابهات، قال بشر رحمه الله: «لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل» فمن عرف الله حق معرفته، وقدره حق قدره ما تجرأ على معصيته، ولا تطاول على مخالفة أمره وشريعته، بل حقه أن تحترق شهواته بالخوف، وتتأدب جوارحه بالرهبة؛ ويمتلئ قلبه ذلة وخشوعا، واستكانة وخضوعا؛ حتى يصير مستوعب الهم بخوفه، والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة، والضنة بالأنفاس واللحظات مؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات([9])، وذلك مقام الخاصة كما أومأ أبو القاسم رحمه الله؛ وفي منازل السائرين: « وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الإجلال وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة، وتصون المشاهد أحيان المسامرة، وتقصم المعاين بصدمة العزة»([10])؛ ولهذه الدقيقة مايز بعضهم بين الخوف والخشية، والرهبة والهيبة، والوجل والإجلال، فالأول لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والوجل للصديقين، والإجلال للمقربين([11]): قال سهل رحمه الله: «خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة، وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال: ﴿وقلوبهم وجلة﴾([12]) وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله: ﴿والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة﴾ [المؤمنون: 60] أهو الذي يزني، ويشرب الخمر، ويسرق؟ قال: ﴿لا، يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق، ويخاف أن لا يقبل منه﴾ قال الحسن: «عملوا والله بالطاعات، واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا»([13])، فأهل المعرفة بالله في دائب مكابدة، ولازب مجاهدة، أفنوا الحشاشة في الحق للحق: فهم في سكرة ولها، وانقباض رهبا، وانبساط رغبا، حارت فيهم أنفسهم؛ إذ أرهقوها بالنقيض: أنسا ووحشة، حضورا وفناء؛ فلا جرم أن كانوا محلا لقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿الدنيا سجن المؤمن فإذا فارق الدنيا فارق السجن﴾([14])؛ ولهذا قال الإمام الجنيد رحمه الله: «الخوف من الله يقبضني، والرجاء منه يبسطني، والحقيقة تجمعني، والحق يفرقني: إذا قبضني بالخوف أفناني عني، وإذا بسطني بالرجاء ردني علي، وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني، وإذا فرقني بالحق أشهدني غيرى فغطاني عنه. فهو تعالى في ذلك كله محركي غير ممسكي، وموحشي غير مؤنسي، فأنا بحضوري أذوق طعم وجودي، فليته أفناني عني فمتعني، أو غيبني عني فروحني»([15])
فهذه حال القوم ـ كما ترى ـ محبة واشتياقا، خوفا ورجاء، شهودا وفناء، فلله درهم، ما أصبرهم على المكابدة، وأجلدهم على المجاهدة
أولئك آبائي فجئني بمثلهم** إذا جمعتنا يا جرير المجامع([16])
فإلى درة أبي القاسم رحمه الله قال: ﴿وادعوه خوفا وطمعا﴾ جمع الله الخوف والطمع؛ ليكون العبد خائفا راجيا، كما قال الله تعالى: ﴿يرجون رحمته ويخافون عذابه﴾ [الإسراء: 57] فإن موجب الخوف معرفة سطوة الله وشدة عقابه، وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه، قال تعالى: ﴿نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم﴾ [الحجر: 49- 50] ومن عرف فضل الله رجاه، ومن عرف عذابه خافه، ولذلك جاء في الحديث: ﴿لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا﴾([17]) إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف؛ ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات، وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى﴾([18])
واعلم أن الخوف على ثلاث درجات:
الأولى: أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم.
والثانية: أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة.
والثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها.
والناس في الخوف على ثلاث مقامات:
فخوف العامة من الذنوب. وخوف الخاصة من الخاتمة. وخوف خاصة الخاصة من السابقة. فإن الخاتمة مبنية عليها...
ن التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم الغرناطي:2/604..
([1]) صحيح مسلم: ح2685.
([2]) الأسماء والصفات للبيهقي:2149.
([3]) ن مفاتيح الغيب للرازي:27/473
([4]) ن إحياء علوم الدين للغزالي: 4/142
([5]) ن إحياء علوم الدين:4/155.
([6]) ن المدارج:1/510.
([7]) ن مختصر المقاصد للزرقاني: 165، وكذا طبقات الشافعية لابن السبكي: 6/365.
([8]) ن منازل السائرين:26.
([9]) ن نفسه
([10]) منازل السائرين: 27.
([11]) ن المدارج:1/508.
([12]) ن الإحياء: 4/172.
([13]) ن المدارج:1/507.
([14]) أخرجه الإمام أحمد وغيره: ح 6855
([15]) ن الرسالة القشيرية:1/158
([16]) البيت للفرزدق. ن شرح نقائض جرير والفرزق لأبي عبيدة معمر بن المثنى:3/824
([17]) لا يصح مرفوعا. ن المقاصد الحسنة للسخاوي:412.
([18]) صحيح مسلم: ح 2877.