
د. جمال بامي
مدير وحدة العلم والعمران بالمغرب
قال سيدي عبد الله كنون في كتابه "ابن بطوطة" (منشورات إيسيسكو، 1996): "هو الرحالة العالمي الشهير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يوسف اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة.. ولواتة التي ينتسب إليها هي بفتح اللام، قبيلة مغربية منازلها الأصلية ببرقة من أرض طرابلس...
كانت ولادته بطنجة يوم الاثنين 17 رجب عام 703هـ، وعصر ولادته كما لا يخفى عصر ازدهار العلم والثقافة على عهد بني مرين، فمن الطبيعي أن ينشأ رحالتنا، وهو سليل أسرة علمية، على حب العلم والإطلاع...
كانت أسرة ابن بطوطة أسرة علم وصلاح، وقد ظهر فيها القضاة ومشايخ العلم كما أخبر بذلك في رحلته لما خيره ملك الهند في وظائف الوزارة والكتابة والإمارة والتدريس، فقال –رحمه الله-: "أما الوزارة والكتابة فليست شغلي، وأما القضاء والمشيخة فشغلي وشغل آبائي"..
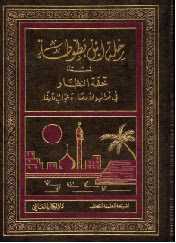 وفي قراءة عميقة لبعض فقرات من الرحلة، يستخلص العلامة عبد الله كنون في كتابه (ص: 10) أن ابن بطوطة كان ذا ثقافة لغوية وفقهية لا يستهان بها، إذ أنه لما كان بالبصرة وشهد صلاة الجمعة فيها بمسجد علي، لاحظ أن الخطيب يلحن لحنا كثيرا جليا، وعجب من ذلك وذكره للقاضي، فقال القاضي له: "إن هذا البلد لم يبق به من يعرف شيئا من علم النحو"، وتأسف ابن بطوطة معلقا: "وهذه عبرة لمن تفكر فيها، سبحانه مغير الأشياء ومقلب الأمور.. هذه البصرة التي إلى أهلها انتهت رئاسة النحو، وفيها أصله وفرعه، ومن أهلها إمامه الذي لا ينكر سبقه، لا يقيم خطيبها خطبة الجمعة على دؤوبه عليها".
وعلى الرغم من أن ابن بطوطة لم يسم علماء بعينهم أخذ عنهم بطنجة إلا أن بدأه الرحلة وهو في سن اثنين وعشرين سنة ليكون فيما بعد من أمره ما كان، يدل على أنه التقى بعلماء كثر في بلده طنجة، وأخذ عنهم خصوصا منهم أقاربه الذي اشتهروا بالعلم والأدب وولاية القضاء.
كان من عادة ابن بطوطة أنه كلما سمع برجل من الصالحين إلا وشد الرحلة إليه لزيارته، محققا هدفين رئيسين في الآن نفسه؛ التجوال واكتشاف الأمكنة والبقاع، وملاقاة الصلحاء والأخيار أخذا وتبركا واقتداء.. واشتهر صاحبنا ابن بطوطة بسرعة كبيرة على التأقلم مع البلدان التي يحل فيها، فينسجم مع أهلها وعاداتهم وطرائق عيشهم، وهو ما يمكن أن نعتبره -مع شيء من التحفظ في الاستعمال التقني للمصطلح- وعيا أنثربولوجيا مبكرا ساهم لا محالة في دقة المعلومات الواردة في الرحلة ومعقوليتها.
إن معلومات ابن بطوطة عن الكثير من المقاطعات الإفريقية المجهولة، وعن نهر النيجر، وعن بلاد الزنج (زنجبار) لا تقل فائدة عن معلومات الحسن بن الوزان المشهور بليون الإفريقي في كتابه "وصف إفريقيا"، أما جغرافية بلاد العرب، وبخارى وكابل، وقندهار؛ فإنها استفادت كثيرا من رحلة ابن بطوطة، حتى معلوماته عن الهند وسيلان والصين وسومطرة؛ فإنها غاية في الأهمية وتمتاز بأصالة ودقة كبيرين.
نحن إذن إزاء رحالة عالمي، عالمي بموسوعية رحلته وبسعة إطلاعه وبغزارة معلوماته ودقتها، لكن أيضا عالمي بهمته العالية وافتخاره ببلده وإفادته للإنسانية، وهذا درس ما أحوجنا إليه اليوم، بمعنى أننا نحتاج إلى علماء ورحالة وباحثين مغرمين بالوطن وأقوياء في أدائهم العلمي ونافعين للإنسانية، وهذا مدخل نبيل لاستعادة ألق الحضارة الإسلامية وازدهارها وتأثيرها في العالم..
قال المؤرخ الدكتور محمد عبد الله عنان في مقال حول "أدب الرواد المسلمين" (مجلة الرسالة، عدد 56، القاهرة، 1934) عن ابن بطوطة: "على أن أعظم الرواد المسلمين على الإطلاق هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي الشهير بابن بطوطة، ولم يكن ابن بطوطة رحالة عظيما فقط يجوب أنحاء العالم المعروف يومئذ، بل كان مكتشفا عظيما يقصد إلى مجاهل البر والبحر، وكتابه "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، وهو المعروف برحلة ابن بطوطة، أجمل وأنفس أثر عربي في هذا النوع من الأدب.."..
يقول العلامة عبد الله كنون في كتابه عن ابن بطوطة (ص: 14-15): "خرج ابن بطوطة من طنجة مسقط رأسه في سنة 725هـ (1325م) يجوب أقطار العالم، واخترق بلاد المغرب ومصر والشام وبلاد العرب وبلاد الروم وقسطنطينية، وفارس وخراسان وتركستان والهند وسيلان والصين وجزائر الهند الشرقية، واخترق في عوده قلب إفريقية من السودان إلى بلاد النيجر، ووقف على كثير من مجاهل بعض الأقطار والأمم التي لم تكن معروفة يومئذ تمام المعرفة، ووصل إلى أعالي نهر النيجر، وإلى تِمبوكْتو وسُكوتُو قبل أن يصل إليها الرواد الأوربيون ويكتشفها الرحالة الإنجليزي ننجو بارك بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون، وسلخ في رحلاته نحو ربع قرن، وترك لنا عن أسفاره واكتشافاته ومشاهداته، ذلك الأثر الذي يعتبر بحق من أبدع آثار السياحة والاكتشاف"..
لاشك أن رحلة بن بطوطة مملوءة فوائد وأخبار وآثار في ميدان الجغرافيا والتاريخ والآثار والعوائد الإنسانية واختلاف "الأهواء والملل والنحل"، لكننا سنقتصر على الوقوف عند بعض فقراتها وأخبارها إبرازا لقيمتها العلمية وقصديتها، وإلا فمعظمها إفادات وإجادات..
يفيدنا ابن بطوطة بأخبار طريفة في رحلته؛ من ذلك ما لاحظه بمدينة دمياط من أنه "إذا دخلها أحد لم يكن من سبيل إلى الخروج منها إلا بطابع الولي، فمن كان من الناس معتبرا طبع له في قطعة كَاغَد يستظهر به لحراس بابها، وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظهر به". يعلق العلامة عبد الله كنون على هذا الخبر بقول لا يخلو من دعابة على عادة هذا العالم الجليل (ص: 18 من كتابه): "وهذا الإجراء الذي كان يوحي به -ولا شك- موقع المدينة الحربي، يشبه ما نسميه اليوم بالجواز؛ ولم يقل صاحبنا ما كان حضه بالنسبة إلى هذا الإجراء؛ هل الطبع في الكاغد أو على ذراعه فكان من أصحاب الأذرع الممدودة للكشف عنها عند الخروج..".
لما وصل ابن بطوطة إلى مصر بهرته بعظمتها ومعالمها، فوصفها وصفا دقيقا، وكان سلطانها يومئذ محمد الناصر بن السلطان قلاوون، وقد أثنى عليه رحالتنا واستحسن الزاوية التي عمرها هذا السلطان خارج القاهرة، لكنه فضل عليها الزاوية التي أنشأها أبو عنان المريني خارج فاس الجديد. ثم عرج ابن بطوطة على ذكر بعض علماء مصر وقال أن أعلاهم منزلة القاضي الشافعي بدر الدين بن جماعة، وذكر أيضا النحوي الأندلسي الشهير أبو حيان. وفي قوص عاصمة إقليم الصعيد رأى العالم الصوفي الشهير فتح الدين بن دقيق العيد، وكان هو الخطيب بها.
وفي 9 رمضان 726هـ وصل ابن بطوطة إلى دمشق، فنزل بها بمدرسة المالكية التي تعرف بالشرابشية، ووصف دمشق بقول : "ودمشق هي التي تفضل جميع بلاد الدنيا حسنا وتتقدمها جمالا، وكل وصف وإن طال فهو قاصر عن محاسنها".
وقد تحدث ابن بطوطة عن مرافق المدينة وعمرانها؛ تحدث عن المدارس والمعاهد والمزارات، وعن الأوقاف الخيرية التي أوقفها أهل دمشق على السابلة والمحتاجين وتجهيز البنات الفقيرات إلى أزواجهن وإعانة العاجزين عن الحج، وإصلاح الطرق، وذكر أن لطرق دمشق رصيفين في جنبيهما يمر عليها المترجلون ويمر الركبان في وسطها. ومن أطرف ما أورده ابن بطوطة حول دمشق مسألة تتعلق بالوقف، قال: "مررت يوما ببعض أزقة دمشق فرأيت مملوكا صغيرا قد سقطت من يده صفحة من الفخار الصيني وهم يسمونها الصحن، فتكسرت، واجتمع عليه الناس، فقال له بعضهم: اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني، فجمعها وذهب الرجل معه فأراه إياها، فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن. وهذا من أحسن الأعمال؛ فإن سيد الغلام لابد له أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره، وهو أيضا ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك، فكان هذا الوقف جبرا للقلوب، جزى الله خيرا من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا"..
وقد أفادنا ابن بطوطة إفادات بالغة الأهمية حول بعض المنشآت الحضارية المتقدمة التي عاينها في الطريق بين الحجاز والعراق عبر نجد. فقد تحدث عن مصانع الماء في الصحراء القاحلة وسير الركب ليلا، وقد أوقدت المشاعل أمام القطار (يقصد به صفوف الجمال المتتالية) والمحارات، فترى الأرض تتلألأ نورا، والليل قد عاد نهارا ساطعا"...
خمسة وعشرون سنة إذن من يوم الخميس 2 رجب سنة 725هـ إلى يوم الجمعة من أواخر شعبان سنة 750هـ، وهي الرحلة الأولى والرئيسة، شاهد فيها ابن بطوطة الجزائر، وتونس، وطرابلس، ومصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، وفلسطين، والحجاز، وتركيا وما جاورها من البلدان والهند، والصين، وجزر إندونيسيا كجاوة وسومطرة.
يقول الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (مطبعة النجاح الجديدة، 1992، ص: 184): عن صاحبنا ابن بطوطة: "خرج فريدا ولكنه لم يغادر مسقط رأسه حتى استطاع أن يربط العلاقات بينه وبين الناس نظرا لقوة شخصيته، وحدة ذكائه، وسعة ثقافته الإسلامية، وسماحة أخلاقه، فأصبح بينهم مرموقا يقدمونه في صلواتهم ويحكمونه في قضاياهم....
لم تكن سنه عند مغادرة طنجة تتجاوز الثانية والعشرين فهو في مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب، ولكنه لم يركن إلى اللهو والعبث، ولم يستأثر الدعة والخمول، بل هاجه الشوق إلى السفر لتحقيق رغبة في نفسه تدعوه لمشاهدة الأراضي المقدسة، قال: "فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والديّ بقيد الحياة، فتحملت لبعدهما وصبا، ولقيت كما لقيا من الفراق نصبا". كان سلطان المغرب، عند مغادرة ابن بطوطة مدينة طنجة، هو أبو سعيد عثمان، ولما رجع من رحلته وجد السلطان أبا عنان بن أبي الحسن المريني حاكما، وكان من بين وزراء هذا الأخير أبو زيان بن وِدرار الذي استأنس بابن بطوطة وتأثر بأخباره وعلو همته، فدافع عنه في مجالس العلم ومجالس الدولة لمّا شاع بين الناس أن ابن بطوطة يتزيد في الأخبار ويتقول مالا وجود له. وكان العلامة ابن خلدون قد أشار في مقدمته إلى هذه القضية، ودافع باستماتة على رحالتنا عندما قال في المقدمة (تحقيق علي عبد الواحد وافي (الجزء الثاني، ص: 565): "فتناجى الناس بتكذيبه، ولقيت أنا يومئذ وزير السلطان فارس بن وِدرار البعيد الصيت، ففاوضته في هذا الشأن وأريته إنكار أخبار هذا الرجل، لما استفاض في الناس من تكذيبه، فقال لي الوزير فارس: "إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره فتكون كابن الوزير الناشئ في السجن، وذلك أن وزيرا اعتقله سلطانه فمكث في السجن سنين ربى فيها ابنه في ذلك المحبس، فلما أدرك وعقل سأل عن الُّلحمان التي كان يتغذى بها، فإذا قال له أبوه هذا لحم الغنم، يقول وما الغنم؟ فيصفها لها أبوه بشياتها ونعوتها، فيقول يا أبت: تراها مثل الفأر؟ فينكر عليه ويقول أين الغنم من الفأر، وكذا في لحم البقر والإبل، إذ لم يعاين في محبسه إلا الفأر، فيحسبها كلها أبناء جنس الفأر، وهذا كثيرا ما يعتري الناس في الأخبار، كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد الإغراب.. فليرجع الإنسان إلى أصوله، وليكن مهيمنا على نفسه، ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته، فما دخل في الإمكان قبله، وما خرج عنه رفضه، وليس مرادنا الإمعان العقلي المطلق؛ فإن نطاقه أوسع شيء، فلا يفرض حدا بين الواقعات، وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء، فإذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته، أجرينا الحكم في نسبه ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه، "وقل رب زدني علما".
الشاهد عندنا أنه لما أصبح ابن بطوطة يذيع مشاهداته وما عاينه في رحلته أمر السلطان أبو عنان المريني كاتبه الأديب الكبير محمد ابن جزي بأن يضم أطراف ما يمليه هذا الرحالة في كتاب يكون جامعا لفوائده مكملا لمقاصده مع العمل على تنقيح الكلام وتهذيب معانيه. قال ابن جزي: "ونقلت كلام الشيخ أبي عبد الله (ابن بطوطة) بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها موضحة للمناحي التي اعتمدها، وربما أوردت لفظه على وضعه فلم أخل بأصله ولا فرعه، وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخبار ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار، على أنه سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك. وخرج عن عهدة سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلك، وقيدت المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط ليكون أنفع في التصحيح والضبط، وشرحت ما أمكنني شرحه من الأسماء العجمية لأنها تلتبس بعجمتها على الناس، ويخطئ في فك معماها معهود القياس"..
لكن الجانب السياسي كان حاضرا بقوة في اختيار ابن جزي لصياغة رحلة ابن بطوطة؛ فهذا الجانب السياسي يرتبط حسب الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ في كتابه سابق الذكر (ص: 186): "بالغاية التي كان يتوخاها أبو عنان من نشر الرحلة؛ فإنه كان يريد أن يستغلها للدعاية له ولأعماله، وأن يجعلها وسيلة للمس بأعدائه والكشف عن مساوئهم، بحيث لا يقتصر ابن بطوطة على نشر الأخبار مجردة بل يضيف إليها في كل مناسبة ما يرفع به شأن بني مرين على العموم. وإذا كان ابن بطوطة قد يوفق في هذا العمل بالنسبة إلى مرئياته العامة فهو ليس له إلمام كبير بكثير من الأحداث التاريخية التي وقعت بالمغرب أيام غيبته الطويلة، لذلك كان من الضروري أن يضاف إليه شخص آخر تكون له دراية بالوقائع الحديثة ومعرفة بأحوال الدولة القائمة (..) ولم يجد أبو عنان من بين كتابه من تجتمع فيه هذه الصفات مثل أبي عبد الله بن جزي، لذلك أمره بجمع ما يمليه ابن بطوطة في كتاب يكون جامعا لفوائده مكملا لمقاصده". ويمكن أن نضيف إلى الجانب السياسي في تكليف ابن جزي بالصياغة الأدبية لرحلة ابن بطوطة جانبا أدبيا؛ إذ أن صاحبنا ابن بطوطة رغم ولعه بالعلم فقها وحديثا وتاريخا وتصوفا، ورغم روايته عن العديد من أساطين العلم في كل البلاد الإسلامية التي زارها، ورغم توليه القضاء بالمغرب وتونس والهند، إلا أنه لم يكن أديبا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، يشهد على ذلك شعره المتوسط الذي بثه في ثنايا الرحلة؛ وبما أن كتابة الرحلة جاءت في إطار مشروع سلطاني فإن اختيار رجل من طينة ابن جزي لأداء المهمة يعود إلى أدبه العالي وتمرسه في فن الكتابة..
إن الحديث عن ابن بطوطة ذو شجون، لكنا نكتفي في خاتمة هذه المقالة في الإلماح إلى بعض القضايا الشائكة التي احتوتها الرحلة، من ذلك ما رواه رحالتنا عن شيخ الإسلام بن تيمية الذي جاء في الرحلة ابن بطوطة رآه في المسجد بدمشق ينزل من المنبر ويشبه نزوله باستواء الرحمن على العرش، وهو ما جعل بعضهم يصف شيخ الإسلام بالتجسيم.. وأريد هنا أن أحيل القارئ الكريم إلى ما كتبه العلامة عبد جنون في كتابه "في اللغة والأدب" (سلسلة شراع العدد 8، 1996) حول هذه المسألة مبرزا ملابساتها ومبرأً ساحة شيخ الإسلام وكاتب الرحلة معا..
وأريد أن أشير كذلك إلى كتاب قيم تناول رحلة ابن بطوطة بشكل جديد ومبدع، وهو كتاب "إيران بين الأمس واليوم" قراءة جديدة لرحلة ابن بطوطة للدكتور عبد الهادي التازي (منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، 1984) ففيه الكثير من الإفادات والاكتشافات.
وبعد، فهذه بعض جوانب من شخصية هذا الرحالة الرائع الذي رفع رأس المغرب عاليا؛ توفي رحمه الله حسبما أورده الخطيب ابن مرزوق –معاصره- سنة 777هـ، وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن وفاته كانت سنة 779هـ.
أما عن قبر ابن بطوطة، فيوجد بطنجة قبر ينسب إليه على الرغم من أنه لم يتوف بها، لكن العلامة جنون يشكك في نسبة هذا القبر إلى ابن بطوطة؛ لأن صاحب هذا الضريح على ألسنة العامة هو أحمد بن علال وليس ابن بطوطة. يقول عبد الله كنون في كتابه عن ابن بطوطة (ص: 34): "وعلى كل حال فهو، وإن يكن ذا صفة رمزية، ضريح متواضع جدا لا يتناسب وعظمة الرجل الذي طبقت سمعته الآفاق". رحم الله ابن بطوطة وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
وفي قراءة عميقة لبعض فقرات من الرحلة، يستخلص العلامة عبد الله كنون في كتابه (ص: 10) أن ابن بطوطة كان ذا ثقافة لغوية وفقهية لا يستهان بها، إذ أنه لما كان بالبصرة وشهد صلاة الجمعة فيها بمسجد علي، لاحظ أن الخطيب يلحن لحنا كثيرا جليا، وعجب من ذلك وذكره للقاضي، فقال القاضي له: "إن هذا البلد لم يبق به من يعرف شيئا من علم النحو"، وتأسف ابن بطوطة معلقا: "وهذه عبرة لمن تفكر فيها، سبحانه مغير الأشياء ومقلب الأمور.. هذه البصرة التي إلى أهلها انتهت رئاسة النحو، وفيها أصله وفرعه، ومن أهلها إمامه الذي لا ينكر سبقه، لا يقيم خطيبها خطبة الجمعة على دؤوبه عليها".
وعلى الرغم من أن ابن بطوطة لم يسم علماء بعينهم أخذ عنهم بطنجة إلا أن بدأه الرحلة وهو في سن اثنين وعشرين سنة ليكون فيما بعد من أمره ما كان، يدل على أنه التقى بعلماء كثر في بلده طنجة، وأخذ عنهم خصوصا منهم أقاربه الذي اشتهروا بالعلم والأدب وولاية القضاء.
كان من عادة ابن بطوطة أنه كلما سمع برجل من الصالحين إلا وشد الرحلة إليه لزيارته، محققا هدفين رئيسين في الآن نفسه؛ التجوال واكتشاف الأمكنة والبقاع، وملاقاة الصلحاء والأخيار أخذا وتبركا واقتداء.. واشتهر صاحبنا ابن بطوطة بسرعة كبيرة على التأقلم مع البلدان التي يحل فيها، فينسجم مع أهلها وعاداتهم وطرائق عيشهم، وهو ما يمكن أن نعتبره -مع شيء من التحفظ في الاستعمال التقني للمصطلح- وعيا أنثربولوجيا مبكرا ساهم لا محالة في دقة المعلومات الواردة في الرحلة ومعقوليتها.
إن معلومات ابن بطوطة عن الكثير من المقاطعات الإفريقية المجهولة، وعن نهر النيجر، وعن بلاد الزنج (زنجبار) لا تقل فائدة عن معلومات الحسن بن الوزان المشهور بليون الإفريقي في كتابه "وصف إفريقيا"، أما جغرافية بلاد العرب، وبخارى وكابل، وقندهار؛ فإنها استفادت كثيرا من رحلة ابن بطوطة، حتى معلوماته عن الهند وسيلان والصين وسومطرة؛ فإنها غاية في الأهمية وتمتاز بأصالة ودقة كبيرين.
نحن إذن إزاء رحالة عالمي، عالمي بموسوعية رحلته وبسعة إطلاعه وبغزارة معلوماته ودقتها، لكن أيضا عالمي بهمته العالية وافتخاره ببلده وإفادته للإنسانية، وهذا درس ما أحوجنا إليه اليوم، بمعنى أننا نحتاج إلى علماء ورحالة وباحثين مغرمين بالوطن وأقوياء في أدائهم العلمي ونافعين للإنسانية، وهذا مدخل نبيل لاستعادة ألق الحضارة الإسلامية وازدهارها وتأثيرها في العالم..
قال المؤرخ الدكتور محمد عبد الله عنان في مقال حول "أدب الرواد المسلمين" (مجلة الرسالة، عدد 56، القاهرة، 1934) عن ابن بطوطة: "على أن أعظم الرواد المسلمين على الإطلاق هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي الشهير بابن بطوطة، ولم يكن ابن بطوطة رحالة عظيما فقط يجوب أنحاء العالم المعروف يومئذ، بل كان مكتشفا عظيما يقصد إلى مجاهل البر والبحر، وكتابه "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، وهو المعروف برحلة ابن بطوطة، أجمل وأنفس أثر عربي في هذا النوع من الأدب.."..
يقول العلامة عبد الله كنون في كتابه عن ابن بطوطة (ص: 14-15): "خرج ابن بطوطة من طنجة مسقط رأسه في سنة 725هـ (1325م) يجوب أقطار العالم، واخترق بلاد المغرب ومصر والشام وبلاد العرب وبلاد الروم وقسطنطينية، وفارس وخراسان وتركستان والهند وسيلان والصين وجزائر الهند الشرقية، واخترق في عوده قلب إفريقية من السودان إلى بلاد النيجر، ووقف على كثير من مجاهل بعض الأقطار والأمم التي لم تكن معروفة يومئذ تمام المعرفة، ووصل إلى أعالي نهر النيجر، وإلى تِمبوكْتو وسُكوتُو قبل أن يصل إليها الرواد الأوربيون ويكتشفها الرحالة الإنجليزي ننجو بارك بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون، وسلخ في رحلاته نحو ربع قرن، وترك لنا عن أسفاره واكتشافاته ومشاهداته، ذلك الأثر الذي يعتبر بحق من أبدع آثار السياحة والاكتشاف"..
لاشك أن رحلة بن بطوطة مملوءة فوائد وأخبار وآثار في ميدان الجغرافيا والتاريخ والآثار والعوائد الإنسانية واختلاف "الأهواء والملل والنحل"، لكننا سنقتصر على الوقوف عند بعض فقراتها وأخبارها إبرازا لقيمتها العلمية وقصديتها، وإلا فمعظمها إفادات وإجادات..
يفيدنا ابن بطوطة بأخبار طريفة في رحلته؛ من ذلك ما لاحظه بمدينة دمياط من أنه "إذا دخلها أحد لم يكن من سبيل إلى الخروج منها إلا بطابع الولي، فمن كان من الناس معتبرا طبع له في قطعة كَاغَد يستظهر به لحراس بابها، وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظهر به". يعلق العلامة عبد الله كنون على هذا الخبر بقول لا يخلو من دعابة على عادة هذا العالم الجليل (ص: 18 من كتابه): "وهذا الإجراء الذي كان يوحي به -ولا شك- موقع المدينة الحربي، يشبه ما نسميه اليوم بالجواز؛ ولم يقل صاحبنا ما كان حضه بالنسبة إلى هذا الإجراء؛ هل الطبع في الكاغد أو على ذراعه فكان من أصحاب الأذرع الممدودة للكشف عنها عند الخروج..".
لما وصل ابن بطوطة إلى مصر بهرته بعظمتها ومعالمها، فوصفها وصفا دقيقا، وكان سلطانها يومئذ محمد الناصر بن السلطان قلاوون، وقد أثنى عليه رحالتنا واستحسن الزاوية التي عمرها هذا السلطان خارج القاهرة، لكنه فضل عليها الزاوية التي أنشأها أبو عنان المريني خارج فاس الجديد. ثم عرج ابن بطوطة على ذكر بعض علماء مصر وقال أن أعلاهم منزلة القاضي الشافعي بدر الدين بن جماعة، وذكر أيضا النحوي الأندلسي الشهير أبو حيان. وفي قوص عاصمة إقليم الصعيد رأى العالم الصوفي الشهير فتح الدين بن دقيق العيد، وكان هو الخطيب بها.
وفي 9 رمضان 726هـ وصل ابن بطوطة إلى دمشق، فنزل بها بمدرسة المالكية التي تعرف بالشرابشية، ووصف دمشق بقول : "ودمشق هي التي تفضل جميع بلاد الدنيا حسنا وتتقدمها جمالا، وكل وصف وإن طال فهو قاصر عن محاسنها".
وقد تحدث ابن بطوطة عن مرافق المدينة وعمرانها؛ تحدث عن المدارس والمعاهد والمزارات، وعن الأوقاف الخيرية التي أوقفها أهل دمشق على السابلة والمحتاجين وتجهيز البنات الفقيرات إلى أزواجهن وإعانة العاجزين عن الحج، وإصلاح الطرق، وذكر أن لطرق دمشق رصيفين في جنبيهما يمر عليها المترجلون ويمر الركبان في وسطها. ومن أطرف ما أورده ابن بطوطة حول دمشق مسألة تتعلق بالوقف، قال: "مررت يوما ببعض أزقة دمشق فرأيت مملوكا صغيرا قد سقطت من يده صفحة من الفخار الصيني وهم يسمونها الصحن، فتكسرت، واجتمع عليه الناس، فقال له بعضهم: اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني، فجمعها وذهب الرجل معه فأراه إياها، فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن. وهذا من أحسن الأعمال؛ فإن سيد الغلام لابد له أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره، وهو أيضا ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك، فكان هذا الوقف جبرا للقلوب، جزى الله خيرا من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا"..
وقد أفادنا ابن بطوطة إفادات بالغة الأهمية حول بعض المنشآت الحضارية المتقدمة التي عاينها في الطريق بين الحجاز والعراق عبر نجد. فقد تحدث عن مصانع الماء في الصحراء القاحلة وسير الركب ليلا، وقد أوقدت المشاعل أمام القطار (يقصد به صفوف الجمال المتتالية) والمحارات، فترى الأرض تتلألأ نورا، والليل قد عاد نهارا ساطعا"...
خمسة وعشرون سنة إذن من يوم الخميس 2 رجب سنة 725هـ إلى يوم الجمعة من أواخر شعبان سنة 750هـ، وهي الرحلة الأولى والرئيسة، شاهد فيها ابن بطوطة الجزائر، وتونس، وطرابلس، ومصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، وفلسطين، والحجاز، وتركيا وما جاورها من البلدان والهند، والصين، وجزر إندونيسيا كجاوة وسومطرة.
يقول الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني" (مطبعة النجاح الجديدة، 1992، ص: 184): عن صاحبنا ابن بطوطة: "خرج فريدا ولكنه لم يغادر مسقط رأسه حتى استطاع أن يربط العلاقات بينه وبين الناس نظرا لقوة شخصيته، وحدة ذكائه، وسعة ثقافته الإسلامية، وسماحة أخلاقه، فأصبح بينهم مرموقا يقدمونه في صلواتهم ويحكمونه في قضاياهم....
لم تكن سنه عند مغادرة طنجة تتجاوز الثانية والعشرين فهو في مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب، ولكنه لم يركن إلى اللهو والعبث، ولم يستأثر الدعة والخمول، بل هاجه الشوق إلى السفر لتحقيق رغبة في نفسه تدعوه لمشاهدة الأراضي المقدسة، قال: "فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والديّ بقيد الحياة، فتحملت لبعدهما وصبا، ولقيت كما لقيا من الفراق نصبا". كان سلطان المغرب، عند مغادرة ابن بطوطة مدينة طنجة، هو أبو سعيد عثمان، ولما رجع من رحلته وجد السلطان أبا عنان بن أبي الحسن المريني حاكما، وكان من بين وزراء هذا الأخير أبو زيان بن وِدرار الذي استأنس بابن بطوطة وتأثر بأخباره وعلو همته، فدافع عنه في مجالس العلم ومجالس الدولة لمّا شاع بين الناس أن ابن بطوطة يتزيد في الأخبار ويتقول مالا وجود له. وكان العلامة ابن خلدون قد أشار في مقدمته إلى هذه القضية، ودافع باستماتة على رحالتنا عندما قال في المقدمة (تحقيق علي عبد الواحد وافي (الجزء الثاني، ص: 565): "فتناجى الناس بتكذيبه، ولقيت أنا يومئذ وزير السلطان فارس بن وِدرار البعيد الصيت، ففاوضته في هذا الشأن وأريته إنكار أخبار هذا الرجل، لما استفاض في الناس من تكذيبه، فقال لي الوزير فارس: "إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره فتكون كابن الوزير الناشئ في السجن، وذلك أن وزيرا اعتقله سلطانه فمكث في السجن سنين ربى فيها ابنه في ذلك المحبس، فلما أدرك وعقل سأل عن الُّلحمان التي كان يتغذى بها، فإذا قال له أبوه هذا لحم الغنم، يقول وما الغنم؟ فيصفها لها أبوه بشياتها ونعوتها، فيقول يا أبت: تراها مثل الفأر؟ فينكر عليه ويقول أين الغنم من الفأر، وكذا في لحم البقر والإبل، إذ لم يعاين في محبسه إلا الفأر، فيحسبها كلها أبناء جنس الفأر، وهذا كثيرا ما يعتري الناس في الأخبار، كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد الإغراب.. فليرجع الإنسان إلى أصوله، وليكن مهيمنا على نفسه، ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته، فما دخل في الإمكان قبله، وما خرج عنه رفضه، وليس مرادنا الإمعان العقلي المطلق؛ فإن نطاقه أوسع شيء، فلا يفرض حدا بين الواقعات، وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء، فإذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته، أجرينا الحكم في نسبه ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه، "وقل رب زدني علما".
الشاهد عندنا أنه لما أصبح ابن بطوطة يذيع مشاهداته وما عاينه في رحلته أمر السلطان أبو عنان المريني كاتبه الأديب الكبير محمد ابن جزي بأن يضم أطراف ما يمليه هذا الرحالة في كتاب يكون جامعا لفوائده مكملا لمقاصده مع العمل على تنقيح الكلام وتهذيب معانيه. قال ابن جزي: "ونقلت كلام الشيخ أبي عبد الله (ابن بطوطة) بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها موضحة للمناحي التي اعتمدها، وربما أوردت لفظه على وضعه فلم أخل بأصله ولا فرعه، وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخبار ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار، على أنه سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك. وخرج عن عهدة سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلك، وقيدت المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط ليكون أنفع في التصحيح والضبط، وشرحت ما أمكنني شرحه من الأسماء العجمية لأنها تلتبس بعجمتها على الناس، ويخطئ في فك معماها معهود القياس"..
لكن الجانب السياسي كان حاضرا بقوة في اختيار ابن جزي لصياغة رحلة ابن بطوطة؛ فهذا الجانب السياسي يرتبط حسب الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ في كتابه سابق الذكر (ص: 186): "بالغاية التي كان يتوخاها أبو عنان من نشر الرحلة؛ فإنه كان يريد أن يستغلها للدعاية له ولأعماله، وأن يجعلها وسيلة للمس بأعدائه والكشف عن مساوئهم، بحيث لا يقتصر ابن بطوطة على نشر الأخبار مجردة بل يضيف إليها في كل مناسبة ما يرفع به شأن بني مرين على العموم. وإذا كان ابن بطوطة قد يوفق في هذا العمل بالنسبة إلى مرئياته العامة فهو ليس له إلمام كبير بكثير من الأحداث التاريخية التي وقعت بالمغرب أيام غيبته الطويلة، لذلك كان من الضروري أن يضاف إليه شخص آخر تكون له دراية بالوقائع الحديثة ومعرفة بأحوال الدولة القائمة (..) ولم يجد أبو عنان من بين كتابه من تجتمع فيه هذه الصفات مثل أبي عبد الله بن جزي، لذلك أمره بجمع ما يمليه ابن بطوطة في كتاب يكون جامعا لفوائده مكملا لمقاصده". ويمكن أن نضيف إلى الجانب السياسي في تكليف ابن جزي بالصياغة الأدبية لرحلة ابن بطوطة جانبا أدبيا؛ إذ أن صاحبنا ابن بطوطة رغم ولعه بالعلم فقها وحديثا وتاريخا وتصوفا، ورغم روايته عن العديد من أساطين العلم في كل البلاد الإسلامية التي زارها، ورغم توليه القضاء بالمغرب وتونس والهند، إلا أنه لم يكن أديبا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، يشهد على ذلك شعره المتوسط الذي بثه في ثنايا الرحلة؛ وبما أن كتابة الرحلة جاءت في إطار مشروع سلطاني فإن اختيار رجل من طينة ابن جزي لأداء المهمة يعود إلى أدبه العالي وتمرسه في فن الكتابة..
إن الحديث عن ابن بطوطة ذو شجون، لكنا نكتفي في خاتمة هذه المقالة في الإلماح إلى بعض القضايا الشائكة التي احتوتها الرحلة، من ذلك ما رواه رحالتنا عن شيخ الإسلام بن تيمية الذي جاء في الرحلة ابن بطوطة رآه في المسجد بدمشق ينزل من المنبر ويشبه نزوله باستواء الرحمن على العرش، وهو ما جعل بعضهم يصف شيخ الإسلام بالتجسيم.. وأريد هنا أن أحيل القارئ الكريم إلى ما كتبه العلامة عبد جنون في كتابه "في اللغة والأدب" (سلسلة شراع العدد 8، 1996) حول هذه المسألة مبرزا ملابساتها ومبرأً ساحة شيخ الإسلام وكاتب الرحلة معا..
وأريد أن أشير كذلك إلى كتاب قيم تناول رحلة ابن بطوطة بشكل جديد ومبدع، وهو كتاب "إيران بين الأمس واليوم" قراءة جديدة لرحلة ابن بطوطة للدكتور عبد الهادي التازي (منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، 1984) ففيه الكثير من الإفادات والاكتشافات.
وبعد، فهذه بعض جوانب من شخصية هذا الرحالة الرائع الذي رفع رأس المغرب عاليا؛ توفي رحمه الله حسبما أورده الخطيب ابن مرزوق –معاصره- سنة 777هـ، وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن وفاته كانت سنة 779هـ.
أما عن قبر ابن بطوطة، فيوجد بطنجة قبر ينسب إليه على الرغم من أنه لم يتوف بها، لكن العلامة جنون يشكك في نسبة هذا القبر إلى ابن بطوطة؛ لأن صاحب هذا الضريح على ألسنة العامة هو أحمد بن علال وليس ابن بطوطة. يقول عبد الله كنون في كتابه عن ابن بطوطة (ص: 34): "وعلى كل حال فهو، وإن يكن ذا صفة رمزية، ضريح متواضع جدا لا يتناسب وعظمة الرجل الذي طبقت سمعته الآفاق". رحم الله ابن بطوطة وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.







