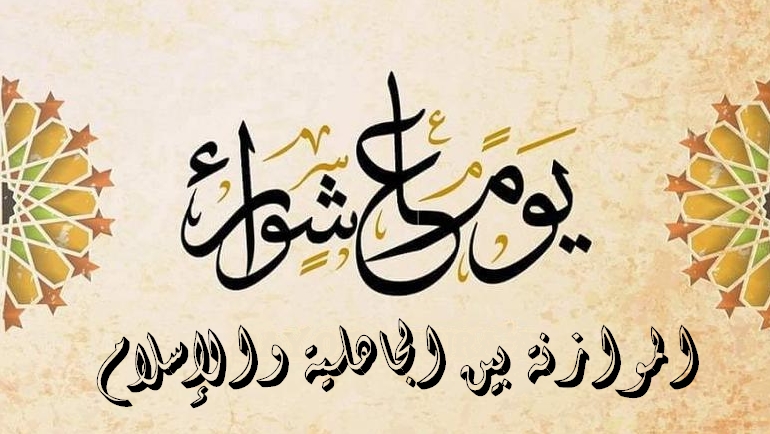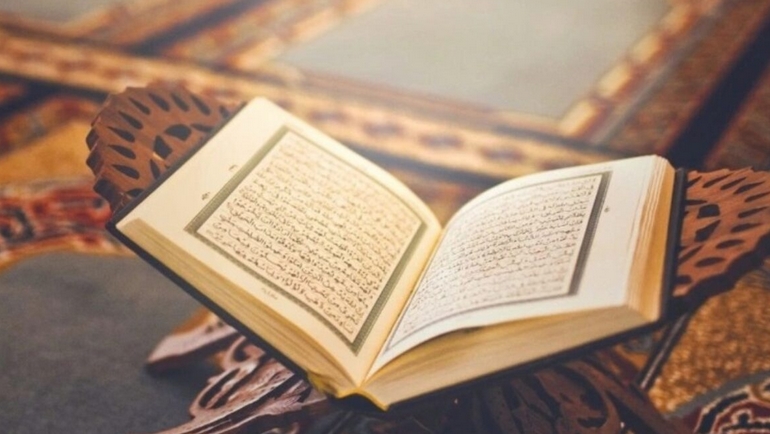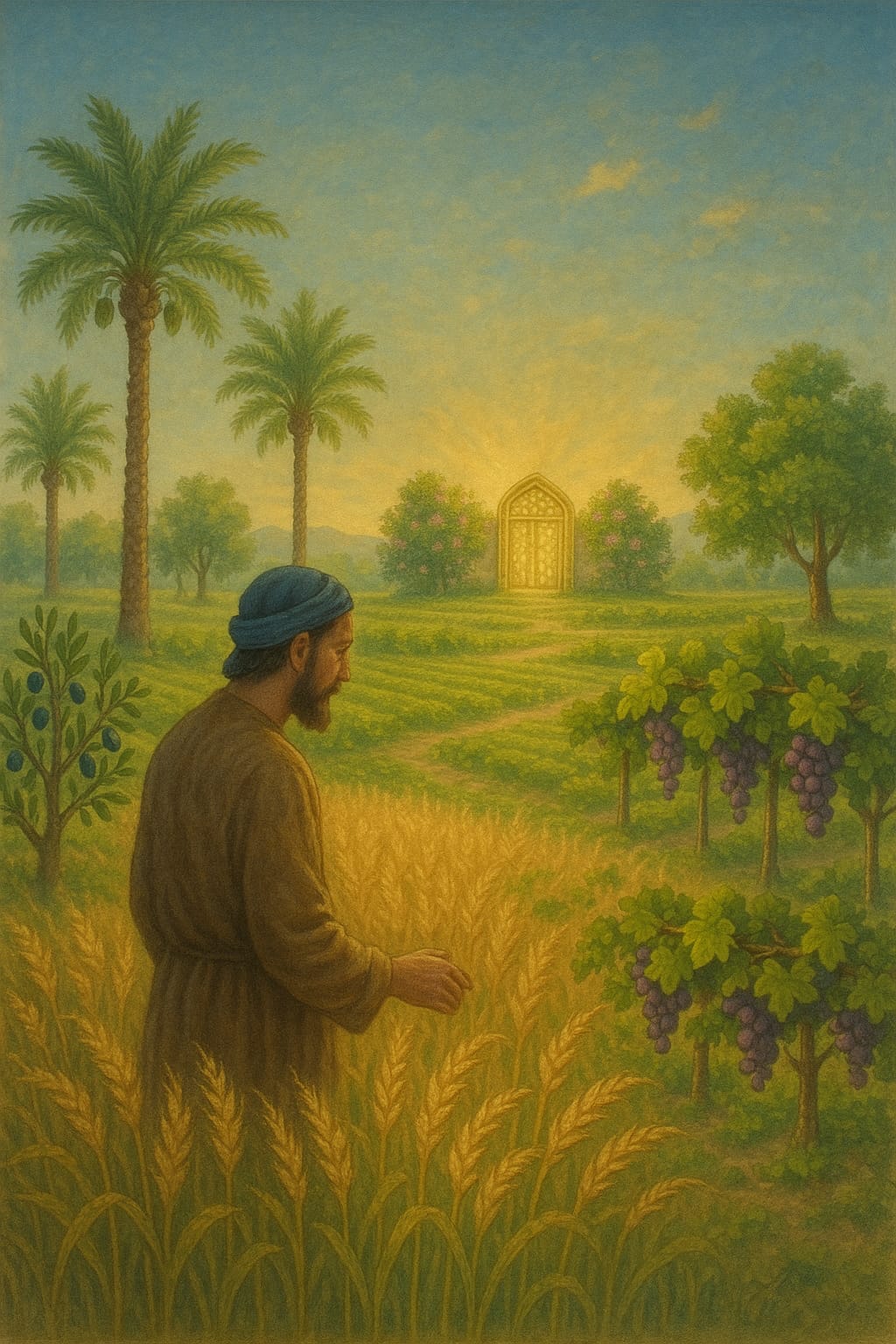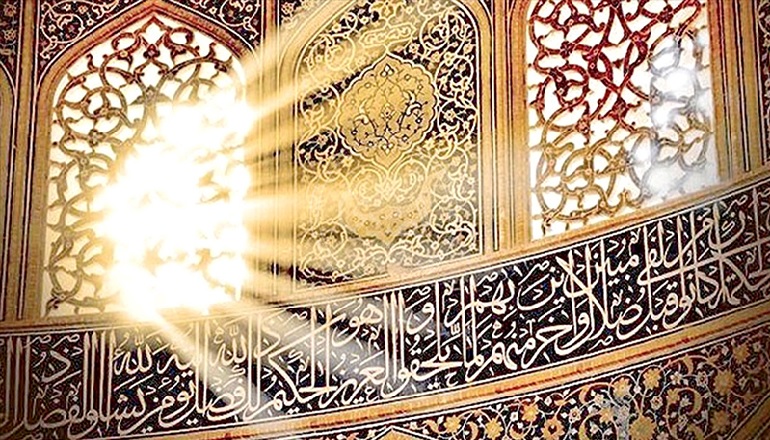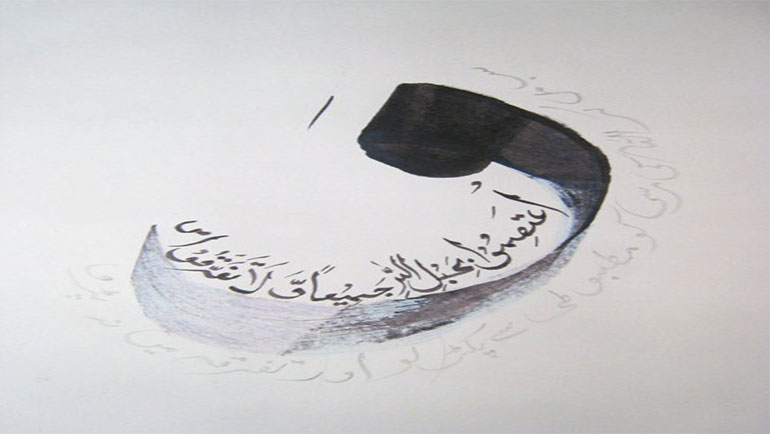أسْرَارُ البَيَان في القُرْآن(29) البَيَانُ في حَذْفِ يَاءِ المتَكَـلِّم في قَوْلِهِ تعَالى: ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾

وذلكَ قولُهُ تعَالى في سُورَة (النَّمْل): ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾. حيثُ يَستَوقفُكَ الفعْلُ (تَشْهَدُونِ) . فتَقضِي بَدَاءةً بأنَّهُ فعلٌ مُضارعٌ منَ الأفعَال الخَمسَة، وقدْ رُفِعَ بثُبُوت النُّون في آخِرهِ، لأنّهُ يبدُو علَى شَاكلَة أَفعالٍ منْهَا؛ مِثْل (تَعْلَمُون – تَهْتَدُون – تَنْظُرُون...). لكنَّكَ لا تَزالُ علَى ذُكْرٍ منْ أَمرٍ ذي بالٍ، فتذكُرُ أنَّ (حَتى)، إذَا دَخلتْ علَى الفِعْل المضَارع، نَصبَتهُ بوَاسطةِ (أَنْ) مُضمَرةً، وأنَّ علامَةَ نَصبِ الأفعَال الخَمسَة هيَ حذفُ النُّون، مِثلَ مَا تجدهُ في قولهِ تعَالَى ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾.
وبِشَيْءٍ منَ التّدبُّر، تَكتَشفُ أنّ الفعلَ (تَشْهَدُونِ)،وإنْ كانَ منَ الأفعَال الخَمسَة، فقَدْ جاءَ علَى حالةٍ ذاتِ خُصُوصيّة بَيانيّة فريدةٍ. ذلكَ أنَّ أصلَهُ: (تَشْهَدُونَنِــي)، وأنَّهُ وقعَ فيهِ حَذفَانِ: حذفُ (النُّون) لأَجْل النَّصْب، وهيَ (النُّون) الأُولَى ، وحَذفُ (يَاء المتَكَلّم) لِـمزيَّةٍ بَلاغيَّةٍ تَكرَّرَت كَثيراً في القُرآنِ. فبَقيَت في آخِر الفِعْل(النُّونُ)الثَّانيَة وهيَ(نُونُ الوِقايَة)،وتحْتَها الكَسرةُ،دَالّةً علَى اليَاء المحذُوفَة.
لذَلكَ تَجدُ هذَا الفعْلَ المضَارعَ في الآيَة،مَشكُولاً بالكسرَةِ في آخرهِ (تَشْهَدُونِ). لكنَّ الوَقفَ علَى الفِعلِ بالسُّكُون، لأنَّهُ فاصلَةُ الآيَة، يُخْفِي هَذهِ الكَسرةَ نُطقاً ، فيَغفلُ عنهَا القَارئُ، خاصّةً وأنَّ الفَواصلَ السَّابقَة واللّاحقةَ، تَنتَهى بنُونٍ مَفتُوحةٍ: (يَرْجعُونَ - مُسلمِينَ - تَأمُرينَ - يَفعَلُونَ) ؛فكلُّهَا جاءَتْ مَفتوحَةَ(النُّون)،لكنْ يُوقفُ عَليها بالسُّكُون.
وَيَمتَدُّ هذَا الإيقَاعُ الصَّوتيّ بالمدّ العَارضِ للسُّكُون، مُتردِّداً في الفَواصِل، فيُخْفِي اخْتِلافَ الحَركَة بالكَسْر في (تَشْهَدُونِ). كمَا أخفَاها في أَواخرِ سُورَة (البُرُوج) ؛ فيَكادُ القَارئُ لا يَنتَبهُ إلى الضَّمّة في قولهِ تعَالى ﴿في لَوْحٍ مَحْفُوظٌ﴾ علَى روَايَة(وَرْشٍ عنْ نَافِع)، فيكُونُ (مَحْفُو ظٌ)،بذَلك نَعتاً لكَلمَة(قُرْآنٌ)،المرفُوعَةِ في الآيَة السَّابقَة:﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾. بَينَمَا تَجدُهَا في قِرَاءَة(حَفصٍ عنْ عَاصِم) مَجرُورةً: ﴿في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾،فهيَ نَعتٌ لقَولهِ(لَوْحٍ) تَابعٌ لهُ في جَرّهِ. لكنْ عندَ التّلاوَةِ يُوقفُ علَى(مَحْفُوظ) بالسُّكُون، فلَا تَبِينُ الحَركَةُ، فَتَتسَاوَى القِراءَتَان، إلّا عنْدَ الْـمُتمكِّن منْ دقائِقِ قَواعدِ التَّجْويدِ، فيَقفُ علَى (مَحْفُوظ) بِـــــ(الرَّوْمِ)، يُشيرُ بهِ إمَّا إلَى (الرَّفْع) أوْ إلَى(الجَرّ).
وقدْ ورَدَ هذَا المضَارعُ (تَشْهَدُونَ) في الفَاصلَةِ، مَرفوعاً والنُّونُ فيهِ مَفتوحَةً، في آيتَيْن،إحدَاهُما، قولُهُ تعَالَى في سُورَة البَقرَة : ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾، والأُخْرَى في قَولهِ تعَالَى في سُورَة(آل عِمْرَان): ﴿لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾.فالفعلُ (تَشهَدُونَ) هُنا مَرفوعٌ بثُبُوت النُّون، وهيَ (نُون) مَفتوحَة علَى الأَصْل. لكنَّ الوقْفَ عَليهَا بالسُّكُون أيضاً،يُخْفي تِلْكَ الفتحَةَ.
ومثْلُ هذَا الحَذفِ معَ (حَتّى)، لمْ يَقع في القُرآنِ إلا مَرّتينِ: مرّةً في هذهِ الآيَة، وَمرَّةً في الآيَة الّتي في سُورَة (يُوسُف)، وهيَ قولهُ تعَالى ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ﴾،إذِ الأصلُ فيهُ: (تُؤْتُونَــنِــــي)، حيثُ حُذفَت (النُّونُ) الأُولى منَ الفِعْل، لأجْلِ النَّصْب (بأَنْ) مُضمَرةً بعدَ(حَتّى)، وبقِيَت (نُونُ الوقايَة) مَكسُورةً ، دالّةً علَى حذفِ (يَاء المتكَلّم). ومثلُ هذهِ الآيَة في النَّصبِ،لكنْ (بأَنْ) ظاهرَةً، قولهُ تعَالى في سورَة (يُوسُف): ﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾. وقولهُ عزّ وجَلّ في سُورَة(المؤْمِنُونَ): ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾. ومنهُ، عَلى شَاكلَتهِ، مَا جاءَ علَى الجَزمِ، كقَولهِ تعَالى في سورَةِ (الأَنْبِيَاء): ﴿سَأُريكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ ؛هكذَا جاءَت بِكسْرِ النُّون. والأَصلُ (تَسْتَعْجِلُونَـنِــــي).في حين تَجدُهَا مَفتوحَةً في سُورَة(يُونُس)، في قولهِ تعَالى: ﴿وقَدْ كُنتُمْ بهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾.
فإذَا أَوليْتَ الأمرَ فَضلَ تدبُّرٍ، انكَشفَ لكَ منْ ذلكَ بَيانٌ لَطيفٌ مُعجِزٌ ، يتبدَّى في تِلْكَ الحَرَكةِ المرسُومَة خَطّاً تحتَ النُّون،والْـمَخفيَّةِ لَفظاً عندَ الوَقفِ، تُبْصرُهَا العَينُ ،وَلا تَسمَعُها الأُذْنُ.في انْزيَاحٍ صَوتيٍّ بَديعٍ،خرجَ بكَ في حَرفِ (النُّون) منَ (الفَتحِ) إلَى (الكَسْرِ).فَتحٍ كانَ ارْتبَطَ في ذِهْنكَ بمَا يُحيلُ إلَى (الجَمْع)، وكَسرٍ ارْتبَطَ في ذِهنكَ بمَا يُحيلُ إلَى(التَّثْنيَة).وكأنكَ تَلمَس عَلاقةً صَوتيَّة بينَ (النُّون) المفتُوحَة في(الفعْل):(تَشْهَدُونَ)بضَمير الجَمْعِ،و بينَ(الاسمِ)الْـمَجمُوع: (شَاهِدُونَ). كمَا تَلمَسُها في (النُّون) الْـمَكسُورَة في الفِعْل بضَمير التَّثنيَة:( تَشْهَدانِ)، و بينَ (الاسمِ) المثَنّى: (شَاهِدَانِ).
أمَّا الإعرَابُ في مثلِ هذهِ الحالَة، فيسَتلزمُ أنْ يُذكرَ فيهِ ما حُذِفَ، بَياناً لِـما طرَأَ علَى الْفعْل؛ فنَقُول: (حتى تَشْهَدُونِ): فعلٌ مُضارعٌ مَنصوبٌ بأنْ مُضمَرةً وُجوباً بعدَ (حَتّى)، وعَلامةُ نَصبهِ حذفُ النُّون لأنّهُ منَ الأَفعَالِ الخَمسَة. و(النُّونُ)،نُون الوقايَة. و(يَاءُ المتكَلّم) المحذُوفةُ ضَميرٌ مُتَّصلٌ مَبنيّ علَى السُّكُون في مَحلِّ نَصبٍ مَفعولٌ بهِ.
وأنتَ تَرى أنَّ هَذا الحَذفَ، قَد خَرجَ بالكَلمَة عنْ أصْلِها، وغَـيَّـر بِنْيَــتَـــها، ولا يَخلُو ذلكَ منْ مَزايا بَيانيّة، قدْ تَدقُّ وتَلطُفُ، حتَّى لَيَكادُ النّاظرُ لا يُدركُ لهَا غَوراً، ولا يَكشفُ لهَا سِرّاً. وإنَّ ذلكَ ليَعقبُهُ أثَرٌ منْ زيَادةِ مَعنىً، وَانفساحٍ في الدَّلالاتِ.وقدْ تَنبّهَ لذَلكَ القُدمَاء. وممَّا يُستَأنَس بهِ في هَذا السِّيَاق، ما وَردَ في كتابِ (البُرهَان في عُلُوم القُرآن)، لِلإمَام(الزَّركَشيّ)،إذْ قالَ في سيَاق كلامِهِ عنْ حَذفِ(اليَاء) في قولهِ تعَالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾: « وَيُحْكَى عَنِ الْأَخْفَشِ-[هوَ الأخفَشُ الأكْبَر، أبُو الخَطّاب عَبدُ الحَميد بْنِ عَبدِ المجِيد-تــــ177ه]-، أَنَّ الْـمُؤَرّج السَّدُوسيّ-[أبُو فَيْدٍ مُؤَرّج بنُ عَمْرو-تـــ 195ه]-، سألَهُ: عنْ ذلكَ فَقَالَ: لَا أُجِيبُكَ حَتَّى تَنَامَ عَلَى بَابِي لَيْلَةً. فَفَعَلَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ إِذَا عَدَلَتْ بِالشَّيْءِ عَنْ مَعْنَاهُ، نَقَصَتْ حُرُوفَهُ. وَاللَّيْلُ لَـمَّا كَانَ لَا يَسْرِي، وَإِنَّمَا يُسْرَى فِيهِ، نَقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ». ونفسُ الكلَام ذكَرهُ الإمامُ(السّيُوطيّ) في(الإتْقَان في عُلُوم القُرآنِ)، وكذلكَ جاءَ في كتابِ(عَرُوس الأَفْرَاح) للإمَام(بهَاء الدِّين السُّبْكيّ).
وَ إنَّكَ لَتقِفُ منْ ذَلك الحَذفِ علَى لَفتاتٍ بَديعَةٍ، تَشعُّ منهَا وَمضاتٌ، تَستَثيرُ الفِكرَ وتَستَـهْوي النَّظَر.ومنْ ذلكَ آخرُ فاصلَةٍ في سُورَة (الكَافِرُون)، في قولهِ تعَالَى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِــيَ دِينِ﴾،حيثُ يَحصلُ الوَقفُ علَى كلمَة(دِينِ)، بمَدّ يَسْتلزمُ فضْلَ تأمُّلٍ؛ ذلكَ أنَّ كَلمَة(دِينِ) جَاءَت مَحْذُوفَةَ اليَاءِ رَسْماً. مِمَّا غيَّرَ حُكْمَ الوَقفِ عَليْـهَا، منَ الْـمَدّ الطَّبيعِيّ القَاصِر الّذي يُمدُّ حَرَكتَيْن،إلَى الْـمَدّ العَارِض للسُّكُون، الْـمُسْتَطِيل،الّذي قدْ يَصلُ بالإشْبَاع إلَى ستِّ حَركاتٍ. لأنَّ النُّونَ المُتحَركةَ إذا وَقفْتَ عَليْهَا سَكَّنْتَهَا، فمُدَّت اليَاءُ التي قبْلَهَا، كمَا تمَـدُّ الوَاوُ في (الكَافرُونَ)، لنَفْسِ السَّبَـب. وَلوْلا حَذْفُ (ياءِ المتَكلِّم) مِنها لَـمَا حَدثَ ذلكَ. فقَولُكَ (دِينِـي) بإظهَارِ اليَاءِ في آخِرهَا، يَسْتلزمُ أنْ تَقفَ علَيْهَا بالمدِّ الطَّبِيعيّ. فانْظُرْ كيفَ نَشَأَ عنْ حذْفِ تلكَ اليَاءِ انْسِجامٌ صَوتيٌّ امتدَّ على ثَلاث فوَاصِل: ( الكَافرُونَ – تَعبُدُونَ – دِينِ).ومَا منْ شكٍّ، فَفي ذلِكَ لَطائفُ منَ المعَاني، وكَوامِنُ منَ الدَّلالاتِ.