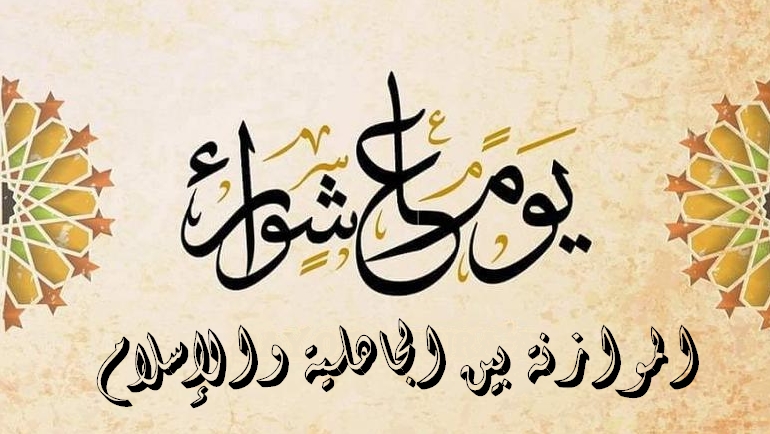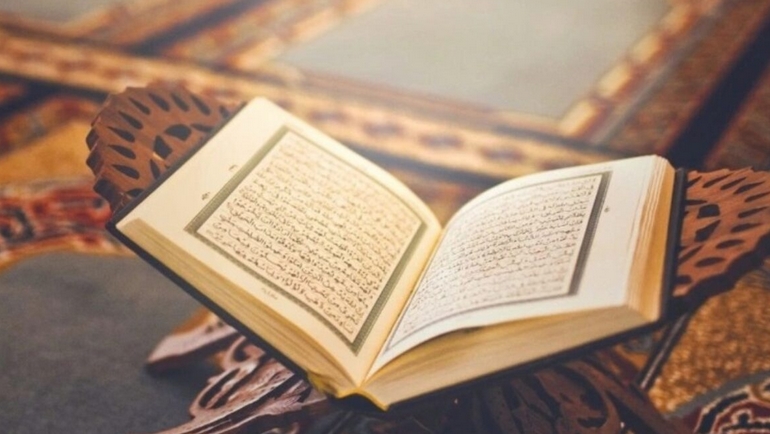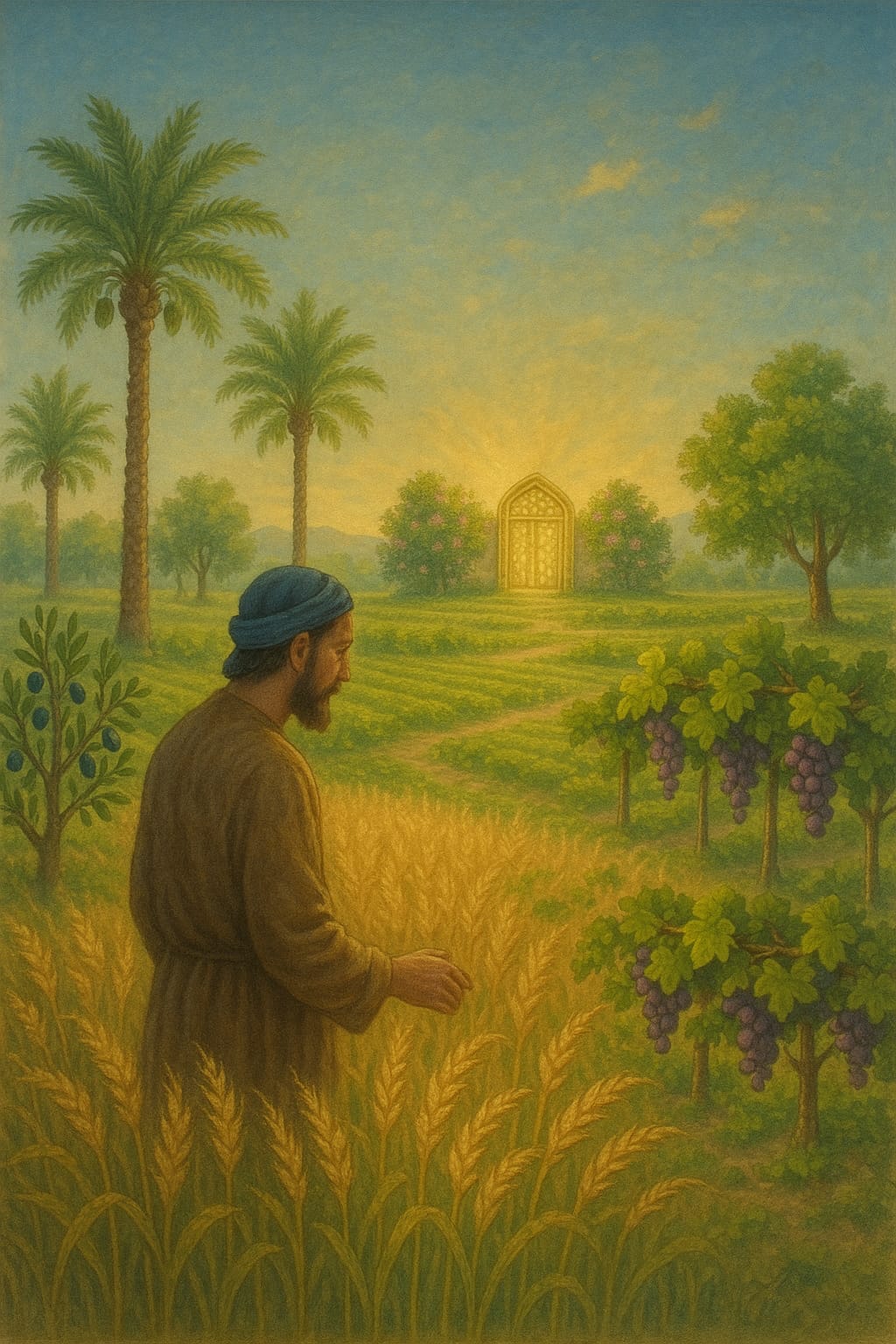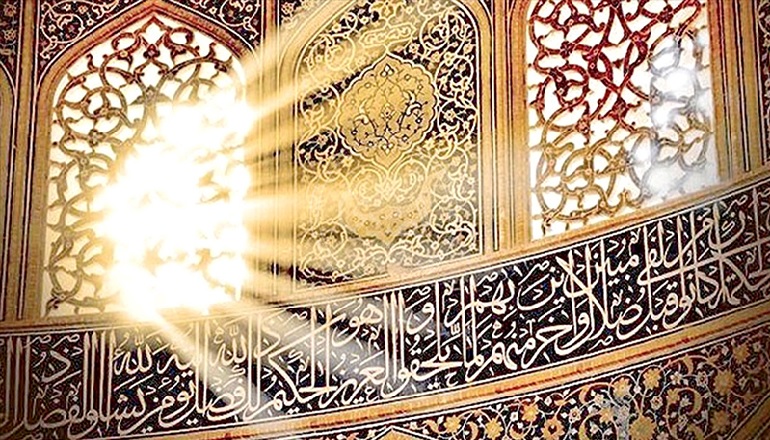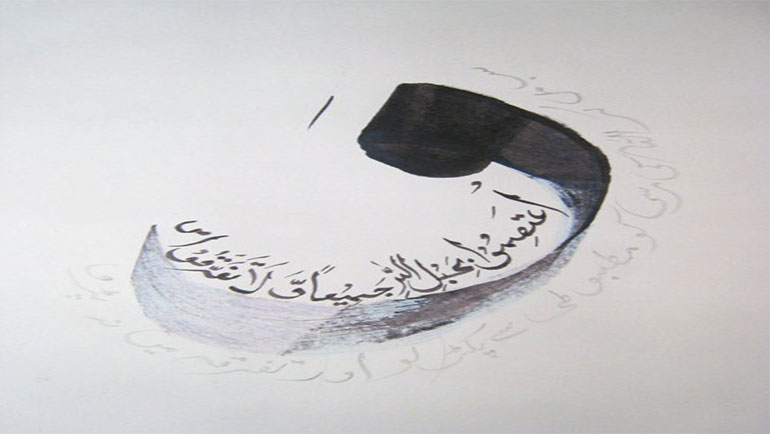أسْرارُ البَيَان في القُرْآن(35). البَيانُ في الفَرقِ بينَ جَمعِ التَّكسِير في قَولهِ تعالَى في سُورَة(البَقَرَة): ﴿سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ ، و الجَمعِ السَّالِم في قولهِ عزَّ وجلَّ في سُورَة(يُوسُف):﴿سَبْعَ سُنْـبُلَاتٍ﴾.
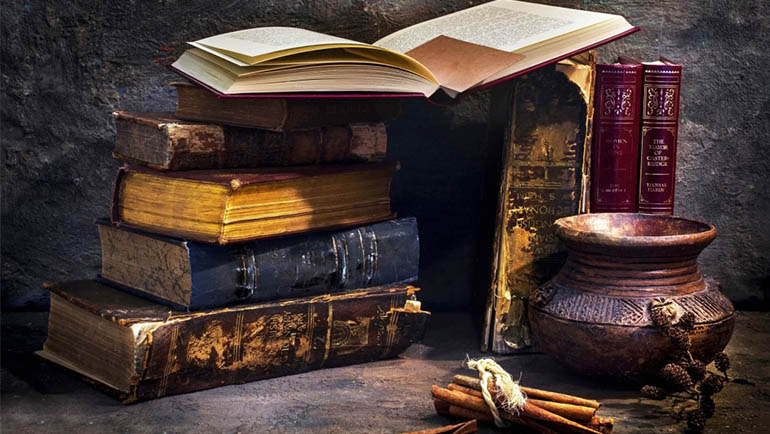
و ذلكَ قولهُ تعالَى في سُورَة (البَقَرَة) : ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، في كُلِّ سُنبُلَةٍ مائَةُ حَبَّةٍ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِـمَن يشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. وقولُه عزّ وجَلَّ في سُورَة (يُوسُف): ﴿وَقالَ الملِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾. فَأنتَ تَرى أنّ كلمَةَ (سُنْبُلَة)، قدْ جُمعَت في الآيَتين جَمعَين مُختَلفينِ: (سَنابِل)، وهوَ جَمْعُ تَكسيرٍ للكثْرَة ، و (سُنْبُلات) ، وهُو جمْع مُؤنَّث سَالِم . والجَمعُ السَّالمُ، ويُسمّى أيضاً الجَمعَ الصَّحيحَ، في أصلهِ دَالٌّ علَى القِلّة.
ومنَ المعلوم أنّ دَلالةَ الجمعِ علَى القِلّة، تَثبُت في جمْع التّكسِير، بِصِيَغ تجعَل العَدَد بينَ الثَّلاثَة و العَشَرةِ. وهيَ أربَعةُ أوزانٍ جَمعَها (ابنُ مَالكٍ) في قولهِ:
أَفْعِلَةٌ أَفْعُلٌ ثُمَّ فِعْلَة *** ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّة
ومَا عدَا هذهِ الأَربَع منَ الصّيَغ، فإنَّمَا هيَ دَالّةٌ على الكَثْرَة. فالأمْرُ في جَمعِ التَّكسيرِ يَكادُ يَكونُ مَحسوماً من خِلال أَوزَان الصّيَغ المعلومَة. لكنّ الأمرَ ليسَ بهَذا الفَصْل الحَاسِم، فاللّغَة في إنجَازِها كَلاماً وخِطاباً، إنّمَا تَحُفّها مَقاماتٌ وأحوَالٌ وسياقَاتٌ، لهَا أثَرهَا في بناءِ المعْنَى وتَوجيهِ الدّلالَة. كمَا أنّ الاستعمَالَ، وجَريَانَ الصيغَةِ علَى الألسُن، وكثرَةَ الوُرودِ، يَرتقي باللَّفظَة إلى تَفضيلٍ ذي اخْتِياراتٍ، يَكادُ مَعهَا يُغَيَّبُ غَيرُها. فكلماتٌ مثلُ(رِجْل – عُنُق – فُؤَاد)، لمْ يَشعْ منهَا علَى أَلسُن النّاس سِوى أَوزانٍ منْ صيغِ القِلّة: ( أَرْجُل – أَعْنَاق – أَفْئِدَة)، ولمْ يُستَعمَل لهَا منْ أوزانِ التَكسِير الأخْرَى شيءٌ إلا نَادراً. ومثلُها علَى صِيَغِ العَكسِ منَ الكثْرَة: (رَجُل – كِتَاب – قَلْب)، قَالوا فيهَا علَى الغَالبِ الشَّائعِ: (رِجَال – كُتُب – قُلُوب).فَلا تَنْمازُ دلالةُ الكَثرَة فيهَا منْ دلالَة القِلَّة إلّا بِقرينَةٍ.
وأمَّا الجمعُ السَّالمُ، فقدِ اعتبَرهُ كَثيرٌ منَ النُّحاةِ دالّا علَى القِلّة. وذلكَ لاعتِباراتٍ بِنائيّة وصرفيّةٍ، تَلحقُهُ فتَجعلُهُ أقرَبَ إلى المثَنّى. قالَ (ابنُ يَعيشٍ) في(شَرحِ المفصّل): «ومنْ ذلكَ جَمعَا السَّلامَة؛ بالوَاو والنُّون نحوُ (الزّيدُون، والْـمُسلمُون)، والألِفِ والتَّاءِ. فهَذانِ البِنَاءَان أيْضاً منْ أَبنيَة القِلَّة؛ لأنّهُما علَى مِنهَاج التَّثنيَة، والتَّثنيَةُ قَليلٌ، فكانَا مِثْلَه». فهذهِ قاعدَتُه الكُلّيّة، لكنْ يَحدُثُ فيهِ أيْضاً لاعْتبارَات بَلاغيَّة، أنْ يُنقَل من أَصلِ دَلالَتهِ، إلَى الدّلالَة علَى الكَثرَة. فيخرجُ عنْ دلالتِهِ الحَقيقيّة إلى دَلالةٍ مَجازيّةٍ، تُبرزُها قَرائنُ حَاليّة ومَقاميَّة.
والبَيتُ المشهُورُ (لِحسّان بْنِ ثَابِت)، ومَا صَحبهُ منْ آراءٍ نَقديّةٍ، يَكشفُ عنْ هذَا الاتّساع في دَلالاتِ الصِّيَغ الصّرفيّة. فقدْ ذكرُوا أنّ (النَّابغَةَ الذُّبيانيّ) انتقَدهُ عندما أنشدَهُ بَيتهُ:
لنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَى*** وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا
فقالَ لهُ: «أَنْتَ شاعِرٌ، وَلكنَّكَ أَقْلَلْتَ جِفَانَك وأَسْيَافَك». لكنّ أئمّةً في اللغَة انتَصَروا(لِحَسّان)،وجَعلُوا الجمعَ في البَيتِ، معدولاً، دالّا علَى الكَثرَة: قالَ(ابنُ الأنبَاريّ) في (المذكَّر والمؤَنّث):« وَاعلَم أنَّ كلَّ اسْمٍ مُؤَنّثٍ يُجمَعُ بالألفِ والتَّاءِ؛ كَقولكَ: هِنْدٌ والهِنْدَاتُ، وزَيْنَب والزَّينَبَات. والألفُ والتّاءُ لجَمعِ القَليلِ، وربَّمَا كانتْ للكَثيرِ. قالَ حَسّانُ:...».ثمَّ ذكرَ البَيتَ. وقالَ (ابنُ جنّي) في(المحتَسَب): «والأَلفُ والتّاءُ مَوضُوعتَان للْقِلّة، فهُمَا عَلى حدّ التَّثنيَة، بمَنزلةِ (الزَّيدُون) منَ الوَاحد إذَا كانَ علَى حدّ (الزَّيدَان). هذَا مُوجِبُ اللَّغة علَى أَوضَاعِها، غيرَ أنَّهُ قدْ جاءَ لفظُ الصِّحّة، والْـمَعْنَى الكَثرَةُ، كقولهِ تعَالى:﴿إِنَّ الْـمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ﴾، إلى قولهِ تَعَالى: ﴿وَالذّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذّاكِراتِ﴾، والغَرضُ في جَميعهِ الكَثرَةُ، لا مَا هوَ لِـما بَينَ الثلاثَةِ إلَى العَشرَة». ثمّ ذكرَ إنكارَ أُستاذهِ(أَبي عَليّ الفَارسيّ) لِقصّةِ (النَّابغَة)، فقالَ: « قالَ (أَبُو عَليّ): هَذا خبرٌ مَجهولٌ لا أَصلَ لهُ؛ لأنَّ اللهَ تعَالى يقولُ:﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ﴾، ولا يَجُوز أنْ تَكونَ الغُرَف كُلُّها الَّتي في الجنَّة منَ الثّلاثِ إلى العَشْر».
وعليْهِ، فيَجتمعُ لنَا من كلِّ هذَا، علَى اقتِضابِه، أنّ الدّلالةَ في الجمعِ، علَى القلَّة أو الكَثرةِ، وإنْ كانَتْ في أَصلِها، تَرجعُ إلى البِنيَة الصَّرفيّة بأوزانٍ مَخصُوصةٍ، أوْ زيادَة أحرفٍ تَنقلُ المفرَدَ إلى الجَمع، فإنَّ للمَقامَات والسّياقَات، تَأثيراً علَى تَوجيهِ الدَّلالَة، وتَخصِيصِ المعْنَى، فتُشرقُ منْ ذلكَ وَمَضاتٌ بَيانيّةٌ، وتَتدلّى قُطوفٌ دَانياتٌ منَ اللَّطائفِ البلاغيَّة الّتي تَستوقفُ النّظَر، وتَستثيرُ الفِكْر.
والمتدَبِّر لِلآيتَيْن الكَريمَتَين، يجدُ أنَّ (سَنابل) في (البَقرة)،جَمعُ تَكسيرٍ جاءَ علَى صيغةٍ تدلّ بوزْنِها(فَعَالِل)، علَى (الكَثرَة)،لأنّها ببَساطَة، خَالفتْ أوزَانَ القلَّة الأَربَعة. بَينمَا (سُنْبُلات) في(يُوسُف) هيَ جمعٌ سَالمٌ، بزيَادة(ألفٍ وتاءٍ مَبسُوطَة)في آخِر المفرَد. وهوَ جمعٌ كمَا رَأينَا دالٌّ علَى القلَّة. وعلَى هذَا، تُدركُ أنَّ آيةَ (يُوسُف) جاءَتْ علَى الأَصْل؛ حيثُ العَددُ ( سَبْع ) عددٌ قلِيلٌ، وناسبَهُ الجمْعُ السَّالمُ (سُنبُلات ) الدّالُّ في صيغتهِ علَى القلَّة.
لكنّ آيةَ (البَقرَة) ، تستلزِمُ وقفةً للتَّدبُّر، حيثُ جَمعتْ بينَ عددٍ قليلٍ، (سَبْع) ، وجمعِ تَكسيرٍ دالٍّ علَى الكَثرَة (سَنَابِل) ؛ فاسْتِعمَال اللَّفظ الدّالّ علَى العدَد: (سَبع)،وهوَ عددٌ داخلٌ في أعدَاد القَليل، خلقَ في آيَة(البَقرَة): ﴿سَبْعَ سَنَابِل﴾، تَوَتُّراً نَظميّاً خَفيّاً، فهذَا الانزيَاحُ بالعُدُول عنِ الصِّيغَة الَّتي دَرجَ استِعْمالُها ، إنّمَا هوَ ارتقَاءٌ بَلاغيٌّ، يُخفِي لَطيفَةً بَيانيّةً بَديعَةً، تَكشفُ لكَ عنْ دلالَة في الغَايةِ منَ الاتّسَاع والاسْتِفاضَة.
ذلكَ أنّ الحَديثَ في (يُوسُف) عنْ (سُنبُلات) قَائمَاتٍ مُكتَملاتٍ، تَامّات الخِلْقَة، مَحصُورَات العَدَد. أمَّا الحَديثُ في(البَقرَة) فعنِ(الحَبَّة)في أَصلِ بَذْرِها، وهيَ الَّتي تُستَصغَرُ حَجْماً و وَزناً. فكانَ التَّذكيرُ بعَظمَة القُدرَة الإلَهيّة في أنْ تَتفرَّعَ الحبةُ الوَاحدةُ، علَى صِغَر حَجمِها، في إنْباتِـهَا، فُروعاً، فتُخرجُ سَبعاً أعظَمَ منهَا في الحَجْم و أوفرَ في العَدَد، ثمَّ لا تكونُ هذهِ السّبعُ علَى ما تَتصوّرُهُ الأذهَانُ، ودرجَتْ عليهِ الأفْهَام منِ اسْتِقلالِها هذَا العدَد، بلْ عرَضَتْ في انْزيَاحٍ، عمَّا يُتوقّعُ أنّهُ يَستَتبعُ العادةَ، إلى بِنيَةٍ صَرفيّةٍ دالَّةٍ علَى الكَثرَة. فكانَ ذلكَ النَّظمُ المتفَرّد، في جَمعهِ بَينَ عدَدٍ دالٍّ علَى القَليلِ، وإضَافتهِ إلَى تَمييزهِ بصيغةِ جَمعٍ دالٍّ علَى الكَثرَة: ﴿سَبْعَ سَنَابِلَ﴾،ليَستَتْـبعَ ذلكَ بيانٌ عنْ هذَا النَّظمِ البَديعِ اللَّافت، فَتَتَـنَاسَل الكثْرَةُ مُنْـهَلَّةً؛ ذلكَ أنَّ الحبَّةَ الوَاحدةَ تَزْكُو في اسْتِزادَةٍ تَتَكَوْثَرُ إلى سَبعِمائَة حَبَّةٍ : ﴿في كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَة حَبَّةٍ ﴾ ، ثمَّ تَرْبُو في تضاعُفٍ إلى غايةٍ لا يَعْلَمُ مُنتهَاها إلا اللهُ تعَالى: ﴿وَاللهُ يُضَاعِفُ لِـمَنْ يَشَاءُ﴾. ثمَّ انتَهَى كلُّ ذلكَ إلى الفَاصلَة الْـمُنيفَة الوَارفَة: ﴿وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾،بهذا الجَلالِ في الاحْتِوَاء، وذاكَ الكَمَال في الإحَاطَة.
وهكذَا يُطالعُكَ هذَا السّبْكُ والحَبْكُ في عِقدٍ مُنتَظِم منَ التَّكَوْثُر الصَّاعِد الغامرِ. فناسبَ السّيَاقَ في الآيَة أنْ تكونَ الصّيغةُ علَى وزنٍ منْ أوزانِ جُمُوع الكَثرةِ ( سَنَابِل)، لتَخلُق هذَا التَّوتُّر النَّظميّ الدقيقَ الَّذي يَستوقفُ القَارئَ، ويَدفعَهُ إلى فَضْلِ تَدبُّرٍ، لعلّهُ يُدركُ نَفحةً من أسْرارهِ، فيعرفَ فضلَ اللهِ عَليهِ، في نِعمهِ الغَامرَة، بالثَّوابِ الكَثير الجَزيلِ علَى العمَل القَليلِ اليَسيرِ . أمّا في (يُوسُف)، فجاءَ التَّركيبُ علَى الأَصلِ، لأنَّ السُّنبُلات كانتْ سَبعاً في العددِ، لا تَكاثُرَ فيهَا ولا اسْتزَادَة. قالَ (ابنُ القَيّم) في (الجَامعِ لأمْثَال القُرآنِ): «وَتأمّلْ كيفَ جمَعَ (السُّنبُلَة) في هذهِ الآيَة علَى (سَنَابِل)، وهيَ منْ جُمُوع الكَثرَة، إذِ الْـمَقامُ مَقامَ تَكثيرٍ وتَضعِيفٍ؛ وجَمَعَها علَى(سُنْبُلات) في قَولهِ: ﴿وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾، فجاءَ بهَا علَى جَمْع القِلَّة؛ لأنَّ السَّبعَةَ قَليلَةٌ، وَلا مُقتَضَى للتَّكثِير»